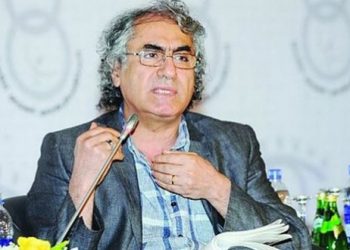د. آدم غارفينكل هو محرر فخري في “آميركان إنترست”.
خاص بـ”المسبار”
ترجمة: أحمد مغربي
في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 جرت حادثتان إرهابيّتان في الولايات المتّحدة، كانت إحداهما قاتلة والأخرى، حمداً لله، لم تكن كذلك. أُشيرُ بالطبع إلى جريمة قتل (11) يهوديّاً أثناء أدائهم صلواتهم في كنيس في “بتسبرغ” صبيحة يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول)، وقبلها بأيام قلائل، أُرسِلت مجموعة من القنابل الأنبوبيّة -العاطلة عن الانفجار وفق ما تبيّن لاحقاً- إلى شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي. ما الذي تتشارك الحادثتان فيه، وما مغزاهما؛ ليس بالنسبة إلى الولايات المتّحدة وحدها، بل كل الشعوب والأمم خارجها، وهي التي تتطلع إلى الولايات المتّحدة كمصدر للحماية أو الإلهام أو كلا الأمرين معاً؟
أول ما تتشاركه الحادثتان أنهما مجرد حلقة أخيرة من سلسلة طويلة من الإرهاب الداخلي -يتعلّق كثير منه بتلامذة مدارس، فيما الآخر أكثر صراحة في طابعه السياسي على غرار المقتلة الدامية في “تشارلوتسفيل” بولاية فيرجينيا في صيف 2017. لطالما شملت حوادث إرهاب داخلي في الولايات المتّحدة، مسلمين –لنتذكر مثلاً “فورت هود”، “سان برناردينو”، أورلاندو، وماراثون بوسطن-، لكن لم يكن معظمها كذلك في السنوات القليلة الماضية. وفيما يرجع كثير منها إلى ما قبل الصعود السياسي لدونالد ترامب، إلا أنها شهدت تصاعداً مقصوداً تمطّى منذ حملاته (ترامب) الانتخابيّة ثم فوزه وتنصيبه رئيساً. تمحور ذلك التصاعد حول عبارات التعصّب وكراهية الأجانب، وهي وُجِّهت ضد الأفارقة- الأميركيّين؛ والمهاجرين الذين أدانهم الرئيس ترامب في خطاب تنصيبه ولا أقل من ذلك، بكونهم مسؤولين عن “مجزرة”؛ والآن اليهود.
عقب الحادثتين (في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018) اللتين ارتُكِب كلاهما من قِبَل مستوحِد تقليدي، وهي شخصيّة حذّر منها جميع خبراء الإرهاب؛ إذ لم يكن سيزر سايوك وروبرت باورز سوى اثنين من بين كُثُر؛ قدّم دونالد ترامب من البيت الأبيض، وكذلك نائبه مايك بِنْس، إدانات تقليديّة لتلك القضايا، مع تعازٍ سطحيّة.
لم يُشِر أيٌّ منهما إلى وجود حاجة لمزيد من الصرامة في قوانين حمل السلاح -وهي لها دلالتها في حال باورز-، حتى إن ترامب أنحى باللائمة على كنيس “بيتسبرغ” لأنه لم يكن يؤجر حارساً مسلحاً لحمايته. ولم يُصَنّفا (ترامب وبِنْس) الحادثتين كعمل إرهاب مسلّح، على الرغم من استحالة توصيفهما بدقة على غير ذلك النحو.
أسوأ من ذلك، وكإضافة قويّة إلى الهـالة الأورويليّة المحيطة بواشنطن، أعلن بِنْس أنه لا يمكن إلقاء نأمة من اللوم على التطرّف أو خطاب الاستفزاز السياسي المتطرّف، بشأن أجواء التشجيع على العنف. “لكلٍّ أسلوبه الخاص، وبصراحة، يستخدم الناس على الجانبين لغة قويّة بشأن خلافاتهم السياسيّة”، وفق تصريح أدلى به بِنْس إلى برنامج “إن بي سي نيوز ساترداي”. وأضاف: “لكني لا أظن أنه من الممكن ربطها مع أعمال العنف أو التهديد به”.
يصح ما قاله بِنْس بشأن انخراط كلا الجانبين في استخدام لغة قويّة. ومثلاً، ليس أمراً مجديّاً أن يلجأ مشاهير هوليود كروبرت دي نيرو إلى إطلاق شتائم في محافل عامة، ضد رئيس الولايات المتّحدة؛ على نحو ما حصل في حفل “جوائز طوني” في يونيو (حزيران) الماضي. إذ تؤتي لغة ملتهبة كتلك بنتائج معاكسة لمبتغاها، لأنها تستفز أنصار ترامب كما تُظهِر لقاعدته الشعبيّة مدى راديكاليّة اليسار وانفلاته. إنّها تساعد البيت الأبيض وقاعدته، كلٌّ على طريقته، في إظهار كل من يعارض ترامب بهيئة راديكالي، انفعالي ولا يحترم منصب الرئاسة. صحيح أنّ كثيراً من الناس يحبّون ترداد القول المأثور: “حارب النار بالنار”، لكن الحكمة بالطبع تُملي على الإطفائيّة أن تحارب النار بالماء!
مع ذلك، يبقى دي نيرو مجرد مواطن عادي، فيما ترامب وبِنْس هما الشخصان الوحيدان المنتخبان في السلطة التنفيذيّة لحكومة الولايات المتّحدة. هل يظنّان حقاً، بل يأملان أيضاً أن يقنعا الجميع، أنه لا يجدر بهما الارتقاء إلى مستوى أعلى من السلوك بما يتوازى مع مسؤوليّات منصبيهما؟
لا يجدر أن يوجد تساوٍ، لا أخلاقيٍّ ولا سوى ذلك، في ذلك المجال؛ بين مسؤوليْنِ رفيعيْنِ منتَخَبَيْنِ وبين منتقِدينَ (لهما) تحركهم العواطف.
يضاف إلى ذلك، أن ما تحدث بِنْس عنه ينبو عن الوصف، بل يذهب على عكس كل ما تعلمناه من السيكولوجيا الاجتماعيّة. إذا كان يؤمن حقاً بما قاله، عندها يكون غبيّاً على نحو صادم؛ إذا لم يكن يؤمن بذلك حقاً، بل يجده ملائماً كي يعتّم على العلاقة بين الكلام والأفعال، يكون بذا كاذباً. بديهي القول بأن الشر والكلام العنيف ينبئان عن الشر والسلوك العنيف؛ لطالما كان الأمر كذلك، بل سيبقى أيضاً كذلك: كلما تصاعد دخان الحقد غير المبرر تكون هنالك نار العنف المجنون.
لربما لا يستطيع بِنْس (أو لا يرغب) توصيل النقاط المتفرّقة، لكن آخرين لم يجدوا صعوبة كبيرة في فعل ذلك. إذ لاحظ أحد المراقبين بذكاء، أنه منذ ثلاث سنوات دأب ترامب على الصراخ بـ”أطلقوا النار” في مسرح حاشِد؛ في إشارة إلى قضية “شنِك ضد الولايات المتّحدة” التي ترجع إلى عام 1919 وتخص القاضي أوليفر ويندل هولمز جونيور، (وهي قضية) أرست قيوداً معقولة على ممارسة الحق الأول في الدستور01. لذا، تشبه شكوى دونالد ترامب من تكاثر الحقد –كقوله: “إنه أمر رهيب، رهيب كل تلك الكراهية في بلادنا، وبصراحة، في العالم بأسره”- شكوى مزارع من الثمار التي تعطيها محاصيله؛ لأن أسلوب عمل ترامب كمستثمر سياسي هو زرع الكراهية والحصول على حصادها.
تصح صورة صرخة “أطلقوا النار في مسرح حاشد” تشبيهاً لوصف أسلوب خطاب ترامب، ولا يحتاج الأمر إلى عالِم متمرّس ليرى أن ذلك ما تسير إليه الأمور منذ فترة طويلة. بالعودة إلى 14 مارس (آذار) 2016، قبل وقت طويل من حصول دونالد ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة؛ حذَّرتُ بل توقّعتُ أيضاً كل ظاهرة “الأخبار الكاذبة”:
“ترامب هو… سياسي يشبه سحرة القبائل. إنّه بارع في السحر الاجتماعي، وتهييج العواطف وتغيير كل ما لا يحبه إلى شيء آخر يحبه. ولا يملك أتباعه المُنَوَّمون مغناطيسيّاً بواسطة عالَم دراماتيكي من القوى المتضاربة يروّج ترامب له بطريقة سحرة القبائل المُبسّطة؛ سوى إحناء الرأس بالموافقة، ليس اقتناعاً بمنطقه بل بتأثير سحره الشيطاني”.
“إذاً، ليس دونالد ترامب مجرد مرشح جمهوري آخر للرئاسة، حتى إن أمره لا يقتصر على الاقتراع الرئاسي. إنه نذير وتحذير بشأن خيط عميق من اللاعقلانيّة المتصاعدة في الجسد السياسي للولايات المتّحدة. كذلك هو حاضنة لعنف سياسي كامن. إنّه لم يعمل بالطبع على تنظيم قوات مسلحة رديفة، لكنه في كل مرّة يهدّد فيها بأن يلطم أحداً ما على أنفه يكون بالنتيجة، قد أعطى الإذن لأتباعه بأن يكونوا عدوانيّين تجاه الآخرين، ولا يُستثنى من ذلك أن يفعلوا ذلك بالعنف أيضاً”02.
لم يوافق كثيرون على توقّعاتي بشأن العنف آنذاك في مارس (آذار) 2016، على الرغم من أنّ مدَّهُ كان يتصاعد فعليّاً. لنلقِ نظرة استرجاعيّة على ذلك المدّ، مع التنبّه إلى جو عدم التسامح الراديكالي الذي استبق ترامب، وكان فعليّاً عنصراً رئيساً في سياق نجاحه السياسي.
يمكن البدء في مراجعتنا الانتقائيّة بتذكّر أول مقتلة عنصريّة صريحة في الأوقات القريبة: قَتْلُ ديلان رووف (9) مُصَلّين سود في كنيسة في “تشارلستون” بولاية “كارولينا الجنوبيّة” في 2015. وتلا ذلك في صيف 2016، اغتيال (5) ضباط شرطة في “دالاس” على يد ناشط أسود. إذاً، صحيح أن العنف والإرهاب يحدثان على الجانبين، إلى حد ما. بعد ذلك، بعد تنصيب ترامب رئيساً، تحديداً في مايو (أيار) 2017، حدث هجوم جسدي مباشر من قِبَل مرشح للكونغرس في ولاية “مونتانا”، على أحد مراسلي الصحف؛ وكان ذلك متوافقاً مع أجواء تلك الفترة. في 14 يونيو (حزيران)، أُطلِق الرصاص على مجموعة من أعضاء الكونغرس الجمهوريّين كانوا يلعبون كرة السلّة في بلدة “الإسكندرية” بولاية فيرجينيا، وجُرِح كثير منهم. مرَّة أخرى، هناك عنف من الجانبين، مع افتراض أنّ كلَّ عنفٍ يُغذي الآخر. إبّان تلك الحوادث، حدثت أعمال شغب انقساميّة في الجامعات ضد متحدثين من اليمين، وصدامات بين يساريّين ونازيّين جدد في شوارع “سكرامانتو”، وكاليفورنيا وغيرها؛ وتُوِّجَ ذلك كلّه بكارثة “تشارلوتسفيل” في 12 أغسطس (آب) 2017.
وكأن تلك الحوادث كلها لم تكن كافية، فجاءت في غرة أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مقتلة (58) شخصاً في “لاس فيغاس” بفعل أسباب لم يستطع أحد تحديدها؛ وبالأحرى إنه الإرهاب الذي لاعقلانيّة فيه، ويحدُث مُبَرِّراً نفسه بنفسه.
تراكم ذلك العنف كلّه إلى حدّ أنه صار قاعدة في توقّعات الناس. ولنتذكر التالي: لا يتأتّى ضرر الإرهاب الرئيس من عدد قتلاه، بل يحدث أكثره بفعل نسف الثقة الاجتماعيّة التي تُبقي على المجتمعات متفاعلة وموحَّدَة ومتفائلة03. ساعدت الحكومة الأميركيّة بغباء الإرهابيّين في السنوات التي تلت عام 2001 عبر تحويلها البارانويا إلى روتين بيروقراطي، وبتكرار تذكير الأميركيّين مرات عدّة يوميّاً، بإمكان حدوث مقتلة جماعيّة عبر بثها في الأمكنة العامة شعار “إذا رأيت شيئاً ما، قُلْ شيئاً ما”. لقد التهمنا نسيج الوضع الطبيعي للأمور، وهو ما يكون متضمّناً في توقّعات الجميع وتنبني عليه الثقة الاجتماعية، في نهاية الأمر. عندما يصبح مجرد ركوب باص أو حافلة مترو أنفاق، عملاً محمّلاً بشحنة إدراكيّة، مهما كانت روتينيّة؛ تكون النتيجة اضطراباً سيّئاً.
إذاً، في أوقات كهذه، بعد حادثتي إرهاب في أسبوع واحد، يكون الدور المتوقّع للقيادة، إذا تصرفت وفقاً للمسؤوليّة، هو شفاء الانقسامات والنُصح بالخير على المستويات كلها. وبدلاً من ذلك، عمل ترامب والجمهوريون على تسعير الانقسامات، انتظاراً لمحصولها الأكثر ملاءمة لهم سياسيّاً في المستقبل.
حتى بعد “تشارلوتسفيل”، حدثت إنكارات، وظهر أناس لا يريدون رؤية أو أقلّه الاعتراف، بوجود رابط بين التكاثر الواضح للغة العنف وبين السلوك العنيف؛ ورفضوا فهم ما فعلته حملة ترامب بداية، ثم البيت الأبيض؛ بتعمّد شديد. لا أستطيع أن أفهم كيف يتمكن أي شخص من الاستمرار في حال إنكار للعنف السياسي في الولايات المتّحدة، وكذلك التلاعب به مِنْ قِبَل ترامب وأنصاره، بعد حوادث الأسبوع الماضي.
ماذا عن اليهود؟
شكّل الهجوم على كنيس “بيتسبرغ” المقتلة الأكبر على الإطلاق، ضد اليهود الأميركيّين. وجاء بعد تصاعد حوادث تتسم بمعاداة الساميّة، خلال السنتين المنصرمتين، على الرغم من أن المرجعيّة الأقدم للبيانات لا يمكن الوثوق بها. وعلى الرغم من كل الأعمال الجيّدة التي أنجزتها “رابطة معاداة التشهير” (= “بناي بريث” بالعبريّة وتعني “أبناء العهد”) في تاريخها اللامع، فإنّها منخرطة في تجارة اكتشاف معاداة الساميّة. إذ يمثّل ذلك سبب وجودها الوحيد، وهو سبيلها في الحصول على المال. ولسنوات طويلة، دأبت على تضخيم معاداة الساميّة، على غرار ما تفعله بالضبط منظَّمَة “كير” (مجلس العلاقات الأميركيّة الإسلاميّة) في تضخيم الحوادث التي تسمّى “إسلاموفوبيا”، وللأسباب عينها تماماً.
إذا قيل ذلك كلّه، يكون مجافياً لكل منطق إنكار أنّ حوادث معاداة الساميّة هي اليوم أكثر انتشاراً في الولايات المتّحدة مما كانته (لنَقُلْ) في 2009، عندما انكشفت قِصّة الخداع المُنظّم الذي مارسه برنارد مادوف . آنذاك، كان من شأن قضية مادوف أن تشكّل عاصفة متكاملة من التوقعات بارتفاع معاداة الساميّة: إذ كانت يهوديّة كليّاً، كانت خداعاً عميقاً ومنحرفاً؛ وطاولت المال، وبدا كل من تورّطوا فيها “يهوداً” (أو متوسطيّين أو عرباً/ شرق أوسطيّين… لا يستطيع معظم الأنجلوساكسون أن يخبروا عن الفارق بين هؤلاء وأولئك، خصوصاً في مكان متعدد الألسنة كنيويورك). لم يحدث شيء. لا شيء. لم تظهر نأمة من معاداة الساميّة في تلك القضية.
قارن ذلك الخلاء المدوّي مع الهجمات التي تكاد لا تكف من قِبَل الجمهوريّين على جورج سورس، التي كانت صفارات إنذار واضحة عن معاداة الساميّة. في سياق هجوم في يوم سبت على كنيس، رفض مسؤول “لجنة الحزب الجمهوري لحملة انتخابات الكونغرس” إدانة حملة إعلانيّة تربط مرشحاً ديمقراطيّاً مع جورج سورس وهو من الأشخاص الذين تلقوا قنبلة أنبوبيّة عبر البريد في الأسبوع المنصرم. إذ يتضمّن الإعلان الذي أُطلِق في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مُستهدِفاً الديمقراطي دان فيهان (يتنافس مع الجمهوري جيم هيغدورن في تمثيل الدائرة الأولى في “مينوسوتا” في الكونغرس)، مشهداً مُمَنتَجاً يظهر فيه كولن كبيرنك راكعاً ومحذّراً من أنّه “دُفِعَ مال إلى غوغاء اليسار كي يتظاهروا في الشوارع”، ويعقب ذلك صورة لسورس محاطاً بأكوام من النقود. ويكرّر الإعلان نغمة كلاسيكيّة في معاداة الساميّة: “البليونير جورج سورس يموّل المقاومة “.
ليس مجرّد إعلان مُفرَد. إذ زعم عضو الكونغرس الجمهوري مات غايتس في فلوريدا، من دون أدلة، أن سورس موّل “قافلة” المهاجرين الآتين من هندوراس. ربما التقط ذلك من حلقة 25 أكتوبر (تشرين الأول) من برنامج “لو دوبس تونايت” الذي تبثّه قناة “فوكس نيوز بيزنس”، وزعم فيها كريس فاريل من مجموعة “جوديسيال ووتش” [تعني حرفيّاً “مراقبة العدالة”] -ومرّة أخرى من دون دليل- أن تلك القافلة مموّلة ومُوجَّهَة من “وزارة الخارجيّة التي يحتلها سورس”.
هنالك المزيد. في الأسبوع الماضي، كتب كيفن ماكارثي، زعيم الأغلبية الجمهوريّة في مجلس النواب، تغريدة حذفها بعد الهجوم على الكنيس، وكانت “لا نستطيع أن نترك سورس وستاير وبلومبرغ، يشترون هذه الانتخابات [النصفيّة للكونغرس]”. الرجال الثلاثة المذكورون في التغريدة هم يهود.
أكثر من ذلك. في وقت مبكّر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، خلال احتجاجات ضد بريت كافاناه الذي أضحى قاضياً في المحكمة العليا، غرّد ترامب من دون أن يستند إلى دليل، بأن الناس الذين يحتجون ضد كافاناه “دُفِعَ لهم من قِبَل سورس وآخرين”. أعاد رودي جولياني بثّ تغريدة تشير إلى سورس بأنه من “أعداء المسيح” وهم جزء من مؤامرة، ومُلمِّحاً أيضاً إلى أن سورس يدفع للمحتجين ضد كافاناه. ومع ذلك، الأرجح أن تذهب جائزة التهوّر المطلق عبر تشبيه سورس بهتلر، إلى النائب الجمهوري عن تكساس لوي غوهمرت الذي اقترح أن سورس يهيمن على سياسات الحزب الديمقراطي. وأثناء ظهوره على شاشة “فوكس نيوز”، قال: (ربما رفعوا سواعدهم وفردوا أكفهم وهتفوا “هايل سورس”).
لكن، ينال النائب الجمهوري عن آريزونا بول غوسار، جائزة الجنون المؤامراتي.
إذ طرح في مقابلة مع قناة “فايس نيوز” أنّ سورس ربما كان وراء تظاهرة “البيض الوطنيّين” في أغسطس (آب) 2017 في “تشارلوتسفيل”. وعندما سُئل إن كان يعتقد بأن سورس موّل تظاهرة “النازيّون الجدد” التي سارت في “تشارلوتسفيل”، أجاب بالقول: “أليس مثيراً أن يتبيّن أنّ ذلك ما كان”؟ يصلح ذلك القول لأن يكون جزءاً من -مثلاً- خطاب مُعادين مسعورين لإسرائيل يزعمون أن الحكومة الإسرائيليّة، وليس النظام السوري، هاجمت الثوار السوريّين المدنيّين في غالبيتهم، بجرعات كبيرة من الغاز السام في 2013. من شأن ذلك النوع من التخرّصات المؤامراتيّة التي تمثّل كذبة كبيرة محرّفة، عندما يخترق الخطاب اليومي بعمق كافٍ، أن يكون إشارة إلى وجود شيء ما يثير الاضطراب في ثقافة الناس. إنّه مؤشّر لا يُخطئ عن العنف.
المسألة هي أنه جزئيّاً بسبب الغرف المسمّمة على شبكات الـ”سوشيال ميديا” التي تُكافئ أقوالاً صادِمَة بأن تصفها كـ”سَبَق” سماوي، وصلت الأمور الآن إلى حد أنه، وفق وصف صائب لرئيس “رابطة معاداة التشهير” جوناثان غرينبلات، “صار طبيعيّاً ومسموحاً الحديث عن مؤامرات اليهود للتلاعب بالحوادث، أو ممولين يهود يسيطرون بطريقة ما على مسارات الأمور”. ومرّة أخرى، كل مَنْ تُفاجئه هذه الأشياء أو يفكر أنّ دونالد ترامب لا يتحمّل مسؤوليّة عن ذلك التحوّل الدراماتيكي، يكون ببساطة غير متنبّه لما يجري، أو لديه ذاكرة ضعيفة.
إذاً، لنتذكّر أن حملته الانتخابيّة وأثناء اجتماع معهم، علّق ترامب مازحاً عن امتناع “تحالف اليهود الجمهوريّين” عن تأييده، قائلاً: “السبب في ذلك هو أني لا أحتاج أموالكم”. وتضمّنت حملة تغريدات ضد هيلاري كلينتون، وضع نجمة داود على أوراق الدولار. في أبريل (نيسان) 2016، نشرت جوليا لوف مقالاً نقديّاً في مجلة “جنتلمان” الفصليّة عن ميلينيا ترامب، فكان أن أغرقها اليمين المتطرّف بصور وإساءات معادية للساميّة، تُوِّجَتْ بتهديدات بالموت على غرار إرسال صورة يهودي يقتل بطريقة الإعدام أو أشخاص يطلبون توابيت تحمل اسمها. عندما أُعطِيَ ترامب فرصة لإدانة تلك الهجمات التي يشنها أنصاره، قال: “ليس لدي رسالة” لهم04. وبالطبع، قال ترامب آنذاك: إن متظاهري تفوّق العرق الأبيض في “تشارلوتسفيل” الذين حملوا أعلاماً عليها شعار الصليب النازي المعكوف، ضمّت صفوفهم بعض “الناس الطيّبين”.
التوجيه عبر عدم التوجيه
على الرغم من أن لديه ابنة يهوديّة (تحوّلت إلى تلك الديانة) وثلاثة أحفاد يهود، كان ترامب مؤيّداً للفرص المتساوية (في العمل)، ثم حاصداً لغلة كراهية الأجانب والتعصّب. وبغض النظر عما يظنه هو بنفسه أو يفكر به، فإنه مُشَرَّب بلائحة طويلة من أفكار التنميط السلبيّ، ولم يرتفع فوق مستوى إطلاق عنان أنصاره في تفعيل تعصّبهم لمصلحته سياسياً. يحضر إلى ذهن المرء مشهد كلاسيكي من فيلم “بيكيت” الذي ظهر في 1964، والمستند افتراضاً إلى حوادث حقيقيّة من عام 1170. في ذلك المشهد، يعطي الملك هنري الثاني التوجيه عبر عدم التوجيه، إذ يقول خلال جلسة استماع في محاكمته: “ألا يخلصني أحد من هذا القسّ الذي يدسّ أنفه في ما لا يعنيه”؟
كلا. لم يأمر ترامب بنقش نجمة داود على أكوام من النقد، وكذلك لم يطلب من أحد إرسال قنابل أنبوبيّة إلى أشخاص دأب على انتقادهم على “تويتر”، أو يأمر مختل مستوحد آخر بكتابة تغريدة بأن قافلة المهاجرين من هندوراس يموّلها جورج سورس قبل أن يهاجم جمع مصلين في كنيس. لا يحتاج ترامب إلى ذلك؛ إذ كل ما عليه أن يفعله هو أن يرسِّخ تلك النبرة، ثم ينظر إلى الناحية الأخرى [متظاهراً بالبراءة]. سيتولى آخرون التخلّص من يهود ومهاجرين ومعارضين يدسون أنوفهم في ما لا يعنيهم. عندما وصف ترامب نفسه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) بأنه “وطني”، وهي صفة يمكن أن تعني عشرات الأشياء وفق السياق الذي توضع فيه، سمع اليمين المتطرف ذلك بأن ترامب اعترف علانيّة أخيراً بكونه واحداً منهم. ووفق ما نقلته تقارير، كانوا متأثرين وشُحِنَتْ صفوفهم مجدداً. عندما يرتكبون مزيداً من أعمال العنف، سيدير ترامب نظره إلى الناحية الأخرى، ويضحك في سرّه.
إذاً، الآن لدينا تصاعد جدي في الإرهاب الداخلي في الولايات المتّحدة تدعمه موجة قاتمة من خطابات سياسيّة سامّة، ينسّقها جزئيّاً رئيس الولايات المتّحدة نفسه. على الرغم من أنه أمر صادم، لكنه أيضاً يجب ألا يكون مفاجئاً. في خاتمة المطاف، عندما هنّأ ترامب في يونيو (حزيران) المنصرم ماتيو سالفيني، رئيس “حزب رابطة الشمال” الإيطالي، وأعضاء آخرين في حكومة أقصى اليمين الجديد في إيطاليا، تعمد بوضوح أن يُضرّ بالاتحاد الأوروبي.
وإذ أثار قضيّة المهاجرين المشحونة سياسيّاً، فكّر ترامب في تجزئة الأوروبيّين داخل كل بلد على حِدَة، وكذلك ضمن الاتحاد الأوروبي ككل. باختصار، بدا توجهه سياسيّاً غير متمايز عن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين05.
ما الدروس والتحذيرات التي يجب أن يأخذها حلفاء الولايات المتّحدة وأصدقاؤها القدامى في الخارج؟ الأول هو أنّ الولايات المتّحدة تغيّرت، أقلّه في الوقت الراهن. إذ لم تعد تعمل وفق بوصلة أخلاقيّة كما لم تعد حليفاً موثوقاً، إلا بالمصادفة؛ أي عندما تتوافق المصالح مؤقتاً.
هل تتغيّر أميركا وتعود إلى سابق عهدها، وتمسك مجدداً بمهمّتها وحسّها البديهي الطبيعي، عند ذهاب ترامب؟ ربما؛ لكن يصعب أن تعود الأشياء إلى ما كانته بالضبط. حدثت مشاكل، وظهرت مزاعم من نُخَبْ مع يقين متزعزع، ولقد هزّ ترامب القضبان بشدّة حقاً. وكما يعرف الجميع أيضاً، إنّ ردّة ضد ترامب وما يمثّله، ربما تذهب بعيداً في الاتّجاه الآخر نحو أشكال مجنونة من الرؤى الطوباويّة، لا تكون بحد ذاتها خالية من توجّهات نحو العنف. لا نحسب أننا نعرف. بمجرد أن يتلوث نظام سياسي بالعنف، تؤدّي التوقعات بمزيد من العنف إلى جعل ذلك العنف أكثر إمكاناً. وتتولّد دورة انحدار إلى العنف يصعب الخلاص منها قبل أن يواجه الجسم السياسي ما أنبتته. من يتولّى كَسْر تلك الدورة؟ وكيف؟
- غابرييل شونفِلد، (صرخة “أطلقوا النار” في مسرح كثيف التسلّح: ذلك ما يفعله ترامب منذ ثلاث سنوات)، “نيويورك دايلي نيوز”، 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
- غارفينكل، “عن ترامبوبروليتاريا”، “أميركان إنترست”، 14 مارس (آذار) 2016، [التشديد في النص الأصلي].
- ناقَشْتُ تآكل الثقة الاجتماعيّة في الولايات المتّحدة في “بطريقة ما، نؤمن بالقليل جداً”، في “تي. إيه. آل. أون لاين”، 13 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
- جوليا لوف، (ما مدى مسؤولية ترامب عن حادث إطلاق النار في “بيتسبرغ”؟)، واشنطن بوست، 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
- انظر مقالي: “الخوف والإرهاب”، في “عين أوروبيّة على التحوّل الراديكالي”، 25 يونيو (حزيران) 2018، وظهر أيضاً على الإنترنت بعنوان “انعدام الأمن القومي: الإرهاب والخوف”، “أميركان إنترست أون لاين”، 17 يوليو (تموز) 2018.