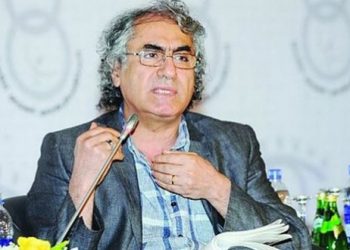أسس نشأة الزوايا بالمغرب:
كانت الزوايا تعرف باسم الرباط وبدار الكرامات، ومن أقدم الزوايا بالمغرب نجد زاوية الشيخ أبي محمد الماجري، والتي انتشرت فروعها في بقاع عديدة بالمغرب، وامتد صيتها وتأثيرها إلى مصر، واستمر وجودها حتى في عهد ملكيات أخرى كالمرينيين. وإذا كانت الزوايا بالمغرب قد اهتمت بكل ما هو ديني واجتماعي، فإنها ستشهد تطورا خاصا في القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الميلادي، ففي عهد السلطان أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي في القرن الرابع عشر، اهتمت الزوايا بكل ما هو اجتماعي من إطعام وإيواء فقراء ومعوزين، وتيسير وصول الحجاج إلى الحجاز من خلال فروع لها في شمال أفريقيا، والتي كانت ممر الحجاج من المغرب إلى الحجاز، ومهمتها كانت أيضا نشر مبادئ التصوف. وتعد فترة السعديين، الفترة التي قام من خلالها السعديون بزعامة القائم بأمر الله سنة 1510 بنشر الدعوة الإسلامية بالاعتماد على الزوايا تحديدا، وتمكن أولاده من بعده في تأسيس نواة الدولة بعد القضاء على الوطاسيين. وبسبب اعتمادها على الزوايا فقد كان لهذه الأخيرة دور كبير في تجييش المجاهدين ضد البرتغاليين فيما يعرف بالاحتلال الأيبيري، وتمكنوا من هزيمتهم وتحقيق انتصار تاريخي في ما يعرف بمعركة وادي المخازن يوم 5 أغسطس (آب) سنة 1578م. لقد كانت الطريقة الصوفية –إذن- وتحديدا الجزولية، الإطار الأيديولوجي الذي قامت على أساسه الدولة الشريفية السعدية[1]، واستمر تأثير الزوايا في المجال الديني والسياسي والاجتماعي حتى عهد الدولة العلوية اليوم.
وتسند الزاوية في إنشائها إلى أصول الشيخ أو الصالح، حيث لا نكاد نجد شيخ زاوية في المغرب لا يمتد أصله إلى أهل البيت، وهو ما يعرف بالنسب الشريف، والذي على أساسه حظي هؤلاء على مر التاريخ بمكانة رفيعة داخل المجتمع المغربي، وفي هذا الإطار يقول محمد بن سليمان الجزولي (أحد رجالات مراكش السبعة): “ ليس العزيز من تعزز بالقبيلة وحب الجاه، إنما العزيز من تعزز بالشرف والنسب، وأنا شريف في النسب، جدي رسول الله وأنا أقرب إليه من كل ما خلق”.[2] لكن النسب الشريف وحده لم يكن العامل الوحيد ولكن الأساسي، وكان يجب -إلى جانب ذلك- أن يتمتع الشيخ بصفات الورع والتقوى، وكذا الكرامات التي تجعل المريدين يعتقدون في صلاحه وحظوته عند الله.
كما يعد الجهاد أحد أسس تأسيس الزوايا واستمراريتها وشرعية وجودها، وساعدت الظروف التاريخية في تعزيز مهام الزوايا في المغرب، وتوسيعها لتشمل أيضا الجهاد في سبيل الله وضد المستعمر وخاصة في فترة الاستعمار الأيبيري، وتمكنت الطريقة الجزولية من الانتشار في مناطق واسعة من المغرب، وخاصة بمنطقة الجنوب (سوس). وأصبحت تراهن أيضا على مفهوم الجهاد، ومن خلاله تعبئة المجاهدين وتوحيد القبائل والصفوف، مما جعلها تماثل السلطة المركزية داخل الدولة، بعد أن تراجعت بانهيار الدولة المرينية وضعف السلطة الوطاسية، وعلى هذا الأساس استندت في إنشاء فروع جديدة لها داخل مختلف ربوع الدولة باعتبارها ذلك الإطار الأيديولوجي الذي يمكن من خلاله توحيد الصفوف، وهو ما استندت عليه الدولة السعدية في شرعنة وجودها وشرعية سلاطينها، حيث “ظهر أمرهم فيها بفضل نسبهم وجهادهم وارتباطهم بالنسب الشريف الذي رفع قدرهم وميزهم على من حولهم”[3]، وكذلك الحال بالنسبة للزاوية الدرقاوية التي اهتمت بالجهاد، وتوسع نفوذها إلى المجالات الحدودية، ونافست السلطة السياسية في مناطق الجنوب الشرقي للمغرب آنذاك.
بالإضافة إلى النسب الشريف والجهاد، استندت الزوايا بالمغرب إلى الفكر الصوفي الذي ظهر بالمغرب مع الفتح الإسلامي لشمال أفريقيا، وإنشاء الرباطات الدعوية والجهادية وفي فترة الموحدين، حيث كان الشيوخ يعتمدون على المصداقية الروحية والزهدية في جذب المريدين، ثم ستتقوى الزوايا بتحالف الصوفية مع النسب الشريف، والتي استمرت حتى الفترة الحالية مع العلويين.
الزوايا بالمغرب الحديث: السياسة والدين وبناء الدولة
تحمل الزوايا بالمغرب في العصر الحديث رمزية دينية قوية مرتبطة بالنسب الشريف، ودعمت الحكم العلوي على اعتبار مشاركتهم مع السلطة الحاكمة في الأصول الشريفة نفسها، والانتساب إلى آل البيت، وبقي هذا التحالف الضمني مستمرا إلى اليوم، وخاصة أن السلطة الحاكمة في المغرب تستند في حكمها على شرعية دينية أيضا.
واختلفت وظيفة الزوايا اليوم عنها في الماضي، فلم يعد حاضرا مفهوم الجهاد، وتقلصت وظائفها في الإيواء والخدمات الاجتماعية مع تغير القوانين والأنظمة السياسية داخل الدولة. واقتصر الجهاد على جهاد النفس والصبر عليها، كما أصبحت الخدمات الاجتماعية مقتصرة على إطعام الزوار وطالبي البركة والكرامات، وقضاء الحوائج من خلال الهبات التي تحصل عليها الزاوية، وخاصة إذا كان هناك ضريح للزيارة والتبرك. ومن أشهر الزوايا بالمغرب نجد -على سبيل المثال لا الحصر- الزاوية الدلائية والبودشيشية والتيجانية.
الزاوية الدلائية: ينسب تأسيس الزاوية الدلائية إلى أبي بكر بن محمد سعيد الدلائي خلال القرن الرابع عشر الميلادي، والذي تتلمذ على أحد شيوخ الصوفية أبي عمر القسطلي بمراكش، وبأمر منه أسس زاوية يتولى فيها التلميذ السير على نهج شيخه، من تعليم أصول الدين وإطعام الزوار وإكرامهم، وعرفت الزاوية انتشارا واسعا، وتمكنت من تأسيس إمارة كبيرة “وقد شاهدت الزاوية الدلائية في بداية عهدها العصر الذهبي للسعديين، ثم أدركت زمن الفتنة والتدهور، غير أنها نظرا لمناعة موقعها في جبال الأطلس ولمكانة رجالها الصالحين، استطاعت أن تحتضن الثقافة الإسلامية في عصر عصفت فيه الاضطرابات بالمراكز العلمية التقليدية مثل فاس ومراكش. وعمرت الزاوية الدلائية زهاء قرن ظلت فيه مركز إشعاع للعلم والدين”[4].
ستتقوى الزاوية الدلائية بسقوط الدولة السعدية[5]، وستتمكن من الهيمنة على الأطلس المتوسط وفاس، والسيطرة على مناطق واسعة وعلى السواحل أيضا، مما سمح لها بعقد علاقات تجارة مع دول أجنبية، وسيبرز طموحها السياسي ومعارضتها لسلطة (المخزن) وهو ما جعل السلطان الرشيد يقوم بهدم الزاوية الدلائية القديمة والزاوية التي تفرعت عنها، وما زالت بقايا الزاويتين قائمة إلى يومنا هذا.
الزاوية البودشيشية: تنتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبدالقادر الجيلالي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، في حين لقبت بالبودشيشية نسبة إلى علي بودشيش، الذي كان معروفا بإطعام الطعام بزاويته، وتمكنت الزاوية البودشيشية من الحفاظ على استمراريتها وتناقل المشيخة إلى يومنا هذا، وخاصة أنها خرجت من عباءتها الدعوية إلى التربوية، ومن بين شيوخها: أبو مدين بن المنور، والحاج العباس، الذي ورث عنه الشيخ حمزة الحالي مشيخة الزاوية تفعيلا لوصية الشيخ العباس.
تعد الزاوية البودشيشية من بين أشهر الزوايا بالمغرب وأقواها اليوم، وتمكنت من استقطاب آلاف المريدين من داخل المغرب وخارجه، ويغلب على طقوسها الجانب الروحي، بحثا عن الوصول إلى تنقية القلب وصفائه، والوصول إلى درجات كبيرة من الإيمان والسلام الروحي. وتوجد الزاوية البودشيشية في شرق المغرب، ويحج إليها العديد من الباحثين عن لذة التصوف وأقصى درجات حب الله، والباحثين عن الاعتكاف مع الذكر الجماعي والتسبيح والتهليل، وقيام الليل[6]، كما يحضرون حصص التربية الدينية التي يطغى عليها التوجه الصوفي.
تستقطب الزاوية البودشيشية اليوم عدداً كبيراً من المريدين داخل المغرب، ولا يقتصر الأمر على فئات معينة، بل إنها تشمل الفئات الشعبية والطبقات الفقيرة، كما تستقطب الفئات المثقفة والطبقات الغنية، وهو ما يعني تحولا على مستوى مريدي الزوايا بالمغرب، ولم يعد مقتصرا على الطبقات الشعبية البسيطة كما لم يعد التدين الشعبي مرتبطا بهذه الفئة فقط.
وبالإضافة إلى المغاربة، فالزاوية البودشيشية تمكنت من استقطاب جنسيات أخرى، أفريقية وأوروبية وأمريكية، وتوجد لديها فروع في دول خارجية مختلفة، ويعود هذا الإقبال على الزاوية البودشيشية إلى منحاها الصوفي الروحي، الذي يحقق للفرد صفاء الروح والتوازن النفسي -كما يقول بعض مريديها من الأجانب. ولذلك يحرصون على الزيارة السنوية للزاوية ولشيخها من أجل تلقي دروس الترقي الروحي من الشيخ، وتعلم كيفية دخول حضرة الله بالقلب والروح.
الزاوية التيجانية: تعتبر الزاوية التيجانية من الزوايا الصوفية أيضا الأكثر شهرة في المغرب والجزائر وبعض دول أفريقيا. تأسست على يد أبي العباس بن محمد بن المختار بن أحمد سالم التيجاني، الذي ولد بالجزائر وتوفي بالمغرب، وتلقى تعليما صوفيا ونشأ في حضرة الزاويا الدرقاوية والناصرية والوزانية، وهو ما أثر في تكوينه الفكري والديني مؤسسا بذلك طريقة تعرف انتشارا واسعا جدا اليوم.
انتقل الشيخ التيجاني من الجزائر إلى المغرب فارا من اضطهاد الأتراك واستقر بفاس بالمغرب، وتلقى ترحيبا من السلطة الحاكمة وعناية خاصة من السلطان سليمان، وكان يعتبره ذا حظوة إلهية خاصة.
أتى الشيخ أبو العباس التيجاني بأمور جديدة في نهجه الصوفي، وتجاوز طابع الزهد والتقشف الذي كان يعرف بها الزهاد والمتصوفة، بل إنه كان يؤمن بالعيش الرغيد في الدنيا والآخرة، وهو ما يفسر اتساع دائرة مريديه، حيث شملت التجار والأثرياء والراغبين في حياة الغنى والترف في الحياة الدنيا قبل الآخرة.
من بين أهم ما تؤمن به الطريقة التيجانية، وصول المريد إلى درجات عليا من الصفاء الروحي الذي يوصل إلى لقاء حسي ومادي مع النبي محمد، وهو ما تمكن من الوصول إليه الشيخ التيجاني في لقائه مع النبي محمد، والذي خصه وأتباعه بصلاة “الفاتح”، وعلى هذا الأساس أيضا يتم التشديد في شروط الانتساب إلى الطريقة التيجانية، لأن من يلتحق بها لا يحق له الخروج منها أو الالتحاق بطريق أخرى.
تعتمد الطريقة التيجانية -كغيرها من الطرق الصوفية- على الذكر والصلاة وقراءة الأوراد، وتبدأ بعض طقوسها بعد صلاة العصر بجوهرة الكمال التي تميز هذه الطريقة، وذلك لأن مريدي هذه الطريقة يؤمنون بأن الشيخ التيجاني تلقاها شخصيا ومباشرة من الرسول محمد، ولذلك فروح النبي تنزل خلال الاستغفار والتهليل وترديد “جوهرة الكلام”. ثم تليها “صلاة الفاتح” وهي الصلاة التي يؤمن التيجانيون بأن الله أنزلها مع ملَك إلى الرسول محمد.
هناك مراتب مختلفة في الطريقة التيجانية تبدأ من المريد وتنتهي عند القطب أبي العباس التيجاني، غير أنه لا يحل لأي شيخ -مهما علت مرتبته- أن يحل محل الشيخ التيجاني، فمريدو هذه الطريقة ما زالوا يعتبرون أن زعيمهم هو الشيخ التيجاني مؤسس الطريقة، ولا يقومون بزيارة أي ولي من الأولياء غير الشيخ التيجاني، ولا يلتزمون إلا بالورد التيجاني، كما لا يقومون بالتجديد في الأذكار والأوراد؛ فهي مهداة من النبي محمد مباشرة، وتقتصر على الصلاة والأذكار وتختفي طقوس (الحضرة)[7] أو أي نوع من أنواع السماع والتغني بالدعاء والذكر.
ويعتقد المنتسبون إلى الزاوية التيجانية -كأغلب مريدي الطرق الصوفية- أن لهم مكانة خاصة وحظوة إلهية، وأنهم سيكونون في أمان من العذاب وسيدخلون الجنة مع الزمرة الأولى مع النبي محمد. ويقول أبو العباس الشيخ أحمد التجاني: «وسألته صلى الله عليه وسلم لكل من أخذ عني ذكرا أن تغفر لهم جميع ذنوبهم ما تقدم منها وما تأخر، وأن تؤدي عنهم تبعاتهم من خزائن فضل الله لا من حسناتهم، وأن يرفع الله عنهم محاسبته على كل شيء، وأن يكونوا آمنين من عذاب الله من الموت إلى دخول الجنة، وأن يدخلوا بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى، وأن يكونوا كلهم معي في عليين في جوار النبي (ص) فقال لي (ص): “ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاورني أنت وهم في عليين”»[8].
ظلت الزاوية التيجانية إلى يومنا هذا متمسكة بالأسس والمقومات الروحية الأولى التي جاءت مع الشيخ أحمد التيجاني، وركزت على تقديسه وتبجيله وتمجيده، وحافظت على طريقته في التلاوة والذكر والصلاة، ويعد المنتسبون للطرقة التيجانية اليوم بالملايين، ويتعدى وجودهم دولتي المغرب والجزائر إلى دول في أفريقيا وعدد من دول العالم.
[1]-ىمحمد ظريف، “مؤسسة الزوايا بالمغرب”، مرجع سابق، ص36.
[2]– ميشو بيلير، “محاولة في تاريخ الزوايا والطرقية في المغرب”، مجلة أمل، العدد19/20، سنة 2000، ص13.
[3]– حسين مؤنس، “تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي”، العصر الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، بيروت، 1992، مجلد (2)، ج(3)، ص103.
[4]– محمد حجي، “الزاوية الدلائية دورها الديني والعلمي والسياسي”،، مرجع سابق، ص21.
[5]– [إن غياب السلطة المركزية مع سقوط آخر سلاطين الدولة السعدية، سيدفع الدلائية إلى التفكير في خوض المغامرة التاريخية الكبرى. إن الطموح “الدلائي” في التحول إلى سلطة مركزية (المخزن) الذي بدأ يتحول مع “محمد الحاج” سيقتضي تحولا من نوع آخر: هو تكسير بنية “الزاوية” وبلورة بنية “الطريقة”، وهكذا سيتم التفكير في التملص من الخصوصيات المحلية (=القبيلة) لاختراق المجتمع بأكمله، هذا على الصعيد السياسي، أما على المستوى الأيديولوجي فسيتم التركيز على العلم. وعلى الرغم من ذلك فإن الدلائية ستفشل في تحقيق هذا التحول، وبالتالي فشلها أمام العلويين. ترجع أسباب هذا الإخفاق إلى عاملين: عامل مادي، ذلك أن الدلائية لم تستطع كسب العنصر العربي إلى جانبها، وعامل أيديولوجي يتمثل في كون الدلائية ركزت على العلم ولم تهتم بعنصر كان من الممكن أن يساهم في تحقيق هذا التحول، وهو الشرفاوية (chérifisme)… ] محمد ظريف، “مؤسسة الزوايا بالمغرب”، مرجع سابق، ص96.
[6]– يقول الشيخ حمزة: “إذا أردت أن تسمو أخلاقك وتصفو أذواقك وتهيج أشواقك، فعليك بذكر الله وصحبة الصالحين المحبين والتأدب معهم”.
[7]– تعتمد العديد من الطرق الصوفية على رقصات خاصة خلال الذكر والتهليل والتسبيح وهو ما يعرف بالحضرة، والتي ينفصل خلالها المريد عن العالم المادي ويدخل في حالة من الانتشاء الروحي تقربه إلى الله.
[8]– برادة علي حرازم، “جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني”، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1997، ج1، ص69.