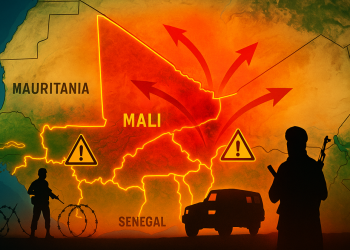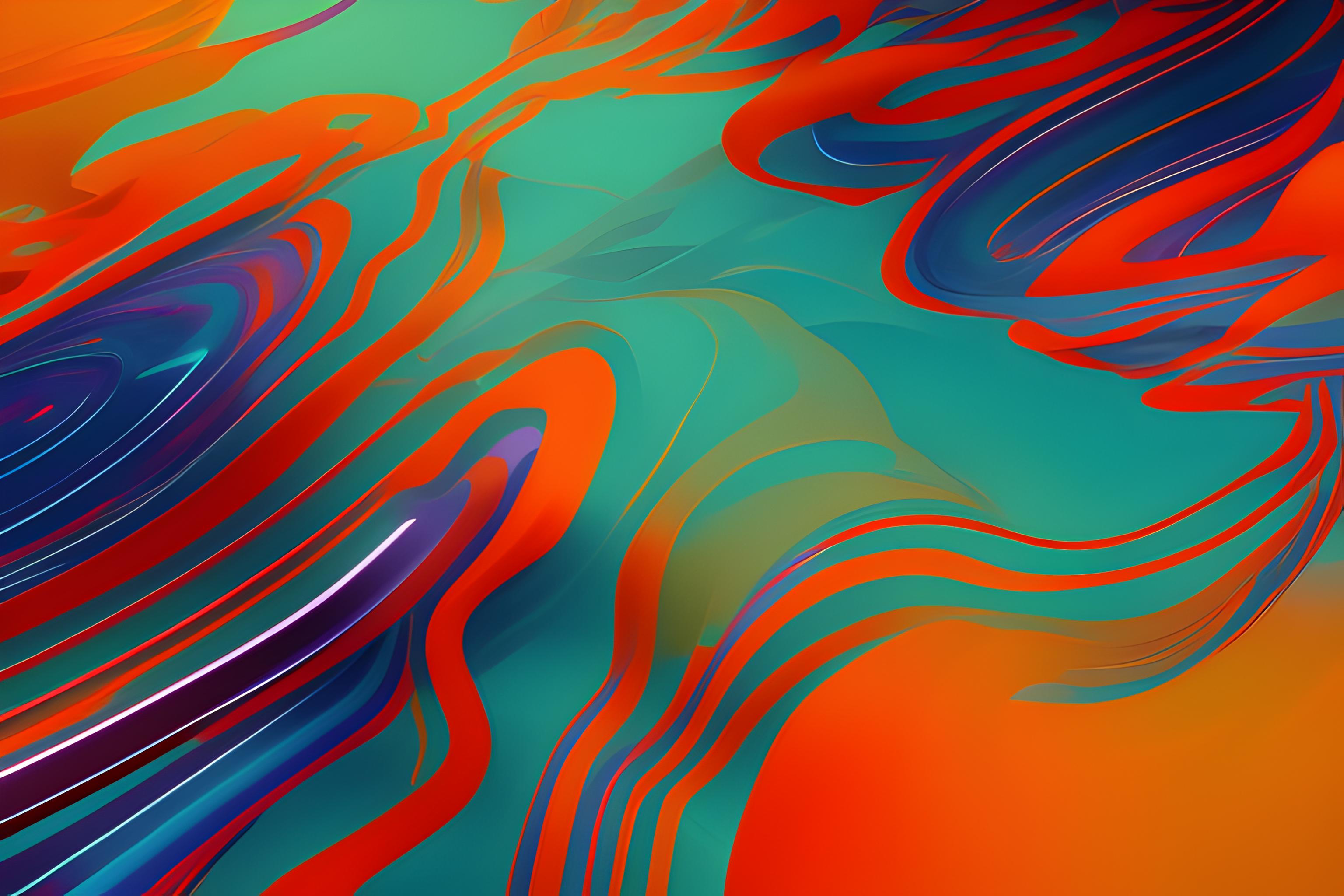دراسة نشرت في كتاب المسبار الشهري (130) “مرجعيات العقل الإرهابي- المصادر والأفكار” أكتوبر – تشرين الأول 2017.
إن العنف الذي يُمارس اليوم،والذي يُعتبرسمة من سمات العقود الأخيرة التي يمربها العالمين العربي والإسلامي؛ يعبرعن أزمة حضارية بدأت بوادرها ترتسم في شرايين هذه الحضارة منذ سقوط الخلافة العباسية في بغداد بعد الغزوالمغولي سنة1258 م والتي أعلنت بعد ذلك عن انتهاء العصرالذهبي في الإسلام، وبداية التراجع الحضاري للمسلمين، مقابل النهوض الغربي،الذي أسّس للحداثة الكونية
يعتبر أحمد بن تيمية (1263-1328) أحد أهم رموز السلفية بعد أحمد بن حنبل (780-855)، حيث زامن مرحلة حكم المماليك للعالم الإسلامي، وهي مرحلة أخرى من أزمات الحضارة الإسلامية، وسينطبع فكره بتلك الظرفية التاريخية التي عاصرها، ومن الملاحظ أن الاتجاه السلفي سيزداد تزمتاً، وسيتجه تدريجياً نحو الانغلاق كآلية سيكولوجية لحماية الهوية الجماعية التي باتت تهددها المخاطر من كل جهة[1]، من خلال اللجوء إلى «الماضي الأزلي»[2] واستلهام تقاليده.
وخلال القرن الثامن عشر الميلادي، وتحت حكم الإمبراطورية العثمانية، سيظهر محمد بن عبدالوهاب كرمز من رموز الفكر السلفي. بعد ذلك سيكون لفكر المودودي وسيد قطب بالغ الأثر على الحركات الإسلامية في المنطقة، وكان لمفهوم الحاكمية الإلهية الذي جاء به المودودي وتبناه قطب فيما بعد تأثير كبير في رسم معالم أيديولوجية دينية تسعى إلى تغيير الواقع، لكن من خلال استجداء الحلول من «السلف الصالح» و«عقيدة السنة والجماعة».
بعد مرحلة التأسيس سيشهد الفكر السلفي تطوراً ملحوظاً مع توالي الظروف التاريخية التي مرت بها المنطقة، إذ سيتحول من تنظير فكري، إلى ممارسة واقعية تستعمل العنف المادي من أجل التغيير، وهو الذي عبرت عنه «السلفية الجهادية» في أوضح صورة. ويُعتبر الجهاد الأفغاني أول تجربة ميدانية «للحرب المقدسة» التي اضطلعت بها الجماعات الدينية، التي ستعمل على تحويل الأفكار التي نظر لها المنظرون إلى واقع على الأرض، وبالتالي تأسيس «دولة الخلافة الإسلامية» من جديد، وقد شكل التدخل السوفيتي في أفغانستان، الفرصة المناسبة لإعلان الجهاد على «الشيوعيين الكفار».
وتعتبر هذه الاستراتيجية تعبيراً صريحاً عن فشل هذا الفكر، ومن خلال ذلك، طابعه المتشدد، بل أسهمت التحولات السياسية والجيوسياسية في انتشاره، إذ سيتحول إلى معضلة عالمية، خصوصاً مع أحداث الحراك التي عرفها العالم العربي، والتي في إطارها ظهرت جماعات جهادية تتبنى العنف وتسعى إلى إسقاط الأنظمة وبسط السيطرة[3]، وأهمها ما يسمى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، المعروف بـ«داعش»، و«جبهة النصرة في سوريا» ولائحة عريضة من الجماعات والتيارات.
إن القصد من هذا العرض التاريخي هو النظر إلى السياق العام الذي يُؤطر ظاهرة العنف الديني كما نلاحظها اليوم، لذلك فإن أي فهم لهذه الظاهرة لابد له من استحضار مجموعة من المعطيات والمحددات التي تتضافر لكي تنتج هذا العنف الذي يمس من جهة الفكر السلفي، باعتباره المشتل الذي نبتت فيه فكرة «الجهاد»، كما يمس من جهة أخرى صميم الدين الإسلامي، الذي تحول في مخيال الغربيين إلى دين عنف وقتل، وهو ما يفرض على المسلمين إعادة النظر في دينهم وفي واقعهم الحضاري والسياسي، من أجل النهوض وتجاوز التأخر التاريخي.
ومادام الحديث عن العنف و«الجهاد» والإرهاب، فإن مواجهته تقتضي الغوص عميقاً في الفكر الذي سمح بظهوره، ونظر له قبل أن يتحول إلى واقع على الأرض. وتعتبر الرموز التي ذكرناها ذات مسؤولية، إما مباشرة أو غير مباشرة في هذه الأحداث، وكي لا يتم إصدار أحكام متسرعة وطلباً للموضوعية، لابد من الرجوع إلى الأدبيات التي نظرت لهذا الفكر لمساءلة أطروحاتها والكشف عن مدى مسؤوليتها المعنوية في هذه الأحداث، وسينصب اشتغالنا على أحد أهم هذه الرموز، القيادي الإسلامي الباكستاني أبي الأعلى المودودي، الذي عاش خلال القرن العشرين، وأسهم في تأسيس «الجماعة الإسلامية في الهند» وفي التنظير لأيديولوجيتها السياسية.
من هو أبو الأعلى المودودي؟
أبو الأعلى المودودي بن سيد أحمد المودودي، داعية إسلامي ولد بمدينة أورنك آباد الدكن بولاية حيدر آباد، في 25 سبتمبر (أيلول) 1903، تعلم على يد أبيه القرآن وأصول الفقه واللغة العربية، لأنه لم يرد إلحاقه بالمدرسة القومية، اشتغل في البداية في مجال الصحافة لأن اهتمامه كان بالسياسة وليس الدين، لكنه سرعان ما انخرط في صفوف «حركة الخلافة» التي قادها أحد أبرز وجوه زعماء مسلمي الهند وهو «مولانا محمد علي»[4]، الذي تقرب منه المودودي وأوصاه بالانتقال إلى دلهي للمساعدة في نشر «مجلة هامدراد» الخاصة بحركة الخلافة، وكانت هذه هي بداية اهتمامات المودودي الإسلامية[5].
بين 1921 و1924، سوف يرتبط المودودي بـ«جمعية علماء الهند»، الرابطة الأم للعلماء المسلمين في الهند[6] وأصبح رئيساً لتحرير صحيفتها «مسلم»، وبدأت أفكاره تعكس اهتماماً متزايداً بأحوال مسلمي الهند وخارجها، وسبل النهوض بأوضاعهم. وقد خلف سقوط «الخلافة العثمانية» سنة 1924 أثراً بالغاً على المودودي، الذي بدأ في انتقاد فكرة القومية، وقد شكلت الأحداث الدامية التي قامت بين مسلمي الهند والهندوس، دافعاً له لكتابة كتابه «الجهاد في الإسلام»، ومع اتساع هوة الخلاف في دلهي اتجه إلى الإقامة في «حيدر آباد»، حيث كرس وقتاً أطول للدراسة، وأطلق لحيته وارتدى الزي التقليدي للمسلمين الهنود، وكان سؤاله المحير: لماذا ضعف حكم المسلمين في الهند؟ وما الذي أدى إلى انهياره؟[7]
وقد توصل إلى أن السبب هو تأثر المسلمين بالتقاليد المحلية، التي أضعفت الروح الإسلامية، مستلهماً بذلك أفكار المصلحين المسلمين القدماء خاصة، «أحمد سرهندي» و«ولي الله دهلوي» ودعا إثر ذلك لتأسيس كيان منفصل للمسلمين والقطيعة مع الثقافة الهندية والهندوسية. بعدها سيصدر مجلة «الفرقان» سنة 1932، كما سيُلبي دعوة المفكر الإسلامي محمد إقبال الذي استدعاه ليترأس «دار السلام التعليمية» التي أسسها في « باتان كوت» في مقاطعة البنجاب.
كان النصف الثاني من الثلاثينيات مرحلة فاصلة لمسلمي الهند، الذين سينقسم رأيهم حول مسألة انفصالهم عن الهند وتكوين دولة خاصة بهم، وقد اتجه المودودي نحو فكرة «جمعية علماء الهند» التي تروم تأسيس كيان يضم مسلمي الهند، ومن هنا نلاحظ بعض الأفكار التي عارضها المودودي، فمعارضته للدولة القومية كانت بسبب اعتبارها نظاماً سياسياً يحكم وفق الأغلبية، والمسلمون كانوا أقلية، وبالتالي ففكرة القومية ليست في صالح الأقلية المسلمة التي ستذوب قوميتها في الأغلبية الهندية، وبالتالي سيفقدون قوميتهم الحضارية[8] وكان الهدف منها تبليغ الأفكار الإسلامية.
بعد ذلك سيؤسس «الجماعة الإسلامية في الهند»، وسيستدعي لها علماء المسلمين في الهند وبحضور (75) فرداً، وسينُتخب أميراً لها، وسيكون لهذه الجماعة بالغ التأثير على المشهد السياسي في الهند بعد ذلك في باكستان[9]. كما سيعمل على حشد الدعم واستقطاب الأتباع من خلال مجلته «ترجمان القرآن» حيث سيدعو إلى «ضرورة وجود جماعة صادقة في دعوتها إلى الله، جماعة تقطع كل صلاتها بكل شيء سوى الله وطريقه، جماعة تتحمل السجن والتعذيب والمصادرة، وتلفيق الاتهامات، وحياكة الأكاذيب، وتقوى على الجوع والعطش والحرمان والتشريد، وربما القتل والإعدام، جماعة تبذل الأرواح رخيصة، وتتنازل عن الأموال بالرضا والخيار».
سنة 1947 بعد انفصال باكستان عن الهند، نشأ صراع بين «الجماعة الإسلامية» بقيادة المودودي، والتي تريد دولة إسلامية بالتصور الذي نظر له، مقابل تصور حزب «الرابطة الإسلامية»، الذي يريد باكستان دولة للمسلمين»[10]، حيث شارك المودودي في رسم المشهد السياسي في الهند وبعد ذلك في باكستان من خلال «الجماعة الإسلامية»، وقد كان معارضاً لفكرة القومية الهندية التي نادى بها حزب المؤتمر الوطني الهندي بزعامة غاندي. اعتقل المودودي لمدة عامين، لكن تحت الضغط الشعبي يتم الإفراج عنه. ومباشرة بعد ذلك يستمر في المطالبة بالدستور الإسلامي، والتزام الدولة بالشريعة الإسلامية، ومن ثم فكرته حول «تكفير الدولة» التي ستؤدي به إلى السجن والحكم عليه بالإعدام، وسيلغى هذا الحكم سنة 1955 وسيفرج عنه بعد ذلك. في العام الثاني صدر دستور ينص على إسلامية باكستان وهو ما اعتبره المودودي نصراً له، حيث سيطلق حملة واسعة من أجل أسلمة مؤسسات الدولة. خصوصاً مع صعود الجنرال أيوب خان للسلطة، والذي سيغازل الجماعة الإسلامية، لا سيما وأنه أعلن الجهاد أثناء الحرب الباكستانية- الهندية. سنة 1972 سيستقيل المودودي من قيادة الجماعة، وسينتخب «ميان طفيل» خلفاً له[11].
توفي المودودي سنة 1979 في نيويورك بعد عملية جراحية، ودفن في لاهور، وقد خلف عشرات المؤلفات التي بلغت (120) عملاً، تُرجم أغلبها إلى اللغة العربية، نذكر منها: «الحكومة الإسلامية»، «كتاب ختم النبوة في ضوء القرآن والسنة»، «مبادئ الإسلام»، «نحن والحضارة الغربية»، «الخلافة والملك»، «فكرة الجهاد في الإسلام»، «الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة»، «الإسلام ومعضلات الاقتصاد»، «منهاج الانقلاب الإسلامي»، «تطبيق الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر»، «موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه»، «تفسير سورة الأحزاب»، «نظرية الإسلام السياسية»، «المصطلحات الأربعة في القرآن: الإله، الرب، العبادة، الدين»، «الإسلام والمدنية الحديثة»، «حقوق أهل الذمة في الدول الإسلامية»، «فتاوى المودودي».
أثر المودودي في أغلب التيارات الإسلامية خلال القرن العشرين، ناهيك عن تأثر سيد قطب بالمودودي، حيث هناك تشابه بين فكر الرجلين، خصوصاً ما يتعلق بمفهوم «الحاكمية»، الذي استقاه قطب من خلال قراءته للمودودي، وهو ما يُعبر عنه هذا الأخير من خلال الشهادة التي قدمها سكرتيره خليل الحامدي الذي أكد في أحد لقاءاته: «أنه في أحد أيام الستينيات الميلادية، دخل شاب عربي على الأستاذ المودودي، وقدم له كتاب «معالم في الطريق» لمؤلفه سيد قطب، وقرأه الأستاذ المودودي في ليلة واحدة. وفي الصباح قال لي: «كأني الذي ألفت هذا الكتاب»، وأبدى دهشته من التقارب الفكري بينه وبين سيد قطب. وأضاف: «غداة تنفيذ حكم الإعدام بسيد قطب، دخلنا على المودودي، وقص علينا كيف أنه أحس فجأة باختناق شديد، ولم يدرك لذلك سبباً، فلما عرف وقت إعدام سيد قطب من الصحف الباكستانية قال: «أدركت أن لحظة اختناقي هي نفس اللحظة التي شنق فيها سيد قطب»!
السياق التاريخي لفكر المودودي
شكل القرن العشرون عصراً لصراع الأيديولوجيات بكل أنواعها: الاشتراكية، الرأسمالية، الفاشية، القومية والدينية، إنه «عصر التطرفات»[12] كما سماه المؤرخ البريطاني إريك هوبزباوم (Eric Hobsbawm) (1917-2012). وكان لهذا الصراع بالغ الأثر على كل الكتابات التي تم إنتاجها حول بناء الدولة في المجتمعات التي خضعت للاستعمار.
«في الهند (التي كانت آنذاك تضم باكستان وبنغلاديش) أسهمت ما يُسمى «الإهاجة الخلافية» الداعية إلى الإبقاء على الخلافة، في بروز حركة الاستقلال الهندي. وباختصار، فإن الشرق الأوسط والعالم الإسلامي أصبحا في وضع تاريخي جديد لا سابق له»[13]، وهي الظروف التاريخية التي عاش فيها أبو الأعلى المودودي، والتي كان لها تأثير بالغ على الطروحات الأيديولوجية التي بلورها، والتي استند فيها إلى ديانته الإسلامية، حيث كانت إرادة الاستعمار البريطاني في تغيير قوانين الإسلام التي سادت الهند زهاء سبعة قرون. بالإضافة إلى ذلك موقف زعيم المؤتمر الوطني «غاندي» الذي رأى أن الإسلام ليس دين عقل، وإنما جاء إلى الهند عن طريق القوة والسيف[14]، كانت لكل ذلك آثار لدى مسلمي الهند، والتي شكل فكر المودودي التعبير البارز عنها، حيث نادى بتطبيق الشريعة في الهند وتحويل نظامها السياسي إلى نظام الخلافة الإسلامية.
لم يكن المودودي متفقاً منذ البداية على فكرة انفصال باكستان التي ستحتضن مسلمي الهند، والتي لم تطبق فيها الشريعة كما نظر لها المودودي قط[15]. ومن جهة أخرى، فإن المودودي كان قومياً هندياً في إحدى مراحل حياته، إلا أنه استسلم لإغراء الطائفية الإسلامية، للفترة اللاحقة لسقوط الخلافة، في مواجهته لحركة النهضة الهندوسية التابعة لحركتي شودهي وسانغتان (Shudhi and Sangathan) وكذلك الهيمنة الهندوسية الجلية على حزب المؤتمر الهندي الوطني تحت زعامة المهاتما غاندي[16]. وهذا ما أشار إليه ولي نصر الباحث المتخصص في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، في رسالته للدكتوراه في جامعة بركلي بعنوان: «طلائع الثورة الإسلامية والجماعة الإسلامية في باكستان»، وكتابه الآخر «المودودي وصناعة الإحياء الإسلامي»، منشورات أكسفورد للنشر[17].
هل نَظّر المودودي للإرهاب؟
يُعتبر المودودي من بين أهم المنظرين لفكرة قيام «الدولة الإسلامية»، وأحد أهم رموز حركات الإسلام السياسي، الإصلاحية منها والحركية والسلفية و«الجهادية»، وهو صاحب فكرة «الحاكمية الإلهية» و«تكفير المجتمعات والدول» وفكرة «الجهاد العالمي» وتأسيس الدولة على أساس الشريعة الإسلامية، معلناً رفضه القاطع للدولة المدنية والعلمانية والقومية.
إن الفكر السياسي للمودودي، لا يمكن فهمه خارج السياق التاريخي الذي جاء فيه، وهو تاريخ الهند المعاصر، حيث يُشكل فيه المسلمون أقلية دينية، التي رفض المودودي ذوبانها في دولة قومية علمانية ديمقراطية، وهي المشروع السياسي لحزب المؤتمر الوطني بزعامة المهاتما غاندي، ومن هنا العداء الشديد والمطلق لفكرة الديمقراطية، وكل ما يرتبط بها من مفاهيم كـ«العلمانية» و«الحريات الفردية» و«القوانين الوضعية» و«التعايش» وغيرها، حيث ينعتها بـ«الجاهلية المعاصرة»، لأنها لا «تطبق حكم الشريعة»، ولا تترك للأقلية المسلمة فرض عقيدتها الدينية، لذلك نرى أن كل البنيان النظري الذي شيده، جاء ضد هذه الفكرة لأنه لم يترك منفذاً من منافذ تسرب فكرة الديمقراطية التي تسود في الدول الغربية التي تعتبر إنجلترا – التي قامت باستعمار الهند- أهم ممثليها، بل أعرق بلد تنشأ فيه فكرة الديمقراطية نفسها، لذلك جاء تأصيل المودودي لفكرة «الحاكمية الإلهية»، كأنموذج للمجتمع الصالح، الذي يشبه تماماً دولة الرسول في شبه الجزيرة العربية خلال القرن السابع الميلادي.
كان لسيد قطب بالغ الأثر في نقل التجربة الإسلامية للمودودي في الهند، إلى التربة العربية والإسلامية، لأنه أعاد التأصيل لثنائية «الجاهلية» و«الحاكمية»، وأسقطها على المجتمعات العربية والإسلامية، وهو المشروع الذي ستتأثر به كل جماعات الإسلام السياسي في كل بقاع العالم، بكل تياراتها وأطيافها، خصوصاً الحركات الإسلامية «الجهادية» التي تنشط في مناطق التوتر والحروب، كسوريا والعراق، والتي أسهمت ظروف الثورات العربية في إنضاج الشروط الموضوعية لازدهارها، وذلك نظراً للانفلاتات الأمنية، ولضعف الدول وعدم قدرة جيوشها على القضاء عليها؛ ونظراً لاستنزاف حروب العصابات لها، والتي اعتمدت كاستراتيجية قتالية أنهكت الدول، وبالتالي تمدد هذه الجماعات على حساب مساحات شاسعة من الأراضي[18].
إن السبب في تبني فكرة الحاكمية هو عدم أخذ الجماعات الإسلامية لفكرة «الظرف التاريخي» والتحولات المجتمعية بعين الاعتبار، ولذلك نجد صلابة المواقف الراديكالية للمقاتلين وللقيادات الميدانية التي تحركهم، واعتمادهم على الموروث الفقهي المتشدد، الذي يؤكد فكرة الموت في سبيل الله، كتقنية من بين تقنيات أخرى تجعل إلحاق الضرر بالطرف الآخر، ولو اقتضى ذلك استعمال أشكال القتل والمواجهة كافة، التي لا تمت للإنسانية بصلة، ولا بجوهر الدين كذلك. لأن ما يُميز المقاتلين الذين يلتحقون بالجبهات هو خضوعهم لما يُشبه «غسيل الدماغ»، وللتجييش والضخ الأيديولوجي، العملية التي يتولاها الشيوخ ورموز السلفية الذين وظفوا وسائل التواصل الاجتماعي، والفضائيات في توجيه هذا الضخ الإعلامي الأيديولوجي العنيف الذين يستقطب الشباب بالخصوص، الذي يعاني من تمزقات على مستوى الهوية، خصوصاً الشباب المسلمين بالدول الأوروبية، الذين يعيشون في الهوامش، ويعانون مختلف أشكال الحرمان العاطفي والاجتماعي والجنسي[19]. وواضح أن هذا الشحن الأيديولوجي، المُخطط له سلفاً، يجعل «الجهادي» يدخل إلى جبهة القتال وهو مهيأ نفسياً للموت، وبالتالي تكمن قوة وخطورة هذه الجماعات، التي استطاعت إنهاك جيوش نظامية منظمة وقوية. بالإضافة إلى ذلك تدخل بعض الدول لدعم هذه الحركات بالإعلام والمال والسلاح، الشيء الذي شكل سبباً من بين أسباب أخرى، وعاملاً مهماً في استمرارها في القتال.
الحاكمية لله أو شريعة السماء
معلوم أن مفهوم «الحاكمية لله» من أهم المفاهيم التي تحتكم إليها الجماعات الإسلامية، ويُعتبر أيضاً من المفاهيم الرئيسة التي سيؤسسها المودودي في فكر الجماعات الأصولية المعاصرة، ويُفيد الاحتكام إلى الله باعتباره الحاكم الأوحد ذا السلطة المطلقة، لأنه الخالق للكون والإنسان، وبالتالي فهو الوحيد المستحق للعبادة والطاعة دون غيره من الموجودات الأخرى لأن «السلطة العليا المطلقة ليست إلا لله»[20]. وبالتالي وجب اعتباره الموجود الأول الذي يجب أن تعود إليه السلطة، وأن تكون سلطة البشر مستمدة من الله مباشرة. ويعتبر الخوارج أول من طرح مفهوم الحاكمية، اعتراضاً على واقعة التحكيم الشهيرة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان أثناء معركة صفين. وسيُعيد المودودي طرح هذا المفهوم والتأصيل النظري له وسيترجمه سيد قطب بعد ذلك إلى اللغة العربية، في كتابه «معالم في الطريق» وتفسيره: «في ظلال القرآن».
إن إقامة الدولة يجب أن تتأسس -إذن- على الحاكمية كغاية مطلقة يتجه إليها الاجتماع الإنساني. ويرتبط مفهوم الحاكمية بمفهوم آخر هو مفهوم «التمكين» وهو تحصيل القوة اللازمة لتقوية المجتمعات كي تحتكم إلى سلطة الله، كما أن نظام الحكم في الإسلام قائم على الحاكمية لله وحده، وبالتالي فقد كان الرسول هو صاحب السلطة لأن الله اصطفاه من بين أتباعه لتأدية رسالته فكان بذلك مشرعاً، يُطبق شرع الله وفقاً لما جاء في القرآن، ويستشير أصحابه فيما لم تنزل فيه آيات، وكان يحكم بين الناس وفقاً لما أنزل. يقول المودودي في هذا السياق: «حكم الله ورسوله في عين القرآن، وهو القانون الأعلى الذي لا يملك المؤمنون إزاءه سوى اختيار سبيل الطاعة والانصياع، فلا يحق لمسلم أن يصدر من نفسه حكماً في أمر صدر من الله ورسوله فيه حكم، والانحراف عن حكم الله ورسوله نقيض الإيمان وضده»[21].
إن الحاكمية -كما يصفها المفكر المصري حسن حنفي- تعطي «تصوراً مركزياً للعالم. فالله قمة الكون، خلقه ويحكمه ويسيطر عليه، فالأنبياء هم المعلنون عن هذه الحاكمية، ومعهم القادرون على السير على هداهم»[22]. ولما كانت الحاكمية لله، فالاستخلاف لا يكون إلا في الحاكمية، وقد قرر جميع الأنبياء هذه الحاكمية وهذا الاستخلاف من خلال ثلاث حقائق ثابتة:
أولاً: أن سلطة الله هي السلطة العليا التي على الإنسان أن يخضع لها ويقر بعبوديتها، والتي يتأسس على طاعتها النظام الكامل للأخلاق والمجتمع والحضارة.
ثانياً: حتمية طاعة النبي بوصفه ممثلاً ونائباً عن السلطان الأعلى والحاكم المطلق.
ثالثاً: قانون الله هو القانون الحاكم، الذي لا يفترض المساءلة والنقاش. وما دونه من القوانين الوضعية فهي جاهلية محضة[23]، «أول شيء دعا إليه الرسول هو أن الملك لله والحكم له، ولا يحق لأحد أن يشرع للناس قانونهم»[24].
إن كل خروج عن هذه القاعدة السياسية، يعتبر «خروجاً معلناً وصريحاً عن الدين الإسلامي لأن القرآن دعا إلى ذلك }وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ{[25]، وهذه هي المعضلة النظرية في هذا الطرح الإسلامي الحركي، حيث إن المنظرين للإسلام السياسي وفي مقدمتهم المودودي، يضفون على تنظيراتهم مسحة دينية شبه مقدسة إن لم تكن كذلك فعلاً، تعتبر كل من لا يوافقها، أو يبدي اعتراضه عليها، كافراً وغير راض بـ«شرع الله تعالى»، وبالتالي يجب معاقبته لأنه يشكل عائقاً أمام تطبيق حاكمية الله في الأرض وتطاولاً على سيادته المطلقة، وهذه الآيات ليست خاصة في نظره، فهي تعكس ما يذهب إليه بعض المفسرين، بل هي عنده أحكام عامة صالحة لكل زمان ومكان. يقول المودودي في هذا الصدد: «هذه محكمات الكتاب وما فيها خطأ أو شك أو اشتباه، وهذه هي العقيدة المحورية التي يدور عليها أسلوب الإسلام في التفكير ومناهجه الأخلاقية ونظامه الاجتماعي، ولا يمكن أن يصل المسلمون إلى الإيمان الكامل دون أن يقيموا على أساسها حكومة إسلامية، ومجتمعاً إسلامياً، وهيهات أن يكونوا مسلمين دون أن ينفذوا قانون الله وشريعته»[26]، لأن «الإيمان الصحيح يقتضي الإيمان بشريعة الله، وإلا فإن الإيمان كذلك باطل، لأنه لا يجوز أن نفصل ما بين إيماننا والمنهج الذي نتخذه في حياتنا، فمن اللازم على المسلمين الإيمان بالله من جهة، وتطبيق شريعته الإلهية من جهة أخرى». «إن المسلمين لو أرادوا أن يعيشوا مسلمين حقيقة، فلابد من أن يطيعوا الله في دقائق حياتهم وعظائمها، وأن يحكموا شريعته وقانونه في حياتهم الشخصية والجماعية، إذ الإسلام لا يقبل أبداً أن يعلن الإنسان إيمانه، بأن الله رب العالمين ثم يصرف أمور حياته وشؤونها وفق قانون غير إلهي»[27].
تستند الأصولية الدينية بكل أطيافها في تبرير أفعالها على منظومة نصية، تتعدد بتعدد توجهات الحركة الإسلامية في المجال التداولي الإسلامي. حيث استحكمت الأيديولوجيا السنية فيما عرف بأهل الأثر، حيث سيصبح القرآن مرتهناً بيد الروايات المنسوبة للنبي محمد، وأقوال الصحابة والتابعين، ليصير النص التأسيسي هامشياً[28]. وتدخل ضمن هذه التفاسير والتأويلات حتى أفكار المنظرين الأيديولوجيين، الذين يعتبرون في مخيال الكثيرين، «علماء» و«شيوخاً» أكثر من قادة وزعماء سياسيين. كما هو الشأن مع نموذج المودودي.
تتميز الدولة الإسلامية في نظر المودودي بثلاث خصائص أساسية:
الأولى: أنه ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب، أي نصيب من الحاكمية، فإن الحاكم الحقيقي هو الله.
الثانية: أنه ليس لأحد من دون الله، شيء من أمر التشريع.
الثالثة: أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشرع، الذي جاء به النبي من عند الله، مهما تغيرت الظروف والأحوال، وأن الدولة لا تستحق الطاعة إلا من حيث إنها تحكم بما أنزل الله وتنفذ أوامره في خلقه[29].
إن الطرح الذي بين أيدينا، أثرت فيه مجموعة من العوامل كنا قد ذكرناها سابقاً، وهي بالخصوص الانشغال السياسي للمودودي، أولاً: الأثر البالغ لـ«سقوط الخلافة العثمانية» سنة 1924 عليه، بعدما تم بناء الدولة التركية على أساس القومية؛ ثانياً: «أيديولوجية حزب المؤتمر الوطني الهندي»؛ ثالثاً: «الإحساس القومي الإسلامي». لذلك فقد رفض كل هذه النظم السياسية لأنها تعبر عن «حاكمية البشر»، وليس حاكمية الله، لذلك فهو يرفض:
العلمانية: لأنها تعني -عنده- عزل الدين عن الحياة الاجتماعية والسياسية للأفراد، وحصره في علاقة العبد بربه.
القومية: لأنها تقوم -عنده- على مصلحة الأمة ورغباتها، دون التفكير في مصالح الأمم الأخرى.
الديمقراطية: لأنها تمثل -عنده- حاكمية البشر للبشر.
يرفض المودودي كل هذه النظم لأنها تعبر عن إرادة الفرد وشهواته، وتترك المجال أمام الشيطان الذي يبشر بالإلحاد والعنف، يقول المودودي: «تظهر هذه المفاسد في مظاهر العصبية الجنسية والوطنية المتطرفة وتسلط القومية والدكتاتورية والرأسمالية والنزاع الطبقي بين عناصر الأمة. إلا أنه لا شك في أنهما من حيث الروح والجوهر سيان، متماثلان في فرض ألوهية البشر على البشر وقطع علاقة الإنسان بالإنسان وتجزئة النوع الإنساني أجزاء، ثم جعل أفراد النوع الواحد كالسباع الضارية يأكل بعضها بعضاً»[30].
إن الدولة الإسلامية التي ينظر لها المودودي، ليست دولة ثيوقراطية، لأن الحكم فيها ليس لرجال الدين، وليست دولة ديمقراطية، لأن الحكم ليس للشعب، بل هي دولة «دينية» لأن الحاكمية فيها لله طبقاً لاختيار الشعب، فالله هو المشرع والمسلمون هم المنفدون، وهي دولة لا تقوم على الجنس أو المصلحة، أو الحدود الجغرافية، بل دولة فكرية، دولة المبادئ والغايات[31]، وهذه الدعوة لحاكمية الله ورفض حاكمية البشر في نظر حسن حنفي، هي التي «تدفع الجماعات الدينية المتطهرة إلى قيام مجتمع مغلق داخل المجتمع الكبير، وتجعل هدفها إقامة الدولة الإسلامية، وشق عصا الطاعة على النظم القائمة، وعدم التعاون مع الدولة اللادينية الذي يظهر الطعن في شرعية دساتيرها، ورفض الطاعة لمن يحكم بغير ما أنزل الله، وتحريم الصلاة في مساجدها، وتحريم الخدمة في قواتها المسلحة، وتحريم العمل في وظائفها الحكومية»[32].
حاكمية البشر أو الجاهلية المعاصرة
إن من بين المفاهيم الرئيسة الأخرى التي قام أبو الأعلى المودودي بالتأصيل لها في متنه الأيديولوجي، مفهوم «الجاهلية»، الذي جاء به كمقابل للحاكمية، حيث يعتبر أن حكم البشر من دون الله نوع من الجاهلية يعممها على كل الأنظمة السياسية التي تتخذ غير الإسلام نظاماً للحكم، وعلى رأسها النظام الديمقراطي، فـ«الأمور التي كان الله يتولى فيها حكمه لم يكن فيها ما نصطلح عليه اليوم بالديمقراطية»[33]. الثنائيات الحادة، آلية من آليات الفكر الأيديولوجي، الذي يوظف التقابل بين واقعين كي ينقض الكائن أي الواقع المعيش، ويؤسس للممكن أي النتيجة التي يريد التوصل إليها، وذلك من خلال توظيف الصور الرمزية والبلاغية والتخييلية من أجل التأثير في المتلقي، وتسهيل عملية الدمج والقولبة، إن هذه المفاهيم تعبر عن رمزية وجدانية خاصة لدى كل مسلم؛ لأنها تعبر عن المخيال الجماعي وكذلك عن المرحلة الأولى التأسيسية للثقافة الإسلامية، أي «فجر الإسلام»، الذي يعتبر انقلاباً على مرحلة الجاهلية، باعتبارها مرحلة الكفر والشرك والضلال[34]، يقول في هذا الصدد:
«يختلف الإسلام عن الجاهلية، لأنه قائم على الحاكمية لله فيما الثاني قائم على الحاكمية للإنسان»[35]، والجاهلية كما يؤكد المودودي لم تنته بعد، بل «هي أفكار ومشاعر وأوضاع ذات سمات معينة، فإذا وجدت، وجدت الجاهلية، ولو لبست أزهى الثياب»[36]. وسبيل المسلمين للعيش داخل مجتمع السعادة والأخلاق والازدهار، هو التشبث بشريعة الله وأحكامه لأن «نظام الحكم الصالح أساسه الإيمان والتقوى»[37].
إن هذه الثنائية التي اعتمدها المودودي، تنطلق من تقسيم أفلاطوني[38] للعالم، يؤسس فيه لمجالين متصارعين تحكمهما ثنائية الشر والخير. فالحاكمية تمثل الخير والجاهلية تمثل الشر. الحاكمية حق، والجاهلية باطل، الحاكمية هي الصواب والجاهلية هي الخطأ، الحاكمية إيمان والجاهلية كفر. كما أن هذا التوجه نحو وضع تقابلين أدى بالمودودي -كما يقول حنفي- إلى مقابلة الإسلام بالغرب. هذا الغرب الذي تأثر -في نظره- بأفكار ثلاثة أسماء هم: «هيجل» و«ماركس» و«داروين»، الذين شكلت أفكارهم سبباً في انهيار البناء الأخلاقي في الغرب، وأفول الدين والقيم، حيث لم يستطع فلاسفته «تجاوز حدود الشك واللاأدرية في باب الحقائق الغيبية، ما وجدوا أمامهم سبيلاً لمعرفة حقيقة الدنيا ولا حياتها إلا بالتعويل على الحواس، مما جعل فلسفتهم عن الحياة فلسفة سطحية بحتة»[39]، وبالتالي كانوا سبباً مباشراً في تحول الغرب إلى حضارة مادية، لا تؤمن بالمثل العليا، وبالتالي فقدانها لكل حس إنساني، وما الاستعمار سوى مظهر من مظاهر الانحلال، وكذلك انتشار النظم المتعددة والفلسفات، مثل: الفاشية والنازية والشيوعية والقومية وغيرها. إن الغرب -إذن- يختلف في نظر المودودي عن الإسلام وحضارته الروحية، التي يجب حمايتها، وتأسيس الدولة على أساس الإسلام، وأساس الحاكمية الإلهية، حيث تسمو التشريعات الإلهية عن أهواء البشر وانفعالاتهم المتغيرة. إنها مقابلة حادة -إذن- بين عالمين: عالم الجاهلية التي يمثلها الغرب، وعالم الحاكمية، التي يمثلها الإسلام بتعاليمه وشرائعه.
لقد مَيّز المودودي بين أنواع ثلاثة من الجاهلية:
الجاهلية المحضة: وتمثلها المدنية الأوروبية التي تحكمت فيها أفكار هيجل وماركس وداروين، حيث السيادة للإنسان الفرد، وأفول الدين وسيادة القيم المادية المنفلتة من كل ضابط أخلاقي.
جاهلية الشرك: وهي كل الحضارات الإنسانية التي لا تدين بدين الإسلام، والتي تتخذ إما تعدد الآلهة أو عبادة الأوثان عقيدة لها، مثل الحضارات القديمة، كاليونان والرومان واليابانيين والصينيين.
جاهلية الرهبانية: وتمثلها كل النظم التي تجعل من الدين أمراً شخصياً، وتنعزل عن المجتمع لتحقيق الخلاص الفردي، مثل التصوف والرهبنة.
مفهوم «الانقلاب» أو السبيل إلى الدولة الشمولية
إن تجاوز هذه الثنائية القطبية في بنية العالم، لابد لها من انقلاب، أي ثورة تقضي على التصور المادي الغربي الجاهلي للعالم، من أجل تأسيس نظام إلهي فوق سماوي مفارق وحاكمي. تكون فيه السيادة الكونية لله دون البشر. وهذا المنهج لا يجب أن يكون عن طريق الدعوة والعمل السياسي من داخل المؤسسات، بل يجب أن يكون عملاً جهادياً، لأن الإسلام في نظره ليس مجرد دين بين الأديان، بل هو عقيدة إلهية كونية، يجب أن تنبسط على العالم بأسره. «الإسلام ليس نحلة كالنحل الرائجة، والمسلمون ليسوا أمة كأمم العالم، بل إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاج انقلابي يريد أن يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويأتي بنيانه من القواعد، ويؤسس بنيانه من جديد حسب فكرته ومنهاجه العلمي»[40]، كما أن الإسلام في نظره «ليس مجرد مجموعة من العقائد الكلامية وجملة من المناسك والشعائر، كما يفهم من معنى الدين هذه الأيام، بل الحق أنه نظام كلي شامل يريد أن يقضي على سائر النظم الباطلة الجائرة الجارية في العالم ويقطع دابرها، ويستبدل بها نظاماً صالحاً ومنهاجاً معتدلاً يرى أنه خير للإنسانية من النظم الأخرى، وأن فيه نجاة للجنس البشري من أدواء الشر والطغيان»[41]. هذا الطرح هو ما جعل المودودي يوجه دعوته «لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلاباً عاماً في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملؤوا الأرض فساداً، وأن ينتزعوا هذه الإمامة الفكرية والعملية من أيديهم، حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون بدين الحق، ولا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً»[42]، وهي مهمة يتولاها «حزب أممي عالمي، الذي سمي حزب الله بلسان الوحي»[43]، وهو التفسير الذي أعطاه المودودي للآية «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله»[44].
فيما يتعلق بالفصل بين الأمور الدينية والأمور الدنيوية[45] فهي مسألة باطلة وعلى القائمين بالدعوة إلى الإسلام أن يجتثوها من جذورها. نقرأ للمودودي: «القائمون بدعوة الإسلام في هذه البلاد – وطبعاً في سائر أقطار العالم لأن الدين واحد لم يتغير، والكتاب واحد لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه – يرون ويعتقدون أن معاني العبودية هذه كلها باطلة من أساسها، ويرون القضاء عليها وقطع دابرها، كما يريدون استئصال نظم الكفر والجاهلية واجتثاث شرورهما من جذورهما، لأن هذه المعاني والتعابير هي التي شوهت وجه الحقيقة ومسخت فكرة الدين مسخاً»[46].
هذا الخطاب الداعي صراحة إلى العنف، يؤكد تلك المسؤولية المعنوية المباشرة التي تساءلنا حولها في البداية، فـ«الانقلاب» وفكرة «اجتثاث الأنظمة الكافرة»، نجد أنها من بين الشعارات التي تحملها الحركات الإسلامية المتشددة أو العنيفة [جماعات «التطرف العنيف»] التي تملأ أحداثها وفظاعاتها وسائل الإعلام السمعية والبصرية وشبكات التواصل الاجتماعي، ونجد هذه الدعوة الصريحة إلى إراقة الدماء ظاهرة في كتابات المودودي، خصوصاً في كتابه «الحكومة الإسلامية» حيث يقول: «الأمن الحقيقي هو الناتج من إقامة حدود الله وشريعته، ومن يفهم الأمن والاطمئنان على أنه حياة الجميع تحت خيمة النظم الشيطانية في سلام دون أن تراق قطرة من دماء المسلمين، فهو -إذن- لن يفهم وجهة نظر الإسلام البتة، ولم يدرك نظريته ومهمته»[47].
من بين الآليات الأخرى التي تشتغل بها الأيديولوجيا: آلية التعميم التي توظفها الأيديولوجية الدينية للمودودي، تجعل من كل مسلم انقلابياً، لأن الإسلام -كما قلنا- هو محض انقلاب «إن لفظ المسلم وصف للحزب الانقلابي العالمي الذي يكونه الإسلام وينظم صفوفه ليكون أداة في أحداث ذلك البرنامج الانقلابي الذي يرمي إليه الإسلام ويطمح إليه بصره، والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابي عن تلك الحركة الدائبة المستمرة التي يقام بها للوصول إلى هذه الغاية وإدراك هذا المبتغى»[48].
إن الجهاد هو «الركن السادس» من أركان الإسلام لأنه يشكل «السعي المستمر في إقامة نظام الحق». ولازم على كل شخص الدخول تحت راية هذا المنهاج الإلهي، ويخلص عبوديته لله وحده دون سواه، وعدم اتباع نهج الحرية الفردية السائدة في النظم والقوانين الوضعية المستحدثة». إن هذا هو معنى العبودية الذي نبثه ونعممه وندعو البشر كافة، المسلمين وغير المسلمين، إلى قبوله والإيمان به والإذعان له»[49].
دور حزب الله في الانقلاب العالمي
إن الانقلاب الإسلامي، الذي يقضي على «الجاهلية الكونية» ويؤسس للسيادة العليا لله في الأرض، يتولى حمله والقيام به مجموعة من الرجال الذين يعملون على تطبيق الدعوة الإلهية «الذين يسوسون أمرها ويديرون شؤونها. وهذا التدبير وتلك السياسة بحاجة إلى صفات وخلق لابد لكل من يريد إدارة شؤون العالم وتدبير أمره من أن يتصف ويتحلى بها»[50]. يقوم هؤلاء بحمل راية الإسلام وحمل السلاح من أجل نشر شريعة الله في الأرض على كل أمم العالم وأقوامه وأجناسه بحيث «وجب على الحزب المسلم، حفظاً لكيانه وابتغاء للإصلاح المنشود، ألا يقتنع بإقامة نظام الحكم الإسلامي في قطر واحد بعينه، بل من واجبه الذي لا مناص له منه بحال من الأحوال ألا يدخر جهداً في توسيع نطاق هذا النظام وبسط نفوذه في مختلف أرجاء الأرض. ذلك بأن يسعى الحزب الإسلامي في جانب وراء نشر الفكرة الإسلامية وتعميم نظرياتها الكاملة ونشرها في أقصى الأرض وأدناها، ويدعو سكان المعمورة على اختلاف بلادهم وأجناسهم وطبقاتهم أن يتلقوا هذه الدعوة بالقبول، ويدينوا بهذا المنهاج الذي يضمن لهم السعادتين، سعادتي الدنيا والآخرة»[51].
لا يميز المودودي بين أنواع «الجهاد» وشروطه، بل إننا نجده يدعو إلى الجهاد بإطلاق، أي الجهاد العالمي المسلح، لأن كل أمة «جاهلية» في نظره، مادامت لا تطبق شرع الله؛ فالجهاد الإسلامي «هجومي ودفاعي معاً، هجومي لأن الحزب الإسلامي يضاد ويعارض الممالك القائمة على المبادئ المناقضة للإسلام، ويريد قطع دابرها ولا يتحرج في استخدام القوى الحربية لذلك، وأما كونه دفاعياً، فلأنه مضطر إلى تشييد بنيان المملكة، وتوطيد دعائمها حتى يتسنى له العمل وفق برنامجه وخطته المرسومة»[52]. والانقلاب الإسلامي لا يتم بالطرق السلمية، بل لابد من توظيف العنف لأجل ذلك اتباعاً لسنة الأنبياء الذين كانوا -بدون استثناء- دعاة انقلاب بامتياز: «مما لا مجال فيه للريب أن رسل الله الكرام، كانوا كلهم دعاة الانقلاب ورسل التجديد والتغيير، تجديد النظم السياسية والاجتماعية والخلقية والاقتصادية وتغييرها تغييراً شاملاً، وأن النبي العربي الأمي سيد هؤلاء الدعاة وحامل لوائهم»[53].
إن الجهاد هو بمثابة ركن سادس من أركان الإسلام الصحيحة، وعدم تلبية الأمر الإلهي هو محض عصيان وكفر بما أنزله الله عز وجل: «لقد نص القرآن الكريم على أن الذي لا يلبي نداء الجهاد، ولا يجاهد بماله ونفسه في سبيل إعلاء كلمة الله، وإقامة الدين الذي ارتضاه لنفسه وتوطيد نظام الحكم المبني على قواعده، فهو في عداد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتابت قلوبهم، فهم في ريبهم يترددون. وهذا هو المقياس الذي يقاس به صدق المرء في عقيدته وإخلاصه لها»[54].
عالمية دعوة المودودي الجهادية وتبعاتها
إن ما يميز أفكار المودودي، خصوصاً فيما يتعلق بالحكومة الإسلامية والجهاد والجاهلية، هو تعميمها ليس فقط على المجتمع الهندي الذي ظهرت فيه دعوته، ولا في الدول الإسلامية، بل إنه امتد بدعوته إلى أقصى مداها لتشمل العالم. وبالتالي فعلى «حزب الله» القائم بهذه الدعوة أن يسعى إلى الامتداد في كامل أرض المعمورة وألا يكتفي بأرض دون غيرها. ويمكن تلخيص دعوته تلك كما أوردها في كتابه «تذكرة يا دعاة الإسلام» وهو الخطاب المؤسس للجماعة الإسلامية في الهند الذي ألقاه في لاهور سنة 1941 في ثلاث نقاط أساسية يبرزها كما يلي:
«أولاً: دعوتنا للبشر كافة والمسلمين خاصة، أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئاً ولا يتخذوا إلهاً ولا رباً غيره.
ثانياً: دعوتنا لكل من أظهر الرضا بالإسلام ديناً أن يخلصوا دينهم لله ويزكوا أنفسهم من شوائب النفاق وأعمالهم من التناقض.
ثالثاً: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلاباً عاماً في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملؤوا الأرض فساداً، وأن ينتزعوا هذه الإمامة الفكرية والعملية من أيديهم، حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويدينون دين الحق، ولا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً»[55].
إن هذه الدعوة في نظر المودودي – وهنا مكمن المعضلة المفاهيمية – تتميز بـ«شموليتها وكونيتها مادام الإسلام يتطلب الأرض ولا يقتنع بقطعة أو جزء منها، وإنما يتطلب ويستدعي المعمورة الأرضية كلها، ولا يتطلبها لتستولي عليها وتستبد بمنابع ثروتها أمة بعينها، بعدما تنتزع من أمة أو أمم شتى، بل يتطلبها الإسلام ويستدعيها ليتمتع الجنس البشري بأجمعه بفكرة السعادة البشرية ومنهاجها العلمي اللذين أكرمه الله بهما، وفضله بهما على سائر الأديان والشرائع». إن هذه الثورة العالمية يجب أن تتخذ أشكالاً متعددة، فمن جهة يجب أن تكون بالقلم، وبالسيف، وبالمال، يقول: «إن تغيير وجهات أنظار الناس، وتبديل ميولهم ونزعاتهم، وإحداث انقلاب عقلي وفكري بواسطة مرهفات الأقلام نوع من أنواع «الجهاد»، كما أن القضاء على نظم الحياة العتيقة والجائرة بحد السيوف، وتأسيس نظام جديد على قواعد العدل والنصفة أيضاً من أصناف الجهاد. وكذلك بذل الأموال وتحمل المشاق ومكابدة الشدائد أيضاً فصول وأبواب مهمة من كتاب الجهاد العظيم»[56]، من أجل غاية رئيسة هي سيادة القانون الإلهي أي الشريعة الإسلامية التي دعا إليها القرآن والسنة، وذلك عبر «انقلاب اجتماعي عالمي»[57] يُجبر البشر أينما وجدوا على اتباع شريعة الله المنزلة؛ «أما القتال في سبيل اللهّ، فهو الذي غايته أن يرفرف لواء القانون الإلهي العدل على العالمين وتعلو كلمته في الدنيا، بحيث يتبع المقاتل في سبيل الله ذلك القانون العدل نفسه، وكذلك يحمل غيره من أفراد البشر على اتباعه وامتثال أوامره»[58].
معضلة هذه الأفكار أنها تحمل طابعاً إطلاقياً، فكل مسلم هو مجاهد بالضرورة، وإلا فإن إيمانه غير صحيح، فالمسلم الحقيقي هو المجاهد في سبيل الله من أجل القضاء على «الجاهلية» (المعاصرة) وتأسيس المدينة الإلهية. وهذه قمة التشدد لأنها دعوى أيديولوجية لا تأخذ في اعتبارها اختلاف الأديان والعقائد والملل والثقافات، مادامت تقصي كل أنواع الاختلاف داخل العالم، وتعيد فكرة التوحيد من جديد من أجل توحيد العالم وجعله مسلماً بالقوة، لأن الإسلام «دين انقلابي»، وليس دين دعوة فقط.
إنها الأطروحة نفسها التي تحاول الحركات الإسلامية «الجهادية» تطبيقها على أرض الواقع، لأن هذه المشاريع ترى العالم كـ«أرض للثورة»، على الرغم من أنها تبقى خطاباً طوباوياً، يصطدم دوماً بصخرة الواقع، لأن الأساس النظري له قائم على فهم غير موضوعي للواقع، شكل بالأساس رداً انفعالياً، أكثر منه خطاباً عقلانياً واقعياً قابلاً للتطبيق. لذلك نجد الآليات الموظفة كآلية العنف والتفجير وظاهرة الذئاب المنفردة كآخر ورقة تلعب بها هذه الجماعات رهانها. إن عدم فهم الواقع أيضاً يظهر في أن أغلب الإسلاميين يعتبرون أنفسهم كأغلبية في العالم، في حين أنهم ليسوا سوى جزء من العالم.
حدود الالتباس بين الدين والأيديولوجيا
إن الخلط الذي يقع اليوم بين الإسلام كدين، وما بين الأيديولوجيا الدينية التي تعبر عنها الحركات الإسلامية، يرجع أساساً إلى الخطأ الذي تسقط فيه الجماعات الدينية في صياغتها لمشاريعها السياسية، ومرد ذلك -في نظرنا- هو عدم وضوح الحدود الفاصلة بين ما هو ديني عقدي متعلق بالإيمان الديني وبالإسلام كعقيدة، وما هو عملي يربط الدين بالدنيا، وهو ما عبرت عنه الشريعة في لحظة معينة من التاريخ الإسلامي. لذلك فكل تأصيل أيديولوجي يستمد مقولاته من الدين الإسلامي لا يؤدي إلا إلى تعقيد الإيمان الفردي البسيط كإجابة عن الظمأ الأنطولوجي للإنسان، لأن وجود الإنسان محتاج إلى ما يثريه، ويمنحه السكينة والسعادة[59]، وما بين الأيديولوجيا كمحرك للتغيير السياسي المرتبط بالمصالح الفردية والجماعية، وبالتالي الخاضع للواقع المتغير وغير المستقر والتاريخي، وبهذا المعنى يظهر التناقض العميق للأيديولوجيا في علاقتها مع العقيدة التي تحتاج إلى عنصر ثابت مطلق ومتسام، لا يحتكم إلى تحولات الوضع التاريخي ولا يتغير بتغيره.
إن هذا الخلط هو ما يجعل الجماعات الإسلامية وحركات الإسلام السياسي تسقط في مأزق بتعبير الباحث المغربي حسن أوريد[60]، لأنها تورط الدين في حسابات سياسية، هي نابعة بالأساس من صميم السياسة كفن لتدبير النوازع وكمجال للمصلحة، يقول أوريد متحدثاً عن المراجعة الفكرية التي قامت بها حركة النهضة الإسلامية في تونس: «المزج بين الدعوي والسياسي، يسيء للدين كما يشين السياسة، ذلك لأن مدار الدين هو العقيدة والقيم، ومناط السياسة هو المصالح، ويتميز الدين في أساسه العقدي والأخلاقي بالثبات والاستمرارية، وتنطبع السياسة بالتحول والسعي نحو التكيف»[61].
وارتباطاً بالأيديولوجية الدينية الإسلامية، التي يعتبر أبو الأعلى المودودي أحد رموزها الكبار خلال القرن المنصرم، يتأكد لنا أن الطموحات السياسية للمودودي التي ارتبطت بمرحلة معينة من تاريخ مسلمي الهند، جعلت فكره ينتشر بعد ذلك خارج الهند، ووجدت فيه الجماعات السلفية التكفيرية المعين النظري والمرجعية الفكرية المناسبة، لكي تعبر عن وجودها وتجيش وتجند المقاتلين من كل ربوع العالم، وهذا ما جعل التصدي للإرهاب يتخذ بعداً دولياً، ويستلزم القضاء عليه تجفيفاً لمصادر تمويله من جهة، ومن جهة أخرى تقويض أساساته النظرية والفكريةّ، من خلال نقد أيديولوجي وفلسفي، يكشف أن الدين يجب أن ينفصل عن تلاعبات السياسة، وربما هذه هي المرحلة التي تتجه نحوها الأحداث. لأنه كما أشرنا سلفاً، يحمل مشروع الإسلام السياسي بكل فروعه واتجاهاته تناقضاً جوهرياً في خطاباته، لأنه يقدم نتائج مطلقة لمتلقيه تأخذ طابع التجييش واللعب على العواطف أكثر من تركيزها على مشروع مجتمعي متعدد الجوانب والاتجاهات، يأخذ في الاعتبار الاختلافات القائمة في المجتمع، ويجيب عن القضايا الاقتصادية الدقيقة ذات الطابع العقلاني الواقعي، كتوزيع الثروة، والانتاج الصناعي، والعدالة الاجتماعية وغيرها، بعيداً عن الشعارات الحماسية من قبيل «الإسلام هو الحل» أو «إسلامية إسلامية» أو» تطبيق شرع الله» وهو ما سماه فرج فودة بـ«برنامج سياسي للحكم»[62] وهي القضية الغائبة في أغلب مشاريع الإسلام السياسي.
هذا ما يؤكد أن مجال السياسة مجال للجزئي، تطرح فيه مسألة تطابق النظر مع ما ستؤول إليه النتائج، يصف المفكر محمد عابد الجابري هذه المسألة على النحو التالي: «إن ممارسة السياسة بتوظيف الدين عملية تحمل تناقضاً جوهرياً: ذلك أن مجال السياسة هو مجال الجزئي والنسبي، مجال المحاولة والخطأ… إلخ، أما الدين فمجاله هو المطلق. ولذلك نجد الداعية السياسي باسم الدين لا يقدم نتائج جزئية ملموسة، وإنما يقدم نتيجة مطلقة وهي الثواب في الدار الآخرة: الجنة»[63]. ويطرح هذا الخلط -في نظر الجابري- مفارقة مثيرة يبرزها كما يلي: «إن صاحب الدعوة يطلب لنفسه النتائج السياسية الجزئية النسبية! في حين يعد من يستقطبهم بنتائج مطلقة، ولكن لا في الدنيا، بل في مجال المطلق: في العالم الآخر!»[64]. ويشكل هذا التناقض -في نظر الجابري- «كأنما الدنيا خلقت لهم، يعني دعاة الإسلام السياسي، والآخرة لأتباعهم!»[65].
نقرأ للجابري: «يلجأ المكيفون الأيديولوجيون في التنظيمات السياسية/ الدينية إلى وسيلة يقفزون عليها إلى الجهاد. هذه الوسيلة هي جعل أعضاء تنظيماتهم يتقمصون (السلف الصالح) وعلى رأسهم النبي (صلى الله عليه وسلم). فيفكرون ويتصرفون وكأنهم ذلك السلف نفسه يواجه طغيان قريش، ومن خلالهم طغيان فرعون وقارون وهامان، متيقنين أنهم بفضل هذه المواجهة ستكتب لهم الجنة. وهذا كله خطأ في فهم الدين»[66]، وواضح أن هذه التفاصيل المعرفية الدقيقة، لا تطرح على بال الجهاز المفاهيمي لأبي الأعلى المودودي، بله الجهاز المفاهيمي لأغلب الفاعلين الإسلاميين، بالأمس واليوم.
إن هذا الخطاب الديني العنيف هو ما يفقد طروحات الإسلام السياسي الراديكالي مصداقيته، وبالتالي نجد أن عموم المسلمين يتبرؤون منه ويواجهونه، لا سيما أنه يشوه صورة الإسلام والمسلمين عبر العالم، لأن العنف يعبر عن أزمة الخطاب، وربما يكون بذلك صرخة اليأس تجاه واقع معقد ومليء بالتناقضات، يستدعي تغييرُه طرقاً أكثر عقلانية ومعقولية، تتجاوز العنف المادي والقتل والترهيب.
الخاتمة
إن الخلاصة التي يمكن الوصول إليها بعد هذا التحليل لأفكار المودودي يمكن إيجازها في مجموعة من النقاط المهمة:
أولاً: الطابع الأيديولوجي لفكر المودودي، والذي يجب فصله عن الدين، لأن الدين قد يتحول إلى أيديولوجية للتجييش والدمج والانقلاب، والمودودي خير أنموذج عن الأيديولوجية الإسلامية السلفية الانقلابية التي ارتبطت بسياق تاريخي محدد، والتي استغلت في زمن ومكان آخرين.
ثانياً: ارتباط المشروع النظري الفكري بسياق معين، لا يمكن لغير المطلع عليه، أن يأخذ فكرة وافية عن هذا الصرح الأيديولوجي الذي بناه المودودي، وهو ما أبرزناه في تحليلنا، إذ بينا أن الطموحات السياسية للمودودي ورغبته في الزعامة، في فترة شهد فيها مسلمو الهند تحولاً جوهرياً في تاريخهم، جعلته يوظف الموروث الديني والشعور القومي، كأفكار يمكن أن تؤسس لدولة دينية تحتضن الهنود، وتحكم بينهم بما أنزل الله.
ثالثاً: إن امتداد فكر المودودي وتأثيره على رموز السلفية والإسلام السياسي في الوطن العربي، جعل فكره أكثره انتشارا، ورفع المودودي إلى مرتبة المنظرين الكبار للدولة الإسلامية في الفترة المعاصرة من تاريخ الإسلام.
رابعاً: المودودي له مسؤولية معنوية في ظهور الجهاد والإرهاب في العالم المعاصر، مادامت أفكاره تشكل عقيدة مجموعة من الجماعات الإرهابية، التي توظف مفاهيم، «الحاكمية» و«تكفير الدول» و«تكفير المجتمعات» و«الانقلاب» و«تطبيق الشريعة» و«القضاء على الجاهلية» وغيرها من المفاهيم. وحتى إن سلمنا جدلاً بأن هذه الجماعات هي التي أساءت الفهم، فإن الثابت هو أن المودودي، أضفى على طروحاته مسحة دينية مقدسة، قد تغري كل مسلم لا يمتلك العدة النقدية والحس العقلي في التمييز بين الصواب والخطأ، مادام أنه ينطلق من النصوص المؤسسة، وهي القرآن والسنة، ليصوغ من خلال آياتها ومقولاتها، فكراً لا نكاد نميز فيه بين حدود الدين والأيديولوجيا، وذلك راجع بالأساس إلى طبيعة الإسلام نفسه، الذي ظهر في البداية كحركة دينية وسياسية وأيديولوجية تهدف إلى توحيد عرب شبه الجزيرة العربية، وهو ما يقتضي -كما رأينا في المحور الأخير- إعادة النظر في ديننا وتراثنا، من أجل تخليصه من كل التأويلات المغالية، والمتطرفة التي قام بها أشخاص كان هدفهم في المقام الأول سياسياً، ومن ذلك، الحد الأدنى من الفصل بين المجال الزمني، والمجال الديني المطلق، من باب المساهمة في حماية الدين من مقتضى العمل السياسي، المتميز بطابعه النسبي والمتحرك والذي يغلب عليه منطق المصلحة، وإرجاع الدين بالمقابل إلى نفوس معتنقيه وقلوبهم، وفي ذلك تحصين للدين من انحرافات الفاعلين في الحقل الديني.
[1] عبدالغني، عماد، السلفية: النشأة والخطاب والتيارات، موقع «منتدى الحوار لتجديد الفكر العربي»، 15 مارس (آذار) 2013، على الرابط المختصر التالي:
goo.gl/y3Tz7J
[2] يتحدث عالِم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (Max Weber) عن عقيدة الماضي الأزلي كمشروعية تقليدية في المجتمعات التقليدية، يقابلها المشروعية الحديثة في المجتمعات الحديثة.
[3] الملاحظ أنه لولا دعم بعض الدول للجماعات الجهادية، من جهة، وتوافر الشروط الموضوعية في الدول التي ظهر فيها، لما كان له كل هذا الزخم.
[4] خالد، عكاشة، أمراء الدم، صناعة الإرهاب من المودودي إلى البغدادي، دار سما للنشر، ط1، 2015، مصر، ص14.
[5] المرجع السابق، ص15.
[6] نفسه، ص15.
[7] نفسه، ص16.
[8] نفسه، ص18.
[9] سيلقي المودودي خطاباً خلال المؤتمر، نشر فيما بعد على شكل كتاب بعنوان: «تذكرة يا دعاة الإسلام» متوافر للتحميل في موقع «منبر التوحيد والجهاد» [ilmway.com/site/maqdis/d.html] المحسوب على المرجعية «السلفية الجهادية».
[10] المرجع السابق، ص20.
[11] نفسه، ص21.
[12] إريك، هوبزباوم، عصر التطرفات، القرن العشرون الوجيز، ترجمة: فايز الصايغ، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2011.
[13] المرجع السابق، ص12.
[14] عبدالقادر، العجيلي حميد النجار، الحاكمية في الفكر الإسلامي المعاصر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة الزقازيق، 2008.
[15] تشكلت باكستان كدولة تضم الأقلية المسلمة في الهند من خلال إعلان لاهور وبقيادة أحد قادة حزب المؤتمر الوطني الهندي: محمد علي جناح.
[16] انظر: ولي، نصر، المودودي وصناعة التجديد الإسلامية، ترجمة: غادة بن عميرة، مقال منشور بموقع حكمة، اطلع عليه يوم 20 مايو (أيار) 2017، على الرابط المختصر التالي:
http://cutt.us/CuY1w
[17] هدى، الصالح، ما الذي يجمع بين المودودي والخميني والبغدادي، مقال منشور بموقع العربية نت، بتاريخ 9 يوليو (تموز) 2016.
[18] حول هذه الاستراتيجيات، انظر: أبو بكر، ناجي، إدارة التوحش، أخطر مرحلة ستمر بها الأمة. وثيقة متوافرة في مواقع عدة على شبكة الإنترنت.
[19] نجد كثيراً من الرموز السلفية تدعو إلى «الجهاد الجنسي»، أو ما اصطلح عليه بعض الدعاة بـ«جهاد النكاح».
[20] أبو الأعلى، المودودي، حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، ترجمة: خليل أحمد الحامدي، مكتبة الرشد، 1983، الرياض، ص2.
[21] أبو الأعلى، المودودي، الخلافة والملك، دار القلم، الكويت، ط1، 1978، ص17-18.
[22] حسن، حنفي، أثر أبي الأعلى المودودي على الجماعات الدينية المعاصرة، أنفاس نت، 17 أغسطس (أب) 2007، على الرابط المختصر التالي:
http://cutt.us/QOXqW
[23] المرجع السابق.
[24] أبو الأعلى، المودودي، حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، ترجمة: خليل أحمد الحامدي، مكتبة الرشد، 1983، الرياض. ص3.
[25] المائدة الآية:44.
[26] أبو الأعلى، المودودي: الحكومة الإسلامية، دار المختار الإسلامي، الطبعة الأولى، سنة 1967، ص35.
[27] أبو الأعلى، المودودي: الحكومة الإسلامية، ص29.
[28] يوسف، هريمة، السيادة العليا في مشروع الإسلام السياسي: الحاكمية أنموذجاً، موقع مؤمنون بلا حدود ، 11 مايو (أيار) 2017، على الرابط المختصر التالي:
goo.gl/8q25uL
[29] أمراء الدم، ص29.
[30] أبو الأعلى، المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، دار الفكر الحديث لبنان، ط2، 1967.ص27-28.
[31] أمراء الدم، مرجع سابق، ص30.
[32] حسن ، حنفي، الدين والثورة، الحركات الدينية المعاصرة، مرجع سابق.
[33] أبو الأعلى، المودودي، الخلافة والملك، دار القلم، الكويت، ط1، 1978، ص8.
[34] حول آليات اشتغال الفكر الأيديولوجي، انظر: بول، ريكور، من النص إلى الفعل، أبحاث في الهيرمنيوطيقا، 1986. حيث يُدقق ملياً في أهم وظائف الأيديولوجيا، وخصوصاً وظائف التشويه والتبرير.
[35] أبو الأعلى، المودودي، موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، دار الفكر الحديث لبنان، ط2، 1967، ص37-38.
[36] يوسف، القرضاوي، نظرات في فكر المودودي، دار المقاصد، الطبعة1، ص120.
[37] حول تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، ص6.
[38] يُميز أفلاطون في كتابه «الجمهورية» بين عالم المثل الأبدي وعالم الظواهر الزائل.
[39] موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه، ص163.
[40] أبو الأعلى، المودودي، الجهاد في الإسلام، بدون تاريخ، ص3. موقع «منبر التوحيد والجهاد» سالف الذكر.
[41] المرجع السابق، ص10.
[42] نفسه، ص1.
[43] نفسه، ص11.
[44] الأنفال، 39.
[45] كان المودودي من أشد المعارضين لفكرة العلمانية، التي دعا إليها حزب المؤتمر الوطني الهندي.
[46] أبو الأعلى، المودودي، الجهاد في الإسلام، ص2.
[47] أبو الأعلى، المودودي، الحكومة الإسلامية، مرجع سابق، ص44.
[48] المرجع نفسه، ص4.
[49] أبو الأعلى، المودودي، الجهاد في الإسلام، مرجع سابق، ص2.
[50] أبو الأعلى، المودودي، تذكرة يا دعاة الإسلام، منشور في موقع منبر التوحيد والجهاد، ص7.
[51] الجهاد في الإسلام، مرجع سابق، ص14.
[52] المرجع نفسه، ص16.
[53] نفسه، ص9.
[54] نفسه، ص12.
[55] تذكرة يا دعاة الإسلام، مرجع سابق، منشور بموقع التوحيد والجهاد سالف الذكر.
[56] المرجع نفسه، ص5.
[57] نفسه، ص9.
[58] نفسه، ص6.
[59] عبدالجبار، الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1، 2016، لبنان، ص5-6.
[60] انظر: حسن، أوريد، الإسلام السياسي في الميزان، حالة المغرب، منشورات توسنا، ط1، الرباط، ط1، 2016.
[61] المرجع السابق، ص5-11.
[62] فرج، فودة، الحقيقة الغائبة، مطبعة النجاح الجديدة، ط2، 2006، الدار البيضاء، ص14.
[63] محمد، عابد الجابري، لماذا يلجأ الإسلام السياسي إلى العنف، سلسلة مواقف، دار النشر المغربية، العدد (24)، 2004، الدار البيضاء، ص33.
[64] المرجع السابق، ص34.
[65] نفسه، ص34.
[66] محمد، عابد الجابري، لماذا يلجأ الإسلام السياسي إلى العنف، مرجع سابق، ص32.