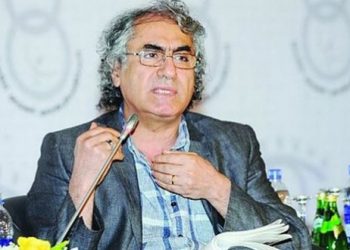البروفيسور محمد الحدّاد *
اللقاء الذي عقد حول موضوع حوار الأديان، بين العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الأخيرة إلى مصر، والبابا تواضروس الثاني رئيس الكنيسة القبطية المصرية، ليس مجرّد حدث بروتوكولي عادي، فهو أوّل لقاء مع الكنيسة القبطية يحصل على هذا المستوى الرفيع، الذي يضاهي لقاء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ببابا الكنيسة الكاثوليكية سنة 2007. ومن المعلوم أنّ الكنيسة الكاثوليكية لا تمثّل الأقباط الشرقيين، لذلك جاء اللقاء الأخير بمثابة التوسعة لهذا الحوار، ومدّ اليد إلى المسيحية بشقيها الغربي والشرقي، إضافة إلى أبعاده الإقليمية المختلفة.
ثمة –أوّلاً- دلالة رمزية تتمثل في الاعتراف بالغير، وبالمختلف في الدين، على أعلى مستويات التمثيل السياسي. وهذه الرمزية ذات أهمية بالغة في سياق ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من عنف ودمار ناتجين عن ضعف ثقافة الاختلاف، وتنامي الحركات المتطرّفة في كلّ الأديان، واختطاف الإسلام من جماعات الإرهاب التي شوّهت صورته أمام العالم. ويتفق كلّ العاملين في مجال حوار الأديان على أنّ من أهمّ آليات التصدّي لهذا الوضع الخطير نشر التسامح والاحترام المتبادل، وتطوير المبادئ الإنسانية الكبرى كي تتحوّل من الإعلان إلى التطبيق. ولا ينجح ذلك إلاّ بمبادرات تتنزّل في سياسات دول المنطقة وقرارات المسؤولين عن شؤونها.
وثمة –ثانياً- دلالة عملية، تحمل رسالة تطمين لمسيحيّي الشرق الأوسط الذين لم يشهدوا في تاريخهم القريب مخاطر من حجم ما يواجههم منذ سنوات، فكأنّ قروناً من التعايش مع المسلمين قد نسي ذكرها بفعل العمليات الإرهابية من جهة، وعمليات التهجير القسري للسكان من جهة أخرى. ناهيك عن أنّه برزت كتابات من مراقبين مرموقين يحذّرون من شرق أوسط خالٍ من المسيحيين في أفق قريب. لكنّ الأقباط في مصر، وهم المجموعة المسيحية الأكثر عدداً في الشرق الأوسط، والأكثر رسوخاً في الحضور، والأوفر قدرة على الملاءمة، سيحولون دون الوصول إلى هذا الوضع الكارثي.
ولقد كان من حسن حظّ مصر أن وجد فيها على مدى التاريخ الطويل مؤسسة دينية قويّة ونافذة، لم تحد يوماً عن الاعتراف بالمسيحية القبطية جزءاً لا يتجزّأ من الشخصية الوطنيّة. فلما بدأت التهديدات تحيق بالتعايش السلمي بين المكونين الدينيين في مصر: الإسلام والمسيحية القبطية، طرح الأزهر سنة 2012 مبادرته المشهورة مع عدد من المثقفين، للمحافظة على الوحدة الوطنية أثناء أزمة كتابة الدستور، ومنها وثيقة “الحريات العامة” التي وقعها –آنذاك- مع البابا الراحل شنودة الثالث، وتضمّنت إقراراً واضحاً بمبدأ الحرية الدينية. وربما كان للأزهر دور في تسهيل لقاء العاهل السعودي والبابا تواضروس الثاني، على الأقل من ناحية توفير المناخ الملائم للحدث. والمهم الآن أن يسهم الانسجام بين البلد الراعي للمقدسات الإسلامية وأكبر مؤسسة إسلامية في دعم حوار الأديان والتعايش بين الجماعات الدينية المختلفة في المنطقة، وتقديم إشارات إيجابية للمستقبل، لا سيما أنّ هذا التوجه سيكون مكمّلاً لجهود الإصلاح الديني في الداخل، سواء من جهة المجهود الذي يقوم به الأزهر لنشر ثقافة الاعتدال والوسطية داخل المجتمع المصري خصوصاً، وفي الأقطار الإسلامية عموماً، أو من جهة الإصلاحات السعودية في المجال الديني، وآخرها قرار مجلس الوزراء تجريد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصلاحيات المتعارضة مع مبدأ المواطنة والدولة المدنية.
ليس أفضل من الأزهر في الدفع بهذين التوجهين المتكاملين: نشر الاعتدال داخل الدائرة الإسلامية، وتشجيع الحوار داخل الدائرة الدينية الأوسع. فلقد ولّت عهود سيطر فيها وهم تحويل كلّ منطقة الشرق الأوسط إلى دين واحد، وقد تسبّب هذا الوهم في مآسٍ ما زالت تبعاتها مستمرّة إلى اليوم. وليست حركات التطرّف الديني والإرهاب إلاّ نتيجة التغافل عن أفكار انتشرت أحياناً عن طريق المقرّرات المدرسية والمبادرات الرسمية والجمعيات الخيرية، ولم يقع الانتباه إلى مخاطرها ومنزلقاتها، فهذا ما ينبغي اليوم مراجعته وتقديم إشارات إيجابية على تغيّرات حاسمة ليس أقلّها الاعتراف بالتعدديّة الدينية في المجتمعات العربية والشرق أوسطية، وتوجيه رسالة واضحة وحاسمة لمشاريع التطرف والإرهاب التي تسعى إلى تقسيم المجتمعات ودفعها إلى العنف والتناحر بأنها غير مرحّب بها.
* أكاديمي تونسي أستاذ كرسي اليونيسكو للأديان المقارنة في جامعتي السوربون بفرنسا ومنوبة بتونس