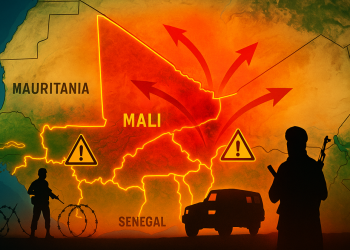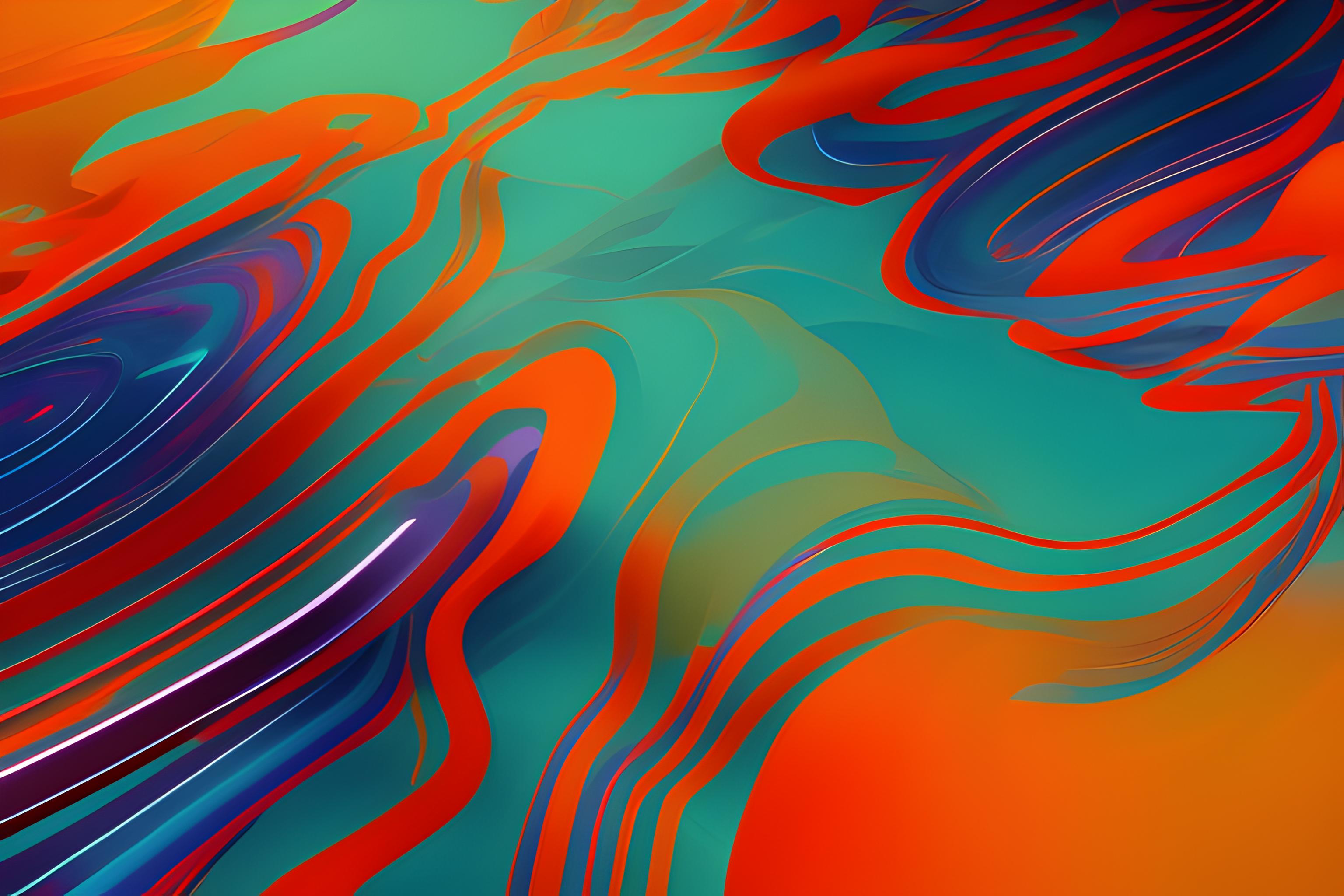يتميز السودان من بين دول الإقليم بتعدّديات في كل المناحي، تعدد في القوميات وفي الهويات وفي الأقليات، وحول هذه الميزة تكثر المراجع وتتعدد الآراء، فمن تركيز على اختلاف البيئات الطبيعية لأقاليمه الجغرافية (وطن بحجم قارة) وإفرازات هذه البيئات من تنوع في المناخ، إلى تعدد في الأعراق والمعتقدات واللغات والتقاليد والعادات وفي طرائق العيش عمومًا، وقد فاضت الدراسات الأنثروبولوجية والجغرافية بتفصيل التنوع السكاني واللغوي والإثني والعرقي بدراسة كل الجماعات تقريبًا، وانتقلت المصطلحات الأنثروبولوجية والجغرافية من حيزها التخصصي إلى الاستخدام في مجالات السياسة والاقتصاد والإدارة وانتقلت معها بذلك المصالح والأغراض المتصارعة داخليًا وخارجيًا. وهذا التنوع والثراء يتمظهر، دائمًا، في الحيوية السياسية التي ينفرد بها السودان دون الدول القريبة منه من تعدد أيديولوجيات وكثرة أحزاب، وتفجر ثورات شعبية مدنية كانت أو ثورات عسكرية في صورة انقلابات عسكرية. هذا التوتر والقلق السوداني، هو في الواقع، صدى للتعدد الإثني والثقافي والأيديولوجي إضافة لتعدد المناخ الطبيعي نفسه، من مناخ صحراوي جاف في الشمال إلى مناخ استوائي خانق في الجنوب.
يناقش الباحث في هذا المقال مستقبل الإسلاميين في السودان، ويقوم المقال على فرضية أن مستقبل الإسلاميين في السودان سيتأثر بعدة عوامل:
- العامل الأول: انقسام الإسلاميين الداخلي والصراع بين القيادات منذ بدايات حكم نظام الإنقاذ (يونيو/ حزيران 1989 إلى أبريل/ نيسان 2019) وتفجّر هذا الانقسام آخر أيام الإنقاذ، وحتى بعد سقوط دولتهم لا يزال الصراع قائمًا، ولذلك هناك أكثر من مركز قرار الآن: هناك مجموعة سجن كوبر وهي مجموعة المدنيين والعسكريين المعتقلين وعلى رأسهم عمر البشير، الرئيس السابق، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع وآخرين، وهناك مجموعة المؤتمر الوطني بقيادة (إبراهيم غندور، وإبراهيم محمود العائد من تركيا أخيرًا) ومجموعة الحركة الإسلامية بقيادة الأمين العام علي كرتي، وكل مجموعة لها أنصارها وتوجهاتها وتحالفاتها المختلفة عن الأخرى، ولكن إذا أجملنا منصات الإسلاميين السودانيين الآن في منصتين هما: حزب المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، يمكن مناقشة حالة عدم الانسجام بين الطرفين على النحو التالي:
يظهر التباين في مواقف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في تقييمهما المختلف لما حدث في أبريل (نيسان) 2019 من سقوط سلطة الإنقاذ وعزل البشير، ففي حين ترى لجنة المراجعة التي شكلها حزب المؤتمر الوطني، وقامت بإجراء تحقيق موسع بين قيادات النظام داخل معتقل سجن كوبر في الخرطوم، أو خارج السودان في تركيا ومصر بمن فيهم المهندس صلاح عبدالله قوش الذي كان آخر مدير لجهاز المخابرات العامة، خلصت هذه اللجنة إلى أن ما حدث في أبريل كان خيانة من داخل التنظيم الإسلامي نفسه ومن داخل قيادات الجيش. الحركة الإسلامية بقيادة الأمين العام المكلف ليست متحمسة لهذه النتيجة المتداولة على نطاق واسع بين الإسلاميين وبين النخبة السياسية والإعلامية السودانية، بل إن الحركة، على خلاف الحزب، تنتهج نهج الانحناء للعاصفة والمحافظة على هيكل حركة الإسلاميين، وهذا الدور الذي يسعى علي كرتي للعبه يشبه -إلى حد بعيد- الدور الذي لعبه محمد إبراهيم نقد، سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، والذي تحمَّل تكاليف إنقاذ هيكل الحزب الشيوعي بعد الهجمة الشرسة التي قادها ضدهم الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري، بعد فشل انقلاب الضباط الشيوعيين في يوليو (تموز) 1971. قدرات علي كرتي التنظيمية والسياسية، وهي محل جدل الآن، هي التي تحدد، بشكل كبير، مسارات مستقبل الإسلاميين في السودان.
قاد علي كرتي الحركة الإسلامية في خط سياسي أدى لحالة تمايز من حزب المؤتمر الوطني المحلول. فالحزب، وفقًا لما يصدر من رموزه في الإعلام، ضد العسكريين في السلطة وضد العملية السياسية (الاتفاق الإطاري) التي تجري في السودان الآن. أما الحركة؛ فتميل إلى عدم المواجهة الآن بل دعمت، عبر كوادرها في الدولة، رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وساندته حين قرر فض شراكته مع تحالف قوى الحرية والتغيير في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. إذن لدينا خطان سياسيان متباينان، وهذا يثبت وجود خلاف داخلي وسط الإسلاميين في السودان.
ولكن لا يمكن إهمال أنّ هاتين المجموعتين (الحزب والحركة) تتحركان تحت مظلة واسعة باسم الإسلام السياسي العمومي، وتتقارب مواقفهما أحيانًا، خصوصًا في مواجهة أعدائهما التقليديين في السودان.
العامل الثاني المؤثر على مستقبل إسلاميّ السودان: هو المصير الذي سينتهي إليه مسار القوى السياسية المناهضة للإسلاميين. نجاح أو فشل هذه القوى في إدارة المرحلة الانتقالية سيكون له تأثير بالغ على مستقبل الإسلاميين.
العامل الثالث: حجم الرفض الشعبي للإسلاميين في الأوساط الشعبية، وبرغم أنه كان موقفًا موحدًا ساهم في إسقاط سلطتهم، ولكنه سرعان ما بدأ يتضعضع تحت ضربات الإحباط الشعبي من الأداء الباهت للحكومة الانتقالية، وسيصبح هذا العامل محل سؤال وشك إذ لم يعد العداء الشعبي ثابتًا بعد برود الثورة، وانتهى العداء إلى انحصاره مع أعداء سياسيين ذوي منطلقات أيديولوجية معادية للإسلاميين تاريخيًا مثل: الحزب الشيوعي السوداني، وقوى اليسارالأخرى، وبعض التيارات الليبرالية.
العامل الرابع: قدرة الإسلاميين على إجراء المراجعات والجراحات العميقة داخل تنظيمهم وتقديم قيادة جديدة.
العامل الخامس: موقف الدول المؤثرة في الداخل السوداني (أميركا، السعودية، الإمارات، مصر، وربما بريطانيا) من الإسلاميين السودانيين في مرحلة ما بعد سقوط سلطتهم.
نشأة وتطور الحركة الإسلامية في السودان:
ماذا نعني بالإسلاميين أو حركة الإسلام السياسي في السودان؟ يستخدم مصطلح (الإسلام السياسي) في الأوساط السياسية والفكرية والأكاديمية والإعلامية لوصف حركات سياسية تستخدم شعارات إسلامية مدخلاً للوصول للسلطة، وتعتبر الإسلام “نظامًا سياسيًا للحكم”، وهذا وصف ينطبق على إسلاميي السودان كما ينطبق على نظرائهم في مصر والشام وشمال أفريقيا[2].
يرجع المؤرخون السياسيون نشأة الإسلام السياسي السوداني كرد فعل لصعود التيار اليساري بكلية غردون الجامعية (جامعة الخرطوم لاحقًا) في أواخر الأربعينيات، حيث تمكن الشيوعيون من السيطرة على اتحاد طلاب الكلية، فقامت مجموعة من الطلاب بقيادة بابكر كرار ومحمد يوسف محمد وغيرهما، بتكوين “حركة التحرير الإسلامي” التي تعتبر نواة للحركة الإسلامية الحديثة بالسودان، وكان ذلك في أواخر عام 1949، في الوقت ذاته كان عدد من الطلاب السودانيين الذين يدرسون بمصر قد انضموا إلى جماعة الإخوان المسلمين هناك، وعلى رأس هؤلاء الطلاب: صادق عبدالله عبدالماجد، وجمال الدين السنهوري وغيرهما، وقد أدت مسألة العلاقة بين إسلاميي السودان الأوائل وجماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى انشقاق في صفوف التيار الإسلامي في السودان، تعمق بالاختلاف حول ما إذا كان الأجدى أن تركز الحركة على التربية الروحية فقط، أم تخوض المعترك السياسي، وتم حسم هذه الموضوعات الخلافية في مؤتمر جامع عقد عام 1954.
وتحالف الإخوان المسلمون (وهو الاسم الذي أقره مؤتمر 1954) مع عدد من الهيئات والجماعات الإسلامية، وأسسوا (الجبهة الإسلامية للدستور) وكان ذلك في أواخر1955[3]، وعملت جماعة الإخوان المسلمين في إطار هذه الجبهة حتى قيام الحكم العسكري الأول. وبعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) التي أطاحت بالحكم العسكري الأول، برزت الحركة الإسلامية باسم “جبهة الميثاق الإسلامي” التي تحولت إلى حزب سياسي فاعل، بعد أن كانت جبهة الدستور مجرد جماعة ضغط. واستمرت جبهة الميثاق منذ أواخر 1964 وحتى قيام انقلاب مايو (أيار) في 25 مايو (أيار) 1969[4].
وبعد انقلاب مايو (أيار) بقيادة جعفر نميري الذي اتخذ توجهًا يساريًا في البداية، شاركت الحركة الإسلامية مع الأحزاب الوطنية الأخرى (حزب الأمة والحزب الاتحادي) في تكوين الجبهة الوطنية المعارضة لنظام نميري. وعقب المصالحة الوطنية عام 1977 شارك الإخوان بفاعلية في مؤسسات مايو (أيار) إلى أن تمت المفاصلة بين الطرفين (الرئيس جعفر نميري، وزعيم الإسلاميين وعرابهم حسن الترابي)، هذه المفاصلة حدثت قبل شهر واحد من سقوط نظام نميري في أبريل (نيسان) 1985 بانتفاضة شعبية قادتها الأحزاب السياسية مجتمعة، وبعد سقوط نميري ظهر الإسلاميون باسم جديد هو (الجبهة الإسلامية القومية) بقوة هائلة شكلت معارضة قوية للحكومة الائتلافية بين (حزب الأمة والحزب الاتحادي الديمقراطي)، واشتركت في حكومة ائتلافية مع حزب الأمة لبعض الوقت.
وفي 30 يونيو (حزيران) 1989 قاد الإسلاميون انقلاباً أطاح بالسلطة الديمقراطية الحاكمة، واستولوا على السلطة في السودان بانقلاب عسكري بقيادة العميد -حينها- عمر البشير.
عوامل سقوط حكم الإسلاميين:
سقوط نظام الإسلاميين في 11 أبريل (نيسان) 2019 مثَّل إدانة شاملة لمشروعهم السياسي بقدر قوة ومراس الجماهير التي خرجت ضدهم وأسقطت حكمهم، وقد تضافرت عوامل عديدة أدت للسخط الشعبي العام ضدهم وساهم في سقوط سلطتهم، وهنا نعدد جزءاً من هذه العوامل[5]:
ـ تنكرهم للمبادئ الأساسية التي رفعوها واستقطبوا بها العضوية وهي (الحرية والعدل والتضامن والوحدة والشورى والنزاهة)، بالإضافة إلى الفشل في السياسات الكلية للإسلاميين التي كانت ديباجتها (السعي الحثيث لبناء ديمقراطية تقوم على التراضي، وتنمية تقوم على توازن يمكنه أن يتطلع إلى مسار سريع للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية)[6].
ـ ومن عوامل السقوط أيضًا: عدم تبني روح تجديدية، تجعل مراجعة السياسات والهياكل والقيادات شأناً راتباً، فليست هنالك سياسة واضحة لإبراز القيادات الجديدة، وخصوصًا، في أوساط النساء والشباب، وتوليد قيادات جديدة قادرة على تحقيق الاستمرارية والتطور، وقد نشطت مجموعات منهم، وسط الشباب، في عملية مراجعة شاملة بعد انفصال جنوب السودان (يوليو/ تموز 2011) ولكن تم قمع هذه التوجهات الإصلاحية، وهو عامل مهم إذا علمنا أن أغلب هؤلاء الشباب شاركوا في الثورة ضد نظام قادتهم، وبعضهم اتخذ موقفًا محايدًا تجاه البشير ومجموعته القابضة على السلطة وهي تنحدر نحو السقوط.
- من العوامل التي ساهمت في سقوط الإسلاميين أيضًا: عدم احترام حقوق القوى السياسية المعارضة في التعبير والنقد والاحتجاج، في إطار القوانين والأعراف الديمقراطية، وهو ما دفع هذه القوى للتحالف ضدهم وإسقاطهم في النهاية.
- من عوامل السقوط أيضًا: الفشل في إدارة التماسك الاجتماعي ورعايته وفق رؤية الإسلاميين التي ادعوا أنها تقوم على (تعزيز تماسك وتضامن وتكافل المجتمع السوداني. والسعي لكي يكون التنوع والتعدد في أعراق المجتمع وثقافاته ومعتقداته سببًا معززًا للوحدة والتضامن، وذلك من خلال الاعتراف بالتنوع وإثرائه والعناية به في جوانبه الإيجابية، ومحاربة اتجاهات التعصب والانكفاء، وتشجيع التعارف والتعايش والتسامح، التزامًا بنهج الدين القويم والأعراف السودانية الراسخة)، أي إن الممارسة العملية هزمت الشعارات والأهداف المعلنة.
- الفساد المالي غير المسبوق والفساد الإداري والقرارات المنفردة للرئيس البشير، التي ساهمت جميعها في تأزيم الوضع الاقتصادي في السودان، وهذا كان الدافع الرئيس لاندلاع المظاهرات الشعبية نهاية عام 2018، واستمرت وتفاقمت المظاهرات حتى خرجت عن السيطرة في أبريل (نيسان) 2019.
- على مستوى السياسة الخارجية وخاصة ما يتعلق بالمحيط الحيوي للسودان (الخليج العربي، مصر، إثيوبيا) اتسمت علاقة الخرطوم بدول الإقليم باللاثبات واللعب على الحبال، وهو عامل أساسي إذ حسم المجتمع الإقليمي حول السودان أمره، وساند الثورة الشعبية ضدهم. وكان هذا العامل جزءاً من الإرادات التي اجتمعت عليهم خلال ثورة ديسمبر (كانون الأول) وساهمت بفاعلية في سقوطهم.
- الصراعات الداخلية بين قادة الإسلاميين.
الصراع الداخلي:
بدأ الصراع الداخلي مبكرا وسط العسكريين في (مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني)، وهو المجلس العسكري الذي تشكل فور نجاح انقلاب يونيو (حزيران) 1989، إذ رفض بعض الضباط تدخل المدنيين في السلطة بشكل سافر، يقصدون بالمدنيين “دكتور حسن الترابي ومجموعته”، وقدم عدد منهم استقالاتهم من قيادة الدولة[7]، ثم انتقل الموقف الناقد لمسار سلطة الإسلاميين إلى “مثقفي الحركة الإسلامية” الذين -برغم مواقعهم القيادية داخل التنظيم- اتخذوا مواقف معارضة لنظام إخوانهم منذ وقت مبكر (الطيب زين العابدين، عبدالوهاب الأفندي، خالد التجاني النور، التجاني عبدالقادر) على سبيل المثال لا الحصر.
ثم حدث التنازع الأخطر بين زعيم الإسلاميين والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الدكتور حسن الترابي والرئيس عمر البشير، وخرج إلى العلن ووصل إلى مرحلة المواجهة بداية من ديسمبر (كانون الأول) 1998، بما عرف بـ”مذكرة العشرة” ضد هيمنة الترابي على حزب المؤتمر الوطني -واجهة الإسلاميين السياسية- وانتهت المعركة بما عرف بـ”قرارات الرابع من رمضان” في ديسمبر (كانون الأول) 1999 التي أصدرها عمر البشير والتي أنهت، وللأبد، العلاقة التحالفية الوثيقة بين الترابي والعسكريين بقيادة البشير. وهكذا وجد الترابي نفسه خارج السلطة وخارج الحزب الذي بناه عبر سنوات وسنوات. أعلن الترابي من جهته المفاصلة النهائية مع البشير، وشكل حزباً جديداً موازياً باسم “حزب المؤتمر الشعبي”، وأصبح الصراع بين قطبي الإسلاميين في السودان، المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، شرسا وربما يمكن القول: إن صراع الإخوة الأعداء هو العامل الأكثر حضورا وتأثيرا في إضعاف ومن ثم سقوط دولة الإسلاميين في السودان، بل توسع الصراع بخروج قيادات إسلامية تمردت على الدولة، وقادت حربًا شرسة ضد المركز الحاكم في إقليم دارفور، وعلى رأس هؤلاء خليل إبراهيم مؤسس حركة العدل والمساواة.
الآن ومستقبلاً، لا يزال ذلك الصراع الدامي بين الترابي والبشير يلقي بتبعاته على حاضر الإسلاميين ومستقبلهم؛ إذ تجد جزءًا من قيادات المؤتمر الشعبي ما زالت متأثرة بذلك الصراع، ويشكل جزءاً من مواقفها السياسية الراهنة ضد ما يسمى بـ(فلول النظام) أي الإسلاميين أعضاء حزب المؤتمر الوطني الذي كان حاكمًا.
قال الإخواني راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، مُتباكيًا على فشل التجربة الإسلامية السودانية، في حوار صحفي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) 2010[8]، طرح فيها تساؤلات استنكارية، لخّصت أسباب فشلها: “للأسف، فشل التجربة الإسلامية السودانية أمر واقع، وهل يُتوقع ممن فشل في إدارة الحوار في صلب جماعته، أن ينجح في التوافق مع جماعات طالما أعلن عليها الجهاد، ولم يدخر وسعاً في التعبئة ضدها وتضليلها وتخوينها، والحلف نهارًا أمام الملأ أنه لن يعيد تلك الأحزاب الطائفية؟ وهل يُتوقع ممن أسس مشروعه على استبعاد الآخرين والانفراد بالسلطة ونظَّر لذلك ورتب عليه أمره، أن يتراجع عن ذلك ويتحول إلى ديمقراطي يحترم حقوق الآخر ويفي بما يعاهد عليه؟”. ومن هذه الجهة يمكن تعزيز عوامل سقوط الإسلاميين في السودان المذكورة سابقاً بهذه النقاط التالية:
1. علل السلطة من صراعات ونزاع داخلي.
2. اختطاف القرار بواسطة أقلية بسيطة من القيادات، ثم صار الأمر إلى شخص واحد هو الرئيس المعزول عمر البشير في نهاية المطاف.
3. ضعف مؤسسات الحركة الإسلامية، وأصبحت خارج التأثير تمامًا، وبذلك ضعف العمل المؤسسي وأصبحت القرارات متعجلة ومرتجلة، وقد وضح ذلك جليًا في الاستجابة للتظاهرات المنتظمة التي اندلعت في السودان بدءًا من نهاية عام 2018، وحتى لحظة السقوط في أبريل (نيسان) 2019.
4.انتشار الفساد المالي وسط بعض قيادات الإسلاميين بشكل ظاهر وعلني، أثار عليهم سخط الشعب.
5. تسرب العضوية والقيادات ذات الخبرة وخروجهم تمامًا من الحزب والحركة، بعضهم شكل أجسامًا سياسية معارضة لسلطة البشير وجماعته.
مستقبل الإسلاميين في السودان:
هناك عدة سيناريوهات تفرض نفسها على واقع الإسلاميين ومستقبلهم في السودان، ويمكن القول: إن الإسلاميين فقدوا العقل المفكر لهم والشخصية المتفق عليها، القادرة على اجتراح طريق جديد، كما أن الخارجين من مظلتهم خصموا من رصيد الحركة الإسلامية الشعبي، خاصة في إقليم دارفور، غرب السودان، وهو الإقليم الذي كان معقلاً للإسلاميين خاصة في الثمانينيات من القرن الماضي.
ويلاحظ الدارس المتابع أن هناك وعيًا مستجدًا بدأ يتشكل وسط قادة الطرق الصوفية، وهم حلفاء محتملون للإسلاميين دائمًا في مواجهة اليسار السوداني، هذا الوعي قاد الصوفيّة للاستقلال بقرارها السياسي ويتمثل هذا في “تحالف نداء أهل السودان” الذي تشكل حديثاً بقيادة الخليفة الطيب الجد ود بدر (خليفة الطريقة القادرية، في أم ضوّا بان).
مستقبل الإسلاميين السودانيين على ضوء تجارب نظرائهم في البلاد العربية
هنالك، دائمًا، أربعة سيناريوهات عربية أمام حركات الإسلام السياسي:
- الأول: يصل تنظيم الإسلاميين للسلطة منفردًا عبر الانقلاب العسكري (السودان) أو عبر الانتخابات (مصر بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011).
- الثاني: وجود نظام سياسي يسمح بالمنافسة بين كل القوى السياسية، في إطار تعددي ويشارك الإسلاميون جزئيًا في السلطة عبر تحالفات وتفاهمات مع القوى الأخرى في الدولة المعنية بأنظمة برلمانية مستقرة نوعا ما (الأردن، المغرب، تونس بعد ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010).
- الثالث: صراع مفتوح بين السلطة القائمة والتنظيم الإسلامي (مصر، تونس الآن). في السودان هناك احتمال ضعيف نسبة لتوازن الضعف السائد بين كل القوى السياسية في السودان، ولكنه قائم في السودان، أن ينفجر صراع حاد وعلني بين القوى الليبرالية إذا دانت لها السلطة الكاملة من جهة، والإسلاميين من جهة ثانية.
- الرابع: هو سيناريو يحدث عند تشظي وسقوط الدولة التاريخية، مثلما هو الحال في اليمن وليبيا، وفي هذه الحالة من الفوضى تنهار الحدود ما بين ما هو إسلامي وما هو ليبرالي أو تقليدي، ويندغم الجميع في مواجهة ضد أو مع مشاريع التدخل الأجنبي.
على ضوء هذه السيناريوهات، يبدو أن مآزق الإسلاميين في السودان أكثر تشعبًا من نظرائهم. هم منهكون من الحكم ثلاثين عامًا، ومطاردون من أعدائهم ومن إكراهات اللحظة السياسية في السودان، وفي الإقليم حول السودان. عليه؛ يمكن الجزم باستحالة عودة الإسلاميين للحكم على نمط الإنقاذ السابق، ولكن في نظام تعددي ديمقراطي مستقر، يمكن تصور وجود مؤثر لهم ضمن الآخرين، وليس وحدهم كما في السابق.
الخاتمة:
أخيرًا، إذا كان هنالك أمر واحد يجمع عليه غالب أهل السودان اليوم، وينتظر أن ينخرط فيه الجميع، إسلاميين وليبراليين وتقليديين وثوريين، فهو أن وطنهم يمر حاليًا بأصعب وأدق وأحرج فترة في تاريخه الحديث، وأن بقاء أو فناء ما يعرف بالسودان الوطن والدولة، يتوقف على إدراكهم المشترك لهذه الحقيقة وللكيفية التي يعالجون بها قضاياه المصيرية (هذه القضايا هي حصاد حكم الإسلاميين وغير الإسلاميين في السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم)، ويمكن تلخيص هذه القضايا في النقاط التالية:
أولاً: قضية التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وتبعات ذلك من ضنك العيش والإفقار والهجرة إلى المدن في مقابل الثراء الطفيلي. أضف إلى ذلك مشكلات الجفاف والتصحر ودمار البيئة والهجرة إلى المدن ومشكلاتها، وانفراط عقد الأمن في مناطق عدة من الوطن.
ثانيًا: مشكلات التنوع والتمايز الإثني والثقافي والديني، وتصاعد وعي الجماعات المهمشة في بعض الأقاليم الرافضة للعلاقة القائمة بين الإقليم والدولة، والمطالبة بالمشاركة في السلطة، وقسمة الثروة من خلال تغيير جذري في أسس وبنيات الدولة والسلطة، وحساسية الفئات الحاكمة تجاه هذه المطالب.
ثالثًا: العلاقة بين الدين والسياسة في وطن متعدد الانتماءات الدينية. هذه العلاقة التي تتعقد بطرح جماعات السلطة الحاكمة وتوجهاتها نحو التحام السلطة السياسية والمجتمع، من خلال المنظور الديني الذي ينظر إلى المشكل الوطني في البلاد من خلال الدين، ويفسره بفقدان الهوية الدينية وعدم الإخلاص والوفاء بالعهد للعقيدة، ذلك في مواجهة ما تطرحه الفئات غير المسلمة ممن يخشون ضياع حقوقهم في إطار الدولة الدينية، فينادون بدولة المواطنة وبالمساواة في الحقوق والواجبات وحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.
رابعًا: الإشكال القائم على هوية السودان والسودانيين وانتماءاتهم العربية والأفريقية، كأنما هناك قوميتان تتصارعان وتتنافسان على ولاء السودانيين.
خامسًا: مشكلات الحرب الأهلية التي تدور رحاها اليوم، ومنذ سنوات طويلة، وهي أعقد المشكلات لأن طبيعة الصراع الدائر ومداه يؤثران سلباً على مستقبل الوطن، فكلما طالت الحرب زاد أوارها وقلت فرص التفاهم. وصراع الحروب المفتوح لا تتحمله الدولة، وقد يكون مدمرًا.
[1]* باحث وكاتب سياسي سوداني.
[2] راشد الغنوشي، الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية، المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، 2000، ص859.
[3] الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الرابعة، 1999، 1/232..
[4] المرجع نفسه.
[5] إبراهيم الكاروري، الإسلاميون وأسئلة الثورة السودانية، دار البشير، 2022، ص7 و8.
[6] النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني في السودان، الخرطوم، 2005، ص 28.
[7] عبدالرحيم عمر محيي الدين، الترابي والإنقاذ: صراع الهويَة والهوى.. فتنة الإسلاميين في السلطة من مذكرة العشرة إلى مذكرة التفاهم مع قرنق، دار كاهل للنشر، الخرطوم، الطبعة الرابعة، 2009، ص435.
[8] صحيفة سودانايل الإلكترونية، الخرطوم، 26 ديسمبر (كانون الأول) 2010م.:
www.sudanile.com