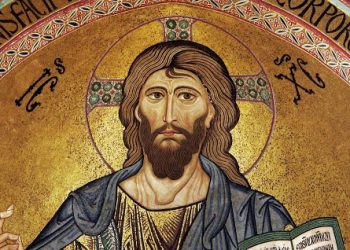إصلاح التعليم الديني بالمغرب
الإنجازات والحدود
السياق المغربي
يوم 23 مايو 2003، قامت مجموعة من شبان الأحياء الشعبية بالدار البيضاء بتفجير أنفسهم في عدة مناطق من المدينة، وأسفرت العملية عن مقتل 45 شخصا. وكان أفراد المجموعة ينتمون إلى الأيديولوجيا الإسلامية السلفية الجهادية. وقد مثّل هؤلاء الشباب اللون المحلّي لهذا النوع الجديد من الإرهاب السياسي الديني. وقد تخرجوا في المدارس المغربية ولم يعرفوا غيرها.
تطوّر الشعور العام من الصدمة إلى الحيرة، وبعد مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الأمني (حملات إيقاف واسعة في أوساط الأصولية الراديكالية) بدأ يطرح التساؤل حول الأسباب العميقة لهذه الكارثة، سواء من السلطات العمومية أو وسائل الإعلام أو الشخصيات السياسية والجمعياتية. وقد طرحت الدوافع الاجتماعية، مثل السكن والعمل والرواتب والمعدّات الصحيّة والتجهيزات الاجتماعية والثقافيّة… إلخ. لكن طرح أيضا مشكل المنظومة التعليمية وبرزت عدّة أسئلة منها:
طبيعة التعليم الديني والاجتماعي الديني في المجتمع المغربي.
الخطاب الديني المدرسي.
مضامين الكتب المدرسية.
تكوين مدرسي الدين والعلماء والوعاظ وطرق الإحاطة بهم.
طرق تنظيم وإدارة المؤسسات المخصصة للتعليم والاجتماع الدينيين.
لقد استيقظ الوعي المغربي على وقع هذه الأحداث الأليمة ولم يعد يقبل التخفي وراء خطاب أيديولوجي وسطحي يرمي بالأفكار والممارسات الدينية المتطرفة إلى مسؤولية خارجية مرتبطة ببلدان مسلمة من آسيا أو الشرق الأوسط أو الشتات المغاربي في أوروبا، واعتبار التطرف مناقضا للإسلام المغربي المعتدل والمتسامح والمحترم للغير.
وقد بدا للبعض أنّ هذه الأحداث تعبّر عن نهاية أسطورة الإسلام المغربي المتميّز، لكنها تعني أيضا فشل إصلاح المنظومة التعليمية وهي حركة بدأت منذ إقرار «الميثاق الوطني للتربية والتكوين» (2000) ولم تتجاوز سنتها الثالثة عند وقوع هذه الأحداث.
ثقل الماضي
كي نفهم الوضع الحالي ومأزق الإصلاح التعليمي الديني في المغرب، فإنه يتعيّن أن نقيّم ثقل الماضي البعيد والقريب، ونسائل التراث ونعاين امتداداته في الحاضر.
التعليم الديني: الهياكل المفككة: لم يكن التعليم الديني موحّدا، على غرار التعليم المغربي عموما، فهناك هياكل عديدة تتولّى تنظيم هذا التعليم، بعضها ينتمي إلى التعليم الحكومي العام وبعضها إلى الجمعيات (جمعيات الأحياء والزوايا… إلخ). والبعض من مؤسسات النوع الثاني قديم وقد يعود إلى العهد السابق للحماية، أما البعض الآخر من الجمعيات فقد ظهر وتعدّد في مرحلة قريبة شهدت تنامي الأصولية الدينية في صلب المجتمع.
إلى عشية الأحداث الأليمة التي شهدتها الدار البيضاء سنة 2003، كانت السلطات العمومية متلائمة مع هذا الوضع المفكك في فضاء التكوين والاجتماع الدينيين، ولم يكن يتوفر إحصاء دقيق وشامل لمختلف الأطراف التي تبث المعرفة الدينية، وكانت المعلومات حول أماكن العبادة والوعظ موزّعة بين عدة مصالح وزارية (وزارة الأحباس والشؤون الإسلامية، وزارة التربية، وزارة الداخلية).
وقد أنشئت سنة 2004 إدارة التعليم التقليدي ضمن وزارة الأحباس والشؤون الإسلامية، بغاية توسيع مراقبة الدولة لمختلف الأماكن التي يدرّس فيها الدين بطريقة تقليدية، وخاصة في الأرياف المغربية وفي جنوب المغرب. فهذه الأماكن كانت منفصلة عن السلطات العمومية تديرها تقليديا زوايا وأسر أو طلبة تخصصت منذ أجيال في نقل المعرفة الدينية التقليدية.
تقليديا، كانت الزوايا هي المضطلعة بنشر المعرفة الدينية في الأوساط الواسعة، لكن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تنامي مؤسسات خاصة تهدف إلى نشر المعرفة الدينية وتديرها جمعيات للوعظ الديني والدعوة. وقد انتشرت شيئا فشيئا في المملكة مراكز مستقلة للتكوين الديني تحمل تسميات عامة مثل «دار القرآن» أو «دار السنة» أو تحمل أسماء أعلام من التراث الديني مثل الإمام مالك مؤسس المذهب المالكي، ويَرتبط جزء من هذه المراكز ببعضها البعض وتحظى بمساعدات مالية أجنبية.
أمّا التعليم الديني العمومي فهو لا يخلو أيضا من التفكك في مستوى الأطراف التي تشرف عليه وتراقبه. فهناك هياكل التعليم الديني التابعة لوزارة الأحباس والشؤون الإسلامية التي تغطّي أربعة مجالات رئيسة وهي:
التعليم القرآني الحديث الذي تتولاّه هذه الوزارة منذ 1964.
دروس العلوم الدينية التي يلقيها علماء تعينهم الوزارة في مختلف مساجد المملكة. وقد شرع في تنظيم هذه الدروس منذ 1984 بقرار من ملك المغرب، كي يعاد إحياء التقليد القديم والمحاضرات الدينية العامة في المساجد؛ لأن هذا التقليد كان قد تراجع وضمر.
المركز الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية، وقد أنشئ سنة 1974، وكان مستقلا بنفسه في البداية، ثم وضع تحت إشراف الوزارة سنة 1985.
المدارس التقليدية، وهي مراكز قديمة للتعليم الديني موزعة على كامل التراب المغربي، ومهمتها تكوين الوعاظ والمؤذنين وأئمة المساجد.
مؤسسة دار الحديث الحسينية، وقد أنشئت سنة 1964، وعهد إليها بتكوين الإطارات العليا للعلماء.
وهناك أيضا الهياكل التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، إذ تشرف هذه الوزارة بدورها على بعض هياكل التعليم الديني وأهمّها التعليم القرآني الموجّه إلى الأطفال الذين لم يبلغوا سنّ الدراسة. أمّا التعليم الديني في المرحلتين الابتدائية والثانوية فهو يمثل الوظيفة الثانية للوزارة في هذا الميدان، وكان تنظيمه قائما على التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي سنة 1973. وينتهي هذا التعليم بشهادة باكالوريا في التعليم الديني تفتح المجال للدخول إلى الجامعة. أمّا التعليم العالي فإن الوزارة تشرف فيه على جامعة القرويين المشهورة، وهي تضم أربع كليات موزعة في فاس وأغادير ومراكش وتطوان. وإضافة إلى هذه المؤسسات التقليدية فقد وقع إحداث قسم للدراسات الإسلامية في كل الكليات الأدبية بالمملكة منذ الثمانينات.
تلتقي كل هذه الهياكل للتعليم الديني حول هدف تكوين إطارات في مختلف فروع العلوم الدينية وأهمها الفقه والحديث والتفسير والسيرة… إلخ. فهي تقدّم تعليما مختصا وموجّها إلى جزء من المتعلمين المغاربة، وقد تضاعف عدد المقبلين على هذا التعليم مع إنشاء أقسام الدراسات الإسلامية وفتح التعليم في وجه المتحصلين على شهادات من هذه الأقسام، إذ يمكن انتدابهم لتدريس مادة أحدثت نهاية السبعينات دعيت «التربية الإسلامية».
الوظيفة الأساسية للتعليم الديني: اضطلعت الدولة المغربية منذ الاستقلال بوظيفة التكوين الديني لشبابها، على غرار ما هو حاصل في أغلب البلدان الإسلامية. وقد اعتبر هذا التكوين جزءا من التربية الوطنية، كما تنصّ المادة السادسة من الدستور (1963) التي تعتبر الإسلام دين الدولة وتضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية. فقد عهد إلى المدرسة المغربية بمهمّة تعليم كل الأطفال المسلمين مبادئ الإسلام تعليما إجباريّا من السنة الأولى من التعليم الابتدائي إلى البكالوريا.
ويمكن القول: إن المقاربة التعليمية التي اعتمدتها المدرسة المغربية تمثل تواصلا مع التقليد القديم للمؤسسات التعليمية في المغرب قبل الاستقلال (المدارس القرآنية، المساجد، الزوايا… إلخ). ولم يعرف في تاريخ التعليم المغربي ما يمكن تسميته بالمقاربة من الخارج للدين، أي الحديث عن العقائد والشعائر من جهة كونها ظواهر اجتماعية وثقافية وتاريخية، فليس المطلوب من دروس التربية الإسلامية أن تقدّم مقاربة علمية لمعطيات الدين الإسلامي، أو قراءة مقارنة لمختلف المذاهب والفرق (سنة، شيعة، عقلانية، تصوف، إشراقية… إلخ) التي توالت وتراكمت على امتداد تاريخ المجتمعات الإسلامية، وليس المطلوب منها أيضا أن تقدم مقارنات موضوعية لمختلف الديانات التوحيدية. بعبارة أخرى: لم يكن مطلوبا من هذه الدروس أن تقدّم الفكر الإسلامي في تنوعه واختلافه، بل أن تقدّم للمتعلّم العقيدة الرسمية للدولة في المجال الديني. فالهدف لا يتمثل في نقل مضمون معرفي، بل تعميق الانتماء الديني. وتقدّم الكتب الدراسية في التربية الإسلامية، خاصة في التعليم الأساسي، نوعا من التعليم الرسمي (كاتيشيزم) يسعى المجتمع إلى نقله إلى الشباب بصفته متضمنا حقائق مطلقة وأزلية.
الاستعمالات السياسية للتعليم الديني: شهدت نهاية السبعينات إنشاء أقسام دراسات إسلامية في التعليم الجامعي الحديث وكليات الآداب والعلوم الإنسانية، كما شهدت إدخال مادة التربية الإسلامية في التعليم العمومي، وقد مثّل هذان الحدثان المهمّان تحوّلا في التعليم الديني بالمدرسة العمومية المغربية. وقد عبّر هذا التحوّل عن إرساء علاقة جديدة بين الدين والدولة المغربية، إذ أصبح الإسلام مستعملا لصدّ التيارات السياسية والأيديولوجية المعارضة وأهمها القومية والبعثية والاشتراكية والشيوعية. وكان شباب المدارس الرهان الأوّل لهذا التوظيف السياسي للإسلام من قبل الدولة فقد اعتبر هذا الشباب ضحية الدعاية اللائيكية والأيديولوجيات الهدّامة. فأصبح المطلوب إعادة الشباب إلى الإسلام، وتعاضدت على تحقيق هذا المطلب الدولة والجماعات الإسلامية؛ فقد اتفق الطرفان ضمنيا على ضرورة التصدّي للأيديولوجيات اللائيكية في الوسط المدرسي والجامعي. وكانت السلطات تعتبر آنذاك أنّها تحتوي بهذه الطريقة الاحتجاجات الشبابية، إذ إن الشباب المدرسي والجامعي كان المحرّك الرئيس لهذه الاحتجاجات.
وقد بدأ تطبيق هذه السياسة القاضية بأسلمة الشباب في منتصف السبعينيات، وتواصلت في السبعينيات والثمانينيات، وتنزلت في إطار القطيعة التي حصلت بين العرش والمعارضة ذات الاتجاه القومي الاشتراكي. وقد ترتب على هذه السياسة اتخاذ العديد من الإجراءات مثل تهميش تدريس الفلسفة وتقليص مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. وبهذه الطريقة برزت المعالم الأولى للدور السياسي للدين الذي لم يتردّد بعض الباحثين من دعوته بـ«أصولية الدولة»، باعتبار أن الإسلام اعتبر أصلا للدولة المغربية، مقابل التعصب الإسلامي الذي اعتبر غريبا عنها، والذي كان يعبّر بدوره عن الاحتجاج والمعارضة.
خصائص الخطاب الديني المدرسي
يثبت تحليل الكتب المدرسية التي كانت مستعملة في التعليم الديني سابقا أن الغالب على الخطاب هو المنحى التمجيدي والمقابلات الحادة التي تجعل الإسلام متفوقا على كل الأديان والأيديولوجيات المنافسة. وتستعمل هذه الكتب الطرق التعليمية القائمة على التلقين كي ترسخ في العقول تصوّرات مانوية قائمة على قطبين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فكل شيء يبدو قابلا للتقييم حسب أحد القطبين، بما في ذلك القضايا الفكرية والاجتماعية المتعلقة بالمجتمع والمرأة والاقتصاد والسلطة والدولة والمعرفة والعلم.
ويتحوّل الإسلام في هذا الخطاب إلى نظام سياسي وأيديولوجي يشمل كل جوانب الحياة ويمنع علمنة المجتمع، بل إنّه يجعل الإسلام منظومة مغلقة ومنفردة لا يمكن لها إقامة علاقات مع الأديان والعقائد الأخرى، لذلك يكثر الحـديث عـن «ذاتية الإسلام» أو «الإسلام في مواجهة الأيديولوجيات المعاصرة». ويتمثل العمود الفقري لهذا الخطاب في النصوص المقدسة طبعا، وهي آيات منتقاة أو أحاديث نبوية، تعرض منتزعة عن سياقها التاريخي. فاعتماد هذه النصوص المؤسسة في تعليم مدرسي يجعل المتلقي يتماهى مع مجمل الخطاب المقدّم، ولا يميّز بين الانتماء إلى الإسلام وهذه الخصائص الإسلاموية للخطاب. يضاف إلى هذا الأمر آثار الأساليب التعليمية التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين، مما يجعل الخطاب أكثر عمقا وتأثيرا في النفس. ويبدو لنا أن بنية الخطاب التعليمي تمثل عاملا أساسيّا في التماهي بين المتلقي والمضمون المدروس. وإلى جانب مرجعياته المطلقة (القرآن، الحديث) فإن هذا الخطاب يعتمد مجموعة أخرى من المرجعيات تتعلق ببعض الكتّاب المعاصرين.
الدين بصفة اللامفكر فيه في الميثاق: مثّل اعتماد الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000 حدثا بالغ الأهمية في تاريخ التعليم بالمغرب، وذلك لأسباب ثلاثة على الأقلّ:
إنّها أوّل مرة يحظى فيها البلد برؤية شاملة تحدّد أسس المنظومة التعليمية الوطنية وفلسفتها وتوجهاتها.
يعبّر الميثاق عن التخلّي عن رؤية قوميّة للتعليم قائمة على إثبات الهوية الوطنية، خاصّة في أبعادها الدينية، والتحوّل إلى رؤية قائمة على نوع من العقلانية التنموية.
كانت أوّل مرّة تحصل فيها وثيقة متعلقة بالتعليم على وفاق وطني، وتقبلها مختلف القوى السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية التي أسهمت في صياغتها.
لقد اعتبر صدور هذه الوثيقة حدثا تاريخيا؛ إذ إنّها فتحت المجال أمام سلسلة من الإصلاحات المتصلة بالمنظومة التربوية المغربية بمختلف عناصرها وفي كلّ مستوياتها. ومع ذلك فقد ظلّت مسألة التعليم الديني والخطاب المدرسي حول الدين مسألة لا مفكر فيها، واقتصر على استعمال بعض الصيغ الفضفاضة في هذا الموضوع القابلة لكل القراءات الممكنة.
لقد راكمت الوثيقة مبادئ متناقضة تستند إلى مصادر ومصادرات متباينة، وكذلك أعدّت وزارة التعليم سنة 2001 كتابا أبيض يحتوي على التوجهات العامة في مجال مراجعة مجمل البرامج التعليمية. ويقدّم هذا الكتاب الاختيارات التي أقرّها الميثاق ويضع مصادر أربعة أساسية بصفتها محدّدات القيم التي ينبغي أن توجّه المضامين التعليمية وهي التالية:
قيم الدين الإسلامي.
قيم الهوية الحضارية والأخلاقية والثقافية للمغرب.
قيم المواطنة.
قيم حقوق الإنسان في مفاهيمها الكونية.
إنّ الإجماع حول المبادئ لا يمكن أن يخفي نقائص الميثاق الذي تفادى الدخول في عرض تقييمي لوضع التعليم الديني واقتراح خطط لإصلاح هذا التعليم التقليدي الذي أصبح بعيدا عن روح العصر وحركية المجتمع. فالميثاق يشير إلى التعليم الديني في فصلين:
الفصل المخصص لرسم المبادئ الأساسية، ويرد فيه أنّ المنظومة التعليمية للمملكة المغربية قائمة على مبادئ الدين الإسلامي وقيمه، وأنها تهدف لتكوين المواطن المتصف بالفضيلة والاستقامة والاعتدال والتسامح… إلخ، وأن القيم المقدسة وغير القابلة للمراجعة هي الإيمان بالله وحبّ الوطن والتعلق بالنظام الملكي الدستوري… إلخ.
الفصل المخصص للتنظيم البيداغوجي، ويرد فيه تأكيد استيعاب القيم الدينية والأخلاقية والمدنية والإنسانية الأساسية؛ كي يصبح المتعلمون مواطنين معتزين بهويتهم… إلخ. وترد فيه أيضا التوصية بإنشاء تعليم ديني أصلي إلى حد المستوى الثانوي، وتطوير المدارس التقليدية، وإنشاء مراكز تكوين الإطارات المتوسطة في الخدمات الدينية، وإنشاء روابط وتنسيق بين الجامعات والمؤسسات في التعليم العالي الديني.
لقد صمت الميثاق عن طبيعة التعليم الديني والأهداف التي يسعى إليها البلد من خلاله، وكانت لهذا الصمت نتائج ثقيلة؛ لأنّ التنفيذ الإداري جاء دون مستوى الغايات المعلنة، وانتهى الأمر بالمحافظة على الأوضاع كما هي، فالسعي إلى التقريب بين قيم ومبادئ متناقضة، تحوّل في الكتب التعليميّة الجديدة إلى خطاب تمجيدي حول تفوّق الإسلام على كلّ الأديان ومبادرته بطرح كل القضايا، مثل حقوق الإنسان والبيئة والعدالة الاجتماعية والاقتصاد المتوازن والاستطيقا… إلخ، وسبقه في ذلك كل العلوم والمعارف المعاصرة.
مراجعة الكتب التعليمية
يحظى المغرب منذ 2002 بجيل جديد من كتّاب التربية الإسلامية، وقد وضعت هذه الكتب لتلبي الإصلاحات المقرّرة سنة 2001 في البرامج المدرسية، كما ضبط الكتاب الأبيض توجهاتها وأهدافها وطرق تنظيمها في مختلف مراحـــل التعليم (صدر الكتاب الأبيض عن وزارة التربية الوطنية سنة 2001 وتضمن 8 مجلدات) على أن الدوافع العميقة لهذه المراجعة تتنزّل في مسار الإصلاحات السياسية والتعليمية والقانونية التي شهدها المغرب منذ سنة 1990، وتعدّ من مراحل هذا المسار الذي طبع المنظومة التعليمية المغربية ما يلي:
إقرار دستور سنة 1992 الذي يشير صراحة في ديباجته إلى حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
التوقيع سنة 1974 على اتفاق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة حقوق الإنسان، موضوعه وضع استراتيجية مشتركة في مجال التربية على حقوق الإنسان، تتضمن دعم حضور هذه الحقوق وما يتصل بها من مبادئ ومفاهيم في البرامج والمحتويات المدرسية.
إصدار وزارة التربية لكتاب أبيض سنة 2001 يتضمن التوجهات العامة حول مراجعة مختلف البرامج التعليمية.
وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات السياسية والتعليمية الكبرى، فقد شهدت سنة 2003 حادثين مهمين عجّلا بالإصلاحات ووضعا قضية التعليم الديني في مركز النقاش العام وهي:
الأحداث الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003، وقد تورطت فيها مجموعة من الشبان المنتمين للأيديولوجيا الإسلاموية المتطرفة. فالهجمات الانتحارية مثلت حدثا غير مسبوق في التاريخ المعاصر للبلد، وأحدثت صدمة عميقة في وعي المغاربة. وقد رفعت القناع عن حقيقة الأوضاع البائسة في بعض الأحياء الموجودة على هامش المراكز الحضرية الضخمة. وأكّدت ضرورة المسارعة بإصلاح عميق للخطاب الديني الذي تبثه المدارس والمؤسّسات المختلفة (الإعلام السمعي والبصري، الصحافة، المساجد، الجمعيات… إلخ).
إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في أكتوبر 2003، إثر أربع سنوات من الجدل المكثف والنقاش العام. وتتميّز المدونة بإحداث قطيعة مع تراث تشريعي قديم ترك المرأة في وضع الدونية والتبعية للرجل (الأب، الأخ أو الزوج). لقد اتجهت المدونة إلى إرساء تحديث حقيقي لأحكام الأسرة وإحلال مبدأ المساواة بين الجنسين والالتزام بالعدالة بينهما، وقد أغلقت المدونة جدلا طويلا تحكمت فيه الانتماءات الأيديولوجية وشاركت فيه كل شرائح المجتمع المغربي.
ولم يسلم مشروع إصلاح التعليم الديني من جدل يشبه ذاك الذي شهده مشروع إصلاح أوضاع المرأة؛ لأن قضية التعليم الديني تتميّز بحساسية خاصة في الماضي وترتبط برهانات سياسية حالية، وقد اعتبر جزء مهمّ من الطبقة السياسية المغربية (الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، التجمع الحركي… إلخ) وجزء من النسيج الجمعياتي المغاربي (جمعية العلماء، جمعية أساتذة التربية الإسلامية، خريجو دار الحديث الحسينية… إلخ) أن الإسلام لا يمكن أن يتحوّل إلى مجرد تراث ثقافي أو ميدان للبحث، بل هو المرتكز الرئيس للهوية المغربية. فالإسلام حسب هؤلاء هو الذي نحت تاريخ الوطنية المغربية ومنحها ثقافتها وشخصيتها. فمادة التربية الإسلامية لا يمكن أن تعامل معاملة المواد الأخرى أو تدرّس مثلها، بل هي «الروح التي ينبغي أن تبثّ وتوجّه كل المواد والاختصاصات في كل مستويات التعليم ومراحله، كي تسهم المنظومة التعليمية في إنشاء النموذج الحضاري المنشود» (من خطاب للسيّد زيد بوشعّارة، ممثل جمعيّة خريجي أقسام الدراسات الإسلامية العليا، مجلة «ترنيتنا» عدد 3-4، مارس 2002، ص 4).
وما إن بدأ عمل اللّجان التي كونتها وزارة التربية القومية وكلفتها بتحديد الاختيارات والتوجهات التعليمية، حتى أطلقت القوى السياسية والاجتماعية المذكورة أعلاه حملة ضمن اللّجان البيداغوجية وفي البرلمان وفي الصحافة، وكان الهدف تحقيق مجموعة من الإجراءات تجعل التعليم الديني مسيطرا في مجموع المنظومة التعليمية، فطالبت بما يلي:
اعتبار التعليم الديني جزءا من أهداف المنظومة التربوية كما تحدّدها الوثيقة الإطارية المتعلقة بالاختيارات والتوجهات التعليمية.
رفع عدد الساعات المخصصة لدروس التربية الإسلامية في كل مراحل التعليم العام.
اعتبار مادة التربية الإسلامية مادة إجبارية والرفع من ضواربها وإخضاعها لمراقبة حازمة.
تعميم تدريس هذه المادة في كل المستويات وفي كل أنماط التعليم المغربي.
إخضاع النصوص المدروسة في المواد الأخرى (اللّغات، الفلسفة، التفكير الإسلامي) إلى القيم والضوابط التي تتضمنها التربية الإسلامية.
إخضاع كتب العلوم الطبيعية إلى مفاهيم العقيدة الإسلامية.
ولئن نجحت الوزارة في الحصول على وفاق حول إصلاحاتها، فإنها لم تحقق شيئا من هذه المطالب، سوى تعميم دراسة التربية الإسلامية في كل مراحل التعليم ومختلف اختصاصاته (الأساسي والثانوي) واعتباره تعليما خاضعا للمراقبة الدورية طوال السنة المدرسية. ولم تستجب الوزارة إلى بقية المطالب.
يبدو الرهان التعليمي للسلطات العمومية واضحا، وهو الاتجاه على نقيض ما كانت عليه السياسة التعليمية في السابق، لأنّها سياسة سمحت بنشأة التطرف الديني ونشره في الفضاءات المدرسية والجامعية، ومنها إلى مختلف الفضاءات الاجتماعية. وقد أصبح ضروريا حماية المؤسّسات المدرسية حتى لا تكون خاضعة للفكر المتطرف في هذا السياق السياسي والاجتماعي الذي يشهد تنامي هذا الفكر، إذ من المهمّ تفادي أن تصبح هذه المؤسسات وكرا للتعصب واللاتسامح. على أنّ الطرف المحافظ لم يخسر المعركة كلها. فقد كان له الكثير من الأنصار ضمن المدرسين والمتفقدين وعمل هؤلاء على الحدّ من طموحات الإصلاحات المعلنة بالتأثير في الكتب المدرسية ومضامين الدروس.
الجيل الجديد من الكتب التعليمية أو الانتقال من أدلجة المضمون الديني إلى تحويله مضمونا أخلاقيا
استنتج الباحث محمد العيادي من دراسة مضامين الكتب القديمة في التربية الاسلامية أنّ هذه الكتب قد لعبت دورا مهما في بثّ الأيديولوجيات الإسلاموية بتخصيصها مساحة واسعة للخطابات التمجيدية. وقد أكدت هذا الاستنتاج دراسة سوسيولوجية كانت قد أنجزت سنتي 1995-1996 وجعلت لها موضوعا القيم الدينية لدى الشباب المغربي. فقد أثبتت هذه الدراسة وجود عدة نقاط التقاء وتواصل بين المخيال الديني للشبان والمضامين الموجودة في الكتب المدرسية.
ما هو الوضع اليوم مع الكتب المدرسية الجديدة؟ وفيم تختلف الغايات الإصلاحية للتعليم الديني كما هي معلنة اليوم عن غايات التعليم الديني القديم (1970-1980) كما حللها محمد العيادي؟
هنا جدول يلخص نتائج المقارنة ويقدّم بعض المعطيات للإجابة عن السؤال، انطلاقا من بحث أوّلي في مضامين الكتب الجديدة المتوافرة إلى اليوم.
| الكتب التعليمية القديمة (1970-1980) | الكتب الجديدة
(2002-2004) |
| مضامين هذه الكتب تنخرط، مثل مضامين كل الكتب المدرسية، في منطق قومي قائم على محور تثبيت الهوية. يستعمل الدين بصفته أيديولوجيا تعبوية توضع على ذمة الدفاع عن الهوية التي تهدّدها الحضارة الغربية
– تعكس رغبة السلطات العمومية توظيف الدين توظيفا سياسيا في الصراع السياسي والأيديولوجي مع تيارات المعارضة الاشتراكية والشيوعية – تحمل رؤية الإسلام نظاما شموليا يتضمن العقيدة والعبادات والأخلاق والاقتصاد والسياسة والحقوق والجمالية والتنظيم الاجتماعي. – تتميز بطابع الخطابة الدينية وتحتوي أحيانا فقرات للترهيب والوعيد بالعقاب في اليوم الآخر. – كثرة الإحالات القرآنية الطويلة والمفصلة مع تفسيرات تقليدية غير مناسبة لسنّ التلاميذ. – تعرض مسألة الشريعة الإسلامية وتفوقها على كل الأنظمة القانونية والفلسفات الحقوقية. |
– تستوحي مضامينها من الرؤية التنموية المتضمنة في الميثاق فتؤكد على نقاط التوافق بين الأخلاقية الإسلامية والمواطنة الحديثة وحقوق الإنسان.
– تمثل محاولة لفصل الخطاب التعليمي الإسلامي عن الثقل الأيديولوجي والسياسي للأصولية بالتشديد على الجانب الأخلاقي أساسا – الاهتمام بالعقيدة والطقوس والأخلاق والتنظيم الأسري والابتعاد عن القضايا الخلافية ( العقاب الجسدي – وضع غير المسلمين – الفوائض في المعاملات المالية) والعمل على التقريب بين القواعد الأخلاقية الإسلامية والحياة المعاصرة. – تحاول صياغة بيداغوجيا ملائمة لسنّ التلاميذ ومعتمدة البعد الأخلاقي والربط بين التعليم الديني ومشكلات العصر (الاقتصادية والتكنولوجية والتواصلية والبيئية والجمالية… إلخ) – خففت من كثافة الاستشهادات القرآنية والمسائل المتعلقة بالعبادات. – تقتصر على المسائل الأخلاقية وتعمل على رفع التعارض بينها ومبادئ حقوق الإنسان في صياغتها الحديثة. |
ولئن ظلّ خطاب التعليم الديني ذا نزعة تمجيدية كما هو متوقع منه، فإن محتويات الكتب الجديدة حاولت أن تقلص الجوانب الأيديولوجية الطاغية على البرامج القديمة. والواقع أن العملية ليست بالهينة، خاصّة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ جزءا من المدرسين لم يتمّ إعداده ليتقبّل التمييز بين الإيمان والمعرفة وبين الأيديولوجيا والتراث الديني.
ومما يؤكد هذه الرغبة في التخلّي عن الأيديولوجيا، صمت الكتب التعليمية عن إشكاليات الشريعة التي كانت محلّ جدل دائم في العالم الإسلامي الحديث، ومنها مثلا وضع الذميّين (غير المسلمين في العالم الإسلامي) ومفهوم الجهاد والحدود ومنع الربا في المعاملات المالية… إلخ، ويتأكد ذلك أيضا بالطريقة الجديدة المستعملة في هذه الكتب التعليمية للحديث عن العلاقة بين الأديان التوحيدية، إذ يقع التركيز على تواصلها وتكاملها ووحدة رسالاتها. ويلاحظ أيضا في هذه الكتب غياب القضايا المتعلقة باليهود أو بالموت أو بمصير النفس بعد الموت. وفي مجال العبادات والقواعد الأخلاقية استبعدت الموضوعات غير المناسبة لسنّ التلاميذ في السنوات الأولى من الدراسة.
لقد تخلّت هذه الكتب عن الأدلجة المفرطة المميزة للكتب السابقة، واعتمدت خطابا أخلاقيا تربويّا مبثوثا في مختلف الدروس غايته الحثّ على تكوين شخصيّة المسلم المستقيم المتضامن مع أسرته وإخوته المسلمين، المتصف بالكرم والتسامح والمحترم حقوق الغير والبيئة وجمال الكون، والحريص على النظافة، والمتفتح على العلم والتكنولوجيا. وقد سعى أصحاب هذه الكتب الجديدة إلى التوفيق بين المضامين الدينية الإسلامية والمعارف الحديثة المبرمجة في مواد أخرى محدثة مثل التربية المدنية والتربية الفنية والتربية الأسرية والتربية التكنولوجية. ومن المفترض أن تكون التربية على حقوق الإنسان حاضرة في كل مستويات التعليم ومدرّسة بطريقة أفقية. وقد أعدت وسائل بيداغوجية متنوعة لتساعد المدرسين في المواد الأدبية (تاريخ، لغات، تربية إسلامية، فلسفة… إلخ) كما أدرج التكوين في مجال حقوق الإنسان ضمن مسار إصلاح المنظومة التعليمية.
حدود المراجعة الحالية للكتب المدرسيّة
هل يمكّن المسار الحالي الساعي إلى تغليب الجانب الأخلاقي من تخليص برامج التعليم الإسلامي من نزعته القديمة المتسمة بالأدلجة المفرطة؟ لا يبدو الأمر مؤكَّدا؛ إذ نلاحظ تواصل حضور الخطاب التمجيدي وغلبة بلاغته في الكتب الجديدة، ولعلّ من العسير أن يكون الأمر على غير هذا الشكل؛ لأنّ الغاية الموضوعية لهذه المادة هي تكوين المسلم المستقيم المؤمن بالتعاليم الأساسية للإسلام (التوحيد والنبوة). فالإسلام يحضر بما تقتضيه هذه التعاليم، أي بصفة الديانة الأخيرة الخاتمة لما سبقها من الديانات. لذلك تعرض هذه الكتب الأحداث والشخصيّات والمعجزات على أنّها معطيات تاريخيّة موثقة، كما تتواصل طريقة تلقين الآيات والأحاديث وحفظها عن ظهر قلب من دون ربطها بسياقاتها التاريخية.
وتشير الدراسات التي خصصت للإصلاح الجديد إلى أصناف كبرى من المصاعب في هذه الدروس:
ضعف التجانس الداخلي لهذه الكتب المدرسية في محاولتها التوفيق بين أخلاقية قائمة على القراءة الحرفية للنص القرآني، والرغبة في ملاءمة الخطاب الديني مع الثقافة الحديثة القائمة على حقوق الإنسان.
النقائص البيداغوجية العائدة إلى قلة الاهتمام بالتكوين وندرة الوسائل البيداغوجية والتعليمية المتاحة وقلة حماسة المدرسين.
غياب تعليم وبحث جامعيين حديثين في مجال الإسلاميات التطبيقية والدراسات المقارنة للأديان، ويترتب على ذلك قلّة المكونين والأعمال العلمية التي يمكن أن تتخذ مراجع وأدوات بيداغوجية.
وبما أن المسار الإصلاحي التعليمي ما زال مفتوحا فإنّ الأمل معقود على مواصلة السعي لحلّ هذه المشكلات التقنية، والتوفيق بين الرغبة السياسية المعلنة ومعطيات الوقت والموارد البشرية والمواد البيداغوجية. على أنه يتعين أن لا نُغيّب تعقّد قضية إصلاح التعليم الديني في مجتمع مسلم مثل المغرب، فهي قضية تتجاوز بأبعادها حدود عمل واضعي البرامج.
لقد سعى واضعو البرامج إلى الالتفاف على مآزق الفقه وتجاوزات الأيديولوجيا الأصولية باعتماد منحى أخلاقي في المضامين البيداغوجية، وهو سعي يمثل نوعا من التوفيق الذي فرضته الضرورة، وليس عملا متأنيا وعميقا لإصلاح الخطاب الديني في التعليم. فالعمل المتأتي يصطدم بالحدود التي يضعها الفكر الديني في شكله الحالي الموروث عن قرون بعيدة، والمتسم بالجمود والبعيد عن مشكلات العصر الحديث ورهاناته ونتائج ثوراته العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فاللاهوت السائد في المغرب يؤسس الأخلاق على التكليف، كما كان الشأن في العصر الوسيط، ويعتبر الحسن: ما أمر به القرآن والسنة، والقبيح: ما منعاه، وهذه الطريقة في عرض الجائز والممنوع بصفة الحقائق المطلقة المتعالية على التاريخ تمنع من تقييم التجارب الإنسانية في سياقاتها الوجودية والتاريخية. ويترتب على ذلك انغلاق الخطاب في الشرعية الشكلية والقراءة الحرفية للنصوص الدينية والانغلاق على المعارف الحديثة التي يمكن أن تقدّم الأدوات المنهجية الكفيلة بإعادة التفكير في قضية الحرية والمسؤولية لدى الإنسان.
إن الفكر الإسلامي مدعوّ أكثر من أي وقت مضى إلى ردم الهوّة التي تفصله عن الحداثة، ولا بدّ لذلك من استعادة العلاقة الجدلية بين العقل والإيمان. فإصلاح الخطاب الديني في التعليم يظل رهين التقدّم الذي يحقّقه الفكر الإسلامي في استعادة هذه العلاقة.
محمد الصغير جنجار، الباحث في الأنثروبولوجيا، يتولّى حاليا خطة المدير المساعد لمؤسسة الملك عبدالعزيز للبحث العلمي بالمغرب.
النص معرب من الفرنسية.