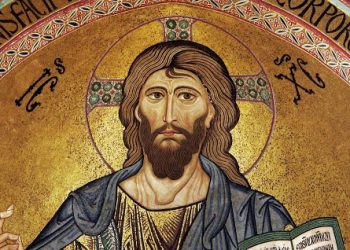الحديث عن الدين في إطار العولمة يفترض الحذر من انزلاقات ممكنة، فالموضوع الديني يفرض نفسه باستمرار. ونلاحظ لدى التيارات الأيديولوجيّة في العالم الإسلامي الخلط بين السياسي والديني وتوظيف الدين. ونلاحظ في الغرب المبالغة في الفصل بين مختلف أبعاد الحياة وتهميش الدين. إنّ ادعاءات هؤلاء وأولئك لا يمكن أن تحجب عنا المشكلات الأساسية المطروحة. فالغالبية من المسلمين من مختلف الثقافات وفي كلّ بقاع العالم يثبتون أنّ بالإمكان الإيمان والعيش بمعقولية في روح العصر، على أنّ هناك تحديات ومشكلات أخرى تصبح مطروحة. فالمسلمون يعملون على أن تظل قيمهم الروحيّة حية. لكن عوامل سياسية وثقافية واقتصادية قد تحوّل أحيانا الممارسات الدينية إلى أشكال ماضوية ورجعية ومتشنجة. وهذا ما يحوّل الممارسة الدينية إلى ممارسة مريبة أحيانا. ثمّ إن غياب سلطة دينية مركزية يجعل الوضع شائكا، فمن جهة يكون كل فرد بمقتضى ذلك متحملا المسؤولية، ومن جهة ثانية يترتب على هذا الوضع في حالات الأزمات التلاعب والانتهازية. ويعتبر أغلب سكان الضفة الشمالية أنهم تحرّروا من سيطرة الكنائس والدين وتخلصوا منها في حياتهم، لكنهم يواجهون أصناما جديدة وأشكالا لرفع الأنسنة عن العالم. إنّنا في طور يدخل فيه التاريخ الأوروبي العولمة ولا يبقى الدين المهيكِل الوحيد لحياة المجتمعات وربّما لم يعد يحدّد شيئا تقريبا، مع أنّنا نعلم أنّ العلمنة لا تعني اختفاء الإيمان الديني. فالدين يواصل وجوده لكنه يفقد تأثيره في الشأن العام. وتطرح انحرافات الحداثة مشكلات أساسيّة، وكذلك الانحرافات الخاصّة بالعالم الإسلامي التي تطرح أيضا الكثير من المشكلات، وهذا العالم يبدو وكأنه آخر العوالم التي تواجه العولمة والعلمنة.
الحديث عن الدين في إطار العولمة يفترض الحذر من انزلاقات ممكنة، فالموضوع الديني يفرض نفسه باستمرار. ونلاحظ لدى التيارات الأيديولوجيّة في العالم الإسلامي الخلط بين السياسي والديني وتوظيف الدين. ونلاحظ في الغرب المبالغة في الفصل بين مختلف أبعاد الحياة وتهميش الدين. إنّ ادعاءات هؤلاء وأولئك لا يمكن أن تحجب عنا المشكلات الأساسية المطروحة. فالغالبية من المسلمين من مختلف الثقافات وفي كلّ بقاع العالم يثبتون أنّ بالإمكان الإيمان والعيش بمعقولية في روح العصر، على أنّ هناك تحديات ومشكلات أخرى تصبح مطروحة. فالمسلمون يعملون على أن تظل قيمهم الروحيّة حية. لكن عوامل سياسية وثقافية واقتصادية قد تحوّل أحيانا الممارسات الدينية إلى أشكال ماضوية ورجعية ومتشنجة. وهذا ما يحوّل الممارسة الدينية إلى ممارسة مريبة أحيانا. ثمّ إن غياب سلطة دينية مركزية يجعل الوضع شائكا، فمن جهة يكون كل فرد بمقتضى ذلك متحملا المسؤولية، ومن جهة ثانية يترتب على هذا الوضع في حالات الأزمات التلاعب والانتهازية. ويعتبر أغلب سكان الضفة الشمالية أنهم تحرّروا من سيطرة الكنائس والدين وتخلصوا منها في حياتهم، لكنهم يواجهون أصناما جديدة وأشكالا لرفع الأنسنة عن العالم. إنّنا في طور يدخل فيه التاريخ الأوروبي العولمة ولا يبقى الدين المهيكِل الوحيد لحياة المجتمعات وربّما لم يعد يحدّد شيئا تقريبا، مع أنّنا نعلم أنّ العلمنة لا تعني اختفاء الإيمان الديني. فالدين يواصل وجوده لكنه يفقد تأثيره في الشأن العام. وتطرح انحرافات الحداثة مشكلات أساسيّة، وكذلك الانحرافات الخاصّة بالعالم الإسلامي التي تطرح أيضا الكثير من المشكلات، وهذا العالم يبدو وكأنه آخر العوالم التي تواجه العولمة والعلمنة.
لا بديـل عـن الحوار.. إلا الحوار
ليس القصد التراجع عن المكاسب المهمّة للحداثة، لكن من حقنا أن نلقي نظرة نقدية على انحرافاتها. وليس القصد أن نشكّك في منفعة الإيمان، لكن من حقنا التساؤل عن انحرافات التقاليد الدينية. ولا بديل عن الحوار والنقد البنّاء كي نظل منخرطين في الانفتاح والتحرّر. فالإكثار من الخطابات يمنع الناس من التمييز والاضطلاع بمسؤولياتهم. والجميع يدرك الآن أن توظيف الدين يؤدّي إلى أشكال من العنف ويهدّد الحرية الإنسانية، وكذلك قطع التوازنات الأساسيّة للحياة فإنّه يطرح أيضا مشكلات جمّة. إنّ بناء دولة القانون، وهو أول الأولويّات، يصطدم بتحويل الدين إلى أيديولوجيا سياسية. وتوازن الكائن البشري يصطدم بالقطائع والمعارضات. لقد رفعت عن العالم روحه الإبراهيميّة عندما تمّ التحوّل من النقيض إلى النقيض، من النظام التيوقراطي إلى الفصل العنيف بين الروحي والزمني، الخاص والعام، الفرد والكائن المشترك، وعندما استبدل مبدأ التمييز بين الفضاءين بالإعلان عن تعارضهما.
كيف يمكن تحقيق المدنية أو احترامها من دون تجريد الإنسان من إنسانيته والإخلال بتوازنه؟ مع أن المدنية، في تقديري، راسخة في الإسلام، على عكس ما تدعيه الأفكار المسبقة. كيف تمكن المساهمة بصفة جماعيّة في البحث عن الحقيقي والجميل والعادل وهي قيم ليست من نوع الماقبليات ولا يمكن لأحد أن يدعي احتكارها؟ وكيف تمكن هذه المساهمة من دون تغذية العودة إلى الماضي؟ وكيف يمكن تدعيم استقلالية الفرد من دون فصله عن الرباط الاجتماعي؟
إنّ الإسلام مهتم بإشكاليّة الدين والعالم، والمفارقة أن البعض يطلب منه أن ينتقل إلى الغرب من دون شروط وأن يخضع للنموذج المسيحي، وهذا موقف متسرع. مع أن المجتمعات الإسلامية ترغب في تحقيق تجديد جذري يخلّصها من جمودها وتمسكها بالقديم. لكننا نلاحظ بصفة عامّة أنّ عودة الدين في ظلّ العولمة لا تصاحبها اتجاهات التجديد بل تتميز بغلبة الاتجاهات المحافظة التي تدافع عن منظومات معارضة للحرية. وفي سياق انحرافات عصرنا فإنّ المجتمعات الإسلامية تصطلي بدورها بردود الفعل السلبية الناتجة عن مواقف بعض المسلمين داخلها، لكن المواطنين المسلمين يظلّون متعلقين بمرجعياتهم وبانفتاحهم ويرغبون في الممارسة الدينية في ظلّ الاستقلالية. فالإيمان بالدين الإسلامي هو الذي صنع على مدى قرون الحضارة الإسلامية ودفع نحو الرقي وقبل باختلاف أنماط العيش من دون تعارضها.
مــا العـمل؟
تطرح تناقضات مجتمعاتنا الإسلامية وتناقضات المجتمعات الحديثة العديد من المشكلات حاليا. فباسم الأديان وبصرف النظر عن تنوعها الداخلي، يواصل البعض تقاليد مطبوعة بالجمود ومتجاوزة من العقل الأدائي. وفي تقديرنا فإنّ العقل الحديث فشل بدوره في تحديد مكانة قيم الروح التي تملأ القلوب البشريّة، ويمكن لهذه القلوب أن تضطرم أمام قرار ضارّ. إنّنا نواجه تهديدا حقيقيا للبشرية. فالشروط تبدو مجتمعة لهذيان رجعي لا عقلي باسم الدين أو لصخب معادٍ للدين باسم العقل. وسينتشر الهذيان أو الصخب في صحراء العالم المعاصر الخالية من المعنى بسبب سعي هذا العالم إلى التخلص مما اعتبره مفكروه وسيلة الاستلاب العظمى، أي الدين. إننا أمام وضعين ينميان الفوضى: وضع اللائيكية المفرطة التي تعارض التقاليد ووضع التقليد المغلق الذي يمثله التعصب السياسي الديني.
ليست القضيّة أن «ننقذ» الدين، وأولى أن لا تكون أيضا الرغبة في العودة إلى الأشكال الكليانية التيوقراطية أو التخيل بأن تطبيق الوصفات العلمية الغربية يمكن أن ينقذ الإنسانية. إنّ المهم هو أن نكون واعين بمشكلات عصرنا، لأن غياب المعرفة والعداء الفكري هما أكبر هذه المشكلات. يبقى أن نبحث عن أفضل السبل كي يتمكن البشر من استعادة المعرفة بالموضوع الديني، من دون التدخّل في الضمائر، وهذا يتطلب:
أوّلا: تعليم الشأن الديني وتاريخ الأديان، وهذا حدّ أدنى لا مناص منه، وهو ينمي العقل النقدي الذي لا تحتكره ثقافة واحدة.
ثانيا: التشجيع على موقف معرفي متبادل، وهذا هو الأهمّ، فلا بدّ من تشجيع التبادل والمناقشة والحوار بين الأديان.
ثالثا: التربية الدينية تحت مراقبة الدولة. ولا تعني هذه التربية إخضاع العقول، لكنها تأخذ بعين الاعتبار البعد الروحي المشروع لدى الإنسان. والمهمّ أن لا يكون المضمون منغلقا، وهذا طموح يمكن بلوغه إذا توافرت الجهود وهو من مسؤولية الجميع. المهمّ أن نحدّد أفقا مفتوحا لا يغلق الحوار بدعوى ملء الفراغ. والمهم من منظور إسلامي أن يتوافر التجانس بين الأبعاد الأساسيّة في الإنسان: الإيمان والعقل، الزمني والروحاني، الفردي والجماعي.
إنّ البعض في الغرب يسعى إلى تعيين الإسلام عدوّا جديدا كي يتهرب من الأسئلة التي أصبحت مطروحة على الجميع، ويتهرب من المشكلات السياسية للعالم. هؤلاء يعادونه لأنّه يقاوم ويرفض مطامعهم السياسية ويزعمون أنّه يخلط بين مختلف أبعاد الحياة ويتنافى مع إمكانات الحريّة والعلمنة التي تمثّل شرط التحرّر.
لكنّ السؤال يطرح بشكل آخر. فكلّ الأديان والثقافات تواجه المخاطر نفسها، ومن الظلم أن يحمّل الإسلام وحده، هذا المجهول، عناصر الغموض والانغلاق والعنف، خاصّة أنه أسهم في تشييد الغرب الذي كان يهوديا – إسلاميا – مسيحيا ويونانيا – عربيا. إنّ عالمنا المعاصر الذي يتّجه نحو العولمة بأشكال متناقضة يبدو حاملا لمخاطر تتعلّق برؤى عقيمة حول الدين، سواء تمثلت في الدوغمائية أو في الإلحاد المتطرف. فالإلحاد والتيوقراطيّة يظلاّن مشكلين في واقع العولمة، لذلك يتعين على كلّ عاقل أن يعرض عن الاختيار بينهما، لكن عليه أن يعلن تفضيله للانفتاح على الانغلاق ورفضه كلّ أشكال التعصّب. ينبغي أن نعمل على تكوين مواطنين منفتحين، وعلى هذا الأساس تصبح الأديان عنصر تحرّر. وعلى المسلمين أن يرفضوا تطرُّفي العالم الحديث: الإلحاد المتعصب والليبراليّة المتوحشة من جهة، والتطرّف الديني من جهة أخرى. ونحن لا نقصد التقليل من قيمة الحداثة بالقول: إنّها كانت معارضة للدين أكثر من كونها محايدة تجاهه، ولا نقلّل من قيمة الدين بالقول: إنه حرّف لأغراض أخرى.
على أن ما يتعيّن على المسلمين فهمه وتذكره هو أن قوّة الثقافة الأوروبيّة، على الرغم مما تواجهه من مصاعب، تتمثّل في الحزم الذي يطبع العقل عند تحديد حدوده. فالكائن المعاصر يلفت الانتباه بقدرته على المخاطرة. وعلى العقل الحديث أن يدرك بدوره أنّ الإسلاموية هي نقيض الإسلام وأنّ الإسلام الحقيقي قد أسهم في تشييد الحضارة ومازال قادرا على مواصلة هذه المهمّة. فإضفاء الإنسانيّة على العلاقات بين البشر كان من نتائج ظهور الفكرة التوحيديّة. ولم ينتظر المسلم القرن السابع عشر ليكتشف الحرية، فقد مثّلت الديانات التوحيدية، وهي جذعنا الإبراهيمي المشترك، مصدره الأوّل في التحرّر الفردي والأنسنة.
ومصدر القلق حاليا هو التمثّلات للعالم وللعولمة بما تتضمنه من أشكال للتبعية ورفع الأنسنة عن العالم وانخرام التوازن، وفي مواجهة ذلك نجد توظيف الدين. أمّا أمل الغد فهو تحقيق الموازنة من دون خلط، والتوفيق من دون تعارض، بين مختلف الأبعاد الرئيسة للحياة البشريّة.
التـحديـات
كان هدف التجربة النبويّة في عهدها التأسيسي إنشاء دولة القانون والمجتمع المتحضر، وقد ترتّب على ذلك القبول بنظام من النوع «الديمقراطي» وبالتعدديّة الفعليّة. فقد كان النبيّ يدرك أنّ من الضروري لبلوغ الهدف المنشود القبول بالتعدديّة الثقافيّة واحترام الحقّ في الاختلاف وحلّ النزاعات على قاعدة القانون والمؤسسات وتعدّد الأفكار والتنافس السلمي على السلطة. لذلك لم تقع الإشارة صراحة إلى الدين في «صحيفة المدينة» وأشير فيها إلى المواطنة والجماعة المدنيّة كي تتأكّد فكرة العيش المشترك. أجل، يضطلع الإسلام في حياة المجموعة بدور الرابط الديني وتمنح الأوليّة داخل المجموعة الإسلامية للقيم القرآنية، إلاّ أنّ الإسلام يدعو أيضا إلى احترام الثقافات والمجموعات والآراء الأخرى. كان هناك حينئذ تطلّع إلى الموازنة بين الفردي والجماعي وبين الزمني والروحي وبين الثابت والمتحوّل وبين الملك والسلطة السياسية، وهذه كلها أبعاد ترتبط بمسؤولية الأطراف المشاركة. أمّا المجتمعات الإسلاميّة اليوم فهي تشكو من علاقة سلبيّة بين القمّة والقاعدة.
وعلى المستوى العام للعولمة، نلاحظ تحوّلا إيجابيّا من السلطة الدينيّة إلى السلطة المدنية وفصلا منطقيا بين سلطة الكنيسة وسلطة الدولة وبين الفضاء العام والفضاء الخاص، لكن قد ترتب على ذلك أيضا تهميش الأسس الإبراهيميّة، بل بلوغ شكل من رفع الإناسة وانهيار الأمل.
إنّ ما يحدث في هذه العصور المدعوّة بالحديثة لا يقتصر على مجرّد الفصل المنطقي بين السلطات وعلى العلمنة السليمة، إنها تتجاوز ذلك إلى تهديد الكيان المشترك والعيش المشترك والمصير المشترك. إنّ الأسئلة حول التعالي والجماعة والمعنى هي أسئلة تظل مفتوحة، حتى ولو حاول البعض كبتها أو طرحها في شكل متطرّف.
لكن المهمّ هو أن نتجنّب إلغاءها من الأصل، بل ينبغي العمل على التصدي إلى الانغلاق من جهة والتمييع من جهة أخرى. فمن الواجب أن نُعمل سلاح النقد الذاتي حول انحرافات تقاليدنا وانحرافات الحداثة. ولا يجوز أن نحمّل الدين، والإسلام خاصّة، نتائج السياسات غير المتجانسة، أو نحمّل العقل المسؤوليّة في الانحرافات الحاصلة. نحن نواجه اليوم تجريد الإنسان من بعده الروحي وتجريده من المشاركة في العمل السياسي وتجريده من العقل، هذه هي الأشكال الثلاثة للعولمة أو ملامح «لا عالم» هو اليوم في صدد التشكّل. فالخلاصة أن من المستعجل التذكير بالتحديات التي تواجه الشعوب كلها. والإيمان والعقل، كل حسب اختصاصه، ينبغي أن يسهم في رفع هذه التحديات بدل التعارض الهدّام بينهما، كي يوفّر كلاهما الفرصة للارتقاء بالإنسان بدل أن يشكّل تهديدا للإنسانية. فكلاهما عنصر يمكن أن يجلب الخير أو أن يجلب الشرّ حسب طريقة استعماله.
وعلى مستوى المعنى، يتمثل الواقع في كون المواطن مبعدا أكثر فأكثر من الحياة الدينيّة التي يتعلق بها أتباع الديانات التوحيديّة عامّة والإسلام خاصّة. إنّنا لا نواجه نهاية العالم لكننا نعيش فعلا نهاية عالم كنا قد ألفناه. وينبغي أن نفهم ما يحدث حاليا كي نكون قادرين على ابتداع عالم نرتضيه، أي عالما يبتعد بنا عن الانغلاق والوثنية. إنّ السوق المعولمة وعولمة الرأسمالية بطريقة متوحشة يحدثان لائيكية متطرفة، وفي هذا المناخ من الانهيار وضعف الأصول تنتشي المجموعات التي تلبس رداء الدين لأنّها تستفيد من غياب المعنى.
أمّا على مستوى المعرفة والعلم، فإنّ الجانب المخيف في العولمة كما تتطور حاليا يتمثل في تضييق فرص التفكير أو على الأقلّ التفكير المختلف. فالعصر الحاضر مطبوع بالتقنية وتهميش الدين ويسعى إلى السيطرة على كلّ شيء بواسطة عقل أداتي، وإلى استغلال نتائج العلوم الصحيحة التي ينظر إليها على أنها منطق التنمية، وترجّح المعرفة الحديثة التقنية والرياضيات وتطبيقاتها لأنّها تستغلها لخدمة منطق السوق. ويترتب على هذا الوضع تهميش النقد الموضوعي والتعدديّة الفكرية. فنحن نشهد اختناق العلوم الإنسانيّة والاجتماعية وعسر المعرفة المتبادلة والحوار بين الثقافات والأديان. وفي هذا السياق تسيطر سرديتان من الثقافة الحديثة تقول إحداها: إنّ وظيفة الدين هي التسلية عن مصائب الإنسان، وتقول الثانية: إنّ وظيفته هي الاستلاب.
وعلى المستوى السياسي، يكمن المشكل في النظر إلى المجتمع على أنه جسم منتج خاضع لأصحاب رؤوس الأموال. فتجريد الناس من المشاركة السياسية قد بلغ حدّا غير مسبوق وهو يهدّد مبدأ المسؤولية الشعبية وأهلية الشعب في أن يكون صاحب حق ويدافع عن حقّه، وأن يختار مشروعا اجتماعيا ويعمل على تحقيقه بعد أن يطرحه للنقاش العام. لقد شمل التهديد شرعية المؤسسات وحقوق الإنسان والمبادرة الحرّة ونشر القيم القانونية في كلّ المستويات ومنها ما يعلو على الدولة، وشمل الحق في المواطنة الإسهام في البحث الجماعي عن العدل والجمال والحقيقة. لقد أصبح المستقبل رهن المنظومات التي تفرض العولمة وهي منظومات ليست معولمة ولا كونيّة.
يبقى مع ذلك أن نتجنّب موقف الانغلاق على الذّات. إنّ طموح المسلم أن يصل إلى حياة متجانسة، التجانس وهو يشعر بالقلق أمام تجريد البشر من فرص الممارسة السياسية ومن الحريّة، ومن تضييق التجربة الروحيّة. لقد انتقلنا من الشعارات الكليانية التي كانت مطروحة سابقا، مثل «لا شيء خارج الدين» أو «لا شيء خارج السياسة» إلى شعار: «لا شيء للدين، لا شيء للسياسة، كل شيء للسوق!» لا يمكن للإسلام أن يفهم من دون العلاقة الأساسية بين المعنى والمنطق والعدل، فهذه هي ضوابط كل حضارة، وكل الاتجاهات المتطرفة تعمل على هدمها وتحريفها. ويمكن للدين أن يتحوّل تحت ضرباتها إلى تيوقراطية تسعى إلى فرض عقيدة واحدة على الجميع وإلى هيمنة طرف أوحد، كما يمكن أن تنتهي إلى لائيكية ترفع الإناسة على العالم وتجرّده من قيمة الإنسانية. ولا هذه ولا تلك هي الحضارة حقا. فالمهمّ هو أن نسعى إلى استعادة حضارة كونيّة قد غابت هنا. ولا بدّ لذلك من العمل المشترك والجماعي عبر المعرفة المتبادلة كي نتخلص من المآزق ونبدع علاقة جديدة بالعالم.
………….
الأستاذ مصطفى الشريف هو فيلسوف وعالم إسلاميات ووزير التعليم بالجزائر سابقا.
النص معرّب من الفرنسية.