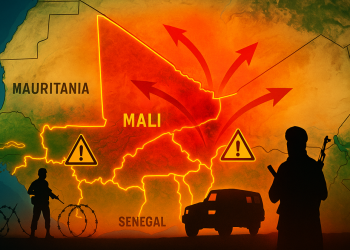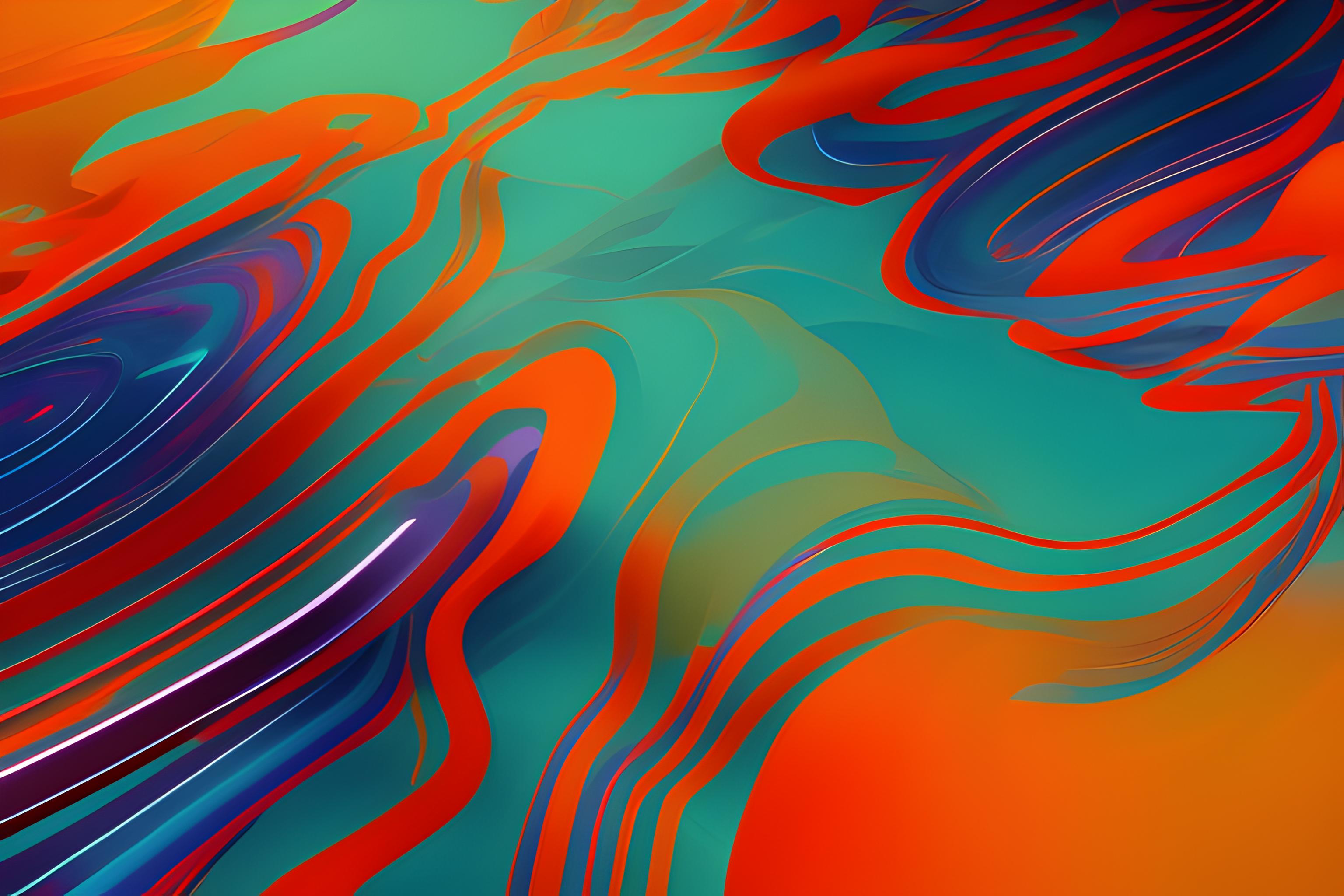تأليف: فرهنك رجائي
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
الطبعة الأولى: 2010
قراءة: عمر البشير الترابي
الكتاب صِيغ بلغة مبهجة وبراقة، وجاء خليطاً بين التجربة الشخصية والشهادة، وبين المنهج البحثي، غير أن اللغة الشاعرية في المقدمة وبعض المواطن التي عايشها الكاتب لم تقلل من البعد الفكري العميق الذي توشح به الكتاب والمراجع الأصيلة التي اعتمد عليها.
تحدث المؤلف في تمهيده للكتاب عن الحوافز الشخصية التي أثارت في نفسه دوافع تأليف الكتاب، ومنها تحديداً مقولة مرتضى فقيه (ت: 1993) للخميني حينما زاره في فبراير 1979م وللمرة الأولى بعد نجاح الثورة “أخيرا أصبحت أنت الشاه بالفعل!”، بالإضافة إلى تساؤلات كثيرة كانت تلح على المؤلف أيام شبابه كيف لرجال الدين أن يتسيدوا الثورة و ينكفئ عنها العلمانيون والليبراليون ورجال المجتمع وطوائفه الأخرى، وما سر صعودهم هذا ، وإلى أين وصل؟ وما يتوقعه ويتنبأ به لمستقبل الحركة التي صنعت التغيير. تلك التي مكنت الخميني العائد من منفاه أن يقول بكل ثقة “لسوف أسحق الحكومة الحالية، وأقيم حكومة جديدة”. الحكومة التي جعلت أحمدي نجاد يؤكد أنها لم تقم إلا لحماية الحق المقدس للأئمة.
اعتُبر المذهب الشيعي المذهب الإيراني الرسمي في القرن السادس عشر الميلادي، ثم في 1979م، لذلك تناول الكتاب التطورات الفكرية داخل هذا الرافد الفكري الأصيل في التجربة الإيرانية، ولكنه ركّز على النخب الحاكمة المتفقة التي زرعت بذور الثورة وشكلت صوتًا معبرًا فيها وعلى امتداد سنواتها إلى يومنا هذا، تلك الثورة التي غيرت خارطة العالم، وفاجأته على حين غرة، بإسقاط النظام البهلوي الذي كان العالم الغربي يراه جزيرة الاستقرار.
الدارسون للتغير الذي حدث في إيران (1979) انشغلوا بدراسة دواعي سقوط النظام البهلوي ولم ينشغلوا بدواعي قيام نظام إسلامي بديل نجح في تأسيس نظام اجتماعي عفا عليه الزمن . لذلك جاء الكتاب معنيًّا بشكل أساسي بهذا الأمر، وبذل فيه المؤلف الكثير من الجهد لتحليل المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية وقراءة دلالاتها و استخلاص مغزاها.
وضَّح الكتاب الموقف المعارض الذي اتخذته “قُم” ضد عملية التحديث الجذري الذي اتخذته السلالة البهلوية في بداية القرن الماضي، والتحدي الذي أفرزته حركة العصرنة في العالم الإسلامي والخلل الذي ألحقته بنمط الحياة الاجتماعية الثقافية في تلك الحقبة.
يرى الكاتب أن مقاربات العقيدة الإسلامية للحداثة مختلفة، لذلك حاول شرح الحركة الإسلامية بتقسيمها إلى أربعة أجيال، تتناول في ما فهمناه فهمها للحداثة والتعاطي مع متغيرات العصر، فالجيل الأول هو الذي تصدى للحداثة مُنطلِقاً من موقفٍ سياسي، داعياً لإحياء الإسلام ودحض أطروحات الحداثة فمنح الثقة للإيرانيين الإسلاميين. أما الجيل الثاني فقد اتخذ موقفاً أكثر صِِدامية من الحداثة بزعم أنهم (الإسلاميين) أنتجوا البديل وصاغوا إيديولوجيَا إسلامية ثورية بديلة تغنى عما سواها. أما الجيل الثالث وبعد استعادته للثقة فإن ثورته مَهّدت الطريق له ليقود حركة راديكالية أحالت الإسلام لممارسة العنف والإقصاء. بينما كان الجيل الرابع هو المتفتق سعيًا لاستعادة تشكيل الإسلام من حيث هو دين وليس من حيث هو أيديولوجيا.
بدأ الكتاب بمقدمة، تناولت العلاقة بين الأسلمة والمعاصرة، وتساءل عن سبب انتهاء الثورة إلى نتيجة دينية، وطرح الثورة و محتوى النظام البديل الذي اقترحته، ووضع السؤال المحوري الذي يحدد فعالية الثورة إذا ما كان النظام البديل قابلا للنمو أم لا، وبيّن أن الإشكالية الحقيقية تكمن في تحليل الإسلام والمعاصرة إلى تيارين إيديولوجيين اشتعل بينهما فتيل معركة صفرية.
التياران (الإسلاموية، والحداثة) سلخا المجتمعات من ماضيها وحرماها من تحقيق تطورها الطبيعي؛ ففي العالم الإسلامي استمرت الحداثة في النصف الأول من القرن الماضي، بينما كانت الإسلاموية في النصف الثاني من القرن ذاته. ذهب الكاتب إلى أن الإسلام والمعاصرة يشكلان رداً على الهيمنة القبلية في المنظور الاجتماعي.
قارن الكاتب بين الإسلام والإسلاموية و الحداثة و العصرنة كما يوضح الجدول (1).
الإسلام
الإسلاموية
العصرنة
الحداثة
الأساس السياسي
العقيدة والحرية
إيديولوجيا
المسؤولية والحرية
السلطة
الأساس الإقتصادي
الإبداع
مصادرة الملكية
الإيداع
الاستغلال
الأساس الثقافي
الطاعة العقلانية
المطلقة
المنطق
العقلانية النفعية
الغاية
الخلاص
التجاس
الانعتاق
الكسب
*المصدر : الكتاب ص 27.
تحدث الكتاب عن أسباب الثورة الإيرانية، فعرض نظريات السوق والمجتمع، و عودة الحياة للمواقف الحقيقية لدعاة التحديث في إيران، و عودة سياسات الاستعادة (التقاليد المحلية) لطرد تآكل الثقة والتبعية التي سكنت الفرد الإيراني بعد محاولات التحديث البائسة، فسُكن الإيرانيون بإحساس عجزهم عن إنتاج حضارتهم منذ سقوط الصفوية، فكان كل ما يمر بهم مستورداً ولا علاقة له بهويتهم.
يُصر الكاتب على أن تيار الاستعادة فرضَه الواقع، فكل المفكرين حاولوا طرح إحيائيات منذ جمال الدين الأفغاني (1897) وميرزا الشيرازي (1895 ) وشريعتي (1977 ) وخميني (1989) وكانوا من دعاة العودة إلى الأصالة والاعتماد على الذات.
في مطلع القرن التاسع عشر بدأ مشروع تحديثي أسهم فيه كل الناس في إيران من كل الاتجاهات، جاء ذلك المشروع وليدًا للشعب وخياراته الطامحة لوضع إيران في الطريق الصحيح، ولكن هذا المشروع اختطفه رضا خان ( ودشنه مشروعا زائفاً) وتسلق به إلى أن نصّب نفسه ملكًا وأسرته سلالة ملكية مستغلاً تطلعات الناس وآمالهم فيه لتبنيه خيار الإصلاح والتحديث، واستمر الاستغلال إلى أن نُفي بعد أحداث معروفة، وجاء بعده ابنه واعتمد هو الآخر على الخارج، وقد فاقم اعتمادهما “الأسرة البهلوية” على نموذجي الأوربة والأمركة من تآكل الثقة في إيران، وحُسب حسمًا من رصيد الحداثة ، أو بالمعنى الأدق العصرنة.
تناول الكاتب في مقدمته سمات الحركة الإسلامية، مؤكدًا أنه ما كان للأصولية أن تظهر في الوجود لولا ظهور العصرنة، ولكي يصل لفهم سليم لهذه الحركات التي تتبنى الإحياء للإسلام قسّمها إلى أقسام فبحسبه هي حركات سياسية و حركات اجتماعية في مجتمعات إسلامية، أرّخ لها بأنها نشأت منذ سقوط الممالك الإسلامية، ويؤكد بأنه على امتداد تاريخ الإسلام ظهرت أسماء “ورعة” و “تقية” لكنها لم تقد حركات إسلامية، وهو بذلك لا ينفي الفكر السياسي من الإسلام فهو يؤكد أن السياسية مكون أساسي في الخطاب الإسلامي منذ دولة المدينة (632)، ولكنه قصد القول بأن التاريخ الإسلامي لم يتعاط مع لقب إسلامي، فلم يكن يُلحق بأي إنجاز، إلا إنه ظهر وتفشى فقط بعد حركة العصرنة الأخيرة.
فالحركة الإسلامية هي ظاهرة حديثة قوتها الدافعة هي الدِفَاعِيَّة.ويقرر بأنه ما من فضاء ثقافي مثل الحركة الإسلامية يساوره هذا القدر من القلق حيال التغلغل الثقافي للآخر “التغريب”،ويفترعون له أحكاما خمسة،فيشعرون أن الإسلام يواجه خطر العصرنة، و يحيلون الدين إلى حدث عام وشَكل من أشكال الاحتجاج الاجتماعي وبأفكار واضحة يمكن ترسيخها، وقسم آخر ليس ضد العصرنة وإنما ضد المضمون السلطوي ونزعة الهيمنة، و هم يرفضون الاكتفاء بدور روحي فقط، متخذينًأنماطا مختلفة متجانسة مع الواقع .
وزعامات الحركات الإسلامية هم إما علمانيون و ملتزمون على حد سواء، و إما عصريون بل ما بعد حداثيين، بالإضافة إلى المصلحين الدينين الأوائل.هم أطياف متنوعة، فيهم من خامرَه عارض العنصرنة ومن سامرته الحداثة إسلامية كعبد الكريم سروش كما سيلي ذكره، كما أنهم (الزعامات) ليسوا أتباع مذاهب تقليدية متشددين (باستثناء أبناء الجيل الثالث).
والآن نعرض لهذه الأجيال الأربعة:
الجيل الأول: سياسات الإحياء من العشرينيات إلى الستينيات
في 1921 قاد رضا خان ميرر بانج حركة انقلابية، وقام عبد الكريم الحائري بالاتجاه لتأسيس دار للسلطة الدينية في مدينة “قم”، وفي الوقت الذي قاد فيه رضا مشروع تغريب إيران، نشأ الجيل الأول المدفوع بالإسلام نهجا إحيائياً لعقيدته في ردة فعل دفاعية.
وافق ذلك سنين قمع حقيقية امتدت إلى 1925 حيث استطاع رضا إزاحة السلالة القاجارية عن العرش و تنامى العمل الحداثي، في بيئة داخلية غاب عنها الأساس الاجتماعي للعصرنة، أو بدا مشوشًا على أقل تقدير.
كان رضا خان هو “مُخلِّص” إيران كما صوّره أتباعه، جاء رضا و وجد نموذجاً للحداثة قدمه روّاد الحركة الدستورية 1905 و ترعرع في البرلمان، فأوهم أصحاب المشروع بأنه رجل المرحلة و رائد الإصلاح حتى ظنه البعض منهم قائد الخطوة التي تخرج إيران من المهلكة إلى المدَنِية والفلاح، وبالرغم من أنهم أرشدوه إلى أن الحضارة النافعة هي حضارة المكتبات والمختبرات، إلا أنه اتخذ الحداثة أداةً للفوز بالسلطة والثروة والكسب المادي “فقط”، وحلّت بسببه محلّ العَصرنة التي تتضمن الحرية والكرامة والعقل الإنساني. أيّا كان من أمر فقد تشكل تياران الأول هم الليبراليون من أنصار الحداثة الذين شايعوا رضا خان، والثاني هم المعتدلون من أعدائها و يملك زمامهم التجار الذين تحالفوا لاحقاً مع رجال الدين.
تتبع الكتاب ترسيخ رضا خان للحداثة و مآلات القوميين العلمانيين له، وإرادته صناعة مبادئ الوطنية و صياغتها وفق النموذج الفرنسي، متزامنًا ذلك مع اتساع نطاق الاستبداد والقمع والانفراد بالرأي، الأمر الذي حدا بالغرب إلى التخلي عنه بشكل مباغت، و انتهت به التطورات منفيًا إلى جنوب إفريقيا مع الإبقاء على سلالته في الحكم.
كان خليفته محمد رضا في بداية حكمه ضعيفاً، ولكن ساعدته عوامل داخلية لأن يبسط سلطاته تدريجياً خاصة بعد نشوء جمهورية كردستان وأذربيجان وتعاطيه مع أزمة إقليم أذربيجان الذي قاد فيها جيشه ليصبح كالبطل الشعبي، بالإضافة إلى أن محاولة اغتياله الفاشلة في 1945 ، التي كانت محاولة انقلابية كانت سبباً وجيهًا لتوليته السلطات التنفيذية بعدما كان يسندها للوزير الأول، غير أن سلطاته هذه لم تدم طويلاً، فقد رافق هذه الفترة بروز الاتجاه التحديثي وأطروحات فكرية عميقة قدمها محمد مصدق ونال جزاءها ما نال من نكال، ولكن ما إن فُتحت الحياة الدستورية حتى استغل قضية تأميم النفط ليدخل عبرها إلى مقعد رئاسة الوزراء بالرغم من مجافاته للشاه الذي رضخ لحسابات خاصة شرحها الكتاب.هذا كله والخطاب الإسلامي يتحوّر ويشتد عوده .
مرّ الكاتب على البيئة الدولية المرافقة متناولاً مشروعات الحداثة الإقليمية والإمبريالية، وكان سقوط الإمبراطوريات الإسلامية العظيمة (العثمانية، الصفوية، المغولية) قد أثار الكثير من الأفكار، و مهّد لنوع من الاستبدال القسري فتسيّد على أنقاض الممالك إحساس قومي متراكم الشعور بالوطنية للأقطار. سرد الكتاب معالجات الانتقال فبقرار إلغاء الخلافة 1924 وما ترتب عنه من انطباعات متداخلة انتهى التمثيل المؤسسي للإسلام.، وانتهت مثله ومعه كل الإمبراطوريات إلى نموذج طرق باب الحداثوية عبر زعماء ديكتاتوريين.
رصد الباحث التغيرات والبيئات التي توضح الممهدات لنشأة التيار الإسلامي الأول، ودَرس البيئة الفكرية متنقلاً بين اليسار والاعتدال، وذكر محاولات الإصلاح الديني بين شريعت سكنلنجي الذي أراد تنقية التوحيد من شوائبه عبر دراساته القرآنية، تماماً مثل أحمد كسروي الذي كان من رواد الحركة الدستورية والتوعية بقيمة الحرية، و أخيرا المفكر علي أكبر زاده.
ورصد الأصوات المعبرة ، فقد تمخضت ردات فعل الإيرانيين من ذوي التوجهات الإسلامية عند ولادة أول أجيال الحركة الإسلامية. فتشكل تياران يمثلان ردة الفعل الإسلامية، الأول في مدينة قُم واتسم بالمحافظة الشديدة والآخر كان في رواق جامعة طهران واتسم بالليبرالية والإحيائية العقلانية. وعلى ذلك وعلى امتداد الأجيال الأربعة سيرصد الكاتب الأصوات المعبرة عن الأجيال في قم وفي طهران.
إسلام قم :حائري وخميني وبروجردي
قُم التي تضم مرقد فاطمة المعصومة(ت 816) شقيقة الإمام علي بن موسى الرضا، والتي أسس فيها الملا محسن فيض مدرسة الفيضية. لم يكن لها دور ديني مؤثر، إذ أن دورها الديني ضعف وانزوى لقرون إلى أن جاء إليها آية الله حائري في 1921 م. حائري الذي درس في النجف الأشرف؛ وتأهل بها و كان له دور مميز في الثورة الدستورية 1906 في إيران دفع ثمنه أن رُحِّل كالطريد إلى العراق (كربلاء)، علم يقينًا بأن أي عالم دين لن يستطيع بلوغ غايته إلا إذا كان قريباً من صاحب معجزة، فعاد إلى قم و دعا العلماء وأعاد بناء المدينة والمدرسة، وساهمت ظروف أخرى مثل نفي تسعة من علماء الشيعة من العراق إلى إيران فاستوطنوا (قم) فضُرب لطلب العلم الشيعي الجعفري فيها أكباد الإبل.
كانت لحائري مواقف مهمة، حسبت له أو عليه، فهو رفض الجمهورية في العشرينيات مما فهم أنه كالتأييد لمساعي رضا خان لتحويل الملكية لصالحه، كما أنه لم يتحدث عن السلالة الملكية بعد خلع القاجاربين واستكان في حادثة قم ( الحجاب وحراقد)، و لم يعارض العسكرة، و تهاون مع قرار منع العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تبنى حائري خطاً متسامحا مبنيا على فلسفة أنه ” ليس منا من ترك دنياه لدينه أو دينه لدنياه”.
في تلك الفترة حاولت قم أن تستوعب صحيفة همانيون التي تمادت في ليبراليتها للدرجة التي صرحت بأن النبي لو عاد إلى الحياة وقال للمسلمين بأن ما يمارسونه ليس الإسلام لما صدقوه، فأدارت لها الحوزة ظهرها، ورحل رئيس تحريرها (علي أكبر حكمي) إلى طهران وكتب بعد فترة كتاباً يسخر فيه من المذهب الشيعي، فردت عليه قم برد شامل صاغه محمد خالصي زادة وروح الله خميني. وكان ردّ الخميني آسرًا وخلابًا ومميزًا وأكثر إقناعا، وكان بوابته للشهرة. في أواخر عهد حائري دعم الخميني بروجردي ليكون المرجع الأعلى، وكان هو المرتكز الثاني الذي مهد حياته.
بروجردي
حل بروجردي في قم في (1944) م ، بعد أن كوَّن سُمعةً طيبةً كأحد الباحثين في العلوم الدينية و اكتسب شعبية لعلمه ودماثة خلقه، و كان من حيث المبدأ لا يتعاطى السياسة. عرف عنه الدعوة إلى التقريب بين السنة والشيعة، واعتداله الشديد، ودعمه للنشاط الثقافي، وأخذ عليه المؤلف تعصبه ضد البهائيين، استمر نسقه إلى أعوام.
إسلام طهران :بازركان طالقاني والجماعات الإسلامية
أما في طهران فقد ظهر تيار و رَبا في جامعة طهران، تناوله الكتاب و عرّف بأهم روّاده، وهما مهدي(بازركان (1907-1995)) و محمود طالقاني (1910-1979).
بازركان الذي درس في فرنسا، وعاد منها مثقفاً موسوعيًا نهم القراءة والكتابة، عَمِل على إخراج الدين والعلم في تطابق تام، و وضع قراءة جديدة للإسلام، وبالرغم من أنه حثّ الإيرانيين ذوي التوجهات الدينية على المشاركة السياسية –في فترة ما- إلا أنه انتهى بدعوة الجمعيات الدينية لعدم الانغماس في عالم السياسة.
أما طالقاني الذي عاش طفولته تحت وطأة الخوف على والده من قمع الشاه، وقضى شبابه شاهداً على استشراء الفكر اليساري، فقد دُفع دفعاً لإحياء مبادئ إسلامية في أربعينيات القرن الماضي، وبنى برنامجه العلمي على فتح الأفق لعقل إسلامي سياسي ناضج، حاول أن يُضَخِّم من دور الشعب.
في أعقاب الحركة الانقلابية 1953 وفي أواخر الخمسينيات أسس بازركان وطالقاني حركات المقاومة الوطنية، وتعرّض الكتاب لمجموعة منها : حركة المقاومة الوطنية، جمعية الحجَتية.
مجمل القول إن الجيل الأول أطلق دعوة “ثقافية” جادة لإثبات صحة التعاليم والمبادئ، فقد عرضت قُم وجهاً ثقافياً للإسلام، بينما عرضت طهران وجهاً فكرياً، وجذب ذلك جيلاً من الطلبة، وقدماها كبديل للفكر الماركسي والحداثة، مما مهد للجيل الثاني تحويل الإسلام إلى أيديولوجيا.
الجيل الثاني سياسات الثورة (1963-1991)
أكملت إيران في 1971 حوالي 2500 عام على النظام الملكي، تقلبت خلالها على توجهات ملكية عديدة فبعد أن حاول خان أوربة إيران دشن ابنه في 1953 التوجه نحو الأمركة بديلاً للتوجه نحو الأوربة. حصلت تغيرات حقيقية اقتصادية فتدهور الاقتصاد الإيراني، وتصدعت الأسس الأخلاقية، وانسلخت إيران من هويتها الفارسية، وفشا سخط شعبي متعاظم.
ثارت مظاهرات مسنودة بمدّ ديني على امتداد سنوات بدأت في 1963م أسفر عنها ضحايا لقمع السلطات التي اعتبرت المتظاهرين “أعداء” يتآمرون على برنامج التقدم والتحديث، و نمى العنف السياسي في نهج الطرفين الحكومي والمعارض على حد سواء، و في تلك الأثناء نمى نهج إصلاحي اقتصادي لا يمكن تجاهله، وفّر بعض السيولة إلا أنه لم يعالج الإحساس بفقدان الهوية، وحتى الأوضاع الاقتصادية فإن الاعتماد على النفط فقط سبب كارثة تمثلت في عجز كبير بلغ في عام 1972 (2.6) مليار دولار وتراجعت قيمة المواطن الاعتبارية.
في 1978 نُشر مقال ينتقص من قدر خميني، ثارت على إثره مظاهرات ولم يكن من خميني إلا أن ردّ بخطاب مطوّل سجّل فيه كل مثالب نظام الشاه، وسارت الأمور في صالحه تصاعديًا بينما كان الشاه يتداعى، إلى أن عاد خميني إلى طهران في شباط من 1979، وخدمته الظروف الدولية، إذا مَثّلت نكسة 1967 مدخلاً عزّزّ الشعور بضرورة اتخاذ تيار بديل للحركات العلمانية في شعوب الدول الإسلامية، مما مهّد لنمو كبير للتيارات الدينية، وشكّل أرضية مناسبة للفكر الأصولي و منحه الدعم اللازم للانطلاق. و كانت البيئة الفكرية لا تزال تدندن بعداوة الغرب، و تحذر من التسمم بأفكاره، وساد الشعور بالبغض له ونمت الدعوات للتطهر من كل مواقفه الامبريالية.
مهدت البيئة المشحونة بكراهية الغرب لظهور الإسلام السياسي، وسلّط الكتاب الضوء على (محمد حسين طبطبائي) الذي طوّر النظرة الدينية في مطالبته بإحياء الاجتهاد، كما أشار لمجهودات مرتضى مطهري ومهدي بازركان ورصد الأصوات المعبرة في قم وطهران .
إسلام قم خميني والجماعات المرتبطة به
بعد وفاة بروجردي برز اسم خميني ليكون مرجع الشيعة الأول وتسيّد الساحة بلا منازع بعد أن أطلق نظرية ولاية الفقيه و اتخذ مشروعاً دينياً سياسياً مزدوجاً، وقد عارض الخميني الشاه منذ فترة طويلة ترتب على معارضته النفي واستقرّ به الحال في باريس، وصادف في تلك الفترة أن وافقت معارضته للشاه هوى الشعب الإيراني مما منح الرجل الكثير من الشعبية.
أكد الكاتب أن اهتمام خميني بالسلطة من الحقائق الثابتة “لديه”، مشيرًا إلى أن الخميني سيكون زعيماً زاهداً ورعاً ما كان خارج السلطة، وعزز نظرته بآراء رجل دين حدد عام 1982 بداية لخميني مستبد غير ذلك الذي كان يؤكد أيام معارضته للشاه أن أي جمهورية إسلامية ستكون ديمقراطيّة. وقبل أن يعلن نظرية الولاية المطلقة التي جعلته لا يقل عن الشاه في السلطات شيئاً. سرد الكاتب تحليلاً نفسياً قرر فيه أن تصرفات خميني كلها مبنية على الصورة الذهنية التي يريد للناس أن يأخذوها عنه.
حاول خميني تأسيس هوية إيرانية حديثة، أساسها الفلسفة وجعل النفس محوراً، كان يخاطب الناس بما يفهمونه، كما تناول الجماعات التي ارتبطت به من مثل “المؤتلفة” و”علماء الدين” المناضلون.
إسلام طهران شريعتي والجماعات ذات الصلة
رصد أيضًا إسلام طهران في تلك الفترة الزمنية، في طهران كان هناك من يطرح بديلاً أيديولوجياً إسلامياً، مثّل له بمرتضى مطهري المفكر الذي ألف أكثر من 50 كتاباً، ونسب له الفضل في أن تشمل الثورة الإيرانية كل مكونات المجتمع الإيراني، فقد كان متعصباً للآريين قومياً، يؤكد أن الإسلام “ركن” من هوية إيران، و ينافح عن حقوق المرأة ويعزز ثقة أهل إيران بأنفسهم.
وعلي شريعتي 1933-1977، وقد كان أكثر راديكالية من مطهري وأكثر ثورية منه، فحارب المواقف السلبية التي تبناها المسلمون، تحدث الكتاب عن مفاهيم شريعتي التجديدية ونظرياته الاجتماعية التي كان يخرجها بوصفه “مسلمًا”، وعرض الكتاب لنتاج شريعتي الفكري، ومحاولته الجادة لتنقيح الفكر الشيعي بمحاولته التفرقة بين التشيع العلوي و التشيع الصفوي، ويقول شريعتي في هذا الصدد بأن الصفويين نجحوا في تحويل المذهب الشيعي من أيديولوجيا نضالية سرية إلى أداة للحكم، كما تطرّق الكتاب لمفاهيم شريعتي و نقل أن ثورية شريعتي الطاغية التي كانت تؤكد على ضرورة وجود قائد إذا أراد الناس الثورة كان لها عظيم الأثر لإنجاح الثورة، ويقول بازركان في هذا الصدد (إن كتاب شريعتي ومثلما يفعل أي كتاب آخر له، قد أسهم في تقوية وضع الخميني قائدًا للحركة الإسلامية الإيرانية).
ثم تناول الكاتب الجماعات ذات الصلة الني عكست بشكل أو بآخر فكر شريعتي ومطهري، مثل حركة حرية إيران، ومجاهدي خلق، والأجواء الثورية الطاغية، كما مرّت على التعليم الديني في تلك الفترة. إجمالاً فقد حولت الأصوات في إيران الخطاب الإسلامي إلى نزعة راديكالية ثورية، مليئة بالحماسة الثورية.
الجيل الثالث: سياسات الإسلاموية 1989-1997:
شكلت وفاة خميني نقلة كبيرة في الفكر الإيراني، واعتقد البعض أنه بوفاة خميني ستفقد القوى الراديكالية وهجها وستنتهي الثورة، تعزّز هذا الإحساس في عهد رفسنجاني الذي وُصفت ولايته “بالجمهورية الثانية” ولكن المؤلف يرى أن موت خميني لم يكن إلا إعلاناً لرحيل حاكم كهنوتي، و أن وفاته أطلقت لجيل جديد الفرصة ليبسط رؤيته التي ترى الثورة ظاهرة كونية ضد الإلحاد ورسالة كونية نحو الإيمان.
تشَكَّلت في عهد رفسنجاني الفصائل والأحزاب والتيارات، وكانت حكومة رفسنجاني كما يصفها هو نفسه “لا يسارية ولا يمينية”، تبنت رؤى اقتصادية إصلاحية وأطلقت مشاريع تأمل أن تؤتى أكلها في 2021 وبالرغم من كونه معتدلاً على المستوى الشخصي إلا أن اقتناعاته الدينية والسياسية استندت من حيث الأساس إلى المذهب المحافظ البراجماتي.
الجدول يوضح تشكل التيارات وتباين رؤاها:
البيئة الدولية : شهدت تلك الفترة انهيار الاتحاد السوفيتي والأزمة العراقية-الكويتية، وعداء الولايات المتحدة الأمريكية.
ثم سادت بيئة معاداة المفكرين خوفاً من الغزو الثقافي الغربي، واستشهد المؤلف بقضية عبدالكريم سروش والمذكرة التي اتهمت حكومة رفسنجاني بأنه يتساهل مع الغزو الثقافي، فقامت ردة فعل قوية كانت تنذر بحقبة مظلمة قيد التكوين، ساردًا آراء خامنئي التي ملئت بإحساس الدفاع عن الإسلام وما يتعرض له من هجوم ثقافي.
إسلام قم :مصباح يزدي والمدرسة الحقانية
لعب يزدي -وهو من تلامذة الخميني- دورًا فاعلاً في الثورة الإيرانية وانتخب في 1990 في مجلس الخبراء، وله مواقف متشددة منها الإشادة بجماعة فدائيان الإسلام التي اغتالت كسروي، ودعا إلى القضاء على أعداء الثورة، و أدان العملية الإصلاحية برمتها، وأدان التعددية بحكم أن الأنبياء لا يؤمنون إلا بفكرة واحدة هي الصحيحة، ويُنَظِّر يزدي للعنف الديني، وبالرغم من ذلك فإنه يحظى بتوقير من خامنئي ويفسر المؤلف ذلك بأن يزدي يعكس نظرة الدولة وأيديولوجيتها، يفصل الكتاب في مواقف يزدي الذي يقلل من ضرورة رضا الشعب و يغالي في أهمية هيمنة الإسلام، ويؤيد العبودية.
أما المدرسة الحقانية فهي تلك المدرسة التي تكفلت بوضع فتوى الخميني بِهدر دم سلمان رشدي موضع التنفيذ، تأسست في 1964، و مكن لها يزدي إبان توليه السلطة القضائية ولها نفوذ واسع اليوم في طهران.
إسلام طهران: فريد وداوري
اعتبر بعض مناهضي الغرب في إيران أن دولتهم بعد الثورة تستطيع أن تتحول إلى أم القرى، لمحاربة الفساد والطغيان، فوصمت أمريكا بالشيطان الأكبر والغرب بجوهر الشر، و قد نظّر لهذه الدعاوي الفيلسوف سيد احمد فريد ورضا وداوري من جامعة طهران وهما فيلسوفان يتبنيان الفكر الهيدجري ” أي المنتسب إلى هيدجر الذي وصف بأنه منظر العنف النازي”.
سيد أحمد فرديد
هو أول أقطاب هذه الفترة ومنظر الجيل الثالث للإسلاميين، كانت له مواقف تتجاهل الآخر، واتهم الفلاسفة منذ سقراط بأنهم خلقوا فجوة بين البشر وخالقهم، وكفّرهم وأفتى بزندقة الفارابي والملا صدرا وهاجم المفكرين الإيرانيين الذي تشيعوا “كما يقول” للغرب ومجدوا نظرية “مركزية الإنسان” التي ساوت بين الله والإنسان، وكان يرى أن زعامة خميني للثورة الإيرانية وفرت فرصة لتقديم نهج فلسفي حقيقي يعيد توجيه الإنسانية إلى خالقها.
مرّ فرديد بتجربة فلسفية انتهت به لعداء مع الحداثة، وفهم “مذهب الإنسانية” على أنها يجعل من الإنسان إلهاً، واعتبر الثورة الدستورية 1906 في إيران هي بداية “مذهب الإنسانية” في إيران وبداية التسمم بالغرب فيها، ويرى في الديمقراطية ولاء للشيطان وجعله ملاذًا، ويرى هدف إيران إعادة الخلق للخالق ويؤمن بالثورة المستمرة، ليصل لوعي وجداني يحل محل النزعة الإنسانية المعاصرة أسماها (اللطف الإلهي)، وهو يرى أن الديمقراطية لو وجدت في الجمهورية الإسلامية فهي ديمقراطية “رأسية”، و لم يتورع فرديد في تكفير مفكرين في قامة الطوسي وهو من علماء الشيعة في القرن الثالث عشر فلا يتوقع منه – حسب المؤلف- أن يكون موقفه أكثر تسامحاً تجاه مفكري إيران المعاصرين من علمانيين ويساريين وغيرهم.
أما داوري فقد ولد في 1933، تخرّج من جامعة طهران و لا يزال يدرّس بها، تحوّل إلى شخصية عامة بطابع ثوري، وهو من منظري المشهد الثقافي الحالي في إيران، وهو يدين لفردويد بإنقاذه من فلسفة دوركايم الوضعية السوسيولوجية، وهو يؤمن بأن التسمم بالغرب هو جوهر إشكالات إيران المعاصرة ومؤمن تماماً بشهية الغرب في الهيمنة وأنها لا يمكن أن تُستأصل ويرى داوري أنه ما من فرق بين الغرب و الحداثة، فالغرب عنده ظاهرة لا تحدها الجغرافيا أو نمطية السياسة، وهو يجسد غروب الحقيقة السماوية، ونهوض كائن إنساني يعتبر نفسه بداية الكون ونهايته ومركزيته.
أسهمت الأفكار التي أطلقها مصبح يزدي في قمّ وفريد وداوري في طهران لبروز جماعات مثل أنصار حزب الله، وغيرها من جماعات الضغط التي ترى في نفسها الحق وسواها الباطل، وتعتبر الثورة الإسلامية هي الحدث الأبرز في التاريخ المعاصر وللحفاظ على كل شيء جائز حتى القتل وغيره ويرى المؤلف أن الإسلام والعصرنة ولدا وليدين فاسدين (الإسلاموية والحداثة).
يرى المؤلف أن المشروع الإسلامي أنتج دولة منفصلة عن مجتمعها، فالدولة (نحن) والمجتمع (هم)، وأكد أن ازدواجية الإسلام السياسي ومن يمارسه أنتجت مرض ادعاء التدين، ويتنبأ الكاتب بأنه مثلما أخفقت الحداثة في ظل الحكم البهلوي القمعي فقد أخفق المذهبان “التقليدي” و ” الإسلاموي” في نواح كثيرة.
الجيل الرابع : سياسات الاستعادة 1997-2005
انتخاب محمد خاتمي يُجَسِّد تَغييراً كبيراً في إيران، فقد حلت في عهده مفاهيم التوافق والحوار عوضاً عن العنف والحماسة الثورية، فخاتمي يتحدث عن حوار الحضارات وإفادتها لبعضها البعض، لا عن مهمة مقدسة لتحرير العالم من الجهل.
كانت البيئة السائدة بنت التحالف بين اليسار الديني واليمين المعتدل، وهو التحالف الذي جاء بخاتمي للرئاسة، وليد القناعة بأن تعقيدات الحياة و الهوية الإيرانية و التحولات العالمية لا يمكن مجابهتها بفهم “نحن وهم”، بل يحتاج إلى نفس إصلاحي حقيقي يؤمن بمعاني التعايش لا الإقصاء.
على المستوى الداخلي اعتُبرت فترة رفسنجاني التي أعقبت القمع الثوري ممهدةً لخاتمي، وكانت حقبة خاتمي ” الأمل الضائع للإصلاح بين الثورة والأعراف الدولية”، دبّ في تيار الإصلاح جنوح نحو الحياة ودخل إلى مرحلة إقامة علاقة وثيقة بين الدين والعصرنة.
اكتشف الجيل الرابع من الإسلاميين أن افتراض التضاد بين الديني والعلماني افتراض خاطئ، فأطلق الخطابين معاً.
في عهد خاتمي عادت الحياة الطلابية، و بدأت المظاهرات ضد القوانين القمعية، وغيرها، إلا أن الآلة الأمنية كانت في يد المحافظين الذين يحظون بدعم من خامنئي، بالرغم من ذلك فقد أطل نقد المسلمات وطرح عقلاني على يد ” هاشم آقاجري” مثلاً أو كنجي الذي يتحدث عن تناقض الجمهورية والإسلام. وهو دليل حراك فكري حقيقي في إيران تجاوز التقليدية . واتجهت المنظومة الفكرية الإصلاحية للحديث عن العولمة و مابعد العصرنة، والتسامح والتعددية على يد المفكرين الذين سنمر على نماذجهم بعد قليل.
إسلام قم منتظري وكديور:
حسين منتظري (ت2009) كان ساعد خميني الأيمن، وهو من كان وراء إدخال مبدأ ولاية الفقيه إلى الدستور، إلا أنه في فترة لاحقة صار أبرز المعارضين، لدرجة أنه اعترض على سلطة خامنئي وشكك فيها، فهو يرى أن رجال الدين رجال لاهوت كبار، و يرى أن سلطة المجتمع هي الأولى في الإسلام ويجسدها أهل الحل والعقد.
مثله تلميذه محسن كديور المولود في 1959، والذي درس الهندسة قبل دراسته للعلوم الشرعية في قم، في 1999 حكم عليه بالسجن لأنه قال بأن الديمقراطية والإسلام من الممكن أن يعززا بعضهما البعض ورفض التفسير التاريخي في عالم معاصر، و يقول بأن الحكومة الدينية في الزمان المعاصر ممكنة ولكن ليس بالضرورة أن تستند إلى الشريعة، يشرح تيارين في الفكر السياسي الشيعي الأول يرى الشرعية الإلهية فقط وهو محصور في أربع نظريات أو صيغ ثيوقراطية (الولاية التعيينية للفقهاء، ولاية الفقهاء التعيينية، والولاية التعيينية العامة لمجلس مراجع التقليد، والولاية المطلقة للفقيه)، و الثاني يرى الشرعية الإلهية والشعبية معاً (الحكومة الدستورية “دولة المشروطة”)، الحكومة الجماعية بالوكالة، وخلص إلى أن هذا الميدان السياسي بحر لا ساحل له، والجميع تنقصه الكفاءة للخوض فيه وانتهى إلى أن مبدأ ولاية الفقيه ضبابي وليس مقنعاً. وهو يفتح الباب لرجال غير رجال الدين ليتولوا الحكم.
إسلام طهران: شبستري وسروش وحجازيان.
ظل صوت الإسلام الليبرالي قوياً فظهر مفكرون قرروا التصدي لتحديات العولمة والعصر وأُجهدوا في سبيل ذلك ما أُجهدو.
محمد مجتهد شبستري:
وهو أستاذ علوم الدين بجامعة طهران، تعلم الإنجليزية والألمانية ويرى أنه لا يوجد فهم واحد للنص، قام بنقد القراءة الرسمية للدين، هو يؤمن بأن الحرية هي الغاية والوسيلة في نفس الوقت، حرية الذات واستقلالها. والحرية عنصر متأصل من عناصر الدين، والقرآن لم يتضمن أي شكل من أشكال الحكم وإنما تضمن الدعوة إلى العدالة.
عبدالكريم سروش:
ولد في 1945، درس الصيدلة وتتملذ على خميني وتأثر به، دافع عن النظام الإسلامي ضد الماركسي ولكنه ما إن رأى الديكتاتورية الدينية، إلا وبدأ الدفاع عن الحكومة الدينية الديمقراطية، وقدّر بأن العلمانية ليست مناهضة للدين، ودعا إلى الفصل بين الدين وفهم الدين، فالدين كامل ولكن فهم الدين ليس كذلك والمعرفة الدينية هي صناعة بشرية، وقد تبنى سروش رؤية نقدية حيال مفهومي الحداثة والإسلام، وهو يرى أن الدين أعظم من أي نظام أيديولوجي، وأن تحويل الدين إلى أيديولوجيا يعرضه للخطر، فالإنسان يزدهر في جو الإحساس بالخشية من الله (الذي يولده الدين)، ولكن ليس في أجواء الكفاح والنضال الذي تخلقها الأيديولوجيات. يركز في خطابه على مبادئ الفضيلة والأخلاق ومركزيتها .
وجه سروش انتقاداته لنظام إيران مشيرًا إلى أن مبادئ الأخلاق والدين تداخلتا إلى حد فصل الأخلاق عن الدين، ويقرر بأن ذلك يضر بالدين ويفقده صفته من حيث هو دين.
اهتم سروش بالتفرقة بين المبادئ الأساسية للدين وما يقترن به من ظواهر عرضية طارئة.
سعيد حجازيان المولود في 1935، عضو بارز من أعضاء الحركة الإسلامية الثورية في إيران، وكان مستشاراً خاصاً لخاتمي، يتبنى حجازيان فقه المصلحة للتعامل مع العولمة والنظام العالمي المعقد . ويحمل العديد من الرؤى الإصلاحية الجديدة التي تناولت نقد التراث وإعادة فهمه و الكثير من الإصلاحات الجذرية التي أخذ على عاتقه التنظير لها لتعزيز سيادة الشعب على نفسه.
سياسات التأرجح :
في خلاصة الكتاب فسر الكاتب ظهور جيل جديد بأنه نضج، وهذا الجيل الجديد تحرر من المخاوف التي فُرضت عليه، وشرع في صياغة نموذج جديد بدفع رؤية إيجابية ترتكز إلى اتجاهات الفكر السائدة، هم التقدميون الذين يأملون التخلص من العقول الرهينة من خلال استعادة السلطة الأخلاقية للإنسان .
التقدميون الجدد يرون إخفاق الحركة الإسلامية عن ما وعدت به، وهم ينتمون لجيل ما بعد الإسلاموية ومابعد الحداثة، يرى الكاتب أن العلمانيين والإسلامويين يتحملون الذنب (ذنب التقهقر)، فهما يفتقران للرؤية الواقعية التاريخية و لا يتقبلان التاريخ ودفعا إلى الهوامش.
و الجيل الجديد جاد في إعادة النظر في تراثه، وتقويم مفهومه للغرب، وبذلك هو يتجاوز العصرنة والإسلاموية.
خلص الكاتب إلى أن “تحويل الإسلام إلى أيديولوجيا يؤدي إلى إفقار القيم الروحانية له وإضعافها، وذلك ينتهك من ضمير الدين نفسه ويثير غضب الخالق .