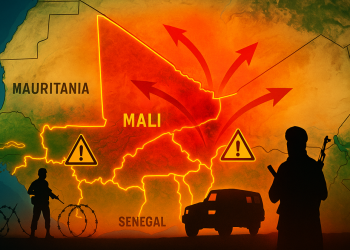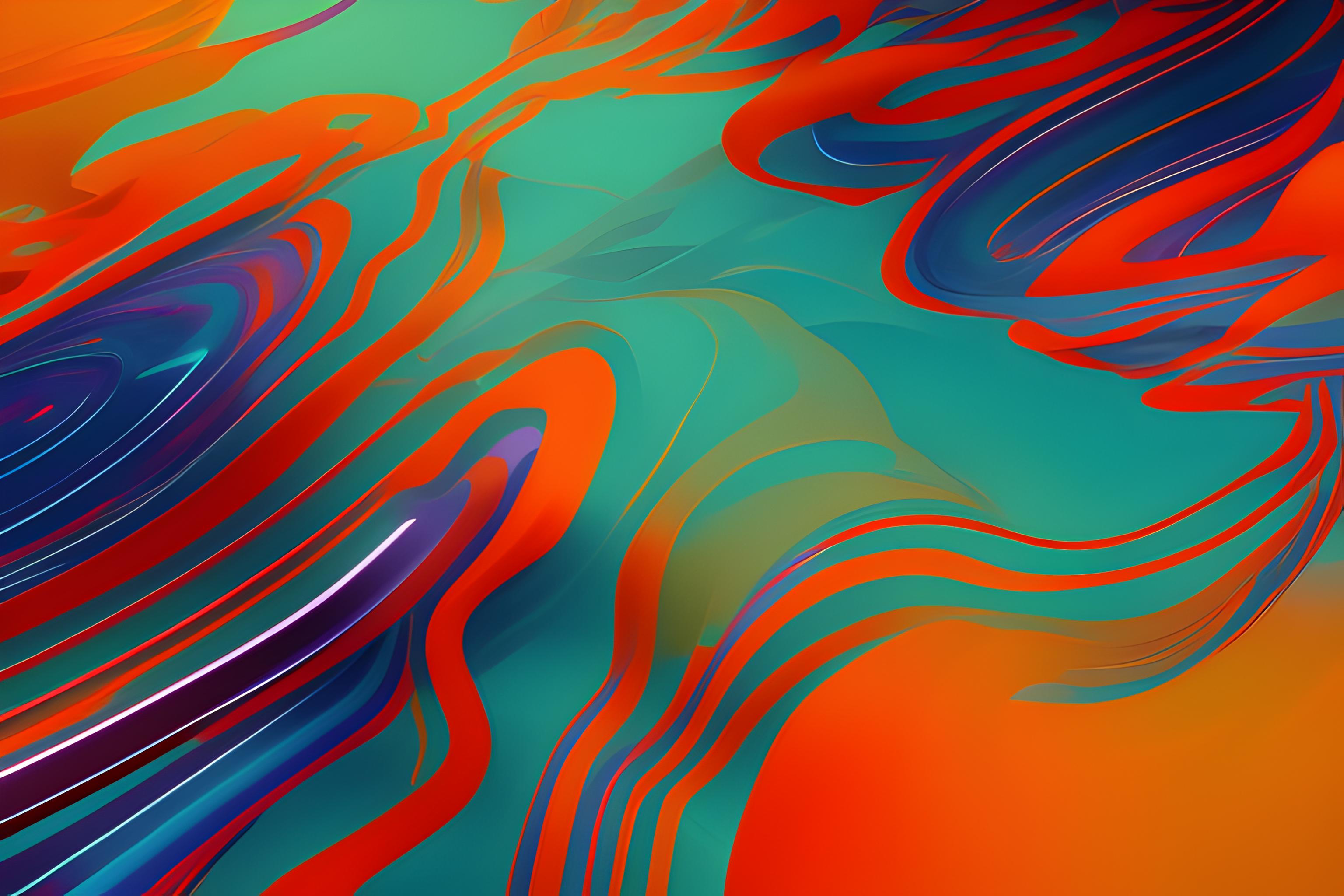كون ماتسو (Koen Metsu)[1]
ترجمة: إبراهيم ليتوس[2]
بجوار مكتبي، قرآن؛ إنه كتاب من الحجم الصغير، مترجم إلى اللغة الإنجليزية مع حواشٍ ككتاب جيب. على الغلاف، تظهر كتابة اسم المترجمَين بحروف ذهبية، وهما: محمد تقي الدين الهلالي ومحمد محسن خان. بالنسبة لأولئك المطلعين -إلى حد ما- على القضايا المتعلقة بالتطرف، سوف تجلب هذه الأسماء الأنظار والانتباه.
ترجمة هلالي وخان واضحة بأيديولوجيتها الأصولية؛ منظومة شاملة من الحواشي والإضافات على النص تدفع القارئ دفعاً في اتجاه معين من الفهم والمعنى. لا تضيف الترجمة فقط ما هو بين قوسين مثل ألفاظ «يهود» و«نصارى»، بل توضح أيضًا كيف ينبغي معاملة هؤلاء الأشخاص. على سبيل المثال، في حاشية لهما على النص القرآني، (سورة 2: 190) نقرأ عن ماهية الجهاد، ووفق تفسيرهم، هو «المعركة المقدسة، مع السلطة الكاملة وبكل سلاح يمكن تخيله»، وعند السورة (60) أضاف المترجمان، ما يجب فهمه من أدوات القتال، على سبيل المثال، من «الحصان المعد للحرب»: إلى «الدبابات والطائرات والصواريخ والمدفعية».
هذه الأمثلة، لا تترك مجالًا كبيرًا للخيال بالنسبة للأوروبيين الذين يعيشون في القرن العشرين، من خيار نحو هذا الخطاب. ومن الصعب أن نفهم، كيف أن الكتاب الديني يتمتع بهذه القوة الكبيرة على الأفراد وتفكيرهم. لأن ما سببته بعض الأفكار لأعمال العنف التي وقعت في أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 وما بعدها، هو خروج عن عرفنا العلماني. لكن مفاهيمنا الأوروبية المعاصرة ما تزال غير مجهزة بشكل جيد لفهم ما يجري مع الإسلام اليوم. كيف انتقل مئات الشباب الذين نشؤوا في فلاندرن (Flemish) ببلجيكا إلى الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، إلى بلدان ليس لديهم أي تعاطف أو علاقة معها، وكانوا على استعداد لتقديم حياتهم من أجل قضية مقدسة؟ إنه سؤال، بالفعل، تجاهله كثير من الناس في السنوات الأخيرة.
من أجل توصيف المشكلة التي يواجهها مجتمعنا، سيقودنا ذلك، إلى مصطلح «التطرف». إنه مصطلح ذو مزايا وعيوب في الوقت نفسه. نعم، كل شخص لديه فكرة معينة وبديهية عما ينبغي للمرء أن يتخيله عند سماع كلمة «التطرف». ومع ذلك، فإنك عندما تحاول بناء سياسة عمومية عليها، تصبح أكثر صعوبة وإشكالية، عند تطبيقها على الدين، إذ يشير ويوحي مصطلح «التطرف» إلى وجود نسخة معتدلة من هذا الدين. فما هو الدين المعتدل؟ هل كان لوثر وكالفن اللاهوتيين «المعتدلين»؟ وما شكل التطرف الذي أدى إلى هجمات 22 مارس (آذار) 2016 في بروكسيل؟ من أين أتت بالذات؟ وماذا نفعل حيال ذلك، لكي نتفاداها؟ هذه هي الأسئلة الأساسية التي يجب أن نجيب عنها، إذا أردنا حقيقة، منعاً لتكرار أعمال العنف في السنوات القادمة؟
الجهاد على نهر الروبل[3]
دعنا نَعُدْ إلى البداية، منذ بضع سنوات، عندما لم يكن هناك أي ذكر لمسألة الإرهاب والتطرف في مناطقنا، وكانت الأمور تسير بشكل اعتيادي. عام 2003، في مدينة بوم، على ضفاف نهر الروبل، اجتمع المجلس البلدي للمدينة حول مشكلة ما يسمونه بـ«تجمعات أو تسكع الشباب»[4]. تشير المذكرة السياسة الصادرة عن تلك الفترة إلى أن هناك مشاكل بخصوص «الشباب المضايقين»، «الذين غالباً ما يكونون شبابًا مهاجرًا» فبحث المجلس البلدي عن حلول وأجوبة، فظن أنه سيجدها عند جمعية تم تأسيسها حديثًا المسماة «بالإصلاح». «يذكر التقرير أن اسم الجمعية يعني «البناء» وأن الجمعية تعرب عن أملها في أن تعمل على «نشاط ترفيهي هادف للشباب الذين يتسكعون في الشوارع» لكن المفاجأة الكبيرة هي أن رئيس جمعية الإصلاح لم يكن فيما بعد، سوى فؤاد بلقاسم، وكان في ذلك الوقت لا يزال مجهولاً كشخص وفي العشرينيات من عمره.
سيصبح من الواضح تدريجيًا، في السنوات التالية، ما يشير إليه هذا «النشاط الترفيهي ذو معنى» الذي زعمت جمعية الإصلاح القيام به. شاهد المساعد الاجتماعي الذي كان يشتغل في بعض الأحياء والشارع، السيد بيتر كالوي، الأمر عن قرب. القارئ لرواية في كتاب له، سيكتشف ما سطره عن الأحياء كنوع من السرد للحقائق، كقصة الدراما المعلنة[5]. في فترة لاحقة بعدها، كانت العلامات يمكن التعرف عليها بسهولة. نذكر منها: توترات مع السكان المحليين والأعلام المرفرفة لحماس وحزب الله (وأمريكا كحصيرة تمسح عليها الأرجل…) في كل وقفة أو تظاهرة يتكرر المشهد نفسه، نتج عن ذلك اندفاع الشباب لرفض نظرية تطور الأجناس في المدارس، والتعامل بالوحشية تجاه بعض المجموعات، مثل النساء والفتيات اللائي يرتدين ملابس «غربية» أو النساء المسلمات اللائي لا يرتدين الحجاب، لفترة طويلة، والمجلس البلدي لم يلتفت لشيء ولم يول أي اهتمام لهذه الظاهرة المتنامية في المدينة. حتى إنه في نهاية المطاف تنتهي وتقرر بلدية المدينة بعقد تعاون مع جمعية الإصلاح. لكن المشاكل لم تنته هنا فقط. بل، لم يمض وقت طويل بعدها، إلا وبلقاسم ظهر كمؤسس لتنظيم الشريعة لبلجيكا. الرد في البداية كان الاستهزاء والضحك على ما تقوم به الجمعية من أنشطة. فوصفوا «بالمهرجين ذوي اللحى الطويلة» فكان هذا هو الحكم السائد من طرف الرأي العام حيال هذه الجمعية الجديدة. لكن، عندما انفجر ما يسمى بـ«الربيع العربي» بعد فترة وجيزة، انتقل عدد من الشباب فجأة إلى الشرق الأوسط للقتال هناك. ويلاحظ أن قسوتهم وطيشهم غير عاديين. عام 2014، اكتسب تنظيم «الدولة الإسلامية» فجأة شهرة عالمية، وبالتالي انضم العديد من الشباب الذين نشؤوا في الغرب إليها.
لم يمضِ وقت طويل بعد، حتى فاقت أوروبا على موجة متطرفة من الهجمات من نوع جديد، وفيه تهجم مشين، حيث يقتل المهاجم نفسه كانتحاري أو يسعى لكي يُقتل على أيدي الشرطة. فأصيبت الأجهزة الأمنية لدينا بالذعر، لما رأته من قسوة وتطرف، فلم يكن لديهم الوسائل ولا المعرفة اللازمة لمتابعة هذه الظواهر الجديدة التي لم تكن معهودة من قبل. علاوة على ذلك، كان لدينا قوانين لم تتكيف ولم تعدل مع هذا الشكل الجديد من الإرهاب. فماذا كان يحدث؟ وما الذي كان يجري؟
لقد جاءت الهجمات الإرهابية التي شنتها «داعش» على الأراضي الأوروبية بقتال لم يكن مماثلاً لوصف الحرب الكلاسيكية. لقد كان بالفعل، شكلاً جديدًا من أشكال القتال، من نوع القتال الذي يمكن أن نسميه: «قتال ما بعد حرب الحداثة»، حيث إن التمييز بين المواطن والعدو تلاشى تماماً، فكان كل مكان وكانت كل جبهة تعتبر لدى «داعش» حرباً محتملة ومستساغة. حينئذ، جاء السؤال: كيف يمكننا حماية مواطنينا عندما يكون هؤلاء المواطنون في الوقت نفسه ضحايا، وقد يكونوا هم أنفسهم مرتكبي الهجمات؟ بعبارة أخرى: كيف لنا أن نفرق بين المواطن المهاجم والمواطن المستهدف؟ وكل ذلك في المكان نفسه وفي الوقت نفسه؟ بكل تأكيد، إن القيام بتلك المهمة صعباً جداً وليس سهلاً للأجهزة الأمنية. كان تنظيم «داعش» عدوًا لا ينطبق عليه التعريف الكلاسيكي المعروف للعدو أو القوة المعادية، أو عدواً مرتبطاً بموقع معين. لقد كانت شبكة العدو فضفاضة، مكونة من خلايا، عناصر وأفراد، الذين يرتبطون أحيانًا فقط ببعض الأفكار والعلاقات المتغيرة. علاوة على ذلك، والأصعب في ذلك على عكس وخلاف عدو بلجيكا كان لزاما التقيد بالقانون في كل ما تقوم به الدولة، ولا يمكن خرقه بأي حال من الأحوال.
عودة مجرمي الحرب
في نهاية عام 2016، أبلغت أجهزة الأمن أن مجموعات كبيرة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTFs) على وشك العودة إلى أوروبا. في ذلك الوقت، كان لا يزال هناك (275) مواطنًا في سوريا والعراق، مات منهم (120) (تقديراً وافتراضاً). لقد كانوا يمثلون جزءًا كبيرًا من المقاتلين السوريين الذين تتراوح أعدادهم بين (3 آلاف) إلى (6 آلاف) مقاتل أوروبي. كان بادياً أن الحرب قد وصلت إلى ذروتها في ذلك الوقت، وكان من المتوقع أنه بعد استعادة وسقوط الموصل والرقة، بلا شك سيعود بعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوروبا.
في الأخير، لم تأت تلك الموجة من العودة الهائلة التي كنا نخشاها، لكن بعد بضع سنوات عاد النقاش والحديث عن المقاتلين من جديد. في نهاية عام 2019، انسحب الأمريكيون من سوريا، وفي الفوضى التي أعقبت ذلك، هددت مجموعات كبيرة من القاتلين الأجانب بالفرار والعودة إلى أوروبا.
سأل العديد من الدول الأوروبية أنفسهم: ما الذي يجب القيام به مع أولئك العائدين من أعضاء المقاتلين الأجانب؟ إن الإعادة المحتملة لمجرمي الحرب شكل ويشكل تحدياً كبيراً للقيود الجغرافية والإقليمية لقوانيننا الوطنية والقوانين الدولية. كيف يمكننا محاكمة المجرمين «العالميين»، الذين يتجاهلون كل القوانين الوطنية والحدود (ويريدون تحديها بنوع من سبق إصرار ووعي) دون التخلي أو خرق مبادئنا الأساسية لنظامنا القانوني؟
كان هناك الكثير من الأصوات في بلادنا التي اعتقدت أنه ينبغي لنا إعادة الأشخاص المعنيين إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن؛ ومحاكمة هؤلاء الأشخاص هنا في بلجيكا. كان هذا حلا يتعارض بشكل صارخ مع التطبيق الإقليمي للقانون الجنائي. إذ -كما هو معلوم- يجب محاكمة ومعاقبة كل من ارتكب جرائم في سوريا وفقًا للقوانين المحلية، وأن يأخذ المجرم عقوبته في الأرض التي اقترف فيها الجريمة. نعم، يمكن لدولة أجنبية استخدام سياستها الدبلوماسية للتوسط، لكن الخيار الأخير يكمن في سوريا ونظام الأسد. ثم أصبح احتمال تغيير النظام (مع افتراض أن هذا أمر مرغوب فيه، والذي هو حاليا مستبعد وقد لا يكون كذلك، بالنظر إلى دول أخرى وأمثلة أدت إلى حالات مأساوية في ليبيا) فلا شيء من ذلك، لا سيما بعد خروج الأميركيين من سوريا.
إن الخيار الأقرب للصواب والبديل كان وما يزال: مقاضاة المقاتلين في سوريا من خلال تقديمهم للمحكمة الدولية ووفق القانون الدولي. منذ عام 2016، صدرت قرارات مختلفة من البرلمان الأوروبي والبرلمان البلجيكي والفلمنكي، وصفت ما حدث في سوريا بأنه إبادة جماعية[6]. تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في البداية للتحقيق في أخطر الجرائم الدولية ومحاكمتها. يتم تعريف اختصاص المحكمة في نظام روما الأساسي. تمنح المادة (5) (1) المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب و«العدوان».
دعمت بلجيكا بالفعل مبادرة «تقديم داعش إلى العدالة» في عام 2016، من خلال وزير خارجية بلجيكا، ديديه رايندرز، بقصد مطالبة الأمم المتحدة بجمع الأدلة ضد جرائم «داعش». عام 2017، دعا الممثل البريطاني الأمم المتحدة إلى تثبيت آلية لجمع الأدلة ضد «داعش». تم تصميم هذه المواد في المقام الأول للاستخدام من قبل القضاة المحليين، ولكن يمكن أيضًا جمعها واستخدامها في بلدان أخرى. يعمل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (UNITAD) على مساءلة تنظيم الدولة الإسلامية، ويعمل منذ بداية عام 2019 على مقابلة الضحايا وجمع أدلة أخرى.
جمع الأدلة للجرائم المرتكبةأمر حاسم؛ لأن معظم المقاتلين السوريين العائدين ينكرون أنهم لعبوا أي دور ذات معنى في القتال مع «داعش». ومن المعلوم، أنه بدون أدلة إضافية ومثبتة، غالبا ما يكون الأمر من الصعوبة بمكان، النطق بعقوبات صارمة ضد المشتبه بهم.
يبدو أن نهاية «داعش» في متناول اليد، ولكننا ما نزال مستمرين في الحد من هذه التيارات الإرهابية وغير قادرين على البقاء على راحتنا. على العكس من ذلك: نحن الآن، نواجه تحديا أكبر من القتال العسكري ضد «داعش».
الحرب الأيديولوجية في سجوننا
غالبًا ما ينتهي المطاف بالمقاتلين العائدين من سوريا إلى السجن، حيث يجدون جمهورًا غفيرا، قابلا وراغبًا في تقبل ونشر أفكار متشددة. ويستند أمن الدولة الذي يمتلك معلومات عنهم، على أن الذين يندرجون تحت احتمالية وخطورة تعرضهم للتطرف من بين السجناء حوالي (450) سجينًا. (أرقام عام 2016) من إجمالي عدد نزلاء السجون البالغ عددهم (10.300)، أي (4.4%). ونظرًا لوجود (4 آلاف) مسلم في السجن، فإن أكثر من (10%) من هذا التعداد السكاني لديه بالفعل مثل هذا الخطر وهذا الاحتمال للميول نحو الغلو. عندما ظهر فؤاد بلقاسم ـزعيم تنظيم الشريعة لبلجيكاـ في السجن عام 2015، هدد سيناريو عام 2003 بتكرار نفسه في البداية. سعى السجناء بكل جهد من أجل فرصة البقاء بالقرب من فؤاد بلقاسم في السجن.
ومع ذلك، استجابت حكومة ميشيل هذه المرة واقترحت خطة عمل جديدة. فتم تخصيص (5.4) ملايين يورو لمعالجة التطرف في السجون نفسها. منذ عام 2016، وفرت الحكومة أيضًا أماكن خاصة للأشخاص الراديكاليين: قسم ما يسمى (DeRadex)، والذي تم توسيعه في سجني هاسيلت وإيتري. هناك (20) مكانًا متاحًا لكل منها، ولكن نادرًا ما يتم استخدامها. يرى وزير العدل الحالي أن الأشخاص المتطرفين يجب أن يعاملوا قدر الإمكان مثل السجناء العاديين… لكن السجون العادية ليست مجهزة لهذا الغرض. يمكن للحراس في السجون، على سبيل المثال، استخدام الكاميرات لمراقبة ما إذا كان العنف يندلع في زنزانة أم لا وحتى لو سمعوا ذلك، فإنهم في كثير من الأحيان، حتى لو سمعوا الحديث بين السجناء لا يعرفون ما الذي يقال بالضبط؟ وكيف يجب فهم وتفسير ذلك.
ارتكب بنيامين هيرمان عام 2018 اثنين من جرائم القتل في مدينة لييج بعد خروجه من السجن، بعدما كان الرجل في إجازة جزائية من طرف إدارة السجن، على الرغم من أنه تبين فيما بعد أنه قد تحول إلى التطرف في السجن من خلال اتصالاته مع الإسلاميين هناك. كان قد ظهر اسمه في مختلف تقارير أمن الدولة. سوف نشهد على أنفسنا بنوع من السذاجة إذا كنا نعتقد أن هيرمان هو الوحيد من بين السجناء الذي تمّ استقطابه.
هناك رابط مهم في الصراع أو الحرب من أجل الأفكار، وهو المرشدون الدينيون الذين يمكنهم متابعة ومراقبة السجناء. يوجد حاليًا (12) مرشداً ناطقًا بالفرنسية و(12) مرشداً ناطقًا باللغة الهولندية، وتتراوح أعدادهم بين 16 إلى 45 بدوام كامل. الأمور مستمرة. عام 2016 قلنا وصرحنا بأن «الحكومة، مع ذلك عازمة على توسيع المرشدين إلى (27) من المرشدين والمرشدات للمسلمين في السجون، بدوام كامل».
لماذا هؤلاء الاستشاريون أو المرشدون مهمون؟ إذا كنا نريد أن نتجنب ما حدث عام 2003، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال الذي مُنِع الناس في ذلك الوقت -بشكل قد يساء فهمه من ناحية الصواب السياسي- أن يسألوه وهو: ما الذي يحدث في الإسلام؟ المشاكل في الواقع لها علاقة بالتفكير المتطرف للإسلام. بعد كل شيء، يشير الجهاديون والمقاتلون الذين توجهوا إلى سوريا، إلى دين معين لتحفيز أفعالهم. يمكن للمرء محاولة تقليل هذا من خلال الإشارة إلى مشاكل نفسية أو اجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه الأمور ستلعب -بلا شك- دورًا ما، فإنها في الواقع، لا تشكل تفسيرًا كافيًا للوقائع.
النظر إلى التطرف فقط من زاوية كونه، أحد أعراض الانحراف النفسي لا يأخذ بالاعتبار الجوانب السياسية والدينية اللذين هما في نهاية المطاف الخياران الواعيان اللذان يجب أن نسلكهما، إذا ما كانت الدوافع دينية وسياسية. فلا يمكنك حل المشكلة «لاهوتية- سياسية» بجلسات في علم النفس. هؤلاء الشبان المتطرفون يقسمون الولاء لإلههم ولدينهم، وهم يؤمنون بكل إخلاص أنهم ذاهبون إلى الجنة، ويشيرون دوما إلى فهوم من الإسلام. ينضمون إلى المنظمات التي ترغب في إنشاء نظام إسلامي، أو ترغب في استعادة الخلافة نفسها. وهكذا تتكرر العناصر نفسها الموجهة لأفكارهم.
التحدي هو تحديد هذه الدوافع وهذه المحركات ومكافحتها. «التطرف» في الإسلام هو عملية مرتبطة بأفكار وأنماط من السلوك المحددة. وهذا النوع من التفكير يمكنك تحديده وتعيين ذلك حتى يصبح له علامات دالة عليه، عند تتبعها تتضح الصورة أكثر وتكون العملية ممكنة التدارك والتصحيح، ثم تقويضها في النهاية. بهذه الطريقة، يمكن منع التوزيع الإضافي لمثل هذه الأفكار -وفي حالات أحيانا- يتم العكس كذلك، ويمكن التراجع والإقلاع.
في ظلال سيد قطب
لفهم التطرف في الإسلام المعاصر، يجب أن نعود إلى جذور تلك الأفكار وإلى المصادر، أي سيد قطب، المنظر الإسلاموي الأخطر في القرن العشرين، ومؤسس الراديكالية الإسلاموية المعاصرة. وهو الذي وصف العالم الذي وقع في الجهل الفاسد بالشر و(بالجاهلية)، والذي كان برأيه وبالنسبة إليه، الحل الوحيد، هو العودة إلى الإسلام الأصلي النقي كما كان في القرن الأول[7].
تريد هذه الحركات تطهير الإسلام من أي تأثير غربي، فالأوروبيون وثنيون والمسلمون الذين لا يشاركون في تطبيق النسخة النقية من الإسلام يعتبرون من الزنادقة. أعدم قطب على يد عبدالناصر عام 1966، ولكن ليس قبل أن ينجحوا في نشر رسالتهم وفكرهم إلى الأجيال التي جاءت بعده من خلال الجامعات المصرية، انتشر هذا النمط من الفكر وهذا الشكل الجديد من الجهاد في الشرق الأوسط، وكانت هذه الأيديولوجية هي أساس كبرى حركات الإسلام السياسي، مثل تنظيم القاعدة.
مع الراديكالية الجهادية تسللت أيديولوجية التطرف إلى مجتمعنا، التي كانت تحمل معاداة أساسية لطريقة حياتنا: بالنسبة لأتباع سيد قطب، لا يوجد حل وسط بين الإسلام وبقية العالم، بل هو أمر مستحيل. الحل الوسط مع القوانين الوضعية والمعايير التي هي من صنع الإنسان أمر مستحيل. في كتابه «معالم في الطريق» أو «المعالم» التي كتبها عام 1964 أن كل شيء يقف في طريق العودة إلى الإسلام الحقيقي -كما هو الحال في حالتنا الديمقراطية، قوانيننا، أعرافنا وقيمنا، بما في ذلك الثقافة الغربية «الضارة»- يجب إزالته بالقوة.
يميز المحللون بين السلفيين «المسالمين» والسلفيين العنيفين. لكن، مع ظهور تقرير من مكتب التحليل والتنسيق للتهديدات لعام 2016 بدا أن إدراكنا التمييز بين الأنموذجين بدأ يتلاشى مع مرور السنوات شيئاً فشيئاً.
ظل الجهاديون لسنوات يسممون عقول الآلاف من الشباب في أوروبا. في المدن التي يصل فيها الأئمة المتطرفون، يتم تشجيع المتعصبين الشباب على ممارسة ضغوط اجتماعية على النساء وعلى الشابات في بيئتهن وفي المدرسة. فجأة بدأت تنشأ مشاكل حول الحجاب في المدارس، حول دروس السباحة، وحول نظرية التطور… إلخ. رئيس التعليم في مرسيليا، التي هي واحدة من أكثر المدن الإسلامية في فرنسا، والتي تم وصفها في مقابلة في صحيفة لو فيجارو عام 2017، ذكرت كيف يستغل المتطرفون الإسلاميون الناشئة وكيف يقفون على أبواب المدارس والطلاب بدعوى مساعدتهم في واجباتهم المدرسية.
يمكننا الدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب، وقد فعلنا ذلك في السنوات الماضية. ولكن ما الهدف من محاربة التجاوزات العنيفة إذا لم نقم بالتصدي لجذور هذه الأيديولوجيات؟ على الرغم من كل التحليلات النفسية والاجتماعية، فإن التطرف جزء من أجندة جيوسياسية تريد تدمير مجتمعنا بالعنف.
لذلك أدعو أن نرمي بسذاجتنا من وراء ظهورنا. وهذا يتطلب أن السياسيين عليهم تعديل أفكارهم، ولكن أيضًا سياساتهم. غالبًا ما تعاني أجهزتنا من الأمية الدينية التي تجعلها عمياء في الحرب ضد التطرف الإسلاموي. بعد تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالإرهاب أكتوبر (تشرين الأول) 2017، على سبيل المثال، قررت الحكومة الفيدرالية إنهاء اتفاقية التعاون مع الرابطة، التي كانت تدير المسجد الكبير أو المركز الثقافي الإسلامي ببلجيكا. لقد فوجئنا أيضًا بعد ما آلت الأمور في مايو (أيار) عام 2019 إلى إدارة جديدة، واتضح بعدها وجود خطباء لا يتحدثون سوى العربية وما يزالون يتقاضون أجورهم من خارج بلجيكا.
حينها… أعلن وزير العدل كون جينس أنه فقط «خطأ المبتدئين». جميل، أن يدافع الوزير المختص عن فريقه ويدعم أجهزته، لكن هذا لا يغير من الحقيقة شيئاً، بأن وزارة العدل وأمن الدولة لا يزالان غير مجهزين على الأقل، أيديولوجياً بشكل كافٍ لمواجهة هذه الإشكالية.
نعرض أيضًا الموقف نفسه في سياستنا تجاه الراديكالية بمفهومها الأوسع التي تسربت إلى مجتمعنا. نحن ننظر إلى دين، العلمانية غريبة عليه، وننظر من وجهة نظر غربية وفردية وعلمانية. إننا نعتبر التطرف عملية فردية وغير تاريخية، ولا ننظر على أساس أنها حقيقة جماعية.
إن أمن دولتنا بالفعل مجهز بشكل سيئ للغاية لمتابعة الأفراد المتطرفين، فضلا على أن يقوم بالتحليلات الأكثر عمقا للظاهرة، إذ إن هذا العمل –وللأسف- لم يعد الجهاز يقوم به كما يجب. على المستوى الجيوـ سياسي، يجب أن نكون قادرين على مكافحة تدفقات الأموال التي تمول الدعاية للأيديولوجية الأصولية من خلال قنواتنا الدبلوماسية، ومن خلال تمويلنا للعدالة والوزارة المالية. ولكن قبل كل شيء، علينا كمجتمع بل يجب أن نفهم ونستوعب أن هذا الصراع إنما هو صراع من أجل الأفكار، حيث يتم تحدي حضارتنا الغربية في جوهرها.
الإسلام والغرب
بالإضافة إلى تجهيز خدماتنا بشكل أفضل، وأيضًا فيما يتعلق بالأيديولوجية الدينية /الثيولوجية، يجب علينا أن نتجرأ على العمل بشكل هجومي/ وقائي أكثر وتفكيك خطابات الأيديولوجية الأصولية.
أحد الخطابات أو الروايات التي يجب علينا -بمن في ذلك المرشدون الدينيون- أن نجرؤ على اختراقها بشكل منهجي، هو الصراع الذي يصور بين الغرب والإسلام. وهي من بين الأمور الكثيرة، وواحدة من تلك الدوافع الأكثر تكراراً في التطرف الإسلامي، الذي يتأتى ويقوم على الشعور العميق من لعب دور الضحية تجاه «الغرب».
وصف محمد صديق خان، قائد الجماعة التي ارتكبت الهجمات في لندن في 7 يوليو (تموز) 2005، دوافعه في بيان له بعد وفاته. تحدث فيه باستفاضة عن الفظائع التي ارتكبت في جميع أنحاء العالم ضد «الشعب المسلم». وعن أي شعبٍ يتحدث؟ عندما يتحدث المقاتلون في سوريا والإرهابيون المحليون عن السياسة الغربية في الشرق الأوسط، فإنهم يتحدثون دائمًا عن «الصليبيين». نادراً ما يكون للمقاتلين الذين ذهبوا إلى سوريا أو الإرهابيين المحليين علاقة بالدولة التي يهاجمونها أو يدافعون عنها. الأوروبيون الذين سيقاتلون في سوريا ليسوا أبناء الأجيال السابقة من المهاجرين السوريين. لا يسافر أي من المتطرفين إلى أرض آبائه وأجداده للقيام بالجهاد هناك. لا تكاد تكون هناك أية حالة معروفة للجهاديين الذين قاتلوا من أجل حركة مؤيدة للفلسطينيين أو كانوا ناشطين في منظمة غير حكومية حاربت العنصرية.
نعم، تشير إفادات الانتحاريين بعد القيام بعمليات استشهادية إلى فلسطين والشيشان والصين والبوسنة والعراق، دون الخوض في تفاصيلها. يتم مشاركة صور الفظائع فيما بينها، غالبًا غير مؤرخة وبدون تبيان للمواقع التي التقطت فيها، وغالبًا غير مصحوبة بالتعليق. صورة لمذبحة الحركيين، الجنود الجزائريون الذين كانو يقاتلون من أجل الفرنسيين، يعزونه إلى الفرنسيين. تحدث العولقي، أحد أشهر زعماء الجهاد (الذي تأثر بكتابات سيد قطب) كان يتحدث في خطبه عن «الرومان» الذين يقاتلون «المسلمين»[8].
ليس «التطرف» نتيجة لضحية ملموسة، أولئك الذين يرتكبون هجمات في أوروبا ليسوا من سكان قطاع غزة، كما أنهم ليسوا ليبيين أو أفغان. فهم ليسوا بالضرورة من الفئات الأكثر فقراً أو الأقل اندماجاً في المجتمعات الغربية. ربع الجهاديين هم من المسلمين الجدد، والذين لا تربطهم صلات ثقافية أو عرقية بأولئك الذين يشعرون بأن الغرب يسيء إليهم أو يسيء معاملتهم.
أحد الأفغان المتطرفين، عمر متين، المهاجم أو الذي أطلق النار في أورلاندو، لم يذكر على لسانه أنه قام بالهجوم من أجل الانتقام لمقتل قادة طالبان على أيدي الطائرات الأمريكية بلا طيار. ولم يهاجم الإخوان تسارنايف روسيا -الأمر الذي يكون منطقيا بالنظر إلى أنهم ينحدرون من أصول ومن الجمهورية الشيشانية- ولكنهم هاجموا المتسابقين في سباق الماراثون في بوسطن. لم يكن الفلسطينيون هم الذين فتحوا النار في باتاكلان. قليل من المقاتلين من أجل سوريا يعرفون أن تنظيم الدولة الإسلامية هاجم مخيم اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك، عام 2014 وقتلوا القادة هناك.
علاوة على ذلك، فإن الشباب الغربي الذين يذهبون إلى سوريا غالبًا ما يكونون غير مدركين للصراعات الهائلة داخل الإسلام نفسه، مما يعني أنهم غالباً ما ينتهي بهم المطاف إلى طائفة معينة وإلى جانب واحد في هذا النزاع المسلح. إنهم يقاتلون حماس في مخيم اليرموك للاجئين وحزب الله شمال دمشق، ويقتلون مسلمين شيعة أكثر بكثير من «الصليبيين». غالبًا ما يكون خيالهم الديني الذي هو مأساوي جدا، غير مناسب وغير قادر تماما لفهم هذه الصراعات، وأين ستنتهي بهم في نهاية المطاف.
لن تخاض المعركة الأيديولوجية ضد التطرف في جيل واحد. بل سوف يمتد ظل سيد قطب على بلادنا لفترة طويلة قادمة. لكن يمكننا بالفعل بدء دفاعنا عن طريق تقويض وتفكيك -بشكل منهجي- هذه الأنواع من الخطابات والروايات التي تتستر وراء لعب دور الضحايا. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يدرك بها شبابنا أنهم انتهى بهم المطاف في حرب أهلية تدور رحاها داخل الإسلام، بدلاً من الصراع بين الإسلام والغرب، كما يحلو للبعض تصويره.
الخاتمة
هناك تطور، في مرحلة التشغيل وواضح للعيان في التاريخ الحديث للإرهاب الإسلامي. فبعدما كان في بدايات الأمر، يتم إرسال المهاجمين والجناة من الشرق الأوسط إلى الغرب (مثل أغلبية أعضاء مجموعة هجمات 11 سبتمبر (أيلول)). جاءت بعدها مباشرة، ظاهرة «الإرهابيين المحليين» حيث تم إغراء وتجنيد السكان المحليين -وغالباً من أصل أجنبي- للقتال في الشرق الأوسط، كما حدث في سوريا والعراق. ومع ذلك، شهدنا في السنوات الأخيرة التركيز أكثر فأكثر على استقطاب وحشد السكان المحليين، ومن الداخل لشن هجمات محلية في الغرب.
كان علينا دائمًا الاستجابة والرد على هذا الشكل المتغير والمتحول الذي يصدر من العدو. لذلك، كان هذا الشكل الجديد الفردي، والإرهاب ما بعد الحداثي، يتطلب منا مواجهته بقوانين وتقنيات وتحقيقات جديدة تشكل ضغطاً على التوازن بين احترام الخصوصية والمسألة الأمنية، لذلك شكلت العودة المحتملة لمجرمي الحرب والمقاتلين تحديًا لقانوننا الإقليمي والدولي لمحاكمتهم كمجرمين في العالم. وهم الذين يتجاهلون، ويريدون عمداً القضاء على القوانين الوطنية واختراق الحدود. لذا يجب محاكمتهم لكن بدون التخلي عن المبادئ الأساسية لنظامنا القانوني.
مع ذلك، فإن التحدي الجديد هو أكبر بكثير ومضاعف مرات ومرات، إذ يتطلب منا، أن نسأل أنفسنا أولاً بشكل أساسي عن الطريقة التي ننظر بها إلى العالم وإلى ذواتنا، كيف يمكننا أن نكسب أرواح وقلوب أولئك الذين يكرهوننا؟ وكيف يمكنك محاربة أيديولوجية دينية مثل الأصولية، عندما تقوم بتعيلم أعضائها الكراهية ورفض مجتمعنا الغربي؟
وهذا لا يمكنك أن تفعله من خلال التغافل أو التجاهل أوالتعامل مع المشكلة من زاوية نفسية أو اجتماعية فقط. إذا كنا نريد فعلا، أن نكون ناجحين في تقويض وتفكيك الخطاب الذي يهدد مجتمعنا، فيجب علينا أولاً أن ندرك أنها تتعلق بالأيديولوجية، وأنها مرتبطة بالقصة الدينية ونمط التدين، كذلك. فقط عندما نعترف بأن المشكلة أيديولوجية ودينية بطبيعتها، يمكن أن ينمو الوعي بأن حلها سيتعلق أيضًا بالدين والتعامل مع المشكلة بطريقة بأخرى، بغض النظر عن ما مدى صعوبة وظيفة الدين والتدين في فهم ذلك في الزمان (العلماني) أو الزمان ما بعد العلمانية.
[1] عضو البرلمان البلجيكي الفيدرالي.
[2] باحث في المركز الدولي للأبحاث وحقوق الإنسان في بروكسيل.
[3] هو نهر طوله (12) كم، يوجد في مدينة أنفرس ويصب في الأنهار التي تصب وتتواصل مياهها إلى بروكسيل .
[4] Beleidsnota rond sociale overlast, (28//10/03) beleidsnota van de gemeente Boom. Voor het volledige verhaal zie Peter Calluy, etc. p.29
[5] Ibid ,Pieter Calluy.
[6] European Parliament resolution of 4 February 2016 on the systematic mass murder of religious minorities by the so called ‘ISIS/Daesh ‘ (2016/2529(RSP)).
[7] Zie ook Salafisme is de oorzaak,terrorisme het symptoom ‘ ,Koen Metsu & Nadia Sminate, 6/05/19 op doorbraak.be
[8] Zie ROY, p44