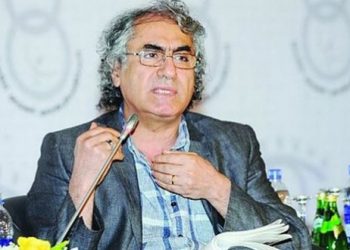عمر البشير الترابي*
ظهور داعش، مثّل علامة معيارية لدارسي الإرهاب. استغلها المناوئون لأمريكا؛ وسياستها الخارجية وآلياتها لمكافحة الإرهاب، معتبرين تمدد داعش في العراق، دليلاً كافيًا على فشل المشروع السياسي الأمريكي لنشر الديمقراطية من جهة، فسياسات المالكي في نظرهم، كانت خير داعم لتشيؤ الفعل الإرهابي وتطوره، وتفريغ المواطن العراقي من إحساس الدولة، وتعزيز الانكفاء نحو الهويّة الدينية بسبب التطييف والتطفيف وسوء التدبير الاجتماعي والتهميش، كما أنّ التنمية السياسية غير المتكافئة والإدارة الكيدية أدتا لانحراف داخل الفعل العنيف؛ فحدث الخلط بين المقاومة لتحرير العراق والقتال لإنشاء دولة جديدة داخل العراق. ومن جهة أخرى، فإنّ فشل سياسة مكافحة الإرهاب، ضمنت تدفق المعينات المالية لبناء “الجسم الإرهابي الأخطر”، للعرق، متمثلاً في داعش.
ظلت الجهود الأمريكية لأعوام طويلة محل تقييم متنازع، فأخذ عليها أنّها تحوم حول مكافحة الفعل النهائي للإرهاب فقط، كالعناية بالمتفجرات والتفجير وغيرهما، ومراقبة الوسائط المالية الضالعة في العمليات الميدانية، دون تتبع حقيقي للحواضن التي تنبني عليها هذه العمليات، من جماعات سياسية داعمة، ومدارس فكرية مفرّخة، وأحزاب دينية مستفيدة. وتتجاهل الربط بين “الأزمات” الكبرى في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى أنها مع بداية الربيع العربي، اعتبرت الحرب على الإرهاب في حكم المنتهية، فنظّرت لأفول القاعدة؛ خاصة بعد وفاة بن لادن، ربما لتسجيل انتصارات على ورق. كل هذا جعل الانتقادات، تتحول إلى تمنيات بظهور قطب مختلف يكافح الإرهاب، بشكل أرجى. روسيا، كانت الإجابة المكتومة، وآن وقت انفتاحها لتظهر على الخارطة اليوم بوصفها، صاحبة رؤية بديلة، وتسوّق نفسها على أنّها ظلّت تحارب الإرهاب، منذ “أفغانستان”، على عكس أمريكا التي رعت تفويج الأفغان العرب –في نظر الروس.
يصر مسوقو الرؤية البديلة هذه، على أن التجربة لا تنتمي لركام الحرب الباردة، وتعافت من انهيار الاتحاد السوفيتي، والحرب الشيشانية. بيد أن البعض يربط الرؤية الجديدة بالعقيدة الروسية الجديدة في السياسة الخارجية، وهي التي ترفض سيطرة قطب أحادي على النظام العالمي، كما أنها تحمل تخوّفًا من إمارة القوقاز الإسلامية؛ التي يستغل بعض أبنائها الأزمة السورية، للتدرب على السلاح والعمل، ويعودون إلى جبالها، وهو ما يشير إليه الروس بقولهم: إنهم يشعرون بأن داعش تهدد روسيا بشكل مباشر. وللشيشانيين في سوريا تنظيم اسمه “جيش المهاجرين والأنصار”، ويقدر عددهم بما بين (400) إلى (700) مقاتل، أغلبهم قدموا من وادي بانكيسي، شمال شرقي جورجيا، وقسم قليل جاء من الشيشان التي تحكم بجهاز أمني قوي من قبل قاديروف. ينقل مراد بطل الشيشاني عن هؤلاء المقاتلين قولهم: “نشعر بالخجل من وجودنا في سوريا والقوقاز محتلة، ولكن الشبان يعودون بعد أن يتدربوا. أحد الرفاق أنهى دورة المتفجرات وذهب إلى الجبال مباشرة(…) وبهذا المعنى فإن الإمارة مستفيدة بشكل كبير من ذهاب الشباب إلى سوريا، فهم يعودون كوادر جاهزين”.
سياسة الاحتواء؛ الروسية، نجحت في ترسيخ صورة الإسلام داخل روسيا على أنّه أحد عناصر الأمة، وفرغت جزءًا من العاطفة الشعورية بالاضطهاد التي خلقت خلال سنوات طويلة، والتي يستثمرها الإرهابيون على مدى التاريخ. ومن ضمن ذلك كان افتتاح المسجد الكبير في موسكو خلال أيام عيد الأضحى كهدية للمسلمين بروسيا. ولكنّ ذات الحدث –افتتاح المسجد- بضيوفه الدوليين، دفع البعض إلى التخوّف من أن تقع روسيا في ذات الخطأ الذي وقعت فيه أمريكا، باختيار الحلفاء الخطأ في حربهم ضد الإرهاب.
أوروبا اليوم، أصبح المهاجرون على أبوابها، ولم يعد التخوّف من عودة آلاف الإرهابيين الأوروبيين في صفوف داعش فحسب، بل من موجة الهجرة غير المنتخبة، فاندفعت لإجراءات عاجلة لوقف الأزمة المولدة للإرهاب، وتراهن على أنها ما دامت اضطرت للتقارب مع إيران لتحقيق مصالح محتومة، فليس هناك ما يمنع من تحقيق تقارب مع الرؤية الروسية للأزمات في الشرق الأوسط، والدول المجاورة لسوريا صارت تدرك أن حل الأزمة الداعشية، يحتاج إلى موقف مختلف حيال حلفاء روسيا في المنطقة. كل هذا يقود لولادة موقف جديد ضد الإرهاب، وربما حول المسألة السورية.
التفاؤل بالدور الروسي، ببعديه الأمني والثقافي، له مبرراته، في ظل المقاربة الصارمة التي ينتهجها فلاديمير بوتين، والاستشراق الروسي المتطرّف تجاه السلفية المتشددة، والاعتماد على ترسانة استخباراتية مهمومة بالمنابع. ولكن المؤكد أنّه لا يستطيع –لا هو ولا غيره- أن يقوم بدورٍ حاسم وحده، دون التنسيق مع الجانب الآخر، الأمريكي، والشرق أوسطي، إذ ينبغي ألا يتم التفاؤل بأي جهدٍ أحادي، لأنه لن ينجح.
* باحث سوداني، عضو هيئة التحرير في مركز المسبار للدراسات والبحوث.