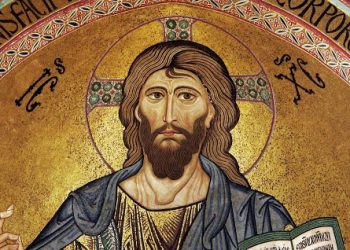تعريف بجامعة هلسنكي
تصنّف جامعة هلسنكي ضمن الجامعات العشر الأولى في أوروبا، وتنتمي أيضا إلى قائمة الجامعات المئة الأفضل في العالم، وقد خرّجت سنة 2009 عددا من الدكاترة الجدد يبلغ 470 دكتورا، وتضمّ في طاقمها حوالي 4000 باحث ومدرّس، كما تضمّ حوالي 35 ألف طالب، وتمنح الفرصة لحوالي 30 ألف كهل لمتابعة دروس التكوين المستمرّ بموازاة نشاطاتهم المهنية، وهي أكبر جامعات فنلندا وأقدمها.
تقع جامعة هلسنكي جغرافيا بين السويد وروسيا، ويمنحها هذا الموقع طابعا دوليا ودورا في الحوار بين الأديان. وقد تولّى تأسيسها سنة1640 بياترا براه (Pietari Brahe) وكانت تدعى «الأكاديمية الملكية»، ومقرها الأصلي ليس هلسنكي، وإنما مدينة توركو (تنطق آبو باللغة السويدية) التي كانت في ذلك العهد عاصمة فنلندا. بعبارة أخرى، لم تكن فنلندا دولة مستقلة آنذاك وكانت تتعايش على أرضها ثقافتان: الثقافة الفنلندية والثقافة السويدية. بيد أننا نشير إلى أن اللّغة المستعملة في الفضاء العلمي كانت اللاتينية، مثل باقي المجتمعات الأوروبية.
خضعت فنلندا ابتداءً من سنة 1809 إلى الاحتلال الروسي ثم أصبحت ولاية مستقلة ضمن الاتحاد الروسي وتمّ سنة 1828 تحويل مقرّ الجامعة إلى هلسنكي لأسباب سياسية، وأصبحت تدعى «الجامعة الإمبراطورية للإسكندر»، وقد أثرت روسيا في الثقافة الفنلندية من خلال لغتها وديانتها المسيحية الأرثوذكسية، وشمل هذا التأثير جامعة هلسنكي أيضا وتواصل مدّة قرن. واستغلت فنلندا الثورة الروسية سنة 1917 لتحصل على استقلالها، أما جامعتها فقد انتظرت سنة 1919 لتحصل على مكانتها في الجمهورية الفنلندية الجديدة.
حدث أهم مستجدّ في الجامعة سنة 2010 إذ تحرّرت من مراقبة الدولة وأصبحت مستقلة. ولئن كانت أهمّ موارد الجامعة حكومية المصدر، فإنّ الجامعة أصبحت قادرة على تنمية علاقاتها بمكونات المجتمع الفنلندي والوسط الاقتصادي وطلب تمويلات خارجية، بل أصبحت مدعوّة إلى القيام بذلك. وقد منحها هذا التغيير حرية أكبر (هذا شأن الجامعات الفنلندية عامة) ومنحها خاصة شعورا أكبر بالمسؤولية، وضرورة أن تحسّن طرق تصرفها فيما يتاح لها من موارد. وعليه، فإلى جانب الوظيفتين التقليديتين التي تتميز بهما كل الجامعات في العالم، أقصد: البحث والتدريس، يتوافر اليوم قطب ثالث في جامعة هلسنكي هو التفاعل مع المجتمع. لاشكّ أن التفاعل الجيّد مع المجتمع يمنح فرصا أكبر للتواصل وحظوظا أوفر للحصول على التمويلات لصالح الجامعة. وفي الوقت نفسه يستفيد المجتمع بطريقة أفضل من وجود الجامعة التي توفّر له متخصصين أفضل كفاءة وتدربا في مختلف الميادين، يمكن أن يمارسوا دورهم المهني مع المشاركة في صنع القرارات الكبرى التي تهمّ المجتمع. ويمكن أن يسهموا في النقاش العام بفضل ما يتوافر لديهم من معلومات، كما يمكن لهم أن يعرضوا المعرفة العلمية على الجمهور الواسع. ويمكن أن يسهموا في بناء دولة راعية أكثر عدلا وأفضل تسييرا بأن يساعدوا في المحافظة على التراث الثقافي الوطني، وهياكل التدريس في ما يدعى بـ«العالم في طريق النموّ».
فنلندا بلد صغير اضطر مواطنوه دائما إلى تعلّم لغات وثقافات أجنبيّة، وتاريخ هذا البلد يجمع الكثير من المؤثرات الثقافية والدولية. وهو مصرّ على العيش بسلام مع الجميع، ناهيك عن أنه تحصّل سنة 2008 في شخص رئيسه السابق مارتي أهتــساري (M. Ahtisaari) (على جائزة نوبل للسلام، وكذلك نشير إلى الدور المهمّ الذي اضطلعت به قوات حفظ السلام الفنلندية في عمليات الأمم المتحدة. بيد أن دور جامعة هلسنكي في حوار الأديان والثقافات ظلّ أقلّ بروزا. توجد طبعا علاقات ومقترحات مشاريع في هذا المجال بين الجامعة وأطراف دولية، ويوجد ضمن هيئة التدريس أساتذة أجانب. لكن لا توجد مادة للدراسة والبحث تختص بحوار الأديان، بل لا يكاد يوجد شيء حول الحوار عموما، وقد توصلت من خلال البحث على موقع الجامعة الإلكتروني إلى مشروع بحثي واحد طرح مؤخرا في كلية اللاهوت يدور موضوعه حول الرم. ولا وجود داخل الجامعة لباحث يقدّم نفسه بصفة المختص في الحوار بين الأديان، وثمة لاهوتيان يتقدمان بصفة المهتمين بحوار الأديان، أحدهما يدرّس اللاهوت والثاني يدرس علم الأديان.
الحوار بين الأديان
لا بدّ أن نحدّد أوّلا معنى الحوار بين الأديان قبل الخوض فيه. الحوار مفهوم مركزي ضمن الأديان والثقافات، بيد أن كلمة «حوار» تتضمن مع الأسف غموضا كبيرا، وتحتوي العديد من المواقف والأفكار المسبقة. ويترتب على هذا الغموض لبس في تحديد أهداف الحوار ومساراته. فالاستعمال العادي يطلق كلمة «الحوار» على قضايا متعدّدة في سياقات مختلفة. والمعنى الأكثر استعمالا للكمة يرتبط بالتواصل المتبادل، أي حصول تبادل شفوي أو مكتوب بين شخصين أو أكثر، وإلى هذا المعنى يحيلنا جذر الكلمة في اللاتينية. وهناك تاريخ طويل للحوار المكتوب بين الأديان والفلسفات، أبرزها في التاريخ الغربي محاورات أفلاطون والطرق التعليمية المنسوبة لسقراط، وهي محاورات قائمة على تبادل الأسئلة والأجوبة. وتجدر الملاحظة أن الحوار لا يحصل في هذه الحالة بين شخصين متساويي القيمة، وإنما يحصل بين معلّم حاصل على المعرفة وشخص يتلقى عنه المعرفة، أي إن الأوّل أعلى شأنا من الثاني. ولا تقتصر هذه الظاهرة على الغرب؛ إذ نجدها في التراث اليهو-مسيحي. وفي التراث الهندي أيضا، ولعلّنا قد ورثنا هذه الوضعية أيضا في كثير من الأحيان في حوارات الأديان والثقافات اليوم. فالفكرة القائمة في هذه الحالة فكرة بسيطة تتمثل فيما يلي: يتقدّم شخص حاملا المعرفة ويقوم بعرضها ونشرها ثم ينتهي دوره بعد ذلك ولا يتقبّل شيئا من الآخر.
أمّا الحوار بالمعنى الحديث، فيستمدّ جذوره من مصدرين أساسيين: الشخصانية اليهو-مسيحية من جهة، والإشكال المنهجي والوجودي للآخر كما طرحه الكوجيتو الديكارتي من جهة أخرى([1]). هذان المصدران قد طبعا الثقافة الحوارية في الغرب منذ القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين. وقد نشرت فلسفة الأنوار فكرة الحوار في أوروبا الغربية وبصفة خاصة من خلال فلسفة الأديان (راجع مثلا استعارة الخاتم الواردة في كتاب «ناتان الحكيم» للسينغ الصادر سنة 1779). وقدّم ثلاثة فلاسفة تصورات جديدة للمخاطب «أنت» في ظل الفلسفة الوجودية وهم إبنر (F.Ebner) في كتاب صادر سنة 1921 وروسنزويغ (Rosenzweig) في كتاب صادر سـنة1921 أيضا(M. Buber) في كتاب صادر سنة 1923. لقد بادر روسنزويغ بإقحام العقيدة والطقوس اليهودية ضمن دراسات اللغات وأقحم بوبر مفهوم «البين» بصفته مفهوما للحدث يتضمن معاني في إطار حرية متبادلة، كما أنه ميّز بين الفرديّة والشخص. وبصفة عامة، لقد رأى هؤلاء الفلاسفة المنتمون إلى التيار الشخصاني أن الثقافة الحوارية تمثل مبدأ أخلاقيا وبيداغوجيا([2]).
ينتمي الحوار بأطرافه إلى وضع «بيني» تقترب فيه المواقف بين الأشخاص، أي وضع اشتراك بين حس هذه الأطراف. وعلى هذا الأساس، يحدّد الحوار موقف الناس المنتمين إلى ثقافات أو أديان أو ثقافات مختلفة. وينفي الشعور بالتفوق لدى بعضهم أو شعور بعضهم الآخر بإطلاقية مواقفهم والسعي إلى إقناع الآخرين بها، وتحلّ محلّ ذلك الرغبة في التعلّم من الآخر مع الاحتفاظ بقناعاته الخاصة. وغالبا ما نرى أن الهدف الرئيس للحوار يتمثل في تمكين المشاركين من أن يتعلموا من بعضهم البعض، مما يعني أن الحوار يقوم على قبول مخاطرة تغيير الرأي. لذلك يقال: إنّ الحوار يحمل قيمته في ذاته([3]).
كيف يمكن حينئذ أن نعرّف الحوار بين الأديان؟ هناك العديد من الطرق للقيام بهذا التعريف، وتعدّد الطرق مؤشر على صعوبة هذا التعريف([4]). هناك تعريف يقول: «إن الحوار بين الأديان لقاء بين شخصين أو مجموعتين ينتميان إلى تقليدين دينيين مختلفين، وإن كل طرف يلتزم بدينه ويبحث عن إثراء رؤيته الدينية وتعميقها وتوسيعها عبر فهم متبادل لعقيدة الآخر، والانصياع للحقيقة في إطار احترام الحريات، وعبر تقبّل شهادة الآخر على تجربته الدينية. فالحوار جهد إيجابي يهدف إلى التوصل إلى فهم أكثر عمقا للحقيقة من خلال وعي بالقناعة المتبادلة وقبول كل طرف لشهادة الآخر»([5]).
ومن المعلوم أنّ الكنيسة الكاثوليكية بعد مجمّع فاتيكان الثاني (1962-1965) قد انخرطت في الحوار بين الأديان بفضل القرارات المجمعية الصادرة آنذاك. وشرعت منذ ذلك العهد باعتبار الحوار عملا إيجابيا ووجها من احترام الآخر. ويؤمن المنخرطون في هذا الحوار بوجود طريقة للتدرج في معرفة الواقع وبلوغ الحقيقة»([6]).
وقد أصدر الفاتيكان سنة 1984 وثيقة عنوانها «موقف الكنيسة الكاثوليكية من عقائد الأديان الأخرى» ([7]) وتبرز أهمية هذه الوثيقة في كونها تعرض لأوّل مرّة في وثيقة كنسية رسميّة تعريفا لكلمة «حوار»، فتعتبره «أسلوب عمل وموقفا وروحا يوجهان السلوك»([8]). وتعلن الفقرة الثالثة من هذه الوثيقة أنّ الحوار «لا يعني مجرّد تبادل الحديث فحسب، لكنه يعني مجموع العلاقات بين الأديان وما هو إيجابي وبناء في هذه العلاقات بين أشخاص ومجموعات مختلفة العقائد، تسعى إلى التعرّف على بعضها البعض وإثراء التجارب المختلفة» ([9]). ولا بدّ أن يختبر الشخص الحوار ليضع له حدوده ويتبيّن قدراته الذاتية للمضي في هذا الحوار([10]) فلا يمكن تحديد قدرة الذات إلا من خلال العلاقة بالآخر.
وتتضمن الفقرة 13 من الوثيقة المذكورة أن الحوار جزء من مهام الكنيسة: «هناك حوار هدفه التقاء المؤمنين المسيحيين بتقاليد دينية أخرى، كي يسلك الجميع طريق البحث عن الحقيقة ويتعاونوا في أعمال ذات نفع مشترك»([11]). ثم تعرض الوثيقة أربعة أشكال من الحوار، أولها «حوار حياة»، أي لقاء يوميا في وضعية تعدّدية تعيش من خلالها مجموعة من الأشخاص تجربة التبادل المنفتح ومقاسمة أفراحهم وأتراحهم ومشكلاتهم الإنسانية وهمومهم الوجودية. وربما كان هذا الشكل الحواري هو الأكثر انتشارا. وهو يمكّن من اختبار التعددية الدينية بصفة ملموسة ومن خلال الحياة اليومية. ويتعيّن أن يكون هذا الحوار مفتوحا ومتاحا أمام الجميع (الفقرتان 29 و30). أما الشكل الثاني من الحوار فهو المتعلق بأعمال أو التزامات مشتركة من أجل دعم العدالة، يشترك فيها أشخاص ينتمون إلى أديان مختلفة، ويتفقون على قيم العدل أو التنمية الشاملة أو تحرّر الشعوب (الفقرتان 31 و31). أما الشكل الثالث فهو حوار المتخصصين ويتمثل في التبادل اللاهوتي أو الحوار بين الثقافات (الحوار الأكاديمي)، ويعمل متخصصون على تعميق فهمهم للتقاليد الدينية لبعضهم البعض، كي يثمنوا القيم الروحية لبعضهم البعض، ويطوّروا الاشتراك والأخوّة (الفقرتان 33 -34). أخيرا، يتمثل الشكل الرابع في حوار التجارب الدينية أو الحوار الروحي بين الأفراد مع تجذر كل فرد منهم في ديانته الخاصة، ويكون محور الحوار هنا تبادل تجاربهم الدينية وإثراءها، مثل الاشتراك في الصلوات والتأملات والإيمان وطرق البحث عن الإله أو البحث عن المطلق([12]).
لا استغناء عن الحوار بين الأديان لإقامة العلاقات بين البشر وتوضيح الاختلافات بين الأديان، ذلك أنه توجد مواقف وأفكار مسبقة رسختها المجادلات اللاهوتية منذ عدة قرون، ولا يمكن للحوار أن يتجاهل ما تركه الماضي من كراهيات وانغلاق على الذات وسوء فهم([13]). ونحتاج إلى الحوار كي ننمي العلاقات بين الأفراد والمجموعات، والحوار هو الذي يوقف شطط الأديان ويحرّر الأفراد من شعورهم بالخوف من الآخر. ويمكن للحوار أن يرسّخ إيمان كل مؤمن؛ لأن الاحتكاك بالآخر يدفع إلى مزيد تعميق التفكير في الإيمان الذاتي. فإذا نجح الحوار في التقريب بين الأديان، وخاصة الإسلام والمسيحية وهما أكبر الأديان في العالم([14])، فبالإمكان أن يصبحا أهمّ بناة وحدة العالم.
بيد أنّ الحوار بين الأديان ليس سهلا وتتخلله الكثير من العوائق. وثمة وثيقة أخرى للفاتيكان صدرت سنة 1991 بعنوان «الحوار والبشارة» عرضت أحد عشر عائقا (الفقرة 52) : 1- تجذر غير كاف في الإيمان. 2- معرفة غير كافية لعقائد الأديان الأخرى وممارساتها. 3- الاختلافات الثقافية واللغوية. 4- العوامل الاجتماعية – السياسية وبعض مخلفات الماضي. 5- سوء فهم للمفردات المستعملة في الحوار. 6- اعتداد بالذات ورفض الانفتاح. 7- قلة الاقتناع بقيمة الحوار بين الأديان. 8- عدم التسامح ورفض مبدأ المعاملة بالمثل. 9- التشكك في الدوافع الحقيقية للمشارك في الحوار. 10- غلبة روح الجدل. 11- بعض معالم المناخ الديني الحالي (مثال: تنامي الروح المادية، اللامبالاة الدينية، تكاثر النحل بما يحدث الخلط ويطرح مشكلات أخرى)([15]).
ليس مهمّا أن نسهب في التعريف أو التصنيف، فهناك معالم عامة مشتركة بين أشكال الحوار، ويبدو أن الأديان قد كانت المسلك الأكثر اعتمادا للتعاون وتحسين العلاقات والاستفادة من الآخر ورفع سوء الفهم، ونذكر في هذا المجال الحوار الإسلامي – المسيحي، فقد كان دافعه الأوّل البحث عن العدالة الاجتماعية والقيم الأخلاقية والسلام في العالم، ولقي استجابة من الطرفين: المسيحي والإسلامي، وكان واضحا في تحديد أهدافه. فالجانب المسيحي ينفي وجود أي تردّد في مجال محاورة آخرين من أديان مختلفة أو ثقافات أخرى، لكنه لا ينفي إمكانية ظهور اختلافات بشأن الانتظارات التي قد تتجاوز أحيانا الأهداف المعلنة والمقبولة لممارسة الحوار([16]). وتعود المسألة الأخيرة إلى ضعف الطبيعة المنهجية للحوار بين الأديان، فهي في الغالب قائمة على الاختبار والممارسة ومنطلقة من الواقع المعيش اليوم، ومن مجموعة من النتائج الحسيّة المقتبسة من المبادئ العامة: «نبدأ بالممارسة –البراكسيس – في الحوار بين الأديان وبين مختلف التقاليد، كما يعيشها كل طرف من خلال إيمانه، ثم ننتقل إلى التفكير اللاهوتي حول العلاقة بين هذه التقاليد، إلا أنه تفكير يظل مطروحا في درجة ثانية»([17]). ونقطة الضعف هنا تتمثل في كون هذا الحوار قد يظل قليل الفائدة كثير التردّد ولا يتقدم نحو مزيد التعمّق([18]).
الأديان تبني السلام
لئن تميّز الحوار بين الأديان بكل المزايا التي عرضنا، فإن دور الجامعات لا يمكن أن يقتصر على القيام بأبحاث حول الأديان، والنظر إلى الأديان على أنها أشياء خاضعة للمراقبة من الخارج، من دون أن تكون قادرة على الخروج بالاستنتاجات المطلوبة. لا بدّ أن تعي الجامعات أنّ الرهانات التي تطرحها الأديان في غاية الأهمية والعجلة بالنسبة إلى العالم. لقد نشر اللاهوتي الكاثوليكي السويسري هانس كونغ (ولد سنة 1928) كتابا سنة 1990 عنوانه بالفرنسية: «مشروع أخلاقية كونية: السلم العالمي عبر السلام بين الأديان» (باريس، سوي، 1991). وقد اختصر مشروعه في الجمل الثلاث الأولى من الكتاب: «لا تعايش بين البشر من دون أخلاق كونية، لا سلام بين البشر من دون سلام ديني، لا سلام بين الأديان من دون حوار بينها».
لا شكّ أن مشروعه قابل للنقاش منهجا ومضمونا، لكنه مشروع يمكن أن يدفع جامعات العالم كلّه إلى التفكير الجدّي حول الأسئلة التي يطرحها. «لا تعايش بين البشر من دون أخلاق كونية». كيف يمكن تأسيس هذه الأخلاقية وهذه الأخلاق الكونية؟ هل العقل وحده قادر على ذلك؟ نحتاج في هذا التأسيس إلى الوسائل التي توفرها المعرفة الأكاديمية، مثل التفكير والمراقبة الموضوعية والحسّ النقدي المتعاطف، لكن البحث الجامعي غير قادر على تحقيق ذلك بمعزل عن الأديان.
أما الجملة الثانية من مقدمة كتاب كونغ فلعلّها الأكثر خطورة وآنية: «لا سلام عالميا من دون سلام بين الأديان». من المعلوم أنّ الأديان قد شهدت انحرافات عديدة في التاريخ، بيد أنّ الاعتراف بهذه الانحرافات ووصفها كما يحصل في الدراسات الأكاديمية لا يعدّ كافيا، فلئن كانت هذه النقائص تحتاج إلى النقد، فإن للجامعة دورا كبيرا ينبغي أن تضطلع به في هذا المجال، ثم إنّ الجامعات تحتاج بدورها إلى نقد ذاتي تقدمه الأديان ذاتها، بالأخذ بعين الاعتبار ما هو إنساني فعلا وما هو صالح للمنفعة العليا للبشر، فلا دين يمكن أن يعتبر بريئا وخارجا عن هذه المحاسبة.
تحيلنا الجملة الثالثة مباشرة إلى البحث عن ذواتنا: «لا سلام بين الأديان من دون حوار بينها». نشترك جميعا في الترحيب بهذه الفكرة، لكن هل مؤسساتنا مستعدّة للتعرف على العلاقات بين السلم الدينية وحوار الأديان وللاعتراف بأهميتها؟ هل هي قادرة على تشجيع هذا الحوار؟ هل يمكن لها حقا أن تتجاوز العوائق المتمثلة في الأفكار المسبقة والفصل الحادّ بين الدين والفضاء العام في الغرب؟
سبق أن ذكرنا أن جامعة هلسنكي حدّدت ثلاثة مجالات لنشاطاتها وتفاعلها مع المجتمع. وتمثل الأديان عناصر ضرورية في المجتمع الفنلندي، فلا يمكن للجامعات أن تتجاهلها، ولئن كانت أطروحات هانس كونغ قابلة للنقاش، فلا يمكن أن نشكّك في أن تفاعلا أفضل بين الأديان سيكون نتيجة منطقية للعمل الأكاديمي. فلئن كان متاحا تدريس الأديان في كلية لاهوت أو كلية آداب، فإننا لن نجد كثيرا بين المدرسين من يمتلك كفاءة تدريس الحوار بين الأديان والتجربة الضرورية لذلك. ولا يوجد حاليا في جامعة هلسنكي درس مخصص للحوار بين الأديان. لكن ثمة قانون جامعي جديد قد يفسح المجال لهذا النوع من التدريس، إذ إن الجامعة تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة، والاتجاه يميل حاليا إلى كليات أكبر وأقسام أكثر اتساعا، ولكن مع تقليص الطواقم الإدارية. ففي هذا الوضع يصبح جائزا التفكير في دروس مشتركة حول الحوار بين الأديان، وجعل هذه الدّروس إجباريّة لكل طالب، على الأقلّ في كليتي اللاهوت والآداب، وصياغة هذه الدروس بطريقة متعدّدة الاختصاص، هذا ما تفتقده حاليا، فالأديان ينبغي أن تدرس حسب مضامينها.
لكن توجد أيضا عوائق، فالبعض من المدرسين الجامعيين يخشى أن تتحوّل هذه الدروس المعدّة بالتعاون مع لاهوتيين إلى دروس تبشير ودعوة داخل الجامعة، ويخشى آخرون أن تسهم في نشر الصور النمطية تأثرا بما هو سائد في وسائل الإعلام. بيد أن للجامعات دورا مهما يمكن أن تضطلع به على الرغم من هذه العوائق كي تنمي الحوار بين الأديان والثقافات وتسهم في قضية السلام العالمي.
إنه الوقت المناسب للمبادرة، على الأقل بالنسبة إلى جامعة هلسنكي، لأن حوار الأديان يأخذنا حتما إلى حوار الثقافات وقضية السلام في العالم. وفي الوقت نفسه يؤدي حوار الأديان إلى حوار داخل المجتمع. فالاتجاه نحو الخارج ونحو الداخل لا يتعارضان، بل هما متكاملان وضروريان وحيويان، إذا عزمنا على العيش المشترك على كوكبنا من دون أن نفنيه ولا أن نفني أنفسنا.
لنختم بهذا الوصف لوسط مدينة هلسنكي: إذا وجدتم أنفسكم في الموقع المعروف باسم «سينتنتوري» ووجهتم البصر إلى الشمال فسترون على شمالكم المبنى الرئيس لجامعة هلسنكي، وترون أمامكم الكاتدرائية اللوثريّة، وهي أكبر كنيسة في المدينة، ثم ترون على اليمين مبنى الحكومة الجميل. إذا تحاورت هذه المؤسسات الثلاث، فإنها لن تستفيد وحسب، لكنها ستفيد أيضا الجهة الرابعة التي لم نذكرها، ما ترونه وراءكم إذا التفتم وهو بحر البلطيق، أي العالم كله الذي ينفذ إليه النرويجيون عبر هذا البحر، بذلك يتحقق الحوار بين الأديان والثقافات وتعدّد أطرافه.
ريستو جيكو باحث في حوار الأديان من جامعة هلسنكي (فنلندا).
النص معرب من الفرنسية.
المراجع
Basset, Jean-Claude 1996. Le dialogue interreligieux : chance ou déchéance de la foi. Paris : Les éditions du Cerf.
Couvreur, Gilles 1990. La mission comme dialogue. Dans : Aubert, Jean-Marie & Couvreur, Gilles et al. : Mission et dialogue inter-religieux. Lyon : Profac, 175-198.
Daniélou, Jean 1971. Les règles du dialogue. Dans : Axes 4,1, 5-8.
Dhavamony, Mariasusai 1998. Christian theology of religions: a systematic reflection on the Christian understanding of world religions. Bern&Berlin&Frankfurt/M.: Peter Lang.
Le dialogue interreligieux dans l´enseignement officiel de l´Eglise catholique 2006. Documents rassemblés par Mgr Francesco Gioia. Solesmes : Editions de Solesmes.
Dupuis, Jacques 1997. Vers une théologie chrétienne du pluralisme religieux. Paris : Les éditions du Cerf.
Dupuis, Jacques 2000. Interreligious dialogue. Dans: Latourelle, René & Fisichella, Rino (eds.) : Dictionary of fundamental theology. New York: Crossroad, 518-523.
[1] «الشخصانية» تيار فلسفي ظهر في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهو يركز على الشخصية بصفتها القيمة العليا والمفهوم الأساس الذي يمنح المعنى لكلّ واقع، وهو في الغالب تيار إيماني، ومن أبرز رموزه الفلاسفة الفرنسيون رونفييه وبلونديل ومونييه.
[2] بدأ الحوار الحديث بتأثير من اللاهوت الكاثوليكي، راجع كوفرور Couvreur، 1990، ص 178-181 وباسيت، 1996، ص 18-22.
[3] ديبويه Dupuis،2000، ص 520.
[4] مثال: باسيت (1996:313-355) يقسّم الحوار إلى ثلاثة عوامل: شكل/ بنية، طبيعة/ نمط، رهان. راجع خاصة ص 320 و342.
[5] الحوار بين الأديان هو حوار مشترك بين شخصين أو مجموعتين ذات ديانة مختلفة بقصد الإثراء المتبادل والتعرف على طريقة كل منهما في ممارسة دينه، ومعرفة عقيدة أخرى، والخضوع للحقيقة، واحترام الحرية والفكر المختلف، والتعمق في القضايا الدينية. فالحوار جهد إيجابي ينمّي الفهم والحقيقة والتبادل مع الآخرين (دهفموني Dhavamony، 1998، ص 202).
[6] دانيلو، 1971، ص 5-7.
[7] نشر النص الفرنسي في «التوثيق الكاثوليكي» عدد 1880 بتاريخ 2/9/1984، ص 844-849، وفي كتيّب عنوانه «سكريتارية غير المسيحيين»: موقف الكنيسة الكاثوليكية تجاه المؤمنين بالأديان الأخرى، تأملات وتوجهات حول الحوار والتبشير، (موقع الفاتكان، 1984)، ونشر أيضا في: الحوار بين الأديان، 2006، ص 1410-1425.
[8] الفقرة 29 من وثيقة «الحوار بين الأديان»، 2006، 1421.
[9] الفقرة 3 من وثيقة «الحوار بين الأديان» 2006، ص 1411.
[10]الفقرة 21 من وثيقة «الحوار بين الأديان» 2006، ص 1417.
[11] ضمن وثيقة «الحوار بين الأديان»، 2006، ص 1414.
[12] ضمن وثيقة «الحوار بين الأديان»، 2006، ص 1421-1422. ونقرأ في الفقرة 57 من الرسالة الكنسية للبابا يوحنا بولس الثاني ما يلي: «يفتح الحوار مجالا واسعا يمكن أن يشمل تعابير وأشكالا متعددة، منها التبادل بين خبراء في التقاليد الدينية أو ممثلين رسميين عنها، أو التعاون للمحافظة على قيم دينية أو تطويرها أو تبادل الخبرات الروحية المشتركة، وهو ما يعبّر عنه بحوار الحياة، فيتمكن المؤمنون من مختلف الأديان أن يقدموا لبعضهم البعض شهاداتهم من خلال الوجود اليومي، ومن خلال القيم الإنسانية والروحانية، وأن يتعاونوا مع بعضهم البعض لتشييد مجتمع أكثر عدالة وأخوّة» راجع وثيقة «الحوار بين الأديان»، 2006، ص 102. ونلاحظ أن مفهوم الحوار يقترب من الفلسفة الشخصانية.
[13] نجد الأفكار نفسها لدى باسيت (1996، ص 435): «ربما يبرز مع الإسلام تحديدا عسر حوار غير متكافئ بسبب صراعات الماضي والعلاقات بين الأقليات والأغلبيات وصراعات النفوذ في المستوى العالمي، إضافة إلى نزعات التقوقع على الهوية».
[14] بلغ عدد المسيحيين في العالم سنة 2010 حوالي 2292 مليون شخص، وبلغ عدد المسلمين حوالي 1549 مليون شخص.
[15] الحوار بين الأديان، 2006، ص 1484-1485.
[16] راجع باسيت، 1996 ، ص 342.
[17] دوبويه، 1997، 1997، ص 32.
[18] دوبويه، ص 33. وهو محق في ما يقول لأن جوهر القضية علاقة هرمنطيقية.