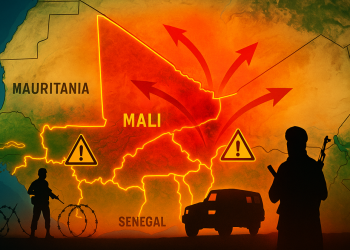حميد زناز [1]
ما هي المكانة التي خُصّ بها الدين الإسلامي في المنظومة التربوية الجزائرية؟ وما أثرُ ذلك على برامج التعليم؟ وما الرهانات والنقاشات الحالية حول البعد الديني للسياسة التعليمية التي انتهجتها الدولة الجزائرية المستقلة؟ وهل صحيح أن المدرسة الجزائرية أصبحت -من جراء تلك السياسة المنتهجة- مصنعاً لتخريج المتطرفين والإرهابيين؟
أثارت مسألة التعليم الديني جدلاً لم يهدأ منذ استقلال الجزائر العام 1962؛ وقد وصل الصراع بين المحافظين والحداثيين إلى أوجه بداية هذه الألفية الثالثة، حينما قررت وزارة التربية والتعليم إعادة النظر في طبيعة هذا التعليم الديني في البلد. رفض الإسلاميون ما تسميه الوزارة «إعادة تنظيم وتطوير التعليم الديني» معتبرين أن السلطة تنوي القضاء الكلي على التعليم الديني في الجزائر، منفذة أوامر خارجية غربية تدخل في إطار محاربة الحركات الإسلامية تحت لافتة «الكفاح ضد التطرف والإرهاب». وقد ثارت ثائرة الإسلاميين عام 2014 حينما نُصّبت على رأس وزارة التربية والتعليم الباحثة الأنثروبولوجية نورية بن غبريط، والتي كتبت منذ مدة في أحد بحوثها: إن المدرسة الجزائرية مصنع لتخريج المتطرفين الإسلاميين. وقد حاولوا استغلال مستواها المتواضع في اللغة العربية، إذ هي مفرنسة التكوين من أجل تشويه سمعتها بنشر دعاية مغرضة تقول بأنها من أصول يهودية[2].
حاولت السلطة، منذ البداية، إقناع الرأي العام ورجال التعليم وأولياء التلاميذ -على وجه الخصوص- بضرورة تجاوز التعليم الديني الكلاسيكي العتيق المرتكز على التلقين والنقل واستبداله بتربية إسلامية جديدة تعتمد على المعرفة والعقل، بعيداً من الأيديولوجيا الدينية بغية تطوير كل المنظومة التربوية لتتماشى والمستجدات البيداغوجية بشكل خاص والتطور الحاصل في كل المجالات. لكن لم ير الإسلاميون والمحافظون في المشروع الإصلاحي الوزاري سوى محاولة من طرف السلطة القائمة لضرب الهوية الإسلامية للبلد بدعوى الحد من ظاهرة التشدد الديني.
فما مصير هذا الإلغاء للتعليم الديني بالطريقة التي كان موجوداً عليها سابقاً؟ هل هو ظرفي أم هو «لا رجعة فيه» كما صرح –آنذاك- أحمد أويحي، رئيس الحكومة السابق؟
لا يخفى على أحد أن هذا الصراع الجزئي هو جزء لا يتجزأ من صراع شامل، هو ذلك الدائر بين رؤيتين متعارضتين بشأن طبيعة الدولة المرجوة في الجزائر: دولة مدنية أم دولة دينية. وإلى يومنا هذا لم تحسم المسألة بعد. سنحاول عبر هذه الصفحات العودة إلى أصل الخطاب الديني في المدرسة الجزائرية، وإلى أين وصل الصراع حول هذا الخطاب؟ وكيف انعكس ذلك على أرض الواقع التربوي في البلد؟
المدرسة بين التديين والتسييس
دارت فلسفة كل الإصلاحات التربوية في الجزائر منذ الاستقلال حول محاولة بناء صرح أيديولوجي يهدف إلى التوفيق بين خيارات اجتماعية وسياسية (كالاشتراكية والتعريب ثم الدمقرطة…)؛ وقيم الدين الإسلامي المقدم على أساس أنه الجامع المؤسس لكيان الشعب الجزائري. وكان القصد هو وضع الجزائر على سكة ما كان يسمى في الأدبيات الثقافية- السياسية بـ«الأصالة والمعاصرة»[3].
عاشت المنظومة التربوية في الجزائر تحت ضغط تاريخي ورهانات اجتماعية وسياسية كثيرة؛ أهمها محاولة المسيرين الجدد للجزائر المستقلة إرساء شرعية سياسية عبر تعميم التعليم وتكوين شعور وطني بهدف امتصاص الخصوصيات الثقافية إلى أقصى مدى. كانت المدرسة -وما زالت إلى اليوم- القناة التي يُعوّل عليها النظام القائم في تمرير الأيديولوجية التي يريد فرضها على البلد، وتُعول عليها المعارضة –أيضاً- من أجل فرض بديل أيديولوجي آخر. وفي مجتمع تنعدم فيه الديمقراطية، ودولة تستعمل الماضي كوسيلة من أجل إطفاء الشرعية على وجودها، تحولت المدرسة إلى ساحة صراع أيديولوجي وثقافي بين السلطة والمعارضة، وحتى بين الكتل المتصارعة داخل النظام ذاته. سنة 1970، أي بعد (8) سنوات من استقلال الجزائر، تم تنصيب السيد أحمد طالب الإبراهيمي[4] رئيساً للجنة وطنية كُلّفت بإعادة هيكلة التعليم في الجزائر، وقد قيّد في تقريره عدداً من القِيم الأساسية التي ينبغي أن تتأسس عليها المنظومة التربوية في الجزائر المستقلة، كانت على النحو التالي: «لقد سجلنا أن الإسلام هو قيمة القيم في الحياة الجزائرية، وأن القيم الأخرى لا تستمد أهميتها ووجودها والاحترام الذي تتمتع به سوى بمدى انسجامها مع الدين الإسلامي»[5].
تم بالتدريج إدخال تعليم اللغة العربية، وجزأرة (جعلها جزائرية) محتوى بعض المواد الدراسية التي لها علاقة بالهوية الوطنية؛ التي بدأت تتبلور وتظهر ملامحها شيئاً فشيئاً بعدما حاول الاستعمار طمسها. ومسّت أول التغييرات في نظام التعليم الموروث عن العهد الاستعماري مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة والتربية المدنية والتربية الإسلامية. وهكذا باتت المرجعية العربية الإسلامية تشتغل كوعاء هوية أساسي، كأول الثوابت المكتسبة من طريق الثورة التحريرية. وأصبح هذا «الثابت» قميص عثمان الذي يرفعه المحافظون كلما ظهرت محاولة تجديد أو تغيير في فلسفة التربية والتعليم في الجزائر. وربما هذا المسار التاريخي الخاص الذي مرت به الجزائر هو الذي عقّد الأمور، وباتت علاقة المدرسة بالدين من القضايا المربكة والشائكة.
ولمعرفة خلفيات ما يحدث اليوم، سنقدم نظرة تاريخية سريعة عن التعليم الديني في الجزائر أثناء الوجود العثماني، ثم إبان فترة الاستعمار حيث عاش هذا التعليم أزهى فتراته مع مدارس جمعية العلماء المسلمين، إذ أسهم -بقسط كبير- في المحافظة على الشخصية الجزائرية العربية الإسلامية، ثم نصل إلى فترة ما بعد الاستقلال والكيفية التي تعاملت بها السلطة مع التعليم الديني.
الحياد العثماني
لم يول الأتراك العثمانيون اهتماماً كبيراً بمجال التربية والتعليم في الجزائر؛ ولم تكن لهم أدنى مؤسسة رسمية تهتم بأمر التكوين. لقد تركوا المجال حراً للجزائريين في إقامة ما يريدون من المؤسسات الدينية والتعليمية كالمساجد والزوايا التي يتعلم فيها الجزائريون اللغة العربية وحفظ القرآن ودراسة علومه المختلفة. وعلاوة على المسجد والزاوية، أسس السكان الأصليون مدارس في كل المدن والقرى. ويعترف الجنرال «فاليزي» عام 1834 بأن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل الاحتلال الفرنسي؛ إذ «معظم العرب (الجزائريين) كانوا يعرفون القراءة والكتابة لأن المدارس كانت منتشرة في أغلبية القرى»[6]. وهو ما ذهب إليه «ديشي» الذي كان مشرفاً على التعليم العمومي في الجزائر، حينما اعترف بأن المدارس كانت مجهزة بشكل جيد في مدينة الجزائر وفي المدن الداخلية، وحتى بين أوساط القبائل. وكانت تزخر بالمخطوطات ويتقاضى المعلمون أجورهم من واردات المساجد. ففي كل مسجد كانت هناك مدرسة يجرى فيها التعليم مجاناً[7].
التعليم الديني في مواجهة الاستعمار
كانت المدارس والكتاتيب منتشرة والتعليم يسير على قدم وساق -كما سبق ذكره- ولكن مارس الاستعمار الفرنسي سياسة فَرنَسة وتجهيل من أجل طمس هوية الشعب الجزائري العربية والأمازيغية؛ بغية تسهيل ضم البلد نهائياً إلى فرنسا. واتبع في سبيل الوصول إلى ذلك أسلوبين: محاربة اللغة العربية، وإنشاء المدارس الفرنسية. ومُنع فتح المدارس العربية وخصوصاً منذ صدور قانون 18/10/1892 الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية، ولا تسلم تلك الرخصة إلا بعد التأكد من حسن نية صاحب الطلب، وإن حصل فلا يسمح بقبول إلا عدد قليل من التلاميذ. وفي 1904 صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة من السلطات الفرنسية، وإن حدث فيمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها.
كانت الغاية هي إلحاق الجزائر بفرنسا أرضاً وسكاناً. وقد تحمل الجزائريون كل الصعاب وتقوقعوا واحتضنوا تراثهم المتمثل –أساساً- في اللغة العربية والدين الإسلامي، إلى أن بدأت علامات النهضة الثقافية تبرز إلى الوجود مع مطلع القرن العشرين. وبرز منهم علماء دين تزعموا حركة نهضوية بسيطة، وشيئاً فشيئاً أنجبت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» التي أسست معاهد للتعليم الديني واللغة العربية، وتزعم الجمعية الشيخ عبدالحميد بن باديس، والشيخ البشير الإبراهيمي، وكان للجمعية فضل كبير في المحافظة والدفاع عن الهوية الجزائرية في بعدها العربي الإسلامي خصوصاً.
مدرسة من أجل استرجاع الهوية
بدأت مع استقلال الجزائر سنة 1962 مباشرةً التنازلات لصالح المحافظين، حيث قدمت لهم التربية الوطنية على طبق من ذهب، لأسباب كثيرة سنتطرق إليها لاحقاً.
وقد كان أغلب وزراء التربية -منذ استقلال البلد- ذوي اتجاهات إسلاموية واضحة، انعكست على التعليم عامة وعلى التعليم الديني بوجه خاص. وقد كان في الجزائر وإلى غاية بداية الثمانينيات تعليم ديني موازٍ في المرحلتين الإعدادية والثانوية، كان يسمى «التعليم الأصلي»، بالإضافة إلى تعليم ديني آخر كانت تقوم به الزوايا. وربما أكبر خطأ ارتكبه دعاة الحداثة في الجزائر، هو عدم إعطاء أهمية كبرى للتربية والتعليم في صراعهم مع المحافظين، حينما احتفظوا بتسيير الاقتصاد وتركوا المدرسة بين أيدي المحافظين الإسلاميين. بل أكثر من ذلك، لقد سمحوا بوصول أعداد هائلة من الإخوان المسلمين في بعثات ليدرسوا في الجزائر، وهو ما يرى فيه بعض الباحثين الجزائريين قنبلة موقوتة وهدية مسمومة قدمها الرئيس جمال عبدالناصر للجزائر بمناسبة استقلالها؛ إذ سهّل انتقال الإخوان المسلمين إلى الجزائر ليتخلص منهم، فبثوا فكرهم بين الشبيبة الجزائرية طيلة أكثر من (20) سنة، ولا يزال تأثير فكرهم قائماً إلى اليوم.
كان الدين الإسلامي حاضراً في المدرسة الجزائرية عبر مادة «التربية الإسلامية» المقررة في كل أطوار التعليم الإجباري. ثم استمرت هذه المادة كاختصاص أو شعبة من شعب التعليم الثانوي هي شعبة «الآداب والعلوم الإسلامية». أما في ما يخص التعليم العالي، فهناك جامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة، وكليات علوم إسلامية أخرى.
منذ الاستقلال، أدمج تعليم تعاليم الإسلام في مادة التربية الأخلاقية والمدنية، وابتداء من إصلاح 1976 الذي تم فيه اعتماد تعليم قاعدي إجباري مدته (9) سنوات، كانت فيه مادة التربية الإسلامية إجبارية على جميع التلاميذ.
تحت ضغط طلب التمرس المتواصل نتيجة لما كان يسمى في البداية بـ«ديمقراطية التعليم»، اضطرت الإدارة التربوية إلى توظيف المعلمين على نطاق واسع. وفي الحقيقة، كانت كفاءة أغلبهم دون المستوى المطلوب، بل منعدمة أحياناً. وربما لهذا السبب أطلق عليهم اسم «مُمرنون» بدل «معلمون». ولم يكن يتعدى مستواهم التعليمي مستوى السنة الثالثة أو الرابعة إعدادي[8]. وبالإضافة إلى هذا الارتجال، تم استقدام متعاونين من المشرق العربي، وعلى الخصوص من مصر، من أجل تعريب التعليم في البلد. في غياب تكوين حقيقي مناسب كان حتمياً أن يعاني هذا «الممرن» المحلي وهذا «المتعاون» المشرقي من نقائص «على المستوى الثقافي والعلمي والسيكولوجي-البيداغوجي. ومما زاد الطين بلة ورسخ العجز ندرة الوثائق، «وهو ما أدى بدوره إلى غياب أدنى اجتهاد أو إبداع بيداغوجي لدى أغلبية المكلفين بالتعليم، وراحوا يقدمون تعليماً نمطياً امتثالياً بعيداً كل البعد من شحذ وتطوير ذكاء التلاميذ»[9].
من العام 1976 إلى 1999 ظلت مناهج مادة «التربية الإسلامية» على حالها ما عدا تقديم أو تأخير حفظ أو فهم سورة من القرآن هنا، وحذف أو إضافة أخرى هناك. ولم يمس المناهج أي تغيير نوعي مدة (23) سنة كاملة. ففي العام الأخير من الألفية الثانية (1999)، وإكمالاً لعملية تهدف إلى تخفيف المناهج كانت قد بدأتها وزارة التربية الوطنية عام 1993، تم «تنظيف» المحتويات التي كانت تبدو كتمجيد للعنف وللجهاد وللكراهية.
كأن السلطات التربوية قد وصلت بعد التطرف الذي عرفته الجزائر، والعنف الإرهابي الذي عاشت، إلى أن مادة «التربية الإسلامية»، والتعليم الديني بصفة عامة، لم يحققا أهدافهما وغاياتهما، التي كانت مسطرة، وفي مقدمتها زرع الإيمان والقيم الإسلامية في نفوس التلاميذ والتلميذات منذ نعومة أظفارهم، والتي كان يؤمل أن تترجم على أرض الواقع في «عادات جميلة وأخلاق رفيعة». وكان البرنامج العام يدور حول: القرآن، الحديث، العقيدة، العبادات، السلوك والأدب. وبقيت منهجية التدريس التقليدية التي يتقاسمها معلم التربية الإسلامية مع زملائه من معلمي وأساتذة المواد الأخرى هي السائدة، تلك المعتمدة على التلقين/ الإرجاع التي أصبحت منذ مدة طويلة غير ذات جدوى، بل مضحكة. وما زاد من إفلاسها كثرة المادة المقررة التي ينبغي حفظها عن ظهر قلب.
في المشروع التمهيدي المتعلق بالمبادئ العامة للسياسة التربوية الجديدة وإصلاح التعليم الأساسي[10] (ديسمبر (كانون الأول) 1997)، يقول المجلس الوطني للتربية: إنه «في نهاية التعليم الأساسي ينبغي على الطفل أن يكون قد تشبّع بالإيمان الإسلامي الأصيل والوطنية والشعور بالفخر والانتماء الوطني». و«يجب أن يكون قادراً على حفظ جزء من القرآن الكريم وأحاديث الرسول، والقيام بواجباته الشعائرية والاقتداء بأقوال وأعمال وسيرة الرسول الأكرم».
التعليم الأصلي
كان السيد مولود قاسم نايت بلقاسم[11] وزير التعليم الأصلي والشؤون الدينية –سابقاً- هو صاحب فكرة إنشاء ومهندس هذا التعليم الموازي للتعليم العام والمسمى «تعليماً أصلياً». لقد أقنع الرئيس هواري بومدين العام 1970 باستحداث تعليم ديني يمكنه إعطاء فرصة ثانية لعدد كبير جداً من التلاميذ الذين فشلوا في متابعة دراستهم في التعليم العام. ومع الوقت كبر هذا التعليم وبدأ يطبق برامج وزارة التربية، واستحدثت شهادتان: بكالوريا التعليم الأصلي، وشهادة الأهلية، بالنسبة للمرحلة الإعدادية. وخوفاً من استفحال تعاظم تأثير التيارات الإسلاموية الصاعدة، أعيد تنظيم التعليم الأصلي من طريق أمر مؤرخ في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1977، وتم وضعه تحت وصاية وزارة التربية الوطنية بعد أن كان تحت وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية. وجاء مرسوم آخر يوم 17 مايو (أيار) 1978 ليلغي ما كان يسمى شهادة «الأهلية للتعليم الأصلي»، واستحداث شهادة موحدة تحت مسمى «شهادة التعليم المتوسط». كما تم –أيضاً- إدماج بكالوريا التعليم الأصلي في شهادة البكالوريا الخاصة بالتعليم الثانوي العام.
وكان امتصاص هذه المعاهد في عقد السبعينيات هو تتمة لحركة بدأت منذ 1962، كانت تبتغي إدماج الحاصلين على شهادات من المعاهد الدينية في مؤسسات الدولة التي ترددت كثيراً في الاعتراف بشهاداتهم. وقد تم توظيف الكثير منهم في التربية الوطنية والإعلام والثقافة، وبشكل أقل في العدالة والشؤون الخارجية.
وفي الحقيقة لا يعني الاختفاء الرسمي لتلك المؤسسات، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتقاليد العربية الإسلامية، زوال البنى الفكرية والثقافية التي كانت أساساً لها؛ إذ ظل مثقفو الحركة الإصلاحية، وعلى وجه الخصوص أبناء «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»[12] -كما تبّين لاحقاً- متشبعين بالثقافة الإسلامية المغاربية التقليدية بشكل عميق. وليس هذا فحسب، بل ترك هؤلاء بصماتهم على الحياة الثقافية، وخصوصاً على محتوى التعليم الديني، وحتى غير الديني في الجزائر.
يكفي إلقاء نظرة متفحصة على المقررات التي كانت سائدة لنعرف أنه من السنة الثالثة إلى التاسعة من التعليم الأساسي؛ كان المحتوى متجذراً في التقليد وأقرب إلى التصور الأشعري في مسألة القدر –مثلاً- منه إلى تصور المعتزلة، وهذا يدل على أن معظم البرامج كانت مقترحة من طرف أعضاء من جمعية العلماء المسلمين أو من المتعاطفين مع فكرها. وهو الأمر الذي جعل الكثير من التربويين والإعلاميين ينتقدون الوجود الديني التقليدي في المدرسة الجزائرية.
ذهب بعضهم إلى رد الصعود الكبير للأصولية في الجزائر، ثم ظاهرة الإرهاب، إلى المدرسة الجزائرية. لم تكن المادة المقدمة للتلاميذ سوى سلسلة من المعلومات، يكتب الأستاذ والكاتب رشيد شكري عنها أنها: تتخللها رسائل عنف ونداءات إلى الانشقاق مقدمة في نصوص قراءة مدعمة بقيم ومبادئ دينية في خدمة أيديولوجيا تنشر اللاتسامح بين الناس وتقسم البشر إلى مؤمنين وكفار. ولتغييب التصورات الحقيقية للحضارة من الأقسام -يضيف الكاتب- يبقى تلامذتنا يعيشون في عالم قروسطي بكل مواصفات التقهقر[13]. أما جريدة «الوطن» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، فقد نددت بالوضع الذي عاشه التعليم في البلد تحت عنوان قوي: «شهادات العار»[14]. جاء من بين أشياء كثيرة غريبة متعلقة بكيفية توظيف المعلمين والأساتذة، أن هناك كثيراً من الأشخاص دخلوا الجامعة ولم يكن لديهم من زاد دراسي سوى قضائهم بعض سنوات في مدارس الزوايا، والبعض الآخر، وبالمسار الدراسي نفسه، أرسلتهم جبهة التحرير الوطني إلى الدراسة في بعض المدارس الدينية في بلدان عربية، ابتداء من سنة 1956، وعند عودتهم لم يجدوا أدنى صعوبة في الحصول على معادلة أكاديمية لشهاداتهم، كشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا والليسانس (الإجازة). وقد فتحت المادة (120) المعتمدة من طرف الحزب الواحد –آنذاك- من أجل إقصاء معارضيه، الأبواب واسعة لهؤلاء لاحتلال مناصب إستراتيجية في «الوظيف العمومي» إذ من أجل منصب عمل واحد في «الوظيف العمومي»: سيختار طالب الزاوية القديم.
وفي كتاب تحت عنوان «النزول إلى الجحيم»[15]، قدمت الكاتبة ليلى أيت العربي تحليلاً لواقع المدرسة الجزائرية وكيف نخرها الفكر الأصولي بتواطؤ مع النظام الحاكم. تقول: «قايض المجتمع الجزائري البيداغوجيا بالأيديولوجيا، المستقبل بالماضي، وحرية التعبير والتنوع والغنى اللغوي بلغة الخشب، والحس المدني بالتعصب، والتفكير بالتعلم السلبي… فشل المدرسة هو فشل المجتمع، فشل البلد برمته، فشل السياسة التي رفضت التوجه إلى المستقبل واكتفت بالنظر إلى الماضي كمرجع ممكن وحيد»[16].
لقد انعكس ذلك التوجه على أداء المدرسة الجزائرية، وارتكزت منهجيات التعليم حول مقاربة لم تترك أية فرصة للتعدد أو للإبداع، فكانت موحدة ووحيدة على كل التراب الوطني، ضاربة بعرض الحائط الخصوصيات الجغرافية والإثنية واللسانية. وكان الدور المناط بالمدرسة -وما يزال- بناء هوية وطنية واحدة مرتكزة على العربية والإسلام والأمازيغية.
المدرسة والتعصب
وجهت السيدة سعيدة بن حبيلس (الوزيرة والبرلمانية السابقة والممثلة للحركة النسوية الجزائرية للتضامن مع الأسرة الريفية) نقداً لاذعاً للمؤسسة التعليمية أثناء النقاش الوطني حول التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2006 المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة، حينما قالت: «وبالنسبة لعلاقة المدرسة بالإرهاب، فلا بد من الإشارة إلى وجوب إضافة مواد أساسية عدة لتربية النشء. نذكر -على سبيل المثال- مادة حقوق الإنسان والتربية المدنية والأخلاقية، التي تزرع حس الوطنية وقيم السلم والتسامح والتضامن في نفوس أبنائنا.
مع العلم أن المدرسة تأثرت أكثر من غيرها بالمخطط الجهنمي الهادف إلى ضرب كيان الدولة وبناء مجتمع تسوده الظلامية، حيث تعتبر النساء عبيداً خلقن لإنجاب الأطفال فحسب… وصرختي هذه نابعة من تخوفي على مصير أبنائنا ومستقبل مجتمعنا؛ لأن تصرفات بعض إطارات التربية تعتبر خطرة، بحيث ما زال -لحد الآن- البعض منهم يرفض تحية العلم الوطني، ويجبر البنات على ارتداء الحجاب، وغيرها من التصرفات التي تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا على الرغم من تعليمات وزارة التربية».وفي كتابه «عن البربرية عموماً والإسلاموية خصوصاً»[17] يوجه الروائي الجزائري رشيد ميموني أصابع الاتهام مباشرة إلى المدرسة في تفشي ظاهرة التطرف الديني والعنف في الجزائر، فيكتب من دون لف ولا دوران أن: «السياسة التربوية في الجزائر هي التي تغذي الأصولية، إذ ليس هناك أدنى شك بأن رجال الدين المتسترين تحت عباءة معلمين، وتناقض البرامج التعليمية، هما من أهم أسباب عودة البربرية.
لقد تحول التعريب السياسي الذي كان من المفروض أن يستعيد الإرث اللغوي المسلوب من طرف الاستعمار إلى تمجيد للإسلاموية وازدراء للغات الشعبية المحلية. تعريب تم بتسرع، مجرد من أدنى الوسائل التي تسمح له بالانفتاح على الحداثة». «لقد عارض عرابو الأصولية –بقوة- إصلاح المدرسة لأنها هي التي تضمن، بالشكل الموجودة عليه، استمرار بقائهم في التوالد. لقد حاولوا –دائماً- إفراغ التربية من الشك والعقل والروح النقدي والنسبية التاريخية والحوار التأويلي… تلك المبادئ التي تشكل جوهر العلوم الإنسانية»[18].
أما المفكر التونسي التنويري العفيف الأخضر، فقد شخّص المرض الذي تعاني منه التربية في الجزائر، وهو الذي يعرف البلد جيداً؛ لأنه عاش فيه مدة من حياته، وذلك عبر مقال موجه إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مؤرخ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2004 تحت عنوان «رسالة مفتوحة إلى الرئيس بوتفليقة جَفِّف ينابيعَ الإرهاب من المدرسة»[19]: قرأت –بذهولٍ- في اليومّية الفرنسية لوفيغارو (27/11/2004) هذا التعليق: «بوتفليقة يريد ردّ الاعتبار للغة الفرنسية»، لمراسلها السيد أرزقي آيت العربي جاء فيه: تغلّب التعليم الديني منذ الثمانينيات في المدرسة المعرّبة على العلوم والفكر الديكارتي (العقلاني).
حيث يتم إخضاع التلاميذ، منذ المدرسة الابتدائية، إلى برنامج سوريالي: يركز على كيفية غسل الميت ورجم المرأة الزانية على الرغم من أن حدّ الرّجم لا وجود له في القرآن، يؤكّد أستاذ الدراسات القرآنية الليبي الصادق النيهوم، في كتابه «إسلام ضدّ الإسلام»، أن الفقهاء أخذوا حدّ الرجم من سِفر التثنية التوراتي، وهكذا طبقوا التوراة ضِداً على القرآن كما قال النيهوم. ويواصل العفيف الأخضر رسالته الصريحة اللهجة:
«أعرف أن التعليم في الجزائر، التي أعتبرها وطني الثاني، ليس بخير. وما زلت أذكر ما صرح به جامعيّ جزائريّ لليومّية «لوموند»، سنة 1994: (لو استولت الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ على الحكم اليوم في الجزائر لما غيّرت فاصلة في مناهج التعليم). ومع ذلك، لم أكن أتوقع أن صغار الجزائر يدرسون منذ نعومة أظفارهم كيف يغسلون المّيت وكيف يرجمون المرأة الزانية». ويذكّر المفكر الرئيس بوظيفة المدرسة الحديثة: «للمدرسة المعاصرة في العالم المتقدم وظيفتان مركزيتان: تخريج مواطني الغد المسالمين والمتشبعين بقيم حقوق الإنسان والذين يتعاملون مع مواطنيهم ومجتمعهم والعالم بالحوار والتسامح والتفاوض والاحترام المتبادل،
وتخريج المختصين، أي عمّال الغد: التقنيين، المهندسين، الباحثين، العلماء والأطباء». ويضيف: «هل ترضى للجزائر التي غامرت بحياتك في سبيل استقلالها، أن تكون مهمة مدرستها تخريج المواطنين المهووسين بالعنف والمختصين في غسل الأموات ورجم النساء؟
هكذا تغتال المدرسة فيهم غرائز الحياة وتنمّي فيهم غريزة الموت في جميع تجلياتها، من الرجم إلى هدم منشآت المجتمع الجزائري ومنها المدارس، كما فعلت الجماعات الجهادية التي هي في معظمها ضحّية هذا التعليم العتيق والعنيف». يؤكد المفكر التونسي للرئيس الجزائري أن الذين يتعلّمون وجوب رجم الزانية صغاراً، يكفّرون كباراً مجتمعهم الذي لا يطبّق «شرع الله» الذي تعلّموه في الصّغر.
ويواصل العفيف الأخضر: «إن التعليم الظلامي في ظلّ دولة تقدم نفسها بأنّها حديثة، مثل الجزائر، لكنها -يا للمفارقة- تطبّق الإسلامويّة بدون إسلامويين، فإنّه يخرّج أجيالاً من الفصاميين -إذن- إرهابيين، ناقمين على الحاضر باسم الماضي. لأنهم يرون أن ممارسات دولتهم لا تتطابق مع الوعي الديني الظلامي الذي زرعته فيهم في المدرسة. وهكذا يتمردون على مجتمعهم الفعلي باسم مجتمع إسلامي مثالي خيالي لم يوجد في التاريخ قط، ولكن المدرسة غسلت به أدمغتهم، فأوهمتهم بأن العودة إلى عبادة الأسلاف، أي إلى تطبيق الشريعة والخلافة الراشدة في القرن السابع، هو «الحل الوحيد» لمشاكل ومعضلات القرن الحادي والعشرين».
ويضيف المفكر التونسي مفسراً: «وهكذا يكون تدريس العقوبات البدنية الشرعية منافياً لمصلحة المسلمين اليوم لأنّه يؤدّي إلى مفسدة: التحريض على الجريمة والعنف. وتحصين وعي الأجيال الصاعدة ضدّ حقوق الإنسان وَجَعلِهِم يستبطنون المرأة كمجرمة جديرة بالرجم، وتكفير مجتمعاتهم التي لا ترجمها، ولا تقتل تارك الصلاة، ولا تعلن الجهاد على غير المسلمين إلى قيام الساعة… وهكذا يخيّل لهم أن هذا المجتمع الكافر هو الذي نزع البركة وحال دون عودة المهدي المنتظر ليملأ الأرض عدلاً كما امتلأت جوراً. وهو -لا شك- عائد مع الثورة الإسلامية الموعودة. وهكذا كلّف هذا الفصام التربوي النادر في تاريخ الحوليات التربوية، الجزائر (150) ألف قتيل. لماذا تكوِّن الدولة الجزائرية الإرهابيين في مدارسها ثم تلاحقهم شباباً في الجبال لتقتلهم؟ رحمةً بشعب الجزائر ضعوا حدّا لهذه المأساة»[20].
وكما جاء في الشهادات السابقة، يجد الطفل الجزائري نفسه منذ نعومة أظفاره في جو تنشئة اجتماعية مرتكزة –أساساً- على التعليم الديني، المرتكز –بدوره- على الحفظ كمنهج شبه وحيد. فليس من الغريب أنه في استطلاع رأي تمّ في مايو (أيار) من سنة 1992 مس (1629) تلميذاً في صف البكالوريا أن (68%) منهم أجابوا بأن الشيخ ابن باديس هو الجزائري الذي يمثل العلم والمعرفة[21].
أما عن الجزائري الذي يمثل السياسة أحسن تمثيل فـ(29%) قالوا إنه عباسي مدني و(20%) الرئيس هواري بومدين و(18%) الرئيس محمد بوضياف. محمد بوضياف الذي انتقد المنظومة التربوية انتقاداً لاذعاً وهو على كرسي الرئاسة حينما قال في خطاب بث على شاشة التلفزيون الجزائري: إن «المدرسة الجزائرية مدرسة منكوبة». ومن العجائب والمفارقات أن يصرح السيد أبو بكر بن بوزيد بأن المدرسة الجزائرية قد صنعت إرهابيين، وهو الذي شغل منصب وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم قرابة العشريتين (من 1993 إلى 2012).
ألم يحن موعد عصرنة المدرسة الجزائرية؟
تحت تسمية «التربية الإسلامية» في التعليم الابتدائي والمتوسط، وتحت تسمية «العلوم الإسلامية» في الثانوي، ترافق مادة التربية الدينية التلميذ الجزائري مدة ساعة ونصف أسبوعياً في المرحلة الابتدائية، ومدة ساعة في التعليم الإعدادي، وما بين ساعة ونصف وساعتين في التعليم الثانوي، وذلك حسب التخصصات، وفي كل مسار التلميذ الدراسي. ويشرف على تقديم هذه المادة في الثانوي خريجو المعاهد المختصة في العلوم الإسلامية كجامعة الأمير عبدالقادر، التي كان يشرف عليها الإخواني محمد الغزالي، ومعهد أصول الدين في الجزائر العاصمة، ومعهد الحضارة الإسلامية بوهران وباتنة وأدرار. أما في الابتدائي والإعدادي، فمعلمو اللغة العربية هم الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية.
لا يخفى على أحد أن المدرسة الجزائرية كانت مرتعاً للمحافظين، إذ كانوا يسرحون ويمرحون فيها منذ الاستقلال -كما رأينا سابقاً- واستغلوا هذه المادة لنشر أفكارهم ورؤيتهم الخاصة للدين. ولكن ابتداء من ثمانينيات القرن المنصرم تحول أغلبهم إلى إسلاميين مناضلين ينشرون الفكر الإخواني في وضح النهار. وقد ذهب الكثير منهم إلى حمل السلاح وممارسة العنف. ومع استفحال ظاهرة العنف الإسلاموي والإرهاب، ابتداء من سنة 1993، بدأ البحث عن أصل هذا الداء المتفشي بين الكثير من الشباب الجزائري. واهتم كثير من الباحثين بعلاقة هذا التطرف الديني بما يتعلمه التلاميذ في المدرسة، وبالأخص التساؤل عن الطريقة التي تُقدم بها تعاليم الإسلام داخل الأقسام. وانصب التفكير حول كيفية إصلاح المنظومة التربوية وتنظيفها مما علق بها من شوائب التطرف والعنف واللاتسامح، وتسليح التلاميذ بمعرفة تقيهم شر السقوط في حبائل المتطرفين. ومن أجل الوصول إلى هذا المبتغى شكلت لجنة لإصلاح المنظومة التربوية سنة 2000 بطلب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نفسه، ترأسها بنعلي بن زاغو، وعرفت باسمه فيما بعد، أي «لجنة بن زاغو»، ضمّت (160) عضواً، وكانت وزيرة التربية الحالية السيدة نورية بن غبريط من بين أعضاء اللجنة المقربين من بن علي بن زاغو.
اشتغلت اللجنة مدة تقارب العام بقصر الأمم بنادي الصنوبر، حيث تجرى المؤتمرات الوطنية والدولية، بعيداً من رجال المهنة؛ ولم يكن يسمح بالوصول إليها حتى للصحفيين. ولم يتسن لنقابات المعلمين والجامعيين وجمعيات أولياء التلاميذ الحديث لأعضائها وتقديم اقتراحات. واقتصر تعاون اللجنة مع «ضيوف» من تونس وفرنسا. وربما هذا ما جعل الكثيرين يتحفظون على ما جاء في تقريرها من تشخيص للوضع التربوي ومن اقتراحات لإصلاحه.
وما أثار غضب المحافظين هو تصريح بعض أعضاء اللجنة بأن المدرسة الجزائرية مصدر لتخريج الإرهابيين، الذين شكلوا الجماعات المسلحة التي مارست العنف والتقتيل؛ لأن مناهج هذه المدرسة ذات طابع عتيق وديني. وذهب بعضهم حتى إلى القول: إن تعميم استعمال اللغة العربية كان من أسباب الفشل التربوي والتعليمي في الجزائر، وهو ما يشير إليه التقرير النهائي تلميحاً، ويقترح إعادة الاعتبار للغة الفرنسية في كل مراحل التعليم.
جاء التقرير في (600) صفحة أغلبها مقدمات وأفكار في مدح التفتح، وضرورة الاهتمام باللغات الأجنبية ونقد مناهج المدرسة التي كانت معتمدة إلى سنة 2000. ومن بين المقترحات العملية القوية التي قدمها التقرير، إعادة النظر في مادة التربية الإسلامية بإدماج مادتين معها، لتصبح مادة جديدة هي «التربية المدنية والأخلاقية والدينية» بالنسبة للتعليم الابتدائي والإعدادي (الإكمالي). أما بالنسبة للمرحلة الثانوية، فيقترح التقرير أن تتناول مادة التربية الأخلاقية والدينية معرفة مبادئ كل الأديان الكبرى.
صادق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عشية الدخول المدرسي (2005/2006)، على قرار حكومته بإلغاء شعبة الشريعة في المدارس الثانوية، وتقليص تدريس مادة التربية الإسلامية في الشعب الأخرى في جميع المستويات الدراسية.
وبدا القرار محاطاً بهالة من الغموض، إذ تضمن بيان أصدره مجلس الوزراء بنداً ينصّ على صون مكانة العلوم الإسلامية، من خلال الإبقاء عليها كاختصاص قائم بذاته في البرامج التعليمية الرسمية. وهو ما فهم على أنه محاولة من الرئيس بوتفليقة لتهدئة الجو بعد انتقادات المحافظين عموماً، وعلى وجه الخصوص «جبهة التحرير الوطني» التي هي حزب الأكثرية البرلمانية، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية التي كانت منضوية ضمن الحلف الرئاسي -آنذاك.
وقد اعتبر المجلس الإسلامي الأعلى، وأحزاب إسلامية كثيرة، القرار ضد ثابت من ثوابت الأمة الجزائرية الواردة بالدستور (الإسلام والعروبة الأمازيغية) وتجفيف منابع الإسلام من المدارس الجزائرية. ونظم طلبة بجامعة العلوم الإسلامية في مدينة قسنطينة شرق البلاد اعتصامات لمدة ثلاثة أيام لحمل السلطات على التراجع عن قرار الإلغاء، معتبرين أن تنفيذه سيضر –حتماً- بمكانة الثقافة الدينية للأجيال المقبلة. وسعى وزير التربية الوطنية –آنذاك- السيد أبو بكر بن بوزيد إلى تهدئة المحتجين قائلاً على موجات الإذاعة الوطنية: إن هذا ليس حذفاً للتربية الإسلامية، بل هو إصلاح مس (9) تخصصات، وهو عبارة عن تأجيل للتخصص من الثانوي إلى التعليم العالي. معللاً بأن التخصص المبكر غير مجد.
خاتمة
قامت مجموعة بن زاغو، وهي التي أشرفت على أكبر ورشة لإصلاح المنظومة التربوية منذ استقلال الجزائر، بإعداد مشروع إصلاحي جذري مقارنة مع ما سبقه، وذلك بمحاولة تغيير المناهج التعليمية أسلوباً ومضموناً، بعدما بينت عدم مسايرة المنظومة التربوية في الجزائر للتطورات الحاصلة على المستوى الدولي والداخلي، لاعتمادها على أساليب تقليدية مبنية على الحفظ والتلقين في أغلب الأحيان، في حين أن التعليم يعتمد في الوقت الحاضر على التفكير والتحليل، ومنهما يتم الانتقال إلى مرحلة الإتقان والإبداع الفكري والعملي. كما أشار تقرير لجنة بن زاغو –محقاً- إلى انغلاق المدرسة الجزائرية وعدم تفتحها، بالإضافة إلى تجذّرها في أيديولوجية قومية ودينية في وقت يسير فيه العالم نحو الانفتاح والعولمة، وخاصة بعد ثورة الاتصال الحديثة.
ولئن كان تشخيص مرض المدرسة الجزائرية صائباً في معظمه، فالوصفة التي اقترحت لجنة بن زاغو من أجل إبرائها لم تكن شافية بالقدر المطلوب، إذ بالإضافة إلى التناقضات التي اكتنفت بعض مقترحاتها، فهي لم تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى على الأرض بين المحافظين والحداثيين، والذي يبقى –دائماً- لصالح المحافظين الرافضين للإصلاح، وهو ما يعيق تنفيذه، إذ لا يمكن القيام بإصلاح بدون إصلاحيين، فمعظم المعلمين والأساتذة هم اليوم من الإسلاميين أو من القريبين إلى أطروحات الإسلام السياسي لسبب بسيط، هو أنهم من خريجي هذه المدرسة التي نريد إصلاحها من أجل أن تنتج غيرهم[22]. ولكن هل كانت الإصلاحات المنتهجة منذ سنة 2000 على مستوى ذلك التحدي؟ وهل اتخذت إجراءات عملية جدية للوصول إلى ذلك الهدف؟
لا يفوت المتتبع للخطاب الأيديولوجي الجديد، الذي يحاول أن يؤطر المنظومة التربوية، تلك الازدواجية في تحديد مهمة المدرسة. فمن جهة يركز هذا الخطاب على «أهمية عولمة المدرسة»، ومن جهة أخرى يؤكد «ضرورة تعميق الهوية الوطنية والدينية». وهي ثنائية لم يستطع مضمون الخطاب الذي تتضمنه مادة التربية الإسلامية في المرحلة الثانوية –مثلاً- أن يتجاوزها؛ إذ لا يستطيع الدارس للكتب المدرسية المخصصة للمرحلة الثانوية أن يعرف بوضوح هدف الخطاب الديني المدرسي: هل هو تكوين ذوات دينية لمجتمع ديني، أم تكوين مواطنين مسؤولين لمجتمع ديمقراطي؟
لم تتخلص المنظومة التربوية، على الرغم من الجهود الإصلاحية الأخيرة، من ذلك الخطاب الديني المربك والانتقائي، الذي نجده مجسداً في الكتب المدرسية الخاصة بالتربية الإسلامية في المستوى الثانوي، حيث نعثر –مثلاً- على موضوعات تقدم خطاباً حول الأخوّة والصداقة والحرية والتسامح ووجوب تعايش المسلم مع الآخر، وفي الوقت نفسه نجد موضوعات تحذر من خطر الغزو الثقافي ومغبة السقوط في تقليد الأديان الأخرى، باعتبارها تشكل خطراً على المؤمنين بالدين الإسلامي[23]!
على العموم، يبقى الإشكال قائماً ما دام الخطاب التربوي في الجزائر لا يقدم للتلميذ أدوات التمييز بين الدين والأيديولوجية الدينية. يعود سبب ذلك الدوران في المكان نفسه إلى تداخل ثلاث شرعيات متناقضة في المدرسة الجزائرية: شرعية إسلامية، شرعية تاريخية، وشرعية حداثية. وينتج عن ذلك صورة ضبابية، حتى وإن بدا أن المرجعية الإسلامية هي التي تلعب دور الوعاء الذي يحافظ على الهوية الجزائرية. وهذا ما ينعكس على الأداء التربوي بشكل واضح، باعتبار أن الانطلاق من الدين، كـ«إطار فكري»، جعل المنظومة التربوية تقترب، من طريق التلقين والحفظ والاستعادة، من نسق الفكر الديني التقليدي.
[1] باحث و مترجم وصحفي جزائري، أستاذ الفلسفة في جامعة الجزائر سابقاً.
[2] دافعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، عن وزيرة التربية نورية بن غبريط، ضد من سمتهم «الظلاميين والرجعيين، من عصور الجاهلية وهكذا دخلت السيدة حنون في الجدل المتصاعد حول الوافدة الجديدة على وزارة التربية بسبب عدم تمكنها من اللغة العربية واتهامها بـ «التغريب» قائلة: إن للسيدة بن غبريط الجرأة لأنها تعمل من أجل إعادة المدرسة الجزائرية المتشبعة بالقيم الجمهورية التي توفر المعرفة وتقوي الحس المنطقي لدى التلاميذ ( جريدة الشروق السياسية 29 /05/2014).
[3] Voir; Organisation de l’éducation et de la formation en Algérie Ordonnance n° 35-76 du 16 avril 1976.
[4] أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق، هو ابن الشيخ البشير الإبراهيمي (1889-1965) أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
[5] El Moudjahid, 1er décembre 1970.
[6] Charles Robert Ageron, Les algériens musulmans et la France, Presses Universitaires de France, Paris, 1968, P 318
[7] عبدالحميد، زوزو، نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصـر (1830-1900)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1985، ص206.
[8] 85% من الــ1(70000) من معلمي الطور الابتدائي لم يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا، و63% كانوا في الوضع نفسه بالنسبة للتعليم الإعدادي (99000). (المصدر: وزارة التربية أبريل (نيسان) 1998).
[9] المصدر السابق.
[10] «التعليم الأساسي» هي المرحلة الدراسية الابتدائية والإعدادية معاً، إذ تحوي هذه المرحلة التسع سنوات الدراسية التي تسبق التعليم الثانوي. بعد التعليم الأساسي يحق للتلميذ الاختيار بين المدارس المهنية والتعليم الثانوي بشعبه المختلفة، حسب نتائجه وإمكاناته. وقد تم اعتماده ابتداء من العام الدراسي (1981-1982).
[11] كان وزيراً للتعليم الأصلي والشؤون الدينية من (1970 إلى 1977)، ووزيراً لدى رئيس الجمهورية من (1977 إلى 1978). وهو الذي كان مشرفاً على ملتقى الفكر الإسلامي. وكان حريصاً على أن ينعقد في كل عام، وكان يدعو إليه زعماء الإسلاميين من كل البلدان، أمثال: القرضاوي ومحمد الغزالي وغيرهما. وكان هذا الملتقى الذي استمر من 1968 حتى سنة 1990 عبارة عن منبر قدمته الدولة الجزائرية للأصولية العالمية، وكان له أثر كبير في نشر التطرف في الجزائر.
[12] هي جمعية إسلامية جزائرية أسسها مجموعة من رجال الدين الجزائريين يوم 5 مايو (أيار) 1931 في نادي الترقي بالعاصمة الجزائر. وكان زعيمها الأول الشيخ عبدالحميد بن باديس. وكان أعضاؤها متأثرين بأفكار النهضة والإصلاح في المشرق. وكان شعارها «الإسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا».
[13] Rachid Chekri (instituteur-écrivain) : « L’école, ce cercueil de l’intelligence »,Le Matin, 03 /08 /2000.
رشيد شكري (معلم و كاتب): «المدرسة، نعش الذكاء»، جريدة لوماتان.
[14] Les diplômes de la honte », El Watan, 15/08/ 2000.
[15] Lila Aït Larbi, La descente aux enfers, éditions Marinoor Algérie 1999.
[16] I bid.
[17] Rachid Mimouni, 1992, De la barbarie en général et de l’intégrisme en particulier, éditions Belfond-Le Pré aux clercs.
[18] المصدر السابق، ص121.
[19] لمزيد من التفاصيل حول المقال الموجه من قبل المفكر التونسي الراحل العفيفي الأخضر إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، راجع موقع شفاف الشرق الأوسط على الرابط التالي:
http://www.metransparent.com/old/texts/lafif_lakhdar_letter_to_bourghuiba.htm
[20] جريدة إيلاف الإلكترونية ليوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2004.
[21] Nouria Benghabrit-Remaoun, « Jeunes en situation scolaire, représentations et pratiques », Naqd, revue d’étude et de critiques sociales, n° 5, 1993.
[22] وهو ما اصطدمت به وزيرة التربية الحالية السيدة نورية بن غبريط، إذ كثفت النقابات، التي هي في أغلبها ذات توجه إسلاموي، من الإضرابات التي شلت القطاع التربوي منذ توليها المنصب، بهدف إجبارها على التخلي عن الإصلاحات، ولكن تحت لافتة مطالب مهنية واجتماعية.
[23] انظر: الجيلالي، المستاري، تمثل الهوية الدينية في المدرسة الجزائرية، كتاب مادة التربية الإسلامية في الثانوي نموذجاً.