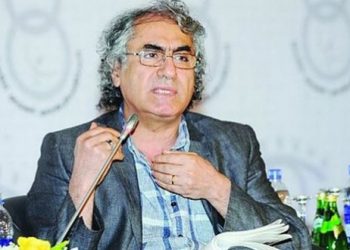السعودية بلدٌ متعدد الثقافات والمذاهب، تلك حقيقة حاول البعض طمسها، سعياً لتكريس رؤية أحادية للدين، تقتصر على أن الصواب هو ما يوافق قراءتهم النابعة من اصطفاء للذات، وتدنيس للآخر، وأنانية تجنح لتكريس القوة والنفوذ والغلبة لديهم وحسب!
تعميمُ رؤية نمطية للمملكة، أمر قام به طرفان: المتشددون في الداخل، والنُقاد في الخارج.. وكلاهما سعياً لتقديم السعودية وكأنها دولة ذات عقيدة ماضوية تكفيرية لا تعترف بالآخر، وتطرد أي تعدد بين مواطنيها، وهو الأمر الذي يُخالف واقع الحال.
الحقيقة تقول عكس ذلك. فرغم كون المملكة تضم طيفاً واسعاً من المسلمين السنة، الذين يعتنقون المذهب الحنبلي، إلا أن المتفحّص لتاريخ المملكة قديماً وحديثاً، يجد أن المذاهب الإسلامية السنية والشيعية، يوجد أتباع لها في مختلف مدن وقرى السعودية على مر العقود.
العام 2015، نشر “مركز المسبار للدراسات والبحوث”، كتاباً بعنوان “التعددية في الخليج وجواره.. الواقع والآثار”، شاركتُ فيه ببحث حول “التعددية في السعودية”، أشرتُ فيه إلى أنه “في السعودية، وعلى الرغم من بروز السلفية كمدرسة تشكل ملامح التدين في المملكة، فإن هنالك حضوراً للمذاهب السنية بمدارسها الأربع: الحنابلة، الأحناف، المالكية، والشافعية، يضاف إليهم المسلمون الشيعة، بثلاثة مذاهب رئيسة: الاثنا عشرية، الإسماعيلية، والزيدية. أي أن هنالك سبعة مذاهب إسلامية يتعبد بها السعوديون، ويتبع سكان المملكة أحكامها الفقهية ورؤيتها العقدية”.
البحثُ تطرق إلى توزع المذاهب الإسلامية في مختلف المناطق. لو أخذنا المنطقة الشرقية والتي تضم “الأحساء والقطيف ومدناً حديثة كالدمام والظهران والخبر، يحضر الشيعة الاثنا عشرية كمذهب سائد في مدن القطيف والعوامية وسيهات وصفوى وباقي قرى محافظة القطيف، إضافة إلى جزء كبير من محافظة الأحساء.
ويمكن اعتبار الأحساء مثالاً على التنوع المذهبي والتعايش السلمي بين المكونات المختلفة، حيث تضم مسلمين شيعة وسنة. وينتمي الشيعة فيها إلى مدارس مختلفة، هي: الشيخية والأصولية. فيما توجد المذاهب السنية الأربعة كافة”، هذا فضلاً عن أن “العديد من الأسماء العلمية الشيعية في المنطقة الشرقية كان لها حضورها الفقهي والشعبي المؤثر على الأتباع، سواء أكانوا مجتهدين أو زعماء دينيين، أمثال: الشيخ الميرزا الفضلي، وابنه الدكتور عبدالهادي الفضلي، والشيخ علي الجشي، والسيد ماجد العوامي، والشيخ محمد الهاجري، والسيد علي السلمان، والشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، والشيخ حسين العمران، والشيخ حسن الصفار، والسيد منير الخباز. من جهتها، ضمت عائلة “آل مبارك” في الأحساء عديداً من رموز علماء المالكية، ومنهم الشيخان: عبدالحميد المبارك، وقيس آل مبارك. والأخير عُين في عهد الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عضواً في هيئة كبار العلماء”.
إضافة لذلك، “الشافعية كان لهم حضورهم في الأحساء بين عدد من البيوتات الشهيرة، حيث يتواجد أكثرهم في مدينتي الهفوف والمبرز. ويعد الشيخ أحمد أحمد بن عبد الله الدوغان – توفي في أكتوبر 2013 – أحد أبرز الزعامات الدينية الشافعية، حيث كان له تلامذته ومريدون كثر”. كما “تعد عائلة الملا من أشهر البيوتات الأحسائية، التي ينتمي العديد من أفرادها للمذهب الحنفي، ومن أشهرهم الشيخ أبو بكر بن عمر الملا، وابنه عبد الله”.
هذا النموذج للثراء في منطقة جغرافية واحدة، دليلٌ على أن السعودية لا يمكن اختصارها في مذهب أو تيار أو رؤية فقهية وعقدية محددة، وهو تعدد سيجده المراقب واضحاً في مناطق أخرى مثل الجنوب والحجاز، وهو أيضاً كان موجوداً نسبياً، وبدرجات متفاوتة في المنطقتين الوسطى والشمالية؛ دون أن نغفل وجود “الصوفية” وبالأخص في المنطقة الغربية، وهي ليست صوفية واحدة، فهنالك طرقٌ عدة.
التنوع المذهبي، يتداخل مع التنوع القبلي والاجتماعي، وهذه العوامل تؤثر في بعضها البعض، كما رصد ذلك الباحث السعودي فهد الشقيران، الذي درس مثال المسلمين الشيعة الإسماعيلية في السعودية، حيث أن “الإطار القبلي للشيعة الإسماعيلية في نجران لا يزال متفوقاً على الإطار المذهبي، مما يجعل مسألة التمثيل الفئوي غير مرتبطة بالمراجع الدينية، وإنما بهياكل اجتماعية أخرى”. الشقيران قارن ذلك بحال السعوديين الشيعة الإثنا عشرية، معتبرا أنه “في المقابل، فإن التمثيل الفئوي للشيعة الجعفرية في القطيف وثيق الصلة بالمرجعية الدينية، مما يجعل البعد الديني متصدراً على الأبعاد الاجتماعية الأخرى في تمثيلهم كجماعة”.
هذا النوع من الرصد التحليلي الذي تناوله الشقيران، ذو أهمية علمية ومنهجية، لأنه يقاربُ موضوع التنوع المذهبي في تمظهراته البشرية، والعوامل الدنيوية المؤثرة فيه، وبالتالي يقرأه من زاوية الدراسات الاجتماعية، التي تفكك الظواهر الدينية علمياً.
الثراء على مستوى المذاهب في المملكة، يمكن جعله رافعة لبناء ثقافة قادرة على التجديد والاجتهاد، كما طرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حواره مع الإعلامي عبد الله المديفر، في نيسان (أبريل) الماضي، عندما قال صراحة “لا توجد مدرسة ثابتة، ولا يوجد شخص ثابت..الاجتهاد مستمر.. وكل الفتاوى تخضع لعامل الزمان والمكان”.
فتح باب الاجتهاد وديمومته، يجعل بالإمكان الإفادة من وجود سبعة مذاهب إسلامية في السعودية، وي وفر علماء وفقهاء داخل كل مدرسة، لديهم رؤاهم المتنوعة، وبذلك يمكن خلق خطاب حديث، يقوم على تجاوز المفهوم الانعزالي – الأقلوي لكل مذهب، والانفتاح على سعة الإيمان، والتعاطي مع الإسلام بمفهومه الحضاري – الإنساني، مع احترام كل مذهب، دون أن يُغلق المجتمع أو الفرد عقله على فتوى تخص مذهباً دون سواه.
التحول الاجتماعي والثقافي الواسع الذي تعيشه السعودية، يُحتم على الجميع تجاوز المخاوف المذهبية، والعمل على التخفف من تركة الخطابات الطائفية، ومعالجة ما أحدثه المتشددون من أضرار في المجتمع السعودي، جعلت أجزاء منه تتوجس من الأخرى في بعض المفاصل التاريخية. وعلاج هذا الأثر السبلي يتطلب جهداً مدنياً وحكومياً مؤسساتياً تشريعياً، عبر الأنظمة والقوانين التي تجرم الخطابات الطائفية والعنصرية ودعوات الكراهية، وأيضاً إصلاحاً للمؤسسة الدينية وتطوير آليات عملها، والمساهمة في الدفع نحو مزيد من النقد العلمي المنهجي للخطاب الديني السائد، والحد من دائرة “المقدس” إلى حدودها الدُنيا، لأن آراء البشر، جميع البشر، دون استثناء، هي ذات طبيعة مؤقتة، غير معصومة، مرتبطة باجتهاد أصحابها.
اليوم، هنالك إرادة سياسية ملكية عُليا واضحة في ترسيخ “المواطنة” كمبدأ أساس للعدالة والمساواة بين مختلف أفراد الشعب السعودي، بغض النظر على مذاهبهم وأعراقهم ومناطقهم، وبالتالي، فإن الهوية الوطنية الجامعة، ستعزز من الحضور الصحي للهويات الفرعية، التي لا تقمعها، أو تزدريها، بل تنظر لها بوصفها جزء من البنية المجتمعية، التي على الأفراد أن يعملوا على جعلها قوة ثقافية ودينية ناعمة، تساعد على الدفع نحو التفكير في علاقة المذاهب ببعهضا البعض، بصورة تفاعلية، إيجابية، غير تصادمية، نازعة فتيل الانفجار؛ وذلك لا يتم دون الاعتراف بحق الجميع في التعايش السلمي تحت سقف القانون والدولة المدنية، وأن الاجتهاد حقٌ لمختلف الطوائف والمدارس الفقهية، وهو فعلٌ يمكنه أن يقلل من مقدار التباينات أو النزاعات، ويجعل العقل ذا طبيعة تشاركية مرنة.