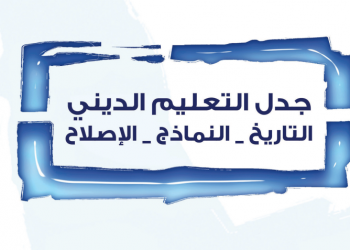كان ومازال يُعتقد أن تدريس الفلسفة لطلبة المدارس سيعمل على اضطراب عقولهم، وبالتالي انحرافهم، بإدخالهم في متاهات الأفكار الغريبة، على شاكلة ما توصف به “السفسطة” خطأً بأنها مجرد مهاترات كلام لا توصل إلى نتائج. غير أن الفلسفة، وهي حب الحكمة قديماً (فيلو وسوفيا)، تُعد مِن أرفع العلوم وأسماها وأكثرها إحاطة بالكون الذي يُحيط بالإنسان، وهو جزء منه. وبطبيعة الحال، يُعد آخرون من اللاهوتيين خصوصاً، أن الفقه، أو علم الدين هو أسمى العلوم، ويجعلونه بالضد مِن الفلسفة، فمَن جعل اللاهوت الأسمى بين العلوم، بما يقابل عند المسلمين “علم الكلام”، المرفوض هو عند بعض رؤساء المذاهب.
تبحث الفلسفة في الوجود، مؤسس نظرياتها عنه مِن نتائج العلوم الطبيعية والاجتماعية، لذا وصفت بأُمِّ العلوم، أو علم العلوم. تأخذ الفلسفة ما وصلت إليه علوم: الفيزياء والكيمياء والرياضيات والاجتماع وغيرها من نتائج في مجالاتها، وتؤسس فكرتها عن الكون أو الوجود بشكل عام، ووفق ذلك تشعبت الأسئلة، وتشعبت الاتجاهات، منها المثالي ومنها المادي، ومن الأول تشكل الفكر الديني، لا الدين نفسه، فهناك فرق بين الدين والفكر الديني، ولا يصح مقابلة الدين بالفلسفة، لأن الأول يختص بالإيمان بالله وعبادته ومصدره الوحي، أي خارج الوجود، الذي وصف بواجب الوجود، أو الموجود بذاته بينما الثانية اختصت بالوجود نفسه، أو ما عُرف بممكن الوجود، ومصدرها العقل.
إن الخشية من الفلسفة ليست أمراً جديداً، بل ارتبط إسلامياً بتحريم الجدل وعلم الكلام، فبين فترة وأخرى كانت تمنع المناظرات والجدل، مقابل تقوية الفكر الديني، وتقديم الفقهاء من أهل الحديث على المتكلمين والفلاسفة، المرميين بتهمة الزندقة والهرطقة، وأبرز الحوادث كانت مع المعتزلة. وأشهر مَن وقف ضد الفلسفة، فكرياً، أبو حامد الغزالي (ت505هـ/ 1111 م)، إلا أنه تأثر بالفلسفة، ودخل في بطنها ولم يخرج منها، والكلام للقاضي ابن العربي، وفق ما نقله صاحب “سير أعلام النبلاء”.
انتقل هذا الخلاف إلى عصرنا الحاضر، فصارت الأنظمة غير الدينية، أو أُطلق عليها بالتقدمية، تسمح بتدريس الفلسفة الإسلامية، وفق أفكار أبي نصر الفارابي، ويعقوب الكندي، وابن سينا وغيرهم، والذين شكلوا ما سماه أو عنونه حسين مروة “النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية”.
أما الدول ذات الاتجاه الديني، والتي كان يُشار إليها بالرجعية، فتدرس الفلسفة وفقاً لما جاء به الغزالي في “مقاصد الفلاسفة”، و”تهافت الفلاسفة”، وما يراه رجال الدين فيها، وهو ما يُشكل النظرة المثالية في الفلسفة. كذلك أن العديد من الفقهاء اليوم يحرمون الفلسفة، بل يقصون من يتحدث بها من زملائهم، لأنهم يجدونها خارج الفكر الديني، وهم لا يعرفون ولا يريدون التعرف عليها، وكأنهم يخشون حججها العقلية، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة، والسبب أن من يتعلم الفلسفة يقدر على التمييز بين الأفكار، ومعلوم أن الفلسفة صناعة العقل، والدين صناعة الوحي.
لم يكن عالمنا قبل عقود من الزمن حيادياً، بل اتسم بوجود قطبين فكريين، يتمثلان في الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي. فأخذ على سبيل المثال في شأن تدريس الفلسفة، كتجربة عشتها وساهمتُ لأكثر من عشر سنوات فيها، وهو ما كان بين جمهورية اليمن الديمقراطية (عدن) والجمهورية العربية اليمنية (صنعاء)، فكانت المدارس حسب النظام الأول تُدرس الفلسفة المادية، من فلاسفة الإغريق والفلاسفة المسلمين، وتدرس الماركسية بماديتها الديالكتيكية والتاريخية والاقتصاد الاشتراكي، وتميز بينهما على أنها المادية والمثالية، فيتم تدريس فلسفة أفلاطون برفض، بينما يُنظر إلى فلسفة ديمقريطس الذرية بقبول، وتدرس مقالات الأشاعرة برفض بينما تُقدم مقالات المعتزلة بقبول ونوع من التمجيد. يُعكس الأمر تماماً في نظام صنعاء، فما هو مقبول بعدن مرفوض هناك. أتذكر جيداً كانت صنعاء تأتي بالشيخ الشعراوي من مصر ليُقدم برنامجاً في رمضان يمتدح فيه الرأسمالية ويذم فيه الاشتراكية، ومن وجهة نظر دينية بحتة، وبالمقابل لدى عدن برامج تؤكد عكس ذلك.
في هذه الحال، يصبح المتلقي تابعاً لنهج أيديولوجي واحد في تدريس الفلسفة، وكأنه يعيش أيام مواجهات المعتزلة والأشاعرة، أو الغزالي وابن رُشد، الذي رد عليه، بعد سنوات طويلة بكتاب “تهافت التهافت”، فما بينهما مئة عام تقريباً. فكان الطالب لا يتعلم الجدل والحوار أو النقاش ليُعد للمناظرة والإبداع الفكري، إنما يصبح تابعاً لفكر أو منهج محدد له مسبقاً، فيظهر التشدد والتطرف، وما جرف التطرف الديني آلاف الشباب، إلا لأنهم لم يتعلموا غير المقالات الدينية، فمن الخطورة أن يضم منهج المدرسة مواد دينية عدة، فيتخرج الطالب وهو لا يعرف غير ما لُقن به من أفكار، وأي فكر آخر يعتبره فكراً معادياً.
نعم، في تدريس الفلسفة فائدة كبرى، وهي تعلم المحاججة والجدل القويم، وعدم الخضوع لفكر معين، بشرط ألا تُقدم الفلسفة على أساس منهج قطبي (مع وضد)، إنما تُقدم المادة الفلسفية كتاريخ للفلسفة وما ظهر مِن أفكار، بشكل محايد، وتُعرض الأفكار العلمية الإيجابية فيها، على أنها أفكار من دون تحديد الصواب والخطأ فيها. تٌعرض نظرية أفلاطون المعروفة بنظرية “المُثل” أو “النماذج”، وتُعرض نظرية أرسطو “الصورة والمادة”، وتعرض نظرية ديمقريطس في تشكيل الأجسام من الذرات، وكذلك الحال بالنسبة لفكرة المدينة الفاضلة مثلما هو الحال عند الفارابي وأساسها “الجمهورية” عند أفلاطون، وأن تُدرس العلاقة بين المادة والحركة والنظريات التي عكستها، بمعنى ألا يكون هناك تثبيت الحق والباطل في الأفكار، إنما تُقدم كحركة أفكار لها زمانها ومكانها.
أن تُربط الأفكار الفلسفية بزمنها، فالأنظمة التعليمية التي قدمت جماعة إخوان الصفا، على سبيل المثال، كجماعة من الكفار، واعتبرت نظرية داروين باطلة، على أساس الفكرة الدينية، خلقت مصاعب للأجيال، وجعلت منهم جنوداً للجماعات المتطرفة، لأنها قدمتهم كمتعصبين لفكر أو فلسفة محددة.
لستُ مع ترك الحرية للمدرس، بل مع ترك الحرية للطالب، وفق المناهج الخاصة بتدريس الفلسفة، والسبب أن الجماعات الدينية قد توغلت في التعليم كثيراً، وكان التعليم مجالها المهم في عملها التنظيمي والفكري، فليس بعيداً أن يتجه المدرس المؤدلج بالطلبة إلى براثن التعصب والتطرف، لأن الفلسفة على الضد من الأيديولوجية التي تعطي إجابات جاهزة. بمعنى الاختيار الدقيق لمدرس الفلسفة وتدريبه بشكل جيد، على أساس الهدف المنشود وهو تعليم الطالب وتربيته على الجدل البناء والتمحيص بين الأفكار، كي لا يكون تابعاً، وهذا ما يضمنه تدريس الفلسفة إذا قُدم بشكل صحيح في المدارس، ليس على طريقة المواجهة بين صنعاء وعدن، على سبيل المثال لا الحصر، وخارج ذلك ستكون الفلسفة رياضة للعقول، أي أن الطالب بفضلها سيكون مطعماً ضد الاعتقاد الجاهز، وبالتالي يصبح مقاوماً للتطرف والغلو.