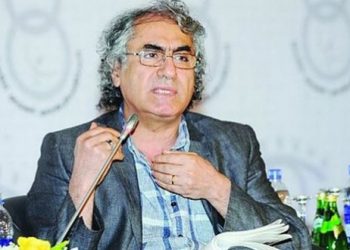آدام جارفينكل*
آلت حرب العراق الثانية التي انطلقت شرارتها الأولى في مارس (آذار) 2003 إلى أكثر النهايات مأساوية على الإطلاق، وانتهت بأكبر كارثة فاجعة للسياسة الخارجية الأمريكية، حيث تكاد تضاهي حرب فيتنام من حيث الآثار المدمرة التي خلَّفتها وراءها –بل إن حرب العراق الثانية كانت أشد دماراً وأكثر خراباً من حرب فيتنام بالنسبة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط– ذلك أن حرب العراق أفضت إلى الإطاحة بنظام البعث الذي كان متحكماً في مقاليد الأمور في العراق، ومسيطراً عليها بحسبانه الأداة الأنجح والأنجع في كبح جماح أطماع نظام الملالي في إيران؛ وهو النظام الذي أثبت منذ ذلك الحين أنه أكبر مصدر لنسف الاستقرار ونشر العنف في المنطقة؛ وما كان له أن يكون كذلك لولا نشوب حرب العراق الثانية وانتهائها إلى ما انتهت إليه.
أما الذريعة المنطقية الاستراتيجية –أو دعنا نَقُلْ المسوغات والأسس المنطقية كما سنرى– من وراء الحرب، فهي لم تكن غير عقلانية تماماً، ولم تكن غريبة الأطوار إلى أبعد الحدود؛ أياً كان مدى التشويش الذي اعترى الحجج التي سيقت لتسويغ تلك الحرب، وبالغاً ما بلغت أوجه سوء الإدارة وملامح ضعف التدبير التي تجلَّت بوضوح في الجوانب العملياتية للحرب المذكورة. بيد أن ما نواجهه في هذا المقام ليس هو التصنيف المتعلق بما لم يكن على ما يرام في التاريخ التقليدي، وإنما التصنيف المتعلق بما جرى بسطه في الجزء الأول من هذه السلسلة من المقالات حيال ما اندرج تحت منزلة المفقود وما كان ينبغي القيام به، ولم يتم في مجمل ما تم طرحه في الروايات السردية الرئيسة.
طرح كبار المسؤولين في إدارة جورج وولكر بوش جملةً من الأسباب التي أفضت إلى الحرب في مرات عديدة وفي مناسبات مختلفة خلال المرحلة التمهيدية لدق طبول الحرب. وقد تغيرت تلك الأسباب من حيث تأطير بؤرة التركيز وتحويل بوصلة التوجهات مع بداية اندلاع مرحلة المقاومة الأولية والانتفاضة العراقية ونشوب الحرب الأهلية الطائفية. فقد جادل البعض -على سبيل المثال- بأن تقدُّم “استراتيجية الحرية” المتمثل في هدف بوش دفع الديمقراطية والمضي بها قدماً، وهو الهدف المستبطن في تعبير كاتبي الخطابات عن توهُّم الحمقى بأن نشر الديمقراطية في العالم العربي إنما هو أمر سهل التحقيق وقريب المنال، ويمكن أن يتم خلال مدة وجيزة بالمقارنة مع التحدي الماثل المتمثل في الإرهاب الذي عمت به البلوى. لم يكن للوهم المتقدم ذكره أن يتنامى إلا بعد أن انهار أي مسوغ وهوى أي أساس منطقي، وغاب أي سبب وجيه لانتشار أسلحة الدمار الشامل نتيجة للفشل الذريع في اكتشاف الأطنان المزعومة من أسلحة الدمار الشامل.
ما سبق بيانه ليس صحيحاً البتّة. فقد ثبت من واقع الخطاب الذي ألقاه بوش في فبراير (شباط) 2002 في معهد الأعمال الأمريكية (AEI) أن صيغة من المثالية المحميّة بالسلاح كانت بالفعل مختمرة -إلى حد بعيد- في مخيلته خلال الفترة العصيبة الفاصلة بين سبتمبر (أيلول) 2001 ومارس (آذار) 2003. ولما كان بوش قد خضع من قبل للعلاج من إدمان الخمر، فقد كان بطبيعة الحال قابلاً للتأثر بالطقوس وما في حكمها، مما يتمثل في هذه الحالة في ما يتم تقديمه عن طريق مرتادين درجوا على الحضور في البيت البيضاوي، ضمن آخرين، بمعية المهاجر اليهودي السابق ناتان شارانسكي الذي كان أيقونة لنضال اليهود للهجرة من الاتحاد السوفيتي، ثم أصبح رمزاً للتطرف السياسي في إسرائيل. وكان بوش كرئيس للجمهورية يختط نهجاً قائماً على أساس فكرة الخلاص العام وليس على الوسائل والأساليب المرحلية. وبكل حال اكتسب هذا المسوغ مزيداً من الزخم والانتشار والرواج، بعد الفشل في اكتشاف أي من أسلحة الدمار الشامل في العراق.
كان الرئيس بوش خلال تلك المدة الفاصلة هدفاً للعديد من المحاولات المستميتة للاستمالة والإقناع. أما السبب وراء ذلك، فيكمن في تلافيف السياسة. فقد كان بعض كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية يرغبون في إشعال فتيل الحرب في بعض الأحيان على خلفية الخوف غير المبرّر بشأن الكيفية التي انتهت بها حرب 1991 وما آلت إليه بعد أن ظل صدام صامداً وباقياً على سدة الحكم؛ حيث كانوا على إدراك بأنه ما لم يتم غزو العراق ودحر العراقيين في الحال، فإن الانخراط في انتخابات 2004 قد يغري الرئيس بالتريث وعدم العجلة. فما من أحد يرغب في معاودة الترشح وخوض غمار الانتخابات مجدداً في حين أن النعوش والتوابيت -قليلةً أو كثيرةً– كانت تأتي تباعاً وتصل يوماً بعد يوم إلى أرض الوطن.
أما الأسوأ مما كانوا يتوقعونه، فهو أن الفريق المنحاز للحرب في الإدارة الأمريكية كان يخشى من أنه إذا خرج بوش خاسراً من معركة إعادة الانتخاب، فإن المرشح الديمقراطي السيناتور جون كيري لن يقرر الذهاب إلى الحرب في حالة فوزه في الانتخابات. لقد كان هذا هو السبب الرئيس للضغط الذي مورس على الرئيس بوش من جميع أفراد بطانته. وهو الضغط الذي خطط له -إلى حد بعيد- نائب الرئيس ديك تشيني ووافقه عليه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد بعد تردد وتلكؤ (بعد تفكيره لاحقاً) ولكن تمت متابعته بإصرار وإلحاح من قبل نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ورهط من مرؤوسيه المباشرين في الوزارة.
وأما بوش نفسه، الذي أطلق على نفسه لاحقاً مسمى “صاحب القرار”، فقد كان شديد الحذر، متوخياً أقصى درجات الحرص والحيطة في اتخاذ القرارات، التي كان من بينها قرار الذهاب إلى الحرب في العراق، وقد خاض حملة ترويجية لسياسة خارجية أكثر تواضعاً وأقل طموحاً؛ وكان واعياً بما فعل وقاصداً متعمداً لفعله: ففي حين أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أطاحت بفرصته للشروع في تطبيق السياسة آنفة الذكر، فإن تفكيره ما فتئ متأثراً بقراره المتخذ سلفاً -حتى إن إقدامه على خوض غمار الحرب جعل من القلق صفةً ملازمةً له وأمراً متأصلاً فيه.
وأما ريتشارد بيرل المسؤول السابق بوزارة الدفاع الأمريكية، والذي سيرد عنه المزيد من التفاصيل فيما بعد، فقد أومأ ذات مرة إلى طريقة بوش في اتخاذ القرارات، واصفاً إياها في حوار خاص بأنها “حاسمة بشكل مضطرد”؛ وكان محقاً في وصفه. عندما يكون بوش متأكداً من إلمامه بموضوعٍ ما، ومن أخذه بناصية ذلك الموضوع، كان يتصف بالجزم والحسم والحزم في الإعلان عن ذلك الموضوع وتوجيهه؛ ولكنه عندما يكون غير متأكد من رأيه وغير مستيقن به، يلجأ إلى التسويف والمماطلة والتهرب من اتخاذ القرار، فيجعل كبار مساعديه في حالة مستديمة من التجاذب والتصادم إزاء الموضوع المطروح على بساط البحث والنقاش –الأمر الذي أثر أيما تأثير في اتخاذ القرارات بشأن كوريا الشمالية وإيران على سبيل المثال. ولأجل هذا فإن السبب في بعض التوترات الداخلية متطاولة الأمد، إنما يعود إلى خطأ في شخصية الرئيس نفسه.
لقد كان منطق الانتظار صائباً وسديداً، لا سيما وأن التهديد المتمثل في انتشار أسلحة الدمار الشامل في العراق، خاصة ما يتعلق منها بالأسلحة النووية، لم يكن تهديداً ماثلاً، ولا ينطوي على أمر عاجل. صحيحٌ أن تأثير منطقة حظر الطيران تضاءل وأن أثرها اضمحل، كما أن الاهتراء اعترى نظام العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة بعد حرب 1991. وكان مسؤولو الإدارة الأمريكية قلقين أيما قلق من أن العراقيين قد ينجحون يوماً ما في إسقاط طائرة أمريكية من الطائرات التي تجوب منطقة حظر الطيران. ثم ماذا بعد؟ مهما يكن من أمر، فإن تلك المخاوف لا تبرر البتَّة إطلاق عمليات حربية استباقية كبرى، أو حتى أي شيء على غرار القصف المتهور الذي أقدمت عليه إدارة كلينتون عام 1998 تحت مسمى “ثعلب الصحراء”، وهو الذي أفضى إلى إغلاق العراق بالكامل، وإيصاد بابه تماماً أمام مفتشي الأمم المتحدة، مما أدى إلى زيادة الشكوك ورفع مستوى عدم اليقين إزاء ما كان يقوم به العراقيون وإلى أين وصلوا وماذا أنجزوا.
فضلاً عما تقدم، لم تكن الحرب في أفغانستان قد وضعت أوزارها بعد؛ كما أن العمل قد بدأ للتو في تشكيل حكومة مستقرة في كابول، مع إعادة التعمير والتنمية في دولة طالما عانت من ويلات الحرب الأهلية ومن غزو سوفيتي استمر لعقد من الزمان، فضلاً عن موجات العصيان والتمرد التي كانت تتدافع موجةً إثر أخرى. لعل هذا هو ما دفع الجنرال برنت سكوكروفت مستشار الرئيس جورج وولكر بوش للأمن الوطني، إلى أن يجادل في مقال شهير نشره في “واشنطن بوست” ويسوق الأدلة ويقدم الحجج واحدة تلو الأخرى ضد شن الهجوم على العراق. وأغلب الظن أن هذا هو ما جعل ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي يدلي بالعديد من المزاعم المفرطة في الغلو والموغلة في التطرف، والتي لا تقوم على أي سند أو أساس حيال تقدُّم العراق في اتجاه بناء قدراته للأسلحة النووية. وقد أورد تشيني تلك المزاعم بعد مدة وجيزة في خطاب له أمام قدامى المحاربين المشاركين في الحروب الخارجية (VFW).
كان الخطاب المذكور أعلاه من مسؤول كان أقرب ما يكون في إدارة بوش ممن أدلوا بترهات وأباطيل عن برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقل مثل هذا عن ملاحظة أبدتها كونداليزا رايس التي كانت وقتها تشغل منصب مستشارة الأمن الوطني، وهي ملاحظة أبدتها عفو الخاطر وابتدرتها بطريقة تلقائية مرتجلة دونما سابق تدبير أو إعمال للفكر، عندما تحدثت عن “سُحُب الفِطْر” أو “سحب فطر عيش الغراب (mushroom clouds)”، كنايةً عن وجود أسلحة نووية في العراق (يشار إلى أن سحابة عيش الغراب هي سحابة تأخذ شكل فطر عيش الغراب، وتتكون من دخان كثيف ولهب وحطام، ناتج عن انفجار هائل؛ وفي الغالب يتم الربط بين هذه السحابة والانفجارات النووية). كان ذلك الغلو في إطلاق التصريحات المتطرفة أمراً مقصوداً في حالة تشيني، إن لم تكن كذلك في حالة كونداليزا رايس، للإسهام في اتخاذ القرار لخوض غمار الحرب. ومن ثم فإن تلك التصريحات لم تكن كذبات بَلْهاءَ أطلقها أصحابها عمداً وعن قصد عن حقائق تتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق. فهي -إذن- أخطاء ولكنها ليست أكاذيب أو أساطير حضرية أو خرافات معاصرة.
من الملاحظ أن الكثير جداً من الروايات ذات المصداقية أو الجديرة بالثقة من المصادر الخاصة بحرب العراق لم يرد فيها أي ذكر للتوقيتات والجداول الزمنية أو الحسابات السياسية التي بموجبها يتحدد الإطار الزمني للحرب. أما السبب، فهو ليس سراً باتعاً: ذلك أن الذين لم يسبق لهم قط أن عملوا في السلك الحكومي يُتوقَّع منهم أن يتغاضوا عن الرابط بين السياسة والشؤون السياسية، وحريٌّ بهم أن يكونوا كذلك؛ أولئك الذين يرون أن من الأفضل من حيث التقدير ألا يأتوا على ذكر المواعيد الزمنية والحسابات السياسية، مع أن ذلك من العوامل الحاسمة في مثل هذه الحالة وفي العديد من الحالات الأخرى. وفي الحالتين آنفتي الذكر كلتيهما، في مقال سكوكروفت وفي خطاب تشيني، كان المستهدف الأول الذي وجهت إليه الحجة وسيقت إليه البيِّنة هو جورج وولكر بوش، وهو رجل من المؤكد أنه تفهَّم تأثيرات الروزنامة السياسية وأدرك تداعياتها –ذلك أن تجاهل البعد السياسي إنما يعني عدم إدراك تأثير ما كتبه سكوكروفت في عموده في لحظة فارقة وحاسمة؛ كما أنه يعني إساءة فهم كنه الغلو في تصريحات تشيني، فضلاً عن أنه يجعل من شرح الأمر وتبيانه ضرباً من المحال فيما يتعلق بإطالة أمد المعركة، وما يعنيه ذلك بالنسبة لعقلية جورج بوش.
حتى العالِم العظيم الضليع الملم بشؤون الشرق الأوسط بيرنارد لويس، الذي أصبح وقتها طاعناً في السن، تم إقحامه عنوةً في الخدمة، في هذه الحالة عن طريق موظف في وزارة الدفاع يدعى هارولد رود، وكان ذات يوم أحد تلاميذ لويس في جامعة برنستون، كما كان مقرباً من وولفويتز ومن سكوتر ليبي مستودع أسرار تشيني. أما كيف، وإلى أي مدى، كان لويس مقتنعاً في ذلك الوقت، فهذا أمر غير واضح بالنسبة لي؛ إذ إنني لم أكن على إلمام بفحوى ما دار من نقاش بين لويس والرئيس، ولكنني حضرت حديثاً أدلى به بروفيسور لويس في معهد الأعمال الأمريكي (AEI) في ربيع عام 2002، حيث تكلم وقتها بوضوح شديد في رد على سؤال وجهه إليه أحد الحاضرين، إذ أورد ما مفاده أنه بينما يتعذر فرض الديمقراطية على بلد مثل العراق عن طريق إملاءات خارجية، فإنه سيكون من العسير جداً، وقد يستغرق وقتاً طويلاً للقليل من مسوغات المواقف والأسانيد، إن وجدت، لزرع ثقافة ديمقراطية في التاريخ العراقي. وأشار لويس ضمناً إلى أن تكلفة مثل هذا المشروع لا تستحق عناء النظر إليها حتى في الظروف الحالكة وبالغة الحرج.
إذا قُدِّر للبروفيسور بيرنارد لويس أن يؤتى به لاحقاً لمساندة حرب ضد العراق لسبب أو لآخر، فلن يُفْصِحَ عن ذلك على الملأ، ولن يعلنه على رؤوس الأشهاد. وليس لمثله بأي حال أن يبدي الرأي في أفضليات سياسية بشأن أمر معاصر. فهو يرى نفسه مؤرخاً وليس من شيمته الانغماس والإيغال في الشأن السياسي. وهو أيضاً يكنُّ احتراماً ويبدي تقديراً سليماً للغاية للتقاطعات والصعوبات التي تكتنف عملية رسم السياسات.
إنه لم يقل ذلك، لي أنا على أقل تقدير، ولم يقله للخاصة. وقد حصلت على إذن من رئيس هيئة الأركان المشتركة بوزارة الدفاع عام 2004 لتوجيه الدعوة إلى البروفيسور لويس لمخاطبة حضور خاص من كبار الضباط والمسؤولين رفيعي المستوى. (كان من ضمن المهام الموكلة لي في مجموعة تخطيط السياسات أن أتولى تنظيم حلقة دراسية عن شؤون الشرق الأوسط). كان البروفيسور لويس الذي أعرفه منذ سنوات عديدة يشعر بالعرفان والامتنان وهو يشرح كيف أن إدارة بوش كانت أول إدارة ضمن سلسلة من الإدارات التي لم توجه له الدعوة للتحدث على مستوى وزارة الخارجية.
كنت على علم بذلك، ولكنني غيرت الموضوع وحولت دفة النقاش. فقد تعرض لويس للأذي -ويا للحسرة- بضربة مزدوجة من وزارة الدفاع ومن وزارة الخارجية على حد سواء، من جراء ما كان دائراً بين الوكالات الحكومية من سجال وجدال وشجار، خلال الفترة الرئاسية الأولى لجورج بوش الذي تقلد منصب الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. وقد حاولت أن أضفي شيئاً من الشعور بالأمان من خلال استقطابه للتحدث في وزارة الخارجية، إلا أن محاولتي باءت بالفشل؛ وهذا قصارى ما يمكنني قوله في هذا الصدد. وفي أثناء مأدبة غداء أقيمت على شرفه بعد أن ألقى عرضه التقديمي بقينا -هو وأنا فقط- في صالة تقديم الطعام بالطابق الثامن، فحاولت استخلاص أي تصريح منه ينم عن دعمه وتأييده للذهاب إلى الحرب، ولكنني لم أفلح في الحصول منه على أي تصريح من هذا القبيل. بيد أنه مع انهيار مسوغ أسلحة الدمار الشامل واندلاع التمرد، ربما شعر وقتها بأنه ليس ملزماً باستذكار نصيحة ربما تم تقديمها بطريقة تعوزها الحكمة وتفتقر إلى الرَّوِيَّة. بل وربما انتابه الشعور بالتأنيب والندم لتخليه عن مقولة: “إنني مؤرخ ولست نبياً”. أو ربما هكذا بدا لي.
ثمة مسوغ آخر للحرب كان الأوسع انتشاراً، ولكنه الحجة الأبلغ تأثيراً من بين ما جرى طرحه خارج أروقة الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت، هو ما جرى طرحه من قبل الصحافي توماس فريدمان؛ وهو كاتب عمود في نيويورك تايمز. جادل فريدمان بأن الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان لم تكن كافية لإثبات جدية الولايات المتحدة في منع وقوع هجوم جديد، ليس على الولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضاً على إسرائيل والدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين للولايات المتحدة الأمريكية. وكتب توماس فريدمان قائلاً ما مفاده: “يجب على أمريكا أن تأخذ رهناً” من العالم العربي لترسيخ سمعتها وتسخيرها في الجهود الكبيرة التي ستُبذل لاحقاً. وإلا فإن هذا يؤدي إلى ما كان من الممكن أن يندرج تحت منزلة المفقود، وضمن فئة ما ذهب أدراج الرياح.
لقد أصبحت أسطورة حضرية أو خرافة عصرية صغيرة، تلك التي كانت تحكي عن أن المسؤولين الإسرائيليين كانوا من المؤيدين لخوض غمار الحرب في عامي 2002-2003. فقد كان بعضهم من القادة الأكثر وعياً وحكمة في إسرائيل؛ ولذا سرعان ما أدركوا أن المستفيد الأكبر والرئيس من الإطاحة بنظام البعث هو نظام الملالي في إيران. فقد كان المسؤولون الإسرائيليون مشغولين ومهمومين بالجهود العراقية لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، ولكن ليس بنفس درجة انشغالهم واهتمامهم بالجهود الإيرانية في هذا الخصوص. وقد جاء هذا برداً وسلاماً على معظم الحكومات العربية، وما انفك الأمر ماضياً وفق شروط ميسَّرة لتلك الحكومات مع الولايات المتحدة.
درج الاستراتيجيون والأخصائيون العسكريون في إسرائيل على استخدام لغة اصطلاحية عند التحدث عن العمليات العسكرية وما في حكمها. ولعل المصطلح الأوثق صلة هو ما يُستخدم للتمييز بين العمليات الكبرى، تحت مسمى “جليد كبير (Big Snow (sheleg gadol)”، والعمليات الصغرى وتسمى “الجليد الصغير Little Snow (sheleg katan)”. وإذا كان الأمريكيون سيهاجمون العراق، فإن معظم الخبراء الإسرائيليين كانوا يفضلون نوعاً من العمليات التي لا تؤدي إلى مساعدة إيران وإنما إلى تقييدها وكبح جماحها. وإذا كان للولايات المتحدة أي حضور عسكري لقواتها في أفغانستان على الحدود الشرقية لإيران، فإن وجود حضور عسكري آخر في العراق على الحدود الإيرانية الغربية، من شأنه أن يضع إيران في بين فكّيْ كمَّاشة أو -إذا شئتم- بين المطرقة والسندان. ومع أن النظامين الأفغاني والعراقي أطيح بهما بطريقة سهلة نسبياً، فإن الوضع المذكور آنفاً يمكن استبعاده عند قراءة أعمال الشغب والقلاقل لنظام الملالي: لم يعد هنالك دعم للإرهاب، ولن يكون هنالك نشاط سري لامتلاك الأسلحة النووية أو خلافه.
ومع حدوث ما حدث، كانت تلك الخاطرة الأساسية (مشعشعة) في أذهان بعض الأميركيين أيضاً؛ حيث كان أحدهم هو ريتشارد بيرل الذي كان أول رؤسائي المباشرين في واشنطن عندما عملت لمدة وجيزة عام 1977 ومرة أخرى عام 1979 لدى السيناتور هنري جاكسون، الذي لم يشغل منصباً رسمياً في إدارة بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة، كتلك المناصب التي كان يشغلها في الإدارات الجمهورية السابقة، ولكنه كان يعرف جميع المسؤولين الكبار. وكان فكره ذا وزن وقيمة؛ ومع وضع قوة الولايات المتحدة قيد الاستخدام، كانت تلك الرؤية ذات جاذبية منطقية معتبرة لدى البعض. وقد كان دائماً من الأمور المحفوفة بالمخاطر أن يتم إقحام قوة أرضية أمريكية في قلب العالم العربي؛ والشيء الوحيد الذي يمكنه تسويغ ذلك الإقحام في هذه الرؤية إنما يتمثل في وجود هدف كبير كبر المخاطرة التي اقتضته؛ وهي سياسة مفهومة كفرصة رئيسة وليس كرد فعل دفاعي أتى استجابة لتهديد ماثل.
بيد أن الأمر قد يستدعي وجود عدد كبير جداً من القوات الأمريكية لممارسة الضغط المطلوب على إيران، وربما يكون هنالك حضور مستدام طويل الآمد. أما الفوائد والمزايا، فقد تكون مذهلة لأنها قد تكون مقدِّمة لإصلاح جذري للنظام الإيراني، بل وربما تضع النهاية لذلك النظام. ويمكن لذلك أن يحد من انتشار المذهب الجهادي والانجذاب نحوه على نطاق العالم، على المستويين السني والشيعي. وبذا قد يؤدي ما تقدَّم إلى السماح بتحقيق التحرر السياسي بقدر أكبر في بعض الدول العربية على أقل تقدير؛ وقد يفتح ذلك الباب على مصراعيه أمام الاستيعاب والاندماج الإسرائيلي– السوري، ومنع حزب الله من أخذ السياسة اللبنانية رهينة كما ظل على هذا الدأب طوال تلك السنين. إلا أن الأشخاص المعنيين، وتحديداً رامسفيلد، وكذا السياسات التي صيغت لمتابعة تلك السياسة بعيدة الشأو وتنزيلها على أرض الواقع، مع استحالة ذلك، ومع منطق مصطلح الجليد الكبير الذي لم تتم مناقشته إلا داخل أجزاء محدودة من المنظومة الحكومية –حسب علمي– فإن ذلك كله سرعان ما خفت بريقه وخبا أواره وتوارى عن دائرة النقاش وسقط من أجندة الحوار عندما اتجهت البوصلة نحو دق طبول الحرب.
أصبح ما سبق بيانه بمثابة المسوغ الرئيس ذي الجاذبية السياسية الكبرى، حتى للديمقراطيين، متجسداً في الخطر المحدق المتمثل في احتمال امتلاك التنظيمات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل واستخدامها ضد الولايات المتحدة. وقد تضاعفت تلك المخاوف وتفاقمت من جراء ظهور الجمرة الخبيثة ذات المصدر الغامض، والتي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) بفترة وجيزة. وكان المصدر الأرجح لمواد أسلحة الدمار الشامل هو العراق، حسب افتراض الجميع وقتها.
وقد ذهب المنطق حينها إلى أن صدام حسين كان يرغب في الثأر لنفسه والانتقام من الولايات المتحدة؛ لإقدامها على طرد الجيش العراقي من الكويت عام 1991. ويرى البعض أن صدام كان يرغب في مهاجمة إسرائيل –ليس بمجرد صواريخ سكود كما حدث عام 1991، وإنما بأسلحة بقوة تدميرية ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية- ليصبح الملك البطل المتوج على العرب.
جاء تحليل المعلومات الاستخباراتية في صالح ذلك الاحتمال، وخلص التحليل إلى أن الهوية الشخصية لصدام، بانتمائه للسنَّة وبوصفه من العلمانيين، ليس فيها ما يردعه عن التعاون بطريقة إجرائية كاملة الدسم مع المجموعات الإسلامية الشيعية أو السنية، طالما أن ذلك يصب في خدمة أغراضه. فإذا كانت المعلومات الاستخباراتية عن البرامج العراقية لأسلحة الدمار الشامل، وعن تكدس تلك الأسلحة في العراق، ذات مصداقية في ذلك الوقت في الأوساط الحكومية الأمريكية وفي غيرها، وإذا جاز لأحدهم أن يقبل بالمنطق الذي جرى بسطه آنفاً، وبصفة خاصة إذا أدى أحدهم القَسَم لشغل منصب حكومي، وأخذ على نفسه عهداً بالذود على الأمة والذَّب عن حياضها، ثم أصبح يميل نحو الاصطفاف إلى جانب من ينشدون السلامة، فإذا كان ذلك كذلك، يضحي من السهل إذاً إدراك كنه التوجه العام للفكر الأمريكي في ذلك الوقت. ويسهل أيضاً إدراك الأسباب والدواعي التي استوجبت اتخاذ ذلك التوجه على وقع إيقاع الوحدة الوطنية التي تبلورت بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) مما أفضى إلى وضع التهديد الخاص بأسلحة الدمار الشامل في العراق في لب العديد من المسوغات، حيث تم تبني ذلك بطريقة حظيت -إلى حد بعيد- بتأييد الحزبين سواءً بسواء.
لهذا السبب، ضمن أسباب أخرى، ما كان لأحد أن يتخيل وقتها رجوعاً إلى الأشهر الأخيرة من عام 2002 وفي منتصف شتاء 2003، أن الكارثة المتخيلة التي دُرِئَتْ آثارها ستكون هي الحرب. بيد أن الخيال غالباً لا يصبح واقعاً وبصفة خاصة لدى المجموعات. والنتيجة دائماً تكون هي ذاتها: الدهشة والذهول والاستغراب. للوقوف على كيفية حدوث ما حدث، ترقَّبوا الجزء الثالث من هذه السلسلة من المقالات –وهو جزء سيظهر قريباً.
* آدام جارفينكل: كاتب عمود لدى مركز المسبار، كما أنه عضو بهيئة تحرير مجلة “أمريكان بيربوس (American Purpose)” في واشنطن. عمل خلال الفترة من 2003 إلى 2005 كاتباً لخطابات وزير الخارجية –ملتحقاً بمجموعة تخطيط السياسات بالوزارة. هذا المقال هو الأول في سلسلة مخطط لها من خمسة أجزاء.