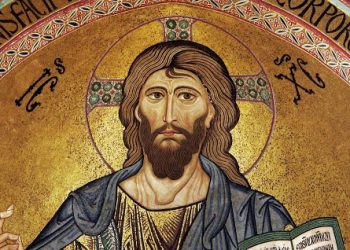اضطلع القرآن في كل الأزمنة بدور حاسم في الحوار بين المسيحية والإسلام. والأكيد أن سبب الحضور القوي للقرآن في هذا السياق الخاص يعود إلى كونه قد مثّل دائما المصدر الإسلامي الأكثر يسرا للمراجعة، خاصة إذا ما قارناه بالسنة النبوية التي يصعب التعامل معها على غير المتخصصين. ويفسّر هذا الوضع اللقب الذي كثيرا ما أطلق على القرآن، لاسيما بعد التقدّم العثماني في أوروبا الوسطى، فقد أطلق عليه «الكتاب المقدس التركي» «Bible Turque». ويبدو لنا اليوم ميسورا جدّا الحصول على نسخة من المصحف، لكن الأمر لم يكن على هذا الشكل في بداية الإسلام. ففي العهد العمري الشهير وقع النص على أن أهل الذمة يلتزمون بأن لا يعلموا القرآن لأبنائهم، بعبارة أخرى، كان القرآن مخصوصا بالعرب من دون غيرهم، ثم أصبح شيئا فشيئا متاحا للمسلمين ذوي الأصول الفارسية أو التركية من الذين اعتنقوا الإسلام حديثا، ولم يكن في وسعهم أن يمتلكوا نسخة منه.
اضطلع القرآن في كل الأزمنة بدور حاسم في الحوار بين المسيحية والإسلام. والأكيد أن سبب الحضور القوي للقرآن في هذا السياق الخاص يعود إلى كونه قد مثّل دائما المصدر الإسلامي الأكثر يسرا للمراجعة، خاصة إذا ما قارناه بالسنة النبوية التي يصعب التعامل معها على غير المتخصصين. ويفسّر هذا الوضع اللقب الذي كثيرا ما أطلق على القرآن، لاسيما بعد التقدّم العثماني في أوروبا الوسطى، فقد أطلق عليه «الكتاب المقدس التركي» «Bible Turque». ويبدو لنا اليوم ميسورا جدّا الحصول على نسخة من المصحف، لكن الأمر لم يكن على هذا الشكل في بداية الإسلام. ففي العهد العمري الشهير وقع النص على أن أهل الذمة يلتزمون بأن لا يعلموا القرآن لأبنائهم، بعبارة أخرى، كان القرآن مخصوصا بالعرب من دون غيرهم، ثم أصبح شيئا فشيئا متاحا للمسلمين ذوي الأصول الفارسية أو التركية من الذين اعتنقوا الإسلام حديثا، ولم يكن في وسعهم أن يمتلكوا نسخة منه.
وإذا حصل أن امتلك مسيحي نسخة من المصحف فإنه يمتلكها بصفتها غنيمة حرب. هكذا امتلكت بعض المكتبات في أوروبا نسخا من المصاحف قبل فترة طويلة من إنشاء الجامعات الأوروبية. فعلى سبيل المثال كانت مكتبة الفاتيكان تمتلك بعض النسخ من المصاحف منذ حوالي السنة الألف. أما المكتبة الوطنية بميونيخ (ألمانيا) فهي تحتفظ بنسخة من الغنيمة تحمل الرمز: مخطوط عربي 2-3 (Ms. Arab. 2-3)، وتتمثل في مصحف أعدّ سنة 1306 ليقدّم للحاكم المريني أبي يعقوب يوسف بن يعقوب (1286-1307) ثم اشتراه لاحقا يوحنّا ألبرشت فيدمانستلير(Johann Albercht Widmannsteller) وهو مثقف إنسوي ألماني عاش في القرن السادس عشر (1508-1558). ثمة نسخة أخرى من المصحف أكثر أهمية، فقد أعدّت سنة 1227 بإشبيلية ونقلت إلى شمال إفريقيا، وبالتحديد إلى تونس، بواسطة لاجئين مسلمين. ثم عاد هذا المخطوط إلى أوروبا بعد أن غزا شارل كانت (شارلكان) تونس سنة 1535، وهناك، في أوروبا، بادر فيدما نستلير باقتنائه أيضا، ونرى عليه إلى اليوم الهوامش التي سجلها عليه، وهي تؤكّد أن هذا الكاتب الإنسوي قد درسه دراسة معمّقة ودقيقة.
لدينا شهادة مشابهة يثبتها مخطوط كان في فترة قديمة على ملك مكتبة فيدمانستلير نفسه، وقد ورد إليها من مدينة بيلوس (Bellus) من جاتيفا (Jativa) ويعود تاريخه إلى سنة 1518. يحتوي هذا المخطوط أيضا على العديد من التقييدات، لكنها ليست مكتوبة هذه المرة باللّغة اللاتينية وحسب، إنها مكتوبة بالإسبانية أيضا. وعندما توفي فيدمانستلير سنة 1558 بادر ألبرشت الخامس، دوق البافيير، باشتراء المخطوطات والكتب التي كانت على ملكه وضمها إلى مكتبته. إنّ هذه المصاحف الثلاثة التي تحدثنا عنها تشهد على بدايات الدراسة القرآنية في أوساط المتعلمين المسيحيين بأوروبا.
نعلم، إضافة إلى ذلك، أن فيدمانستلير كان يعتزم ترجمة القرآن لكنه توفي وفاة مبكرة فحال ذلك مع الأسف من دون إنجاز هذا المشروع. بيد أننا نحتفظ منه بما يمكن وصفه بـ«تلخيص» للترجمة اللاتينية للقرآن، التي أمر بطرس المبجّل (Petrus Venerabilis) روبرت الكتوني (Robert de Ketton) بإعدادها في أسبانيا سنة 43-1142. ولم تكن هذه الترجمة متقيدة بحرفية النصّ وقد طبعت ونشرت بمدينة بال (Bâle) سنة 1543، ولم تسلم عملية الطبع والنشر من النزاعات!
كان القرآن في ذلك العصر، وفي سياق النهضة في أوروبا، يعتبر عموما كتاب هرطقة وينظر إليه على أنه خطر. وعليه، فقد سعى مجلس مدينة بال في مرحلة أولى إلى منع نشره. ولم يصدر القرآن إلا بفضل تدخّل شخصي من مارتن لوثر. وكانت قد أتيحت الفرصة قبل ذلك للوثر كي يطلع على نسخة من هذه الترجمة نفسها قبل أن تأخذ طريقها للمطبعة. ثمّ إنه كان قد أعدّ بنفسه ترجمة لنص عنوانه «الردّ على القرآن»، وهو نص سجالي ضدّ القرآن لا يحتوي في الواقع إلا على عدد نادر من النقول الصحيحة عن القرآن. أما صاحب هذا «الردّ» فهو ريكولدو دي مانت كروس Riccoldo de Moute Croce ، كان راهبا من الدومينيكان واسع العلم ومتعدّد الألسن، عاش حوالي سنة 1400. وقد لقي ردّه صدى عظيم العواقب. أما نوايا لوثر فلا بدّ أن ننزلها في سياق عصره، أي سياق التهديد الذي كان يمثله العثمانيون، وما كان هؤلاء يشعرون به من أخطار محدقة، خاصة في أوروبا الوسطى، فقد كان لوثر يرغب في أن يثبت للمسيحيين أن القرآن ليس نسيج متناقضات وحسب، لكنه لا يمثل إلا «كتابا مقدسا من درجة أدنى».
لم تبدأ دراسات القرآن في إطار الجامعات، سواء في ألمانيا أو في البلدان المجاورة، إلا بفضل جهود معاصر للوثر وصديق له، هو فيليب ميلنشتون Philipp Melanchthon. فالعمل الملتزم الذي بدأه في القرن السادس عشر، مكّن من إقحام دراسة العبرية إلى جانب اللغة اليونانية في البرامج الجامعية. وترتب على هذا الأمر دخول لغات أخرى من العائلة اللغوية نفسها إلى الدرس، أقصد اللّغات السامية، فقد أصبح ينظر إليها على أنها ضرورية لدراسة الكتاب المقدس في إطار جامعي. وبذلك أقحمت السُريانية والعربية في برامج الجامعات الأوروبية.
منذ أن اندلعت المواجهات التي رافقت نشر المصحف في مدينة بال، أصبح متواترا أن يعتمد قرار كان قد اتخذ قديما ضمن مجمّع فيينا (16-1315) يقضي بإنشاء كراسي جامعية لتدريس اللّغات الشرقية، أي العبرية والسريانية والعربية والإغريقية، في جامعات بولونيا وسلمنكا وباريس وأكسفورد، بيد أن هذا المشروع لم يخرج إلى النور آنذاك. أما بعد أن أعيدت هيكلة النظام الجامعي بدفع من حركة الإصلاح الديني فقد أصبح ممكنا تنفيذ هذا القرار، هكذا أحدث أوّل كرسي لتدريس اللّغة العربية بجامعة ليدن البروتستانتية بهولندا. وعيّن طوماس أرينيوس Thomas Erienius (1584-1625) أوّل مشرف على هذا الكرسي، وكان يتمتع بثقافة خارقة تجمع بين العبرية والسريانية والعربية. وقد حرّر مصنفا في النحو العربي ظل المرجع الأساس طوال قرنين، ولم يفقد قيمته إلا مع ظهور مصنّف سلفستر دي ساسي (Sylvester de Sacy). وإضافة إلى مصنفه في النحو العربي ترك طوماس أرينيوس أيضا مصنفا عنوانه «تاريخ البطريرك يوسف» (« Historia Josephi Patriarchae ») كانت له قيمة كبرى في المجال التعليمي، وتمثل في تحقيق للنص العربي للسورة الثانية عشرة من القرآن (سورة يوسف) تصحبها ترجمة ثلاثية إلى اللّغة اللاتينية، وتتضمن الترجمة الثلاثية العناصر التالية:
– ترجمة أولى ذات طابع حرفي يمكن أن نطلق عليها بلغتنا المعاصرة «ترجمة بين السطور» (traduction interlinéaire) وقد تولّى أربينيوس إعدادها بنفسه.
– ترجمة ثانية أقل تقيّدا بحرفية النص من إعداد أربينيوس أيضا.
– وأخيرا الترجمة التي كان قد أعدّها سابقا روبرت دي كيتون.
إنّ هذه الطريقة التي اعتمدها أربينيوس في الترجمة قد أثبتت بوضوح أنّ الدراسة الفيلولوجية المعمقة شرط لا مناص منه لفهم النص القرآني. لم يكن مفاجئا حينئذ أن يحظى مصنف «تاريخ البطريرك يوسف» بشهرة مهمة، ومنذ ذلك العهد أصبحت دراسة القرآن جزءا لا يتجزأ مما كان يدعى «الفيلولوجيا المقدسة». (« Philologia sacra ») أي دراسة اللغات التي تحظى بأهمية خاصة في فهم الكتاب المقدس العبري -المسيحي. وقد ظهرت بعد ذلك مصنفات في اللّغة العربية ونصوص تعليمية لهذه اللغة تحتوي على ترجمة سور أخرى من القرآن، بيد أن السورة الثانية عشرة (سورة يوسف) ظلت النص المفضّل الذي يُعتمد مدخلا في دراسة القرآن.
هكذا بدأت المعرفة في البلدان الناطقة بالألمانية بكتاب «مسيحيات الناثرين العرب» («chrestomatie aus («arabiscren Prosahriftstellera وقد نشره ريدولف برينو Rudolf Rrünnow سنة 1895. ويتميّز الكتاب بفهرس ممتاز وضعه أوغست فيشرAugust Fischer أستاذ اللّغة العربية في جامعة لايبزيغ Leipzig، وقد عرف هذا الكتاب نجاحا متواصلا. وقد تحصلت أنا شخصيا على معارفي الأولى حول القرآن بفضل هذا الكتاب تحديدا.
ثمّ سأقدّم مثالا أخيرا هو بيستون (A.F.L Beeston) مؤلف مدخل لقراءة التفاسير القرآنية يعتمد أساسا تفسير البيضاوي، فقد اختار بدوره أن يجعل السورة الثانية عشرة (سورة يوسف) مدار التفاسير المعروضة، فهي السورة التي اعتبرت -من دون شك- الأكثر يسرا بالنسبة إلى القراء.
ما سعيت إلى أن أثبته أمامكم من خلال بعض هذه العناوين المذكورة لا يختلف إذا اعتبرنا الدراسات الجامعية. فلو راجعنا برامج الدروس الجامعية في الأزمنة الماضية، ألفينا أن النص القرآني ظل في أوروبا المدخل الأكثر استعمالا في التمهيد لدراسة اللغة العربية. ناهيك عن أن النشرة الكاملة الأولى للنص القرآني باللغة العربية التي وصلتنا محفوظة كلّها، هي من إعداد الراعي الديني الهمبورجوازي أبراهام هنكلمانAbraham Hinckelmann الذي كان واعيا بالدور التعليمي الذي يمكن أن يضطلع به القرآن في الدراسات العربية. وقد لا يكون من نافلة القول أن نذكر هنا أن هذا الراعي الديني كان يملك مجموعة من المخطوطات القرآنية ذات قيمة عالية، وقد نجت من قصف مدينة همبورغ أثناء الحرب العالمية الثانية.
وفي القرنين التاسع عشر والعشرين أصبح اللاهوتيون المسيحيون والبعض من اليهود، الأكثر اهتماما بالدراسات. فأصبحت الدراسات المقارنة بين القرآن والكتاب المقدس العبري – المسيحي ذات مكانة مهمة في هذه الدراسات، وانكب كثيرون على دراسة نواحي الاتفاق والاختلاف بين النصين دراسة عميقة. ومع ذلك فإن طريقة طرح الأسئلة المقارنة المتصلة بالكتاب المقدس العبري – المسيحي والقرآن قد تغيرت تغيّرا عميقا مع الوقت. فقد كان المقصود في المرحلة الأولى البحث عن المواضع التي يدين فيها القرآن للنص التوراتي، ثم تغيرت طريقة مقاربة المسائل المقارنة بصفة محسوسة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد حصل هذا التغيّر بالاستمداد من لويس ماسينيون (Louis Massignon) وأصبح المقصود تفهّم القرآن بصفته أثرا مستقلا بذاته وموضوعا جديرا بأن يدرس لذاته وفي ذاته. وبدأ الباحثون يرونه تعبيرا عن «صنف من التديّن له مميزاته الخاصّة»، حسب عبارة موهلر (J.A. Möhler).
وقد ظهر في فترة أكثر تأخرا اتجاه في دراسة القرآن ضمن الإطار الجامعي، يتمثل في إعادة القرآن إلى إطاره التاريخي، أي نهاية العصر القديم وإبراز المناحي الخاصة لتديّن ذلك العصر. ويمكن أن نلاحظ في الآن ذاته توسيع مجال البحث إلى الأبعاد الجمالية المتصلة بالقرآن، مثل طرق ترتيله. ومن البديهي أن ظهور هذا النوع الأخير من الموضوعات يرتبط بهجرة المسلمين إلى أوروبا.
اسمحوا لي أن أنهي محاضرتي بإضافة بعض الأفكار الشخصية حول التعليم الديني في أوروبا. ففي ألمانيا يخضع النظام التعليمي والجامعي إلى السلطات الإقليمية، أي دول الفدرالية وليست الدولة الفدرالية، أي الحكومة المركزية. والتعليم الديني كما يقدّم في المدارس هو تعليم ذو توجّه «مذهبيّ، أي إن كل مجموعة دينية هي التي تحدّد باستقلالية عن غيرها محتوى تدريسها، بالمقابل تضطلع الدولة بمسؤولية تكوين الأساتذة. ليس في نيتي أن أناقش معنى هذا التوافق، فهو يعكس من دون شك تجارب تاريخية معينة. بيد أنني أرغب في تقديم مقترح هو التالي: يبدو مستحبّا أن ترافق الدروس الدينية ذات الطابع المذهبي الخاص بالمجموعات المختلفة مادة مدرسية تقحم في البرامج لتدريس مختلف الأديان ضمن مقاربة مقارنية، وبطريقة أكثر ما يمكن التزاما بالحياد. فمقاربة من هذا النوع ستكون أكثر فائدة في المعرفة بالقرآن وفي المعرفة بالكتاب المقدس العبري – المسيحي. فكل من الكتابين إذا تخلينا عن قراءته وتأويله في أفق مجموعة من الأتباع المخصوصين، بدا لنا نحن القراء في صورة مختلفة تمام الاختلاف.
وعلى هذا الأساس يمكننا القول: إن دراسة القرآن في إطار جامعي قد قدمت عملا رائدا. ويخطر لي أن أتمنى إنجاز هذا العمل الرائد بالاتجاه المعاكس أيضا! ويكفي أن نتذكر المفكر العظيم ابن حزم، الذي اهتم منذ القرن الحادي عشر بالنص التوراتي، معتمدا طريقة في القراءة نجدها بعد قرون في النقد الحديث للكتاب المقدس.
تغيير زاوية النظر: هذا هو الشرط الضروري لإنجاح الحوار بين الأديان.
الأستاذ هارتموت بوبزاين أستاذ جامعي وباحث متخصص في اللغات السامية، نشر ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية.
النص معرب من الفرنسية.