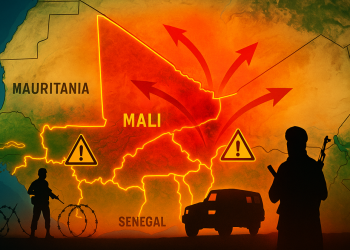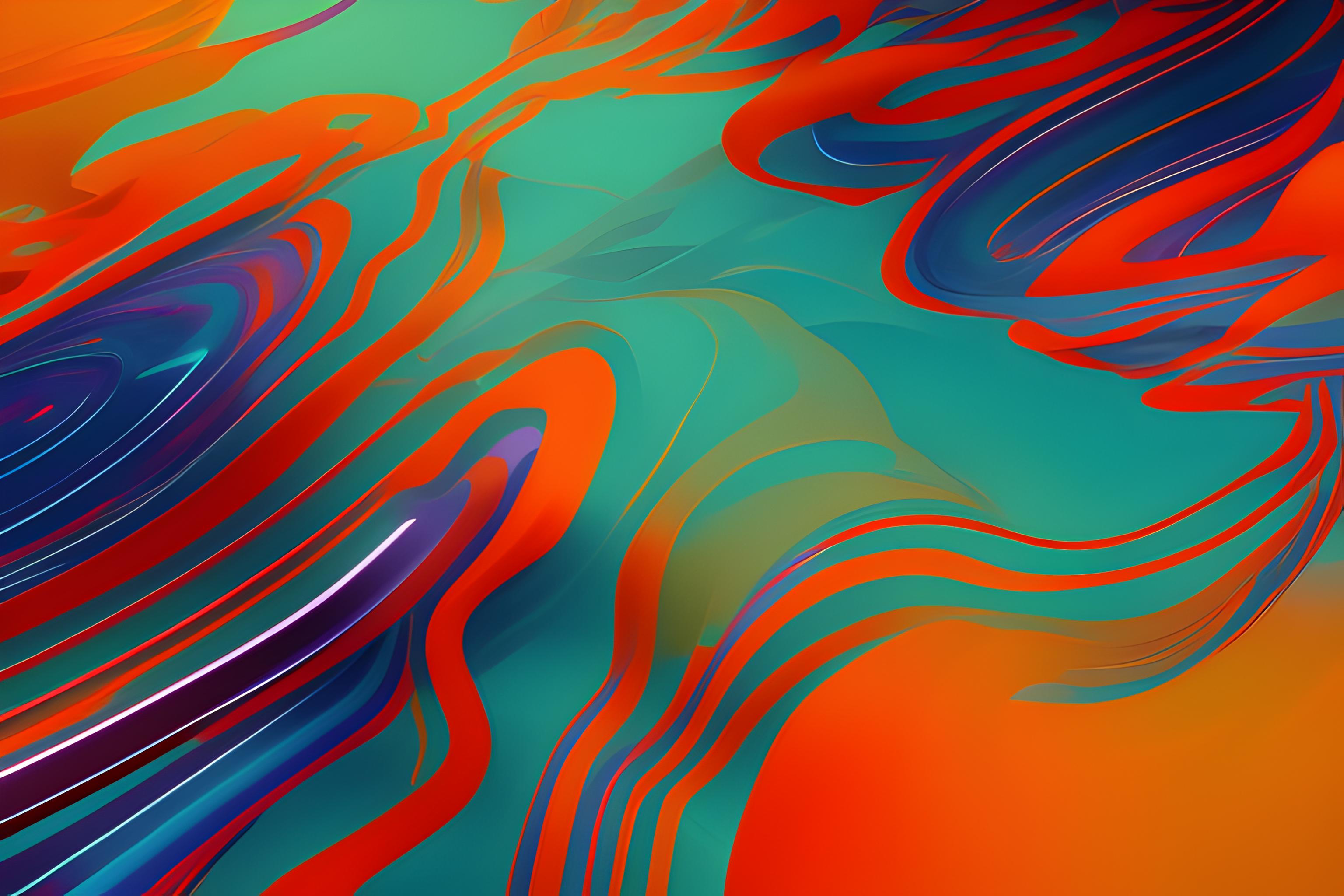عبد التواب عبد الله(*)* تقرأ هذه الدراسة سيرة الشيخ راشد الغنوشي، أبرز الإسلاميين التونسيين، وأهم محطاته التعليمية، والنشاط في صفوف ورئاسة الحركة الإسلامية التونسية، كما تقدم قراءة في خطابه وفكره، من خلال ثلاث قضايا رئيسية هي: موقفه من العلمانية والعلمانيين، وموقفه من المجتمع المدني، وموقفه من الغرب.
وتلاحظ الدراسة أن هناك مناطق غير واضحة ومحل اشتباه في خطاب الغنوشي، يقترب فيها من الأطراف المتشددة، بينما لديه مناطق أخرى يكون فيها رمزا وداعية للاعتدال، كما تلحظ الدراسة كذالك التنناقض بين مرونته النظرية في كثير من الأحيان، وتصلباته العملية، سواء في إدارة للحركة، أو في الموقف السياسي عموما. يعد الشيخ راشد الغنوشي أحد أبرز وجوه الحركة الإسلامية التونسية، والإسلاميين الجدد في العالم العربي في العقدين الأخيرين، وعلى الرغم من تحفظات البعض على أثره أو آثاره التجديدية، إلا أن السائد أن الرجل يمتلك العديد من الآراء والأطروحات المتميزة، التي تتميز بدرجة ما عن الخطاب التقليدي للإسلاميين، الذين انتمى إليهم واعتمد على مرجعياتهم في فترة سابقة، مثل الإخوان المسلمين في مصر وسوريا. وسنعرض فيما يلي للتعريف بشخصية وحياة الشيخ الغنوشي وأهم مؤلفاته، دون تحيز لها أو عليها، عارضين لتطوره الفكري، في ضوء تاريخ الحركة الإسلامية التونسية، وعارضين نقديا لبعض مقارباته التجديدية، التي تحدد في الوقت نفسه مدى حقيقة وعمق التجديد في فكر الغنوشي، وفكر حركة النهضة التونسية، وكذلك المقارنة بينها وبين خطاب الحركات الإسلامية الأخرى. أولا: محطات في حياة الغنوشي ولد الشيخ راشد الغنوشي عام 1941 في قرية حامة قابس أو الحامة كما هو شائع في الجنوب التونسي، ودرس المرحلة الابتدائية في بلدته، ثم انتقل إلى بلدة مثيلبة حيث نال الشهادة الأهلية المتوسطة، ومن ثم درس في المدرسة الخلدونية في العاصمة، وبعد ثلاث سنوات حصل على الثانوية العامة من المدرسة التابعة لجامعة الزيتونة. عمل في بداية حياته معلما في مدينة قفصة حتى سنة 1964، وبعدها سافر إلى دمشق ليدرس الفلسفة، حيث حصل على إجازة في الفلسفة سنة 1968، وفي دمشق تسنى له قراءة النتاجات الفكرية للإخوان المسلمين، وتحديدا ما كتبه سيد قطب وأبو الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية في باكستان حول الحاكمية والدولة الإسلامية، وبعد إتمام دراسته في دمشق، سافر الغنوشي للدراسة في جامعة السوربون بفرنسا، وهناك بدأ نشاطه الإسلامي وسط الطلبة العرب والمسلمين، كما تعرف على جماعة الدعوة والتبليغ، ونشط معها في أوساط العمال المغاربة، حتى عاد إلى تونس سنة 1969 ، وباشر التدريس في ثانويات تونس العاصمة و حمام الأنف والقيروان، وفي هذه المرحلة كان صعود البورقيبية والتغريب كبيراً في الشارع التونسي. وتعد علاقة الغنوشي بعبد الفتاح مورو لحظة مهمة في السيرة الشخصية للغنوشي والإسلامية التونسية، حيث نشط كل منهما في دعوة الشباب، ومارس مورو الخطابة في مسجد سيدي يوسف فترة طويلة، كما كانت هذه العلاقة فصلاً مهما في تحول الغنوشي عن إعجابه بالفكر القومي والعلماني نحو التوجه الإسلامي، وهو التحول الذي تأكد بعد عودته لتونس، لكن نرى أنه ظل ذا أثر في تطورات الغنوشي في ما بعد. تأسيس الحركة الإسلامية التونسية يعتبر لقاء الغنوشي-مورو الفاتحة الحقيقية التي انتهت بتأسيس الحركة الإسلامية التونسية في ما بعد، ممثلة في الجماعة الإسلامية، وتبدأ القصة عام 1970 حين قرر كل من الغنوشي ومورو الشروع في إعطاء دروس، وإقامة حلقات دينية تعليمية في المساجد، وكانت جل هذه الدروس تتمحور حول حضارية الإسلام وخطورة الثقافة الغربية المادية. وانضم الرجلان إلى جمعية تقليدية دعوية في البداية هي جمعية “المحافظة على القرآن الكريم” العام 1971، وأخذا يمارسان نشاطهما من جامع سيدي يوسف في العاصمة التونسية، ثم خرجت الفكرة الإسلامية من دائرة المسجد إلى دائرة الجامعة، التي مثلت المجال الطبيعي لتفريخ أعضاء حركة النهضة فيما بعد. وفي هذه المرحلة شرع راشد الغنوشي في كتابة المقالات في جريدة الصباح اليومية، وفي مجلة جوهر الإسلام، من أجل نقل أفكاره إلى أكبر شريحة ممكنة من المثقفين، ثم في مجلة المجتمع ومجلة المعرفة، التي كانت المنبر الفعلي للحركة الإسلامية في تونس، والتي تخصصت في نقد الفكر اليساري والعلماني، والتركيز على موضوع المرأة في الإسلام، ولم يكن خطاب الغنوشي فيها خطاب الشيخ السلفي التقليدي، بل خطاب الإسلامي المنفتح الذي يستخدم الآليات العقلية، كما يستخدم الإسنادات الدينية في الإقناع، دون الانحباس السلفي داخل النص الديني. ركزت مقالات الغنوشي في المعرفة على نقد الحضارة الغربية وإفرازاتها المادية وانعكاساتها الخطيرة على مجمل الأوضاع في البلاد الإسلامية، وهو ما يعكس تأثره المبكر بفكر سيد قطب ومالك بن نبي وأبو الأعلى المودودي و محمد الغزالي. وبعد سنوات من النشاط المتواصل والدعوة المستمرة، انعقد اجتماع سري عام 1979 بضاحية منوبة في تونس، قرر إثره راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو تأسيس تنظيم إسلامي على غرار تنظيم الإخوان المسلمين، أطلقوا عليه اسم “الجماعة الإسلامية”. ولا شك أن هذا الاجتماع المبكر بين الغنوشي ومورو يؤكد على ثنائية الرافد الخارجي والداخلي في إنشاء حركة النهضة في تونس، فبينما تأثر الأول بتراث الإخوان المسلمين وكتاباتهم في المشرق، تأثر الثاني بتراث علماء الزيتونة، فقد خرج جامع الزيتونة عشرات الشخصيات المغاربية التي قادت العمل الوطني والنضالي في أقطار المغرب العربي، وكان مناهضو الاستعمار يلجأون إلى الزيتونة لإكمال دراستهم والتزود من معين الوطنية والإسلام، ومنهم على سبيل المثال الشيخ عبد الحميد بن باديس، المصلح الجزائري المعروف، الذي يعد النسخة المغربية من الإمام محمد عبده، والرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكذلك شيخ الحركة الإصلاحية في تونس الشيخ عبد العزيز الثعالبي(1) وغيرهم كثير. اجتمع الرافد المشرقي والرافد الوطني في نشأة الحركة الإسلامية في تونس، في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، حيث لم تحرم تونس من عدد من الوجوه الإصلاحية طوال تاريخ استقلالها، مثل الشيخ عبد القادر سلامة، ومحمد صالح النيفر، والشيخ ابن ميلاد، الذين نشطوا في إلقاء محاضرات ومواعظ ودروس دينية، كان بعضها ينتقد الحالة السياسية والثقافية والاقتصادية في تونس، وهو ما يفسره الباحث السوداني الدكتور حيدر إبراهيم كرد فعل على التغريب الذي مارسته البورقيبية في إطار أوسع للغرب، ويرى أن تاريخ الحركة الإسلامية التونسية هو التاريخ الموازي والمضاد للبورقيبية، وفي إطار أوسع للغرب، فقد كان الحبيب بورقيبة من أكثر الزعماء صراحة في إعجابه بالثقافة الغربية، وكان أحياناً يعبر عن استيائه من الثقافة العربية، التي تشتمل ضمنا بعض العقائد الإسلامية والدينية(2) . كان هذا هو السياق الذي نشأ فيه وخرج منه الشيخ راشد الغنوشي، وهو سياق رد الفعل على البورقيبية والتغريب، فقد كان بورقيبة مبهورا بأوروبا ولا سيما بفرنسا، التي عاش فيها فترة، وكان مشمئزا في قرارة نفسه من الفكرة العربية والمشرقية، والتي كان يعتبرها عالما مغايرا تماما لعالمه، معتبرا العروبة صيغة رجعية مغرقة في التقاليد واللاعقلانية، وأن القومية العربية فكرة ديماغوجية، بل كان أكثر الحكام العرب انسلاباً وأسرعهم تحررا مما اعتبر مسلمات في الذهنية القومية العربية، شأن السلام مع إسرائيل، أو الإعجاب بمقولة الوحدة، كما سعى لعلمنة مجتمعه وتغريبه في اتجاه الثقافة الغربية بشكل غير مسبوق، وهو ما جعل الحركة الإسلامية التونسية تركز على الجانب الفكري والتربوي والثقافي في مرحلتها الأولى بشكل أساسي. ولم يكن الغنوشي أو غيره من قادة الحركة الإسلامية الصاعدة في أواخر السبعينيات إلا حزءا من الإيديولوجية العربية والإسلامية، التي تكونت في مواجهة الثقافة والهيمنة الغربية، وزاد من تمكنها صعود الخطاب الثوري العربي طوال فترة الخمسينيات والستينيات، حيث كان الإعجاب بجمال عبد الناصر رديفا للإعجاب بسيد قطب، وربما فاقه في كثير من الأحيان؛ من هنا نشير إلى أن راشد الغنوشي كان معجبا في بواكيره بالتجارب الثورية القومية التي جسدها عبد الناصر، وهو ما استمر فترة حتى لقائه بعبد الفتاح مورو ذي المرجعية الإسلامية الزيتونية. العلاقة بالسلطة التونسية في 27/12/1974 تم إجراء تعديل في الدستور التونسي، وأسندت رئاسة الدولة للحبيب بورقيبه مدى الحياة، ونظرا للتوترات التي شهدتها البلاد في السنوات الأولى، اضطر الحزب الدستوري الحاكم في تونس لإقرار مشروع التعددية السياسية سنة 1981، وقد بادر أعضاء الجماعة الإسلامية التي كان يتزعمها راشد الغنوشي إلى عقد مؤتمر عام، أعلنوا في ختامه عن حل الجماعة الإسلامية، وتأسيس حركة جديدة باسم حركة الاتجاه الإسلامي، وانتخب راشد الغنوشي رئيساً لها وعبد الفتاح مورو أميناً عاما، وتم الإعلان رسميا عن هذه الحركة في 06-06-1981، وتقدمت هذه الحركة الجديدة بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على اعتماد رسمي، ولكنها لم تتلق أي جواب من وزارة الداخلية، وقد صدرت وثيقتها التأسيسية في التاريخ نفسه، ولا زالت تعد المرجع الفكري لحركة النهضة(3) . وفي يوليو/تموز 1981 ألقي القبض على الغنوشي، وأحيل إلى المحاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 1981 مع مجموعة من قيادة حركة الاتجاه الإسلامي بتهمة الانتماء إلى جمعية غير مشروعة، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. وبعد ثلاث سنوات من الاعتقال، جرى إطلاق سراح الغنوشي في 02-08-1984 بعفو رئاسي، بعد وساطة من رئيس الحكومة آنذاك محمد المزالي. وخلال فترة اعتقال الغنوشي، تولى قيادة حركة الاتجاه الإسلامي كل من الفاضل البلدي وحمادي الجبالي، وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 1984، عقدت حركة الاتجاه الإسلامي مؤتمراً سريا، انتهى إلى تثبيت راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو على رأس الحركة، وفي 06-06–1985 عقدت حركة الاتجاه الإسلامي مؤتمراً صحافيا، كشفت فيه علانية في الذكرى الرابعة لتأسيسها عن وثائق مؤتمرها السري، وأسماء أعضاء المكتب السياسي، والذين كان من بينهم راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو وصالح كركر وصادق شورو وحمادي الجبالي وعلي العريض وفاضل البلدي. أعيد اعتقال الغنوشي في أغسطس/آب 1987، وحوكم مع مجموعة من رفاقه بتهمة قيام عناصر من حركة الاتجاه الإسلامي بتفجير أربعة فنادق سياحية في تونس العاصمة في أغسطس/آب 1987، وهي تعرف بالمحاولة الانقلابية التي فجرت العلاقة مع النظام، ويُحمّل خميس الماجري أحد أعضاء مجلس الشورى السابقين الشيخ راشد الغنوشي المسئولية الكاملة عنها، وقد استقال الماجري من حركة النهضة بعد أن يئس من التغيير داخلها. يقول الماجري عما يسميه الحوادث الكارثية التي ارتكتبتها حركة النهضة ومسئولية رئيسها عنها: “إني ولله الحمد لم أساهم في أي حادث كارثي ارتكبته الحركة، بل إن أفرادا قلائل زجوا بها إلى عدة مغامرات من بينها الإعلان السياسي في 6/6/1981، حيث كنت في أقصى الشمال الغربي، وفي المحاولة الانقلابية سنة 1987 لم أكن على علم بها، لأني كنت في حالة مطاردة وملاحقة، أما في سنة 1989 فقد كنت ممن رفض الدخول بكثافة في الحملة الانتخابية، والذي زج بالبلد في المغامرة هو الأستاذ الغنوشي، الذي خالف قرار مجلس الشورى الذي كنت أحد أعضائه، حيث وقفتُ بكل قوة رافضاً مغامرة الإستعصاء وفرض الحريات، ثم سجنت بعد ذلك، ولا يمكن بأي حال تحمل مسؤولية ما قُرر بعدي”(4) بعد هذه الحادثة تم في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 وأمام الحالة الصحية المتردية للرئيس بورقيبة (توفي في 6/4/2000)، قام الوزير الأول زين العابدين بن علي بتغييره وأعلن نفسه رئيسا جديدا للجمهورية في ما عرف باسم تحول السابع من نوفمبر، ويبدو أن النظام الجديد كانت لديه علاقات طبيعية بحركة النهضة كفصيل سياسي مهم في الشارع التونسي حينئذ، فحضر مندوب من حركة النهضة اجتماعات صياغة الميثاق الوطني، كما بدأ حوار بين النظام الجديد والحركة، كان من نتائجه تغيير اسم الحركة من “حركة الاتجاه الإسلامي” إلى “حركة النهضة”، كما أصدر زين العابدين بن على عفوا عن الغنوشي ورفاقه في 5/5/1988، ولكن رغبة الحركة في الهيمنة وسياسة حرق المراحل، توجس منها النظام الجديد خيفة، وهو ما يزال في مرحلة تثبيت الأركان، وهو ما اتضحت بوادره في الانتخابات الرئاسية و التشريعية سنة 1989، حيث دعى النظام الإسلاميين للمشاركة بنسب محدودة في بعض الدوائر، ولكنهم شاركوا بنسب كبيرة ما أقلق النظام والقوى السياسية الأخرى. وبدأ مسلسل من العلاقة السيئة بين السلطة والحركة، استمر لما يزيد عن عقد ونصف الآن، خلا بعده الشارع التونسي من التعددية، كما خلا من الاعتدال بدرجة كبيرة، سواء في التغرب أو التقليد، واستقرت أغلب قيادات حركة النهضة خارج تونس، واستقر الغنوشي تحديدا في لندن، وليكون الجانب المهم فيه بعد ذلك هو أطروحاته الفكرية والإصلاحية، التي لا شك تطورت عن بدايته، وقد حكم عليه غيابيا في تونس سنة 1991 وسنة 1998 بالسجن مدى الحياة. قراءة فكرية في بعض أطروحات الغنوشي يؤكد الغنوشي على تواصله مع تيار الإصلاح الإسلامي، الذي بدأه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما، مرتئيا أن الإسلام هو الشرط الوحيد لتجديد حياة المسلمين، حيث يقول إن “التخلف الذي تردى فيه المسلمون منذ قرون، وأسلمهم الى الضعف وغلبة الأمم عليهم، وسبقها لهم في مجالات العلوم ونظم الحياة، مما يفرض إعادة التفكير في الإسلام باعتباره الشرط الضروري لكل تجديد وتطور في حياة المسلمين، بسبب ما يتمتع به الإسلام من مكانة محورية في تكوين العقليات والسلوكيات الفردية والجماعية لدى المسلمين. وفي هذا الصدد يكثر في أدبيات المصلحين منذ قرنين على الأقل الاستئناس بالحديث الشهير الذي بشر فيه صاحب الدعوة عليه السلام بأن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها”(5) . وهو يرى أن هذا الحديث الذي خضع لتأويلات غير قليلة، يمكن تفسيره بـ”جماعة” أو” مذهب” أو” مدرسة”، كما يمكن أن يكون فرداً، ورأى أن هذا التيار تمثله بعض الاتجاهات من مثل: اتجاه مدرسة التنظيمات الذي تعبر عنه تجربة محمد على في مصر، ويرى سقوطها عائدا لهجمة الجيوش الغربية عليها، وكذلك تجارب شبيهة، كإيران مصدق، وفترة عبد الناصر، ويعيد فشلها لأسباب خارجية، ونجاعة الأخيرة ناتجة عن فقدانها للسند الشعبي. أما الاتجاه الأقدم والأعرق في رأي الغنوشي فهو اتجاه السلفية الجهادية، الذي مثله محمد بن عبد الوهاب في السعودية، ودعوة ولي الله الدهلوي في الهند، والسيد أحمد الشهيد، ويضم إليه المهدي السوداني، وعثمان بن فودي، الذي كان من المجددين في مالي ونيجيريا وأسس دعوة ودولة هناك، كما يضم له محمد عبده ورشيد رضا، بل وتيارات الإخوان المسلمين حيث يرى أن حركة الإخوان في بلاد العرب، والجماعة الإسلامية في شبه الجزيرة الهندية، تعتبران نموذجاً لهذا المشروع الإصلاحي، الذي يخوض اليوم معارك كبرى ضد خطة الهيمنة الغربية وامتداداتها وعملائها. وهنا يلاحظ أن الغنوشي الذي كتب هذه الورقة عام 2002، لا يفرق بين السلفية العلمية والسلفية الجهادية والسلفية الإصلاحية، ولكن يدمج الجميع في تيار واحد، صار الأشهر المعبر عنه هو تنظيم القاعدة، فالسائد في الخطاب العربي المعاصر، هو تعريف تيار الشيخ محمد عبد الوهاب وربما انضم إليه تيار الأفغاني وعبده وغيرهما بتيار الإصلاح، أو السلفية الإصلاحية، أما أن يدمج الجميع في تيار معاصر، يشير إلى تنظيم متطرف كالقاعدة وغيرها من الجهاديات المعولمة، فلا شك أن الغنوشي لو كان يقصد ذلك فهو مصاب بإشكال كبير، خاصة وأنه لم يشر للقاعدة والتنظيمات الجهادية الأخرى، السابقة أو اللاحقة، وإن لم يكن يقصد ذلك فتظل المشكلة مصطلحية ومفهومية عنده فقط. كما يلاحظ في الاقتباس السابق استخدام الغنوشي لتعبيري “الهيمنة” و”العمالة” وهما تعبيران تآمريان وإيديولوجيان بامتياز، وهو ما يوحي بتصلب نظري مستور في الخطاب الفكري لراشد الغنوشي، كما سنوضح من خلال عدد من النماذج، وقضايا فكرية ثلاث، هي: 1- قضية العلمانية والموقف من العلمانيين. 2- الموقف من المجتمع المدني. 3- الموقف من الغرب. 1- الموقف من العلمانية والعلمانيين يُلاحظ على موقف راشد الغنوشي من العلمانية والعلمانيين ضبابية وعدم وضوح كبيران، حيث يحمل شبهة تكتيكية في كثير من الأحيان، ويمكن الاستدلال على ذلك بأن الغنوشي في موقفه النظري الغالب من العلمانية هو التشدد والرفض، وكذلك الموقف من العلمانيين، ولا تحضر إمكانية التحالف والحوار إلا على قضايا مشتركة، ذات مرجعية علمانية بالأساس، مثل الديموقراطية وحق المشاركة للإسلاميين، أو الدفاع عن حقوقهم الإنسانية، أو الموقف من العلمانية الغربية، التي تحتضن الجزء الأكبر من الحركة الآن، بينما تظل مرونته -أو تجديده النظري- محصورة في الإطار التقليدي، بل يستخدم التعبيرات نفسها للتخوين والاتهام ذوي الدلالة العقدية أو السياسية. يقسم الغنوشي العلمانيين إلى فريقين، متطرف ومعتدل، يرى في المتطرفين فريقا عميلا ومنافقا في رأيه، وهم يستلهمون مرجعية فكر الأنوار وخلفائه الماركسيين “ممن لا يرون في الدين غير كونه وهما وملاذا للعاجزين، وأداة استغلال في يد أصحاب النفوذ للضعفاء والمساكين، وهو تيار لا شأن له بالإصلاح الإسلامي، لأنه خارج الدائرة جملة، حتى وإن اضطره صعود المد الإسلامي للهروب من لافتة الشيوعية والتخفي تحت لافتة الديموقراطية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، وكان تحوله هذا بسرعة البرق على إثر سقوط الإميراطورية الشيوعية، بما يجعله امتدادا لمدرسة النفاق التي برزت تاريخيا إثر انتصار الإسلام”(6) . هكذا تحضر تعبيرات: “خارج الدائرة جملة” و”امتداداً لمدرسة النفاق”، وهي تاريخيا -كما أشار الغنوشي- تعرف بإظهار الإسلام وإبطان الكفر، وهي تأتي بعد حديثه عن المفاصلة بين هذا الاتجاه وبين المد الإسلامي-السياسي- مما يوحي بخطاب اتهامي بالجملة، لا شك أنه يفتقد ما قد يلح عليه البعض من اعتدال الغنوشي. وهذا ما يتضح أكثر في توصيفه للعلمانيين المعتدلين، الذين كنا نظن أنه سيلح على التقارب منهم، أو التخطئة الجزئية لهم، فلم يكن إلا كمن يقول: ليس لهم من الاعتدال إلا اسمه، ولكنهم متطرفون ومنبوذون في الحقيقة؛ فميزتهم فقط أنهم “يبدون حرصا متزايدا ولا سيما هذه الأيام على انتمائهم الإسلامي، ولا يستبعد من بعضهم أداء بعض شعائر الإسلام” ولكنه يضيف: “وكثير منهم قد تصل به اللجاجة الى حد أن يقدم نفسه مجتهدا ومجددا في الإسلام، مدافعا عنه لدرجة اتهام كبار فقهائه بالجهل بمقاصده، كاتهام دعاة الحركة الإسلامية وعلمائها بالإساءة اليه، وباستغلاله في أغراض سياسية”(7) ؛ وهو يرفض منهم اقتصارهم في نظرتهم للدين على أنه تراث حضاري فقط، ولا شأن له بالدولة والتشريع، ويسخر الغنوشي منهم في كونهم يرفضون قوانين الإسلام وشرائعه، بينما يقبلون “سلطان القانون الدولي ومؤسساته وعهوده، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”(8) . ويذكر الغنوشي عدداً من النماذج من هؤلاء العلمانيين المعتدلين مثل “المصري نصر أبي زيد، والجزائري الفرنسي أركون…وبعض الإسلاميين الإيرانيين”، وهو يرى في هذا الاتجاه “امتدادا لغلاة المتصوفة من أقطاب فلسفة الحلول من أصحاب الأذواق والمواجيد والتفسير الإشاري، ولذلك لا عجب أن احتل أقطاب فلسفات الحلول ووحدة الوجود مكانة متميزة لدى أصحاب التيار العلماني”، وهو يرى أن هذا التيار لم يضف شيئا مذكوراً، وليس أكثر من تكرار لعلي عبد الرازق -صاحب الإسلام وأصول الحكم- قائلا: “هذه الموجة من المصلحين لا تضيف شيئا مذكورا الى دعاوى علي عبد الرزاق، بل هي نقل وإحياء لها رغم توبته منها”(9) . ويتضح موقف الغنوشي أكثر من العلمانية في كتابه “مقاربات في العلمانية والمجتمع المدني”، الذي يقول فيه تحت عنوان “جاءتنا العلمانية على ظهر دبابة وبقيت تحت حمايتها” ما يوحي ويؤكد اتهامه لها: “سيلاقي المنافقون من حكام العرب والنخب العربية الملتفة حولهم، والتي لم يبق لهم من مشروع ومن مصدر استرزاق غير محاربة الإسلام والإسلاميين، سيجدون عنتا شديدا إذا أرادوا أن يجعلوا لخطابهم ضد الحركة الإسلامية مصداقا لدى الشعوب”(10) ؛ هكذا نذير العنت للأنظمة الحاكمة والنخب العلمانية يطلقه الغنوشي في وجه الجميع، ما لم يطبقوا الإسلام كما تتصوره جماعات الإسلام السياسي، وهو نذير يشبه نذر الراديكالية الإسلامية في تشكلاتها العنفية المختلفة. ويفسر الغنوشي لنا عنوانه في المقاربات “مجئ العلمانية على ظهر دبابة” باستشهاده بالحالة الجزائرية “لقد بلغ الأمر في الجزائر، إلى حد خروج حشود العلمانيين إثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مظاهرة يستصرخون الدبابات لمنع قيام حكم إسلامي، شاهدين على أن العلمانية قدمت إلى بلادنا على ظهر دبابة ولا تزال، غير قادرة على الحياة إلا في حمايتها” ويضيف في رفض العلمانية للإسلام: “قامت العلمانية وخرجت منادية بأعلى صوتها: “لا للعروبة، لا للإسلام.. قالتها في صراحة أن مشكلها ليس مع اجتهاد من اجتهادات المسلمين ضد آخر، إنه ضد الإسلام نفسه”(11) . هكذا يخلع الغنوشي لباس الهوية والانتماء عن العلمانية العربية والعلمانيين العرب، أي انتماء، فهم ضد العروبة وضد الإسلام وضد الوطن وضد الجماهير.. هم منافقون ليس أكثر كما أكد في سياق سابق، لا شك أن نقد التجربة الجزائرية والانقلاب على نتيجة الانتخابات كان خطأ بدرجة ما، رغم تبرير البعض لها، لكن لاشك أن الإسلاميين الجزائريين كانت لهم أخطاؤهم كذلك في إدارة مرحلة ما بعد الانتخابات، وهو ما كنا ننتظر من وجه إسلامي يوصف بالاعتدال شأن الشيخ راشد الغنوشي أن يشير إليه، ولكن الرجل كما يشير لا يراهم يملكون رؤية وليسوا أكثر من جهلة، فهم “ليسوا في غالبهم من أهل العلم أو الثقافة، وإنما هم إلى عصابات المافيا أقرب”(12) . هكذا تتشكل وتتضح رؤية الغنوشي للعلمانيين العرب على المستوى النظري، رغم أن بعض هؤلاء عمليا كانوا من مؤيديه، وممن وقفوا ضد استبداد النظام البورقيبي بحركته، وهم مطالبون دائمون بالديموقراطية، ورفض التعذيب، ونموذج الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وبعض المثقفين الموضوعيين في تونس ماثل، ودليل قوي على ذلك، فقد خسرت هذه المنظمة شرعيتها ونزل عليها جام الغضب من النظام التونسي الحاكم، نتيجة وقفتها ورفضها للمحاكم الاستثنائية والعسكرية للإسلاميين في تونس. 2- الموقف من المجتمع المدني لا يختلف الغنوشي عن تصور الإسلاميين للمجتمع المدني بالمرادفة بينه وبين المجتمع الأهلي، دون تفريق بينهما، وهو الخلط الذي يتجاهل ما يسمى “قيم المجتمع المدني نفسه” شأن التسامح السياسي والفكري والديني والروح المدنية وغيرها من بنيات هذا المجتمع”(13) . ويرى الغنوشي أن مفهوم المجتمع الإسلامي المدني “راسخ متين، لأنه متفرع عن طبيعة الإسلام التمدينية الحضارية، وتحقيق لرسالة الإسلام، ومقاصده التمدينية في الانتقال بأهله من حال البداوة، إلى حال المدن والحضارة”، وفي حديثه عن تاريخ تطور المفهوم في الغرب بالمقارنة بالعالم الإسلامي يقول: “لقد اتجه نضال الشعوب الغربية إلى تحرير الإنسان والمجتمع والدولة من هيمنة المقدس الساحق، على حين تتجه الشعوب الإسلامية في نضالها المعاصر إلى تحرير الإنسان والمجتمع والدين من هيمنة الدولة الحديثة التي سحقت المجتمع”(14) . وهو يرى أن مهمة الحركة الإسلامية الآن هي إقامة مجتمع أهلي إسلامي، عبر مبادرات أفراده بإقامة مؤسساته، وهو يثنى على تجربة محمد خاتمي في إيران حين جعل مشروعه للحكم قائما على إقامة مجتمع مدني إسلامي في ظل سلطة القانون، أي سلطة الشريعة، وهو ما ينقل مركز الثقل من الحاكم إلى المحكوم، ومن الأمة إلى الدولة، كما يستشهد بما قاله الإمام محمد مهدي شمس الدين، من أن المقدس هو الأفراد والجماعات، ليس غيرهم(15) . ويرد الغنوشي انحدار أو تراجع المجتمع الأهلي الإسلامي إلى “تمكن الغزو الغربي من الإجهاز على نمط الدولة السلطانية، التي ورثت الخلافة، بدءاً بتنحية سلطان الشريعة، وإبدالها بالقانون الغربي، كما حصل في معاهدة لوزان، التي فرضت على دولة تركيا التخلي عن الشريعة الإسلامية”، وهو ما كان من نتاجه، حسبما يذكر الغنوشي، مصادرة الوقف الإسلامي، وتأميم مؤسسات المجتمع الأهلي الإسلامي، وتأميم مؤسسات التعليم وإلحاقه بالدولة، واسبتدال فئة العلماء -باعتبارها صانع فكر الدولة وثقافته- بفئة المثقفين خريجي المدارس الغربية”(16) . إن نظرة الغنوشي للمجتمع المدني إيجابية لحد كبير، وهو ينصف التجربة الغربية في الانتصار لهذه القيم، رغم تحفظاته على الثقافة والسياسة الغربية في كثير من تشكلاتها وتجلياتها، وهو ما يعكس وعي الغنوشي بأهمية تقوية المجتمع المدني في مواجهة الدولة التسلطية، التي عانى منها وأقرانه فترة طويلة، و”تأنيسها بعد توحش، وإحداث انقلاب في موازين القوى لصالح الأفراد وكرامتهم، ولسلطان الجماعة، واستغناءها لحد بعيد عن الدولة، وتقليص تمدد هذه الأخيرة وحصرها في أضيق نطاق، ليمثل هدفا رئيسا لجهاد الحركة الإسلامية الحديثة على طريق دورة حضارية جديدة”(17) . ونرى في مثل هذا الخطاب وعيا متنورا بأهمية المجتمع المدني، لكن لا شك كذلك أنه موظف لخدمة الهدف الإسلامي ليس أكثر، كما أنه لا يؤكد على أهمية التحالف، فضلا عن إمكانية القبول بممثلي المجتمع المدني، الذين ينتمي أغلبهم لمرجعية “نفاقية” و”علمانية” حسب توصيفات الغنوشي نفسه. الموقف من الغرب يتبدى الغرب في كثير من الأحيان في فكر وخطاب الغنوشي في صورة العدو المتآمر ضدنا، والذي ينبغي علينا مواجهته دائما، ما يجعل الصراع في تصوره غير منته، حسب قوله:” الحقيقة التي للمسلمين أن يفخروا بها، هي أنهم كما كان لهم شرف الإسهام الكبير في انهيار امبراطورية الإلحاد، فقد كان لهم الشرف العظيم أن كان لمقاوماتهم الإسلامية الدور الطليعي في استنزاف قوى العملاق الأميركي، وإصابة جيوشه واقتصاداته ومجتمعه بأعظم الخسائر التي فاقت قوى تحمله”(18) ، وهو خطاب يقترب كثيرا من خطاب الراديكاليين الإسلاميين لأقصى حد. بل يرد الغنوشي الأزمة الاقتصادية العالمية -التي بدأت في الربع الأخير من 2008-للمقاومة الإسلامية، وهو المنطق نفسه الذي يتحدث به زعماء القاعدة، وسقوط اليمين المحافظ في الولايات المتحدة، ويصعد بدلا منه الديموقراطيون ممثلين في الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية الجديدة (انتخابات 2008)، ولكنه لن يكون عالم الإنصاف والعدل، ولكن عالم الأنصاف، أي أنصاف الحلول حتى لا يستبشر المسلمون، فكما أن أوباما يحتوى الأنصاف في جذوره (من أب مسلم وأم مسيحية)، فكذلك ستأتي حلوله، يقول الغنوشي: “يمكن اعتبار أن المرحلة -كما قيل- هي مرحلة الأنصاف وليس الإنصاف: رئيس من أب أسود وأم بيضاء، أب مسلم وأم نصرانية، رئيس من أب أفريقي وأم أميركية. وهكذا مرشح أن تكون الحلول أنصافا بين المحافظة والتجديد، بين رأسمالية بجرعة اشتراكية أو إنسانية، سيطرة أميركية بشراكة أوروبية”(19) . ويعتمد الغنوشي المرادفة بين الحرب على الإرهاب والحرب على الإسلام، كما يحاول كثير من قادة الراديكالية الإسلامية ترويج هذا الترادف، فواحد من ملامح العالم الجديد بعد إدارة بوش في رأيه هي “أن الفشل الذريع لاستراتيجية الحرب على الإرهاب، كانت غالبا الاسم الرمزي للحرب على الإسلام، تلك الحرب التي مثلت تهديدا خاصة للوجود الإسلامي في الغرب، يضع أمام الإسلام فرصة لأداء رسالته في إعادة المعنى والقيمة الخلقية إلى حضارة فقدتهما”(20) ، كما أن من ملامح هذه الفترة الجديدة -حسب الغنوشي- أنها تقدم فرصا جديدة للأقليات الإسلامية، وللحركة الإسلامية والديموقراطية، فالأقليات الإسلامية في الغرب بشكل خاص، تنفتح أمامها فرص غير مسبوقة للاندماج الفاعل في مجتمعاتها. وفي حديثه عن الوجود الإسلامي في الغرب، يرى الغنوشي أن تأثير جماعات الإرهاب تشوه صورة الإسلام هناك، وتسبب العديد من المشاكل لهذا الوجود، وهي نقطة مهمة نوافقه عليها، إذ تفصل بين إسلاميتين، إسلامية واعية يمثلها الغنوشي وغيره، وإسلامية عدمية تمثلها جماعات الإرهاب حسبما يصفها، يقول الغنوشي: “يضاعف من مشاكل المسلمين تصاعد تأثير جماعات الإرهاب على صورة الإسلام عامة، وعلى الأقليات المسلمة بشكل خاص، بما يكاد يجعل من كل مسلم في الغرب مشروع إرهابي يخشى منه”(21) ، وهو ما يزيد من أثره على حد قول الغنوشي: “غياب نماذج مجتمعية إسلامية تشهد لعدالة الإسلام ورحمته وقدرته على استيعاب كل كسب حضاري، بما يرجح صورة الإسلام الخطر، والربط بينه وبين الإرهاب والعداوة للفنون الجميلة وللديموقراطية وللسلام ولحرية المرأة ولحقوق الإنسان، بما هو الضد من كل وجه لدين، إنما جاء لمصالح العباد وتتميم مكارم الأخلاق واعتبار البشر كلهم إخوة”. يلح الغنوشي في كثير من كتاباته(22) على إمكانية وضرورة المصالحة بين الإسلام والقيم الحديثة، شأن الديموقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهو بهذا الخطاب يفارق ويفاصل مع الجماعات الجهادية، ولكن يظل هناك التقاءات غير مقصودة بين خطاب الرجل وبين هذا الخطاب الذي يرفضه، من قبيل تصور الحرب على الإرهاب حربا على الإسلام، أو امتداد هذه الحرب منذ الحروب الصليبية، أو وصف المخالفين من الحكام أو النخب العلمانية بالنفاق والعمالة كما سبق أن ذكرنا، وهو ما جعل خطاب الغنوشي يحمل سمات الاعتدال والمرونة، كما يحمل سمات التشدد والتصلب، كما اتضح في بعض مواقفه العملية بالخصوص طوال فترة رئاسته للحركة. إن واحدا من أبرز علامات الاعتدال في فكر راشد الغنوشي، يتضح في تمييزه النخب الغربية إلى فريقين، وأن منهم العقلاء الذين يمكن التحالف والتعاون معهم، وهم الذين يفهمون السياق الدولي فهماً عادلاً وموضوعياً، مقابل فريق اليمين المتطرف الذي ينظر لهذا السياق -وبخاصة قضايا المسلمين فيه- نظرة أيديولوجية غير عادلة، فهو لا ينفي وجود القوى العاقلة في الغرب، التي “تنطلق من أن الإسلام أمر واقع ومكون من مكونات الحقيقة الغربية، وليس من سبيل غير العمل على إدماجه، والإفادة مما يتوفر عليه من إمكانات خلقية اجتماعية يحتاجها الغرب”(23) . ويرى راشد الغنوشي أن هذه القوى العاقلة هي التي “لا تزال غالبا تمسك بمقود القيادة السياسية، ولكنها تتلقى ضغوطا هائلة، وبالخصوص من قبل القوى اليمينية والصهيونية، وما تمتلكه من قنوات إعلامية نافذة، وتهدد بالوصول إلى الحكم لتنفيذ برامجها.. ولا يؤمن وصولها”(24) . وتبدو دعوته للتحالف بين القوى الإسلامية في الغرب، وبين الاتجاهات العقلانية والحقوقية هناك، حيث يقول: “الواضح أن محصول المسلمين ضعيف على صعيد عقد تحالفات مع القوى ذات المصلحة في التغيير، مثل القوى الحقوقية والإنسانية واليسارية، عدا أمثلة محدودة برزت هنا في السويد، خلال حكم الاشتراكيين، كما برزت في بريطانيا خلال الحرب على العراق وفلسطين، عندما تولى قيادة الرابطة الإسلامية فريق تمكن من عقد تحالف واسع مع فئات يسارية ومضادة للعولمة وللحرب قادت مسيرات مليونية”(25) . ويدعو الشيخ راشد الغنوشي المسلمين في الغرب لضرورة تطوير فكر “الإسلام الغربي”، والذي يعتبره واحداً “يمثل أهم تطورات عصرنا، وهو مرشح لأن يكون له دور مهم جداً في مستقبل علاقات الإسلام بالغرب، كجسر تواصل وتقارب، قد ينتهي بوضع حد نهائي لعلاقات الحرب، فاتحا عهداً جديداً من التعارف والتعاون”(26) ، وهو ما يتم في رأيه عبر تفاعل إيجابي بين ثقافة إسلامية أصيلة وسطية، وبين مقومات الثقافة الغربية المحلية، من أجل إنتاج مسلم سويدي أولا ثم مصري أو تونسي، ويحدد لذلك عددا من الأدوات مثل المزاوجة بين تعليم اللغات المحلية واللغة الأم، ودوام تواصل الأجيال الجديدة مع بلد المنشأ، وغيرها من الأدوار الاجتماعية والسياسية داخل المجتمع الغربي نفسه. ويشدد الغنوشي على تطوير الخطاب الإسلامي الموجود في الغرب قائلا: “الخطاب الإسلامي في الغرب مطلوب أن يتطور في كل اتجاه، في اتجاه إسلامي جامع لكل مكونات هذا الوجود، متجاوزا الحدود القطرية والاختلافات الحزبية والمذهبية باحثا عن الإجماع” وهو ما يؤكد على ضرورته للأسباب التالية: “حتى يمكن لهذا الكم الإسلامي الممزق أن يكتشف مصالحه الجامعة ويعبر عنها تعبيرا واحدا، وأن يتطور في اتجاه الأجيال الجديدة متوجها إليها بلغاتها، حاملا همومها، مستوعبا مشاكلها، وأن يتطور في اتجاه أبناء البلد الأصليين، حاملا خطابا إسلاميا وطنيا بأثواب قيمية إنسانية جامعة، مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومكانة الآداب والفنون، ومكانة المرأة، والدفاع عن مقومات الوطنية، وكذلك ضرورة التحالف مع القوى التحررية في الغرب”(27) . تبين هذه العينة التي اخترناها من القضايا، أن خطاب الشيخ راشد الغنوشي يتميز بانفتاح عال في كثير من المسائل، ولكنه انفتاح يظل محكوما في المقام الأول بضغوط الموقف السياسي والسياق الذي يتكلم فيه وإليه، ولكن يظل إشكالية، على الرغم من مرونته التي لا تختصر السياسي في الديني، مميزة بينهما دون تقسيم، إلا أنه يحتوي تصلبا في الموقف من الحكومات والنخب العربية المخالفة له، وكذلك في الموقف من العالم الغربي في كثير من الجوانب، وليس فقط من يصفهم بالعقلاء في فضائه، من المتعاطفين مع القضايا العربية الإسلامية.
* كاتب وباحث مصري متخصص في الدراسات الإسلامية.
المصدر: المسبار 16يناير2011