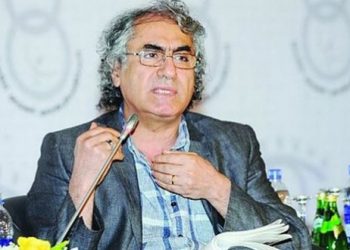سناء عيسى
افتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكبر نصب تذكاري في العالم عن العبودية، وذلك في جزر غوادلوب الفرنسية في منطقة الكاريبي في العاشر من مايو (أيار) الجاري، وقد أحيا الافتتاح السجال حول ما خلفته تجارة فرنسا للعبيد من آثار على المنطقة. كان هولاند يأمل أن يؤدي افتتاح النصب التذكاري إلى إسكات بعض الأصوات الغاضبة، التي تطالب -منذ مدة- بأن تدفع فرنسا تعويضات مالية للمتضررين، وهي مسألة نجح هولاند -حتى الآن- في تجنبها.
الماضي الأليم
لقد قاطعت المنظمة التي بادرت بفكرة مشروع المتحف عام 1998 الحفل الافتتاحي؛ احتجاجاً على رفض هولاند مناقشة قضية التعويضات المالية. وتقول جاكلين جاكويراي (رئيسة اللجنة الدولية للمواطنين السود): ” نريد من هولاند تقديم الاعتذار باسمه وباسم الشعب الفرنسي، والنظر في مسألة التعويضات المالية. إنّ العبودية جزء من تاريخ فرنسا، ويجب على فرنسا أن تواجه ماضيها”.
تبقى العدالة الانتقالية والذاكرة ركيزة السجال السياسي والثقافي والاجتماعي اليوم، ونجد السجال عاد إلى الولايات المتحدة بعد أن أثيرت بعض التوترات العنصرية، لكن الانقسامات الإثنية والعنصرية هي انقسامات عالمية لها تاريخ طويل ومؤلم من المحرقة اليهودية إلى مجزرة الأرمن وكل ما جرى بينهما.
مفاهيم العدالة الانتقالية تصوّر مرحلة التغيير على خطوتين، تسعى الخطوة الأولى إلى إحلال الاستقرار على المجتمع في مرحلة ما بعد الصراع، من خلال إجراءات موقتة تشير إلى الالتزام بمعالجة انتهاكات الماضي. أما الخطوة الثانية من العدالة الانتقالية، فتتعلق بأخلاقيات ومظاهر العملية ونتائجها. النظر العميق إلى الأبحاث عن العدالة الانتقالية التقليدية يظهر تبايناً وتوتراً بين المفاهيم الغربية الليبرالية لأطر العمل، والأنماط القانونية والدولية، وبين أجندة العدالة في مرحلة ما بعد الاستعمار في سياقات التمييز العنصري.
الأمراض التاريخية
يثير مصطلح “العدالة الانتقالية” مشاعر الأمل والنهضة، لذلك فالمطلوب هو تجاوز المخططات المتوافرة عن العدالة الانتقالية من أجل الوصول إلى الأمراض التاريخية التي تتحدى حلول القانون المبسطة والانعكاسية. في الواقع، هناك سرديات تُفرض على الآخرين لأغراض سياسية ويصبح “يوم الذكرى” هو تضليل عن القضية الأساسية: وضع الإنسان تحت الضغوط الاقتصادية والسياسية وكيف يقلب المجتمع على منافسيه ويبين حقيقته الهمجية.
لا يتم تحليل الماضي لأجل الدرس والوعظ، كما لا يتم إحياء ذكرى الضحايا بسبب حقهم، بل في الحالتين نجد أنّ التاريخ يتم الاستيلاء عليه ببشاعة، للتأثير الثقافي والسياسي من قبل المتحمسين والمحاربين الثقافيين. إنّ تصوير مهربي البشر في عرض البحر المتوسط ومجندي الأطفال بأنّهم من “تجار العبيد الجدد” دون اعتبار للسياق المختلف، أو إلقاء القليل من اللوم على فشل الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ملف المهاجرين (في المثال الأول) وعدم الإشارة إلى فضلات السياسات الاستعمارية (في المثال الثاني) هو بالتحديد ما يعبّد الطريق لبناء القوات التي تشارك في أعمال الإبادة والإرهاب.
يجب أن نكون واضحين بخصوص ما الذي نستذكره وما الغاية من الذكرى. على سبيل المثال، “ذكرى الآحاد” في بريطانيا كانت دائماً مصممة لتذكر من قضى “في خدمة الوطن” ولم يكن مسموحاً الاستيلاء عليها لأغراض سياسية مع احترام الأسر التي شارك أبناؤها في الحروب وكُتبتْ لهم النجاة. ما نلاحظه اليوم هو تغيير في هذا النهج منذ حربي أفغانستان والعراق ومساعي تقديم خطاب عسكري طفيف مع اقترابنا من ذكرى عام 1914.