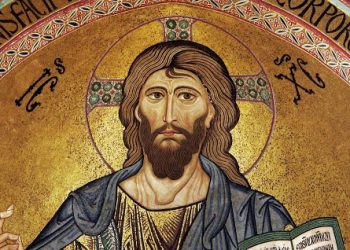«ما وجدت من أصحاب كتب المقالات أحدا قصد الحكاية المجردة من غير ميل ولا مداهنة سوى أبي العباس الإيرانشهري، إذ لم يكن من جميع الأديان في شيء…» (البيروني).
«إنّ الذي لا يعرف من الأديان غير دينه لا يعرف من أمور الدين شيئا» (أدولف هارناك).
اخترنا أن نصدّر مقالنا بشاهدين، الأول لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني المتوفى بعد 440هـ/ 1050م، صاحب الكتاب الفريد من نوعه «تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة»، والثاني لأدولف هارناك (1851- 1930) الذي يعتبر من الآباء المؤسسين لعلم تاريخ الأديان.
إنّ القرون الطويلة التي فصلت بين الرجلين والمساحة الشاسعة بين الشرق والغرب التي باعدت بينهما لم تحل دون الاشتراك في هذه الرغبة التي عبّر عنها كل منهما بعبارته، وهي المعرفة الموضوعية بالأديان الأخرى. ولقد جمع البيروني بين الرياضيات والفلك والتاريخ، وارتحل في الأقطار والبلدان، فكان الشاهد على أن الحضارة العربية الإسلامية قد عرفت في فترات ازدهارها محاولة حقيقية لإرساء معرفة موضوعية بالأديان المختلفة. فالإمبراطوريات الإسلامية قد تميزت بالتعددية الدينية، وكان الإسلام أحيانا دين الدولة ودين الأقلية أيضا، كذا كان شأنه في الهند –مثلا- التي أقام بها البيروني ليدرس حضارتها ودياناتها وعلومها. إنّ وضع التعددية هو الذي يدفع إلى البحث والتأمل والمقارنة وهو الذي يمهّد الطريق للموضوعية والتسامح. وقد شهدت الحضارة العربية الإسلامية في أوضاع التعددية عدّة محاولات لتأسيس مبحث خاص بدراسة الأديان والفرق ووضع مناهج ملائمة لذلك. لكن تلك المحاولات لم تنجح في الاستمرار، بل اختفت كلّما سيطرت الديانة الواحدة والمذهب الواحد وغلبت التقسيمات الطائفية. وكانت تلك المحاولات قد شهدت نموذجها الأرقى مع تأسيس الخليفة العباسي المأمون (198-218/ 813-833) «بيت الحكمة» ببغداد، فلم تضطلع هذه المؤسسة بترجمة الفلسفة الإغريقية فحسب، بل ترجمت آثارا عديدة منها كتب دينية في غير الإسلام، وأحدث حركيّة هائلة في البحث وجمع المصادر وتهذيب الأفكار، والشاهد على ذلك ما سجّله محمد بن إسحاق المعروف بابن النديم (ت438-1047) في «الفهرست» المصنّف بعد حوالي قرنين من تأسيس «بيت الحكمة»، فقد جمع كمّا من المعلومات والإرشادات حول الأديان وجملة من العناوين المثيرة كانت متداولة في مكتبات بغداد إلى عهده، لكنها ضاعت وأتلفت ولم يصلنا منها شيء. وقد صنّف معاصره البيروني الكتاب الأكثر موضوعية وعلمية في ميدان الأديان والحضارات المقارنة فكاد مصنّفه يلحق بقائمة الكتب الضائعة، ويرجع الفضل حديثا إلى المستشرق الألماني إدوارد سخاو (Edward Sachau) في إبراز قيمة البيروني، إذ إنه سخر حياته للتعريف به وترجمة بعض آثاره إلى اللغتين الإنجليزية والألمانية وإخراج أول طبعة من كتاب «تحقيق ما للهند…» سنة 1887.
لقد ضاع قبل ذلك أو أتلف العديد من العناوين المهمة، ومنها المصادر التي ذكرها البيروني، مثل كتاب أبي العباس الإيرانشهري الذي أشاد به وامتدحه، لكننا لا نعلم شيئا عن الكتاب، ولا نعلم الكثير عن صاحبه سوى أنه كان أحد أساتذة الفيلسوف والطبيب أبي زكريا الرازي. ولا بدّ أن نشير إلى أنّ اهتمام الغربيين حديثا بأديان العالم هو الذي أعاد إلينا البيروني وابن النديم وغيرهما، لكن ما أتلف هو أكثر بكثير مما أمكن استرجاعه([1]).
ولئن حظي كتاب «الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت 548هـ/ 1153م) بشهرة فائقة، فإنه ليس أفضل ما أنتجته الحضارة العربية الإسلامية، على الرغم من خصاله العديدة. فالشهرستاني الذي عاش بعد البيروني يتحدث عن الهند مثلا من دون الاستفادة من «تحقيق ما للهند»، فيعيد الأخطاء نفسها والمسلمات التي كان البيروني يسعى إلى مراجعتها وتصحيحها.
من العلوم الدينية إلى علم الأديان
لقد فقدت الحضارة العربية الإسلامية على مرّ القرون علاقتها بتلك المحاولات الرائدة، وساد الصنف المعروف بعلم البدع (hérésiographie)، وهو القائم على تقديم المذاهب المخالفة لإدانتها والتشنيع بها، وليس للفهم والمعرفة. وكان لتقلص نشاط المناظرة بعد القرن الخامس الهجري أثر سلبي، إذ لم يعد المصنفون يهتمون بتدقيق معلوماتهم وتحيينها لأنهم لا يواجهون أتباع الأديان والفرق التي يتحدثون عنها، وظلّ المسلمون قرونا مكتفين بالكتب القديمة، مثل «كتاب الملل والنحل»، وكأن المذاهب والأديان قد توقّفت عند هذا الحدّ والعلم بها لم يعد قادرا على تجاوز ما قرّره الأقدمون. وعندما تأسست الجامعات الحديثة في العالم العربي لم يحظ تاريخ الأديان بالمعنى الحديث والدراسات المقارنة للأديان باهتمام كبير، فلم تُخصّص لها دروس أو كراس تعليمية أو أقسام بحث، وربما درّست في بعض المؤسسات التعليمية الدينية على الطريقة القديمة، كما نرى من مراجع كثيرة سائدة، مثل مؤلفات الدكتور أحمد شلبي التي لا تمتّ بصلة إلى الدراسات الحديثة للأديان.
والسؤال المطروح اليوم هو التالي: هل من حاجة إلى تأسيس فضاء بحث علمي يتخذ موضوعا له الظاهرة الدينية ويتوسّل المناهج المقارنة في هذا للبحث؟ هذا سؤال قد يلقى جوابا بالنفي من وجهات نظر ثلاث:
– وجهة النظر الإيمانية التي تخلط بين الدين معتقدا شخصيا والدين ظاهرة تاريخية اجتماعية ذات تجليات ونتائج يمكن متابعتها من خلال آثارها الحسية، النصية وغير النصية. فالدين من جهة كونه إيمانا شخصيا واختيارا ذاتيّا لا يهمّ إلا أتباعه، أما الظاهرة الدينية التي ترتبط بآثار اجتماعية فهي قابلة لأن تكون مجال بحث مثل كل الظواهر الأخرى.
– وجهة النظر الوضعانية التي تقصر مجال اهتمامها على ما هو حسّي، مع أنّ الظاهرة الدينية إذا درست من خلال آثارها فهي لا تقلّ موضوعية عن الظواهر الأخرى. ثم إنّ الوضعانية التي صاحبت تكوّن كلاسيكيات العلوم الإنسانية والاجتماعية في القرن التاسع عشر استبطنت نظرية المراحل الثلاث لتطوّر الإنسانية وظنت أن الدين مرحلة في طور الاندثار، أو أنّها استبطنت نظريّة الانعكاس الآلي للبنية التحتية على البنية الفوقية وظنّت أن وظيفة الدين وظيفة سالبة في كل الحالات.
– وجهة النظر النفعية التي تشكّك في الأهمية العملية لدراسة الظاهرة الدينية، باعتبارها دراسة لا نفع لها في سوق التشغيل وفي مجال اهتمامات الإنسان الحديث، فضلا عن أنها دراسة تظلّ محلّ شكّ في قيمتها العلمية بسبب تعقّد الظاهرة الدينية وعسر الانفصال عند دراستها عن المواقف الذاتية للدارس، فهي تفتح باب الجدل ولا تقدم إجابات متفق حولها. على أن البحث العلمي لا يحاسب بالنتائج المباشرة التي يقدّمها، إذ يبرز نفعه في تطوير وعي الإنسان بما يحيط به من ظواهر، وليست الظاهرة الدينية ببعيدة عن معيش الإنسان الحديث، في كل المجتمعات على حد سواء، ومنها المجتمعات الغربية التي لم يغب فيها أبدا التفكير في هذه القضية، بل عاد بقوة في السنوات الأخيرة. أما المجتمعات العربية فهي الأكثر جدارة بأن تفتح فضاء بحث علمي حول ظاهرة قويّة الحضور وتخضع لتجاذب أيديولوجي خطير.
تبدو هذه الإجابات الثلاث غير مستندة إلى حجج قوية، إلا أن القضية ليست يسيرة المأخذ، والمصاعب حولها حقيقيّة بصرف النظر عن تلك الإجابات والاعتراضات. فالشكّ قائم حول إمكانية تحديد الظاهرة الدينية تحديدا واضحا يفصلها عن الظواهر الأخرى، ولم يتفق نظر المتخصّصين منذ أكثر من قرن على تعريف أو مجموعة محدودة من التعريفات لتعيين كلمة «دين». وما قد يدرج في حقبة معينة أو في نظر مجموعة بشرية تحت هذه التسمية يخرج عنها إذا اعتبرنا حقبات أو مجموعات أخرى. ويمكن متابعة الظاهرة الدينية عبر أربع زوايا: التكوّن، الشكل، المصير، والمعالجة الكمية، لكنّنا ننازع في كل حالة اختصاصا من الاختصاصات المعترف بها في العلوم الإنسانية. وإذا نظرنا إلى الظاهرة الدينية من حيث هي تاريخ فقد لا تتضح الفائدة من انتزاعها من الممارسة العامة لهذا العلم (مشكلة تاريخ الأديان)، وإذا اعتبرنا أنها تؤدي إلى استكشاف ماهية عامة تمثل الأديان التاريخية تجلياتها، فإنّ هذه الماهية قد تصبح تجريدا فلسفيا أو تمجيدا متخفيا لديانة معينة (مشكلة فينومينولوجيا الأديان).
الواقع أن المصاعب التي تحيط بهذا الموضوع ليست مختصّة به وهي قائمة أيضا، وإن بدرجات أقل، مع عدّة موضوعات أخرى. لكنّ الصعوبة الأكبر تتمثّل في الإرث التاريخي الذي يثقل عملية التفكير ويحول دون الاقتصار في هذه المصاعب على جانبها المعرفي البحت. إنّ صراعات الماضي تظلّ العائق الأكثر قوة الذي يحول دون تقبّل فكرة إخضاع الظاهرة الدينية إلى التحليل العلمي وتطبيق مناهج البحث على الميدان الديني بدل إخراجه من دائرة اهتمامات هذا البحث أو تهميشه.
فالفضاء المتوسطي كان شهد في العصر الوسيط قيام مؤسسات تعليمية حوّلت الدين من شعور وطقوس إلى معرفة مرتبة ومبوّبة وممنهجة، ثم تضخمت هذه المعرفة إلى أن أقصت أنواع المعارف الأخرى، ثم قامت مؤسسات المعرفة الحديثة في خضم الصراع بين العلم الديني والعلم الكوني. لا عجب حينئذ أن دراسة الظاهرة الدينية ظلت تختلط في الأذهان بالدراسات الدينية وتؤدّي إلى التقاء طرفين متناقضين حول موقف الرفض، أصحاب العلم الديني وأصحاب العلم الكوني.
لقد أحدث الانتقال إلى العصر الحديث ثورة معرفية أسهمت فيها الجامعة وتأثرت بها في آن واحد. كانت الجامعات في الفضاء المتوسطي مقامة على أسس متشابهة. فالجامعات العربية والإسلامية قسّمت المعرفة قسمين: علوم المقاصد، وهي العلوم الدينية، وعلوم الوسائل مثل الأدب واللغة والحساب والتاريخ وغير ذلك. والجامعات الأوروبية قسّمت بدورها المعرفة إلى لاهوت وفنون. وتتمثّل إحدى النقلات النوعية للثقافة الحديثة في تخليص العلوم الكونية من الرقابة وتحوّلها إلى معارف قائمة بذاتها بعد أن كانت خادمة لغيرها، ذلك كان مشروع عصر النهضة في أوروبا وقد مهّد لأن تقوم في القرن التاسع عشر اختصاصات متميزة بمناهجها ومصادرها ونصوصها المؤسسة، أصبحت تحظى وحدها بصفة العلمية وغدت تمثل تراثا مشتركا للإنسانية تتحدّد على أساسه درجة الحداثة المعرفيّة في المجتمع.
ولئن لم يواكب تاريخ المعرفة في المجتمعات العربية والإسلامية هذا التطوّر إلا متأخرا فإن الجامعات الحديثة في هذه المجتمعات نشأت على أساس هذا التوجه الجديد([2]). ولنتذكّر على سبيل المثال لا الحصر المعركة التي تلت صدور كتاب «في الشعر الجاهلي» لطه حسين (1924)، فقد مثّلت لحظة تخلّص الأدب والنقد الأدبي من وضعيّة العلم الوسيلة وتحوّله إلى اختصاص قائم بذاته منفتح على الروافد العالمية، حدث ذلك في الظرف ذاته الذي كانت تنشأ فيه جامعة عصريّة إلى جانب التعليم الديني التقليدي. إن فتح فضاء معرفي لدراسة الظاهرة الدينية هو دعم لهذا الاتجاه وليس تراجعا عنه. بيد أنّ الجامعات العربية الحديثة التي نشأت متأثرة بالنظم الجامعية الغربيّة لم تتقلص فيها دراسة الظاهرة الدينية بسبب انتشار الفكر الحديث، بل السبب في الغالب تردّد هذه الجامعات في التكفّل بقضايا المجتمع، بذلك ظلت الدراسات الحديثة للظاهرة الدينية، وظواهر أخرى من الحساسيّة نفسها، مهمّشة بين اختصاصات منعزلة لا تخترق نتائجها في الغالب أسوار الجامعة.
ثم إنّ العلوم الحديثة لم يشتدّ عودها في الغرب إلاّ بعد سلسلة طويلة من المواجهات الفكريّة انتهت إلى تحوّل الجامعات الدينية العريقة، مثل «بولونيا» و«السوربون» و«أكسفورد» و«ليدن»، إلى منارات للمعرفة الحديثة. وقد ترتّب على هذه المواجهات اختلال في تحديد الظاهرة الدينية والتعامل معها. كان التعايش عسيرا في المجتمعات الكاثوليكية، بل ظلّ الصراع شديدا إلى بداية القرن العشرين، ومثّلت فرنسا التجربة الأكثر حدّة في هذا السياق([3]). لكنّ التعايش كان أقلّ عسرا في المجتمعات البروتستانتية أو تلك التي يتعايش فيها المذهبان الكاثوليكي والبروتستانتي، حيث عدّ اللاهوت مادّة من المواد التي تدرّس مع الفلسفة والأخلاق، واتسعت أقسام الأدب (الإنسانيات) إلى دراسة النصوص الدينية دراسة فيلولوجية وأدبية، خاصة نصوص «العهد القديم». لكنّ بعض التيارات البروتستانتيّة لعبت دورا معيقا في حالات أخرى، فبعض الجامعات الأمريكية منع دراسة نظريات داروين إلى حدّ الثلاثينيّات من القرن العشرين وقد عاد الجدل حول هذا الموضوع بقوّة في عهد إدارة جورج بوش الابن ذات التوجّه المحافظ.
وتشهد الجامعات الأوروبيّة اليوم نقاشا خصبا في سبيل تعديل التوازنات التي استقرّت عليها الأوضاع منذ القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أي فترة تأسّس العلوم الإنسانية والاجتماعية. ونذكر على سبيل المثال أنّ المشروع الأوروبي لتوحيد برامج التعليم قد فرض العديد من المراجعات بسبب اختلاف طرق التعامل مع الظاهرة الدينية بين الجامعات الأوروبيّة المختلفة. وفي فرنسا التي يتميّز فيها هذا الموضوع بحساسيّة شديدة لأسباب تاريخيّة معروفة كلّفت وزارة التربية سنة 2002 الفيلسوف ريجيس دوبريه بإعداد تقرير حول «تدريس الشأن الديني في المدرسة اللاّئيكيّة» وبدأت مبادرات عديدة لتنفيذ ما احتواه التقرير من توصيات([4]).
أمّا الجامعات العربيّة فإنّ القليل منها مهيّأ نسبيّا إلى متابعة هذا التطوّر. نشير مثلا إلى أنّ الجامعة التونسيّة قد انفتحت منذ تأسيسها في الستينيّات على هذه المباحث وبرز عدّة باحثين في مجال الدراسات الدينية التاريخية أو الاجتماعية أو الحضارية. وقد أنشأنا في كليّة الآداب بجامعة منوبة (تونس) سنة 2004 أوّل برنامج ماجستير علمي في الدراسات الدينيّة المقارنة يقام في جامعة عربيّة غير دينيّة. لكنّ تجارب من هذا القبيل تظلّ نادرة وهشّة في العالم العربي.
الديني والكوني
إنّ فترات الصراع السابقة قد حجبت حقائق جديرة بأن تراجع بعمق في ظلّ التطوّرات الحاليّة وأن يسهم في ذلك كلّ أصناف الباحثين والمدرّسين.
أوّلا: إن تحوّل الدين من شعور إلى معرفة لم يحصل إلا باقتباس المعارف الكونية التي كانت متاحة في حدود العصر الوسيط، ومنها الفلسفة القديمة بنظرياتها الميتافيزيقية والفيزيائية والمنطقية واللغوية والنفسية، ولم تتوقف هذه المعارف عن التطور لكنها أصبحت تشتغل بدورها في لغة دينيّة. فكلّ تراث العصر الوسيط لا يمكن إدراكه إلا عبر عميلة تفكيك لهذه العلاقة المعقدة بين الرافدين الفكريين. هذه المعرفة معطى موضوعي للدراسة، وهي تمثل الجانب الأكبر مما يدعى بالتراث. وهي حاضرة في كل قطاعات هذا التراث حتى الأدب والعلوم. كما أنها ليست إنتاجا عربيا مستقلا بنفسه لكنّها تفاعل خصب مع مجموع المخزون المعرفي للعالم القديم، وقد أسهمت أديان عديدة في صياغته وتكييفه.
ثانيا: إن الثقافة لا تقتصر على المكتوب بل تشمل كل مجالات الإنتاج الرمزي للإنسانية، وقد كان للأديان دور مهم في توجيهها وضبط وسائل تعبيرها، بل الأديان هي الإنتاج الأكثر تعبيرا عن البعد الرمزي لدى الإنسان. فلا تفهم أغلب الظواهر الثقافية القديمة إلا في إطار استمرارية الوظائف الرمزية على الرغم من تعاقب أديان ودول ومذاهب مختلفة. وليس المكتوب إلا جزءا صغيرا من هذا الإنتاج الثقافي. ثمّ إنّ التحوّل من المشافهة إلى الكتابة وعلاقة كلّ منهما بالآخر يمثّلان مدخلا رئيسا لفهم ظواهر كثيرة ذات أثر بالغ في بنية الأفراد والمجتمعات.
ثالثا: إنّ الدين فاعل من الفواعل التاريخية والاجتماعية، يصنع الحدث كما تصنع به الأحداث. هو أثر ومؤثر ودافع ونتيجة. ولئن كان من الخطأ اعتبار الدين عاملا مستقلا بنفسه متعاليا على الواقع الاجتماعي والتحولات التاريخية، فإنه لا يقلّ خطأ أن يعتبر مجرد انعكاس سالب للعوامل المادية. فالدين جدير بأن يدرس بصفته عنصرا في نظام كلّي متماسك ومتطوّر في الآن نفسه، لأنه يمثّل أحد التعبيرات الممكنة عن الوظيفة الرمزية وهي بعد أساسي لدى الإنسان، وهو لغة من اللغات التي تعبّر بها الإنسانيّة عن بنى مختزلة ومجرّدة.
رابعا: إن تفتيت الظاهرة الدينية إلى مجموعة من الأحداث والتجليات تدرس منفصلة عن بعضها البعض يؤدي إلى التفريط في جوهر القضية، أي البنى والوظائف المتعاضدة التي تنتج الأنظمة الرمزية. توجد في كل الأديان عقائد وميثات ومحرّمات وشعائر ونحو ذلك، لكن لا يوجد دين ابتدع العقيدة أو الميثا أو المحرم أو الشعيرة، مما يعني أنه توجد ظاهرة دينية تشترك حولها البشرية بصرف النظر عن التنوّعات التاريخية التي يمكن متابعتها عند دراسة ماضي المجموعات البشرية وحاضرها. هذه الظاهرة الدينية لا بد أنها تخضع إلى منطق داخلي وآليات اشتغال محددة، ولا يغني عرض تنوّعاتها عن فهم ذلك المنطق وتلك الآليات. على أن الظاهرة الدينية لا تقتصر على تلك العناصر التي تعتبر –تقليديا- مكوناتها الأساسية (العقائد، الشعائر، المحرمات… إلخ)، فالعديد من العناصر الأخرى يمكن أن تلحق بهذا التحليل، مثل العنف أو الشعور بالذنب أو التعايش مع الموت أو تخيّل عوالم موازية ونحو ذلك من الظواهر ذات الأثر في الماضي والحاضر.
خامسا: إن القداسة تخضع لمبدأ التحوّل وليس لمبدأ تعاقب الأدوار، فلا يكون مستبعدا أن العديد من تجليات الحياة الحديثة إنما تمثّل أشكالا جديدة لظواهر دينية موغلة في القدم، ومن هذا المنطلق يمكن دراسة العديد من الموضوعات مثل الاعتقاد في الأبراج وعبادة نجوم الفن وتكيف العقول لوسائل الإعلام المرئية ودور الرياضة في امتصاص شحنات العنف أو تأجيجها والتوجيه الرمزي للمواطنة عبر الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية وتشخيص الفضاءات العمومية وغيرها. كما أن العديد من القضايا الحضارية الآنيّة ليست مجرّد قضايا أخلاقية لكنّها تدفع اليوم إلى مراجعة عميقة لتصوّرات رسختها الأديان منذ القدم، ومن تلك القضايا الإخصاب الصناعي والتوالد من دون أب وزواج المثليين واستنساخ البشر… إلخ.
سادسا: إن المقاربة المعقلنة للأديان بعد ضروري في فهم الحضارات الكبرى التي امتزج تاريخها بتاريخ أديانها، باعتبار هذه الأديان وقائع حضارية أسهمت في هيكلة العقليات لفترات طويلة ومازال أثرها ساريا في الحياة الاجتماعية العامة وآليات التفكير العميقة. والمقاربة المعقلنة لا تتنافى ودراسة كل الظواهر ومنها ما لا يبدو معقولا، أو أنه بالأحرى يخضع إلى معقوليّة غير تلك التي تقوم عليها المعرفة العلمية. والمجتمعات لا تقتصر في تاريخها وحاضرها على فعل العقل المنطقي، بل العكس هو الغالب. كما أن العديد من القضايا الراهنة لا تفهم إلا من خلال امتداداتها البعيدة في التاريخ، وعلاقاتها بعصور سابقة كانت اللغة الدينية فيها لغة التعبير عن حاجات الإنسان وتطلعاته، عميقة الغور في كل ما ينتجه من معارف أو يقدم عليه من أعمال. وحيثما ذهبنا في سبر أعماق الذاكرة الجماعية اصطدمنا بالعامل الديني مكوّنا تاريخيا من مكوّناتها.
الروافد الثلاثة
إنّ مشروع دراسة الظاهرة الدينيّة وتدريسها في المجتمعات العربيّة، بالمعنى الحديث والمقارن الذي قدّمنا، لن يكون منطلقا من فراغ. توجد ثلاثة روافد هي: التراث القديم، ومقاربات القضايا الدينية في العلوم الاجتماعية، ومحاولة إقامة علم خاص بالظاهرة الدينية منذ أكثر من قرن.
لقد أشرنا إلى السبق العربي في صياغة تاريخ الملل والنحل. كان الدافع إلى هذه الأدبيات عرض مقولات أصحاب العقائد والمذاهب والأديان وكانت هذه الأدبيّات في الغالب مقدّمة للردّ عليها. لكنّها لم تكن مجرد جدل مذهبي، بل مثّلت جهدا حقيقيا لمعرفة العقائد من مظانها، مع ما يقتضيه ذلك من تعرّف على اللغات والحضارات المختلفة. فالأشعري في «مقالات الإسلاميين» وابن حزم في «الفصل في الملل والنحل» والشهرستاني في «الملل والنحل» قد بلغوا مستوى ملحوظا من الموضوعية في العرض بالمقارنة بالسائد في ذلك العصر، بصرف النظر عن الرؤية الذاتيّة التي كانوا يحملون -للحقيقة. وليس المقصود طبعا أن نعود إلى منهجياتهم التي تجاوزها عصرنا الحاضر، بل أن نستلهم منهم الجرأة على الإقرار بالتعددية وتحمّل الرأي المخالف.
كما بلغ التعمّق المنهجي أقصاه مع البيروني الذي قدّم محاولة متكاملة لفهم بنيوي لحضارة معينة انطلاقا من سلوكها الديني، مع دقّة في العرض جعلت «تحقيق ما للهند من مقولة» مصدرا معتمدا إلى اليوم في مجال دراسة الديانات الهندية. يضاف إلى هذا ما تركه الفلاسفة مثل الفارابي وابن سينا وابن رشد الذين اهتموا بتشريح طبيعة الدين ووظائفه من خلال معالجتهم قضية علاقته بالفلسفة. ونشير أخيرا إلى أنّ «المقدمة» لابن خلدون قد تضمّنت نظرية متميزة حول الأدوار والتحولات التي يشهدها الدين في صلب العمران البشري. ونحن في حاجة إلى أن نتذكّر ما كان كتبه ابن رشد في القرن السادس الهجري، الثاني عشر الميلادي، حول الموقف الواجب اتخاذه من العلوم الكونيّة إذ قال: «إن كان لم يتقدّم أحد ممّن قبلنا بفحص عن القياس العقلي وأنواعه يجب علينا أن نبتدئ بالفحص عنه وأن يستعين في ذلك المتأخّر بالمتقدّم حتّى تكتمل المعرفة به، فإنّه عسير أو غير ممكن أن يقف واحد من الناس من تلقائه وابتداء على جميع ما يحتاج إليه من ذلك (…) وإن كان غيرنا قد فحص عن ذلك فتبيّن أنّه يجب علينا أن نستعين على ما نحن بسبيله بما قاله من تقدّمنا في ذلك، وسواء كان ذلك الغير مشاركا لنا أو غير مشارك في الملّة» ([5]).
ولم تعرف أوروبا المسيحيّة محاولات بالدرجة نفسها من الموضوعية إلا مع بداية عصر نهضتها، إلا أنّ محاولاتها أسفرت عن نقلة منهجية عميقة كانت أداتها الأولى الفيلولوجيا. ثم كان لنشأة الفلسفة الحديثة وتفرّع العلوم الإنسانية عنها، فضلا عن الاكتشافات العيانيّة لأديان البشرية، الدور الأهم في تثوير الرؤية للظاهرة الدينية، حتى تحوّل لفظ دين من المعنى القديم، أي معتقدات مجموعة بشرية معينة، إلى معنى الظاهرة المشتركة بين مجموع البشرية. وأسفر التقاء الفيلولوجيا بقضايا الفلسفة الدينية الحديثة عن طموح تأسيس علم خاص بالأديان، كما تأسّس علم النفس أو علم الاجتماع. وقد اتخذ هذا العلم مسمّيات مختلفة (علم الأديان، تاريخ الأديان، الأديان المقارنة، التاريخ المقارن للأديان، فينومينولوجيا الدين… إلخ) وحاول أن يدرس الدين لذاته وفي ذاته ليكون جديرا بصفة العلم المستقل. لكنّه لم ينجح بالتأكيد في بلوغ درجة من المشروعية تساوي ما بلغته العلوم الإنسانية الأخرى.
فالرافد الأهمّ في مجال دراسة الظاهرة الدينية المقاربات والنتائج التي تمخضت عنها مختلف العلوم الإنسانية، فقد اهتمت كلّها بهذه الظاهرة وأحدثت في صلبها فروعا مختصة بها (علم الاجتماع الديني، علم النفس الديني، التاريخ الديني، الأنثروبولوجيا الدينية… إلخ). على أن كل اختصاص قد منح الأولوية لزاوية نظره للظاهرة الدينية، على الرغم من أنها جميعا اضطرت إلى توسيع ميدانها الأصلي لتتابع هذه الظاهرة بأكثر شمولية.
فلئن لم تتضح بعد المعالم النهائيّة لعلم خاص بالدين، فإنّ الرؤية للظاهرة الدينيّة قد تطوّرت، والدراسات المقارنة للأديان في الصور المتنوّعة والثريّة التي غذّتها علوم الإنسان والمجتمع أصبحت جزءا من مكتسبات الحداثة المعرفيّة. والمهمّة التي تبدو أكثر فائدة اليوم هي إقامة ارتباط بين الاختصاصات (connexion interdisciplinaire) يمكّن من مقاربة الظاهرة الدينيّة مقاربة منهجيّة وموضوعيّة وعلميّة في فضاءات التدريس والبحث([6]).
فالمطلوب هو امتداد المعرفة العلمية لتشمل كل الأبعاد الإنسانية وكل الظواهر التاريخية والاجتماعية. وليس المقصود إضافة اختصاص جديد لاختصاصات سابقة، بل إقامة تواصل بين اختصاصات مختلفة تتقاطع حول دراسة ظاهرة معينة. وليس المطلوب الخوض في الإيمانيات والغيبيات ووسائل الاجتهاد، وإنّما عرض ما هو موضوعي مشترك بين مجموعات بشريّة مختلفة. إنّ الحرية الأكاديمية والتفتح على المعرفة الكونيّة والإيمان بالطاقات الشبابيّة هي الشروط الضروريّة للنجاح في هذا المسار. وأختم بالإشارة إلى أنّ برنامج ماجستير الدراسات المقارنة الذي أسّسناه سنة 2004 كان قد قام على مبادئ ثلاثة اعتبر أنّها كافية اليوم لتكون منطلقا لهذا النوع من الدراسات في الجامعات العربيّة وهي التالية:
– اعتبار الظاهرة الدينية ظاهرة إنسانية اجتماعية مستمرّة استمرار الوجود الإنساني، وقابلة أن تكون موضوع بحث منهجي معقلن.
– قصر الاهتمام على البحث العلمي دون غيره من الاهتمامات ذات الطابع السياسي أو الإيماني أو الاجتهادي.
– الاعتماد على مكتسبات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومقارباتها المتعددة للظاهرات الدينية، على أن يكون هذا الاعتماد نقديا اختباريا لا تلقينيا إسقاطيا.
فالبرامج التعليميّة العربيّة مدعوّة إلى التفكير في تعميم الدراسات الدينيّة المقارنة في كلّ مستويات التعليم، على الرغم من كلّ المشكلات والمصاعب النظريّة والعمليّة التي أشرنا إليها.
الأستاذ محمد الحدّاد يشرف على ماجستير الدراسات المقارنة للأديان والحضارات بالجامعة التونسية وعلى كرسي اليونسكو للدراسات المقارنة للأديان.
[1] ترجم سخاو للبيروني «الآثار الباقية» سنة 1879 و«تاريخ الهندسة» سنة 1888 ونشر «تحقيق ما للهند من مقولة» سنة 1887. ونشر غوستاف فلوجل كتاب «الفهرست» لابن النديم سنتي 1871-1872 ونقله إلى الإنجليزية بايار دودج سنة 1970.
[2] نذكر على سبيل الإشارة تواريخ نشأة هذه الجامعات: جامعة القديس يوسف بلبنان: 1875، المدرسة الصادقية بتونس: 1880، جامعة الجزائر العاصمة: 1908، جامعة القاهرة: 1925، جامعة الإسكندرية: 1950، جامعة بغداد: 1956، جامعة حلب: 1957، جامعة دمشق: 1958، الجامعة التونسية: 1960… إلخ.
[3] يراجع حول الحالة الفرنسية الدراسة التالية:
Rémond (René), L’anticléricalisme en France. Fayard, 1976.
[4] نشرنا هذا التقرير معرّبا في هذا المجلد.
[5] يراجع كتابه “فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال».
[6] يراجع كتابنا: ديانة الضمير الفردي، دار المدار، بيروت، 2006.