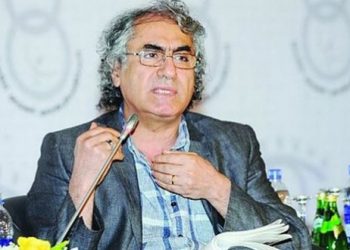يحدّد منطق رواية القصص في السياق الاجتماعي، لا العلمي، ما الذي يؤمن به الناس. ولا يشمل ذلك المعتقدات عن الله فحسب، بل أيضاً الطبيعة البشرية والعرق والسياسة وكيف تختلط جميعاً معاً. ويكفي القول: إن ما يؤمن به الناس، من السامي إلى المخالف للمعقول، يؤثر في ما يفعله الناس.
شريط الكاريكاتور المفضّل لدي عمل من لوحة واحدة من “نن سكويتر” (Non Sequitur) يعود إلى سنة 1995 بعنوان “تنقيح الكلاب”. في اللوحة، يصوّر الفنّان، وايلي ميلر، شخصيته الرئيسة متحدّثاً مع كلبه وهو يهمّ بمغادرة الشقة: “أنا خارج (…) لا تدخل سلة المهملات في أثناء غيابي”. في حين يستمع الكلب بعناية جالساً، ويفكر في بالون الحوار: “اذهب …. وادخل …. في …. القمامة … في أثناء … ذهابي.” استغرقت سنوات لأفهم أن الرسم الكاريكاتوري لا يتعلّق في الواقع بشخص وكلب أو يقتصر عليهما فحسب. إنه يتعلّق بأشخاص، لا سيما أشخاص من ثقافات مختلفة، وبأشخاص لديهم وجهات نظر مختلفة داخل ثقافة ما أيضاً، يعرفون ما يكفي عن بعضهم بعضاً لفهم الأسس فهماً خاطئاً تماماً، دون أن يدركوا ذلك بطبيعة الحال إلا بعد فوات الأوان.
يوجد التنبيه التحذيري نفسه في أحد أشهر أبيات الشعر الإنجليزي المكتوب على الإطلاق -أو أحد ضروب شعر لولاند الإسكتلندية، في هذه الحالة. وهكذا كتب روبرت بيرنز عام 1786: “هلا تمنحنا قوة ما الموهبة، لنرى أنفسنا كما يرانا الآخرون! ليحرّرنا ذلك من ارتكاب الأخطاء، والأفكار الحمقاء”.
ماذا لو كان سوء الفهم متبادلاً ومتزامناً؟ يقدّم لنا الأدب حكاية مفيدة عن ذلك أيضاً: حكاية الكاتب الأميركي أوهنري الشهيرة في أوائل القرن العشرين “هدية المجوس”. وفي القصة، يريد عاشقان شراء هدايا العيد، كل منهما للآخر، لكنهما يفتقران إلى المال. لذا يبيع الشاب ساعته الثمينة ليشتري أمشاطاً وأشرطة تزيّن بها حبيبته شعرها الطويل الجميل. وفي غضون ذلك، تبيع الحبيبة شعرها الجميل إلى صانع شعر مستعار لشراء سلسلة لساعة حبيبها الأثيرة. وعندما يفتحان هداياهما معاً، سرعان ما تتبدّد مفاجأتهما أمام إدراكهما أنهما أثبتا حبّهما الحقيقي لبعضهما، إذ تخلّى كلّ منهما عن شيء مهم من أجل الآخر. وهذا الحادث المؤسف مؤقّت على أي حال: سينمو شعرها ثانية في النهاية، وسيتمكّن ذات يوم من شراء ساعة جديدة، لذا لن تذهب الهدايا سدى.
إن مما يؤسف له أن سوء الفهم المجسّم، أو رابطة حسن النوايا التي لا تؤدي إلى النتائج المتوقّعة، لا تصل إلى نهاية سعيدة دائماً. ففي بعض الأحيان تشكّل عقبة اجتماعية وتحدث عبئا هائلاً من سوء النية والسلوك غير المرغوب، بل حتى مأساة مهلكة. ثمة هدف ذو شقين لاستخدام الأدب في ولوج هذا الموضوع المشحون. الأول: إظهار أن الخيال ليس مجرد ترفيه، وإنما بوّابة لرؤى نقدية حول الطبيعة الاجتماعية للإنسان تعجز الكتابة التعليمية الباردة عن التقاطها. والثاني: إبراز قوة القصص ورواية القصص -بعبارة أخرى، السرد في جميع العلاقات الإنسانية، بما في ذلك العلاقات السياسية.
قال فرانز كافكا ذات يوم: إن الله خلق البشر ليرووا القصص. وسواء أكان ذلك صحيحاً أم لا، فإن الروايات تشكّل تفسيراتنا للأحداث والنيّات وكيف تمتزج معاً. ويرجع ذلك إلى أن كل قصة، وكل رواية، تتحرّك وفقاً لهذا المنطق أو ذاك. وإذا كانت الأفعال الموصوفة عشوائية، فلن يكون لدى المرء قصة. وعندما يستخدم الناس القصص للشرح أو الإقناع، يحدّد الإطار المنطقي المختار طريقة ظهور القصص وتأثيرها في الآخرين. فإذا تابع المستمع المنطق وتقبّله بوصفه صالحاً، تأثّر بالقصّة على الأرجح، وتساوى كل شيء آخر، سواء أدرك بوعي أنه يقيّم هل القصة معقولة أم لا (ليس في الحياة الطبيعية عادة).
غير أن كل شيء آخر ليس متساوياً، والسياق الاجتماعي أهم عامل يؤثّر في فعالية القصص. إذا صدّق السردَ العديدُ من الأشخاص الآخرين الذين يحترمهم المستمع أو يهتم بهم، فإن الضغط يتصاعد على فرد معين لتصديقه أيضاً -وإلا فلا. وينطبق ذلك على الروايات المكتوبة والمنقولة شفهياً. وقد أظهرت التجارب الشهيرة حول التماثل التي صمّمها سولومون آش في خمسينيات القرن العشرين، أنه يمكن حثّ الآخرين على تصديق بعض العبارات التي تحيط بها شكوك مرتفعة عن طريق ضغط الأقران فحسب. وفي الحالات القصوى، تنشئ كل الطوائف، السياسية والدينية، التماسك والروح المعنوية العالية بإنتاج اعتقاد مشترك في حكايات غير محتملة للغاية عن الأصل والسبب.
ما أهمية ذلك؟ لأن السياق الاجتماعي الذي تُخلق فيه القصص وتبلّغ وتُقبل أو تُرفض أمر حاسم في تشكيل العلاقات بين المجموعات داخل الحدود الوطنية وفيما بينها. باختصار، إنها تؤثّر في السياسة المحلية والدولية. وتفعل ذلك عن طريق ما يسمى عادة “الصور النمطية”.
“الصورة النمطية” تبسيط شديد، عن طريق سرد أو حبكة قصصية لخصائص جماعية. هناك دائماً شيء من الحقيقة في الصورة النمطية، ولكنْ هناك دائماً تشويهٌ هائلٌ لفرط التبسيط. في بعض الأحيان تكون التشوّهات ذات أثر إيجابي، لكنها في أغلب الأحيان تتبع تمييزاً بين من ينتمون إلى جماعة ومن لا ينتمون وتميل إلى أن تكون سلبية. المراد هنا أن “الصور النمطية” لا توجد خارج الحبكات القصصية، وأن “الصور النمطية” تشمل عادة رموزاً دلالية مكثّفة وشيئاً من اللغة الانفعالية القوية، التي تعبّر بإيجاز عن تلك الحبكة القصصية. وفي الديناميكيات السلبية للانتماء إلى جماعة أو عدم الانتماء، غالباً ما تكون هذه الرموز الدلالية المكثّفة نعوتاً أو افتراءات حول الخصائص الإثنية العرقية أو تشويهاً لها.
“الصور النمطية” جزء من ديناميكي ذي آثار فعلية شديدة الأهمية. ويمكن وصف العديد من الأمثلة من أنواع مختلفة. يمكننا النظر في أحد الأمثلة الملطّفة إلى حدٍّ ما فيما يتعلق بفنون كتابة الخطابات السياسية، باستخدام انعدام حساسية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة تجاه الآخرين بمثابة مثال. أو يمكننا مناقشة الرابط بين العلاقات العرقية المعاصرة في الولايات المتحدة وتكاثر نظريات المؤامرة الشنيعة حول هذا الموضوع ومسائل أخرى. وحرصاً على الوقت ورأفة بك عزيزي القارئ، نكتفي هنا بالموضوع الأخير.
على الرغم من الماضي الطويل والدنيء والكثير من الأعمال غير المكتملة، فإن الولايات المتحدة المعاصرة هي أفضل مثال في التاريخ على مجتمع ناجح متعدّد الأعراق والإثنيات. قد لا يفيد ذلك بالكثير عن الإنسانية، لكنه صحيح مع ذلك، وهو صحيح على الرغم من الذعر الأخلاقي المؤدلج للغاية، الحالي والمتكرّر بشأن العرقية في الولايات المتحدة.
نحن الأمريكيين ذوو عقلية تؤمن بـ”المساواة” على الرغم من أننا لا نتصرّف دائماً كما يدعونا عقلنا الجماعي إلى التصرّف، لكننا لا نطيق عدم الكمال لهذا السبب. ولأننا غير كاملين، فقد تعيّن على كل جيل -على ما يبدو- إعادة اكتشاف ما لا نفعله ولكن يجب علينا القيام به -ولكن من دون الاستهانة بما أصبنا في فعله، أو التقليل من الإنجازات المتحقّقة بشقّ الأنفس. لكن أداء هذه الحيلة ازداد صعوبة الآن. فالمقولة اليسارية الماركسية الجديدة، وهي لا تزال مقولة الأقلية، لكنها تكتسب مزيداً من التأييد منذ حادثة “جورج فلويد” في 25 مايو (أيار)، بأن أمريكا عنصرية على المستويين: المؤسسي والمنهجي، مقولة خاطئة. وكما عبّرت آيان هيرسي علي على نحو صحيح وصريح في صحيفة “وول ستريت جورنال” في 26 يونيو (حزيران): “أمريكا هي أفضل مكان على هذا الكوكب للسود أو الإناث أو المثليين أو المتحوّلين جنسياً أو أي شيء آخر. لدينا مشكلاتنا وعلينا أن نعالجها. لكن مجتمعنا وأنظمتنا بعيدة عن العنصرية”. لكن مقولتها، على الرغم من صدورها عن امرأة سوداء تقول الحقيقة في مواجهة الهراء، بعيدة الاحتمال بالنسبة للكثيرين اليوم لسببين رئيسين:
الأول: تعذّر إنكار استمرار العنصرية البنيوية، التي تتضح بجلاء في التعليم والإسكان والتمييز الوظيفي ضدّ الأمريكيين من أصل أفريقي. والخلط بين الاثنين أمر محتوم عندما يوضع في إطار أيديولوجي مقابل إطار تحليلي أو حبكة قصصية لأن الأيديولوجية، مهما كانت، هي تركيب سابق لأوانه. إنها تقفز إلى استنتاجات عاطفية تتجاوز الأدلة. إنها تشبه نصف طوبة: ليست مجدية مثل طوبة كاملة إذا كنت ترغب في بناء شيء ما، ولكن يمكن رميها مسافة مضاعفة –تقريباً- إذا كنت تريد إيذاء شخص أو كسر شيء ما.
لا يمكن فصل السبب الثاني عن الأول. فقد اكتسبت مقولة العنصرية التأسيسية مزيداً من القبول أخيراً؛ إذ يوجد الآن في الولايات المتحدة -على نحو علني أكثر من أي وقت مضى- ما من الإنصاف تسميته حزباً سياسياً رئيساً عنصرياً: “الحزب الجمهوري”، كما يُشكل حالياً على صورة الرئيس السابق دونالد ترمب. لقد سعى الجمهوريون -وبخاصة ترمب- إلى “استثارة العنصرية” لتقسيم الأمريكيين ثم الاستفادة من المخاوف الناتجة. فهم يستخدمون عبارات ملطّفة مثل “القانون والنظام” للتواصل مع الناخبين الذين يستمعون إلى إشارات خارج النطاق الطبيعي بدلاً من اللجوء مباشرة إلى المشاعر العنصرية كما كانت الحال قبل سبعين عاماً.
بالنظر إلى الارتياب الديموغرافي المبالغ فيه، فإن العديد من الجمهوريين، الذين واجهوا في أذهانهم الاختيار بين المحافظة على أمريكا “بيضاء” ثقافياً وسياسياً واحترام الإرادة الديمقراطية للناخبين، انحازوا إلى الخيار الأول. إنهم يريدون في الواقع إحلال الظل “الأبيض القذر” للقومية العرقية محل القومية المدنية التي توجد دائماً في قلب الثقافة السياسية الأمريكية. وبخلاف ذلك ما كانوا لينخرطوا في جهود قمع الناخبين في السنوات الأخيرة، ولما حاول بعض الجمهوريين رفيعي المستوى في أوائل الشهر الماضي القيام بانقلاب بناء على كذبة كبيرة عن سرقة الانتخابات، في حين تجاهل معظم الجمهوريين ذلك، ثم اختلقوا له الأعذار بناء على مجموعة كبيرة من الأكاذيب الصغيرة.
هذه ليست ظاهرة جديدة تماماً بطبيعة الحال. في خريف سنة 1957، أدخل الرئيس دوايت أيزنهاور الحرس الوطني في أركنساو تحت السلطة الاتحادية، وأمره بفرض إلغاء الفصل العنصري في المدارس العامة في ليتل روك. كان يعرف كل القوانين النافذة في الدولة منذ قرار المحكمة العليا لسنة 1954 في قضية “براون ضد مجلس التعليم”: فقد أعلن عدم دستورية مبدأ “منفصلون لكن متساوون” المنصوص عليه في القانون في قضية “بلِسي ضد فيرغسون” (1896)، وكان ذلك جزءاً لا يتجزأ من واقع قوانين جيم كرو في حقبة إعادة الإعمار في الجنوب الأمريكي. احترم أيزنهاور يمين الرئاسة الذي يتعهّد بحماية الدستور، وتصرّف وفقاً لذلك. وعندما فعل، جاء رد فعل الدكسيقراطيين (يمينيو الحزب الديمقراطي المؤيّدون لحقوق الولايات الجنوبية) غاضباً.
كان الحزب الديمقراطي سنة 1957 منقسماً -إلى حدٍّ كبير- حول مسألة العرقية، مثل انقسام حزب الويغ سنة 1852 تقريباً، وكما هو حال الحزب الجمهوري اليوم، حول مسألة اتباع سلوك العقلانية أو الجنون بشأن العرقية (وكل شيء آخر). الاختلاف الرئيس هو أن السياسات الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية كانت شأناً محليًّا إلى حدٍّ كبير: ائتلافات وطنية متنوّعة داخلياً من الديمقراطيين والجمهوريين تتشكّل كل أربع سنوات فقط قبل الانتخابات الرئاسية. ويعني ذلك عندما تصبح الخلافات حول العرق أكثر بروزاً وحدّة.
وهكذا سنة 1948، ألغى الرئيس الديمقراطي هاري س. ترومان من جانب واحد الفصل العنصري بين القوات المسلحة الأمريكية. وفي السنة نفسها، ثار جدال كبير في المؤتمر الوطني الديمقراطي بشأن الفصل العنصري. وقاد السناتور، ونائب الرئيس لاحقاً، هيوبرت همفري من مينيسوتا، مسعى لاستبعاد دعاة الفصل العنصري من الحزب، وإصلاح بروتوكولات حقوق التصويت في الجنوب الأمريكي، الذي كان يخضع بقوة لسيطرة الحزب الديمقراطي. وكانت النتيجة انسحاب ستروم ثورموند من ساوث كارولينا من المؤتمر، وخوضه الانتخابات الرئاسية مرشّحاً مستقلاً بناء على برنامج يؤيّد الفصل العنصري صراحة. وقد فاز في أربع ولايات جنوبية، لكن ترومان احتفظ بالرئاسة.
كانت تلك الولايات الأربع -ساوث كارولينا، وميسيسيبي، وألاباما، ولويزيانا- كيانات سياسية صغيرة تخضع في الأساس لحكم حزب واحد سلطوي عنصري، وظلّت كذلك منذ نهاية حقبة إعادة الإعمار سنة 1876. لم يكن لدى الجمهوريين فرصة للفوز في الانتخابات في أي مكان في الولايات الكونفدرالية السابقة، إذ كان يشارك في العمل السياسي فصائل وشخصيات مختلفة بين الديمقراطيين، وكلهم من مؤيّدي الفصل العنصري القانوني. لكن عندما حاول الديمقراطيون، بعد الحرب العالمية الثانية، إصلاح أنفسهم داخلياً، رأى بعض الجمهوريين فرصة لتوسيع قاعدتهم. وقد لاحت أول فرصة لذلك ووضعت موضع التنفيذ سياسياً على المستوى الوطني سنة 1964، عندما صوّت المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس، السناتور باري غولدووتر من ولاية أريزونا، ضد قانون الحقوق المدنية.
بعد أربع سنوات، أطلق ريتشارد نيكسون استراتيجيته الجنوبية “القانون والنظام”، مستخدماً أساساً رسائل خفية عنصرية، ثم عن نقل الطلبة بالحافلات والعمل الإيجابي، لاجتذاب ناخبي الولايات الجنوبية من الجانب الديمقراطي إلى الجانب الجمهوري. وقد قام بذلك مستفيداً من القلق المتزايد في أوساط البيض من أعمال الشغب والعنف العرقي في المدن سنة 1967، وخاصة سنة 1968 بعد اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن في أبريل. نجح نيكسون بفوزه في الانتخابات في سباق متقارب مع نائب الرئيس هيوبرت. همفري، ويرجع ذلك إلى بوتقة العلاقات العرقية الأمريكية أكثر مما يتعلّق بالخلاف بشأن سياسة حرب فيتنام، كما كان يُفترض.
ربما كان أهم تحوّل في السياسة الأمريكية على مدار الـ(75) عاماً الماضية تحوّل الجنوب الأمريكي من معقل ديمقراطي إلى معقل جمهوري. اعتاد الديمقراطيون، لا حزب لينكولن، أن يكونوا حزب العنصرية الأمريكية، إلى حدٍّ كبير على الأقل. ومن المؤكّد أنه كان الحزب الديمقراطي العنصري الأكثر صراحةً الذي شغل المكتب البيضاوي قبل ترمب، أي وودرو ويلسون. وظل الحزب الديمقراطي في خمسينيات القرن العشرين حزب الحكم السلطوي الفعلي للحزب الواحد في الولايات التي يسيطر عليها، وهي الولايات التي تسامحت مع الإعدام خارج نطاق القانون و”جماعة كو كلوكس كلان” ولم تعتذر عن أي منهما. وكانت هذه القوة السياسية شديدة جداً، بحيث لم يجرؤ حتى فرانكلين ديلانو روزفلت، الرئيس القوي الذي حكم عدّة فترات، على تحديها مباشرة. ويواجه الجمهوريون اليوم المشكلة نفسها.
نشأتُ في الخمسينيات في ولاية فرجينيا التي كانت تمارس الفصل العنصري. ولدت قبل قضية “براون ضدّ مجلس التعليم”، وأذكر كيف كان الفصل العنصري جيداً، لأنه استمر من دون أن يمسّ -إلى حدٍّ ما- لمدة ستة أعوام -على الأقل- بعد قرار سنة 1954. وأذكر أيضاً كيف شرح لي الكبار مع تقدّمي في السنّ طريقة العمل الروتينية المتزمّتة للنظام المتماسك الرهيب والمهين على مستوى الحياة اليومية، وهو درس لم أنسه البتة.
إنه درس يفيد بأن النيّات الشريرة الصريحة ليست ما يخلق عادة مواقف فاسدة أخلاقياً مثل الفصل العنصري، أو حتى العبودية قبل ذلك بوقت طويل. الشر ينتج عن الجهل والقناعة والامتثال والكسل بقدر ما ينتج عن الدوافع الشيطانية العلنية. من المؤسف أن بعض العنصريين -البيض والسود في السياق الأمريكي- يمكن أن يظهروا “أناساً طيبين” ويكونوا كذلك في الواقع في كثير من النواحي، أسوياء تماماً عندما لا يثابرون على العرقية. (الأمر مختلف تماماً بطبيعة الحال عندما يقول رئيس أمريكي شيئاً كهذا بعد حدث عنيف احتشد فيه بعض الغوغاء حول علم نازي.) مع ذلك، ما الدرس الذي تعلّمته؟
تخيل وضعاً يكون فيه مشروع تطوير عقاري شاهق لإسكان ذوي الدخل المنخفض في منطقة حضرية، على مسافة قريبة من مناطق التسوّق والأحياء ذات المكانة الاجتماعية الرفيعة. يمكن إيجاد مثال على هذا الوضع بالضبط في قسم كوينز فِلِدج بوسط مدينة فيلادلفيا. في مثل هذا الوضع، يكبر الشباب الأمريكيون من أصل أفريقي، أكثر من الأطفال البيض وسواهم، في منازل محطّمة، وفي ثقافات فرعية تعاني لأسباب تاريخية من غياب الآباء، أو عدم وجود أب يقرأ لهم، ولا يكادون يرون كتاباً للقراءة. من المرجح أن يأتي الأطفال الأمريكيون من أصل أفريقي المقيمون في تلك “المشاريع”، كما يطلق عليها، من منازل يقلّ فيها الدخل المتاح ويرتفع الإجهاد الناجم عن الوفاء باحتياجاتهم الأساسية أيضاً.
ومن المرجّح أيضاً أن يشهدوا أسلوباً في الأبوة والأمومة يختلف اختلافاً نوعياً عن أسلوب أسر الطبقة الوسطى، ويظهر ذلك في أنماط التواصل على وجه الخصوص. يميل الآباء من الطبقة الوسطى، بما في ذلك الآباء في الطبقة الوسطى الأمريكية من أصل أفريقي التي تنمو باطراد، إلى مخاطبة الأطفال في سن معيّنة بجمل كاملة نحويًّا، وغالباً ما يطرحون أسئلة على أطفالهم لتدريبهم على المشاركة في علاقات البالغين العادية. أما تربية الأطفال من الطبقة الدنيا، وينطبق ذلك أيضاً على معظم الأسر البيضاء من الطبقة الدنيا، فتميل إلى اختصار التواصل للغاية. وهكذا يصبح المعيار الأوامر القصيرة والمتقطّعة من الوالد إلى الطفل: “افعل س”، “لا تفعل ص”، “تناول غداءك”، “التقط أغراضك”، وقبل كل شيء، “اهدأ”. يلتقط الأطفال من حديث والديهم القوي الإشارات الدقيقة وغير الدقيقة إلى أن الحياة صعبة ولا يمكن التنبّؤ بها، وأن القلق أمر طبيعي، والثقة نادرة خارج المنزل. لذا فإن فحوى الرسالة هي أن على الأطفال أن يتعلّموا أن يكونوا أقوياء للاعتناء بمصالحهم. على سبيل المثال: إذا لكمك جوني في المدرسة، فلا تأتِ إلي مسرعاً أو إلى معلمك لتشكوه. الكمه فحسب، بقوة أشدّ.
النتيجة هي أن معظم الأطفال الأمريكيين من أصل أفريقي في مشاريع فيلادلفيا، وفي البيئات المنزلية المماثلة في أماكن أخرى بطبيعة الحال، يكبرون بإحساس أقل بالأمان العاطفي، وأقل تغذيةً في كثير من الحالات، وأقل تعليماً في المنزل في المهارات الأساسية قبل أن يذهبوا إلى المدارس التي غالباً ما تمارس فصلاً عنصرياً فعليًّا، وبالتالي تطبّع أوجه القصور التي وصفت أعلاه وتعزّزها. ويعانون من فقر كبير في الكلمات مقارنة بأطفال الطبقة المتوسّطة قبل اليوم الأول من المدرسة؛ ولا يدخلون مجالاً يتيح فرصاً متكافئة فحسب، وإنما ظالماً أيضاً بسبب أوجه القصور في النظام المدرسي. وتبدأ الصعوبة المسبقة في معظم الحالات يوم إحضارهم إلى المنزل من المستشفى بعد الولادة.
لذا فإن الأطفال الأفقر -وينطبق ذلك على كل الثقافات- يميلون إلى تطوير مفاهيم عن الحياة أشدّ قوة وذات محصّلة صفرية. ونظراً إلى أن الثقافة الفرعية تفتقر إلى التقييم العالي للتعليم الذي تُكتسب فيه المعرفة من الكتب، فإن أداءهم الأكاديمي يكون سيّئاً، مما يؤدّي إلى إدامة دورة توارث الثقافة الفرعية. وغالباً ما يفشلون في اكتساب تعليم عميق، ونتيجة لذلك يميلون إلى التوجّه أكثر نحو الحاضر. ويزيد التوجه نحو الحاضر من صعوبة تخيّل مستقبل ملموس، وصعوبة التخطيط، والتركيز على العمل، و بناء الانضباط الذاتي، وتحقيق السيطرة الموثوقة على الدوافع. ولا يتحمّس كثير من أصحاب العمل لتوظيف مثل هؤلاء الأشخاص.
يجب أن يكون واضحاً أن هذه الأنماط تتوقّف على الطبقة لا العرق. وهي ثقافية لا بيولوجية. لكن التاريخ الأمريكي أحدث تداخلاً هائلاً بين الطبقة والعرق. وبالتالي فإن الأفكار النمطية التي تنشأ من الطبقة وتنطبق عليها بشكل ملائم، تنتقل إلى العرق في الغالب، وخاصة عندما يرى البيض من الطبقة المتوسّطة في المناطق الحضرية عدداً من الأمريكيين الأفارقة من الطبقة الدنيا أكبر مما يرون من البيض من الطبقة المتدنية الريفية. (التصوّرات والعلاقات العرقية بين الأمريكيين الأفارقة من الطبقة المتدنّية والبيض قصة شديدة التغيّر والتعقيد لن نتناولها هنا).
نعود إلى كوينز فِلِدج وتطوّر “الصور النمطية”. يرغب الطفل الأمريكي من أصل أفريقي في الرابعة عشرة من العمر في درّاجة، مثل أي طفل آخر. إذا كان والداه أو أحدهما غير قادر على شراء درّاجة، فإن نسبة مئوية صغيرة من الأطفال -وخاصة الذكور- سيتوجّهون إلى الحي الأوسع “لاستعارة” واحدة أو سرقتها. ولنفترض لأغراض هذا الدرس أن النسبة المئوية للأطفال الذكور الأمريكيين من أصل أفريقي الذين يصبحون لصوص درّاجات هي (3%). ذلك يعني أن (97%) ليسوا لصوص درّاجات.
لكن البيض في المنطقة يرون أن كل لصوص الدرّاجات –تقريباً- أمريكيون من أصل أفريقي -لنقل (97%) منهم. لذا يميل البيض إلى تكوين أفكار نمطية بأن الأطفال السود لصوص، وسيعمّمون من الدرّاجات إلى أشياء أخرى، ومن الأشياء الأخرى إلى الدرّاجات. فالعقل البشري -كما نعلم- ترابطي من دون تدقيق. ونتيجة لذلك، فإنهم سيطوّرون -في أحسن الأحوال- مواقف متناقضة تجاه الأمريكيين من أصل أفريقي، لا سيّما الذكور، وستصبح نسبة صغيرة منهم متزايدة الصغر -والحمد لله على ذلك- عنصريين تبعاً لتربيتهم.
الآن، ستواجه الغالبية العظمى من الأطفال السود غير اللصوص مواقف البيض بوصفها غير عادلة وعدائية، وهي كذلك. وسيطوّرون -في الغالب- أفكاراً نمطية مقابلة نتيجة لذلك. ثم ترتدّ الأفكار النمطية وتعزّز بعضها بعضاً على مرّ السنين وحتى الأعمار، وغالباً ما تنتقل بمثابة وراثة داخل العائلات مثل الجينات السيّئة. يتجاهل الجميع روبرت بيرنز. ولا يحاولون رؤية الحياة من منظور الشخص الآخر. إنهم سيّئون في الرياضيات الحدسية، لذا فإن (2%) أو (5%) قد يصبحون (100%) لجميع الأغراض العملية والمؤسفة للغاية.
إن المخاوف والاضطرابات العصبية الموازية التي تنتجها هذه الأفكار النمطية الخاطئة متعدّدة وكبيرة ومستمرة. وهي تتطلب أن نبذل ما في وسعنا على مدى سنوات عديدة لمقاومتها وتقليصها قدر ما نستطيع؛ لكننا نقوم بذلك، وقد نجحنا فيه في كثير من الأحيان حتى وقت قريب، على الأقل. لكن الأمور يمكن أن تزداد سوءاً في بعض الأحيان، عندما يشهد المجتمع بأكمله، لأسباب لا علاقة لها بالعرق، استنزافاً كبيراً للثقة الاجتماعية، ويصبح أكثر وعياً جماعيًّا وتفسد عقلية المحصلة الصفرية، وفوق كل ذلك يتعيّن عليه أن يتعامل مع جائحة وحشية قتلت نصف مليون منا، ودفعت بخلاف ذلك أعداداً كبيرة من الأمريكيين الذين أفسدهم الإحساس بالأمن إلى الجنون.
العنصرية الحقيقية والعنصرية المبالغ فيها على وجه الخصوص، التي يتم التلاعب بها وتوجيهها هي -إلى حدٍّ ما- المحرّك داخل السيارة الأمريكية المسرعة خارجة عن السيطرة في الوقت الحالي، وقد تكون العجلات على وشك الانفصال عنها. في ظل الظروف الحالية، لا تحظى حقائق العلوم الاجتماعية بفرصة مقابل صفّارات الذعر الأخلاقي والمبالغة الأيديولوجية. وذلك أمر مثير للسخرية بطبيعة الحال، إذ لو أجرينا مقارنة رزينة بمقدار عنصرية المجتمع الأمريكي (وكرهه للنساء ومعاداته للسامية) قبل الحرب العالمية الثانية -لنختر سنة 1941 بوصفها سنة مناسبة- فسنجد أنه أقل عنصرية بما لا يوصف -تقريباً- الآن، بعد ثمانين عاماً. لكن ذلك ليس رأي العديد من الأشخاص، لا سيما العديد من الأمريكيين الذين يعرفون القليل عن التاريخ ولا يهتمون به. فالقصص التي يسمعونها ويقتنعون بها تتحدّث عن رواية أخرى، وبعض تلك القصص أصبحت بالغة السخف. وهكذا نصل إلى موضوعنا الأخير: اليهود.
إن نظرية “مؤامرة كيو أنون” هي أكثر من مجرد مجموعة من التشنجات اللاإرادية العصبية المنفصلة. وهي ليست نظرية شائعة عن الماضي والحاضر، ولكنها خرافة كاملة تتضمن قوساً سردياً، نسجه نبي ذو شخصية كاريزمية، وتتنبأ ببلوغ ذروة العنف والتجلّي والخلاص في المستقبل. وبالنظر إلى ميراثها البروتستانتي الخاص بأمريكا الشمالية، وعلى الرغم من معاداة السامية التي تشترك فيها مع أسلافها الأوروبية، فإنها تظهر لغير المؤمنين مزيجاً غريباً من سفر الرؤيا والاختطاف (في المجيء الثاني للمسيح) ولعبة فيديو ذات طابع قتالي. يمكن اعتبارها منافية للمعقول.
لكنها معادية للسامية أيضاً، وتنتشر بسرعة بين الجمهوريين، بل إنها تهيمن الآن على كوادر الحزب على مستوى الولاية في أريزونا ووايومنغ وهاواي وأوريغون وتكساس وغيرها. ولا تكتمل مؤامرة اليمين المتطرّف بدون الادعاء، الذي عبّرت عنه عضو الكونغرس المستجدّة عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين، بأن حرائق الغابات الأخيرة في كاليفورنيا أضرمها عمداً اليهود الذين أطلقوا أشعة الليزر من الفضاء الخارجي.
تماثل تخيّلات كيو أنون “بروتوكولات حكماء صهيون” المزوّرة سيّئة السمعة في أواخر القرن التاسع عشر في روسيا القيصرية. ففي كليهما توجد عصابة سرية من اليهود الذين يخطّطون للسيطرة على العالم، تسمى الآن “العولميون”. ويظهر في كليهما أطفال مقتولون وطقوس مروّعة: قبل فترة طويلة، كان هناك “فرية الدم” عن قيام اليهود بقتل أطفال مسيحيين لاستخدام دمائهم في صنع خبز الفصح اليهودي، الآن شهوة الدم الناجمة عن عقار “أدريانوكوم”، التي تزعم بين جملة أمور، وجود فيديو أسود على شبكة الإنترنت تمزّق فيه هيلاري كلينتون وهوما عابدين وجه طفل ميت لتشربا دمه (لا يوجد مثل هذا الفيديو). اليهود/ العولميون لديهم أموال لا تحصى انتزعت من عامة الناس -هنا يأتي جورج سوروس في هذه الأيام ليحل محل آل روتشيلد القدماء. إنهم يتحكّمون الآن في الإعلام الأمريكي الكاذب “الزائف”. وهم داخل “الدولة العميقة” الأمريكية.
لكن لـ”الكيو أنون” -كما أشرنا- نكهة بروتستانتية مجنونة خاصة: يعتقد أتباعها أن القوة الحقيقية وراء النخبة الأمريكية الحاكمة اليوم ليست سوى الشيطان، وهو أيضاً المسيح الدجّال، اليهودي من النحية النموذجية. في عالم الاختطاف (مجيء المسيح الثاني) المشوّش للإنجيليين الجدد، يعادل يسوع سانتا كلوز بالنسبة للبالغين فيزيولوجياً، كما أن الأشرار في رواية الأبطال الخارقين تختلط صورتهم بشدّة بالشيطان، بحيث يمكن أن تتوقّع قيام رسم متحرّك ليسوع باستلال سيف ضوئي لمقاتلة الأشرار ذوي الأنوف المعقوفة.
التخيّلات الرهيبة المعادية للسامية، التي تحمل أيضاً خزانة مليئة بالصور النمطية، ليست بالطبع أحدث من الصور المجازية العنصرية الواسعة الانتشار في الماضي السياسي الأمريكي. فيما يلي وصف نورمان كوهن الظاهرة الأساسية سنة 1966، مشيراً بالطبع إلى النازيين في ألمانيا وأوروبا ؛ لكن لا يصعب على المرء رؤية أن هذا الوصف يناسب أتباع كيو أنون ويساعد في شرح أحداث 6 يناير (كانون الثاني).
يوجد عالم تحت أرضي ينتج فيه المحتالون والمتعصّبون نصف المتعلمين التخيّلات المرَضية المقنعة بمثابة أفكار لصالح الجهلة والمؤمنين بالخرافات. هناك أوقات ينبثق فيها هذا العالم السفلي من الأعماق ويسحر فجأة ويستحوذ ويسيطر على جموع الأشخاص العاقلين والمسؤولين عادة، فيتخلّون بعدئذٍ عن سلامة العقل والمسؤولية. ويتفق أحياناً أن يصبح هذا العالم السفلي قوة سياسية ويغيّر مجرى التاريخ.
ذلك لا يعني أن أمريكا سنة 2021 تماثل ألمانيا سنة 1933، أو أن أتباع “كيو أنون” نازيون، أو أن النتائج الكارثية للماضي ستتكرّر في المستقبل القريب. لكنها تركّز العقل.
يعتقد بعض الأفراد أن الجنون الأمريكي الحالي يرجع إلى الإجهاد الناجم عن الجائحة، وأن الأمور -بما في ذلك الحزب الجمهوري- ستعود إلى طبيعتها عندما تنقشع السحابة الفيروسية في النهاية. ربما، لكن ذلك قد ينتهي إلى إحداث تغيير أقلّ مما يأمل به الكثيرون. استمعوا إلى وصف غوستاف فلوبير لتداعيات ثورة 1848 في باريس، التي شملت أيضاً نهب المباني المهمة رمزياً، في كتاب “التربية العاطفية” (1869):
“خوفا من تفشي وباء، شكّلت لجنة تحقيق (…) كان من لم يشاركوا في القتال الفعلي متلهّفين جدًّا لإظهار حرصهم. أصيب الناس بالذعر وقاموا بتصفية الحسابات القديمة بشكل أعمى مع كل من كان يثير غضبهم منذ مدة ثلاثة أشهر (…) واضطربت أذهان عامّة الناس، كما يحدث بعد وقوع كارثة. ونتيجة لذلك، ظل بعض الأذكياء حمقى بقية حياتهم”.
في الوقت الحالي -على الأقل- تُظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن معظم الجمهوريين تمكّنوا من استيعاب هجوم 6 يناير (كانون الثاني) على مبنى “الكابيتول”، بل واحتضانه. فقد ألقى نحو (58%) منهم باللوم على الديمقراطيين في الكونغرس، إلى جانب “حياة السود مهمة” وكوادر “أنتيفا”، في أعمال الشغب. ولم يوجّه اللوم إلى دونالد ترمب سوى (27%) فقط. كما أن ترمب هو أيضاً المرشّح المفضّل للحزب للرئاسة لعام 2024، بنسبة (54%).
يعني ذلك أن مثيري الشغب في “الكابيتول” هم في الواقع الحزب الجمهوري الآن، إذ إن العديد من الجمهوريين “العاديين” غادروا الحزب ليستبدل بهم وبأكثر منهم، شعبويون ممن عبّئوا أخيراً. (حدث شيء مماثل سنة 1896 عندما استولى الحزب الشعبوي الذي برز في ذلك الوقت على الحزب الديمقراطي). وهكذا فإن ما يقرب من (80%) من الجمهوريين يوافقون حالياً على ما قام به ترمب بوصفه رئيساً؛ ويزعم (65%) أن هناك “أدلّة قوية” على ادّعاء ترمب بأن الانتخابات سُرقت عللى الرغم من عدم ظهور مثل هذه الأدلة، لانعدام وجودها. قد يكون الحزب الجمهوري أو لا يكون حزباً من حمقى فلوبير، لكنه يبدو بالتأكيد في الوقت الحالي أنه حزب من الوُهاميين والعنصريين والمعادين على نحو متزايد للسامية.
إذن، إلى متى سيستمر “الوقت الحالي”؟ لا أحد يعلم. والنظر في الأحداث بعد وقوعها لا يقدّم رؤية صحيحة كما يقول المثل، وإلا سيكون من السهل التأريخ الأرشيفي -والحال ليست كذلك. لكن يبدو لي أنه بمجرد أن استوعب “الجمهوريون الدكسيقراطيين” في الجنوب باتباع استراتيجية غولدووتر- نيكسون الجنوبية بين سنتي 1964 و1972، فإن سلطوية الحزب الواحد العنصرية لتلك الثقافة السياسية الفرعية أصابت الحزب الجمهوري بأكمله بالعدوى في نهاية المطاف. وأصبح تحوّل الحزب من السلطوية العنصرية إلى معاداة السامية مسألة وقت. ويبدو أن الجميع يفعلون ذلك -بل إن الحزب الشيوعي الصيني، الذي يوصف بدقة على أنه عنصري وسلطوي، يتعقّب الآن يهود كايفنغ الموجودين منذ ألف عام ويضغط عليهم.
من المرجّح -إذن- أن يصبح الحزب الجمهوري أكثر جنوناً، وأن تزداد عنصريته ومعاداته للسامية صراحة عما هي عليه الآن، بوجود الجائحة أو عدمه. ومن الواضح أن ترمب والمجموعة الحالية من المسؤولين والمستشارين الجمهوريين تعلّموا من مثال نيكسون، واستخدموا معاداة السود والرسائل الخفية الكثيرة المعادية للاتينيين والمهاجرين للفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وحاولوا القيام بذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي باستغلال القلق من العنف الذي تلا مقتل جورج فلويد. لم تنجح المحاولة في المرة الأخيرة، ولكن ربما كانت ستنجح ثانية لولا سوء تعامل ترمب مع الجائحة.
إلى جانب السقوط في العنصرية والتعصّب المعادي للسامية، شهدنا أيضاً تحوّل الحزب الجمهوري إلى حزب سلطوي لا يتسامح مع أي معارضة داخلية. كما أنه لم يعد يتظاهر باحترام الفضائل التقليدية لليبرالية الكلاسيكية: التواضع، والكياسة، والتسامح، والنقاش المفتوح سعياً وراء الحقيقة، والاعتراف بمعارضة “موالية”، والإخلاص لحكم القانون.
السؤال الحقيقي -إذن- هو الآتي: هل سيهمّش الحزب الجمهوري نفسه وينزلق إلى عالم النسيان السياسي، أو أنه سيصل إلى السلطة بالفعل؟ إذا أراد الغاية الأخيرة، فلن يمكنه ذلك إلا بالقضاء النهائي على الديمقراطية الليبرالية الأمريكية بتسليم البلاد إلى الغوغاء الشعبويين. لا أحد يعرف الإجابة.
على أي حال، تبرز من كل ذلك بعض الأسئلة الجانبية المثيرة للاهتمام والمتعلّقة باليهود والمسلمين، في أمريكا والشرق الأوسط. ولنطرح القليل منها.
كيف يمكن أن يبرّر العديد من اليهود الأرثوذكسيين واليهود العلمانيين اليمينيين القوميين المتطرّفين، في الولايات المتحدة وإسرائيل، حماستهم الصريحة لدونالد ترمب في مواجهة معاداة السامية السائدة في الحزب الجمهوري؟
هل نعود إلى وضع يجد فيه الرافضون الأشدّ جنوناً وتطرّفاً ومعاداة للسامية في العالمين العربي والإسلامي في الحزب الجمهوري المعادي للسامية حليفهم الطبيعي، مثلما اجتُذب الحاج أمين الحسيني إلى أدولف هتلر والنازيين في ثلاثينيات القرن العشرين؟
أخيراً، كيف يمكن أن تفهم معاداة السامية التآمرية التي ما زالت مستوطنة في المجتمعات العربية والإسلامية الحزب الجمهوري الشعبوي المعادي للسامية في الولايات المتحدة؟ الجواب واضح للغاية: مثلما يفهمها المعادون للسامية في الولايات المتحدة. سيساوون بين الديمقراطيين واليهود (وبالطبع عبدة الشيطان) ويزعمون أن الحزب الديمقراطي مخلب قط المؤامرة اليهودية. وسيزعم أحد بمرور الوقت أن هيلاري كلينتون يهودية سرًّا، وكذلك هوما عابدين (وإلا لماذا تزوّجت من يهودي، ويفترض أنها مسلمة؟).
لكن ذلك ليس ضرورياً. ما عليك سوى إلقاء نظرة على أعضاء إدارة جو بايدن الجديدة. زوج نائبة الرئيس يهودي. المسؤولون الثلاثة الكبار في وزارة الخارجية يهود: أنتوني بلينكين، وويندي شيرمان، وفيتوريا نولاند. ووزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، يهودي. والمدّعي العام ميريك غارلاند يهودي. ووزيرة الخزانة جانيت يلين يهودية بطبيعة الحال. ولاستنفاد وزارات السلطة، فإن وزير الدفاع لويد أوستن أمريكي من أصل أفريقي، ولا يوجد دليل أو إشارة إلى أنه يهودي. لكنْ الأقليةُ الرجعية الفطريون من الأمريكيين الذين يكرهون السود تميل أيضاً إلى كره اليهود، لذلك قد يكون التمييز مصطنعاً. لكن ليس هناك الكثير مما يشجّع العرب أو المسلمين، لأن الرجعيين الفطريين يكرهونهم أيضاً -إنهم جميعاً إرهابيون، وفقاً للصورة النمطية، ولا يستثنى منهم أحد. ربما تكون إدارة بايدن الأسهل استدعاء لكراهية المتعصّبين في التاريخ الأمريكي. فماذا سيفعلون بالوقود المجاني الكثير؟
سيكون هناك ذات يوم أدب -روايات وشعر وأغانٍ وفن كاريكاتوري- يصوّر بعض الهوس الظاهر اليوم، والعنف، والفحشاء العنصرية، والذعر الأخلاقي، والكذب المسترخي، والبطولة والأمل أيضاً. وربما يعبّر عن بعض هذا الأدب بالعربية والعبرية إلى جانب الإنجليزية. ففي النهاية، كثير من الثقافات لديها مصلحة في النزاعات الدائرة حولنا هذه الأيام.
ستعرف الأجيال القادمة شيئاً ما عن هذه المشاعر من خلال هذا الأدب، لكن ما سيعرفونه يتوقّف على من يروي القصص، ومدى جودة الرواية وقدرتها على الإقناع، ومن سيصدّق بالتالي. من المؤكّد أن العمل البحثي لن يلتقط البتة كيف تؤلمنا هذه اللحظة وتصدمنا. وقد كتب المؤرّخ الأسترالي جفري بلَيني في منتصف التسعينيات: “ثمة مجموعة من الأحداث تضفي نكهة على عقد من الزمان”. لقد حصلنا على كل النكهة التي يمكننا التعامل معها في أقل من نصف عقد -وكان معظمها شنيعاً.
إننا نميل، أفراداً وجماعات على وجه الخصوص، إلى نسيان التفاصيل بمرور الوقت، ونفعل ذلك دائماً. لكن أقل ما يجب أن نحاول القيام به هو أن نتذكر جرْس الأوقات، لنحتفظ ببعض الأفكار عما ننساه. وهذا ما يستطيع أن يفعله الأدب، وسيفعله، لنا ولذريتنا.