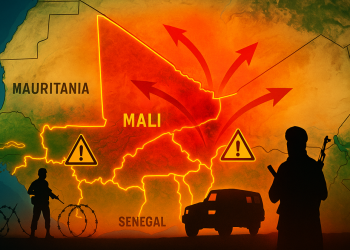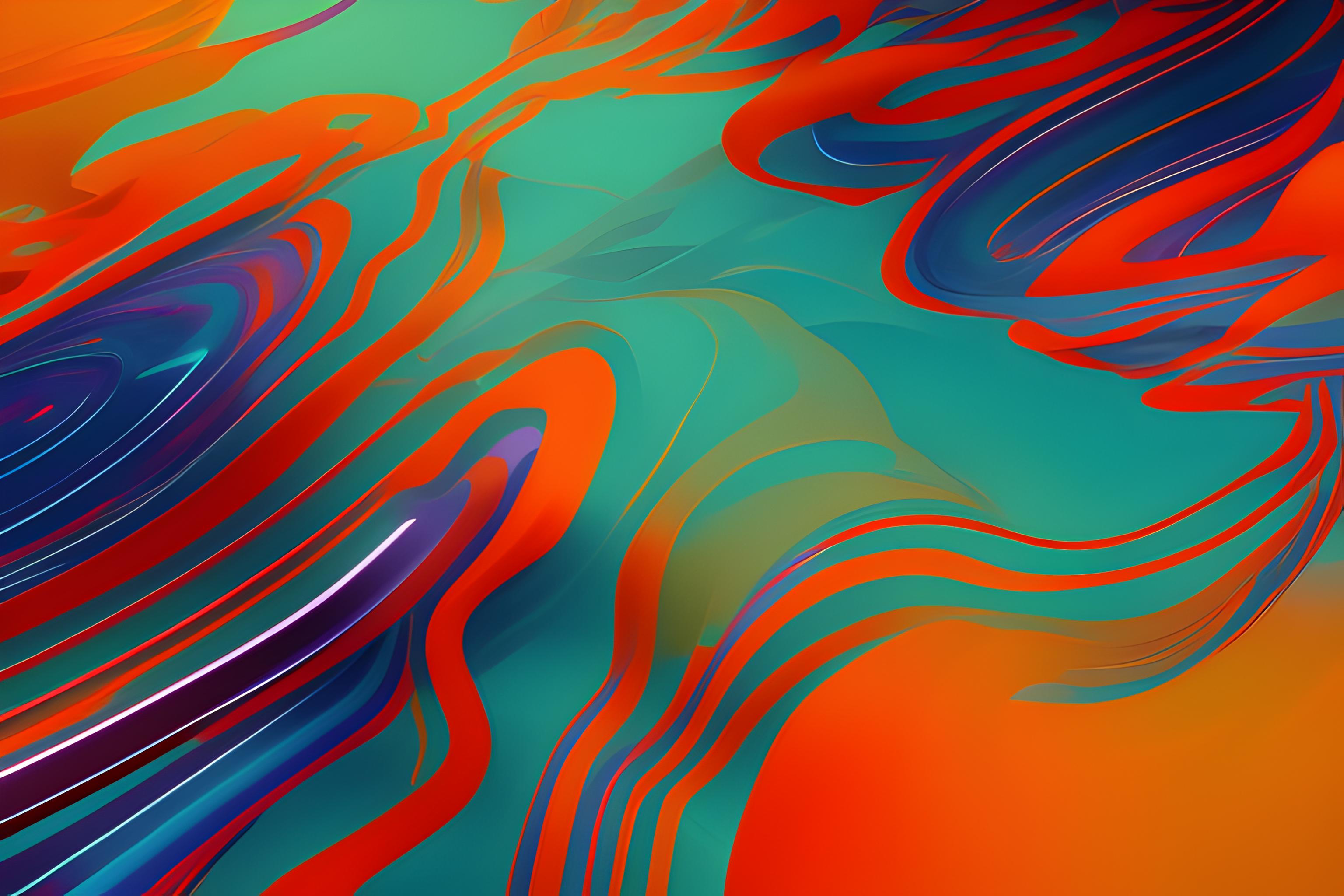يعتبر كتاب عبدالغني النابلسي العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية أقدم نصٍّ عربي معروف عن الطريقة المولوية، وإن كان النصّ دفاعيًّا في أغلبه، ولا يقدّم للقارئ معلومات تفيد في تأريخ التصوف المولوي، بقدر ما يفيدنا النصّ في التّعرف على انتشار المولوية خارج مدينة قونية، وإثارة طقوسها الكثير من الجدل، عند الصوفية والفقهاء كذلك لا يقدّم محقق النصّ الأكاديمي السوري بكري علاء الدين إضاءات كاشفة لحضور التصوف المولوي في حياة عبدالغني النابلسي، لأنه سبق وأن خصّ هذا الموضوع بدراسة عنوانها الطريقة المولوية في كتابات عبدالغني النابلسي 1143هـ 1730م شارك بها في المؤتمر الدولي حول جلال الدين الرومي الذي أُقيم في شهر مايو أيار في إسطنبول وقونية، وركّز في تقديمه للنص النابلسي عن المولوية على ما قدّمه النابلسي من شروحات متأخرة لفواتح النصّ المولوي الأكبر المثنوي المعنوي .
لكن كتاب النابلسي لقي عناية من غير واحدٍ من الباحثين، فبعد نشره على نفقة محمد شمس الدين أفندي شيخ التكية المولوية بدمشق، في مطبعة الترقي بدمشق عام 1911، تجددت طبعات هذا الكتاب حتى عام 1932، وأخيرًا حصل أحمد خيري على درجة الماجستير من جامعة النجاح الوطنية في نابلس بفلسطين عن تحقيقه ودراسته لهذا النص في قسم التاريخ.
وقد عُرف عن النابلسي محبته للمولوية طريقة وممارسة، ومما قاله عن التكية المولوية شعرًا:
المولويةُ جنةٌ في الحرِّ حيثُ الحرُّ نارُ
تزهو طرابلسُ بها ومن الزهور لها إزارُ
يا حُسن واديها الذي كأسُ النسيم به يدارُ
ومعاطِفُ الأغصان قد مالت وأثقلَها الثمارُ
هي جنةُ الفقراءِ أهـلِ اللهِ تمَّ لهم قرارُ
أوما تراها جارياتٌ تحتها الأنهارُ[3]
سنحاول في هذه الدراسة قراءة ما قدّمه النابلسي من خلال حديثه كصوفي نقشبندي عن الطريقة المولوية، ويحسن بنا في عجالة سريعة أن نعرّف بالنابلسي وببعض جهوده في الكتابة الصوفية.
النابلسي: حياته ورحلاته
هو عبدالغني بن إسماعيل النابلسي، المعروف بالنابلسي الأصل، الدمشقي الصالحي المولد والنشأة، النقشبندي القادري، له ما يزيد على (280) مؤلفًا، عُرف النابلسيُّ كصوفيٍّ، وفقيه، ومحدّث، ومؤرخ، ورحالة، وشاعر، ومفسّر، إذ كتب في الفنون الإسلامية كافة.
وُلد النابلسيُّ في دمشق في شهر ذي الحجّة عام 1050هـ/ 1641م، لعائلة عريقة في الفقه والدين معروفة بالعلم والقضاء، يعود نسبه إلى عمر بن الخطاب الخليفة الملقّب بالفاروق. وإذا كان النابلسي معروفًا في دمشق في سن مبكرة بالشعر والأدب، فقد عُرف بعد ذلك بانتسابه إلى الطريقة النقشبندية، والقادرية.
وكما كتب النابلسي «ديوان الحقائق الذي تشع منه أنوار الإلهام الروحي»، كتب «ديوان خمر بابل» الذي نرى فيه الغزل الحسي والمتعة والترف الدنيوي.
رحل النابلسي إلى دار الخلافة (إسطنبول) عام 1075هـ ـ
رحل إلى البقاع وجبل لبنان عام 1100هـ ثم إلى القدس والخليل.
رحل إلى مصر والحجاز عام 1105هـ.
عاد إلى دمشق عام 1119هـ.
تلقّى النابلسي العلم على أشياخ كُثرٍ في فروع العلوم الإسلامية كافة، عمل بالإقراء والتدريس والتصنيف، وترك كثيرًا من المصنفات لا يزال الكثير منها مخطوطًا، وأحصى له بعضهم (223) مؤلفًا[4].
النابلسي مدافعًا عن التصوف
منذ قرون خلت استخدم الشاعر الصوفي أبو الحسن الشُشتري (1212-1269) في إحدى قصائده ألفاظًا مسيحية، لم يكن هذا المسلك عاديًّا عند جمهور الفقهاء، أو الجماهير الغفيرة من العامة، فأخذ الناس في المزايدة عليه والتوهين من شأنه وتأليب الآخرين وتحريضهم عليه، حتى يخرج من أرض المسلمين الأتقياء! الششتري لم يكن شاعرًا يقرض الأشعار مدحًا لسلطان أو هجاءً لشخص، فقد ارتحل من الأندلس، وطاف أقطار المشرق، داعياً إلى طريقته الصوفية عن طريق نظم الموشحات والأزجال العامية التي انتشرت بين الناس، كانت خطته في الدعوة إلى ما يؤمن به واضحة المعالم، لا يتزحزح عن مبادئه مهما كانت العروض، نوليك علينا قاضيًا في طرابلس؟ يرفض الششتري! ويغنّي :
رَضِىَ المُتَيّمُ فِي الهَوى بِجُنونِهِ
خَلُّوهُ يَفْنَى عُمْره بفُنُونِهِ
لا تَعْذِلُوهُ فَلَيْسَ يَنْفَعْ عَذْلُكُمْ
ليس السلو عن الهوى من دينه
قَسَمًا بَمَنْ ذُكِرَ العَقِيقَ لأجْلِهِ
قَسَمَ المُحِبِ بِحُبِّهِ ويَمِينِهِ
مَالي سِواكُمُ غَيْرَ أني ثابِتٌ
عَن فَاتِراتِ الحُبِّ أو تَلوينِهِ
مالي إذا هَتَفَ الحَمامُ بأيْكةٍ
أبداً أحِنُّ لشَجْوِهِ وشِجُونِهِ
وإذا البُكَاءُ بِغَيْرِ دَمْعٍ دأبُهُ
فالصَبُّ يَحْوي دَمْعَهُ بِشؤونِهِ
يأتي إلى مصر، وفي طريقه إليها يُعرّج على الأديرة ويزورها، مثله مثل بقية المتصوفة والزهّاد الذين تزخر كتب الطبقات والتراجم بحكاياتهم ولقاءاتهم مع الرهبان.
كانت مصر في ذلك الوقت تستقبل جميع المتصوفة من فارس وبلخ والعراق والشام وغيرها من البلدان، وقد طاب المقام للششتري فيها كما طاب لغيره من القوم الصوفية، وقد فرح به خلقٌ كثير، وأصبحت أزجاله وأناشيده وموشحاته زادًا روحيًا للفقراء لا غنى عنه. لكن مصر كانت آنئذ مصابة بالتيار النصوصي الذي لا يؤمن إلاّ بقشرة الكلام ولا يتعب فكره قليلًا ليحسن القراءة أو التأويل، فكانت سيرة الشيخ الصوفي الأندلسي ابن سبعين مشوّهة عندهم، كانوا يعدّونه مارقًا وخارجًا على الدين، تخبرهم أن الشيخ ألّف في أنوار النبي ومن أنوار النبي تحقق الصوفي، لا يهمهم طالما أن ابن تيمية وقتها قد كتب السبعينية ردًا على ابن سبعين فابن تيمية على حق، ومن كانت حياته كلها حقًا أضحى زنديقًا عندهم، كبيرهم قال! فلا بد أن يُصدّق الكبير.
وشاء القدر أن يظل الششتري رحّالاً فيترك القاهرة لينتقل إلى دمياط وتحن الطينة إلى الطينة هناك، فيتوارى جسده الطاهر في تراب دمياط؛ ولا يُعرف مرقده النوراني حتى الآن على وجه اليقين على الرغم من تحديد المستشرق الفرنسي لويس ماسنيون (Louis Massignon) (1883-1962) له إلاّ أن العلاّمة المصري علي سامي النشّار (1917-1980) محقق ديوان الششتري لم يعوّل كثيرًا على إشارته لمحل المقام. وعلى الرغم من طغيان التيار النصي السلفي وانتشاره في مصر والدول العربية، فإن الششتري ظلّ موجودًا بتراثه الذاخر، فالنابلسي يدافع عنه في الشام، والشيخ زرّوق في بلاد المغرب يشرح أشعاره، وابن ليون التجيبي يلخّص مؤلفاته العلمية ويحفظها لنا، ويذكر الجبرتي في تأريخه أن العلاّمة محمد فارس التونسي من ذرية سيدي حسن الششتري الأندلسي وهو والد الشيخ محمد بن محمد فارس من أكابر الصوفية، كان يحفظ غالب ديوان جده أقام بدمياط مدة ثم رجع إلى مصر ومات بها سنة أربع عشرة و مئة وألف.
ما يزال الششتري يُذكر حتى لآن، ويتغنّى الكبار والصغار بأشعاره الإلهية والإنسانية والعشقية، صحيح أننا في مصر لم نعد نهتم به كما يهتم به أهل المغرب، إلاّ أن النشار[5] هو من تكفّل بأعباء نشر ديوان الششتري وأعاد إليه الحياة وكان أول من نشر عنه دراسة بالعربية في مجلة معهد الدراسات المصرية بمدريد، وعلى الرغم من صدور دراسات بالعربية حديثة عن الششتري، فإن شيئًا منها لم يكن بدقة النشّار باستثناء أعمال الباحثة المصرية أميمة أبو بكر، فقد كتبت عن الششتري دراسة بعنوان: «الدور الرمزي للمجاز في الشعر الصوفي في العصور الوسطى»[6]. كما كتبت عنه أيضًا دراستها: «العابد المعبود والروح المتألهة لدى الششتري وسان جون»[7]
ماذا قدّم النابلسي في دفاعه عن الصوفية؟
جمع الششتري في قصيدته الشهيرة التي تبدأ بقوله:
تَأدبْ بِبَاب الدَّيْر واخْلَعْ بِهِ النَّعْلاَ
وَسَلّمْ عَلَى الرُّهبَانِ واحْطُطْ بِهْمَ رَحْلا
وعَظّمْ بِهِ القسيسَ إِنْ شئتَ خُطوةً
وكَبِّر بِهِ الشَّمَاسَ إِنْ شِئتَ أَنْ تَعْلا
ودُونَكَ أصْوات الشَّمَامِيس فاسْتَمعْ
لأْلحَانِهمْ واحْذَرْك أنْ يَسلبُوا العَقْلا
فكيف دافع النابلسي عنه وماذا قدّم؟
يبدأ النابلسي رسالته باستهلال يبيّن فيه أنه كتبها بناء على طلب أحد السائلين له، من باب شرح ما استُغلق عليهم من فهم كلمات العارف الششتري، ويؤكد في هذا الاستهلال تلمذة الششتري لابن سبعين ويضع نفسه منافحًا عنه بهذا التأليف.
يستفيض في مقدمته من ذكر الآيات القرآنية التي تؤكد أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام بمعنى الاستسلام، وإسلام الوجه لله هو دين جميع الأنبياء، فيذكر إبراهيم ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، ويذكر أن إبراهيم أبا الأنبياء كان مسلمًا، وينفي عن سليمان الكفر.
يتم استدعاء الحديث، فالعلماء ورثة الأنبياء الماضين في العلوم والحقائق، وهم لا يرثون إلا الثابت، أما المغيّر والمبدل والمحرف من تراث السابقين، فمستبعدُ، ولعله هنا يشير إلى أن ما ثبته القرآن يثبّته أولياء الرحمان، وما غضّ الطرف عنه أو رآه بعيدًا عن الاعتماد تركوه انصياعًا لأوامر الشرع.
ومن العام إلى الخاص، يستند النابلسي إلى نص من نصوصِ ابن عربي الشيخ الأكبر، الذي خصص له النابلسي قسطًا وافرًا من مؤلفاته لشرح كلماته النورانية وتوضيحها لجمهور القراء في دمشق وما يجاورها -كما كان يفعل سيدي علي وفا في القاهرة- يقتبس النابلسي من كلام ابن عربي ما يؤكد وراثة الأولياء/ العلماء للأنبياء السابقين، مشيرًا إلى ختم النبوة بمحمد (صلى الله عليه وسلم) واستمرارية الوراثة لعلماء من بعده حتى يوم القيامة.
– الوارثون من الأولياء تحققوا بمشارب الأنبياء، وقاموا بمهمة التعليم والإرشاد والهداية، وكما ابتلى الله الأنبياء ورأوا من الأذى من أهل الحجاب والظلمات، وكذلك رأى الأولياء من الجاهلين بأحوالهم مثل ذلك، ويورد النابلسي من أشعاره ما يدين به أفعال هؤلاء العُصبة الظالمة لنفسها وللآخرين.
إذا كان كل وليٍّ على قدم نبي، ولكل مشربه الخاص الذي ينهل منه، فيوضح النابلسي أن المشارب تتعدد كتعدد الطرائق والخلائق ، فهناك من هو مشربه عيسوي، وهناك الموسوي والإدريسي وغيره، لكن كل واحد منهم مهما اختلف مشربه إلا أنه جامع إلى جوار مشربه رضاعة ثدي الإسلام الجامع لما سبق، والفاتح لما أُغلق، وهناك من يجمع جميع المشارب النبوية إلى جوار شربه من معين النبي الخاتم (صلى الله عليه وسلم)، وهذا الأنموذج في كل زمان لا يوجد إلا في شخص واحد يكون خاتمًا للولاية كختم النبي للنبوات.
يتحدث النابلسي عن لُغاتِ الرسل، وتحديداً لُغَة عيسى ولسان بني إسرائيل، ويتحدث عن التعريب الذي تلا نقل الإنجيل إلى العربية، ومن ثم حدث تعريبٌ لكثير من الألفاظ السريانية من مثل (الدير- الراهب- البطريق- الشماس- القس- الخمر- الكأس- الكنيسة). ويرى أن هذه الألفاظ ليست في الإنجيل على صورتها هذه، بل في صورة أخرى، تم تقريبها بهذه الكلمات بعد التعريب.
ويؤكد النابلسي أن لكل دين لغته الخاصة باعتبار طقوسه وممارساته، ولكل قوم لغتهم واصطلاحاتهم، فعند الصوفية تجد (عارفاً– سالكاً- مريداً)، وعند أهل الإسلام بشكل عام تؤدي كلمات (ساجد– راكع- صائم– حاج- معتمر– مُحرم) معنى يخصّ المسلمين وحدهم.
وإذ يتحدث النابلسي عن الحدود الفاصلة بين لغات أهل الأديان، فإنه يتحدث عن تأويل المصطلحات المسيحية من منطلق صوفي، فليست هذه المصطلحات إلا رموزٌ لمعانٍ صوفية إلهية اختص بها أهل القرب والنجباء، فالراهب والقسيس والشماس والبطرك لم تعد رُتبًا ووظائف، بل أمست تعبيرًا عن أحوال السالكين إلى رب العالمين.
فالشماس: سُمي شماسًا لشهود شمس الأزل.
والبطرك: لخدمته للكبراء من أهل ملته.
والراهب: لرهبته وخوفه حقيقة القيُّوم.
والقسيس: لتحققه بمعرفة الروح.
والكأس: صورة النفس.
والكنيسةُ: إذ كنسها السالك عن نجاسات الأغيار.
وإن دعت (طائفة) من النصارى القيام بهذه المصطلحات فهم كافرون بالله تعالى!
لمّا نُقِل الإنجيلُ إلى اللغةِ العربيةِ، عرّبُوا أسماء تلك المقامات السريانية الإنجيليةِ، فسمُّوها بالدّير والرّاهب والبطريق والشمّاس والقسيس والخمر والكأس والكنيسة، ولم يكن هذا اللفظ في الإنجيلِ، ولكنّه هناك بألفاظٍ غير هذه الألفاظ، وهي أسماء الأسرارِ الإلهية، وأحوال ربّانية عرفانية، إذا كان فيها العبدُ بتلك الأسماءِ، كما أنّ في شريعتنا يُسمّى العبدُ مُؤمنًا، ويُسمّى مُسلمًا، ويُسمّى عارفًا، ويُسمّى سالكًا ومُريدًا؛ لقيامِه بأحوالٍ باطنيّةٍ إلهيّةٍ، ويُسمّى مُطيعًا، ويُسمّى عابدًا، ويُسمّى راكعًا ساجدًا إذا أتى بأفعالٍ مخصوصةٍ، وأفعالٍ معروفةٍ. وإذا ترك الأكل والشّرب والجماع من طُلوعِ الفجرِ الثاني إلى الليلِ، ناويًا العبادة يُسمّى صائمًا، وإذا قصد مكّة مُحرِمًا يُسمّى حاجًّا ومُعتمرًا.
وهكذا في أمثال ذلك، فيُسمّى شمّاسًا لشهودِ شمس الأزل، ويُسمّى بطريقًا لخدمته كُبراء ملّتِه، ويُسمّى راهبًا لخوفه حقيقة القيّوم عليه، ويُسمّى قِسّيسًا لتحقُّقِه بمعرفة الرّوحِ الأعظم، ويُطلقُ الخمرُ على معاني التّجلّياتِ الإلهيةِ إذا تحقّق العبدُ بها، ويُطلقُ الكأسُ على الصُّورةِ النفسانية إذا تحقّقت بالتّجلّي الحقِّ لها منها، وتُسمّى الكنيسةُ إذا كنسها السالكون عن نجاساتِ الأغيارِ وطهّرتها عن لوث التّصرّف والاختيارِ بالقوّةِ والاقتدارِ.
وهكذا الأمر في هذه الاصطلاحات الإنجيليةِ والمقاماتِ الإلهية والعباراتِ السّريانيةِ، ولما عُرّبت بهذه الألفاظِ وادّعت طائفة النصارى القيام بها، والظُّهور بحقائقها وهم كافرون بالله تعالى وبجميع الأنبياءِ، وإن زعموا أنهم مؤمنون ببعض الأنبياء، كعيسى (عليه السلام) على دعواهم، فإن محمّدًا (صلّى الله عليه وسلم) نسخ جميع تلك الأديان، وما نسخُه لها إلا من حيث الأعمال الشرعية، كما ذكرنا[8].
يرى النابلسي أن الحق سبحانه وتعالى، غيرة منه، قد جعل بعض الأولياء يستخدمون اصطلاحات الإنجيل الحقّ! وكما ينزل عيسى آخر الزّمان ينزل الإنجيل في زمان ختم النبوات على قلوب الأولياء بالإلهام، وتتحول الوراثة التي نصّ عليها القرآن (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) إلى نزول جديد وحفظ واستظهار.
يضرب النابلسي مثالاً على ذلك بالوليّ الصوفي (بايزيد البسطامي) الذي نزل القرآن على قلبه وما مات إلاّ مستظهرًا لآي القرآن جميعها، ويستند إلى الشيخ الأكبر ابن عربي لتعضيد قوله الذي يرى أن نزول القرآن مستمرٌ على أمة محمد، فهو وحيٌ دائم مستمر!
ينتقل النابلسي للحديث عن الششتري الوارث العيسوي، ثم يقدّم بين يدي النصِّ حديثًا عن التحريف، مؤكدًا أنه «لا مُبدّل لكلماته» تعالى، والتبديل والتحريف إن وقع فمن نفوس عامة النّاس، أما الأولياء فهم خارجون على أحكام النّفوس، ربّانيون يحافظون على الكلمة والكتاب، على عكس النّصارى (الذين كفروا) فحرفوا الكلِم عن مواضعه، ولما جاءهم النبي محمدٌ وهم يعرفونه كفروا به! على الرغم من أنه جاء بحقائق الإنجيل والمسلمون أولى بعيسى بن مريم من النّصارى، لأنّهم كافرون بما كان عليه من الحقِّ، وأنّهم جهِلوا وعاندوا والمسلمون مؤمنون به، وبما جاء به من الحقِّ، وسينزل في آخر الزّمان يُقاتِلهم على مِلّتنا هذه، ويُلزِمُهم بها ويُكذّبهم عيسى (عليه السّلامُ) فيما افتروا عليه، ويقتُلهم أو يُسلِمون، ويقتلُ الخنزير ويُبطلُ الجزية، كما ورد في الأخبار الصحيحة.
يشرع النابلسي بعد ذلك في بيان معنى من معاني القصيدة، ويشير إلى أن ما يذكره من معانٍ ما هو إلا طرف يسير من حقائق كلام الششتري وإشاراته التي لا تُحصى.
كانت هذه صورة من صور الدفاع التي وفّق النابلسي في صوغها بصورة معرفية تبتعد عن التكفير والتفسيق، فهل كان يسير على النهج نفسه عندما كتب «العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية»؟
المولوية في تراث عبدالغني النابلسي
في المسرد النقدي بأسماء مؤلفات الشيخ عبدالغني النابلسي[9] ذكر بكري علاء الدين كتابًا للنابلسي، بعنوان: «فتح الكريم الوهاب في العلوم المستفادة من الناي والشباب»، وهو كتابٌ أورده النابلسي النقشبندي في قوائم مؤلفاته[10]، يذكّرنا عنوانه بكتاب ألفه الشيخ النقشبندي عبدالرحمن الجامي 817-898هـ/ 1414-1495م قبل قرنين من عصر النابلسي، بعنوان: الناي. متأثّرًا بما تعارف عليه عند الدارسين لأدبيات الرومي بـ(أغنية الناي) حسب نهج المعارضات الشعرية، معارضًا أغنية الرومي، وكأنه أراد أن يضيف جديدًا إلى ما بثه الرومي من أفكار في أبياته الشعرية[11]، فجعل الجامي نايه ناي توحيد، وأخذ على عاتقه شرح عقيدة وحدة الوجود على لسان الناي، ثم تطرّق إلى الحديث عن الكثرة النسبية، التي هي حقائق المخلوقات، وتحدّث عن الإنسان ومنزلته وكيف سقط في النهاية بعيدًا عن نوعه؟!
لا يمكننا في ظلّ عدم الحصول على مخطوط كتاب النابلسي أن نعرف ماهية الموضوعات التي عالجها النابلسي وناقشها في كتابه، إلاّ أن فارقًا كبيرًا بين كتابات الجامي عن المولوية وكتابات النابلسي، على الرغم من كونهما شارحين لنصوص مولوية، يتجلى ذلك في اختلاف لغة الكتابة فالجامي يدوّن مؤلفاته بالفارسية، وفي المطالعة يظل الجامي أوسع اطلاعًا على المصادر من النابلسي، ولا تغلب على كتاباته النزعة الفقهية كما هو الشأن في نصوص النابلسي.
الكتاب الثاني الذي ألّفه النابلسي مساهمةً منه في مناقشة وشرح الأدبيات المولوية هو كتاب «الصراط السويّ شرح ديباجات المثنوي». ألّف النابلسي هذه الرسالة ليشرح من خلالها ثلاث ديباجات من المثنوي، قدّم بها جلال الدين الرومي الأجزاءَ الأوّل والثالث والرابع، وهذه الديباجات كُتبت في أصل المثنوي الفارسي باللغة العربية، كما كُتبت فصول عدّة في كتاب الرومي «فيه ما فيه» بالعربية، وشرح النابلسي الديباجات الثلاث عام 1088هـ/ 1677م، ويصف بكري علاء الدين هذا الشرح بالتقليدي، فليس هناك ما يشير إلى تعمّق النابلسي في دراسة المثنوي.
ويمكننا القول بعد مطالعة هذا الشرح: إن النابلسي لم يطالع المثنوي، فلم ترد عبارات في الشرح تشير إلى خبرته بالمثنوي وأفكاره كما هو الشأن عند الجامي، كذلك فإن نصًّا من النصوص التي ترد على لسان النابلسي في معرض حديثه عن زيارته لقونية، تظهر مدى اعتزاز الرجل بنفسه، ورؤيته لنفسه أكبر من أن تحدّه طريقة معينة أو يأسره شيخ صوفيٌّ مهما علا قدره –على الرغم من انتسابه إلى الطريقة النقشبندية- يقول النابلسي: وصلنا قونية، وقصدنا زيارة مولانا جلال الدين الرومي، صاحب الطريقة المولوية، وقلنا في نفسنا: إن قَبِل زيارتنا وجدنا ضريحه مفتوحًا، فلما وصلنا إلى باب ضريحه وجدناه مقفلاً. فحين وصولنا سقطت الأقفال وانفتح الباب. فدخلنا، ووقفنا نقرأ الفاتحة. فوجدنا روحانية مولانا جلال الدين في صورة طائر أبيض كبير واقفٌ على الضريح، فحين رآنا تصاغر شيئًا فشيئًا وما زال على ذلك حتى صار كأصغر ما يكون من العصافير، ففتحنا له فمنا فدخل فيه وابتلعناه.
إن هضم النابلسي لروحانية مولانا جلال الدين لا نرى تمثّلها في شرحه لديباجات المثنوي، ولعله في شرحه كان متأثّرًا بما سبقه من شروحات لديباجات المثنوي كشرح الشيخ الأنقروي المعروف بـ(سماط الموقنين)[12].
يمكننا تلخيص موضوعات كتاب النابلسي «العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية» على النحو التالي: انقسم نص كتاب النابلسي إلى مقدمة وعشرة فصول، ودارت جمعيها حول طقوس الطريقة المولوية، وركّز المؤلف على قضية السماع (الغناء والرقص والموسيقى) باعتبارها جوهر النص، كما ذكر بعض الطقوس المصاحبة للسماع عند أصحاب الطريقة ورتبها بالتتابع كما يلي: الصلاة في المساجد، وتلاوة القرآن الكريم التي يُبدأ بها السماع ويُختم بها، ورواية الحديث النبوي الشريف، والوعظ والنصيحة لأتباع الطريقة، وقراءة كتاب المثنوي لمولانا جلال الدين الرومي شيخ الطريقة المولوية، ويليه الغناء والرقص والتواجد، والدوران أو الفتل المولوي، ويليها آداب الأتباع مع مشايخهم وطاعتهم، ثم الدعاء للمشايخ والأتباع ولعامة المسلمين، ويليه مدح الأنبياء والأولياء والصالحين والذكر في المساجد، ويليه حسن الظن والتماس الأعذار لأتباع الطريقة ولعامة المسلمين. وقد قام النابلسي بالدفاع عن أتباع الطريقة في ممارسة جميع طقوسهم السابقة، باعتبارها لا تخالف الشريعة وهي من صلبها، واستدل على ذلك بالآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة والأقوال الصوفية والفقهية، وبصورة خاصة فقه الأحناف[13]. وعلى الرغم من تخصيص النابلسي كتابه للحديث عن المولوية، فإن المدقق في نصه يجد حديث الفقه يعلو على التصوف، فلا نعرف عن الطريقة أو الطقس الممارس إلا النزر اليسير.
يصرّح النابلسي بدفاعه عن المولوية في بداية رسالته، ويصرّح بسلفه الصوفي الذي يقتدي به، فهو سائر على هدي السابقين، ويذكّرنا بدفاع الإمام الشعراني عن أحد أبناء الأولياء في مصر، مخاطبًا السلطة في وقته أن تفرج عنه.[14]. وأوّل استشهادات النابلسي على صحّة السماع هو سلوك الزهريّ راوي الحديث النبوي الشريف، الذي لم تمنعه روايته للحديث من الانشغال بالموسيقى[15]. ويلي ذلك ابن حنبل، الذي سُئل عن سماع الصوفية فأجاب: دعهم يفرحون بربهم. ويركز النابلسي على المرويات التي تشير إلى إباحة الإمام أحمد بن حنبل للسماع، فينقل عن مصادر شافعية وحنبلية وكتابات صوفية ما يؤكد استماع ابن حنبل للغناء[16]. وكما يستند إلى أقوال ابن حنبل يسرد لنا من كلام ابن حنيفة وابن قتيبة وغيرهما ما يؤكد وجهة نظره في إباحة السماع، مختصرًا ما أورده في كتابه إيضاح الدلالات.
ويذكر النابلسي أن كتابه العقود اللؤلؤية هو إعادة كتابة لمصنَّف سابق حوى من الحجج ما يعتبرُ به الجاهلُ، ويتنعّم ويفرح به المؤمن والمحبّ للطريقة، ولا نعرف كيف طُمست الرسالة وأخفيت أنوارها –على حد تعبير النابلسي- مما حدا به لإعادة كتابتها تحت هذا العنوان[17] .
ثم يقدّم النابلسيُّ وصفًّا لما يحدث في مجالس الطريقة المولوية في دمشق، ويخبرنا بأن كل مجلس من مجالس أهل الإسلام لا بدّ فيه من وجود الداء والدواء، ثم يحذّر المخالف من التعرّض للفقراء لأن من يفعل ذلك تكون عاقبته وخيمة، كما خذل الله من تعرّض للمولوية في دمشق.
ثم تبدأ فصول الكتاب، وهي عشرة فصول، في شرح أحوال الطريقة المولوية في دمشق[18]، وما خفي منها على الفقهاء في عصره، ويحاول النابلسي في هذه الفصول أيضًا أن يبدد سوء الفهم الخاص ببعض المعتقدات الصوفية والممارسات التي كانت سببًا في إطلاق أحكام فاسدة. في الفصل الأول نعرف من خلال المعلومات التي يوردها النابلسي أن مجلس المولوية يبدأ بالصلاة المفروضة وتأديتها في جماعة، والجماعة في مجلس المولوية كالجماعة في المسجد، فإطلاق حكم عام على الجماعة أمر خاطئ، بل يخرج صاحبه من الملّة! ويستطرد النابلسي في تثبيت فكرة أن أي مسجد لا يخلو من المنكرات والأداءات التي لا تخلو من الأغلاط، حتى لا يمكن معها الجزم على أن المصلي قد أدى حقّ صلاته وعبادته فيها، مستندًا إلى أقوال صوفية كبار، كأبي الحسن الشاذلي وأبي مدين. ويضرب النابلسي أمثلة على البدع في المساجد، بتكرار الجماعات في وقت واحد، وغيرها من الأمثلة مستدعيًا حديثًا شهيرًا في الجدل بين المذاهب والأديان يعود إلى أصول إنجيلية: «يُبْصِرُ أحَدُكُمُ الْقَذَاةَ في عَيْنِ أخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنهِ». مشيرًا إلى أن مخالفات كثيرة تحدث في المساجد ولا ينشغل المنكر والمخاصم للمولوية بها ولا ينكر على أصحابها.
المخالفون بالنسبة للنابلسي منشغلون بعلوم الدنيا ومحبّون لها، وهذه العلوم تحجبهم عن فهم وإدراك العلوم الصوفية الثمينة، لا يذكر النابلسي المخالفين إلاّ بالمثالب، وهم في نظره بالاستهانة بالعلوم الصوفية من الكافرين الضالين المضلّين! ويستند للتوهين من شأن مخالفه إلى حكايات الصوفية المقتبسة من كلام أبي طالب المكّيّ في قوت القلوب، وابن عربي في الفتوحات المكية. ويعتبر النابلسي أن ما ينقله المخالفون عن الفقهاء لا يدركون مقاصده ولا يفهمونه جيدًا؛ لأنهم أصحاب هوى وغرض نفساني، لذا فإن أحكامهم لا يعوّل عليها.
في الفصل الثاني يحدّثنا النابلسي عن مجلس السماع ويصف لنا بدايته بتلاوة القرآن وقراءة ما تيسّر من الأحاديث، وهو أمرٌ يقرّه العلماء الفحول، ففيم الإنكار إذن؟! ويستشهد بعلماء الصوفية مجددا، سواء في ذلك أن يقتبس من أقوالهم ما يدعم حجته، أو يروي عنهم قصة تعتمد على المنامات والأحلام والرؤى. يعقب ذلك مدح المصطفى بما يُعرف في الطريقة المولوية بـ(نعت شريف). وهذا مصطلح بالتركية والفارسية، يُغنّى بلحنٍ شجيٍّ في بدء الرقص الصوفي لدراويش المولوية، من يستمع إليه سيشعر بمبلغ الحبّ العميق الذي احتفظ به مولانا جلال الدين الرومي للنبي (صلى الله عليه وسلم)، الذي خاطبه قائلاً:
يا حبيب الله يا رسول الله، يا من أنت فذٌّ، أنت خيرة ذي الجلال، فأنت صافٍ جدًا يا رسول الله، أنت تعلم عجز أمتك، أنت دليل الضعفاء، الذين لا رأس لديهم ولا قدم.
وفي ختام النعت الشريف يستحضر الرومي روح شمس تبريزي، الذي يعرف نعت النبي عن ظهر قلب، لأنه الشخص الذي اختاره هذا السيد العظيم واصطفاه[19]. فقد اعتبر الرومي أن شمس تبريزي هو المفسر الحقيقي لأسرار النبي؛ لأنه كان متّحدًا بالحقيقة المحمدية:
قل هو المؤنس لأحمد المرسل إلى العالم
إنه شمس تبريز الذي هو إحدى الكُبر
لأنه عندما تقرأ (والضحى) انظر إلى الشمس
وانظر إلى منجم الذهب عندما تقرأ (لم يكن).
وشمسُ يتنفس مع المصطفى أسرار العشق، لأن الجوهر الحقيقي للنبي هو العشق، ذلك العشق الذي من أجله خاطب الحقُّ محمدًا بقوله: (لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك)[20].
في الفصل الثالث يدافع النابلسي عن السماع المولوي مستندًا إلى نصوص ابن عربي، لم يتحدث ابن عربي عن السماع أو المولوية، بل تحدّث عن سبب شرحه لترجمان الأشواق[21] وأن جماعة من الناس أنكرت عليه إيراده لأشعار الغزل والتشبيب، مما اضطره إلى أن يشرح ما ورد في ديوانه بنفسه، ويقرأه القاضي ابن العديم ليسمع المنكر عليه، ويتوب عن إنكاره. كذا الأمر في السماع المولوي، لو تدبّر المخالف، واعتبره غذاء الآذان لجنّب الفقراء الكثير من العناء، واقتدى بالتابعين والسلف الصالح.
[1] باحث مصري في الإسلاميات والتصوف.
[2] راجع: عبدالغني، النابلسي العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية، تحقيق وتقديم: بكري علاء الدين، دار نينوى، دمشق، 2009.
[3] راجع: عبدالغني، النابلسي «التحفة النابلسية في الرحلة الطرابلسية»، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، بيروت، 1971، ص76. قارن بـــ: عمر، عبدالسلام تدمري: تكية الدراويش المولوية بطرابلس في أقدم وثيقة عنها وما كتبه الرحالة العرب والأجانب في وصفها، مجلة تاريخ العرب والعالم، لبنان، مج 12، ع 140.
[4] مصادر ترجمته: الورد القدسي والوارد الأنسي في ترجمة العارف عبدالغني النابلسي- كمال الدين الغزي. -سلك الدرر – المرادي. -جامع كرامات الأولياء- النبهاني. -الأعلام- خير الدين الزركلي. -معجم المؤلفين- عمر رضا كحالة.
ومن المراجع الحديثة: يراجع أحمد مطلوب، وسامر عكاش، وبكري علاء الدين، وقد أحصى الأخير في مسرد نقدي مؤلفات النابلسي، ونشر هذا الإحصاء في عددين مستقلين في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، وقد حقق نسبة الكتاب للنابلسي وغيره من الكتب.
[5] للتعرف على جهود علي سامي النشار في الدرس الصوفي الحديث راجع: خالد، محمد عبده، «معنى أن تكون صوفيًّا»، الطبعة الثانية، مركز المحروسة، مصر، 2018، ص136-139.
[6] مجلة ألف: مجلة الشعر المقارن، 12 (1992)، ص 40-57.
[7] أعمال المؤتمر الدولي الثاني في الأدب، القاهرة: جامعة القاهرة، 1993، ص40-57.
[8] راجع: عبدالغني، النابلسي، «ردّ المفتري عن الطعن في الششتري»، طواسين، بيروت 2016، ص45 وما بعدها.
[9] راجع: بكري، علاء الدين، المسرد النقدي بأسماء مؤلفات الشيخ عبدالغني النابلسي، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، 1982، مج 59، ج2، ص354 وما بعدها.
[10] يقول عبدالغني النابلسي في كتابه إيضاح الدلالات، مرجع سابق، ص108: وقد صنّفتُ رسالة بطلب بعض الإخوان مني ذلك، وسمّيتها: تُحفة أولي الألباب في العلوم المستفادة من الناي والشباب، وذكرتُ فيها بعض ما كنتُ أفهمه من الآلات المطربة من علوم الله تعالى، ومعارفه التوحيدية، مع أني من أنقص أهل الله تعالى حالاً وأقصرهم باعًا والخير في الأمة إلى يوم القيامة.
[11] تُرجمت رسالة الناي لعبدالرحمن الجامي إلى اللغة العربية، ونُشرت في مجلة رسالة المشرق، بعناية نفيسة محمد سعيد، مج 16، عدد 3، 4، عام 2005، ص337–371.
[12] حُقق هذا الشرح للشيخ إسماعيل الأنقروي، بعناية خالد محمد عبده، وبلال كوشبنار، وصدر ضمن منشورات طواسين، بيروت 2017.
[13] راجع: عبدالغني النابلسي، العقود اللؤلؤية في طريق السادة المولوية، أطروحة جامعية أجيزت في جامعة النجاح الوطنية بنابلس عام 2002، ص72-75.
[14] المرجع نفسه، ص4.
[15] يذكر عبدالغني النابلسي في كتابه إيضاح الدلالات في سماع الآلات أن الزهري كان لا يسمع طلبته الحديث حتى يسمعهم الغناء! وسُئل عن الغناء فأفتى بتحليله، راجع: نشرة مجلة المورد، مج 52، ص98. انظر: العقود اللؤلؤية، ص 5.
[16] العقود اللؤلؤية، ص 6.
[17] المرجع السابق، ص 8.
[18] خصص وائل منير الرشدان دراسة لحضور المولوية في دمشق، ونشرها بعنوان: التكيتان العثمانيتان المولوية والأحمدية في مدينة دمشق، مجلة دراسات تاريخية، سوريا ، مج 27، ع 101،102 عام 2008، ص139-172.
[19] راجع: أنّا، ماري شيمل، وأنّ محمدًا رسول الله، ترجمة: عيسى علي العاكوب، دار الهدى، إيران، ص296.
[20] السابق نفسه، ص293، 294.
[21] قارن: ابن عربي، ذخائر الأعلاق، نشرة دار صادر، بيروت 1998، ص9-10.