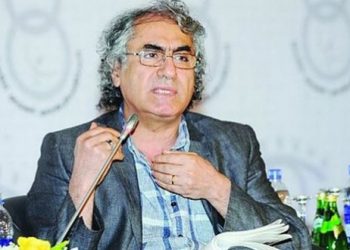في سبتمبر 1994 أوقفت السعودية عشرات من الإسلامويين الذين رأت فيهم مثيرين للفتنة، وفي ديسمبر من هذا العام كان وزير الداخلية الأسبق المرحوم الأمير نايف بن عبدالعزيز يتهيأ للخروج من جامع الجوهرة في مدينة جدة، بعد أن أدى صلاة الجمعة، وحين اقترب من الباب يحف به أربعة من مرافقيه، ناداه شاب في الثانية والعشرين من عمره: «يانايف، اتق الله، وافرج عن العلماء»، التفت إليه الأمير، مقطباً وجهه، ثم مضى في سبيله، وحين اقترب اثنان من مرافقيه إلى الشاب وطلبا منه أن يصحبهما، تمنع قليلاً ثم رافقاه إلى قصر الأمير. كان الأمير وحده في مجلس كبير. أجلسوا الشاب قبالته وقال: «أسمعني ما عندك الآن، قل كل ما في نفسك»، ولكن سالم- وهذا اسمه- كان في حالة من الرهبة وقال له:«قلت كل ما عندي»، وضع الأمير كف سالم بين كفيه وقال: «كنتَ جريئاً في المسجد أمام الناس!».
تابع الأمير:«إنما أنا جندي لهذا الوطن، لم آمر بسجنهم، بل الملك مدعوماً بفتوى من كبار العلماء، ولو أن جلالته أمرني بإطلاق سراحهم اللحظة هذه لما وسعني إلا الامتثال لأمره». لم ينبس سالم ببنت شفة. آنسه الأمير وسأله إن كان يحتاج شيئاً، فأجاب: «شكراً، اسمح لي أن أمضي، ما لم يكن قد تقرر سجني». قال له: لمَ أسجنك؟! ودعاه إلى الغداء معه فاعتذر، سأله إن كان عنده حاجة ليقضيها، فشكره وألح على الانصراف، فأذن له. يقول سالم: صحبني الأمير لتوديعي، وحين وصلنا باب الفيلا، كان أبي قد وصل، فصديقي الذي كان بجواري في المسجد كان قد انطلق ليصيح في الحي ويبلغ والدي. وحين رآني أبي ألقى التحية على الأمير وتجاهلني، التفت الأمير إليَّ، وقال «بأمان الله، بيني وبين والدك كلام»، جلس أبي مع الأمير قرابة عشرين دقيقة، وحسب ما ذكره لي سالم في منتصف 1997 فقد انقضت سنتان ولم يبح له والده بأي شيء مما دار بينه وبين الأمير، «لم يعاتبني ولم يفتح معي نقاشاً حول ما حصل».
بعد أقل من سنة قام الشاب بإرسال رسالة إلى مفتي المملكة يومها المرحوم الشيخ عبدالعزيز بن باز، يلومه ويحمله مسؤولية ما يراه هذا الشاب «انحرافاً عن الشريعة، وتضييقاً على الصالحين». تجوهلت هذه الرسالة. بعد تفجيرات نوفمبر 1995، سقط سالم في يد الأمن، بعد أن ورد اسمه مراراً في اعترافات أكثر من موقوف، تشير إلى علاقة وطيدة له بتكفيريين ذوي ميول جهادية. لا أحد يمكنه أن يكون أكثر حظاً، رافلاً بالاحترام مثل هذا الشاب، فقد كان ينعم باحترام ومحبة والده الذي يحظى بمكانة اجتماعية بين أبناء قبيلته، فلم يعرف الحرمان، ولا القسوة، حتى من رجل الأمن الأول حينها، ولكن كل ذلك لم يحل بينه، وبين أن يكرر بعدها خطأه مرتين في جريمتين استهدفتا استقرار وطنه. هناك دوافع كثيرة وغامضة ودفينة في نفوس البشر تكمن وراء غرقهم في مثل هذه الجرائم. واحد من الأسباب التي أزعم أنها الأقرب في حالتنا هذه هو تأثير المجتمع الصغير، والتعويض عن مجد غابر تلاشى مع قيام الدولة، حين يكون الطفل والمراهق عرضة لتأثير الأب أو الإخوة والعشيرة العالقين بتاريخ مضلل من الغارات والثارات القبلية النافرة من النظام والسلطة، المعجونة بجرعات مخيفة من إغواء التمرد باسم الجهاد ليسبغ على دعاوى الجاهلية إهاب الدين، حينها يكون كل ما يعبر عن التطاول على الدولة شجاعة ويكون المجرم «ذيباً» ملهماً للآخرين، وتكون شخصية الأب الرزين، مستبطنة لأحلام سياسية لن تعود.