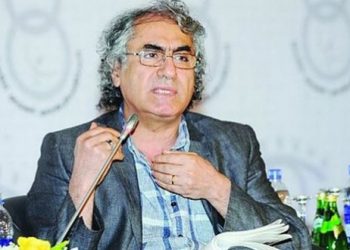في شهر مايو (أيار)، كتبت هنا، على موقع المسبار، عن الأخبار الطيّبة الواردة من شمال أفريقيا. كان وقت الاضطراب الكبير المتزامن في الجزائر والسودان وليبيا. من المسلّم به أن غرضي التحليلي لم يكن ينطبق على ليبيا، كان غرضي الرئيس القول: إن طاقات المجتمع المدني حيّة ومعافاة في كل من الجزائر والسودان، على الرغم من الظروف الخطيرة والمتقلّبة.
هذا وحده لا يمكن أن يضمن -ولم يضمن في هذه الحالات حتى الآن- نتائج إيجابية بطبيعة الحال. ولم يضمنها قط، لأن مشاركة المجتمع المدني شرط ضروري ولكنه ليس كافياً لحدوث تقدّم تحوّلي في الترتيبات السياسية. لكن المجتمعات التي تفتقر إلى نبض مدني نادراً ما تحقّق الإصلاح، هذا إذا تحقّق، بطرق إيجابية ومستدامة، إلا عندما تُجبر على الردّ على صدمات خارجية كبرى. ومن الأمثلة التاريخية على ذلك أن غزو نابليون لمصر سنة 1799 هزّ أركان قفص المماليك. لا الغزو، ولا محمد علي ولا إبراهيم باشا، وقرّاء المسبار يعرفون بقية الحكاية.
لا شك في أن الأمور في الجزائر والسودان تبدو الآن أفضل مما كانت عليه قبل ستة أشهر. وقد حقّقت الحركة السودانية تقدّماً حقيقيًّا، وهناك اتفاق على ترتيب دستوري جديد. لكن ما يُفتقر إليه هو الثقة بأن الحكومة ستفي بوعودها. أما الحركة الجزائرية فقد حقّقت نتائج أقلّ بروزاً، لكن الاحتجاجات بلغت الآن أسبوعها التاسع والثلاثين، ما يظهر مثابرة جدّية مدهشة. والآن ثمة مزيد من الأخبار الطيّبة من ناحية أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ربما ألهمتها الأحداث في الجزائر والخرطوم جزئياً على الأقل.
في أعقاب احتجاجات غير متوقّعة (تمّ سحقها) على الفساد والقمع في أواخر سبتمبر (أيلول) في ثماني مدن مصرية، اندلعت مظاهرات جديدة ومستمرّة في لبنان والعراق. الأحداث المصرية واللبنانية والعراقية تتشاطر بعض الخصائص المشتركة مع ما حدث في الجزائر والسودان قبل ستة أشهر، ولكلّ الحالات الخمس جوانب مشتركة مع مجموعة ما سمّي ثورات الربيع العربي التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2010. وهناك أيضاً العديد من الاختلافات الواضحة بين تلك الحالات. يوجد المزيد عن أوجه التشابه والاختلاف أدناه.
لكن النتيجة التي نخرج بها هنا من الرجوع إلى الوراء والتمعّن هي أن تغيّر الأجيال، وأثره السياسي الذي يضخّمه انتشار التكنولوجيا في مرحلة ما بعد الحداثة، يعيد خلط الدورات الدائمة والمواجهات بين الدعوة والمخابرات في كل أنحاء المنطقة. وثمة أمل متزايد في ألا يعاد، في بعض الحالات، خلط الدورة نفسها فحسب، وإنما انتهاؤها أخيراً لصالح أنظمة سياسية أكثر استقراراً وتشاركية، وبالتالي أكثر شرعية، من نوع النظام الجديد الذي يكافح للظهور، حيث بدأ كل شيء منذ ما يقرب من تسع سنوات، في تونس.
إن من يتمنّون الخير لشعوب المنطقة إنما يفعلون ذلك لصالحهم على الأقل. الأحمق فقط يسرّ لمعاناة الآخرين. ولكن ثمة دافع آخر وأكثر براغماتية، وهو أن التقدّم نحو التكامل الإقليمي الوظيفي الانتقائي الذي يعود بالفائدة على كلّ الأطراف الرئيسة المحلية، لا يمكن أن يتحقّق -على الأرجح- إلا إذا كانت الأجزاء المكوّنة في المنطقة -أي دوائر اتخاذ القرار العليا في العواصم الوطنية– قادرة على إخراج بلدانها من الطريق الذي تسلكه وتنظيم الحوكمة لديها. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يتحقّق الترابط المفيد في المنطقة ما لم تصبح أولاً الأجزاء المكوّنة أكثر ترابطاً.
المنطقة بحاجة في الواقع إلى جرعة قوية من التكامل الوظيفي الانتقائي لسببين مترابطين:
السبب الأول يتعلق بتحوّل كبير في نظام الأمن الدولي العالمي الناجم عن تراجع الحكومة الأميركية عن الاستراتيجية الدولية التي وجّهتها منذ الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك، يميل العالم نحو نظام جديد غير محدّد حتى الآن لتوازن القوى/ مجالات النفوذ. وستكون المجموعة الجديدة من العداوة والمنافسة الجيوسياسية شبيهة في بعض النواحي بما كانت عليه في القرن التاسع عشر، وستختلف في نواحٍ أخرى. لكن أمراً واحداً سيبقى على حاله: ستواجه القوى الصغيرة –بما في ذلك تلك التي تخضع لحكم جيد– مصاعب في ظل وضع غير مواتِ على العموم. فستجلس القوى الكبرى، كما كان حالها من قبل مع ترتيبات مناطق النفوذ، إلى مائدة الطعام وستكون القوى الصغيرة بمثابة مقبّلات. وتعدّ كل الدول في النظام الفرعي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوى صغيرة إلى حدٍّ ما، بل إن الكبيرة منها نسبياً، مثل مصر، هي بحاجة إلى دعم بعضها بعضاً لكي لا تكون لقمة سائغة للضواري المحتملة، سواء كانت تلك الضواري بعيدة أو قريبة.
دعونا نكن أكثر تحديداً: لو أن العراق لم يغزُ الكويت في أغسطس (آب) 1990 ولكن في أغسطس (آب) 2019، وهو وقت اتضح فيه أن الحكومة الأميركية لن تمارس مسؤولياتها تجاه المشاعات العالمية في مضيق هرمز، لما توقّع أحد حدوث أي شيء شبيه بعملية عاصفة الصحراء. ولربما أصبحت الكويت بالفعل المحافظة التاسعة عشرة في العراق، ولما كان أحد مستعدًّا لفعل أي شيء حيال ذلك يتجاوز ما فعله ما يسمّى المجتمع الدولي بشأن الضمّ السريع لشبه جزيرة القرم إلى روسيا. أي أقرب ما يكون إلى عدم فعل أي شيء[1].
السبب الثاني ذو الصلة اقتصادي. فلا توجد منطقة متجاورة ثقافيًّا في العالم تقلّ فيها التجارة عبر الحدود عما هي عليه في منطقة الشرق الأوسط. وكان التفسير النموذجي لهذا الواقع أن اقتصادات الدول العربية لا تكمل بعضها بعضاً لأنها جميعاً تنتج وتستهلك الأشياء نفسها إلى حدٍّ كبير، ولا يوجد تباين بينها لكي تفعل الأفضلية النسبية فعلها الرائع.
ثمة شيء صحيح في هذا التفسير، لكن التفسير الأرجح لندرة التجارة، وعواقبها المحبطة على النمو وخلق الثروة، يكمن في الترتيبات الريعية التي يشجّعها العديد من أنظمة حكم القلة الفعلية في المنطقة. أيًّا يكن الأمر، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلّ كثيراً عن مجموع أجزائها من الناحية الاقتصادية. ونادراً ما تساعد الدول الغنية الدول الفقيرة لتحقيق التطوّر، إلا بين الحين والآخر وبقيود سياسية، على الرغم من أن من مصلحتها الذاتية المستنيرة القيام بذلك.
لماذا؟
لأن الركود الاقتصادي العام وعدم المساواة الصارخة بين دول المنطقة يعزّزان قوة الأيديولوجيات المتزمّتة والتعديلية، وفي الحالات القصوى، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار اجتماعي تامّ وحرب، كما رأينا في السنوات الأخيرة في سوريا واليمن وأماكن أخرى. وتلك الحروب لا تؤثّر على العرب الفقراء فحسب، وإنما على الأغنياء عبر الحدود أيضاً.
يؤدي ضعف الأداء الاقتصادي إلى نقص التمويل في التعليم والبحث والتطوير والاستثمار في قطاعي البناء والصناعة اللذين يستحدثان الوظائف ويدفعان تطوير رأس المال البشري إلى أعلى سلسلة القيمة المضافة في الوقت نفسه.
إن سبب العزلة الأمنية الذاتية المنشأ والتخلّف الاقتصادي لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسيط بقدر ما هو عميق: إنه الانسداد الذي يفرضه تفكير المجموع الصفري [أن ما يربحه طرف يعني خسارة الآخر] على العقل العربي (والعقول الأخرى بطبيعة الحال، لكنها لا تدخل في نطاق اهتمامنا هنا).
ذلك انسداد لا توجد أسسه العميقة في الثقافة، أي الثقافة الدينية في ما يخصّ هذه المنطقة. بل على العكس من ذلك: الدافع المركزي للإسلام هو التكامل منذ البداية، والتغلّب على العداوات المحلية الصغيرة لبناء أمة كبيرة تقوم على وحدة المعتقد. ولو أن محمداً استخدم اختصاصيًّا في العلاقات العامة في أواخر القرن السادس، لتوصّل إلى شيء مشابه جدًّا للدعوة إلى الوحدة.
لا، فأصول عقلية المجموع الصفري توجد في البنية الاجتماعية، لا الثقافية. وتكمن جذورها في الهياكل القبلية والعشائرية للمنطقة التي تعود إلى غابر الزمان، ومن هذه الجذور أساساً انبثقت الثقافات السياسية في البلدان العربية. ومرة أخرى، لا يرجع سبب ذلك إلى الإسلام بل رغماً عنه، وعلى الرغم أيضاً من التلاعب بالسياسية الواقعية المحلية الذي خضعت له نسخة علمانية من الأمة باسم القومية العربية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
الحالة اللبنانية
لذلك تثير الاضطرابات الأخيرة في لبنان والعراق اهتماماً شديداً، وربما تكون طلائع مهمة للغاية لمستقبل أفضل لهذين البلدين والمنطقة بأسرها. وعلى الرغم من اختلاف السياقات وتبعيات المسار التاريخي: فإن للمظاهرات في لبنان والعراق ثلاث خصائص مشتركة:
أولاً: أنها مناهضة للطائفية ومؤيدة للاندماج من الناحية الوطنية. وتجدر الإشارة إلى أن التطلّع في هاتين الحالتين إلى القومية الحديثة ليس ارتدادياً. فالقومية تقدّمية مقارنة بالإقطاعية الوراثية شبه الاتحادية في لبنان. بل هي أكثر تقدّمية مقارنة بالقبلية السابقة لفبر (Weber) في العراق. ولو لم تفرز أي من هاتين القوميتين ما يعتبره الغربيون قيمًا ليبرالية، فإنهما تشكّلان مع ذلك تقدّماً نسبياً. ومن المؤسف أن هذه الأشياء نسبية حقاً لا شاملة. لكن رفض الحركتين الاحتجاجيتين لسياسة الهوية الضيقة بداية جيدة باتجاه مشروع ليبرالي، لأنه يتعارض مباشرة مع النبض الشعبوي الأهلي في العديد من الدول الغربية في الوقت الحاضر.
ثانياً: تحدّد حركتا الاحتجاج جهة فاعلة خارجية، النظام الإيراني، بوصفها مصدراً لشكواهما. وفي كلتا الحالتين، يحدث الشباب الشيعة تحديداً، تأثيراً مهمًّا ردًّا على القوى الشيعية الرجعية الخاضعة للتأثيرات الخارجية، والحكومة نفسها في بغداد (وثّقها جيداً مستطلع الآراء العراقية منقذ داغر) وحزب الله في لبنان. ويوضح ذلك، كما أكّدت في سبتمبر (أيلول) 2014، أن “… الدم العربي أكثف من الماء الشيعي”. “[https://www.the-american-interest.com/2014/09/11/do-we-have-a-strategy-now/]. هناك أجسام مضادّة طبيعية للتأثير الإيراني في العالم العربي، ونحن نرى فعلها الآن.
ثالثاً: أن كليهما أكثر تطوّراً في المنهجية من أسلافهما قبل تسع سنوات. ويعبّر هذا التطوّر الكبير عن نفسه بعدة طرق، لكن جوهره رفض توهّم تحقيق نتائج لفورية وعقلية المجموع الصفري. دعونا الآن نلقِ نظرة قريبة وعميقة على الحالتين.
القول بأنك مواطن لبناني فوق كونك سنيًّا أو شيعيًّا أو مارونيًّا يعني أن التعاون يمكن أن يحقّق أكثر من مجموع الأجزاء. إنه تحوّل نحن ضدّ هم وهم إلى نحن معاً مع هم وهم. إنها فكرة ثورية في السياق اللبناني، وهذه الفكرة هي ما تثير الاحتجاجات الحالية. لكن تحويل هذه الفكرة إلى واقع ثوري أمر آخر.
لبنان بلد غريب مقارنة بالدول الحديثة، وقد صمّم كذلك منذ البداية. فقد تُعُمّد إنشاؤه مفتقراً إلى سمات رئيسة تميل الدول الحديثة إلى امتلاكها: جيش وطني وقوة شرطة تمتد سلطتهما على كل أراضيها الوطنية، ووزارة مالية تجمع الضرائب، وجهاز بيروقراطي يقدم الخدمات على المستوى الوطني، وأحزاب سياسية تتنافس لتمثيل السكان في السلطة التشريعية على أساس رغبات برنامج محدّد من حيث المصلحة الوطنية. جُمع لبنان بمثابة نظام إقطاعي طائفي اتحادي، تكمن فيه السلطة الحقيقية على مستوى المجتمعات المحلية الفرعية، وتتسم فيه المؤسسات الوطنية بالضعف -في الغالب- وتخضع للمؤسسات المحلية على العموم.
هذا الترتيب، الذي انبثق منطقيًّا عن الحقائق الثابتة لنظام الملل العثماني، أظهر نجاحاً جيداً بين سنتي 1946 و1957-58، عندما واجه أزمة ملازمة لتصميمه، أي سهولة عبور الاتجاهات القادمة من خارج الحدود إلى الدولة. فالأزمتان اللتان أدتا إلى شبه انهيار سوريا واستيعابها مؤقّتاً في مصر تحت مسمّى الجمهورية العربية المتحدة التي لم تدم طويلاً، وإلى الثورة العراقية في يوليو (تموز) 1958، كادتا تغرقان لبنان في موجة من الحماسة القومية العربية، السنّية أساساً. وكانت مشكلته تتصل بعدم التناظر: امتدت إحدى مجموعاته الطائفية الرئيسة الثلاث عبر حدوده، لكن من دون المجموعتين الأخريين.
نجا لبنان بشقّ النفس من اضطرابات المشرق سنة 1957-1958، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى الحملة العسكرية العلنية الوحيدة في رئاسة أيزنهاور. لكنه استسلم للتحدّي التالي: إخلال منظمة التحرير الفلسطينية بالتركيبة اللبنانية سنة 1975. وأدّت الحرب الأهلية التي تلت، والتدّخل السوري والاعتداءات الإسرائيلية السياسية والعسكرية اللاحقة في الشؤون اللبنانية، إلى تدمير التوازن الدقيق للنظام الطائفي. كما أن ظهور الثورة الإيرانية بعد سنة 1979 وصعود السكان الشيعة في لبنان منذ ذلك الحين، أفسد التصميم الأصلي وأخلّ بوظيفته بعنف؛ فلم يعد يمكن التعرّف إليه. أصبح لبنان عالقاً، فلا يمكنه العودة إلى نظام لا يمكنه العيش على المدى البعيد على أي حال، ولا يمكنه المضي إلى الأمام لأن البلد يعاني من عدم وجود أي أغلبية طبيعية، ومن ضراوة جهة فاعلة خارجية تعمل عن طريق قوة طائفية محلية تابعة، أي حزب الله.
تخيّل بعض الأشخاص نظاماً لبنانيًّا جديداً قائماً على وطنية حديثة حقيقية تخضع الجماعات الطائفية والهياكل العشائرية التي تدعمها بشكل أساسي. كان فؤاد مخزومي رائداً في هذا الجهد. وهو رجل يتمتع بالثروة والنزاهة، وأول لبناني يؤسس حزباً سياسيًّا مفتوحاً للبنانيين من كل الطوائف الدينية بناء على هوية وأجندة وطنية واضحة. عندما التقيت به في واشنطن قبل عدة سنوات، لم تكن فكرته عما أصبح حزب الحوار الوطني قد تحوّلت إلى مؤسسة بعد. لكن حجته للمضي قدماً في ما بدا كأنه مسعى غير واقعي كانت مقنعة. وقد قال لي: “لا بدّ أن تفشل كل طريقة أخرى للخروج من الفوضى. وعندما يثبت أن كل الخيارات الأخرى غير مجدية، ستكون فكرتي هي الخيار الوحيد المتبقي”.
لا يوجد دليل على أن لمخزومي، الذي يقضي معظم وقته في لندن لأسباب تجارية وأمنية شخصية على الرغم من انتخابه عضواً في البرلمان اللبناني سنة 2018، أي علاقة مباشرة بالمظاهرات الأخيرة -ولا أي جهة ثرية أخرى. ووفقاً لروايات عدة شهود عيان، فإن أي تنظيم يميّز الاحتجاجات اللبنانية إنما هو من النوع الشعبي العفوي. وتشارك فيه كل المنظمات الطلابية والمجالس المحلية والنقابات العمالية وروابط الأحياء، لكن لا يوجد أحد مسؤول، ويبدو أن الملتزمين بالحركة مصممون على إبقائها على هذا النحو.
لكن مخزومي ساعد في غرس البذور الوطنية المحفّزة قبل سنوات عديدة وهو محقّ في الأساس: إذا أريد للبنان مستقل حقًّا البقاء، فإنه بحاجة في النهاية إلى إقامة هيكل حوكمة يتجاوز تشوّهات ولادته. لكنه لا يمكنه أن يفعل ذلك ما لم يحدث شيئان متزامنان إلى حدٍّ ما: اجتماع الشعب اللبناني للمطالبة باتفاق سياسي جديد يتجاوز الطائفية، وحصول هذا الشعب على بعض المساعدة في رفع يد رجال الدين الإيرانيين خناق البلد.
إذا كنت تراهن على أي نتيجة معيّنة، فإن رهانك يتوقّف على تقييمك لأرجحية اجتماع هذين المطلبين معاً. ويؤسفني القول: إن الرهان فكرة سيّئة. فمن الصعب جدًّا التغلّب على مسار التبعية المستحكم في لبنان، لا سيما إذا تعمّدت حركة الاحتجاج حرمان نفسها من قيادة قادرة على طرح “أفكار كبيرة” بنّاءة. ففي النهاية، الأنظمة الدستورية الجديدة لا تسقط من السماء.
الحالة العراقية
الحالة العراقية مختلفة ومتشابهة في آن معاً. مشابهة قبل كل شيء، لأنها ترفض عقلية المجموع الصفري. وليست سنّة ضدّ الشيعة وعرباً ضدّ أكراد، بل عراقيون بعضهم مع بعض. وقد أشار إلى هذه النقطة بوضوح سنة 2015 كوميدي عراقي يسمّي نفسه البشير. في أثناء بث برنامج “البشير شو” على التلفزيون العراقي، سخر البشير من العراقيين المشغولين برسم خرائط مواجهة مع خطوط ومناطق مرسومة من حولهم بعرض خريطة خضراء للعراق تحمل اسم “100% عراقية”. هتف الجمهور موافقاً. ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصبح فيها النكتة السياسية الموجة المتقدّمة لحقيقة جديدة.
توجد تلك الخريطة الآن في الشارع، في قلوب وأفواه الشبّان العراقيين الذين سئموا من رجال الدين الإيرانيين الذين يتلاعبون بحكومتهم، بل سئموا أكثر من الميليشيات المسلحة الإيرانية التي تنهب البلد مثل عصابات المجرمين.
الحدود العراقية رسمها صانعو الخرائط الاستعماريون الأوروبيون في أعقاب الحرب العالمية الأولى، مثلما فعلوا في لبنان والعديد من الدول العربية الأخرى. وفي هذه الحالة، أقحم البريطانيون ثلاث محافظات منفصلة من الإمبراطورية العثمانية إلى كيان جديد، ومنحوه اسماً جديداً، واستوردوا أميراً هاشميًّا من الحجاز ليحكمه، مدعوماً بإعانة ذهبية بريطانية وقوة أمنية بريطانية التدريب. ولعل الأهم من ذلك، أن القومية الإقليمية كانت مفهوماً غريباً في العالم العربي، والعراق ليس استثناء. وسار الولاء والانتماءات، ومن ثم السلطة الاجتماعية والسياسية، بتحديدات دون مستوى الدولة -الحمائل أو القبائل- وتحديدات فوق مستوى الدولة –انتماءات القومية العربية والإسلامية. ترك ذلك مجالاً صغيراً بينهما لمستوى الدولة نفسها -الوطنية.
عندما أطاح الجيش بالنظام الملكي في يوليو (تموز) 1958، وعدت أبواق القومية العربية بجمهورية عراقية مستقلّة بقدر استقلال محافظة عراقية في دولة عربية قومية كبرى. ولكن ذلك لم يتحقّق. وفي مواجهة ندرة الهوية الوطنية في المجتمع، سعت الحكومات العسكرية المتعاقبة لبناء شعور بالوحدة الوطنية. وأوضحت حقبة البعث بعد سنة 1968 هذه المعضلة. فوجد العراق نفسه عالقاً بين أيديولوجية قومية عربية لم تحقّق أي نجاح في الواقع، في حين أن صعود الإسلام السياسي دفع صدام حسين في النهاية إلى نشر الرموز الدينية لملء الفراغ الكبير في خزّان العصبية في البلاد.
لم ينجح شيء، كما أظهر انحدار العراق إلى استبداد إجرامي والخاصية الانقسامية للتمرّد المدني التي أطلقتها الإطاحة بالبعث بقيادة الولايات المتحدة في مارس (آذار) 2003. ولم يكن هناك كثير من الأشخاص الذين كانت هويّتهم المفضّلة في ذلك الوقت أنهم “عراقيون”، باستثناء طبقة رقيقة من أبناء المدن المتعلّمين.
يروى أن جنوداً أميركيين منعوا في إحدى الحوادث مجموعة من السارقين الصغار من استخراج الأنابيب النحاسية من المباني الحكومية المهجورة في بغداد، ووبّخوا السارقين بإبلاغهم بأن ذلك المعدن ملك للشعب العراقي. فردّ السارقون بصدق على الجنود بسؤال: “من هم هؤلاء العراقيون”؟ وكانوا يعبّرون بطبيعة الحال عن تفكير المجموع الصفري، لأنهم أوضحوا للجنود: “إذا لم نأخذ نحن النحاس، فسيقوم بذلك أشخاص آخرون، فلماذا لا نقوم نحن بذلك إذا وصلنا إلى هنا أولاً “؟
بعد مضي ستة عشر عاماً، لزم قيام النظام الإيراني بالاغتصاب المنهجي للمؤسسات العراقية الضعيفة في أعقاب النظام البعثي، بالإضافة إلى انسحاب إدارة أوباما من البلاد قبل الأوان، لتنشيط الاحتجاجات الحالية التي تحمل في ذروتها الرمزية الفكرة بأنه يجب أن يكون هناك شعب عراقي. وخلافاً لما حدث في لبنان، حيث قُتل متظاهر واحد حتى الآن، فإن الدم أريق بغزارة في شوارع العراق، أكثر من (325) قتيلاً حتى كتابة هذه السطور، و(15,000) جريح –أصابت الشرطة العديد منهم– في نحو ستة أسابيع. وذكرت صحيفة “ديلي صباح” (إسطنبول) في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) أن أحد المتظاهرين أحضر أسداً ملفوفاً بالعلم العراقي إلى الاحتجاج، كما لو أنه يقول: “لدينا أسود”.
وهكذا لا تُظهر الاحتجاجات أي علامة على التراجع، خاصة وأن علي السيستاني قدّم الدعم للاحتجاج. وقد اتخذ الوضع في بغداد بعض خصائص الحرب في المدن، إذ يناور الجانبان لحماية قطاعات حضرية محدّدة والتقدّم نحوها. ويعتصم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في المنطقة الخضراء رافضاً الضغوط التي تدعوه إلى التنحي، لكن وقته بدأ ينفد. وليس هناك شك في سمة الاحتجاجات الصريحة المناهضة لإيران، إذ هاجم المتظاهرون القنصلية الإيرانية في كربلاء، أو في كل الأماكن.
ولكن في ظلّ غياب عدوّ واضح، ما الذي يمكن أن يحافظ على لحمة حركة الاحتجاج العراقية إذا حقّقت نجاحاً كبيراً، كإسقاط عبدالمهدي؟ هل يمكن أن تتسع بالقدر الكافي للانتقال من المعارضة إلى البناء؟
لا أحد يعلم، لكن انظر إلى ما حدث في الجزائر والسودان بعد ستة أشهر من الحراك. حقّق هذان الانفجاران في الطاقات المدنية هدفهما الأولي بسرعة، إذ تخلّصا من قادة انتهى تاريخ صلاحيتهم منذ زمن طويل. لكن عزل حكم القلة الحاكمة المسلحة أصعب بكثير من عزل رجل واحد. اللبنانيون والعراقيون اليوم، مثلهم مثل الجزائريين والسودانيين والمصريين والتونسيين والسوريين وغيرهم من قبل –ولا تستثنى، بالمناسبة، حركات الاحتجاج في هونغ كونغ وتشيلي والإكوادور وفنزويلا وبابوا وفرنسا، والآن إيران فجأة لارتفاع أسعار الوقود- يواجهون تحدياً مشتركاً لكل حركات الاحتجاج في الشوارع المناهضة للحكّام، أي إن الإفصاح عما تعارضه الحركة أسهل بكثير من صياغة ما ترمي إليه.
قلبي مع الرجال والنساء الشجعان في لبنان والعراق اليوم الذين يخاطرون بحياتهم لمحاربة الاضطهاد والترهيب وخيانة الأمانة المستحكمة والمكابرة. لكن عقلي يقول: إن تبعيات المسار التاريخي في هذين البلدين تقف بقوّة ضدّ تحقيق نجاح سريع أو أي نجاح على الإطلاق.
تشتدّ حركات الاحتجاج بسبب الغضب المحقّ، لكنها لا تنجح إلا عندما تتغلّب مستويات وأشكال من الثقة الاجتماعية الجديدة على شكوك الماضي واستياءاته. ومن المفيد أن العاطفة تزيد من حدّة الغضب المحقّ، إذ لو هدأ الناس ومنحوا الوقت الكافي لتقييم ظروفهم تقييماً موضوعيًّا، لعاد معظمهم أدراجه على الأرجح وتوجّه إلى المنزل.
من ناحية أخرى، الغضب المفرط في ظل محدودية سيطرة القيادة يجعل حركات الاحتجاج تأتي بنتائج عكسية. وذلك ما حدث خلال المرحلة الأكثر تطرّفاً للحركة المناهضة لحرب فيتنام في الولايات المتحدة بين سنتي 1966 و1970. فقد أحدثت بذاءة العناصر الأكثر تطرّفاً في حركة مناهضة الحرب وعنفهم وسلوكهم غير الوطني “أثر الأتباع السلبي” الموثّق جيداً، ما زاد في الواقع الدعم الشعبي لإدارة جونسون أولاً ثم إدارة نيكسون. وكانت النتيجة إطالة أمد الحرب وسقوط مزيد من القتلى من الجانبين. ولو أن الحركة حقّقت ما ادّعاه معظم المحتجّين بأثر رجعي –من أن حركة الاحتجاج حوّلت الرأي العام الأميركي إلى معارضة الحرب- لكان المرشّح المناهض للحرب حقّق انتصاراً ساحقاً في انتخابات سنة 1972. لكن جورج ماكغفرن فاز بولاية واحدة بالضبط ومقاطعة كولومبيا، ما يخبركم بكل ما تحتاجون إلى معرفته عن الوعي الذاتي لمعظم المثاليين المتطرّفين.
يتوقّف إحداث أثر الأتباع السلبي الذي يعود بنتائج معاكسة على نسبة فريدة لكل مجتمع: توازن الإحباط مع مستوى تسامح مختلف المجتمعات مع الاضطراب. في هونغ كونغ، ظلت الاحتجاجات تحظى بشعبية لدى الأغلبية حتى بدأ المتظاهرون في تحطيم المدينة وإشعال الحرائق ومحاولة قتل شرطي بين الحين والآخر. وبعد أن حقّقوا هدفهم المبدئي بتعليق قانون تسليم المجرمين وإلغائه، أدّى افتقار الحركة إلى قيادة إلى المطالبة بما لا تستطيع أي حكومة محلية منحه والمحافظة على بقائها، ودفع ذلك بدوره المحتجين إلى تصعيد تكتيكاتهم. والنتيجة هي أن أثر الأتباع السلبي أخذ يتشكل في مجتمع قليل التسامح نسبياً مع الاضطراب، ما يعود بالنفع على بكين التي تتحلّى بالصبر.
دروس للاحتجاجات البيروتية والبغدادية
إن دفع الاقتصاد اللبناني -ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم- إلى شفير الهاوية بمثابة منتج ثانوي غير مقصود للاحتجاج قد يتحقّق عما قريب أيضاً. لذا يجب أن يكون للاحتجاجات قيادة كافية على الأقل لمعرفة متى تجيب “نعم”. وعليهم اجتناب “مرض الروح” الذي حذّر منه والتر ليبمان ذات يوم، ويعرّف بأنه “الوقوع في حبّ الأمور المستحيلة”. ويجب ألا يتخلصوا من انسداد المجموع الصفري ليقعوا في مصيدة الطوباوية.
نجحت هذه الاحتجاجات إلى حدٍّ ما، أيًّا تكن نتيجتها المادية. فقد شكّكت في عقلية المجموع الصفري بطريقة لا مثيل لها البتة في لبنان والعراق. كما وجّهت ضربة قوية للنموذج الطوائفي للسياسة الوطنية، وهي فكرة لو أصابت بالعدوى الطبقة الوسطى الإيرانية التي طالت معاناتها، لأدخلت تحوّلاً على المنطقة بطريقة لا يفكر فيها سوى قلة من المحتجين في بيروت وبغداد في الوقت الحالي.
وأدت هذه الاحتجاجات، التي تلت الاحتجاجات في الجزائر والسودان، إلى تقدّم الثورة إلى حيث تحظى بأكبر قدر من الأهمية، أي إلى قلوب الناس وعقولهم. لذا من المحتّم أن تنجح في نهاية المطاف. لكن ما يبعث على الحزن أن ذلك يمكن أن يستغرق طويلاً!
……………………………………………………………………….
آدم غارفنكل، كاتب عمود منتظم في “المسبار”، وزميل زائر متميّز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة.
[1] – هذا افتراض عام، ولكنّ القوى العربية الجديدة لها مواقف قويّة يجب أخذها في الحسبان، حتى مع التخلي الأميركي. (المحرر)