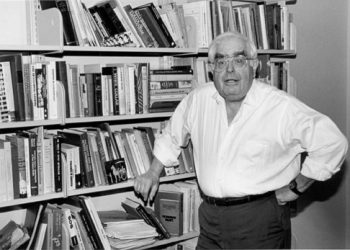-1-
يواجه الفكر السياسي الإسلامي المعاصر سياقًا مغايرًا لسياقات التشكل السلفي، التي لم تعرف الدولة بعيدًا عن الدين، فلم تعاين المشاكل التي تنجم عن ازدواجية السلطة. ولم تقف على الثيوقراطية أصلًا كمفهوم سلبي بحيث تدرك مشاكل الدمج بين السلطتين.
سلفيًا، تشكل الفكر السياسي بصيغته المذهبية كرد فعل للواقع. أعني ترجمة لحالة الافتراق السياسي المبكرة التي جرى تثبيتها دينيًا بفعل الفقه والكلام؛ عبرت نظرية الخلافة عن سطوة الدولة “السنية” الغالبة، وعكست نظرية الإمامة أشواق السلطة لدى المعارضة “الشيعية” المغلوبة، فيما عبرت النظرية “الإباضية” عن مزاج الفرقة الأكثر اعتدالًا، والتي أمكن لها البقاء من فرق الخوارج. لكن أيًا من هذه النظريات الثلاث لم يكن نظرية في الدولة، ولا في الحكومة، بل في الحاكم، الذي اختزل مضمون الدولة والحكومة معًا في الذهن السياسي السلفي.
الفقه -الذي أحرز هيمنة واضحة على مجمل الثقافة- لم يقف على مفهوم “المجتمع المدني”، وقدم تقنينًا نصيًا لواقعة “التغلب” كآلية لإسناد السلطة ولفكرة الشريعة كشق من الدين الذي تقع مهمة حراسته على الحاكم. وقام الأدب السلطاني، أو فكر النصيحة -الذي يستغرق معظم المادة المكتوبة في السياسة في الإسلام الوسيط- بترويج السلطة المطلقة للحاكم بوصفه ظل الله في الأرض، وتأكيد فكرة التفويض الإلهي للسلطة. أما الكتابات الكلامية والفلسفية -المتأثرة نسبيًا بالفكر اليوناني- فلم تقدم اختراقًا حقيقيًا للطرح الأوتوقراطي الثيوقراطي الذي قننه الفقه وكرسته الأدبيات السلطانية.
-2-
في المقابل، يشتغل الفكر الإسلامي المعاصر في واقع اجتماعي معقد، يعاني من حالة بؤس سياسي واقتصادي مزمنة. فيما يعاني هو من حالة تضارب داخلي بين مكوناته التراثية ومثيراته الحداثية. قيم الحداثة السياسية لم تتحول إلى مكونات بنيوية، لكن حضورها المتفاقم يشكل ضغوطًا كافية لتعميق وعيه بالمشكل. الأمر الذي يعني تحميله بأعباء “تغييرية” مزدوجة، حيال الواقع وحيال تكوينه النظري ذاته.
تطرح الحداثة السياسية على هذا الفكر حزمة من الأسئلة الشائكة عن تكوين الدولة، والمجتمع المدني، وطبيعة السلطة، وشكل الحكومة، وفي هذا السياق يبرز سؤال “الأوتوقراطية” كمعضلة قائمة يصعب حلها من داخل النظرية التراثية بشقيها (الخلافة والإمامة)، أي من داخل فكرة الحل والعقد السنية، أو فكرة العصمة الشيعية.
لكن السؤال الأكثر إشكالية هو سؤال “الثيوقراطية” أو الدولة الدينية من حيث المبدأ، بما هي معضلة نظرية، يصعب حلها بغير صدام، لا مع النظرية التراثية التي كتبها الفقه فحسب، بل مع الأصول الأكثر جذرية في نسق التدين التاريخي. وهي الأصول التي ترجع إلى فكرتي الحصرية والتأبيد، والتي تضع “الدين” عند لحظة بعينها، في تناقض مع اثنين من قوانين الاجتماع الطبيعي: قانون التعدد (الذي يفرضه تنوع الكثرة)، وقانون التطور (حركة التغير الضروري في الزمن). وهنا -في الواقع- يكمن مشكل الفكر السياسي الإسلامي، بما هو في نهاية المطاف فكر ديني، يصدر عن نسق التدين التاريخي الموروث.
على المستوى الشيعي تربط هذه الأًصول بين الدين والدولة بشكل عضوي مؤبد، لا يكتفي بإدخال الدين إلى أهداف الدولة، بل يدخل الدولة في أركان الدين. تحولت الدولة ممثلة في الإمام المعصوم، إلى كائن ديني خالص، ينطق مباشرة باسم الله، ويمتلك من ثم صلاحيات شمولية مطلقة. وهي صلاحيات لم تعد تقتصر على الإمام المعصوم فحسب، بل أعيد إسنادها –حسب نظرية ولاية الفقيه- إلى الفقهاء غير المعصومين.
شيعيًا، بدأ التفكير في الدولة من نقطة الإمام، أعني في سياق الموقف المذهبي المناصر لأحقية عليّ وأبنائه في الحكم. في مناظرات الجدل المبكرة مع التيار العام (السني لاحقًا) استند الفكر الشيعي إلى فكرة اللطف الإلهي الذي يقتضي تدخل الله في تعيين الحاكم كي تنتظم حياة المجتمع. فكرة اللطف -وهي فكرة جرى تداولها في النقاش المسيحي المبكر منذ أوغسطين- لم تطرح في السياق الشيعي لتفسير فكرة الدولة بما هي كذلك، بل لصالح الاحتجاج لإمامة بعينها. ومع ذلك فهي تربط ضمنيًا بين فكرة الدولة والإرادة الإلهية. وهو ربط سيحظى بخدمات احتجاجية متواصلة مع تطور التنظير الشيعي.
أما الأصول السنية فبالرغم من أنها لم تسم الإمامة ركنًا من أركان الدين، اعتبرتها “ضرورة” لازمة لحراسة الدين بما هو نظام جمعي (شريعة). الأمر الذي يفضي في نهاية التحليل إلى النتيجة الشيعية ذاتها، وهي الربط الأبدي بين الدين والدولة، وتحميل صلاحيات الحاكم، الأوتوقراطية أصلًا، بحمولة ثيوقراطية مضمرة.
-3-
في الوعي السياسي الحداثي، تتحلل الثيوقراطية إلى أوتوقراطية مضاعفة، بما هي سلطة مطلقة تمارس باسم الله وتفويضه المباشر، أي بما هي سلطة مطلقة ذات حصانة مقدسة أقوى. ومن هذه الزاوية تظهر الثيوقراطية بوصفها أخطر صور الأوتوقراطية.
تاريخيًا، انبثقت “الدولة الحديثة” من تراث الغرب المسيحي، في سياق صراعي طويل ضد فكرة “السلطة المطلقة” بجناحيها: 1- السلطة المطلقة للدين كما مارستها الكنيسة، 2- السلطة المطلقة للحاكم كما مارسها النظام الملكي. ومن هنا ارتبط مفهوم الدولة الحديثة بفكرتين رئيستين:
- العلمانية (نقيض الثيوقراطية)، 2- والسيادة الشعبية (نقيض الأوتوقراطية).
المعاني السلبية للثيوقراطية كما يقاربها الفكر السياسي المعاصر بما في ذلك الفكر الإسلامي، منقولة عن تراث النقد التنويري الأوروبي الموجه أساسًا لازدواجية السلطة في التجربة المسيحية، والدور القمعي الذي لعبته الكنيسة بامتداد العصور الوسطى. ونتيجة لذلك اعتبر الفكر الغربي في مراحل “الانتقال” للحداثة أن حل المشكل يكمن في إجراء نوع من وحدة السلطة، بحيث تصبح الدولة أو الحاكم على رأس الكنيسة. انتهى إلى هذا الحل مفكرون إصلاحيون متحررون نسبيًا مثل ريتشارد هوكر، بل ومفكرون أكثر تحررًا أو “علمانيون” مثل هوبز. وحتى روسو امتدح نظام الدولة في الإسلام بوصفه نظامًا أحاديًا يجمع السلطتين الزمنية والدينية في قبضة واحدة، بحيث لا يتمزق الفرد بين طاعة الله وطاعة الأمير.
واقعيًا، لا يعني وجود نظام أحادي زوال مخاطر الثيوقراطية طالما كان هذا النظام يتحدث باسم الله. ربما يؤدي إلى تخفف نسبي من المشاكل الإجرائية التي تصاحب ازدواج السلطة، لكن الحكومة الزمنية التي تتحدث باسم الله ستحصل على صلاحيات السلطة المطلقة المنسوبة إلى الله (بما أن هذه السلطة الإلهية تتحلل واقعيًا إلى سلطة بشرية يمارسها الحاكم أو الحكومة)، إضافة إلى صلاحيات السلطة الاعتيادية التي تجنح نزوعيًا للتغول على الحرية الفردية والمجتمع المدني.
من هنا تظل مخاطر الثيوقراطية كامنة في فكرة الحكم الإلهي، سواء كانت سلطة الحكم مزدوجة كما في النموذج المسيحي، أو أحادية كما في النموذج التاريخي الإسلامي، الذي يحمل –بدوره- تراثًا قمعيًا هائلًا. الفكر الإسلامي المعاصر يقع في مغالطة ظاهرة حين ينفي الثيوقراطية عن النظام الإسلامي تأسيسًا على غياب الكنيسة.