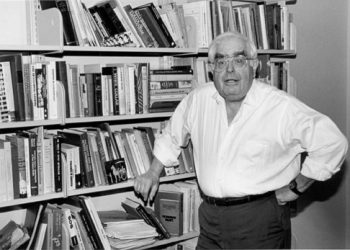-1-
يتوجس الفكر السياسي الإسلامي غالبًا من مصطلح الديمقراطية، ليس بسبب تحفظه المعتاد حيال مفردات القاموس الغربي فحسب، بل لأسباب أصلية ترجع إلى ثقافته الموروثة من تاريخ الأنظمة وتاريخ الفقه على السواء. التيارات الأكثر سلفية -التي تتوجس أصلًا من مصطلح “الفكر” ذاته كمفهوم دخيل على المعجم الشرعي، يتضمن معنى الرأي، ويهدد سلطة النص وسلطة الفقه- تنفر من مصطلح الديمقراطية، وقد تتحدث عن الشورى.
أما التيارات الأقل سلفية -التي أبدت نوعًا من الاستجابة النسبية لميراث الحداثة، وتجاوزت حرفية التقليد الفقهي إلى ممارسة أشكال حذرة من التعقل حيال النص- فقد تتحدث عن الديمقراطية، وقد تشير إلى الشورى بوصفها صيغة من صيغ الديمقراطية، بصرف النظر عن عدم تطابق المضامين والسياقات التاريخية.
بوجه عام، وخارج نطاق الفكر الديني، تظل الديمقراطية مفهومًا إشكاليًا في الوعي السياسي، بدءًا من التحفظات الكلاسيكية المنقولة عن التراث اليوناني خصوصًا أفلاطون وأرسطو، حتى الملاحظات الحداثية وما بعد الحداثية التي توجه سهام النقد إلى جوهر الفكرة ذاتها، أو إلى صياغاتها الأيديولوجية، أو إلى نتائج تطبيقها في سياقات جغرافية وثقافية معينة، أو إلى ربطها خصوصًا بقيم وآليات الرأسمالية الغربية، إضافة إلى الملل من شيوع المصطلح وابتذاله في وثائق وأدبيات النظم السياسية المتعارضة. ومع ذلك يظل المصطلح، بإيحاءاته الحداثية المضادة للحكم الفردي والفكر الشمولي، مدخلًا مناسبًا لمقاربة الحالة الإسلامية الراهنة، المحملة بخصائص أوتوقراطية وثيوقراطية مزمنة.
-2-
تختزل هذه الخصائص إشكالية السلطة في الفكر الإسلامي المبكر، الذي تشكل أصلًا كرد فعل مباشر للواقع المفروض من قبل الأنظمة: الفقه الذي أحرز هيمنة واضحة على مجمل الثقافة، قدم تقنينًا “نصيًا” لواقعة “التغلب” كآلية لإسناد السلطة، ولفكرة الشريعة كشق من الدين تقع مهمة حراسته على الحاكم. فيما قام الأدب السلطاني بترويج السلطة المطلقة للحاكم باعتباره ظل الله في الأرض. أما الكتابات الكلامية والفلسفية المتأثرة بالفكر اليوناني، فلم تقدم اختراقًا حقيقيًا للطرح الأوتوقراطي الثيوقراطي الذي قننه الفقه وكرسته الأدبيات السلطانية.
المبادئ الكلية المنصوص عليها في القرآن لم تشتغل بفاعلية في تاريخ الأنظمة، ومن ثم في تكوين المدونة التراثية التي ستشكل بنية الثقافة. نص القرآن على الشورى في سياق تحضيضي (الآية 38/ الشورى)، ولكن هذا النص ظل معطلًا على مستوى الواقع السياسي، وقام الفقه بتطويعه نظريًا كي يتوافق مع أنظمة الحكم المتعاقبة بأشكالها المختلفة من حكومات الراشدين بطابعها الأبوي القريب من تقاليد القبيلة، إلى الحكومات الأموية بطابعها الملكي الاستبدادي العربي، ثم الحكومات العباسية الأولى بطابعها الملكي الاستبدادي الفارسي، حتى الحكومات العباسية الثانية بطابعها السلطاني التفويضي.
بفعل تواصل التغلب جرى النص عليه في صلب النظرية الفقهية، أي صار يحظى بمشروعية تأسيس تتجاوز فرضية الأمر الواقع، مما سيتحول بالتسرب إلى واحدة من “القيم” المضمرة داخل الثقافة السياسية الموروثة، نصَّ أحمد صراحة على أن “من غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وصار أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه أميرًا للمؤمنين”. (أبو يعلى، الأحكام السلطانية)
-3-
بالطبع لا يستطيع أي نص تكليفي تجاوز سياقاته الثقافية المزامنة. ولم يكن بوسع الفقه أن يشتغل على نص الشورى خارج آليات الاجتماع السياسي الفاعلة في مراحل التدوين، والمطبوعة بطابع العصر الوسيط، وهو عصر ديني بامتياز، امتزجت فيه السياسة باللاهوت على نحو طبيعي، في ظل سيادة النظام الملكي.
[عمليًا، تطغى السلطة “الفعلية” للواقع الاجتماعي على السلطة “النظرية” للنص، أي نص. لكن المشكل فيما يتعلق بالنص الديني هو أنه لا يتخلى عن حضوره النظري، بل يتحول إلى سلطة اسمية معلقة تظل تشوش على “مشروعية” الواقع].
محملًا بثقافة العصر الوسيط الدينية، لم يقف الفكر الإسلامي السلفي على التصورات السلبية التي يثيرها مصطلحا الثيوقراطية والأوتوقراطية، ولا على الإيحاءات الإيجابية التي قد ينطوي عليها مصطلح الديمقراطية في الذهن السياسي الحديث.
[في الذهن السياسي الحديث تتحول الثيوقراطية إلى أوتوقراطية مضاعفة، بما هي سلطة مطلقة تمارس باسم الله، أي بما هي مزيد مقدس من السلطة المطلقة. ومن هنا تظهر الثيوقراطية بوصفها أخطر صور الأوتوقراطية.
في هذا السياق تحمل الديمقراطية، بما هي حكم الشعب أو حكم الجمهور، معنى “إناسيًا” يقابل “الإلهي” بقدر ما تحمل معنى “جماعيًا” يقابل “الفردي”].
الفكر الإسلامي الكلاسيكي –الخاضع كليًا لهيمنة الفقه– لم يطور فكرة الشورى من صيغة أهل الحل والعقد، البسيطة المستمدة من تراث القبيلة العربية الجاهلية، إلى مفاهيم نظرية أو بنيات مؤسسية يمكن أن تشتغل على النظام الملكي الناشئ، والأكثر تعقيدًا من صياغات الحكم القبلية البسيطة.
ظلت الوظيفة الأساسية للشورى في الذهن الفقهي هي عملية تنصيب الحاكم الفرد (بما في ذلك تنصيب الحاكم المتغلب) وليس عملية إدارة الحكومة أو المشاركة في الحكم (حيث لا تعني الشورى أكثر من طلب رأي اختياري من قبل الحاكم).
وفيما انحصر معنى الشورى في أهل الحل والعقد، انحصر أهل الحل والعقد في عدد محدود من الأفراد، فحسب الماوردي لا يلزم صدور البيعة عن غالبية أهل الحل والعقد، ومع تجاهل النقاش حول طريقة تسميتهم، فإن “أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالًا بأمرين؛ أحدهما: أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة. وهذا قول أكثر فقهاء البصرة، وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة.. وقالت طائفة تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي امدد يدك أبايعك.. ولأنه حكم وحكم واحد نافذ” (الأحكام السلطانية، ص33-34).
في التكييف الفقهي السني يشار إلى الإمامة بوصفها “عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه”. ولكنَّ طرفي العقد هما أهل الحل والعقد من جهة والإمام المختار من جهة ثانية. أما جمهور الناس أو الشعب فهو طرف غائب عن العقد، وعلاقته بالطرفين هي علاقة التلقي والطاعة.
في خضم الجدل بين النظريتين السنية والشيعية حول القول بالنص الإلهي والقول بالاختيار، اتفقت النظريتان على أن جمهور الناس أو “كل الأمة” لا دخل له في عملية تعيين الإمام. شيعيًا: كانت المسألة محسومة بالطعن على شرعية الاختيار البشري من حيث المبدأ، وسنيًا: كان الاختيار صلاحية مقررة لأهل الحل والعقد، أو للحاكم السابق قبل موته. دافع الفقه السني عن فكرة الاختيار ضد فكرة النص الإلهي، ولكنه اعتبر أن القول بالاختيار من قبل كل الأمة “يؤدي إلى إهمال فرض الإمامة” أما على مستوى الكتابة في السياسة العملية (الأدب السلطاني) فالتحذير صريح من إشراك الرعايا من عامة الشعب في إدارة السلطة. وفي كتابه “نصيحة الملوك” ينصح الماوردي الملك “ألا يسلط الرعية والعامة بعضها على بعض، ولا يجعل في المملكة آمرًا غيره وغير خلفائه” (ص291-292).
ووفقًا للنظرية إذا بايع أهل الحل والعقد رجلًا صار إمامًا “ولزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته” (الماوردي، الأحكام، ص35). ولكن النظرية –سواء في الفقه أو الكلام- لم تناقش الصفة التمثيلية لأهل الحل والعقد في عقد الإمامة، أو ما الذي يجعل بيعتهم ملزمة للأمة؟
الفقه الذي لا يحفل بتأصيل الأحكام نظريًا، استند في تأسيس مسألة اختيار الحاكم برمتها إلى الإجماع. وهو ما يبقي السؤال قائمًا لأن الإجماع سواء كان إجماع الصحابة، أو إجماع العلماء بعد عصر الصحابة –ومع التسليم بصحة انعقاده– يظل فعل أقلية بالنسبة إلى مجموع الأمة.
أما الكلام السني، وهو تنظيري بطبيعته، فبالرغم من دخوله معركة الجدل مع الشيعة حول شرعية الاختيار من أهل الحل والعقد، ومع اتصاله النسبي بالفكر اليوناني، فلم يستطع اختراق الإطار العام لثقافة العصر الوسيط السياسية، التي لم تر في جموع الناس أكثر من رعايا للحاكم. وفي واقع الأمر لم تكن الأمة كمفهوم “سياسي” حاضرة قط في الوعي السلفي على الرغم من حضورها الواضح كمفهوم “ديني” عام.
[الفكر الإسلامي المعاصر سيستحضر المفهوم السياسي للأمة بأثر رجعي وهو يعيد تفسير سلطة الحل والعقد كوكالة ضمنية أو نيابة مفترضة عن الأمة. وهو نوع من الإسقاط النظري، يرمي إلى استبقاء فكرة الحل والعقد داخل أطر الحداثة السياسية].
-4-
تطرح الحداثة، بالطبع، سؤال الأوتوقراطية كمعضلة يصعب حلها من داخل النظرية التراثية، أي من داخل فكرة الحل والعقد، أو مصطلح الشورى بوجه عام. لكن السؤال الأكثر إشكالية هو سؤال الثيوقراطية بما هو معضلة يصعب حلها بغير صدام، لا مع النظرية التراثية فحسب، بل مع الأصول الأكثر جذرية في نسق التدين التقليدي ذاته.