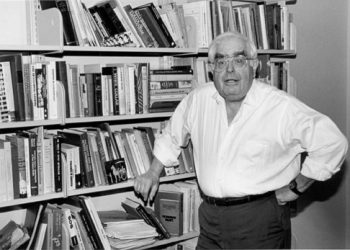-1-
تفترض الأنثروبولوجيا الوضعية أن حالة الاجتماع البدائي الطبيعية شهدت اندماجًا كاملًا للوعي الفردي في محيط الطبيعة )شعور الإنسان بأنه جزء من الطبيعة) قبل أن تشهد ذوبان الفرد في الأطر الجماعية التي فرضتها غريزة الاحتماء من خطر الطبيعية ( شعور الفرد بأنه جزء من جماعة).
الوعي بالذات مستقلة عن موضوعها شرط لأي معرفة، كما أن الوعي بالذات مستقلة عن الجماعة الحاضنة لها شرط لأي سلطة. كان الوعي بالفردانية يتفاقم تدريجيًا مع تواصل التطور باتجاه السيطرة على الطبيعة. لكن سلطة الأطر الجماعية (العائلة/ العشيرة/ القبيلة/ الدولة) ظلت طاغية على الوعي الفردي، خصوصًا بعد تثبيت الدين كإطار جماعي شامل يهيمن على جميع هذه الأطر.
هذه الهيمنة بشقيها (هيمنة الجماعي على الفردي، وهيمنة الديني على الجماعي) لم تتعرض لنقاش جدي طوال العصور السابقة على الحداثة، حيث تكرست سلطة الدولة وسلطة المؤسسة الدينية التي ظلت تفرض صيغًا نهائية جامعة للتدين، تقمع النزوع الفردي للتعبير عن حاجات الروح.
نسبيًا، ساهم نسق التفكير النظري، الذي بلغ ذروته مع الفلسفة اليونانية، في تطوير الوعي الذاتي، لكن هذا الوعي لم يستطع أن يفرض ذاته التعددية في منطقة الدين، الذي تطور بدوره مع النسق الكتابي إلى نظام حصري أكثر شمولية.
بامتلاكه لحالة الاجتماع الجاهزة (المجتمع) تماهى الدين التاريخي مع العرف، وصار يشكل الجزء الأكثر حساسية من فكرة النظام العام التي ستحظى بحماية القانون/ الدولة. بالطبع، يظل التناقض بين الفرد والجماعة الحاوية له بدئيًا بحكم الطبيعة وبصرف النظر عن حضور الدين، لكن تصعيد حضور الدين كسلطة “حصرية مدججة بلائحة تكاليف مقدسة، أدى إلى توسيع وتعميق قابليات التناقض.
الملاحظ تاريخيًا، أن التأثير القابض للدين على النزوع الفردي لم يظهر على أشده قبل تبلور الحصر التوحيدي. فطوال المراحل السابقة على هذا النسق، لم يمتنع ظهور أنواع من التعددية، بل فرضت التعددية نفسها على التدين ذاته، حيث جرى الإقرار بشكل متبادل بحق الجماعات والشعوب في تقديس آلهة أو إله بعينه، وبهامش نسبي للأفراد في اختيار إله من بين الآلهة المتعددة أو التعبير عن عبادته بطريقته الخاصة. في هذا السياق توفر نوع من السلام الديني، ولم يؤد التدين إلى حروب واسعة، ولا إلى صدام بين الأفراد أو مع الأفراد بالمعنى أو على النطاق الواسع الذي سيظهر مع النسق الحصري.
(راجع نموذج التدين المصري القديم، حيث كانت تُجرى في معبد واحد طقوس متنوعة لأوزوريس، وزيوس، وبلوتو، وأبيس. وحيث تقرأ عن تعدديات عبادة إقليمية وفردية لا تثير خصومات واضحة. وقارن ذلك بمرحلة التوتر والعنف النسبي التي ظهرت مع حصرية أخناتون ورد الفعل المضاد لها من قبل كهنة آمون.).
-2-
بوجه عام، غاب مفهوم التكفير ومفهوم الهرطقة عن سياقات التدين المصرية والبابلية والإغريقية والرومانية، ولم يوضع التفكير الفردي على نطاق واسع في مواجهة رؤية أحادية للدين.
مع اليهودية –التي تطورت إلى نسق حصري في مراحل متأخرة- سيظهر مفهوم “التكفير” بمضامينه الإشكالية (اللعن/ الإقصاء/ إباحة الدم/ القتل) “إذا أغواك أخوك سرًا.. قائلًا نذهب ونعبد آلهة أخرى، فلا ترض منه ولا تشفق عليه ولا تستره، بل قتلًا تقتله” (تثنيه 13/6-10. انظر أيضًا 13/1-10 والخروج 23/18. واللاويين 24/13/16). لكن مصطلح “الهرطقة” وهو لا يطابق الكفر، سيظهر في السياق المسيحي محملًا بمضامين إشكالية أكثر تعقيدًا.
نشأت المسيحية أساسًا كانشقاق لاهوتي، وظلت تتطور في الاتجاه ذاته، أي نتيجة لسلسة من الانشقاقات اللاهوتية التي تدور حول طبيعة المسيح أكثر ما تدور حول الشريعة أو الطقوس البحتة، ومن هنا تأتي مركزية “المبدأ الإيماني” ومركزية الكنيسة كسلطة، لا منح نفسها الحق الحصري في تحديد قانون الإيمان فحسب، بل أيضًا صلاحية “معاقبة” الخارجين عليه.
تبعًا لعلاقاتها المتغيرة مع الدولة الرومانية فرضت الكنيسة نفسها إما كسلطة موازية أو مجاوزة لسلطة الدولة حسب الظروف السياسية. ثار النقاش حول ما كان يسمى “حق السيف” هل يجوز للكنيسة بوصفها “مجتمعًا متكاملًا” أن تقرر عقوبة الموت وأن تنفذها عن طريق أحد رؤسائها إذا كانت ضرورية لصالح المسيحية، أم تكتفي الكنيسة بإصدار الحكم ثم تعهد بتنفيذه إلى السلطة المدنية، وهو ما ذهب إليه القديس توما الإكويني؟
بالطبع كانت صيغة السؤال تعكس ثقافة العصور الوسطى المسيحية، التي ظلت تناقش المسألة من زاوية العلاقة بين طرفي السلطة، الكنيسة والدولة، ولم تتوقف للنقاش حول الأسئلة الأولية عن علاقة الإنسان الفرد -بما هو كائن طبيعي حر- بالكنيسة والدولة، بما في ذلك السؤال من حيث المبدأ عن صلاحية الكنيسة وكذلك عن صلاحية الدولة، لفرض قانون يتعلق بالاعتقاد الفردي، وتعميمه كتكليف ملزم، قبل مناقشة العقاب عليه بعقوبة الموت.
بامتداد العصور الوسطى قدمت الكنيسة الكاثوليكية من خلال محاكم التفتيش، النموذج القمعي الأكثر وحشية في تاريخ العلاقة بين الفكر والدين، أو بين الحرية الفردية والنظام الاجتماعي المؤمم من قبل الدين والمدعم بسلطة الدولة. عبر التحالف بين الكنيسة والحكومات المدنية، أرسل آلاف البشر في أوروبا أحياء إلى المحارق بتهمة الهرطقة، التي لا تعني حصرًا إنكار الدين، بل مجرد التفكير فيه بطريقة لا تطابق رؤية الكهنوت الرسمي. وهي في نهاية المطاف رؤية فرد أو أفراد آخرين.
-3-
في السياق الإسلامي لم توزع السلطة بين الدولة ومؤسسة دينية، حيث تقمصت الدولة منذ البداية دور المؤسسة كحارسة للدين، وتم ذلك بمساعدة “الفقه” الذي تقمص، بدوره، دور المؤسسة كمنتج للشريعة.
كان رسّو قد لاحظ في القرن الثامن عشر، أن ازدواجية السلطة في السياق المسيحي الغربي مزقت الفرد بين الدولة والكنيسة، وأفرزت “أعنف حكم استبدادي في هذا العالم”. وأثنى في المقابل، على النظام الإسلامي بوصفه نظامًا أحاديًا تتحد فيه السلطتان السياسية والدينية تحت رئاسة الأمير الحاكم. واعتبر رسو أن هذا النظام الذي “أحسن محمد ربطه” استمر قائمًا في ظل خلفائه، “إلى أن أصبح العرب مزدهرين ومثقفين، وبالتالي مخنثين، فأخضعهم البرابرة، وعندئذ بدأ انقسام السلطة من جديد”.
ما لم ينتبه إليه رسو هو أن أحادية السلطة لم تؤد إلى تخفيف حمولة التسلط الكامنة في نظام الخلافة الأحادي ذاته. فهي وإن منعت ازدواجية الولاء لدى غالبية المحكومين السنيّين)، لم تمنع الجمع بين السلطتين داخل إطار واحد، مما يعني تكثيف حصيلة التسلط بتركيزه في قبضة ثيوقراطية واحدة، تشمل التسلط الاعتيادي الذي يصدر غريزيًا عن طبيعة الدولة والتسلط النوعي الكامن في إلزامية الشريعة.
تاريخيًا، أفرز نظام الحكم الأحادي الإسلامي تراثًا قمعيًا هائلًا شارك الفقه في إنتاجه، من خلال توظيف آلياته ومفاهيمه النظرية (كالإجماع/ البدعة/ الفتنة/ إلى جانب التكفير) لصالح السلطة الأوتوقراطية. وتدريجيًا، مع تراجع قوة الدولة الحارسة (السنية) كان “الفقه” يتحول إلى “مؤسسة” معنوية صريحة تلعب دور الحراسة معتمدة على سلطة العرف، وأحيانًا على سلطة الدولة التي لم تتنازل رسميًا عن دورها التقليدي المعروف. وحتى بعد الوصول إلى الدولة الوطنية المعاصرة، ظلت الدولة بتركيبتها المزدوجة (العلمانية/ التراثية) تحافظ على دورها الرسمي الموروث كحارسة للدين. وتم ذلك من خلال خطوتين جديدتين؛ الأولى: تأميم مؤسسة الفقه باستلحاق “الفقهاء” داخل جهاز الدولة، والثانية: إعادة تأًصيل دور الحراسة بآليات “القانون” كجزء من فكرة النظام العام التي تحمي ثقافة الأغلبية أو الثقافة الكلية للمجتمع.
-4-
منذ البداية، كان التحول الحداثي في صميمه تحولًا نحو الوعي الفردي على حساب السلطة الشمولية التي اقتسمتها الدولة والكنيسة. عندما صارت هذه السلطة موضوعًا للمناقشة، أخذ الاجتماع “الخام” يستعيد وعيه بذاته، وظهر مفهوم “الاجتماعي” بما هو مجال أصلي مقابل لـ”الديني” ومفهوم “المجتمع” بما هو كيان “مدني” مقابل للدولة، ومفهوم “الفرد” بما هو كيان ذاتي مستقل لا يستغرقه المجتمع ولا الدولة، وأخيرًا مفهوم “التعددية” الذي يترجم التمايزات الفردية “الطبيعية” إلى حقوق “قانونية” مقابل المجتمع والدولة.
كانت الضغوط الحداثية المبكرة قد أسفرت عن تراجع السلطتين لصالح الوعي الفردي: الكنيسة انسحبت كليًا من المجال العام، وجزئيًا من المجال الخاص. أما الدولة فاضطرت لتعديل موقعها المهيمن على المجال العام من خلال تراجع سلطة الملوك أمام التوجهات الديموقراطية التي كانت تعبر في الأخير عن تطور الوعي الفردي. لكن الدولة، التي احتلت مساحة الكنيسة في المجال العام، ستعود تدريجيًا من خلال القانون للاستيلاء على مناطق جديدة داخل المجال الخاص (مغايرة للمناطق التي سبق أن حكمتها الكنيسة). ومع ذلك ظلت الحصيلة الإجمالية تشير إلى تفاقم مضطرد لحضور الوعي الفردي والتعددية، بالتوازي مع التطور الاقتصادي التقني والاجتماعي العام.