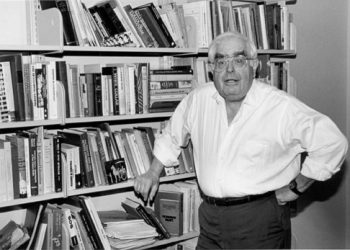-1-
تشكل الفكر السياسي عبر القرون الثلاثة الأولى، التي تمثل عصر التدوين، حيث جرى التفكير في “الدولة” من خلال نموذج الحكم القائم وكرد فعل له، وجرى التعامل مع “الدولة الدينية” بما هي معطى مفروغ من وجوده ومشروعيته. لم يقف الوعي السلفي على “مفهوم” الدولة في ذاتها، ولا على المعنى الإشكالي الكامن في علاقتها بالدين. وهو موقف معرفي مفهوم في سياق تشكله الخاص، وفي السياق العام لثقافة الاجتماع الوسيط، الشمولي الطابع، والخاضع إجمالًا لهيمنة الدين.
في سياقات أسبق، متحررة من وصاية اللاهوت تهيأ للثقافتين اليونانية والرومانية التفكير في الدولة كمفهوم يُعقل لذاته، وإنتاج نظرية سياسية تتعاطى مع الدولة بما هي موجود اجتماعي طبيعي يقرأ بمعزل عن الآلهة، ولا يقرأ بمعزل عن “المجتمع المدني”. وهو المصطلح الذي سيظهر في اللاتينية ثم الفرنسية ترجمة لمصطلح أرسطو “ koinonia politike” الجماعة السياسية. لكن الثقافة المسيحية، التي تكونت على وقع الصدام مع الإمبراطورية الرومانية. ستبدأ التفكير في الدولة من خلال علاقتها بالدين، وستقف على المشاكل العملية والنظرية التي تثيرها هذه العلاقة.
خلافًا للمسيحية، التي اكتمل تكوينها كديانة قبل أن تتوافر على دولة بعدة قرون، امتلك الإسلام دولته “الخاصة” منذ البداية تقريبًا. ولعدة قرون تالية. تكرس الربط في السياق الإسلامي بين الدين والدولة بعد تقنينه فقهيًا في صيغة الدولة الحارسة للدين. في محيطه المحلي المنعزل نسبيًا، لم يدخل الإسلام الناشئ في مواجهة سيادية مع دولة قوية بحجم الدولة الرومانية، ولم يقع بالتالي في مشكل التعارض مع سلطة علمانية مفارقة كما وقعت المسيحية. الفكر الإسلامي السلفي الذي لم يعاين وجودًا للدولة المنفصلة عن الدين، لم يصطدم بمشكل ازدواجية السلطة (الخضوع لسلطة الدين وسلطة الدولة منفصلتين) كما لم يكن مهيأً للوقوف على الوجه الآخر للمشكل، وهو (المخاطر الكامنة في اندماج السلطتين معًا في قبضة واحدة، هي قبضة الدولة الدينية).
-2-
نظريًا، بحكم الصدور عن نسق التدين التوحيدي ذاته، يمثل الدين في المسيحية والإسلام سلطة كلية ذات طابع شمولي حصري، مما يعني الحديث عن سلطة صدامية لا تقبل التشارك. يقول المنطق التوحيدي بحاكمية واحدة، تتسع حدودها بقدر تمدد مساحة الشريعة داخل الديانة. وبما هي قانون تتقاطع الشريعة بالضرورة مع الصلاحيات التقليدية للدولة.
ومع ذلك كان على المسيحية، وهي تولد في ظل الحضور الراسخ للدولة الرومانية، أن تعترف بوجود المجتمع المدني، ومشروعية الدولة العلمانية القائمة. بشكل صريح تخلت المسيحية عن شريعة الكتاب متنازلة لقيصر عن سلطة الحكم بقانون الدولة. مقابل الحصول على مساحة داخل المجتمع المدني. لاحقًا، ومع تحول الدولة الرومانية إلى المسيحية وتفاقم نفوذ الكنيسة، سيشرع الفكر المسيحي في إعادة توزيع ميزان القوة بين السلطتين لصالح الكنيسة، في ظل بقاء الازدواجية.
يعكس هذا التشكل المتطور حضور الاجتماع السياسي كفاعل مؤثر في الفكر الديني المسيحي، ويفتح الباب للمقارنة بينه وبين الفكر الإسلامي السلفي الذي لم يتعرض للمشكل أصلًا بسبب الدمج بين السلطتين، وغياب ميراث النفور من الثيوقراطية، وللمقارنة بينه وبين الفكر الإسلامي المعاصر الذي لا يزال يطرح فكرة الدولة الإسلامية، والذي صار يصطدم بالمشكل وجهًا لوجه في ظل غياب الدمج، وحضور المثير الحداثي الذي أظهر مخاطر الثيوقراطية.
-3-
في كتابه “مدينة الله” طرح القديس أوغسطين نظرية المدينتين أو الدولتين، حيث جعل المسيحية، مقابل روما، مدينة أو دولة إلهية. المدينة الأرضية تشير إلى المجتمع Sosiotes الطبيعي، المقيد بالخطيئة الأًصلية، والمحكوم بالغرائز الأنانية للبشر، والذي يفتقر إلى العدالة، ويعجز عن تحقيق السعادة الدنيوية على الرغم من كونها الهدف الذي يسعى إليه. أما مدينة الله، فتشير إلى جماعة المؤمنين الذين يعيشون حياة الطاعة لله، أي أتباع المسيح. وهي مدينة يمكن تحققها على الأرض، على الرغم من أن حالتها النموذجية لا توجد إلا في الحياة الأخرى. وهي تفترق بذلك عن مدينة أفلاطون المثالية التي لا وجود لها خارج ذهن الفلسفة.
ينسب أوغسطين هذا التقسيم إلى الكتاب المقدس، الذي لا يميز إلا بين نوعين من المجتمعات ينتمي إليها جميع البشر في جميع الأزمنة. ما يجعل الفرد عضوًا في إحدى المدينتين ليس العرق أو الجنس أو صك الانتماء القانوني، بل “الغاية التي يسعى إليها، ويخضع لها في النهاية كل أفعاله” ( City of God, Xiv.1;Xiv.4.). نحن في الواقع أمام استقطاب ثنائي حاسم يقسم العالم إلى أمتين أزليتين: المؤمنين والكفار. وهو الاستقطاب الأصولي المتكرر الذي سنقرؤه بوضوح في جميع الأدبيات المتشددة داخل النسق التوحيدي (انظر النموذج الذي يقدمه سيد قطب في “معالم على الطريق”).
ويقر أوغسطين بأن المدينتين تتقاطعان واقعيًا داخل العالم. فالمدينة الإلهية تشتغل من خلال المجتمع المدني، الذي هو موجود طبيعي مخلوق بعناية الله، وعليها، لذلك، أن تتعايش مع المدينة الأرضية جنبًا إلى جنب، فالمشاكل الناجمة عن هذا التداخل لا تحسم بالانسحاب من العالم أو بالامتناع عن السياسة. يلتزم المسيحي في جميع الأحوال بالخضوع لقانون الدولة المدنية، مستصحبًا إيمانه الداخلي بسمو القانون الإلهي. ويفترض عند التضارب الاعتماد على الحكمة المسيحية بالتوفيق بين السلطتين.
ناقش أوغسطين -في الكتاب الخامس من مدينة الله- الحالة التي يتقلد فيها المسيحي الحقيقي منصب الحكم، حيث يفترض أن تندمج السلطتان، واعتبرها حالة مرغوبة، لكنه -بحس واقعي- استبعد أن تدوم لفترة طويلة من الزمن. وبدا واضحًا أن المسيحية لا تستهدف “دمج” الدولتين، أي لا تسعى إلى إلغاء الدولة العلمانية، لكن عليها في الوقت نفسه أن تعمل على التأثير فيها كي تساعد البشر على الفضيلة وبلوغ الخلاص.
وحَّد أوغسطين بين الكنيسة ومدينة الله، فصارت المقابلة هي بين الكنيسة والدولة، أي بين “سلطتين” متجاورتين تشتركان في حكم المجتمع المدني. لكنه لم يقدم عرضًا تفصيليًا لحدود العلاقة بين سلطة الدولة وسلطة الكنيسة. ومع ذلك فإن شروح أوغسطين المجملة حول المدينتين ستصبح واحدًا من مصادر التنظير الأساسية، التي ستبني عليها الكنيسة الكاثوليكية تغولها المتواصل على صلاحيات الدولة.
بوجه عام، ظلت ازدواجية السلطة، الموروثة من قرون التأسيس، هي الفكرة المحورية التي تحكم الفكر السياسي المسيحي، بتنويعات مختلفة، طوال العصور الوسطى، وعصر الإصلاح حتى الدخول في مراحل الحداثة العلمانية.
الاستحواذ الواسع والمتواصل على السلطة بامتداد العصور الوسطى لم يفض بالكنيسة إلى نفي الدولة المدنية وإنشاء “دولة مسيحية” أحادية السلطة، أي لم ينته إلى دولة دينية بالمعنى الضيق (على غرار الدولة اليهودية في عصر القضاة، أو الدولة الإسلامية الفقهية). وقد أمكن على الدوام استيعاب النزوعات الثيوقراطية المتطرفة، بما في ذلك النظريات البابوية التي تكلمت عن حكم كنسي مباشر، والأفكار النبوئية الألفية التي روجت لتحقيق مدينة الله على الأرض، وتحرير المسيحيين من أي التزام حيال السلطة المدنية كما طرح توماس منتسر، وحتى أفكار الثورة الكاثوليكية المضادة، التي عادت لتأكيد تبعية المجتمع المدني للكنيسة كرد فعل مقابل للثورة البروتستانتية.
بدوره، لم يخرج الإصلاح البروتستانتي عن إطار الفكرة الازدواجية. فالإنسان -حسب لوثر وكالفن- مواطن في مملكتين؛ الأولى هي الحكومة الروحية التي تمثلها الكنيسة، والثانية هي الحكومة المدنية التي تمثلها الدولة. لكن لوثر وكالفن سيعيدان –كل بطريقته- ضبط ميزان القوة لصالح الدولة على حساب الكنيسة “المرئية” لدرجة الحديث عن حق الدولة عند الضرورة في التدخل لتطهير الكنيسة أو إصلاحها وفقًا لكلمة الله. للدولة –إذن- وظيفة مزدوجة، حيال المجتمع المدني وحيال الكنيسة.
في الواقع أعاد لوثر وكالفن تعريف الكنيسة والدولة. فمفهوم الكنيسة لا يشير حصرًا إلى الكنيسة المرئية، ولا يجب تصور الكنيسة بوصفها سلطة الكهنة. يقوم الكهنة بوظيفة محددة داخل الكهانة المشتركة التي تضم جميع المسيحيين. وهو التعريف الذي سبق أن روج له الإصلاحي الإنجليزي جون وكليف (1320-1384). أما الدولة المدنية فلا يجب تصورها ككيان لا إلهي، فهي بحسب الأصل ناشئة بإرادة الله، كي تعبر عن رعايته للناس، وكما شرح بولس في رسالته إلى رومية “ليس ثمة سلطة سوى سلطة الله، والسلاطين القائمة هي مرتبة من الله” (3/1-4)، الدولة مفوضة من الله وليس من الشعب، ولذلك فهي بوظيفتها الأصلية خادمة لله.
بحسب لوثر وكالفن لا يتفسر وجود الدولة بأي نوع من العقد الاجتماعي أو إرادة الناس، بل مباشرة بإرادة الله. ولذلك فعلى الشعب الانصياع لحكم الدولة بوصفه طاعة لله، وليس له حيالها حق المساءلة لأنها لا تسأل إلا أمام الله. وعلى الرغم من الحديث عن تقديم طاعة الله على طاعة البشر عند التعارض -شرحًا لكلمات بطرس “ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس” ( أعمال الرسل 25:29) بحيث يكون العصيان الفردي جائزًا عند الضرورة- يشدد كالفن مثل لوثر على عدم جواز مقاومة الحكام بالقوة، أو العمل على تغيير الحكومات عن طريق العنف، لأن ذلك يعني الخلط بين المملكتين. أوامر الحاكم الدنيوي التي تخالف كلمة الله غير مشروعة، ولن يفلت من عقابه، لكن ذلك لا ينفي مشروعية السلطة في ذاتها، ولا يبرر التمرد عليها، أو حتى التهديد به، كما صرح كالفن بشكل قاطع في رسائله إلى البروتستانت المضطهدين في فرنسا.
واضح هنا أن تصعيد مقام الدولة على حساب الكنيسة، لم يكن يتم لصالح الفكرة العلمانية أو السيادة الشعبية كما كان عند وكليف، بل كان يشتغل لصالح السلطة الإلهية. ولذلك يلزم قراءته في إطار الروح العام للبروتستانتية كحركة أصولية فجة، تعاود النزوع إلى “الشمولية الحصرية” بما هي جوهر التدين التوحيدي. فنحن في الواقع حيال التفاف تحويري، ينطوي على نفي “ضمني” للازدواجية، وتوافق موضوعي مع النموذج اليهودي/ الإسلامي، الذي يسند إلى الدولة وظيفة حراسة الدين. وهي الوظيفة التي جرى تفعيلها بشكل قمعي في مواجهة المخالفين (الهرطقة) خصوصًا عند كالفن.
لكن الدور الذي لعبه الإصلاح البروتستانتي في كسر هيبة الكنيسة، سيقدم دعمًا غير مباشر لعملية التحول الكبرى التي ستنتهي لصالح العلمانية (تنحي الدين كليًا عن المجال العام، وتقليص هيمنته التقليدية في المجال الخاص).
على الرغم من نزوعها الأصولي، يلزم قراءة البروتستانتية في السياق العام لحركة التطور الكلي (الاقتصادي/ السياسي/ العقلي) التي أخذت تجتاح أوروبا بدءًا من القرن الرابع عشر، والتي صارت تكشف تدريجيًا عن تناقضات هيكلية بين النظام الاجتماعي والنظام الديني، وتصدر من ثم ضغوطًا متواصلة على النظام الأخير. في هذا السياق يمكن فهم البروتستانتية كنوع من رد الفعل المبكر، أو الاستجابة “الجزئية” من قبل المسيحية لمثيرات التطور الاجتماعي، التي ستسفر عند القرن التاسع عشر عن انتصار “كامل” للعلمانية مقابل الكنيسة، مع تصعيد فكرة سيادة الشعب كأساس لسلطة الدولة. المساحة التي انسحب منها الدين في المجالين العام والخاص، جرى اقتسامها بين الدولة والمجتمع المدني، الذي تكرس حضوره المستقل مقابل الدولة.
بوصفها تطورًا نقديًا للنظام الديني يصدر من داخله، مثلت الأفكار الإصلاحية، خصوصًا بعد كالفن، حلقة وسطى (انتقالية) بين نسق الفكر السياسي القديم، الذي ظل يفكر في الدولة كموجود اجتماعي أرضي يتفسر بفكرة التوافق والمصالح الاعتيادية، وتحكمه فكرة الشعب صاحب السيادة التي تنتمي إلى العالم. (راجع النموذج الذي قدمه ريتشارد هوكر “1553-1600” في كتابه الضخم “النظام الكنسي”. حيث يحاول التوفيق بين الكتاب المقدس وفكرة العقد الاجتماعي، وفكرة التفويض الشعبي. مع الاحتفاظ بفكرة أن صاحب السيادة -أيًا كان- يظل نائبًا عن الله).