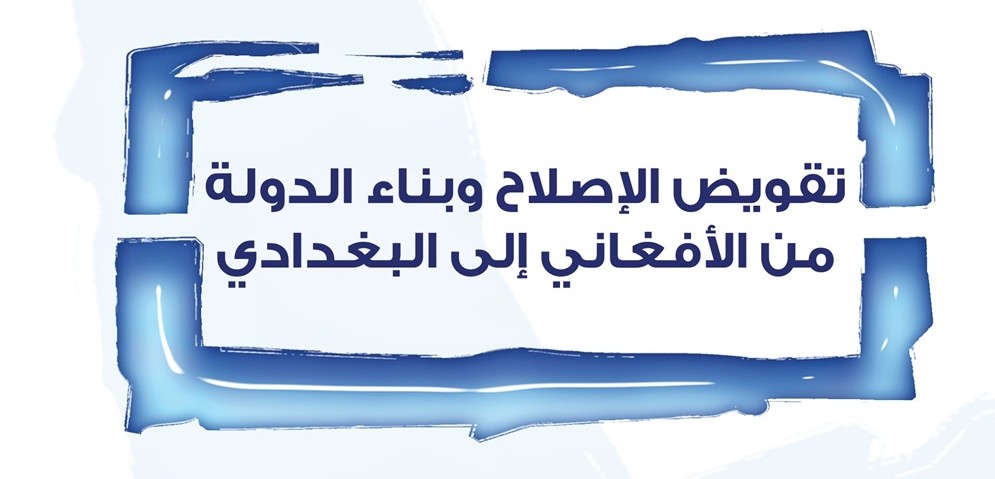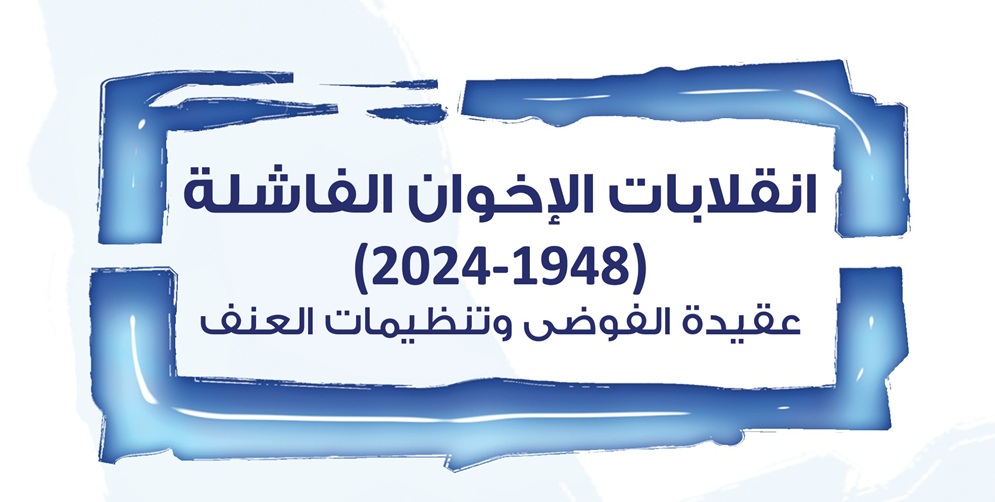دبي
 تمثل عودة المقاتلين من بؤر التوتر في مناطق الصراع تحدياً للدول العربية والغربية على حد سواء، بعد انخرط أفراد منها وتسللهم إلى المناطق المستعرة بالحروب ومع ارك الكر والفر، في منطقة الشرق الأوسط كدول مثل: العراق وسوريا وليبيا، كانت قد أطلقتها شرارة ما يسمى بالربيع العربي. ظهر ذلك التحدي للدول –في الغالب- بعد اكتشاف أولئك المقاتلين سراب الدعوات التي كانت تنادي وتجاهر بها التنظيمات الإرهابية الجهادية كالقاعدة و”داعش” وغيرهما، خصوصا بعد معايشتهم للواقع الذي ظهر جليا مخالفا لأحلام أولئك المغرر بهم، بعد أن أبهرتهم الماكينات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجماعات المسلحة بالانتصارات المتوهمة، أو السيطرة على الأرض والسيادة عليها، أو صورة طبيعة الحياة الملائكية التي قدمت عبر نوافذها، مع إضفاء عناصر التشويق والحركة والمغامرة، وصولا إلى تطابق إيمانهم المختل وفهمهم للإسلام مع تلك الجماعات.
تمثل عودة المقاتلين من بؤر التوتر في مناطق الصراع تحدياً للدول العربية والغربية على حد سواء، بعد انخرط أفراد منها وتسللهم إلى المناطق المستعرة بالحروب ومع ارك الكر والفر، في منطقة الشرق الأوسط كدول مثل: العراق وسوريا وليبيا، كانت قد أطلقتها شرارة ما يسمى بالربيع العربي. ظهر ذلك التحدي للدول –في الغالب- بعد اكتشاف أولئك المقاتلين سراب الدعوات التي كانت تنادي وتجاهر بها التنظيمات الإرهابية الجهادية كالقاعدة و”داعش” وغيرهما، خصوصا بعد معايشتهم للواقع الذي ظهر جليا مخالفا لأحلام أولئك المغرر بهم، بعد أن أبهرتهم الماكينات الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لتلك الجماعات المسلحة بالانتصارات المتوهمة، أو السيطرة على الأرض والسيادة عليها، أو صورة طبيعة الحياة الملائكية التي قدمت عبر نوافذها، مع إضفاء عناصر التشويق والحركة والمغامرة، وصولا إلى تطابق إيمانهم المختل وفهمهم للإسلام مع تلك الجماعات.
جاء كتاب المسبار الشهري “عودة المقاتلين من بؤر التوتر: التحديات والإمكانات” (الكتاب السابع والعشرون بعد المئة، يوليو (تموز) 2017) ليقف على تلك الظاهرة، ويستعرض الإجراءات وآليات الاستيعاب التي اتخذتها حكومات بلدان المقاتلين العائدين إلى ديارهم، وإشكالات إدماجهم في المجتمع، وليقف على حالة الرفض الاجتماعي والإكراهات الحقوقية والسياسية، والتحدي المجتمعي والثقافي والسياسي التي تواجهها الدول وكيفية التعاطي معها، وكيفية علاجها باعتبارها إشكالات طارئة على تلك الحكومات، عملت فيها على سن القوانين التي تراها رادعة أو مناسبة، ومن جهة أخرى فتحت باب التساؤلات حول طبيعة المعادلة الأمنية الجديدة في المنطقة.
التخلي عن العنف الإسلامي: العودة إلى ظاهرة التخلي عن الانتساب الجهادي
يرى الباحث الفرنسي سمير أمغار أن ظاهرة التخلي عن الأعمال الجهادية ليست جديدة. فقد تسنت ملاحظتها طيلة السنوات بين 1970 و1990 في أوساط المجموعات الإسلامية المسلحة في الجزائر. وإذا كانت الأدبيات التي تتناول شرح سيرورة التطرف أدبيات غزيرة، فإن الإنتاجات العلمية الصادرة باللغة الفرنسية، والتي تطرح مسألة معرفة سبب خروج المجموعات الإرهابية ذات المرجعية المستلهمة من الإسلام من العمل العنيف، وكيفية هذا الخروج، ما زالت نادرة إلى الآن. يشكلّ هذا البعد زاوية ميتة في الأبحاث التي تجرى حول العنف السياسي، هذا في وقت يطرح فيه هذا البعد منذ سنوات في أوساط المنظمات الإرهابية. هكذا يفتح العمل على ظاهرة التخلي عن الأعمال الجهادية أفقاً على جانب من الأهمية، فهو يمكن من طرح السؤال حول العنف الإسلامي بحد ذاته ولكن “بطريقة مقلوبة”. تشكّل دراسة سيرورة الردة في الأوساط الجهادية، وبحسب ما يعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة لوزان (‘Université de Lausanne) أوليفييه فليل (Olivier Fillieule) مجالاً لنفهم بعمق شروط السقوط في التطرف العنيف. يعتبر هذا المؤلف أن “فك الالتزام النضالي هو بمثابة كاشفٍ لإمكانات الوقوع في التطرف العنيف، أو بتحديد أدق: إنه كشف لاستنزاف أو لنضوب شروط الالتزام. وذلك على المستويات الفردية والتنظيمية”. بل أكثر من ذلك، إنَّ تحليل التطرف الإسلامي من خلال منظور دينامي وتطوري، يعني التنازل عن التعريف الماهوي الذي يطلقه الجهاديون أنفسهم حول الطبيعة اللازمنية والعالمية لالتزامهم، وبذلك يمكن تحاشي تجميد جهاديين قدامى في وضعيات أيديولوجية وعضوية ليست بالضرورة مما يقولون به. إن سيرورة الخروج من المنطق الجهادي، والتي تقتصر على ترك التطرف، هي ما أشير إليه بعبارة التخلي عن الانتساب الجهادي، مع الإشارة إلى أنها سيرورات معقدة. ومن هنا قد يكون التخلي إرادياً أو بالقوة، فردياً أو جماعياً، فجائياً أو بطيئاً . قد يحدث أن يكون هذا التخلي فردياً جراء توقيف ما، أو مفروضاً بشكل جماعي من جانب التنظيم الجهادي.
تعبئة المقاتلين الأجانب في أوروبا
الباحثان الغربيان المتخصصان بالحركات الإسلامية، لورنزو فيدينو وفرانسيسكو مارون (Lorenzo Vidino and Francesco Marone) يشيران إلى أنه ليس هناك توصيف واضح للمقاتلين الأجانب الأوروبيين، كما أكّدت العديد من الدراسات الأخرى. ويتوافق هذا الاستنتاج مع نتائج الأدبيات الراهنة عن التطرّف. بل لقد تم التخلّي جزئياً عن محاولات سابقة للتوصّل إلى استنتاجات من المتغيّرات الاجتماعية الديموغرافية وتحديد “شخصية الإرهابي”. وينطبق الأمر نفسه على ظاهرة المقاتلين الأجانب في أوروبا أيضاً. أما بالنسبة للخصائص الاجتماعية الديموغرافية، فإن كثيراً من المقاتلين الأجانب الجهاديين يأتون من الطبقة المنخفضة، لكن ينتمي أهالي بعضهم للطبقة المتوسّطة. وتتفاوت مستويات التعليم تفاوتاً كبيراً أيضاً. ولعدد كبير سجلّ إجرامي في بلدان منشئهم. ويستند قرار التوجّه إلى منطقة الصراع إلى دوافع مختلفة (أو مزيج من الدوافع)، بما في ذلك مشاعر الإحباط والاستياء في بلدانهم، والدوافع العدوانية، والمعتقدات الدينية/ الأيديولوجية المتطرّفة، والسعي وراء الإثارة والمغامرة، والرغبة في الخلاص الشخصي، والإحساس بالرفقة أو الأخوّة. كما أنه غالباً ما يكون قرار مجموعة صغيرة بدلاً من قرار فردي. وربما تكوّنت مثل هذه “المجموعة من الأشخاص” في الحيّ، أو في مركز للتسلية، أو في أحد السجون. ويمكن أن يفسّر ذلك التركّز الجغرافي في مدن أو مناطق محدّدة داخل مختلف بلدان المنشأ. ويضيفان أنه على الرغم من فعالية بعض التدابير الإدارية، فإن معظم البلدان الأوروبية اختارت أيضاً إدخال استراتيجيات واسعة إلى حدّ ما لمكافحة التطرّف العنيف. فابتكر العديد من البلدان الأوروبية برامج تهدف إلى إزالة التطرّف وإعادة الاندماج، بالنظر إلى حدود التدابير القمعية، وإلى أن الطامحين لأن يكونوا مقاتلين أجانب والمقاتلين الأجانب العائدين لا يشكّلون بأكملهم تهديداً بالضرورة.
كيف يفكّر الإرهابيون وكيف يتصرّفون؟ خلية “ليبيت دي شيمون” أنموذجاً
محمد الحداد (أكاديمي وباحث تونسي، أستاذ كرسي اليونسكو للأديان المقارنة – تونس، وعضو هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث بدبي) درس ما قامت به السلطات القضائية والأمنية الفرنسية من تسريب كمّ هائل من الوثائق ومحاضر التحقيق، المتعلقة بإحدى أخطر الخلايا الإرهابية في فرنسا، تلك المعروفة إعلامياً بخلية “ليبيت دي شيمون”، نسبة لمنطقة تقع شمال باريس وتقطنها جالية كبيرة من المسلمين، ومن بينهم أغلب أعضاء الخلية. لماذا سمحت السلطات الفرنسية بكلّ هذه التسريبات غير المعهودة؟ يرى البعض أنها أرادت بذلك أن تردّ ردّاً قويّاً على كل الذين اتهموا المصالح الأمنية بالتقصير والإهمال، ويرى البعض الآخر أنها أرادت أن تضع حدّاً لحملات التشكيك التي ما فتئت تتعاظم بعد مقتل الإرهابي محمد مراح ووجود شبهات حول علاقاته بأحد الأجهزة الاستخباراتية. تقدّم هذه الوثائق معطيات مهمة حول عالم الإرهاب من الداخل، والمنطق الخاص للإرهابيين، وتدفع إلى إعادة التفكير في مسائل كثيرة، منها العلاقة بين بلدان المنشأ والبلدان الغربية، ومنها المسؤولية الذاتية للبلدان الغربية في ترك الإرهاب يترعرع داخلها. وثمة مؤشرات عديدة تؤكّد أنّ تأثير الغرب في تنامي الإرهاب “الإسلامي” لا يقلّ خطورة عن تأثير المجتمعات ذات الأغلبية المسلمة. خلية “ليبيت دي شيمون” مثال جيد على تعقد العلاقة بين بيئة المنشأ وبيئة الهجرة في عصر العولمة، حيث يصعب تحديد اتجاهي “الذهاب” و”العودة”: هل هو من المجتمعات الإسلامية نحو الغرب أم من الغرب نحو المجتمعات الإسلامية؟ ذلك أنّ العالم الذهني للإرهابيين هو غير العالم المقنّن لرحلات الطيران العادية، العالم في ذهن الإرهابيين هو دار كفر ودار إسلام، وهذا التصنيف يسفر عن مفاجآت كثيرة. تقع منطقة “ليبيت دي شيمون” في شمال العاصمة باريس، هناك عاش الأخوان شريف وسعيد كواشي اللذان ارتكبا في يناير (كانون الثاني) 2015 العملية الإرهابية ضدّ “شارلي إيبدو”، الصحيفة الساخرة التي نشرت صوراً اعتبرت مسيئة للإسلام فتولّى الأخوان قتل كلّ طاقمها تقريباً. قبل أن يشتهر الأخوان بهذه الحادثة، كان لهما مسار طويل ومتدرّج في الإرهاب بدأ قبل ذلك التاريخ. ويتبيّن من خلال وثائق التحقيق أنّه كان معلوماً بدقة لدى المحقّقين، كيف استطاعا مع ذلك أن يخرجا من فرنسا ويعودا إليها، ويتدرّبا على الأسلحة، وينفّذا إحدى أكبر العمليات الإرهابية في تاريخ فرنسا، وهما تحت المتابعة وأحيانا تحت التنصّت من الأجهزة الأمنية؟ ومن لا يتابع المسألة بدقة قد يميل إلى التشكيك ويتحصّن بنظرية المؤامرة، أما المتابعة الدقيقة للوثائق المسربة، فتثبت أنّ ذلك ممكن جدّاً، بحكم القوانين المعمول بها في أوروبا، وبحكم الرؤية التي تحملها المجتمعات الأوروبية للإرهاب. مسار الأخوين الإرهابيين، وأعضاء آخرين أصبح قابلاً بأن يرسم بدقّة تكشف تعقّد السياق وقضايا الإرهاب. البداية لم تكن في سوريا ولا العراق، وإنما في الأحياء الفرنسية ذات الكثافة السكانية من المهاجرين وأبنائهم. خلية “ليبيت دي شيمون” ليست إلاّ قطرة من بحر، إذ يقدّر عدد الشبان الفرنسيين الذين التحقوا بالجهاد في سوريا أو العراق بحوالي (1300) شخص، لكن عملية “شارلي إيبدو” التي حصلت على التراب الفرنسي أعادت تسليط الأضواء على هذه الخلية وأعضائها، وسمحت برسم دقيق لطريقة تكونها ثم تطورها. ثمة شيء بارز هو دور السجن في تشكيل العلاقات بين الإرهابيين.
الجهاديون الفرنسيون: رهانات سياسية ونقاشات سوسيولوجية
يرى محمد علي عدراوي (باحث أول في السياسة والعلاقات الدولية في دراسات الشرق الأوسط -جامعة سنغافورة الوطنية)، أن المجتمع الفرنسي بات الآن، ومنذ سنوات عدة، مخترقاً بالعديد من التساؤلات التي تستوجب الشرح حول إيقاف ظواهر التحدي الجهادي والاحتراز منه. وإذا كانت أكثر مظاهر هذا التطرف وقعاً على علاقة بالأحداث التي اقترفت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 في باريس، فإن هذه الأحداث لا تستطيع أن تبعد النظر عن الهجمات المتعددة (التي حصلت بشكل مطرد وبطريقة مدمرة) ضد أهداف متطورة (مدنية، عسكرية، ودينية…) بالتوازي مع عدد كبير من أشخاص نجحوا في بلوغ أراضٍ في الشرق الأوسط أو حاولوا ذلك، حيث ينشط الآن الفاعلون الأساسيون من الحركات الجهادية (تنظيم الدولة الإسلامية، جبهة النصرة التي تحولت منذ عام 2016 إلى جبهة فتح الشام والتي اندمجت عام 2017 مع مجموعات محاربة أخرى لتشكل مجتمعة ما يعرف بهيئة تحرير الشام…).
وإذا كان ثمة العديد من التساؤلات التي تطرح حول وجود استثنائية محتملة فرنسية وفرنكوفونية ترتبط بالنصيب الأوفر (بعبارات مطلقة ونسبية) من الأشخاص الذين يتحدرون من فرنسا ومن بلجيكا؛ والذين اختاروا أن يصبحوا من المحاربين في صلب الحركات الجهادية المعروفة بعداوتها الواضحة للعديد من البلدان الغربية، فإن النقاشات باتت أكثر تشعباً وهي تتناول الدلالة الاجتماعية، والثقافية والدينية والسياسية لهذه الواقعة الاجتماعية التي تتمثل بالتبعية لمجموعات، أو الأخذ بأطروحات تحاول بالعنف الهائج -غالب الأحيان- إثارة مواقف صراع متنامٍ.
أما الهدف البعيد، فهو إقامة دولة تجمع مسلمي العالم كله، دولة تضم الناس جميعاً، نساءً ورجالاً حتى الذين يعيشون في أوروبا. وهذا ما يفسره المنظرون للجهاد باعتبار هؤلاء جنوداً في جيش يعيش حالة حرب دائمة.
يخلص الباحث إلى أن الحركة الجهادية الفرنسية هي حركة تتميز عن سائر التجارب القومية الأوروبية والغربية في الراديكالية، من حيث إمداد تطرفها باستعدادات اجتماعية وثقافية مهمة وموجودة أصلاً في أوساط الأجيال الشابة عند المسلمين الفرنسيين، حيث نجد أن قسماً مهماً من هذه الأجيال قد فتن دون انقطاع بهذا المخيال الأخروي والحاد عند بعض المجموعات الجهادية، وعلى رأسها الدولة الإسلامية. ودون الإشارة بالضرورة إلى خصوصية فرنسية لا يمكن تجاوزها (والتي يصعب الدفاع عنها، ذلك أن هذا البلد يؤوي الجماعات الإسلامية الأساسية في أوروبا الغربية، الأمر الذي يجعل من وجود الفرنسيين وسط هذه الحراكات وجوداً نسبياً)، فإنه لا بد لنا أن نلاحظ أن الحراكات الجهادية تجد في هذا البلد أرضاً خصبة، لا سيما وسط الشبيبة المسلمة المقاومة للخطابات المسيطرة، حيث يشكّل ضعف أو انعدام الاندماج الاجتماعي والنفسي بنية عداوات مسبقة أكيدة، وسيتكفل التطرف الديني بتوجيه ذلك نحو نمط من العنف لم تتحدد معالمه بدقة.
كذلك يتضح من تحليل الحالة الفرنسية أن حقل التطرف قد بات يعرف ومنذ نشوب القتال السوري تغيرات مهمة. فالمهمة الجهادية باتت عرضةً للانقسام والتذرر. إذ إن الفاعلين الذين ذهبوا إلى هناك لم تعد تجذبهم أيديولوجيا محددة واضحة البنى (الخلافة، والطوباوية الأخروية في حالة الدولة الإسلامية على سبيل المثال). إنهم لا يندرجون في إطار أخلاقية عنيفة، بل هم أشخاص تثقفوا على الحياة الجهادية وهم يقللون من علاقاتهم الاجتماعية. وإذا كانت الوجوه التي انجذبت إلى هذا النوع من الإسلام المتطرف على هذه الشدة من التنوع (على الرغم من بقاء عوامل ثقيلة، مثل الفقر، والابتعاد عن الأرض والانتماء إلى أجيال سابقة) فذلك يعود إلى الرسوخ الثقافي للفكرة الجهادية. وحده البعد الأيديولوجي ذو البعد الكوني، حيث تكون الطاقات موجهة نحو نشر العنف والبحث عن حالة حرب دائمة (ما يتيح إعادة نشر كل أشكال الغطرسة الخاصة بالأجيال المعاصرة نحو معنى ديني عابر للأمم وثوري)، إن الحركة الجهادية تعبر بذلك وبشكل جيد عن شكل من الثورة كما جاء في كتاب (Scott Attran, L’Etat Islamique est une Revolution, Les Liens qui Liberent, 2016)، يمكن استشعار نتائجه طالما أن هذا المخيال يمارس شكلاً من أشكال التفوق الرمزي في حقل المطالب المحلية، القومية والعالمية الآيلة إلى التطرف.
سلوك المقاتلين الشباب العائدين من بؤر التوتر وتداعياته
الباحثة والأكاديمية المغربية إكرام عدنني تفتتح دراستها بتساؤلها: لماذا يلتحق الشباب بالجماعات المتطرفة؟ وما هي أسبابه وخلفياته؟، وتشير إلى أن تصاعد ظاهرة التطرف داخل المجتمعات العربية بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تداخل عوامل عدة؛ منها: ظهور الشعارات الساذجة والعبارات الطنانة حول تسيب المجتمع، وضياع الهدف فيه، وضرورة اتخاذ مواقف صارمة للتعامل مع هذا الوضع، وإظهار المتطرفين بوصفهم ينتمون إلى فئة الحق، بينما ينتمي الآخرون -كل الآخرين- إلى فئة الضلال، وتوجيه هجوم ضد أي شخص يتحدى آراء الجماعة المتطرفة، وظهور خطاب الكراهية ضد الأقليات في المجتمع، ورفض اعتبارهم جزءاً من النظام الاجتماعي القومي، أو إنكار أنهم يشاركونهم هويتهم القومية، ومن ثَم وصفهم بأنهم عملاء أجانب لا يستحقون التعاطف. وترى أن نفسية الشباب بالمنطقة العربية تتوافر فيها القيم السلبية، إنها نفسية متأزمة تعيش حالة الضغط من جراء ما يجري حولها وفي محيطها الاجتماعي والسياسي والديني…، نفسية تبحث عن تحقيق ذاتها وعن منافذ التفريغ، والتي قد تكون منافذ التطرف والتعصب. وقد تكون نوعاً من الثورة على مختلف القيم السائدة في المجتمع، بما فيها القيم الاجتماعية والدينية، ولا يتعلق الأمر بشباب العالم العربي فقط، ولكن أيضاً بالشباب ذوي الأصول العربية المقيم في الدول الغربية والذي يعيش أزمة هوية، فهو يعيش في عالم غربي بعقلية وثقافة أجنبية، مما يخلق تلك الهوة بينه وبين الإنسان الغربي. وهذا ما يفسر كيف تمكنت الجماعات الإرهابية من أن تستقطب، بالإضافة إلى عدد كبير من شباب العالم العربي والإسلامي، شباباً من مختلف دول العالم الغربي، والذين تمنحهم الإحساس بالانتماء والاعتراف بهوية موحدة، على أساس ثقافي وديني بالدرجة الأولى. وإن عودة المقاتلين تستلزم تقدير حجم الخطر الذي سينتج عن عودة هؤلاء الشباب والنماذج الاحتمالية للعنف الذي يمكن أن يهدد استقرار المجتمع؛ كما يطرح ضرورة التفكير في السياسات التي يجب أن تتبع من طرف الدول المختلفة، في مواجهة الخطر القادم الذي يدخل في إطار مكافحة الإرهاب. وتحاول الباحثة الإجابة عن التساؤلات التالية: هل دول المنطقة العربية يمكنها في الوقت الراهن استقبال العائدين من بؤر التوتر؟ وهل خطورتهم باتت من الماضي أم ما زال الخطر قائماً؟ وهل فتح باب التوبة هو الحل، أم إن على الدولة أن تمنع مواطنيها من العودة إلى بلادهم؟
وبالتالي فجهود المؤسسة الأمنية لن تؤتي أكلها في ظل تواضع الأجهزة الأمنية، وتواضع الميزانيات المخصصة لمجابهة الإرهاب، وفي ظل استخفاف الأجهزة الأمنية بخطورة هؤلاء العائدين. وهو ما يتطلب نهج سياسات فاعلة بمساعدات دولية، والتنسيق بين الدول التي يوجد فيها المقاتلون، أو التي ستشهد الظروف نفسها بعد عودة اللاجئين من أجل الكشف عنهم، وتحديد الوسائل والأساليب والاستراتيجيات الأنجع للتعامل معهم. ويطرح التساؤل حول كيفية تحديد درجة خطورتهم، وخصوصاً إذا أثبتت الأدلة أن هناك من انخرط في عمليات قتال، ففي هذه الحالة من المؤكد أنه يجب أن يعرض على القضاء للنظر في أمره. فمن تسبب في القتل وسفك الدماء لا بد له من عقاب وأن ينال جزاءه، أما إذا لم تثبت أي أدلة عليه، فلا يخلو الأمر من ضرورة المراقبة والمتابعة لتبيان مدى انخراطه في المجتمع من عدمه. ولكن تبقى فكرة أن كل الجهاديين سينخرطون بالضرورة في عمليات إرهابية، صورة نمطية ولا يمكن الجزم بدقتها، بل يجب الأخذ بعين الاعتبار التفاوت على مستوى طبيعة ونفسية وتوجهات العائدين، ورغبتهم في الاستمرار في سلوكهم العنفي واستعدادهم للقيام بعمليات إرهابية من عدمه. من جانب آخر، هناك فئات عبرت عن ندمها ورغبتها في العلاج والاندماج، كما أن هناك بالفعل مجموعة من الشباب، ممن وجدوا أنفسهم قد وقعوا في مأزق حقيقي، وعبروا عن خيبة أملهم في ما كانوا يعتقدون أنه جهاد في سبيل الله، بحيث اكتشفوا أنهم تعرضوا إلى تغرير من طرف جماعة إرهابية، ووجدوا أنفسهم في مواجهة مقاتلين من دينهم نفسه، ويحملون شعارات الجهاد في سبيل الله نفسها، وبالتالي وقعوا في مأزق مقاتلتهم أو أن يتم ضرب رقابهم بدعوى رفضهم الجهاد في سبيل الله والخروج عن تنفيذ أوامر الحاكم. وهو ما يشكل دافعا لهم للعودة، ولن يكون لهم من ملاذ إلا بلدانهم الأصلية. وبالرغم من وجود مجموعة من القوانين التي تجرم الإرهاب، تجد الحكومات الرسمية اليوم نفسها عاجزة أمام التعامل مع هذه الحالة، فمن جهة، لا يمكن منع أي مواطن من العودة إلى بلاده، فهذا أمر مكفول له دستوريا، حيث يحجر الدستور التونسي –مثلا- في فصله (25) “سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”، ومن جانب آخر، تجد هذه الحكومات نفسها في مأزق أمام قلق الرأي العام من هذه العودة، ومن افتقارها إلى إمكانات مادية وخطط واستراتيجيات واضحة للتعامل مع هذه الأزمة. ولا يمكن المراهنة على المقاربة الأمنية فقط، على اعتبار أن العديد من الدول التي شهدت حراكا عربيا ما زالت تعاني من اختلالات اقتصادية وسياسية قوية.
التحدّي الثّقافي لمعالجة التيّار الجهادي في تونس
الباحث والأكاديمي التونسي محمّد كمال الحوكي، استعرض التحديات الثقافية في معالجة التيارات الفكرية المتطرفة. أحد أهمّ هذه التحدّيات عودة المقاتلين من بؤر التوتّر إلى أوطانهم. الأمر الذي يطرح أمام سلطات بلدانهم مسؤوليّات كبرى، منها الآني مثل المعالجة الأمنيّة، ومنها بعيد المدى والمتمثّل في استراتيجيّات الوقاية من توسّع هذا الفكر من خلالهم، بعد عودتهم محمّلين بثقافة الموت والتّدمير. ويمكن اعتبار هذا الأمر أخطر تحدٍّ على المدى القريب. أمّا حماية أفواج جديدة من الشّباب من هذا المصير، فهي أمر لا بدّ من معالجته على المدى المتوسّط، ثمّ تأمين المجتمع من تداعياته المختلفة على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يؤكّد هذا التحديّ الثقافيّ المهمّ والأساسي لمعالجة الظّاهرة معالجة ناجعة، نظراً لأنّ المعالجة الأمنيّة وحدها ستبقى قاصرة بدون حلول ثقافيّة. هناك تحدٍّ اقتصادي كذلك، وهو تطوير الحياة الاجتماعيّة والاستجابة لمشاكل الشّباب المتمثّلة في البطالة وانسداد الآفاق. ويبقى الثّقافي اليومي هو الأهم. فالتحدّي الرئيس هو التحدّي الثّقافي الذي من دون النّجاح فيه ببناء ثقافة الحياة والسّلم والعمل والإبداع، سيبقى الخطر قائماً مهما حوصر أمنيّاً واقتصاديّاً. يعمل الباحث في دراسته على توضيح التحدّي الثّقافي، وإبراز أهميّته في علاج الظّاهرة، واعتباره علاجاً استراتيجيّاً لوقاية وحماية الشّباب في تونس، ويوضّح كيفيّة محاصرة العائدين وتطويق أثرهم بالإنجاز الثّقافي ذي الأثر العميق في المجتمع. يدعو الباحث إلى وضع استراتيجية علميّة لحماية طائفة من الشّباب مؤهّلة للانخراط في هذه التيّارات المتشدّدة؛ وهو العمل الذي يجب أن يرمي إليه البعدان الثّالث والرّابع، ونعني بهما المديين المتوسّط والبعيد. فأنواع القضايا في المجتمعات تصنّف صنفين: “يتمثّل الصّنف الأوّل في الإشكاليّات الظّرفيّة التي هي وليدة مستجدّات وظروف معيّنة. أمّا الصّنف الثّاني فيتمثّل في الإشكاليّات المزمنة، التي يعسر حلّها، لذا تمتدّ في الزّمن والتّاريخ فتتوارثها الأجيال الثّقافيّة”. لذلك نحرص على تشخيص معمّق لتصنيف الإشكاليّة وتحديد الحل ونوع الحل. فهدف هذه المرحلة هو حماية شباب، توجد الآن بينه وبين هذا التيّار قنوات مفتوحة، واحتمال تفاعله معه وارد. لكن الهدف الأكبر يبقى في تحديد استراتيجيّة وقاية على المدى البعيد، وهذا في حدّ ذاته مكوّن التحدّي الثّقافي المطروح أمام الدّولة، وعليها الاستعداد له وتوفير أدواته وكلّ محفّزات النّجاح فيه. فهو السّبيل إلى إعادة تأطير ثقافة المجتمع وتوجيهها نحو الصّالح العام، ببناء ثقافة إيجابيّة تبني ولا تهدم، تحيي ولا تميت. ويرى أن أزمة الفكر الدّيني أصبحت ترمي بظلالها على كلّ جوانب الحياة في البلاد العربيّة والإسلاميّة. على الرغم من عدم الاعتراف بها من قبل المؤسّسة الدّينيّة الرّسميّة، أو تهميشها كلّما تمّ طرحها من جديد. وهي عنوان الأزمة المعرفيّة التي يعيشها العرب والمسلمون. فلا يمكن الحديث عن فئات باغية وضالّة دون التّذكير بأنّ التيّارات المتطرّفة ونسختها الأخيرة “داعش” بالذّات ليست إلاّ الجانب التّطبيقي لما يوجد في المدوّنة الفقهيّة، وهذه حقيقة يتغاضى عنها الجميع، وخصوصاً المؤسّسة الرّسمية التي تخرج وتدين ما تقوم به هذه الجماعات، دون الالتفات إلى أحكام الجهاد في كتب الفقه، ومسائل الإيمان في كتب العقيدة، والتي لم تفعل “داعش” شيئا سوى تطبيقها مع قراءات ظاهريّة تصدر في “نشريّات” مذهبيّة محدّدة، وتنشر تحت عناوين مختلفة ليست “داعش” إلاّ تلميذها الشّرعي. ولذلك على المؤسّسة الدّينيّة أن تتطوّر وتعيد النّظر في الكثير من الموروث الدّيني، ومراجعته وإصلاحه وإبراز ما بقي صالحاً منه، وإبانة ما يعتبر مجرّد تراث فكري تاريخي لا غير، مع فتح باب الاجتهاد وإدخال مسائل ومناهج العلوم الإنسانيّة كأدوات رئيسة في إنتاج الفكر الدّيني بالأساس. إنّ معالجة ناجعة لآفة الإرهاب يجب أن تتميّز، بالشمول والعمق وطول النّفس. كما أنّها ليست معالجة محليّة. صحيح أنّ لكلّ قطر إسلامي خصوصيّاته، لكن المعالجة يجب أن تتميّز بالتّكامل الاستراتيجي وبعد النظر.
عودة المقاتلين من بؤر التوتر: الحالة التونسية
منذر بالضيافي، الباحث التونسي في الحركات الإسلامية، يقول: إن عودة المقاتلين من بؤر التوتر تحولت إلى “كابوس” يؤرق كل التونسيين، وذلك بالنظر إلى العدد الكبير لهؤلاء، من الشباب التونسي من الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية والتنظيمات المتشددة وأهمها “القاعدة” والدولة الإسلامية “داعش”، خاصة تلك التي تقاتل في ليبيا وسوريا والعراق، حيث تجمع جل التقارير الدولية (الأمم المتحدة) والدراسات الأمنية لكبريات مراكز البحث المختصة، على أن تونس تحتل الصدارة، بما بين (3) و(4) آلاف مقاتل، بما يجعل منها البلد الأول المصدر للإرهابيين، مما يفسر تصاعد الجدل السياسي والإعلامي وأيضا المجتمعي، في تونس حول هذه الظاهرة، وتحديدا تأثيرات هذه العودة المرتقبة “لجيش من المقاتلين”، عودة يتفق الجميع على أنها إلى جانب مخاطرها الأمنية، يمكن أن تهدد بنسف كل مسار الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، الذي حقق خطوات مهمة تبشر بوضع اللبنات الأولية لتأسيس تجربة ديمقراطية في دولة إسلامية، خصوصا وأن كل شروطها التاريخية والمجتمعية تكاد تكون متوافرة، بالرغم من أن المنجز الاجتماعي والاقتصادي، الذي قامت عليه ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011 لا يزال دون المأمول ودون الانتظارات، ولعل هذا ما يفسر تصاعد الحراك الاحتجاجي بين الفترة والأخرى. في هذه الورقة، يرصد الباحث مدى جدية هذا الخطر الداهم على استقرار تونس، وعلى مستقبل الانتقال الديمقراطي فيها، ورصد كيفية تعامل النخبة السياسية، سواء التي في الحكم أو في المعارضة، مع عودة كهذه، وما هي التصورات المقدمة لمواجهة هذا التحدي الخطير، بعيداً عن “المناكفات” السياسية التي ميزت نقاشات ومواقف الأحزاب والسياسيين والنخب. وأخيرا، عرض ومناقشة “الخطة الحكومية” في التعاطي مع هذا التهديد؟ بالرغم من خطورة ظاهرة عودة المقاتلين، التي تمثل تهديدا صريحا للأمن القومي، وكذلك لمسار الانتقال السياسي والديمقراطي، فإن الحكومة التونسية، بضغط من المجتمع الدولي واستجابة لمطلب داخلي، فرضه السياق الديمقراطي الذي تمر به البلاد، فإننا نجدها قد اختارت ترجيح سيناريو إعادة الإدماج على التجريم، وعلى إعطاء الأولوية للحل الأمني، الذي حصر في الحالات التي يثبت تورطها في جرائم فظيعة وضد الإنسانية، وهي في الواقع عملية صعبة ومعقدة. وهذا الخيار بدأت الحكومة في تطبيقه في الواقع، وهي التي أعلنت عن عودة (800) مقاتل قامت بتصنيفهم وفق درجة “الخطورة”، بين من آوتهم في السجون استعدادا لمحاكمتهم، وبين من أطلقت سراحهم، لكن فرضت عليهم مراقبة أمنية لصيقة ومشددة. ويلاحظ الباحث أنه وعلى خلاف الوضع السابق عن ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011، إذ كان الحل الأمني هو الأساس في التعامل مع حركات الإسلام السياسي كلها، سواء التي تلجأ لاستعمال العنف، أو التي تنتهج منهجاً سلمياً في نشاطها. فإننا في حال اليوم نجد استجابة من قبل السلطات للمنظمات الأهلية أو المجتمع المدني وتحديدا المنظمات الحقوقية، التي تدعو إلى مقاربة شاملة لمقاومة الإرهاب، ليس البعد الأمني إلا جزءا منها. فجرت مسألة عودة المقاتلين حادثة من جديد، هي الجدل حول ضرورة محاربة الإرهاب، لكن، دون التعدي على حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة. هناك شبه إجماع، اليوم في تونس، بأنه لا يمكن العودة للوراء تحت أي طائل، بما في ذلك الحرب على الإرهاب. وأن هناك “يقظة” إيجابية، تقف حاجزا أمام جنوح السلطة إلى إعادة الهيمنة على كل الفضاءات وتدجين الحراك الاجتماعي والسياسي. كما أنه لم يعد ممكنا للحكومة أو الرئيس تهديد الحرية التي يضمنها الدستور وعديد التشريعات.
المقاتلون التونسيون بين الرفض الاجتماعي والإكراهات الحقوقية والسياسية
منيرة رزقي -باحثة في علم الاجتماع- تشير إلى أن ظاهرة التحاق التونسيين ببؤر التوتر بأعداد كبيرة مقارنة بالديموغرافيا التونسية، وبروزهم كفاعلين في صناعة الموت في أماكن عدة من بقاع العالم، تحتم على الدارس ضرورة متابعتها وتمحيصها وملاحقة تبعاتها المتوقعة على المجتمع والدولة، خاصة مع انقسام النخبة والساسة وعموم التونسيين حول طرائق التعاطي مع الظاهرة وأشكال مجابهتها. ولأن الإنسان لم يولد ليحل مشاكل العالم -كما قال الكاتب الألماني غوته- ولكن ليحدد مكمنها، وبالتالي يتمكن من ضبطها في مفاهيم واضحة، فإننا نرنو من خلال هذا البحث إلى محاولة فهم هذه الظاهرة، والسعي إلى تحليل وتفكيك أشكال تمثل الرأي العام التونسي لها.
تعتمد الباحثة رزقي المقاربة (الفيبرية) لمحاولة تفسير وفهم أشكال تعاطي التونسيين، سواء من النخبة السياسية، أو المنظمات والجمعيات الحقوقية، أو من عموم التونسيين، مع قضية عودة المقاتلين من بؤر التوتر كالعراق وسوريا وليبيا، بعد انحسار النفوذ الداعشي فيها. وتعتمد المنهج النوعي أو الكيفي من خلال رصد الوقائع والتصريحات والتفاعلات الاجتماعية في رد الفعل على القضية المثارة، سواء التي تخص الفاعل السياسي أو النخبة أو عموم التونسيين. كما وظفت المنهج الكمي من خلال الاعتماد على تقنية الاستمارة لاستقاء معطيات كمية تفيد مسار البحث.
وترى أن المشهد التونسي يعيش سياسيا واجتماعيا تفاعلات مركزية متصلة بقضية آنية فائرة، ألا وهي عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر، بعد توالي الوقائع التي تفيد بتراجع التنظيمات التي انخرطوا فيها، وهذا ما أدى إلى تنامي المخاوف في صفوف التونسيين، من مخاطر هذه العودة وما سيحف بها مقابل انقسام السياسيين والحقوقيين حول هذا الشأن. ويتضح الانقسام من خلال تضارب المقولات بين من يقول بانسلاخ هؤلاء المقاتلين وتبنيهم لهوية جديدة، وهو ما يسقط عنهم الانتماء التونسي، وبين من يتمسك بالمحددات الدستورية التي تمنع هذا الفعل. وتحاول الإجابة عن التساؤلات التالية: ماذا نحن فاعلون بهؤلاء المقاتلين الذين انخرطوا في الحروب الدائرة في مختلف بؤر التوتر بنوايا جهادية إذا ما قرروا العودة؟ وهل ثمة إمكانات لاستيعابهم أو احتوائهم للاندماج من جديد في صلب المجتمع، وضمن منظومة العيش المشترك، بعد أن شقوا عصا الطاعة وانسلخوا عن العقد الاجتماعي الذي انبنت عليه العلاقة بين الدولة ومواطنيها؟
التعاطي مع المقاتلين العائدين من بؤر التوتر
يتساءل المختار بن نصر -رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل- في بداية دراسته: هل يعيد اليوم التاريخ نفسه؟ ويجيب بأنه عند انتهاء الحرب الأفغانية وتراجع دور المقاتلين العرب في ساحات المعارك، وجد المقاتلون التونسيون أنفسهم تائهين، ولا خيار أمامهم إلا الانخراط في حرب أهلية أفغانية أو العودة إلى تونس. لكن وقتها كانت العودة حلما صعب المنال بسبب الملاحقات الأمنية، ولم يبق أمام هؤلاء إلا بعض الأماكن التي تمثل لهم ملاذات آمنة. فمنهم من توجه إلى أوروبا الغربية للحصول على اللجوء السياسي وخصوصاً ببريطانيا، ومنهم من ذهب إلى السودان التي حل فيها الإسلاميون في السلطة، وتوجهت مجموعة أخرى نحو البوسنة لتشارك في القتال الذي عرف بحرب الإبادة العرقية بين 1993 و1995. ومع بداية الحملة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والتي تزامنت مع فشل المحاولات الجهادية في مصر وليبيا والجزائر، انطلقت موجات التضييق والملاحقات لتطال أولئك المقاتلين. فطردت السودان الجهاديين بمن فيهم التونسيون، وشددت الحكومات الأوروبية مراقبتهم وعرقلت تحركاتهم بعد سلسلة التفجيرات التي هزت فرنسا آنذاك، مما دفعهم للبحث عن ملاذات جديدة أكثر أمنا وأكثر حرية. وتزامن ذلك مع سيطرة طالبان على العاصمة كابول وسيطرتها على أغلب الأراضي. يحدث اليوم الأمر نفسه، فالجماعات الجهادية يضيق أمامها الأفق، وتوشك حروبها الممولة والمدعومة من أطراف عدة أن تضع أوزارها، ويوشك جيل جديد من المقاتلين أن يتشرد بعد أن لحقت الهزائم المتتالية بـ”داعش” وأمثالها في كل بؤر الصراعات من ليبيا إلى سوريا إلى العراق. أي مصير لهذه البنادق التائهة والتي انتهت الحاجة إليها؟ سوف لن يتسنى الوقت لإحصاء أعداد القتلى، وسوف يفر الأحياء منهم بحثا عن عوالم أخرى، وسوف يحاول من تقطعت به السبل العودة إلى الديار، عودة فيها المرارة والانكسار والهزيمة هذه المرة، عودة المنبوذ والفار والمطرود والمنهك الذي ضاقت عليه الأرض بما رحت.
تهدف دراسة الباحث إلى تصور كيفية التعاطي مع العناصر العائدة من أماكن التوتر وبؤر الصراعات والحروب، والحد من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تشكلها إن هي بقيت دون تأهيل وتأطير ومراقبة، وذلك بإيجاد حلول عملية وفعالة. فهؤلاء الأشخاص الذين يكونون قد عاشوا في أماكن الصراعات أو احتكوا بعناصر إرهابية، أو اشتركوا في أعمال العنف أو القتل، أو أسهموا بشكل من الأشكال في دعم أو مساعدة عناصر إرهابية، يكونون في كل الحالات قد عاشوا تجارب قاسية تكون قد أثرت بعمق في نفسياتهم وتفكيرهم وحياتهم، مع احتمال أن يكون بعضهم قد انخرط بإرادة أو قسرا في جرائم موغلة في الوحشية.
الجزائريون الأفغان: هجرة للجهاد وعودة للإرهاب
يشير الباحث والأكاديمي الجزائري حمنة ولهي إلى أن الجزائريين الأفغان يُحصرون بالمواطنين الجزائريين الذين تنقلوا أواسط الثمانينيات من القرن الماضي إلى أفغانستان لمحاربة الغزاة السوفيت، تلبية لفتوى الجهاد التي أطلقها الشيخ عبدالله عزام ضد القوى الشيوعية الكافرة حسبه. ويعد عبدالله أنس أول الجزائريين تلبية للنداء وعملا بالفتوى، حيث نقرأ في كتابه “ولادة الأفغان العرب” تفاصيل اطلاعه على محتوى الفتوى وتنقله إلى مقاطعة بيشاور الباكستانية، ومساهمته في تأسيس مكتب الخدمات الذي يقدم الدعم اللوجستيكي للمجاهدين الأفغان بواسطة الأفغان العرب. بعدها توالت التنقلات حتى بلغت (3000) فرد -حسب ما يذكر الباحث محمد مقدم صاحب كتاب “الأفغان الجزائريون من الجماعة إلى القاعدة”- حيث وصلوا إلى بيشاور عبر بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وإسبانيا، أو عبر المملكة العربية السعودية. حيث يعد الجهاد من بين أكثر الأحكام الشرعية مثاراً للجدل والخلاف بين العلماء والفقهاء، لما يتحقق من ورائه من أهداف وما يترتب عليه من آثار. وهدف الباحث من هذه الدراسة ليس التأصيل لمفهوم الجهاد، وإنما مناقشته كظاهرة برزت من داخل جماعة الإخوان المصرية، التي تعد أصل جل الجماعات ذات الطابع الحركي والتنظيمي. ولغرض جلاء المفاهيم التي يحدد بها الباحث الظاهرة، ويفسر ما أفرزته من أحداث وأفعال، معتمدا على كتاب الجهاد القرضاوي.
ويرى أن ظاهرة الأفغان الجزائريين تشكلت بفعل عوامل عدة، أبرزها عدم الالتفات إلى المطالب الشعبية المتعلقة بهويته وعقيدته، وغياب الحوار، وفرض سياسات مغتربة، وكذا الأزمات الاقتصادية والبطالة والتهميش، وأيضا غياب البرامج التي تحارب الفكر المتطرف واعتماد الحلول الأمنية التي تؤزم الوضع وتزيده تعقيدا. وأن عودة المقاتلين من بؤر التوتر تفرض على دولهم إعادة تأهيلهم وإدماجهم، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتصحيح أفكارهم من جهة، ومن جهة أخرى متابعة تحركاتهم ورصدها، والتعامل معها بحزم إن اقتضى الأمر.
الجزائر واحتواء الراديكالية الجهادية
يشير الأكاديمي الجزائري بوحنية قوي إلى أن عودة مئات الجهاديين الجزائريين من بؤر توتر جغرافيا المنطقة العربية والإسلامية شكلت هاجساً كبيراً في الأوساط السياسية والأمنية الجزائرية؛ بالنظر إلى مخرجات تمرسهم على فنون القتال مما سمح لهم بتشكيل خلايا نائمة وارتكاب عمليات إرهابية. وكان للجهاديين الجزائريين العائدين من بؤر النزاع النصيب الأكبر في ارتكاب مثل هذه العمليات أو الإعداد لها، وفق تقارير دورية لوزارة الداخلية الجزائرية. فأكثر من (1050) عنصراً جزائرياً قاتل في أفغانستان والعراق والبوسنة والهرسك عادوا إلى الجزائر، من الفترة الممتدة بين 1989 و2003.
تأتي هذه الدراسة من باب تحليل فاعلية مقاربة “العفو والمصالحة” وتقويض اتجاهات العنف الإسلامي في الجزائر، من خلال عدد من العناصر، وهي: مقاربة العفو والمصالحة: المفهوم والأدوات. الهجرات الجهادية وأثرها في تحولات الإرهاب في الجزائر. مآلات المقاتلين الجزائريين: بين الاستئصاليين ودعاة الحوار. في محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المؤسسة الأمنية الجزائرية واختراق شبكات التجنيد. هندسة السلم والأمن في الجزائر: وتراجع ديموغرافيات الرعب.
الجهاديون المغاربة في سوريا: الدوافع والديناميات
تحاول ورقة محمد مصباح –باحث مغربي متخصص في الإسلام السياسي- دراسة ظاهرة المقاتلين المغاربة في الساحة السورية، من خلال وصف مسار تحول عدد من الشباب المغاربة نحو الجهاد في سوريا، ورصد لعملية الاستقطاب المستعملة في تجنيد المقاتلين الأجانب، مع تسليط الضوء على الدور المتزايد الذي باتت تلعبه وسائط التواصل الحديثة في الدعاية للجهاد. بعد ذلك سيتم تقديم توصيف دقيق لمسار السفر، ورصد للفرص والتحديات المرتبطة بالرحلة نحو الأراضي السورية. كما سيتم الوقوف على أهم الفصائل التي يقاتل المغاربة في صفوفها. وفي الأخير سنقوم بتقديم تفسير للأسباب المعقدة التي أسهمت في بروز هذه الظاهرة.
يقول الباحث في الدراسة: إن التحولات المأساوية التي عاشها العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى ولادة الجيل الثالث من الجهادية العالمية، والتي شكلت الساحة السورية بؤرة الجذب الرئيسة لها. وقد حاولنا في هذه الورقة تسليط الضوء على مختلف الجوانب التي ترتبط بموضوع المقاتلين المغاربة في سوريا والعراق، سواء من خلال عرض أدوات الاستقطاب والدوافع والأسباب التي تفسر تنامي الظاهرة، ثم أيضا تحليل ووصف المجموعات المسلحة التي كان المغاربة أعضاء فيها. وفي هذا الإطار تظهر مجموعة من الخلاصات ترتبط بظاهرة المقاتلين العابرين للحدود، أبرزها أن الالتحاق بالتنظيمات الجهادية في سوريا لم يكن بالضرورة مرتبطا بالبعد الأيديولوجي فقط، فقد لاحظنا أن التبريرات التي قدمها عدد من الجهاديين الذين التحقوا بالساحة السورية تؤكد البعد التضامني مع الشعب السوري. بالإضافة إلى ذلك فإن عملية التحول الأيديولوجي نحو الجهادية “الصلبة” هي عملية متأخرة تتعمق في معسكرات التدريب مع عملية التلقين المنظمة للأيديولوجيا الجهادية. وتمثل شبكات التواصل الاجتماعي إحدى الأدوات الفعالة في الدعاية الأيديولوجية للجهاد في سوريا، ولكن عملية الاستقطاب تعتمد أساسا على الشبكات التقليدية، وعلاقات القرابة والجوار، وهذه العلاقات هي التي تلعب دورا حاسما في الاستقطاب أكثر من العلاقات المنسوجة داخل الفضاء الافتراضي. ثم إن ديناميكيات الانتماء للجماعات الجهادية في سوريا، تتميز بالتقلب المستمر والمرتبط أساسا بالصراع القائم بين الفصائل الجهادية في سوريا، ومن هنا تمت ملاحظة تغير مستمر للولاءات من “جبهة النصرة” ثم “حركة شام الإسلام” إلى تنظيم “داعش”، وهي في تغير مستمر. وأخيرا يمكن الإشارة إلى تعدد الأسباب والدوافع التي تفسر الظاهرة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الدولية التي سهلت عملية التسفير للعشرات من الجهاديين نحو سوريا، من دون إغفال العوامل المحلية والمسارات الشخصية للجهاديين.
عودة مقاتلي المغرب العربي من العراق وسوريا ومعادلة الأمن الجديدة في شمال أفريقيا
يقدم الأكاديمي الجزائري نسيم بلهول، في دراسته تحليلاً لتداعيات عودة مقاتلي شمال أفريقيا من العراق وسوريا على الأمن الجهوي المغاربي. والبعد الوظيفي للعائدين من بؤر التوتر الإقليمية، والتورط الأمريكي في صناعة الإرهاب واختراق الجماعات المسلحة لتسخيرها في خدمة أهدافها، للتوضع والتموضع في شمال أفريقيا، لتتحول نقاط هذا الجزء المهم من الجغرافيا العربية والإسلامية اليوم، مرتعاً خصباً لوكالات التجسس الأمريكية بالتوازي مع تنامي ظاهرة عودة الجهاديين إلى المنطقة. مستعرضا في بحثه: الشباب في شمال أفريقيا: بين الاستقطاب الجهادي والمضايقات الأمنية. جغرافيا انتشار جهاديي المغرب العربي. مقاتلو المغرب العربي: بين جهنم صراع الأمراء ومطاردة الدوائر الأمنية. بناء مصفوفة رعب في شمال أفريقيا.. بحثا عن ملاذ آمن. في التوظيف الاستخباراتي للعائدين من العراق وسوريا. الاستثمار الأمني في الجهاديين.. الأجندات الجديدة وتحديات الأمن في شمال أفريقيا.
يرى الباحث أن مستقبل منطقة شمال أفريقيا، مع العائدين من سوريا والعراق، في منتهى الخطورة في ظل وجود وتولد تنظيمات جديدة، فجغرافية المغرب العربي من الفضاءات الأكثر جاذبية للجماعات الجهادية. ومرشحة لأن تكون ملاذا مهما لتلك العناصر والهجرات (الجهادية)، التي أضحت تؤسس لما يسمى بتهديدات الجيل الثالث من الإرهابيين الذين يرفضون الاعتراف بالحدود، مشبعين بفكر الخلافة في تقاطع لزج بين حركة الدوائر الاستخباراتية الغربية والقصور الاستراتيجي لتلك العناصر، في رؤية تقضي بأن الحالة الجهادية لا بد أن تكون خلافة بلا حدود. سيشكل العائدون من سوريا والعراق قفزة نوعية على الاستراتيجيات القديمة. حقيقة، المرحلة الآن، تقضي بأن هناك فروقا بين خارطة العائدين بعد مرحلة أفغانستان، والخارطة الحالية التي ينتشر فيها الجيل الثالث من الجهاديين في شمال أفريقيا.
في إطار مصفوفة الإرهاب الجديدة، تبقى معادلة الأمن مهزوزة في شمال أفريقيا: حيث لا تزال تواجه معظم دول شمال أفريقيا حالياً أزمات بدرجات متفاوتة. فالوضع الذي يغذيه تطرف الراديكاليين، وسوء الإدارة، والانقلابات، والاضطرابات الاجتماعية، يشير إلى اضطرابات جيوسياسية عميقة لن تؤدي سوى إلى تشجيع الفصائل التي تستخدم العنف. ولا تزال تونس ما بعد الثورة، المتفائلة فجأة بعد الموافقة أخيراً على دستور جديد، تكافح للتوحد حول هوية مركزية. وقد أدّت الاضطرابات السياسية وعدم اليقين إلى تباطؤ اقتصادي حاد، كما أن مسارات أعمال التهريب الجنائية تنتعش في جنوب البلاد. وعلاوة على ذلك، لا تزال الجماعة المتطرفة «أنصار الشريعة» تزدهر وتكسب مؤيدين على الرغم من تصنيفها كمنظمة إرهابية، وتم وضعها تحت المراقبة على نطاق واسع. وقد قُتل على الأقل سبعة من الإرهابيين المزعومين أثناء مداهمات قامت بها الحكومة خارج مدينة تونس في الأسبوع الماضي، لكن التهديد في مجمله لا يزال قائماً. وفي الجزائر، فإن فترة الولاية الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة (المريض) والمسبب لخلافات تبدو حتمية لا محالة، الأمر الذي يزيد من احتمال قيام اضطرابات كبيرة بعد انتخابات أبريل (نيسان). ولا يزال النزاع حول منطقة الصحراء الغربية في حالة غليان، مما يعيق أوجه التعاون كافة بين الجزائر والمغرب. ومن جانبها، عملت المغرب على الحد من نفوذ الإسلاميين بمهارة وبراعة، وغالباً ما حجمت الإرهاب الداخلي. إلا أن عزلتها الجغرافية وإقصاءها من التحالفات الإقليمية الكبيرة، قد يُحد من نفوذها وقدرتها على العمل مع الأطراف المتعددة.
وفي غضون ذلك، وفي إطار الهجرات الجهادية المعاكسة، لا تزال المنطقة محاطة بثغرات اجتماعية وسياسية وأمنية عديدة، عمق تأثيراتها المعضلة الليبية وما تعانيه من انقسامات قبلية وعرقية أدت إلى إحداث صدوع أمنية في شمال أفريقيا. فحدود الدولة في شمال أفريقيا غير الخاضعة للسيطرة هي أساساً عبارة عن مناطق تجارة حرة لتهريب المقاتلين من ذوي الخبرة والأسلحة، إلى المناطق المجاورة غير المستعدة جيداً للتعامل مع عمليات انتشار من هذا القبيل. وإذا استمر المتطرفون بدون رادع فسوف تزدهر تحركاتهم وتؤدي حتماً إلى توسيع نطاق أهدافهم.
عودة المقاتلين من بؤر الأزمات: الحالة المغربية
إدريس لكريني -أستاذ القانون والعلاقات الدوليين، ومدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، جامعة القاضي عياض، المغرب- يرى أن تعاطي الدول المعنية اختلف بهذا الموضوع، بين من استحضر البعد العلاجي الأمني المبني على الصّرامة، واعتماد عقوبات مختلفة في مواجهة هؤلاء العائدين، بوضعهم تحت المراقبة الأمنية ومحاكمتهم وسجنهم، وبين من فضّل التعاطي مع الموضوع بأسلوب أقل حدّة، من حيث العمل على إدماجهم داخل المجتمع، وحثهم على مراجعة تصوراتهم وأفكارهم، أو الجمع بين الخيارين. إن استمرار هذه الظاهرة، يطرح أكثر من سؤال بصدد جدوى وفعالية الجهود المختلفة، التي راكمتها العديد من دول المنطقة في سبيل تطويق ومحاصرة الإرهاب. فما الذي يدفع شبابا في مقتبل العمر إلى الالتحاق بهذه الجماعات ومعانقة الفكر المتطرف؟ وما السبل الاستباقية الكفيلة بمنعهم من الإقدام على مثل هذه الخطوات؟ ذلك ما تسعى الدراسة إلى تناوله في هذه الورقة، من خلال الوقوف على مخاطر هذه العودة التي تؤرّق صناع القرار في المنطقة المغاربية وغيرها، وعلى أهمية المقاربات الوقائية في علاقة ذلك بتعزيز المنظومة التشريعية، كسبيل لردع هذه السلوكات التي غالبا ما يستغلّ أصحابها غموض أو غياب النصوص القانونية ذات الصلة، واعتماد تنشئة اجتماعية بنّاءة تقوم على ترسيخ قيم التسامح والحوار وقبول الآخر، وتقودها مختلف القنوات المعنية بهذا الخصوص، من مؤسسات تعليمية وإعلام ومجتمع مدني وأحزاب سياسية، مستحضرين في ذلك التجربة المغربية الغنية في هذا السياق. علاوة على التطرق لأهمية تدبير الأزمات الدولية والإقليمية بما يسمح بإنهاء مواقع التوتر، التي تعدّ عامل جذب للجماعات الإرهابية، والحد من تمددها وانتشارها. وبناء عليه، تركز الورقة على أربعة محاور، نتناول من خلالها السياق العام لعودة المقاتلين من بؤر الأزمات، وتداعيات هذه العودة وأسئلة المقاربات الاستباقية، ثم جهود المغرب الاستباقية في مواجهة الظاهرة، قبل الختم بتناول دور المقاربات الاستباقية في الحدّ من هذه الظاهرة.
العائدون من بؤر التوتر وإشكالات إدماجهم في المجتمع الألماني
السيد عبدالصمد اليزيدي -الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين-، ومحمد عسيلة -المستشار التربوي لدى المجلس الأعلى للمسلمين- تناولا في دراسة مشتركة إشكالات إدماج العائدين من بؤر التوتر، ويشيران إلى أنه بحكم عدم دراية ثلة من الأئمة الشمولية بالإشكاليات، وتجاوز البعض منهم من طرف هذه الديناميات على مستوى اللغة والثقافة والإعلام، والتفاعل مع المؤسسات، وعدم متابعتهم لما تحدثه هذه التقاطعات، وفي غياب برامج وتصورات لاحتضان هذا الشباب داخل فضاءات المساجد، وعدم أخذهم وإدراج قضاياهم واهتماماتهم في الخطاب الديني بلغة وثقافة ومعجم لغوي يفهمونه ويتفاعلون معه؛ حاول هؤلاء الأئمة الدخول في هذا الحراك الفكري عن الهوية بيد فارغة –تقريبا- أفقدت البعض منهم مشروعية الاعتراف من طرف هذه الشريحة الشبابية، ليس بسبب عدم كفاءاتهم في العلوم الشرعية، بل لأنهم يعتمدون مقاربة وسطية ومندمجة. دفعت هذه الوضعية بهذه الشريحة من الشباب إلى مغادرة فضاءات المساجد إلى بيوت ومرائب اكتروها أحيانا، غير بعيدة من تلك المساجد التي أسسها وبناها الأجداد والآباء والأمهات، ودخلوا في تواصل مع “جوجل” للبحث عن “الإسلام والأجوبة الصحيحة” التي لا تعرف من الألوان إلا الأبيض أو الأسود، ولا تعترف بالمقاربات الوسطية أو “المنزلة بين المنزلتين”، كما كان يقول بذلك المعتزلة، واستحسنوا خطابا يدرج العداء العلني أو المستتر للديمقراطية على أنها منتوج وإبداع بشري أرضي أمام شريعة ربانية وسماوية. خطاب يناهض أي تقارب أو زواج بين الإسلام والأرض والهوية الأوروبية. إذا فَقَد الإنسان توازن عقله بشحنه بأفكار ومعتقدات شاذة، وتحجرت مشاعره وتبلدت عواطفه واضطرب سلوكه، واستُلِبت إرادته وانسلخ عن واقعه، وتاهت رؤيته للواقع وضاعت هويته في مجتمعه ووطنه (الجديد) وعاش في حالة من الاغتراب والتقوقع والتشرذم، فهنا يكمن المرض العضال الذي يستوجب العلاج، والذي علينا كمؤسسات تربوية وإسلامية ونفسية بناء حلف وتحالف تعاقدي مع كل الفاعلين لعلاجه وتقويم اعوجاجه؛ لأننا نعتبره سلوكاً لا يمت بصلة إلى التدين الإسلامي، ولا إلى مبادئ القيم الإنسانية التي نادى بها ديننا الحنيف، ويكمن ذلك في مستويات عدة، يقدمها الباحثان: على المستوى الشرعي، وذلك من خلال خلق فضاءات استقبال ونقاش وحوار وجدال وتدافع بين الشباب مع السادة المختصين لتقديم أجوبة مطمئنة في لقاءات تفاعلية بعيدة عن الجاهزية. على المستوى النفسي والروحي بمرافقتهم من خلال برامج يسهمون في تشكيلها من الأعلى إلى الأسفل. على المستوى التربوي داخل المساجد وداخل المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، من خلال خلق مواد تربوية/ تعليمية تجعل من الإسلام والمسلمين موضوعا لها، ودراسة ذلك بشكل موضوعي. على المستوى المجتمعي، وذلك من خلال القيام بعمليات تحسيسية تستهدف إحداث تغيير في تقبل المسلمين والإسلام كجزء فاعل ومغنٍ للثقافة وللحضارة الأوروبية الألمانية. ويقف الباحثان على مؤشرات وأعراض ما يسمّيانه بالخلل “النفسي والتواصل المجتمعي”، ويلخصانه في: فقدان البصيرة. وعدم القدرة على فهم حقيقة الواقع المعيش، والاستناد إلى نظريات المؤامرة والأحكام الجاهزة. والشعور بالانهزامية. وتقمص دور الضحية على جميع المستويات.
قراءة في كتاب: الجهاد والموت – أوليفييه روا
تقدم الباحثة اللبنانية في علم الاجتماع –عضو هيئة التحرير بمركز المسبار للدراسات والبحوث- ريتا فرج قراءة في كتاب الجهاد والموت (Le Djihad et La Mort) للباحث الفرنسي المتخصص في الإسلام السياسي أوليفييه روا ، حيث يحلّل المؤلّف الأسباب والدوافع التي تحمل قسماً من «أبناء البلد»، معظمهم من الجيل الثاني للمهاجرين ومن المتحوّلين إلى الإسلام، في فرنسا والغرب عموماً، على الانضمام إلى “داعش”. ما يجمع بين هؤلاء هو البحث عن قضيّة، والتمرّد على المجتمع والأهل، ورفض النظام. وليس للإرهابيين قاعدة شعبية بل هم هامشيون في الأحياء والضواحي حيث يعيشون منفصلين عن المجتمع. ويعرض الكتاب مسارات معظم الذين نفّذوا عمليات إرهابية في فرنسا وأوروبا، متوقّفاً عند الأساليب الماهرة التي يستخدمها “داعش” في استمالتهم.