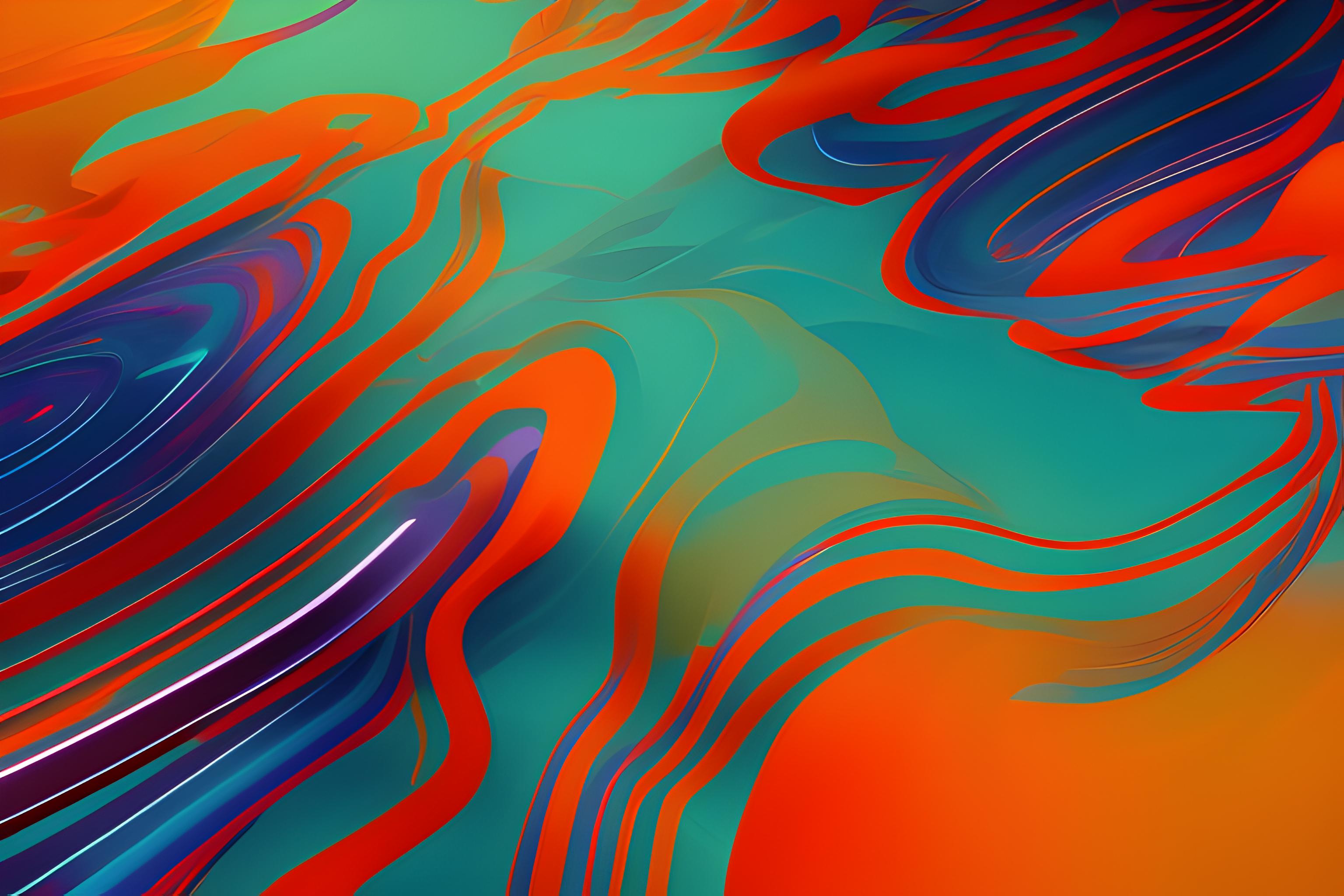انطلقت في غمرة تداعيات الانتخابات الرئاسية الأميركية، وأحداث يوم 6 يناير (كانون الثاني) الصادمة، الإدانات المتلهفة لتأكيد استثنائية “اقتحام الكابيتول هيل”، أو نظرات شماتة اعتبرته سدادَ دين، وآخرون بالغوا فرأوا فيه نعيًا للديمقراطية، وآخرون زمّوا شفاههم بحزن وقلق؛ معترفين بأنّ الواقع معقّد. ولكلِ هؤلاء موقفٌ يمكن النظر إليه بتفهّم. بيد أنّ ما استوقفني، هو التنظير للحدَث على أنّه “إرهابٌ محلي”.
ارتفعت في الإدارة الأولى للرئيس باراك أوباما، نغمةٌ تقول بأفول الإرهاب الإسلاموي، ولمّا جاءت احتجاجات 2010 العربيّة، تحوّلت النغمة إلى لحنٍ تام، وما إن قُتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أبوت آباد (2011)، إلا وصار اللحن أغنية؛ تَشارَك فيها الباحثون المتحلِّقون حول مراكز صناعة القرار الأميركي؛ والسياسيِّون الذين وجدوا في ذلك ذريعة لتخفيض ميزانية الصّرف على بنود مكافحة الإرهاب؛ والإخوان المسلمون؛ وراكبو “موجة الثورات”.
لم يمض وقتٌ طويل حتى استطاعت الجماعات الإرهابيّة إثبات أنّها حيّة وباقية. وأنّ ما أفل؛ هو الأملُ في مستقبل مستقر أو تنميَة حقيقية، وأنّ إدارة أوباما تخلّت عن واجبها؛ فأيقظَت الغول/ الوحش، وتركت المنطقة بين يديه بلا سلاح؛ فانسحبت من العراق بعد تأجيجه.
نتج عن هذا تعقيدات كثيفة، أبرزها يتعلّق بداعش؛ حاولت الاستراتيجيات اللاحقة التعافي منها، ولكنّها ظلّت أسيرة لإغواء نِتاج أفكار الأفول المتمثلة في الخلط بين (الإرهاب والتطرف)، وظهور تنظيرات باردة حول التطرف العنيف، التطرف اليميني، والإرهاب، حتى ظهر ما تندّرنا بتسميته “الإرهاب الوسطي المعتدل”، وفوق هذا، طغيان مدارس تبرير الإرهاب، بذكاء، وربما دون قصد.
غيّرت دوريّات أميركية تَخصّصت في مكافحة الإرهاب، تسميَة العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 في مصر؛ من وصفها بعملياتٍ “إرهابيّة”؛ إلى مسمّى “العنف السياسي”.
مرّ الأمر حينها بصمت وهدوء، ولكنّه عكس حقائق متناقضة تعيشها هذه الدراسات النقدية للإرهاب، إذ ينمو في داخل لاوعيها أمران: الأوّل: يتخيّل أن الإرهاب يمكن أن يتحوّل إلى تمرّد، أو عنف سياسي، في لحظةٍ؛ لا بسبب تغيّر الفاعل، وإنما بسبب تغيّر موقف الدارس من حاكمٍ ما. الثاني: تتحوّل فيه المطالب ذات الشبهة السياسية إلى مسوِّغ (لتبرير) الإرهاب.
ولسنوات لاحقة؛ حافظت جماعات إسلاموية متطرّفة على نفسها، بعيدةً عن قوائم الإرهاب الأميركيّة، باستخدام خطابات سياسية تستغل ثغرات مطلبية، وأخرى فيها نفس إصلاحي مزعوم. ولكنّها في الأساس، اعتمدت على التغذّي على الخلط المقصود؛ بين الإرهاب وغيره من أشكال (عدم الرضا السياسي).
ثارت في سنوات لاحقة، نقاشات عن جدوى ملاحقة الإرهاب في بيئة سياسية هشّة، ولكنّ كل هذا الخط، وصل إلى صخرة كؤود لم تكن متوقّعة، قمعت الأفق التبريري وسدته؛ بسبب الخطر الكبير الذي أظهرته الظاهرة الداعشية المرعبة وعقابيلها، والعائدون إلى أوروبا وأميركا من سوريا والعراق، فتراجعت إلى الوراء كل التنظيرات التبريرية وانحسرت، وبقيت في السطح رؤية حاسمة: كل تيار سياسي يستند إلى مبادئ فوضوية ترفض سلطة الدولة، أو عقيدة دينية تبرر القتل لأسباب دينية، فإنّها تقع في دائرة الإرهاب؛ الذي يمثل القضاء عليه أولويةً للبشر وللعالم. وهذا اختصار مخل؛ لكنّه يستحضر موجات الإرهاب على مسارها التاريخي التراكمي: أناركيةً (فوضوية)، تلتها يسارية تمرّديّة، ورثتها موجة دينية، وانتهت إلى الظاهرة المعقّدة الأخيرة التي استغلّت الموجات كلها.
بالعودة إلى اقتحام الكونجرس الذي وصفه الرئيس المنتخب، جو بايدن، بأنّه إرهاب محلي، ثمة أسئلة تستحقّ التفكير:
هل يعكس التصنيف، اتجاهًا يميّع النظر إلى الإرهاب والتطرّف؟ أم إنّه يستجيب لتطورات جديدة؛ تتعلّق بمجموعات اليمين المتطرّف، التي تبرر وجودها بوجود اليسار المتطرّف؟
هل منح التوصيف حجّة مضادة: الديمقراطية تموت في بلادها، ويتم استخدام الإرهاب كسلاحٍ في التنافس السياسي: إذ يتهم الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)؛ الكثير من خصومه بالانتماء لحركة أنتيفا Antifa: The Anti-Fascist، التي اقترح تصنيفها إرهابية في يونيو (حزيران) الماضي؟
هل يمكن تصنيف (تمرد، مظاهرات، أحداث شغب، تعدٍّ على مبانٍ حكومية)، على أنه “إرهاب”؟
هذه أسئلة جدلية، ولكنّها موضوعية.
ثمة أزمّة تعيشها أميركا، ولا شك أنّها ستتعافى منها؛ لأنها أمة عظيمة تجيد رسم دربها بعناية، عبر استراتيجيّاتها المتعدّدة: سواء في مسار المساءلة، أو في طريق الحوار. ولكنّ الطريق، أيًّا كان، يجب أن لا يتضمّن تسييس ملف الإرهاب مجددًا؛ خاصةً في ظلّ التعقيدات التي ستُحدثها الإدارة الجديدة، في ملفات (الحرية) و(الحقوق)، وانعكاساتها على العالم، وعلى منطقة الشرق الأوسط وروسيا بالتحديد.
تداول كثيرون أنّ أحداث 6 يناير (كانون الثاني) السوداء؛ لطّخَت روح التعافي، وعرقلَت المسيرة التي ينتوي سيرها الرئيس جو بايدن؛ المتعلّقة بقواعد إعادة البناء لصورة أميركا. ولكنّ ما يجب أن يتحدّث عنه المهتمون، هو ضرورة ألّا تتحوّل هذه الأحداث إلى فخّ يضلل الناس عن كارثة 11 سبتمبر (أيلول)، أو داعش، ويغبّش الوعي عن التطرّفات التي لم يتم حسمها، ولا تزال تغذّي سلسلة من تطرفات أخرى.
في خبرتنا في الشرق؛ قامت نظرية وقف الإرهاب في ستينيات القرن المنصرم، على فرضية أنّ الإرهاب يتغذى على الاهتمام به؛ فيكون تجاهله هو المسلك الأفضل لوقفه، وربما يُفسّر ذلك أنّ غالبية العمليّات الإرهابية حتى التسعينيات، كان مسار الإعلان عنها، محدَّدًا بأنّ مرتكبها مختلٌ عقلي. يفيد هذا النمط؛ في مجتمع ترسّخت فيه فكرة الدولة؛ بحيث يتمترَس الإرهاب فيه حول قضيّة مطلبيّة أو عرقيّة أو سياسيّة، ولكنه حينما يرتبط بمجال جغرافيّ فيه أمراض تاريخيّة وحداثويّة، وعداء للدولة ومؤسساتها وللحدود الوطنية والسيادية؛ فإنّ الأمر يصير معقّدًا ويحتاج إلى تحليل متعدّد الجوانب، يأخذ بالاعتبار هذه العوامل وغيرها.
بدأ الإرهاب الذي نعانيه بتنظيرات سيد قطب؛ عبر تجنيد طليعةٍ تنظيمية تكفّر الدولة، وتتبنّى مفاصلةً مع المجتمع، وعُزلة شعورية عن أهله، ثم تُكفّر المجتمع، فتهجره لتُكوّن مجتمعها الخاص وشرعيّتها الخاصة، ثم تبدأ بقتل مجتمعها القديم، الذي تصفه بالجاهلية، وتحاول سرقة دولته، باغتيال قائدها، والانقلاب عليه، وتسييس الدّين، وتديين السياسة، والدعوة إلى جديد منقطع تماماً عن كل تقليد، فلا يتم استحضار أنموذج الصحابة ومجتمعهم هنا، إلا في مسارٍ محدد: إكساب الطليعة المزعومة شرعيةً توازي شرعيّة النبي وصحابته؛ أي شرعيّة العصمة.
ولمّا بدأ تلاميذ سيد قطب بتطبيق فكرته، وانتهوا إلى تكفير المجتمع، ومحاولة اغتيال قادته، لم ينجحوا إلا في إيران مع ثورتها عام 1979، وكان نجاحهم ناقصًا. ولما حاولوا تقليد هذا النجاح في مصر؛ باغتيال الرئيس أنور السادات، فشلوا. ولمّا راجعوا حادثة جهيمان العتيبي عام 1979، تولّد لديهم يقين بأنّ الدّول ومجتمعاتها، يستمدّان رسوخ أقدامهم من رابطةِ الشرعيّة الدوليّة، وانصرف تقديرهم إلى أنّ هذه الرابطة، ليست سوى عُظمَى الدول؛ فتحوَّل شِقّ منهم يهدّد الدول الكبرى ويسعى لإرهابها، ولكنه احتاج إلى فصائل عدّة؛ فاخترع بديلاً للمجتمع الجاهلي؛ فشرعيّة المجتمع الجاهلي تعمل على قتل المسلمين فحسب، بينما الجاهلية الجديدة للمسلمين، في تصوّر قطب وأتباعه، مضاعفة عن الجاهلية الأصلية. تبعاً لذلك أُدخلت تحويرات، بمهاجمة ما أسماه «القطبيون» العدو البعيد، وجاءت على أساسه تقسيمات للدّيار؛ ديار حرب تعمّ العالم في تصورهم، وديار إسلام لا وجود لها إلا في عقول المتطرّفين. وتمّ إدراج ذلك في فكرهم تحت أبواب الحرب المقدّسة، التي يصرّ عليها «الجهادويون»، بالاندفاعة القطبية لتأكيد أنها فرع من «جهاد الطلب» المزعوم!
ليست المرة الأخيرة… ثم كان ماذا؟
إنّ التحفّظ على وصم فعلٍ عنيف بالإرهاب، ليس تمجيدًا له، ولكنّه ضبط للمصطلح. يوازي هذه الحساسيّة في المسار الفقهي العربي؛ استفزاز الفقهاء من الخلط في الحديث عن الجماعات الإرهابية، في وصفها مثلاً: بالبغي، عوضاً عن توصيفات أدق، لاختلاف الأحكام الفقهية المتعلّقة بالمصطلحات، فهذا لا يعني أنّ البغي جيّد ومفيد، ولكنّه يقيّد الاصطلاح بالفعل.
إن إضافة الإرهاب الحديث إلى فكرة التمرّد، وإلى منافاة الدولة ومعاداتها، ورفض التضابط الاجتماعي، يُعدّ فكرةً حركيّة تتغذّى من معين فكري يشترك فيه كثيرون، ولكنّها تصب كل هذا في مصبٍ واحد يمكن الإمساك بمخرجاته بسهولة: فهي ضد الدولة بإطلاق، وضد التسامح بتمام، ودعوة للقتال المفتوح، أما ما يغيب، فهو إرادة تبرير هذا التطرّف، والتي لا تنتهي لدى كل المتطرفين: إسلامويّين، ويسارويّين؛ كلٌّ يستغلّ الثغرات التي ينتجها إهمال تعريف الإرهاب، وإغفال شروطه، والتعامي عن العلامات، والتغاضي عن المخرجات.