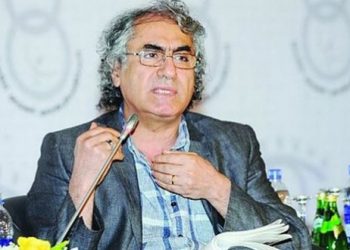عمار علي حسن∗
لم تكن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للأزهر الشريف، وكذلك لقاؤه بابا الكنسية الأرثوذكسية بحدث عابر، وظني أن نتائج عميقة ستترتب عليه في قابل الأيام، منها ما يتعلق بطبيعة الخطاب الديني الرسمي في المملكة، ومنها ما يرتبط بإدراك الطريقة المثلى التي يواجه بها التطرف والتشدد والتزمت الذي يؤسس أيديولوجيا لسلوك عنيف ينتهي بالإرهاب، وثالث يتمثل في الرسالة التي يبعث بها الملك إلى مؤسسات وشخصيات تنتج الخطاب الديني في المملكة وخارجها.
فابتداء، عاشت السلطة الرسمية في المملكة العربية السعودية، منذ إنشائها وحتى هذه اللحظة، حريصة على إبداء انحيازها لتصور ديني محدد، أنتج بمرور السنين رؤى وأفكاراً وخطابات وفتاوى ووعظاً امتد تأثيره إلى العالم الإسلامي كله، إثر تبني شخصيات ومؤسسات في دول عدة لمثل هذا التصور وتلك الطريقة في التدين، التي تنتهجها المؤسسة الدينية السعودية، وتحرص عليها، وتقدمها للمسلمين بطرق وأنواع شتى، تتجدد أشكالها وآلياتها باستمرار، لكن مضمونها يتسم بالثبات النسبي.
وراعت السلطة السياسية الرسمية طيلة الوقت مصالح ومواقف المؤسسة الدينية الرسمية، والشخصيات العادية من الدعاة والوعاظ والخطباء والأئمة، فكانت الأولى مقيدة بتصورات الثانية، والثانية محددة بخيارات الأولى، وهو تقييد لا يقوم في الحالتين على الإجبار، إنما على التفاهم والطوعية، وتبادل المصالح.
ولأن المؤسسة الدينية في المملكة تؤمن بأن “ما لا يزع بالقرآن يزع بالسلطان” فليس بوسعها إلا أن تتفاعل بشكل واضح وجلي مع أي خطوة يتخذها الملك، ويكون تفاعلها إيجابياً، وتترتب عليه تصورات وأفعال جديدة، ستمتد آثارها أيضاً إلى العالم الإسلامي بأسره.
من هنا، فإن زيارة الملك سلمان للأزهر ستخلق لدى المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة انطباعاً قوياً بأن الانفتاح على الأزهر، كمؤسسة دينية تعليمية ودعوية لها تأثيرها واسع النطاق في حياة المسلمين المعاصرين، يتطلب منها هي أيضا انفتاحا عليه، بما يعني التفاعل الإيجابي والخلاق مع مساقاته العلمية والتعليمية التي تتسع لمسارات وتصورات دينية متعددة، تعتمد على مرجعيات متنوعة، وتدفع على يد بعض شيوخه في اتجاه تجديد الخطاب الديني.
ويأخذ هذا المسار خطوة أوسع بعد أن قابل الملك سلمان، لأول مرة في تاريخ المملكة، بابا الكنيسة، وهو رأس المسيحيين الأرثوذكس في العالم بأسره، والذين يشكلون الكتلة البشرية والدينية الرئيسة من مسيحيي الشرق. فهذا لقاء يتم على قاعدة من التسامح الديني، أخذت تتصاعد بشكل ملحوظ في شبه جزيرة العرب، مهد الإسلام، خلال العقود الأخيرة، وهو توجه بات ضرورياً مع الاتجاه إلى حوار متواصل بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، في ظل الإيمان الراسخ بالتنوع الخلاق، والتعدد الثقافي والديني، بوصفهما من أسس الدولة الوطنية الحديثة.
وما سبق من تأثير لقاء الملك مع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة على التسامح وتنوع الخطاب الديني، سيكون له مردوده على مسألة محاربة الإرهاب، التي لا يجب أن تقتصر بأي حال من الأحوال على الجوانب الأمنية والعسكرية والمعلوماتية، إنما هي معركة فكرية بالأساس، ولا سبيل إلى الانتصار فيها إلا إذا تم الاقتناع بهذا، ثم الانطلاق إلى بناء تصور فكري متكامل يواجه التطرف الديني من منبعه، ويحاصره، ويجهز عليه أو على الأقل يقلل من أخطاره، ويهبط بها إلى الحد الأدنى من الإيذاء.
وهذه المعركة الفكرية تقوم على تفكيك خطاب المتطرفين، ثم بناء خطاب جديد، ينهل من منبع مقموع أو مسكوت عنه في تاريخ الفكر الديني الإسلامي أعلى من شأن العقل، وآمن بالتعدد، ورفع من قيم التسامح والمحبة والخيرية والرحمة، وفي الوقت ذاته يستفيد من عطاءات فكرية معاصرة، سواء تلك التي توظف معطيات مختلف العلوم الإنسانية في تطوير الفهم الديني للمسلمين، أو التي تنظر إلى ما جرى عند أتباع ديانات أخرى ومنها المسيحية، التي تمكنت عبر الإصلاح الديني من تجاوز الآثار السلبية للتزمت الديني على المجتمعات البشرية، وفي مطلعها العنف والإرهاب.
وبالقطع، فإن كل هذا لن يتحقق بسرعة ويسر بمجرد زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للأزهر
وكذلك لقاؤه بابا الكنيسة، فهذه بداية لا بد من أن تتأسس عليها تصورات وإجراءات يتم تطبيقها من دون انقطاع، وتنهض بها مؤسسات وشخصيات، وتشارك فيها السلطات الرسمية وقوى المجتمع الأهلي والمدني، وتتسع بمرور الوقت الدوائر الاجتماعية المعتقدة في جدوى السير على هذا الدرب الطويل.
∗ كاتب وباحث مصري في علم الاجتماع السياسي.