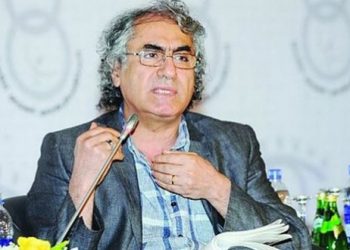-1-
يعرف ستيفن هوكنج كعالم كبير في الفيزياء النظرية بدراساته المرموقة في علم الكون، وأبحاثه في الديناميكا الحرارية وحول الثقوب السوداء، وكتاباته في التسلسل الزمني. ولكنه يعرف أيضًا كملحد كبير، وربما كانت شهرته الواسعة كعالم ترجع جزئيًا إلى شهرته كملحد.
لا يدهشني إلحاد هوكنج في حد ذاته، فالعالم يضم الكثير من علماء الفيزياء الملحدين والمؤمنين على السواء، بل يدهشني طريقة تناوله لموضوع الإلحاد، التي تبدو مشربة بحماسة أيديولوجية وشبه إيمانية. وفي الوقت ذاته تبدو متعجلة بعض الشيء بمقاييس الثبوت العلمي، التي لا تقبل بما دون اليقيني التجريبي، ولا تميل إلى توظيف نتائجها في إثبات قضايا لا تشتغل عليها التجربة، وتخرج من ثم عن مجال العلم أصلًا.
يكاد هوكنج يعيدنا إلى أجواء المعركة بين العلم والكنيسة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث ساد الاعتقاد في قدرة شمولية مطلقة للعلم على الإحاطة بالعالم والكائن البشري، تستطيع الوصول إلى قانون واحد يفسر كل شيء. كانت معركة العلم جزءًا -هو الأهم- من الموقف التغييري الواسع الذي فرضه قانون التطور، والذي كان في صدامه مع الدين موجهًا بالأساس إلى السلطة المعرفية للاهوت التاريخي (التي تقحم نفسها على دائرة العلوم الطبيعية) أكثر مما كان موجهًا إلى فكرة الدين المطلقة في ذاتها (بما هي فكرة تنتمي إلى الميتافيزيقا).
في القرن العشرين، وبعد ظهور النسبية ونظرية الكم، كان العلم قد انتقل إلى مناطق عملانية وأكثر طموحًا، وصرنا نستمع إلى نغمة أكثر تواضعا في التعاطي مع فكرة القدرة المطلقة للعلم. بدا كأن العلم، وقد مضى بعيدًا في طريقه، لم يعد يحفل كثيرًا بفكرة المواجهة مع اللاهوت، الذي صار بدوره أقل اعتدادًا بذاته. لم يعد ثمة مواجهة بمعنى المعركة بين اللاهوت والعلم، أو لم يعد للمواجهة توترها المبكر، حيث كان اللاهوت يخوضها من موقع السلطة.
-2-
لا يخوض هوكنج معركة مع الدين التاريخي (سلطة الكنيسة أو معارف الكتاب المقدس) بل مباشرة مع فكرة الله: ليس ثمة حاجة إلى هذه الفكرة لتفسير النظام الدقيق للكون، فليس هناك في الواقع كون واحد بل أكوان متعددة “وكما فسر دارون ووالاس كيف أن التصاميم الإعجازية في الكائنات الحية يمكن أن تظهر بدون تدخل من كائن أعظم، فإن مفهوم الأكوان المتعددة يمكن أن يفسر دقة القوانين الفيزيائية دون حاجة لوجود خالق مدبر صنع الكون من أجل مصلحتنا. فبسبب قانون الجاذبية يستطيع الكون أن يخلق نفسه من لا شيء. الخلق الذاتي هو سبب أن ثمة شيئًا بدلًا من لا شيء. هو سبب وجود الكون ووجودنا”. (التصميم العظيم، ص165).
لكي تستطيع الجاذبية خلق الكون ذاتيًا، تفترض فيزياء هوكنج وجود احتمالية رياضية قابلة للتحقق بالصدفة العشوائية مع مرور الوقت الأزلي، عند وجود عدد من الأكوان قدره (10) أس (500) (“10” أمامها “500” صفر).
وهي احتمالية يحتاج اختبارها إلى مصادم هيدروني بحجم مجرة حسب راسل ستانارد الفيزيائي البريطاني المعروف.
اعتقد هوكنج أن الافتراض السائد بأن علاقة الأرض بالشمس مصممة على هذا النظام لتأمين متطلبات الحياة البشرية، لم يعد قائمًا بما أن هناك نماذج مشابهة خارج مجال حياة البشر، واعتبر أن هذه المقدمة كافية لترتيب نتيجتين: 1- نفي فكرة الخلق من قبل قوة خارجية مفارقة للطبيعة. 2- إثبات فكرة الخلق الذاتي من قبل الطبيعة.
أعلن هوكنج موت الفلسفة، ونقل اختصاصها إلى العلم، حيث يمكن للفيزياء أن تقدم قانونًا كليًا يفسر كل شيء. لكنه كان في الواقع ينتقل من مربع العلم إلى مربع الفلسفة. وفيما قصر في استيفاء شروط المربع الأول (حيث افترض صحة قضية غير تجريبية)، لم يكن مزودًا بأدوات المربع الثاني (حيث قفز إلى استنتاجات لا تتولد عن المقدمة بالضرورة). لذلك -وكما صرح فيزيائيون وعلماء معاصرون ليسوا جميعًا مؤمنين- لا تمثل نظرية هوكنج طرحًا علميًا بالمعنى الضيق، بل مجرد حدس ميتافيزيقي غير قابل للتجربة، أو مجرد موقف أيديولوجي غير منتج في قضية علمية. (راجع مثلًا تعقيبات كل من راسل ستانارد، وجون بولكنجهورن، وروجرز بنروز، وبول يفنز، وماسيلو جليسر، وبيتر ويت، وكريج كالندر، وجون بترورث، وبروفيسور الرياضيات جون لينوكس).
-3-
يبدو إلحاد هوكنج تقليديًا بشكل مفرط، فهو لا يزال يخوض في الجدل حول سؤال “البرهنة على وجود الله” وهو سؤال ينتمي ببنيته التفكيرية إلى “الذهنية الأنطلوجية” القديمة التي تشكلت في ظلها الثقافة التوحيدية، والتي يتشارك فيها الدين مع المثالية اليونانية. التطورات العقلية الجذرية المصاحبة للحداثة أسفرت عن تحولات ذهنية بنيوية، انعكست على منهجية التعاطي مع “المسألة الدينية” التي لم تعد تختزل في سؤال البرهنة.
وهو يقحم العلم في قضية ليست فوق تجريبية فحسب، بل فوق برهانية أصلًا. ويعاود الحديث في دليل “النظام” الذي قتل بحثًا في مواجهة العقل الديني. يتوافق العقل الديني مع العقل العلمي التقليدي في القول بنظام مضطرد للطبيعة. الفارق بينهما ينحصر في نقطة جوهرية هي أن: هذا النظام بحسب الأول مخلوق بفعل خالق مفارق للطبيعة، أي للكون أو للأكوان، لأن الأكوان حين تتعدد لن تخرج عن الطبيعة. ولذلك فإن أي اكتشاف علمي في الطبيعة هو اكتشاف داخل المخلوق.
وبالتالي لا يمكن لأي كشف علمي في ذاته أن يكون برهانًا على نفي فكرة الخلق. ومن هنا لا معنى للمقابلة بين الله والطبيعة، فالمسألة لا تنتهي عندما تقرر في نوع من التبسيط، أن سبب الظاهرة هو الطبيعة ذاتها. البحث في نقطة الخالق المفارق -إذن- هي محل النزاع، وباعتبارها كذلك يلزم أن يتم البحث من خارج الفيزياء أي من نقطة أعلى تشرف على السؤال من خارجه. وهذا ما يكاد ينتهي إليه العقل العلمي المعاصر وهو يعيد صياغة العلاقة بين الدين والعلم في معادلة ذات طرفين: ليس ثمة برهان مستمد من الطبيعة له أدنى قيمة في البرهنة على وجود الله، ولا يمكن أن يكون هناك برهان مستمد من الطبيعة ينفي وجود الله.
وإلى ذلك فالعقل الديني نفسه لا يختزل آليات البرهنة على وجود الله في فكرة النظام، وهو يفهم هذه الفكرة في إطار أعم هي القدرة المطلقة لله التي لا يحدها أي قانون. ولذلك فهو في شق منه ينكر مبدأ السببية أو العلية الآلية في الطبيعة باعتبارها افتئاتًا على الاقتدار المطلق لله في الكون. وهكذا فكل انتظام في قوانين الطبيعة يشير إلى إرادة الله، وكل اضطراب في هذه القوانين يشير إلى قدرة الله الطليقة عن القوانين.
ومن هنا فإن اكتشاف الفيزياء الذرية وما بعد الذرية (النسبية ونظرية الكم)، وإن أدت إلى تغيرات جذرية في أطر التفكير العام، هزت مفاهيم المنطق التقليدي، وكشفت عن مظاهر جديدة لأزمة الدين التاريخي مع الواقع، إلا أنها فتحت الباب من جديد أمام التأويلات الدينية كي تستعيد فكرة الاقتدار المفارق (الإلهي) لتفسير اللاحتمية أو عدم انتظام السببية في بعض الظواهر مثل حركة الإلكترون.
يستند حضور الدين في الواقع إلى فكرة الإيمان، من حيث هو موقف معرفي فوق حسي، أي فوق برهاني، وفوق تجريبي، وهو ما يجعل فكرة الله/ القيم فكرة مطلقة، خارج نطاق الحسم الفلسفي (العقلي) أو العلمي (الفيزيائي).
في الواقع، لا يمثل إلحاد هوكنج التقليدي “العلمي” خطرًا حقيقيًا على الدين “النظري” قياسًا إلى إلحاد نيتشه الروحي الخشن. شن نيتشه هجومه على الدين بعد أن وضعه مقابل الحياة. اعتبر الدين مسؤولًا عن تكريس الأخلاق التي هي تلويث للغرائز بقيم مضادة للحياة. الأخلاق الدينية أو المثل الأعلى النسكي الذي يقوم على فكرة الخير والشر، وفكرة الحقيقة استطاعت التسرب إلى الروح الإنساني وتركيبته الذهنية، بحيث لم يعد يستطيع التفكير إلا من خلالها حتى لو أراد الخروج عليها أو توجيه النقد إليها. وهو يسكن في الفلسفة والسياسة والاجتماع والفن والعلم، واعتبر نيتشه أن جميع الأفكار الحداثية مثل “المساواة، والحس الديمقراطي والضمير المهني والحياد العلمي هي أفكار ملتبسة بالمعنى الكهنوتي وحتى الإلحاد نفسه” ما هو-على الأرجح- سوى واحد من الأطوار الأخيرة من تطوره، وأحد أشكاله النهائية. والإلحاد -حسب نيتشه- ليس كافيًا للخروج من الدين، بل يلزم أيضًا الكفر بالأخلاق في حد ذاتها كمبدأ، والكفر بالحقيقة كمطلوب أخلاقي في ذاته. ومن هذه الزاوية يتشارك العلم مع الدين (المثل الأعلى النسكي) “فهما قائمان على أرضية واحدة. على الإسراف نفسه في تقدير الحقيقة (بشكل أصح على الإيمان نفسه بأن الحقيقة شيء لا يقدر، شيء لا يقبل النقد)”. (جنياجولوجيا الأخلاق – المقالة الثالثة).
ربما كان أجمل ما كتب هوكنج في بحوثه الواسعة في علم الكون هو قوله: “لن يكون هناك الكثير من الكون إذا لم يكن موطنًا للأشخاص الذين تحبهم”.