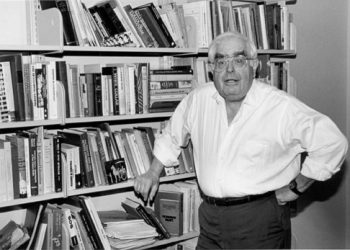-1-
نحتفظ في أذهاننا بمعنيين مباشرين للأخلاق والدين، لكن بمجرد أن نشرع في التساؤل عن العلاقة بينهما، ينفتح النقاش من جديد حول مفهوم الأخلاق ومفهوم الدين كليهما.
في المنظور الديني التقليدي ليس للأخلاق وجود مستقل عن الدين.
الدين مصدر الأخلاق، وهي جزء منه لا يستغرق بنيته الكلية، والأخلاق أخلاق أي خيرة لأن الله وصفها بذلك، وليس باستحسان العقل أو تقرير العرف. ولذلك فهي محكومة بالدين لا حاكمة عليه، بمعنى أنه لا يصح محاكمة الدين إلى مبادئ مستقلة عن منطوقه، أو بعبارة مكافئة لا يجوز التساؤل عن أخلاقية الأحكام الدينية. فمثلًا حين ينص الدين على إباحة الرق فهذه الإباحة أخلاقية في ذاتها، أي لا يجوز تقييم خيريتها بمعايير خارجية ( فوق دينية). وينطبق ذلك على بقية الأحكام التي تبدو صادمة للحس الأخلاقي الخالص مثل أحكام التحريض على العنف، أو أحكام التفريق بين البشر في حرمة الدماء بسبب الدين ( لا يقتل اليهودي بغير اليهودي قصاصًا، ولا يقتل المسلم بغير المسلم قصاصًا).
في المقابل يعتبر الفكر الوضعي أن الأخلاق – كالدين- ظاهرة اجتماعية تاريخية نشأت وتطورت داخل العالم بفعل الإنسان. وهي رغم تقاطعها مع الدين التاريخي تحتفظ بوجود مستقل عنه، حيث الدين بالأساس بنية طقوسية لاهوتية؛ ثمة أخلاق رفيعة في سياقات غير دينية، وهي تغيب أحيانًا في سياقات دينية، ولذلك يمكن الحديث عن أخلاق دينية خاصة بكل ديانة، ويمكن محاكمة هذه الأخلاق الخاصة إلى الأخلاق الكلية.
-2-
حسب الأنثروبولوجيا الكلاسيكية ( التطورية) بدأ الدين كحالة طقوسية خالصة قبل أن يتحول إلى نظام شامل يضم اللاهوت والأخلاق. وهي فرضية مناقضة للتصور الكتابي الذي ينظر إلى الدين كمطلق كلي ولد نهائيًا ولا يرد عليه التطور، وهو ما ينطبق على الأخلاق بوصفها شقًا من الدين.
لكن الثابت – بغض النظر عن هذه الفرضية الخلافية- هو أن الارتباط بين الأخلاق والدين يرجع إلى مراحل سابقة عن ظهور النسق الإبراهيمي الذي دشنته اليهودية. وهذا واضح على سبيل المثال في الديانة المصرية القديمة ذات الطابع الأخلاقي الصريح.
ومنذ الفلسفة اليونانية جرى تفكر الأخلاق بالتماس مع الدين. اعتبر سقراط أن الإيمان مكمل للأخلاق، لكن الأخلاق لا ترتكز عليه. مصدر الأخلاق هو الحكمة، التي تؤدي إلى الفضيلة بوصفها الطريق الموصل إلى السعادة، وهي الغاية النهائية للإنسان. وجعل أفلاطون للدين مكانة في الأخلاق أكثر مما فعل سقراط، فالفضيلة لا ترجع إلى الحكمة بل إلى بصيرة ملهمة مشربة بنفس ديني. وقف أفلاطون على فكرة الحساب الأخروي، حيث يقضي الإنسان ألف سنة في العالم الآخر منعمًا أو معذبًا جزاء ما قدمه من خير أو شر. ومع ذلك ظلت الأخلاق عند أفلاطون تقوم – كما عند سقراط- على فكرة استهداف السعادة، وليس إرضاء الآلهة.
أما أرسطو فقدم تأصيلًا عقليًا خالصًا للأخلاق لا يتكئ على الدين رغم إلمامه بالمفهوم الإلهي. السعادة هي الخير المطلق، أو الخير النهائي المطلوب لذاته، ونحن نطلب الفضائل من أجلها. تستطيع الفضائل تحقيق السعادة بما هي التوازن الذي يهيئ لقيام الإنسان بوظيفته ككائن بيولوجي اجتماعي عقلي معًا، بوجه عام لم يكن الدين في السياق اليوناني بعيدًا عن الأخلاق، ولكنها ظلت مبحثُا ومطلوبًا اجتماعيًا يصدر عن العقل.
ثمة تقاطع بنيوي عريض بين الدين والأخلاق. وبصرف النظر عن كونه تاريخيًا أو مطلقًا، يكشف هذا التقاطع عن نتائج إشكالية تظهر في صور من التعارض الصريح بين نصوص دينية ثابتة وقيم الأخلاق الكلية، وهو ما يضع الديانة التاريخية أمام مشكلة التناقض مع جوهرها الأخلاقي المفترض، أو أمام مشكلة الشك في صحة تمثلها الكلي للدين المطلق بما هو جوهر أخلاقي.
-3-
لكن في ظل هذا التقاطع أيضًا، يقوم الدين والأخلاق بعمليات إسناد متبادلة على مستوى التأسيس النظري. تقليديًا ولفترة طويلة ظل الدين حاملًا تاريخيًا للأخلاق. لكن في القرن الثامن عشر، عندما كان الدين في موقف دفاعي صريح أمام ضغوط التطور العقلي، قدمت الأخلاق علي يد كانط إسنادًا تأسيسيًا للدين.
حسب كانط لا يستطيع العقل النظري برهنة الدين لعجزه عن تجاوز حدود التجربة، ولكن الأخلاق بما هي عقل عملي تستطيع إثبات حرية الإرادة، وخلود النفس، ومن ثم وجود الله. في البداية ” نحن لا نعتبر الأفعال ملزمة لأنها فروض إلهية، بل هي تعتبر فروضًا إلهية لأننا نشعر بأننا ملزمون بها في داخلنا”. تقوم الأخلاق على فكرة الواجب. ولأن المكافأة على فعل الواجب لا تتحقق كاملة في الحياة الحاضرة تفرض العدالة وجود حياة ثانية كي يكافئنا الله على الفضيلة بالسعادة. هنا يبدو الله جزءاً من نظرية الأخلاق، جزءاً ضروريًا كي تكون الأخلاق ممكنة.
لكن الأخلاق بعد أن لعبت دورها في إثبات وجود الله ستعود فتكشف عن مصدرها الإلهي، فشعورنا الأصلي بالإلزام الأخلاقي هو جزء من طبيعتنا التي خلقها الله. هذا الشعور بالنسبة لكانط هو جوهر الدين الذي يكاد يستغرق معناه، فأهم ما في الدين ليس الطقوس ولا تفاصيل اللاهوت، بل فعل الواجب استجابة لصوت الضمير الذي هو صوت الله.
بحصره التقريبي لمعنى الدين في الأخلاق، كان كانط يقدم مفهومًا عقليًا اختزاليًا للدين لا يقبله اللاهوت الكتابي المؤسسي. ولكنه كان لا يزال يتعاطى مع المسألة من داخل الإطار التقليدي للجدل بين اللاهوت والميتافيزيقا. فالفكرة المطلقة ظلت هناك، وظلت الأخلاق كالدين إلهية قادمة من خارج الاجتماع.
-4-
في القرن التاسع عشر ستنتقل المسألة – على يد فيورباخ- إلى منطقة قراءة مغايرة؛ الدين ليس أصل الأخلاق بل الأخلاق هي أصل الدين، وكلاهما بشري صادر من داخل الاجتماع. ينطوي التكوين الإنساني بطبيعته على الأخلاق ( العقل والإرادة والمحبة)، وهي أعلى ما في الإنسان، أو هي الإنسان في كماله المثالي. لقد نسب الإنسان هذه الطبيعة المثالية إلى قوة عليا مفارقة وأطلق عليها إسم الله، فصارت مطلقة، ومن هنا ظهر الدين في صورته التقليدية } فيورباخ – جوهر المسيحية{.
حسب فيورباخ، الدين مفهوم اجتماعي طبيعي يمكن أن يفتح بابًا للأمل أمام الإنسان، الذي عليه توظيف طاقاته الأخلاقية الطبيعية لتحقيق سعادته الفردية والجماعية، أي لتحقيق ” خلاصه” الاجتماعي، وهو مكافأة الفضيلة التي تنجز داخل العالم وليس في السماء.
ثمة مسافة واضحة بين دين فيورباخ الطبيعي الاجتماعي، ودين كانط العقلي الإلهي، لكن أخلاق فيورباخ ظلت قريبة من أخلاق كانط من حيث احتفاظها بشيء من خصائص المطلق، فهي على الرغم من صدورها داخل العالم عن الإنسان، تنبع من طبيعة ثابتة فيه تشبه الفطرة، وهي تنزع إلى الكمال. لذلك يلزم فهم نقد فيورباخ على أنه موجه إلى الدين التاريخي، أي الدين الطقوسي التشريعي، الذي تكون بفعل المؤسسة، من تراكمات اجتماعية زائدة عن القانون الأخلاقي. لقد نقل فيورباخ المبحث الديني الأخلاقي خطوة واسعة باتجاه الانثروبولوجيا والاجتماع التاريخي، ولكنه لم يقطع كليًا مع الميتافيزيقا.
-5-
على أن تقليص الدين إلى مجرد أخلاق كما فعل كانط، أو تصعيد الأخلاق إلى موقع الدين كما فعل فيورباخ، لم يكن كافيًا لإشباع التمرد العقلي الجامح للقرن التاسع عشر الأوربي، الذي كان يستهدف فكرة المطلق من جذورها.
عبر نيتشه عن هذا الجموح في حده الأقصى وهو يشن حملته الواسعة لا على الدين والأخلاق فحسب، بل أيضًا على الأيديولوجيا ومجمل الحداثة الأوربية التي لم تتخلص بعد من الحمولات المطلقة للقيم.
لم تعد المسألة هي ما إذا كان الدين أخلاقًا أو الأخلاق دينًا، فكلاهما ينتمي لوهم المطلق الموروث والمناقض ” لطبيعة الحياة”. تلك الطبيعة التي يلزم أن تكون هي ذاتها قانون ” الأخلاق” بديلًا عن قانون الخير والشر. حسب نيتشه يعمل الدين على تكريس أخلاق الجماهير الدارجة، وهي أخلاق القطيع التي تذل الجسد وتقهر الدوافع الحيوية وحرية العقل والإحساس بالجمال.
وقف نيتشه على الخصائص الأنطولوجية المشتركة بين الدين والمثالية اليونانية، وشن حملته على الدين عبر الهجوم على أخلاق أفلاطون. وبالنسبة له كان أفلاطون هو من أطلق ” الأضلولة الدوجمائية الأكثر خطرًا والأطول عمرًا في تاريخ الفكر، وهي اختراعه للروح المحض وفكرة الخير في ذاته”، وكانت المسيحية نوعًا من المثالية الدارجة أو ” الأفلاطونية المخصصة للشعب” } ما وراء الخير والشر- تباشير فلسفة المستقبل{.
فكرة الروح المحض الأفلاطوني كفكرة المطلق المفارق الديني، تقابل ” منظورية” نيتشه التي تعني أن جميع القيم نسبية من حيث نشأتها وقابليتها التأويلية، فليس ثمة في الواقع شيء مطلق. لقد عبر الدين عن فكرة المطلق قبل الفلسفة اليونانية، وهي ظهرت في هذه الفلسفة قبل أفلاطون، لكنها في الواقع لم تحظ قبله بتأصيلها النظري الذي منحها هذه القدرة على البقاء في الفكر. الأهم- وهذا ما يرمي اليه نيتشه- أن الدين هو المسئول تاريخيًا عن تعميم وترسيخ وتوريث منظومة القيم السائدة. وهي قيم العبيد البليدة والخانعة التي تنبع أصولها من روح الضعف والضغينة لدى الكهان ( جنياجولوجيا الأخلاق – م ا ف 7).
نقد نيتشه الموجه إلى الأخلاق ينصب على نقطتين؛
الأولى: أنها، كالدين، مطلقة أي قبلية ونهائية.
الثانية: أنها بقيامها على فكرة الخير ضعيفة لا تعبر عن جوهر الطبيعة الحيوانية للإنسان وهو القوة.
لكن نقد الأخلاق يعني محاكمتها إلى فكرة ما، هي بالضرورة مرجعية قبلية ونهائية ذات طابعي قِيَمي، أي مطلقة. كما أن نيتشه يقطع في خصوص الطبيعة الحياوية للإنسان بجوهر أحادي واحد يربط فكرة القوة بالقسوة، وهو قطع ميتافيزيقي غير مبرهن، ينطوي على احتجاج بمحل النزاع.