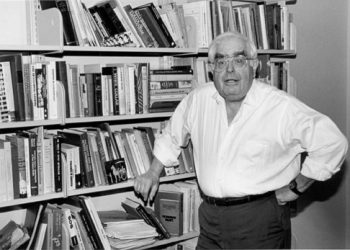-1-
طوال العصور السابقة على الحداثة، حيث فرض الدين هيمنة واسعة على مجمل الثقافة، لم تواجه الديانات التاريخية مشكل تعارض حاد مع “العلم”، الذي لم يكن قد تبلور بعد كمفهوم مستقل عن الفلسفة واللاهوت، يشير حصرًا إلى البحث في الطبيعيات بمنهج التجربة.
ابتدأ ظهور المشكل مع المسيحية الكاثوليكية، التي فرض عليها الدخول في صراع بقاء مع النظام الاجتماعي الجديد، الآخذ في التخلق منذ القرن السادس عشر.
بنهاية القرن التاسع عشر كان الصراع قد أسفر عن تراجع الكنيسة عن موقع الهيمنة الذي ظلت تشغله طوال العصور الوسطى في المجالين العام والخاص.
كشف المنهج التجريبي عن هشاشة الأسس التي بنت عليها الكنيسة سلطتها المعرفية خصوصًا في الطبيعة. وظهر العلم، بمنجزاته التقنية ذات المردود الاقتصادي المباشر، لا كمنافس عصي على المواجهة فحسب، بل كبديل مرشح للحلول محل الدين في المستقبل.
أخذت فيزياء نيوتن تولد وعيًا آلويًا متصاعدًا، وتكرس تغييبًا تدريجيًا للفكرة الغائية (الطبيعة موجهة بغايات من خارجها)، وهو ما تواصل مع الفيزياء الكهربائية والمغناطيسية. وساد الانطباع بقدرة العلم المطلقة على تفسير العالم والإنسان، من خلال قانون كلي يشرح الفيزياء والبيولوجيا والنفس والاجتماع. سيتولى العلم الإجابة عن جميع الأسئلة التي كان اللاهوت والفلسفة يتقاسمان الإجابة عنها، وستنتهي الحاجة إلى الدين.
انتهى كونت إلى قانون موحد لتاريخ الوعي البشري؛ بتطور الاجتماع عبر مراحل ثلاث: الأولى: لاهوتية غيبية تبحث عن تفسير الكون والإنسان من خلال قوة عليا مفارقة. والثانية: عقلية مجردة تبحث عن تفسير العالم والإنسان من داخل العالم والإنسان، وهي مرحلة الفلسفة التي تظل غيبية لكونها لا تستند إلى يقين التجربة. والثالثة: عقلية علمية تقوم على الملاحظة التجريبية بحثًا عن قوانين الطبيعة والاجتماع، وهي ختام التاريخ.
وفقًا لتحليل كونت تنتج الفلسفة معرفة غيبية بما هي ميتافيزيقية، لكنها مع ذلك تمثل نقلة نوعية في تطور الوعي البشري بما هي تفكر من داخل العالم. وكان يفترض من ثم أن يشكل حضورها تحديًا حقيقيًا للدين. لكن المرحلة الفلسفية لم تشهد أي تقلص للظاهرة الدينية، بل على العكس شهدت ظهور الديانات التوحيدية الثلاث. لم تطرح الفلسفة نفسها بديلًا عن الإيمان من خلال تقديم جوابات عقلية عن أسئلة الطبيعة والاجتماع، بل تقاسمت مع الدين النظر في موضوع الإلهي، وتدين قطاع منها، فيما قدم القطاع الآخر إسنادًا عقليًا غير مباشر لفكرة الإيمان بالله.
ومن ثم يصعب اعتبار الفلسفة طورًا مستقلًا بالمعنى الزمني بين اللاهوت والعلم. وإن أمكن النظر إليها مع برتراند رسل بوصفها وسطًا موضوعيًا بينهما. فهي كاللاهوت من جهة كونها تأملات غير تجريبية، وكالعلم من جهة استنادها إلى العقل.
-2-
موجة التطورات اللاحقة في القرن العشرين، حملت تغيرات جذرية وحادة في أطر التفكير العام نتيجة لاكتشافات الفيزياء الحديثة (النظرية النسبية/ نظرية الكم) التي هزت مفاهيم العقلانية وأسس المنطق التقليدي القديم. لكننا سنستمع إلى نغمة أكثر تواضعًا في التعاطي مع فكرة القدرة المطلقة للعلم. بدا كأن العلم، وقد مضى بعيدًا في انتصاره، لم يعد يحفل كثيرًا بفكرة المواجهة مع اللاهوت، الذي صار بدوره أقل اعتدادًا بذاته. لم يعد ثمة مواجهة بمعنى المعركة بين العلم واللاهوت، أو بعبارة أدق لم يعد للمواجهة توترها المبكر حيث كان اللاهوت يخوضها من موقع السلطة.
كشفت هذه الموجة عن مظاهر جديدة لأزمة الديانة التاريخية مع الحداثة، لكنها لم تؤد إلى مزيد من التقلص في حجم الظاهرة الدينية على المستوى الشعبي، أو إلى انكفائها من الناحية النظرية. بل بدا وكأنها تفتح الباب من جديد أمام التأويلات “الغائية” كي تستعيد فكرة التدبير المفارق (الإلهي) في تفسير “اللاحتمية” (عدم انتظام قانون السببية في بعض الظواهر/ حركة الإلكترون كما كشفت عنها الفيزياء الذرية وما بعد الذرية).
عند منتصف القرن العشرين، صار واضحًا أن خسارة اللاهوت، ممثلًا في الكنيسة، لموقع السلطة لم يكن يعني زوال الدين، وأن الفكرة الدينية لم تظل حاضرة فحسب، بل عاودت التعبير عن نفسها بقوة سواء من داخل المؤسسة التي أبدت مرونة لافتة لإعادة التكيف مع الأطر الجديدة، أو من خارج المؤسسة في أشكال من التدين الذاتي الحر، أو أشكال التدين الأصولي الأكثر تشددًا. الأمر الذي مثَّل –بالنسبة للوعي الحداثي- ظاهرة فجائية ومدهشة بعض الشيء.
لا يعني ذلك أن الكشوف العلمية في القرن العشرين غيرت التوجه العام السائد في الوعي الحديث، الذي لا يزال يتوجس من التفسير الغيبي لظواهر الطبيعة، لكن مع الانبعاث الجديد للتدين استعاد التأويل الديني بعض الثقة في النفس حيال العلم. وظهرت نزوعات فردية داخل العقل “العلمي” للالتقاء مع الدين من خلال الفيزياء.
في دراسته الشيقة “The tao of Physics” ينتهي فريتجوب كابرا إلى تماثل منهجي بين حالة “الاكتشاف” الفيزيائية وحالة “الكشف” الصوفية التي تنطوي عليها كل تجربة تدين ذاتية. ومن موقعه كفيزيائي متخصص يشكك كابرا في رهان العلم على المادة وعلى الطبيعة الاجتماعية: “لقد بلغ العلم قوة لم يسبق لها مثيل، لكن تأكدنا أن طبيعة ما يكتشفه لم يعد مماثلًا لما كان عليه في الفترة الوضعية الظافرة. فهل بإمكانه إدراك العالم كما هو؟ إنه يقدم طبعًا معارف مؤكدة لتوطيد عمل تقني أكثر فأكثر فاعلية، ولكن فكرة أن الفكر العلمي بناء تاريخي متطور، تقود إلى وجهات نظر أقل حسمًا وإلى شيء من المضارعة. ألا تتضمن النظريات رهانًا على المادة أو على الطبيعة الاجتماعية غير مضمون؟”.
-3-
التطورات البنيوية الهائلة في القرن العشرين جلبت تحولات أنطلوجية، وأدت إلى إعادة النظر في المفاهيم التقليدية التي قامت عليها الحداثة التنويرية، بما في ذلك مفهوم “العقلانية” الذي تغيرت دلالاته مع تراجع المنطق الصوري، وظهور النتائج العلمية التي أفرزتها النظرية النسبية ونظرية الكم. وبما في ذلك أيضًا مفهوم “التجريبية” الذي أسفر عن آلوية مفرطة فرضت المعايير النفعية على مضمون الأخلاق وانتهت إلى “تشييء” الإنسان أي جعله شيئًا حسب تعبير أدورنو. (الوعي بخطورة التشييء يشير إلى تناقض داخلي مع طبيعة الروح) عمليًا جرى تجاوز حالة الافتتان بالعلم التجريبي إلى الانغماس في تطبيقاته التقنية، وجرى تجاوز النظر إلى علاقة الدين والحداثة كمعركة بينه وبين العلم ستنتهي حتمًا بزوال الدين.
بشكل نسبي تفاقم الوعي بعجز العلم عن تقديم جواب حاسم عن سؤال الدين. فهو يستطيع أن يكشف عوار المعارف الجزئية في المدونة الدينية حول الطبيعة وجزئيًا حول الإنسان، ولكنه لا يملك آليات التعاطي مع جوهر الدين في ذاته بما هو أولًا: فكرة؛ وفكرة مطلقة مجردة. وبما هو ثانيًا: حاجة؛ وحاجة فوق معرفية، أي ليست مجرد مطلوب عقلي، بل حالة نزوع شعوري ينتج ذاته بذاته من داخل الروح وتجربة الذات الفردية. هذا الجوهر المطلق هو الذي بقي من الدين بعد هزيمة الديانة التاريخية، أعني بعد تساقط الإضافات الوضعية التي خلفتها المؤسسة وصنعت بها سلطتها المعرفية والتشريعية (بقاء الدين بعد معركة التطور يشير إلى صلابة بنيوية لافتة، تستدعي النقاش حول نواة صلبة وعميقة عصية على الانكسار).
لكن مع الوعي بعجز العلم عن حسم المسألة الإلهية، يلزم رصد التغير في طريقة النظر إلى هذه المسألة، نتيجة لتغير المشاغل والهموم العقلية والروحية للإنسان المعاصر، وتغير آليات ومداخل التفكير فيها. في هذا السياق فقد سؤال البرهنة على وجود الله أهميته المركزية كسؤال محوري يختزل المسألة الدينية، بعد أن صار بصيغته النمطية، ينتمي إلى الذهنية الأنطلوجية القديمة التي تشكلت في ظلها ثقافات التدين التوحيدي الثلاث، والتي تتشارك فيها مع الفلسفة اليونانية.
-4-
في السياق الإسلامي تُقرأ المسألة بطريقة مختلفة بعض الشيء.
لم تواجه المدونة الإسلامية معركة شبيهة بمعركة كسر العظام التي واجهتها المسيحية الغربية مع العلم والعلمانية، صحيح أن الهياكل الكلية (الاقتصادية / العقلية/ الاجتماعية) بدأت تتحرك باتجاه التطور، لكنها لم تصل إلى مرحلة التغير الجذري عن مثيلاتها القديمة التي أفرزت المدونة. ولذلك فهي لم تتعرض حتى الآن لتحدٍ جدّي من قبل قانون التطور العام الذي يفرض بقوته حقائق التغيير. ومع ذلك ففي الفضاء المفتوح للعالم، لم يكن في وسع المحيط الإسلامي تلافي الإشعاعات الحديثة الواسعة القادمة من الغرب، والتي كانت في شق منها موجهة إلى فكرة الدين ككل. بالطبع، ثمة مواجهة، لكنها تجري بإيقاع بطيء نسبيًا.
بوجه عام، ليس ثمة خطر يهدد فكرة الدين في ذاتها من قبل العلم. لكن التحدي العلمي لا يزال قائمًا أمام المدونة المدرسية الواسعة بشقيها: المتن (النصوص خصوصًا روايات الآحاد المنسوبة إلى النبي) والهوامش (مادة التفسير والكلام والفقه التي تجاوزت حجم المتن وصلاحياته السلطوية).
المشكل هنا لا يتعلق بمفردات المعارف التفصيلية المناقضة لنتائج الكشف العلمي فحسب، بل يتعلق في المقام الأول، بالروحية الذهنية للمدونة التي تكونت في سياقات القرنين السابع والثامن، والتي لا تزال حاضرة في منهجية التفكير العام. بشكل صريح أو ضمني تعمل هذه الروحية على تأخير استجابات مناسبة لمثيرات التطور العلمي. وتساعد على تكريس حالة التحصن الدفاعي التي تصاحب الوعي الديني المؤسسي خصوصًا في مراحل التراجع.
على المستوى العامي، وكنموذج قابل للتعميم، لا تزال تُشخص بعض حالات المرض النفسي والعضوي بدخول الجن في جسم الإنسان استنادًا إلى تراث المدونة المكتوب. وهو تشخيص يحظى بتأييد صريح أو ضمني من قبل الهيئات الفقهية التي تمثل الإسلام الرسمي، وتلعب جزئيًا دور المؤسسة. (تكتسب هذه الهيئات صفتها المؤسسية من ارتباطها بالدولة، وهي لا تشكل “مؤسسة دينية” بالمعنى الضيق، لافتقارها إلى صلاحيات نصية جامعة، تكفل لها –كالكنيسة- تمثيل الديانة ككل، وسلطة إدخال تعديلات على بنية المدونة).
يقوم التدين “المؤسسي” على ثقافة الفقهاء الموروثة من أدبيات الكلام والفقه التقليدية، وهي ثقافة “لغوية” وذات طابع جدلي غير مناسب للتعاطي مع التحديات العلمية الراهنة على مستوى المنهج والموضوع. ومع بعض المحاولات التأويلية التي لا تدخل في صلب الموضوع، يتواصل الرطن بالديباجة المحفوظة عن حض الإسلام على العلم (في السياقات الدلالية العامية، لا يزال مصطلح العلماء يشير أساسًا إلى فقهاء الدين).
شرائح التدين المعرفي –التي تعمل على هامش النسق الرسمي، وتفكر من خارج الإطار، والتي تتوافر على ثقافة علمانية وأحيانًا علمية متخصصة كافية للوعي بإشكاليات المدونة مع العقل العلمي– تتطوع للدفاع عن المدونة كما هي، بوصفها شقًا من “هويتنا” التاريخية المقدسة.
لكنها لم تقدم أكثر من محاولات مفتعلة لتسكين المدونة داخل النظرية العلمية، أي “تطويع” النظرية للمدونة. وهي عملية غير ممكنة بالمعنى العلمي، لأنها تحتاج على الدوام إلى “تأويل” المدونة، مما يعني الخروج من مربع العلم والدخول من جديد في مربع الفقه والكلام.