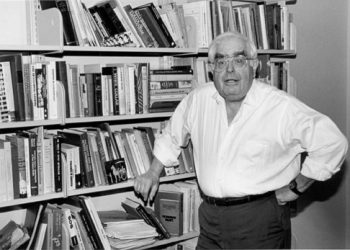-1-
بالنسبة للبعض، هذا مصطلح مفتعل، جرى ترويجه ضمن صرعة الأسلمة الاسمية التي تنتشر في المنطقة تحت ضغط المد الأصولي، والتي تستخدم من قبل قوى “رأسمالية” متعددة لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية.
فدلالة المصطلح تكاد تنحصر، عمليًا، في إعادة تسمية سعر الفائدة بمسميات مستمدة من قاموس الفقه، بغرض تجاوز عقبة دينية طارئة صارت تهدد الاندماج في نظام السوق.
وبحسب البعض، لا معنى للحديث -من حيث المبدأ- عن “اقتصاد ديني”، من منطلق أن الاقتصاد علم وصفي لا تتفسر قضاياه بعلل غائية مستمدة من خارج الواقع، أو من منطلق أن الدين معنى مطلق يخاطب المشترك الإنساني بما هو كذلك.
لكن الاقتصاد في الواقع ليس مجرد علم وصفي، بل معطى اجتماعي واقعي يمكن قراءته على أكثر من مستوى جماعي أو فردي، سياسي أو قانوني، كما أن الدين، تاريخيًا، لم يكن مجرد معنى مطلق (روحي أخلاقي) يخاطب المشترك الإنساني، أو فكرة مجردة تعبر عن تجربة الذات الفردية، بل فرض نفسه كسلطة جمعية ذات بنية تشريعية سياسية، في صيغ متعددة تشي بصدورها عن سياقات اجتماعية متباينة.
تتخذ الديانة التاريخية شكل مدونة مكتوبة، تضم حزمة من التصورات (اللاهوتية) والتكاليف (الأخلاقية/ التشريعية) ويجري تمثلها في الواقع بدرجات متفاوتة فرديًا وعلى مستوى التدين الشعبي العام. مما يعني أن الدين بما هو بنية تشريعية يتقاطع مع الاقتصاد بما هو جزء من البنية الاجتماعية. الأمر الذي يبرر قراءة العلاقة بين الإسلام والاقتصاد في إطار القراءة الشاملة لعلاقة الدين والاجتماع. وهي قراءة لازمة لفهم الظاهرة الدينية التي يثير حضورها على الدوام نوعًا من التوتر في المحيط الاجتماعي.
-2-
في العقل الديني (التوحيدي) حيث الدين حقيقة مطلقة مفارقة، لا شيء في البنية الدينية يرجع للاجتماع. الدين فاعل دائمًا والاجتماع مفعول، وبالتالي لا مجال للحديث عن تأثير اقتصادي في الدين، ثمة فقط تأثير ديني في الاقتصاد. وفي المقابل ينظر العقل الوضعي إلى الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية خالصة، أي تنتمي إلى العالم. ومن ثم فهي تخضع لقوانين الاجتماع الطبيعي في التعدد والتطور، وتتبادل حركة التأثير والتأثر مع المثير الاقتصادي.
في الماركسية لا يمثل الدين ظاهرة اجتماعية فحسب، بل ظاهرة اجتماعية “ثانوية”، تجد تفسيرها دائمًا في ظواهر الاجتماع السياسي خصوصًا الاقتصادية. يوفر الدين -في الواقع- غطاءً أيديولوجيًا يستر الاغتراب الاقتصادي الناشئ عن الرأسمالية. فهو يوظف من قبل القوى المهيمنة بشكل “تبريري” لإضفاء مشروعية على سلطة النظام الطبقي. ويستخدم من قبل الطبقات المقهورة في “التعويض” عن حالة الحرمان، أو في “الاحتجاج” عليها. وهو ما يظهر عن إنجلز الذي قدم تحليلًا طبقيًا للإصلاح البروتستانتي في كتابه “حرب المزارعين الألمان”، فجماعة الأنا بتستي (الذين رفضوا تعميد الأطفال) كانت تعبر بلغة دينية عن حركة احتجاج سياسية معارضة للقهر الاقتصادي والاجتماعي داخل مجتمع إقطاعي.
-3-
ماكس فيبر –بدوره- يقرأ الدين من داخل التفسير الاجتماعي الخالص، لكنه سيعالج علاقة الدين بالاقتصاد من زاوية أوسع من الزاوية الماركسية. فهو يقر باستقلالية نسبية للموضوع الديني ضمن السياق الاجتماعي، ويقدم طرحًا وظيفيًا للدين يتجاوز كونت ودور كايم، فالدين لا يؤدي دور اللّحمة اللازمة لتماسك المجتمع، بل يؤدي أيضًا دور المثير القادر على إحداث التغيير أو التطور الاجتماعي. وفي سياق هذا الدور الأخير يقدم طرحه عن التجانس بين تطور الرأسمالية وحركة الإصلاح البروتستانتي خصوصًا عند كالفن.
بحسب فيبر، وفرت الكالفينية، تأصيلًا نظريًا للأخلاق المسيحية يتلاءم مع الخصائص العقلانية للاقتصاد الرأسمالي؛ ربط كالفن بين المبدأ الأخلاقي وممارسته عمليًا كفعل دنيوي داخل العالم، فالله يتعبد الناس بالطاعة من خلال السلوك أي الفعل الاجتماعي، والطاعة تنطوي على تنازلات عاجلة مقابل الوعد بمكافآت آجلة، مما يعني أن المؤمن يجري عملية لحساب المنافع تشبه حساب الربح والخسارة. أهم ما ينسب إلى كالفن هنا هو تقديمه لتبرير ديني معقلن لفكرة “الربح” كنجاح دنيوي يعبر عن نعمة الرب ومطابق لروح الرأسمالية، ولفكرة “سعر الفائدة” متجاوزًا التفسير الكاثوليكي التقليدي للربا.
وتأسيسًا على ذلك اعتبر فيبر أن الجوانب الأكثر إيجابية في نشأة الرأسمالية واستقرارها، أوضح حضورًا في المناطق البروتستانتية من أوروبا. وبسبب غيابها واجهت الرأسمالية عراقيل تطور في السياقات الدينية الأخرى كالهندوسية والبوذية والإسلامية (الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية).
وفقًا لهذا التحليل تبدو الرأسمالية وكأنها نتاج مباشر للبروتستانتية، ويبدو التطور الاقتصادي تابعًا لتطور ديني صريح، أي صادر عن بنية تحتية ذات طابع نظري. لا يتوافق فيبر مع الرؤية الماركسية حول أسبقية التطور الاقتصادي (المادي) كبنية تحتية مطلقة، لكنه لا يجعل الدين بنية تحتية مقابلة، بل يتحدث عن تفاعل متبادل بين التطور الديني والتطور الاجتماعي عمومًا؛ فكل تطور اجتماعي يخلق تطورًا دينيًا، كما أن كل تعددية اجتماعية تفرز تعددية في الرؤى الدينية، فأنماط التدين تختلف باختلاف طبقات الانتماءات المهنية التي تبصم رؤية أفرادها ببصمتها الخاصة (الفرسان، المزارعون، العسكريون، الحرفيون، القساوسة، رجال الفكر). قارن فيبر بين التطور العملاني الذي تبنته البرجوازية الأوروبية، والقائم على زهد إيجابي نشيط يعتد بالعمل كسلوك نافع ومستحب من الله، وتصور النبلاء المثقفين الذي يمارس التدين من خلال التأمل الداخلي في الله كوجود مثالي محض. ولاحظ بشكل إجمالي أن التصور الأول ساد في الغرب المسيحي والشرق الأوسط الإسلامي، بينما هيمن التصور الثاني على طابع التدين الهندي، وبدرجة أقل الصيني.
لكن ما يلزم التنبه إليه -بعيدًا عن فكرة البنية التحتية- هو أن الدين بوجه عام، فعل ينشأ داخل العالم، ويتطور وفقًا لقوانين التغير الاجتماعي. لم يصنع كالفن الرأسمالية، بل أنتجها التطور الصناعي ضمن حركة الانقلاب الشامل التي أخذت تدب في أوروبا قبل قرنين من عصر الإصلاح. وفي هذا الاطار يلزم قراءة البروتستانتية كرد فعل لضغوط التطور الاجتماعي العام، التي فرضت على المسيحية –من خلال كالفن- أن تظهر ضربًا من المرونة التشريعية كي تتوافق مع النظام الناشئ.
الدين هنا، أو بالأحرى التدين، يبدي استجابة صريحة للمثير الاجتماعي، تسمح بتمرير إرادة التطور واستكمال دورتها.
-4-
في دراسته حول “الأخلاق الاقتصادية للديانات الكبرى” يعلل فيبر تخلف النموذج الرأسمالي في المنطقة الإسلامية بغياب تأصيل أخلاقي اقتصادي معقلن، وهو تعليل ينطوي على مبالغة نظرية. بوجه عام ليس ثمة فوارق جذرية في التصور الأخلاقي بين الديانات التوحيدية الثلاث، فيما يتعلق بالموقف المتداخل أو المزدوج حيال المال والعمل الدنيوي. الفوارق تكمن في السياقات الاجتماعية الاقتصادية ومن ثم الثقافية. يحتوي النص الديني على طيف واسع من الخيارات التي يمكن تأصيلها نظريًا، والمناخ الاجتماعي هو الذي يعين خيار الرؤية السائدة. لم يكن كالفن أول من صرح بأن الجزاء الأخروي يتم تحصيله عبر الفعل الدنيوي (الاجتماعي)، ولم يستحدث مشروعية الربح الملازمة لفكرة التجارة. التأصيل الأخلاقي الاقتصادي الذي قدمته البروتستانتية الكالفينية وجد -في الواقع- تحت ضغط الرأسمالية الصناعية، أي نتيجة لتطور اقتصادي اجتماعي سابق على كالفن. كان الزخم “الدنيوي” المصاحب لحركة التطور هو الذي أدى إلى تصعيد قيم العمل ومشروعية الربح إلى سطح المدونة الدينية، على حساب قيم التواكل والزهد أو الانسحاب الأخروي الكامنة –بدورها- في صلب المدونة، والتي كانت أوضح حضورًا في أخلاق العصور الوسطى.
في السياق الإسلامي لا يتعلق المشكل بغياب تأصيل أخلاقي ديني معقلن، فهذا التأصيل كامن في نصوص المدونة الإسلامية الواسعة، التي تتسع لقيم الربح وقيم الزهد على السواء. وقد جرى استخدامها بالفعل في التنظير المعاصر لتأييد سياسات اقتصادية واجتماعية متباينة (رأسمالية واشتراكية). المشكل يتعلق بمستوى التطور الكلي، أي بالهياكل الاقتصادية/ الاجتماعية/ العقلية التي لم تتغير بشكل “جذري” عن مثيلاتها في مراحل التأسيس الديني، التي تنتمي إلى العصور السابقة على الحداثة إجمالًا، ظلت الهياكل الاقتصادية ريعية، والاجتماعية قبلية عشائرية، والعقلية أسيرة لروح التفكير التأملي السابق على التجربة.