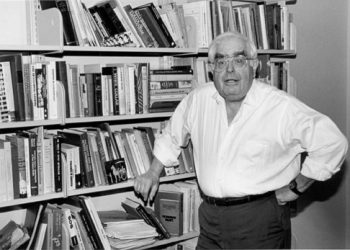-1-
يأخذنا هذا المصطلح المركب مباشرة إلى قاموس سيد قطب، وقضايا الجدل الفرعي الداخلية، التي فرضتها الحركة الأصولية على مشاغل الثقافة، والتي حرفت اهتمامات المجتمع عن مسارها الطبيعي تجاه التطور والخروج من حالة البؤس المزمنة التي يعاني منها على جميع الأصعدة، الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، فضلاً عن الروحية والأخلاقية.
يعتبر سيد قطب المنظر الأول أو الأكثر أهمية للأصولية الإسلامية في المنطقة العربية، بالنظر إلى دوره في “تطوير” الحالة الإخوانية في مصر وتصعيدها إلى مناطق موضوعية وجغرافية أوسع، وبغض النظر عن مقاصده الواعية –التي تعكس خصائصه النفسية والثقافية، والتي تتسع لتأويلات متعددة– أسهمت تنظيرات قطب في خلق وتكريس الجيل الثاني من الحركات الأصولية الأكثر تشدداً على مستوى التكفير ومستوى العنف.
نحت قطب مصطلح “العزلة الشعورية” في سياق الصراع بين الإخوان والسطلة الناصرية، وهو بصدد تكوين بناء تنظيمي جديد، يهدف بطموح إلى تجاوز النسق الإخواني القائم، والذي لم يعد أصولياً بالدرجة الكافية. يمثل هذا البناء “طليعة مؤمنة” عليها السعي للتحول بالمجتمع من حالة الجاهلية إلى حالة الإسلام بمعناه الشامل كمنهج حياة متكامل في التصورات، والتشريعات، والممارسة.
بحسب قطب، لا يجب على هذه الطليعة أن تعتزل المجتمع أو تفاصله، طوال مرحلة الدعوة، مفاصلة حسية، بل عليها مفاصلته على مستوى الوعي والشعور: “ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتها، ولا في شيء من أوضاعها، ولا في شيء من تقاليدها مهما اشتد ضغطها علينا…” إن أولى الخطوات في طريقنا أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته، وألا نعدل في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيراً لنلتقي معه في منتصف الطريق.
-2-
لا تحتاج العزلة الشعورية في الواقع إلى تنظيرات سيد قطب. فهي حالة نفسية تنشأ تلقائياً مع الانضواء في أي جماعة أو حركة ذات طابع ديني أو أيديولوجي تهدف إلى تحويل المجتمع. فكرة الجماعة تنطوي -في حد ذاتها- على مفهوم الانسلاخ. تفضي ثقافة الانتماء الجديد إلى تبني الرؤى المغايرة للتيار العام وتكريس الانفصال عنه. ويسهم الإحساس بخطورة هدف “التغيير” وسمو الغايات الدافعة إليه، في توليد الشعور بالاستعلاء، وهو الشعور الذي يعمل بشكل غير واعٍ على تعويض الإحساس بقلة العدد، ويساعد على الشحن الداخلي المطلوب لمواجهة مخاطر العمل ضد قوة الدولة والمجتمع.
لكن العزلة الشعورية المشربة بالاستعلاء تبدو أكثر حدة وعمقاً في الحركات الدينية منها في الحركات الأيديولوجية، بسبب الخصائص الموروثة من تاريخ التدين الطويل، التي حولت مفهوم المقدس إلى مفهوم نافٍ يؤدي إلى إلغاء الآخر. داخل فكرة المقدس يختبئ المشكل الأخلاقي للاستعلاء بالدين، الذي يبرر ذاته بذاته، بمعنى الاستغناء عن أي تبرير أخلاقي لعملية النفي من خارج الغرض الديني، فبما هي تتم باسم الله فهي طبيعية ومفترضة. وهو المشكل الذي ينكشف بشكل واضح عندما يقف الاستعلاء الديني في مواجهة استعلاء ديني مقابل، قد يتشارك معه في الانتساب إلى الله، أو حتى إلى نسق الديانة أو المذهب ذاته.
-3-
ما ينكشف هنا في الواقع ليس المشكل الأخلاقي للاستعلاء الأصولي فحسب، بل المشكل النظري الكامن في المعنى الأصولي ذاته.
تنطلق الأصولية من فكرة أن المجتمع القائم لا يتطابق مع النموذج المثالي للدين كما تحقق في مرحلة التأسيس، وتهدف إلى سد الفجوة وتحقيق التطابق بينهما. الأصولية الإسلامية تشتغل على مجتمعات لا تعتبرها إسلامية على الحقيقة، أو لا تعتبرها إسلامية بالقدر الكافي، ومن ثم فهي تسعى إلى جعلها كذلك، أي إلى تحويلها إلى مجتمعات مطابقة للنموذج كما تفهمه من كتب الفقه والمدونة التاريخية.
المشكل هنا يتعلق بوجود نموذج معياري من حيث المبدأ، وبقابليته للتطبيق في الزمن المتغير، قبل الحديث عن إمكانية تعيينه في الاجتماع المتعدد.
مبدئياً يصعب الحديث عن نموذج معياري ديني في ظل النمط التاريخي السائد للتدين. ففي هذا النمط لا يفهم من الدين بما هو خلاصة القيم المطلقة، أي القيم الكلية الثابتة في الزمن، بل يحتوي إلى جانب القيم على منظومة تكليفية واسعة من التشريعات التفصيلية، هي في الواقع إفرازات مباشرة للسياقات الاجتماعية في مراحل التأسيس، وبالتالي فهي بطبيعتها قابلة للتغير في ظل قوانين الاجتماع التي يحكمها التطور والتعدد. ما يمكن اعتباره نموذجاً ميعارياً في ظل هذه القوانين هو فقط القيم الكلية بما هي مطلقة، أي بما هي ثابتة (تتجاوز التطور)، وبما هي كلية (تتجاوز التعدد).
فكرة النموذج الميعاري تترجم مبدأي الحصرية والتجميد اللذين يقوم عليهما نسق التدين التاريخي السائد. ونتيجة لذلك تنشأ على الدوام مسافة طبيعية بين المنطوق الرسمي للديانة وممارسات التدين الاعتيادي الشعبية، وهي تتسع بشكل طبيعي مع مرور الزمن.
لا توجد مدونة واحدة قادرة على استيعاب التنوع والتطور على المستويين الفردي والجماعي؛ لأن فكرة المطلق ذاتها لا تشتغل إلا داخل الاجتماع عبر آليات التنوع والتطور، في حين أن أي مدونة دينية هي في الواقع تاريخية.
وفيما تظل المدونة نموذجاً مكتوباً أي مثالياً، يشتغل التدين الاعتيادي (الشعبي) على أرض الواقع محكوماً بقوانين الطبيعة، وغرائز الأفراد التي تعمل بشكل ضروري يسبق التفكير والسعي الأخلاقي. ومن هذه الزاوية يظهر المشكل المبدئي في التفكير الأصولي الذي يفترض قابلية هذه الفجوة للإلغاء.
الأصولية -التي تبدأ دائماً من نقطة نقد لحالة التدين الشعبي القائمة- تزايد أحياناً على نموذج المدونة التاريخي ذاته، الذي لا يبدو -وفق تصورها التأويلي- مثالياً بالدرجة الكافية. بمعنى أنها تصطنع لنفسها نموذجاً واحدياً أكثر مثالية، وبالتالي أبعد مسافة عن طبائع الفعل الشعبي الذي تستعلي عليه.
-4-
لا معنى للحديث عن نموذج معياري إلا بما هو نموذج قيم، وهو معنى أضيق من معنى الدين في النظرية المدونة وفي الواقع التاريخي على السواء. الفارق بين المدونة والتدين الشعبي هو الفارق بين الدين في النظرية والدين في الواقع. بما هي نسق نظري مغلق، تمثل المدونة في جميع الأوقات لحظة الماضي، بينما يعبر التدين الشعبي عن الدين في تجليه الواقعي الحي والآني، وهو ما يعطي التدين الشعبي خصائصه المميزة، وفي مقدمتها طابعه “الاحتوائي التعددي” الذي يتسع عملياً لأشكال متنوعة من التدين لا تقبلها المدونة الرسمية، والتفاعل معها من خلال مخزونه العفوي الأقرب بطبيعته لمنابع الوعي الروحي المباشرة.
وبوجه عام، وعلى الرغم من تسرب بعض التصورات المنغلقة من ثقافة المدونة أو من الثقافات الأسبق، تبدو “الممارسات” الشعبية في مجملها أوسع انفتاحاً على المضامين الدنيوية، أو أكثر تصالحاً مع فكرة الحياة من أدبيات المدونة التقليدية المنحدرة من تاريخ ديني متشائم.
أيضاً يبدي التدين الشعبي قدرة أوسع على التسامح مع الآخر الديني من موقع المشاركة التي يفرضها الواقع، قياساً إلى المدونة الرسمية التي تنطلق من أرضية حصرية، والتي تكونت بامتداد عصر التدوين في سياق اجتماعي أحادي.
من هذه الزوايا يمكن قراءة العلاقة بين التدين الشعبي الاعتيادي والتدين الأصولي المتطرف كعلامة نفور متبادل في صميمها: تنظر الأصولية إلى الممارسات الشعبية كنمط تدين فج متساهل أو منحرف عن النموذج المكتوب، وتابع دائماً للسلطة الخارجة عادة عن الدين.
فيما يشعر الشارع الاعتيادي بالطبيعة الأحادية المتزمتة للأصولية وإيقاعها التكليفي الخشن المخاصم للعفوية والتعدد.