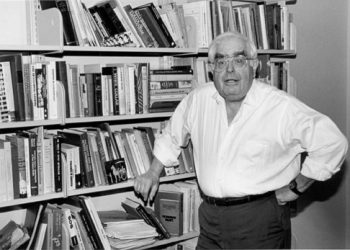-1-
يقر الجميع بوجود صعوبات جوهرية تتعلق بصياغة المشكل أصلًا. يشير إيزايا برلين في مقالاته الخمس عن “الحرية” إلى ما يزيد على مئتي معنى قام بتسجيلها مؤرخو الأفكار لهذه الكلمة “المتلونة” فهي مثل السعادة، والخير، والطبيعة، والحقيقة، مصطلح شديد المسامية لا يمكنه سوى مقاومة تأويل ضئيل.. مسألة الإرادة الحرة، وهي قديمة قدم الرواقيين على أقل تقدير، يصعب صوغها بوضوح، وقد شغلت الناس العاديين والفلاسفة المتخصصين في آن.. والنقاشات القروسطية والحديثة، وبالرغم من إنجازها لتحليل أفضل لجملة المفاهيم المرتبطة بها، لم تقدم لنا أي حل حاسم. بعض الناس يبدون حائرين بشكل طبيعي حيالها، فيما يعتبر آخرون مثل هذا التعقيد “مجرد ارتباك سيزيله حل فلسفي فعال”.
بالنسبة لي، لا معنى للحديث عن حل “نظري” لمشكل الحرية. وهو الدرس الذي تعلمته من تاريخ الفلسفة بوصفه سلسلة من التمارين الفكرية، التي تعيد تقليب المعطيات انطلاقا من نقطة ذاتية مسبقة، لا تحظى أبدًا بالإجماع.
يبدأ الفكر، وهو يبحث عن حل عقلي، من فرضية الوحدة والقابلية للتناغم، وهي فرضية لا يعرفها الواقع. وفيما يصل الفكر من خلال تنسيق الأفكار، إلى ما يعتبره حلولاً مفهومية، تظل معطيات الواقع تشير إلى تناقضات تفصيلية بين مطالب الحرية ومطالب العدالة، أو الحب، أو الفضيلة، أو السعادة، وتظل “الإرادة الفردية” تواجه، مع الحتميات الطبيعية وشبه الطبيعية، عقبات فعلية متغيرة من الإكراه الاجتماعي، والقهر السياسي، سواء في صورها القمعية المباشرة، أو غير المباشرة التي تتغطى عادة بغطاءات العرف أو القانون.
-2-
التعويل على الفلسفة يأتي من الخلط المعتاد بين الفكر والواقع، وهو أحد أهم المشكلات الموروثة من تاريخ المثالية اليونانية. في الفكر حيث ينزع العقل إلى الوحدة والتجريد الكلي -يعني حل المشكل الوصول إلى صيغة مقبولة في الذهن لما يبدو علاقة تناقض بين فكرة الحرية وأفكار كلية مقابلة كالعدالة، أو الفضيلة، أو الخير. ثمة دائمًا طريقة لرفع التناقض من خلال إعادة ترتيب أو تسمية الأفكار وفقًا لمنطق التناغم المفترض.
أما في الواقع -حيث يتسع الاجتماع، بالمكان والزمن، لتجاور موجودات متعارضة، أي حيث يُجرَى فعليًا استيعاب التناقض الناجم عن الكثرة- فإن حل المشكل لا يعني رفع التناقض بل إدارة معطياته القائمة، بحيث يمكن الوقوف على آليات تحقق الحرية، أعني القدر الممكن منها في ظل قوانين الطبيعة وقوانين الاجتماع. يمكن القول: إن الواقع ليس منطقيًا بالضرورة، أو إن له منطقه الخاص الذي لا يتماهى مع منطق العقل اليوناني.
-3-
واقعيًا، ينتج مشكل الحرية عن “حالة الاجتماع” بحد ذاتها، أعني عن التعارض الضروري بين “طبيعة” الوجود الفردي، وطبيعة” الوجود الاجتماعي: ينزع الوجود الفردي بطبيعته إلى “الفعل” وهذا بعينه ما تعنيه مفردة الحرية، فهي –إذن- من جوهر الوجود الفردي ذاته، وأي تعريفات خارجية ستكون بمثابة شرح أو تبرير إضافي. وبطبيعته، يتكون الوجود الاجتماعي من عدد من “الوجودات” الفردية المتقابلة، مما يعني الجمع في صعيد واحد بين نزوعات فعل متقاطعة.
ومع ذلك، فالوجود الاجتماعي في الواقع ليس مجرد حاصل جمع الوجودات الفردية، لأنه يخلق تلقائيًا ما يمكن وصفة بـ”ذات كلية” أو “ذوات كلية” مفارقة للذوات الفردية. وهي –بدورها- تنزع إلى الفعل بطريقتها الخاصة.
معنى ذلك أن نزوعات الذات الفردية لا تتقابل مع نزوعات الذوات الفردية المعاكسة فحسب، بل أيضًا من نزوعات الذوات الكلية التي تنشأ عن حالة الاجتماع (العائلة/ العشيرة/ القبيلة/ المجتمع/ الدولة)، وهي الأطر الجماعية القابضة، التي تشكلت من خلالها مفاهيم السلطة الشمولية المعروفة (العادات/ التقاليد/ العرف/ القانون).
هذا التقابل بين الوجودين الفردي والجماعي، هو الوجه الأقل غموضًا في مشكل الحرية. وهو الذي يشير إلى المشكل بمعناه الحقيقي (العملي) لأنه يتعلق بالقدرة على الاختيار داخل مجال الممكن. أما الوجه الآخر للمشكل فيأتي من كون الوجودين الفردي والجماعي محكومين أصلًا بقوانين الوجود الطبيعي، أي بحتميات الفيزياء والبيولوجيا، التي تسبق فعل الاختيار داخل الوعي، أو تسحبه خارج الممكن.
قريبًا من هذا السياق يمكن تسكين فكرة “الظروف” الفاعلة، التي تكشف عن صورة من “الضرورة” الاجتماعية، تتشابه من جهة اضطراد النتائج مع الحتمية الطبيعية. فالظروف الاقتصادية، أو الانتماء الطبقي، أو بيئة التكون الثقافي، تنطوي على نوع من الحتمية الناعمة، وتعمل كعقبات تحتية في طريق الإرادة فيما هي توجه مسارها منذ البداية. بالطبع، تبدو هذه العقبات بالنسبة للوعي الفردي أقل حتمية من عقبات الطبيعة، ومن ثم قابلة للتجاوز على نحو ما. ولكن هذه القابلية جزئية وتظل نظرية في مجمل سياقات الواقع كما تؤكد الماركسية.
جوهر الحرية هو القدرة على الاختيار. وكلما اقتربنا من أرض الواقع ظهر أن المشكل –وهو بالأساس مشكل الإرادة الفردية- لا يتعلق بالحتميات الطبيعية، التي تتداخل مع الجبر الميتافيزيقي، بقدر ما يتعلق بعقبات الإكراه الاجتماعي والسياسي.
أين موقع الدين من هذه المعادلة؟
-4-
من زاوية أنثربولوجية يصعب الحديث عن وجود فردي سابق على الوجود الاجتماعي. منذ البداية، أدت حالة الاجتماع الطبيعي المبكرة إلى اندماج الفرد في كيانات جماعية فرضتها غريزة الاحتماء من خطر الطبيعة. وعلى الرغم من أن الوعي الفردي أخذ في الظهور والتفاقم تدريجيًا مع تواصل التطور باتجاه السيطرة على الطبيعة، فإن سلطة الأطر الكلية (العائلة/ العشيرة/ القبيلة/ الدولة) ظلت قابضة على كيان الفرد، خصوصًا بعد تكريس سلطة الدين كإطار اجتماعي مهيمن على جميع هذه الأطر.
تاريخيًا، لم يظهر التأثير القابض للدين على النزوع الفردي، بشكل حاد قبل تبلور النسق التوحيدي، الذي سيؤدي بدءًا من التجربة العبرية، إلى تصعيد حضور الدين كسلطة شمولية طاغية. فمع هذه التجربة توسعت صلاحيات المؤسسة الدينية، وتعمق ارتباطها التقليدي بالدولة. لكن دورها الشمولي الأهم يأتي من تحميل الدين بفكرتين: الحصرية، والشريعة.
1- الحصرية
طوال المراحل السابقة على هذه النسق فرضت التعددية نفسها على التدين، وجرى الإقرار على نحو متبادل بحق الجماعات والشعوب في تقديس الآلهة أو الإله الذي تؤمن به، وبهامش نسبي للأفراد داخل الجماعة في اختيار إله من بين الآلهة المتعددة، أو التعبير عن عبادته بطريقته الخاصة. بوجه عام، لم يوضع التفكير الفردي على نطاق واسع مقابل رؤية أحادية للدين، ولم يشتغل مفهوم “التكفير” ومفهوم “الهرطقة”. وفي هذا السياق لم يؤد التدين إلى حروب واسعة أو صدام بين الأفراد أو مع الأفراد بالمعنى الذي سيظهر مع النسق الحصري.
جلبت اليهودية مفهوم التكفير بمضامينه الإكراهية (اللعن/ الإقصاء/ القتل) إلى صلب المصطلح الديني. وهو المفهوم الذي سيشتغل في المسيحية تحت مسمى الهرطقة ليقدم من خلال الكنيسة والدولة معًا، النموذج القمعي الأكثر وحشية في تاريخ العلاقة بين الحرية والدين. أو بين الحرية الفردية والنظام الاجتماعي المؤمم من قبل الدين والمدعوم بسلطة الدولة. ألقت الكنيسة الكاثوليكية آلاف البشر في أوروبا أحياء بالمحارق لمجرد التفكير في الدين بطريقة لا تطابق رؤية الكهنوت الرسمي.
في السياق الإسلامي، وتماشيًا مع التراث القمعي للدولة التي تقمصت دور الكنيسة كحارسة للدين، أنتج الفقه تراثًا نظريًا موازيًا لم يلتفت قط لمطالب الروح الفردي، وذلك من خلال توظيف آليات ومفاهيم شمولية (كالإجماع/ الأمة/ الفتنة/ البدعة) إضافة إلى التكفير بالطبع.
لكن السياق الإسلامي يتوافر في هذا الصدد على خصوصية نسبية:
بدرجات متفاوتة تعطي جميع الديانات (التوحيدية) لأفراد المؤمنين نوعًا من السلطة التوجيهية نيابة عن الديانة حيال “الأفراد” الآخرين. وهو ما يظهر إسلاميًا بشكل أوضح في ظل غياب مؤسسة دينية جامعة، وبسبب تراجع الدور التمثيلي للدولة. من خلال فكرة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” تتوزع سلطة التوجيه –نظريًا- بين الدولة والأفراد، فيما يمثل الفقه في ذاته سلطة خلفية ضاغطة تهيمن على النص، ولا تتطابق مع سلطة الدولة. يمنح مبدأ “النهي عن المنكر” صلاحية التغيير باليد، وهي صلاحية تنفيذية تستدعي النقاش حول “التوتر” الذي ينجم عن التصادم بين سلطات التوجيه (الدولة/ الأفراد/ الفقه)، لكن جوهر المشكل يظل كامنًا في حساسيات الصدام مع حاجز الروح الفردي الذي ينزع للخصوصية بما في ذلك خصوصية فهم الدين.
الشريعة
باستحداث فكرة الشريعة الإلهية تم تأميم “القانون” لصالح الدين، ومن ثم توثيق التداخل بين الدين وسلطة الدولة بشكل نهائي. كان ذلك يعني أولًا: توسيع مساحة السلطة التكليفية التي تحظى بحماية الدولة، والتي تعمل إلى جانب العرف ككوابح تقليدية لحركة النزوع الفردي. وكان يعني ثانيًا: تشديد الطبيعة الزجرية لسلطة القانون عبر تصعيده إلى موقع المقدس.
الأمر الذي يؤدي من الزاويتين إلى مضاعفة قابليات التناقض بين النزوع الفردي والنظام الاجتماعي.
من هنا يمكن القول بأن قابليات التناقض بين النزوع الفردي والدين تتناقص بقدر ما يتخلص الدين من لوائح الفقه التفصيلية الواسعة التي انضمت إلى معنى الدين، عبر تاريخ التدين، بفعل المؤسسة الدينية.
والمعنى أن “الدين في ذاته” بما هو توجه روحي نابع من داخل الذات الفردية لا يتعارض مع طبيعة الوجود الفردي، خلافًا “للدين التاريخي” بما هو نظام تكليفي مصنوع بمعرفة النظام الاجتماعي ويمثل جزءًا منه.
بالطبع، سيظل “الدين في ذاته” ينطوي على حد أدنى من المعنى التوجيهي بما هو حامل للأخلاق الكلية، ولكن هذا الحد الأدنى الأخلاقي يكون مقبولًا من الذات، بما هو صادر أصلًا عن نزوعاتها الأولية، التي تماهي بين الله والمعنى الأخلاقي الكلي.