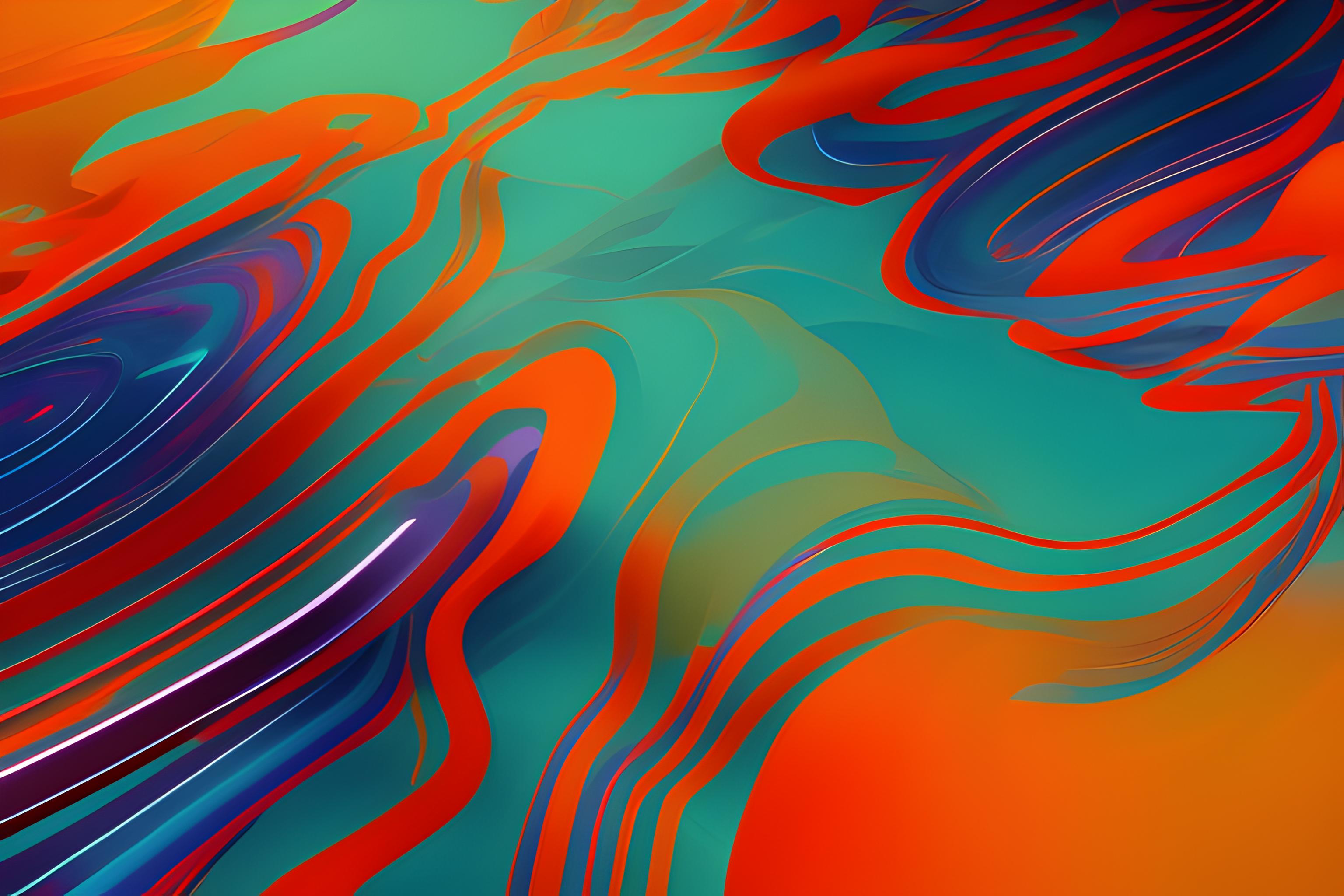تُذكرنا النقاشات التي تحاول إزالة الغموض عن “تجمع المهنيين” الذي يقود التظاهرات في السّودان -ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ إلى الآن- بتلك التي حاولت أن تكشف الظهير السياسي لحكومة البشير الأولى (١٩٨٩). وكلاهما: (المهنيون، والجبهة الإسلامية )، تعاملا مع الغموض بمتعةٍ خفية، تلف التبريرات الأمنية. فالإنقاذ أوّل ما بررت إخفاء توجهها قالت: إنّها فعلت ذلك لخداع مصر، وقد كان أن أذاعت مصر نبأ الانقلاب متهللةً بزوال الصادق المهدي، وقال الرئيس مبارك لعبدالرحمن الراشد جزلاً: “دول تبعنا”. و”تجمع المهنيين” لا يزال يتمتع بلا تصنيف؛ حدّ تبادل الاتهامات بأنّه شيوعي أحمر، بينما يصرّ المتربصون بالإسلام السياسي على ترصد مواقف “تجمع المهنيين” وتسمياته، وأبيات الشعر في بياناته تقترب إبداعاتها من فلتات “دوائر المحبوب عبدالسلام[1]” وخيوط ظلامه، ويزيد هؤلاء القول بأنّ الاحتفاء بالشهداء، وحشد النظافة الذي يُذكِّر بنفير “لقيط” القطن في التسعينيات، والاحتفاء بالمرأة الثائرة باسم “الكنداكة”، يختلف في الاتجاه فقط عن “أخوات نسيبة” ومهيرة، التي كانت سمةً لإعلام التسعينيات!
بعيدًا عن المغالاة أعلاه، فإنّ نظريّة وصف المعارضة الشرسة بأنّها إسلامية، ليست ابنة المؤامرة، فقديماً كتب عراب النظام الراحل، أنّه يأمل أن يأتي اليوم الذي تكون الحكومة في السودان إسلاميةً والمعارضة إسلاميةً أيضاً، ومنذ ذلك الوقت، وكل معارضة يُشك في إسلاميتها؛ حتى من قبل الحكومة.
ذات شتاء، قال أحد زعماء المعارضة السودانية لجلسائه: “نظام الإنقاذ مثل كرة الثلج ، متى تحركتم نحوها تدحرجت وصارت أكبر، ومتى تركتموها، ذابت”. لذا نشأت مقاومة “الحركة” الإسلاموية في السودان بتيار “السكينة” المسلم، ونشأ مقترنًا به، بدلاً من محاربة النظام من الخارج؛ منهج جديد يسعى إلى تفكيكه من الداخل. قاد هذه المحاولات، وطنيون من طبقةٍ رفيعة، منهم الشريف زين العابدين الهندي (ت ٢٠٠٦)، والأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد (ت ٢٠٠٤)، ورفاق الدكتور جون قرنق (ت ٢٠٠٥)، ثم التجمع الوطني الديمقراطي ذاته بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني. ولكن هل نجح هؤلاء في إحداث أي تغيير، يوازي أثر المفاصلة التي سلخت المؤتمر الوطني عن عراب الإسلاميين وحزبه الشعبي الجديد؟! بل يوازي الانسلاخات التالية التي انتهت بقرارات ٢١ فبراير (شباط) ٢٠١٩، التي “ربما” دشّنت لعهد جديد، لا يمكن فهمه دون العودة إلى الوراء؟
تمر قراءة سيناريوهات التغيير في السودان، بمجموعة ممرات: سياسية بحتة؛ لا تعترف سوى بالتاريخ السياسي لسودان ما بعد الاستعمار، أو بتحديد أكبر: سودان ما بعد ١٩٨٩. واجتماعية بحتة؛ لا تتناول تحولات اقتصاد العجز: النفط والفقر وانفصال الجنوب، بقدر تناولها لسياسات التنشئة الاجتماعية لجيلٍ من الشباب الساخط.
فلنبدأ بالفرضية السياسية، التي تزعم أنّ موقع الرئيس البشير الراهن، هو نتيجة انسلاخات دقيقة، نتتبعها بهدوء.
السياق التاريخي: الضروري لفهم رؤوس الأفاعي
لا ينفصل الموقف السياسي الراهن في السودان عن تاريخه السياسي منذ الاستقلال، والذي ينتهي بحقيقة قيام الإسلاميين في العام ١٩٨٩ بتنفيذ انقلابٍ سياسي على السّلطة الديمقراطية، التي كان يمثلها السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء، والسيد أحمد الميرغني رأس مجلس الدولة، لتنتهي بذلك فترة من الائتلافات داخل الحكم، وينفرد الإسلاميون بالحكم مطلقًا، ويشرعون في تنفيذ مخطط التمكين؛ ثم تصدير الثورة، الذي وضع السودان في معاداة للدول الملكية المجاورة والجمهوريات العسكرية العربية، وفي وئام مع إيران الرسمية والإسلاميين الذين يمثلون المعارضة في بقية دول العالم، آنذاك.
عمل الإسلاميون في السودان على ترسيخ حكمهم عبر حزم من الإجراءات: بدأت من الجيش والقوات النظامية التي تمّت أسلمة -بعضها- بشكل منهجي وسريع، صرَف أغلب العقيدة القتالية من مصالح الوطن القُطري، إلى آفاق التنظيم الدولية والتوسعية. وتمّ فصل ما (قُدِّر) بأنه أزيد عن مئتي ألف موظفٍ مدني من وظائفهم في حملة “الصالح العام”؛ التي نَحَّت أساتذة الجامعات ومدراء المصارف وغيرهم، فأُفرِغ -بسببها ولأسباب أخرى- السودان من نخبته، وحلّت محلها نخبة إسلامية أو متحالفة معهم أو متأقلمة على هذا الحال. وبدأت نُخب جديدة في التشيؤ، بديلةً عن تلك المهاجرة، ولكنها كانت أقلّ جودة، وجدوى، في جوٍ جديد يمقت التاريخ والقيم المتوارثة، ويعيش بالنقد وكراهية العالم.
على مدى عشر سنوات من الأدلجة الرفيعة، تمّ تدجين جيل كامل من مواليد الستينيات والسبعينيات، وضمهم لدائرة التفكير الإسلاموي، وضبطهم عليه بشكلٍ آلي محكم، أبَانَ أن التنظيم ليس في حاجة لإبقاء “الأجسام الهيكلية للحركة الإسلامية” الحزبية، ما دام التجنيد العام يحقق الأهداف. هذه اللحظة التي أضاعت فيها الحركة السودانية الأكثر تمددًا حينها، سر تفوقها، وآمنت دون وعي، أنّها جعلت كل البيض في سلة الحكم، ومحت وهجها الحركي الشعبي، في صولجان الحكم والسوق. أو كما عبّر أحد الظرفاء “جمعونا في المساجد (قبل الحكم) وذهبوا هم إلى السوق (بعد الانقلاب)”.
في آخر العشرية الأولى حدث انشقاق داخل جسم الحكم؛ لينفصل “التنظيم” عن النواة الأولى له، تلك التي كان يقودها د. حسن الترابي (ت ٢٠١٦)، الذي خسر النواة الصلبة للتنظيم وكل العسكريين، إلا بقيّة من المدنيين الذين دُرِّبوا على السّلاح؛ تصر الحكومة -في سنوات حياة الترابي، على تنسيبهم لخليل إبراهيم (قتل ٢٠١١) الذي قاد تمرّدًا عسكريًا في نواحي دارفور!
صار الحكم -إذن- لرجال الجيش المقربين من البشير، والمدنيين الإسلاميين التابعين لشيوخ مذكرة العشرة[2] التي خلقت المفاصلة، بالمناصفة للمرة الأولى بعد أن استتب الأمر في أوله للمدنيين فقط، وكان دور العسكر هامشياً. ولكن بالرغم من هذا التحوّل، فإن المدنيين من الإسلاميين عبر قادة الحركة الإسلامية الأذكياء؛ كالأستاذ علي عثمان محمد طه، والدكتور نافع علي نافع، حافظوا على السيطرة الحقيقية، متمكنين من مقابض السلطة، وتمكن بعضهم من إقناع رأس الدولة أن يحافظ على صلة مع المدار الذي تتزعمه إيران، ويندرج تحت الإخوان المسلمين؛ لا وفاءً لدَين محاولة اغتيال مبارك (1995) الباهظ، أو استثمارًا لاستضافة السّودان مجموعةً من المتخاصمين مع دولهم تحت اسم المؤتمر الشعبي الإسلامي؛ وإنما حفاظاً على قنوات اقتصادية بديلة عن النظام العالمي!
ظل الرئيس البشير ينظر للقيادات السياسية في البلاد بعقلية تتزايد فيها مساحة الضيق بالمدنيين، خاصةً المؤدلجين، وظلّ يدفع الإسلاميين ببعضهم؛ فيروّج المختصون بدراسة العلاقات داخل الإسلاميين، أن الرئيس البشير أقصى نافع علي نافع، عبر علي عثمان أو الفريق صلاح قوش، وفي النهاية، فقد أزيح الدكتور نافع باقتراحٍ من علي عثمان بأن يستقيل الشيوخ بمن فيهم هو نفسه، ومعه نافع، وذلك في العام ٢٠١١.
واستفاد من هذه المعارك الهامشية طرف ثالث أقصى الجميع، وحاول البقاء بوصفه عصا للرئيس ويدًا ثالثة. إلا أن الأمر لم يدم طويلاً قبل أن يجعل الرئيس هذا الطرف، واحدًا من أطراف اللعبة، التي يتخلص عبرها من الرؤوس المتنافسة، وتخلّص منه، مؤقتًا.
الذي يُصَدِّق هذا السياق من المعارك الداخلية، والمربعات المتفاصلة، يدرك أن بقاء الرئيس البشير، رهين بقدرته على الحفاظ على توازن القوى، بين الجميع. وبذلك يفسر سعيه إلى إعادة ضبط الهندسة الاجتماعية السودانية لسيرتها الأولى، قبل وصول الإسلاميين للسلطة؛ فقام باستعادة رموز شعبية؛ مثل تعيينه نجلي السيد الصادق المهدي والسيد محمد عثمان الميرغني. وقدم الدعم للتصوف، وأوقف موجة التشيّع؛ إيماناً منه بأن هذه الحركات كفيلة بإيقاف السند الشعبي الذي يتفوّق به رموز الإسلاميين عليه. ولكن الحركة الإسلامية استطاعت أن تستثمر جهودها في صناعة السخط عبر مظاهرات ٢٠١٣، في معركة داخلية تنافس فيها الطرفان (عساكر البشير؛ وإسلاميوه) على تجنب لقب “من هو سبب السخط”، فكانت حملة ٢٠١٣ المعروفة بمظاهرات سبتمبر (أيلول)، حملةً منظمة لإثبات أن الشعب مع المدنيين، وأن البشير مكروه وفاسد، ويعيش في عالمٍ منفصل عن الواقع، وأنه خان حتى الإسلاميين. الأمر الذي فطِن له البشير متأخرًا. فقاده ذلك للتحوّل الرابع.
التحوّل الرابع: البشير الجديد
قاد البشير التحوّلات السابقة بذكاء، ففي ١٩٩٤ أو قبلها، بدأ يتمرّد على شيخه الترابي، إلى أن تمكن من قيادة المفاصلة الشهيرة، بحجة أن رئيسين أغرقا المركب، ثم تاليًا تخلص من بعض الإسلاميين وأبدلهم بأناس أكثر تحررًا؛ مثل محمد أبو القاسم حاج حمد، قبل أن يكتشف أنّ عليه الحركة ببطء وأن لا يستخدم أحدًا من خارج عناصر اللعبة الأساسية، فخياراته هي أحزاب ما قبل ١٩٨٩، أو تيارات الإسلاميين المتفرقة. وليفتح الباب للمزيد، عليه أن يثب! فكان ما عرف بخطوة “الوثبة” أو تحوّلها، الذي دشّن لمرحلةٍ جديدة في تاريخ السياسة السودانية الجديدة، أكثر انفتاحاً واتساقًا مع شروط التخلّص من النظرة الأيديولوجية الضيقة.
يبدو “الرئيس” في وسط هذه المساحات مثل رجل يحتفظ بالخيارات الذكية لأوقات الأزمات، ويتمرّن عليها، فالسرعة التي أخرج بها خطاب الوثبة، كانت محيّرة، فهي وإن كانت استجابة لأحداث سبتمبر (أيلول) إلا أنّها أكثر ذكاء من فكرة الحوار الوطني. ومنح كل طرفٍ ما يُقنعه، فأسَرّ الإسلاميون لبعضهم أنّ عراب الإنقاذ هو صاحب هذا التحوّل، وأسرّ الاتحاديون لبعضهم أنّ هذا اقتراح من مولانا، بينما قال الأنصار، بأنّ الحوار الوطني سيسمح بعودة رئيس الوزراء، وعادت النسور المهاجرة إلى طاولة الحوار، بينما يتهامس المقربون من الرئيس بأن هذه اللغة الفلسفية هي لـ”سيد الخطيب”، القيادي في قطاع الفكر في المؤتمر الوطني!
بعد أحداث سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، سرعان ما تدارك البشير أن الضائقة الاقتصادية ستزداد، وعليه فتح الباب لتنفيس أكبر، وتحوّل مقبل، ولا يوجد ما يمنع التصديق بأنه كان جاداً في رغبته الانتقال لمرحلةٍ تؤهله للرحيل عن الرئاسة بشرف.
أعلن البشير حماسه لملف الحوار الوطني، واستضاف عشرات الأحزاب، وعيّن رموز المعارضين في مقاعد حكومية، وليضمن نجاعة ذلك التحوّل، جعله في قالب عربي، وأرفقه بسياسة تشبه السودان القديم ما قبل ١٩٨٩، فقطع علاقته بإيران، وبدل سلوكه مع جيرانه الخارجيين، وجعل هذا ضمن إعلانات الحوار، آملاً أن ذلك سيدفع الحلف العربي الخليجي لاستيعابه سياسيًا، ولدعمه على المحور القديم من الإسلاميين ونصرته، وتعويض ما كان يدرّه عليه محور الإسلام السياسي من مال عبر إيران وغيرها.
يقول البعض: إن الرئيس فعل ذلك، دون أن يخسر توازن التيارات “التنظيمية” داخل “الحركة الإسلامية”، التي انقسمت، بين من يُنَسّقون مع تيار إسلاميي تونس، أو تيارات تركيا الغولنية؛ والأردوغانية والأربكانية، أو تيارات إيران، أو تيار القرضاوي؛ وهذه التيارات متنافسة، ولكنها تتحالف بتقاطعات محددة. وظلت الدول المهتمة بالإخوان في السودان مثل قطر، تحصل على اهتمام باهت مقارنة بالتيارات الأخرى، لأسباب غير معروفة.
كانت أوراق البشير، تضعه في موقف جيد من الجميع؛ ففي مصر هو مع المشير السيسي، وإن كان لا يخفي ضيقه من الإعلام المصري، والمخابرات في عهد ما قبل الفريق عباس كامل (ولكنه يترك ملف الإخوان ورابعة على الطاولة دومًا)، وموقفه من إيران (تأييد السعودية والموقف في اليمن)، أما في تركيا (الموقف ضد جماعة غولن وانقلاب يوليو المزعوم) كان هو السائد حينها، ولكن بعد (٤) سنوات، أي في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وفور عودة الجنرال البشير من لقاء بشار الأسد: ستتبنى القنوات الإخوانية المصرية التي تبث من تركيا، الحملة ضد الرجل، بقيادة محمد ناصر ومعتز مطر وغيرهما، ولم يكترث البشير الذي لم يعد معجباً بأردوغان، ولم يعد أردوغان معجباً به، ربما بعد زيارة البشير لسوريا دون إذن من تركيا!
هذه هي الأوراق التي يشتري بها البشير، ولاء تيارات الحركة، ويحملها في حقيبة سفره حين زيارته لأيّ من هذه المحطات.
وتزامن ذلك مع تجارة بعض عناصر حكومته بالصمت تجاه ما يجري لإخوانهم المصريين، فإن أيد البشير السيسي علنًا بينما وجّه إخوانه بالحياد؛ تحرك الإسلاميون سرًا لتأليب الشارع ضد السيسي، واستضافة الفارين من الإخوان المدانين بالإرهاب، وغيرها من مواقف تنظيمية لم يتحصل لأحد يقين بتأييد البشير لها، أو حصولها أصلاً.
عاصفة الحزم… تدشين للجديد
هنا وصلنا إلى العام ٢٠١٥، والبشير، شأنّه شأن السودانيين جميعاً، واضح فيما يخص أمن الحرمين، ويدرك أنّ ما حدث لا مناص منه، ولكن الآخرين يقرؤون الصورة بشكل مختلف. فقد كانت عاصفة الحزم في نظرهم، هي قبلة الحياة، والموقف المناسب لحسم الضبابية، وورقة الفوز بقلوب المسلمين وأهل الخليج، وتأمين عبوره الذكي نحو المرحلة الجديدة، ولكن!
السوسة كانت تنخر عصاه التي ادّخرها لهذا اليوم. وكانت بقايا أحلام الإسلاميين بإمبراطورية “الدولة السودانية”، حاضرة في الدوائر القريبة، حتى تلك التي وافقَته في التقارب مع الخليج لغرضٍ غير الذي يريده؛ فهي أذهلها المال المنسكب على مصر، وتأمّلوا أن يكون السودان؛ سودانهم، أو هم، بديلاً لمصر المحظية!
بالفعل، تطوّر التنسيق الخليجي- السوداني بسرعة، قبل أن يصاب بانتكاسات بعد اتفاقيات مصرية- خليجية فهم منها أنها ضمت حلايب لمصر. كما انطلقت شائعات أن بعض الوسطاء الذين اعتمد عليهم الرئيس البشير، طمعوا أن يستقلوا عن البشير، ويخططوا للمستقبل دون مشاركة الرئيس. فانفتحت جبهة جديدة، ساعدها ظهور الخلاف القطري على الساحة.
الخلاف القطري، يحرج البشير أمام إسلامييه؛ فأنصار البشير من الإسلاميين كانوا يُغطّون خذلانه لإيران بالقول بأنّه لم يتخل عن الإسلاميين، بل يقف في حلفٍ تقوده السعودية وقطر وتدعمه تركيا!
أما بعد قطر، فقد صاروا مكشوفين. فحدث تردد يشبه الحياد. ولم يكن حياد السودان مبررًا، وصار يبحث عن المبرر، حينها اختلف مع ساعده الأيمن ومدير مكتبه، وخرج الخلاف وكأنّ البشير تعامل مع خيبة أمل كبرى، بحكمة ظاهرة ولطف. وصار، بفضل ذلك، أقدر الناس على الحياد.
في هذه الأثناء، كان الحوار الوطني انتهى أمده، وتحولت توصياته إلى مشروع عمل يقوده “رئيس الوزراء” الفريق، بكري حسن صالح، صديق البشير الذي اختير نائباً أوَّلَ بعد علي عثمان محمد طه ٢٠١١.
لا يجوز العبور على تجربة رئاسة الوزراء بسرعة؛ فكأنّ البشير غيّر رأيه، إذ أنشأ المجالس الرئاسية التي تضعف من قيمة مجلس الوزراء، بلطف، وهي تهتم بالاقتصاد والسياسة الخارجية، وربما تتجاوز الوزير المسؤول، ورئيس الوزراء نفسه. وبسببها استقال وزراء مثل إبراهيم غندور، الذي يدّخره المؤتمر الوطني، الآن، لمرحلة مقبلة!
المهم في هذا التأريخ “المتبني -عمداً- لنظرية المؤامرة”، هو التاريخ الذي بدأ فيه البشير رحلة التخلص من دولة “مكتب البشير”، التي لم يتمكن الجنرال مهندس محمد عطا، رئيس جهاز الأمن السابق وسفير السودان في واشنطن الآن، أن يتمها. وليتم هذا التفسير المؤامراتي، فأثناء الصراعات، يخرج البشير بأكثر من كرتٍ ذكي؛ فالقاعدة تقول: عليك تحطيم مراكز القوى القديمة، وبناء أخرى جديدة، تتسم بالضعف.
ومن يعصمك من بطش السوق؟
ولكنّ التحدي هذه المرّة جاء من تلقاء اتحادٍ خفي، لم يعد يراه، فتسارعَ تردي الاقتصاد، وانسحبت السُّيولة من البنوك عقب إشاعات مستعجلة، وسارت بين الناس إشاعات مصنوعة عن هزائم للجيش في اليمن!
عالميًا، سمح موقف النظام المحايد من أزمة قطر، بأن يتقارب الإسلاميون، بمفردهم أحياناً، وباسم النظام أحياناً أخرى، مع تيار الغنوشي القريب من تركيا.
وكانت هذه فرصة لهذا الجناح من الحركة الإسلامية ليعمل عليها، فقُدِّمت عملية إزاحة المقربين السابقين من الرئيس على أنها إحباط لمحاولة انقلابية، وأن الجهات الاستخباراتية التي ساعدت في الكشف عنها، هي جهات تركية. لكن البشير -أو الواقع- لم يشأ أن يمنح هذا الفوز للإسلاميين الأتراك كاملاً، فأفسد البشير فرحتهم، بمواصلة الحلف مع السعودية، والإفراج عن المتسببين في الخيبة الكبرى، وودعهم بهدوء!
خطوات حاسمة: فتح الممرات للخيارات كلها… سوريا، تركيا وإيران
ظل البشير ينظر للخريطة الكاملة ولا يتعامل مع تفاصيلها، وحينما قامت أمريكا بخذلانه هي الأخرى، إذ رفعت العقوبات جزئيًا؛ بدأت ملامح الارتداد نحو المربع الأول، ولم يأبه البشير حينها بأنه سيبدو وكأنه يريد أن يكشف للجميع، وخصوصًا من يظنون أنهم حلفاؤه، سواء من القوى التقليدية السودانية “الأحزاب” أو الدول الصديقة، أن خصومهم في السودان أقوياء، وأنه -هو وحده- أفضل ما يمكن أن يحصل عليه العالم من السّودان “الواقعي”، المقسّم على إسلاميين يتنافسون في التشدد، والإقصاء، والأحلام التوسعية.
لم ينتبه البشير أنّ هناك غير الخارج من يلتقط رسائله؛ إذ تحركت التيارات الإسلامية كلها واثبة عليه،؛ خاصة وأنه امتنع عن التعليق عن نيته للترشح للرئاسة، وعلّق لمقربيه قائلاً: “لدينا من يريد أشياء لا يقولها، وقبل أن نفعل أي شيء سنجعل الجميع يتحدث، بفعل صمتنا”.
سافر البعض من الإسلاميين السودانيين إلى طهران، بصفةٍ غير رسمية، ولا تفاصيل يمكن التكهن بها. أما البشير فقد سافر إلى روسيا، والتقى بالرئيس بوتين مباشرة، في نادرة لا يمكن فهمها، إذ كان السودان يكتفي بالتعاون في التصنيع العسكري، والحصول على الدعم الروسي في مجلس الأمن، دون تطوير ذلك إلى تنسيق أو طلب تحالف، كما ظهر في فيديو يزعم البعض فبركته.
وبعد عودة الرئيس من روسيا، نظر إلى مصر بغضب غير مفهوم، ثم صعّد السودان لهجته ضد مصر بوضوح، قبيل إعلان التحضير لاستقبالٍ تاريخي لأردوغان في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٨.
خلال الزيارة، وقع الطرفان (٢١) اتفاقية، في قطاعات مهمة، ومن بينها منحُ البشير تركيا الموافَقة على طلب تطوير “سواكن”، الجزيرة التي “احتلها” سليم الأول وجعلها مركزًا للعثمانيين في القرن الثامن عشر. واستغل أردوغان الاتفاقية للإعلان عن أن الحجاج الأتراك سيأتون أولاً لسواكن ثم إلى مكة والمدينة، وزار الرئيسان المسجد الحنفي والشافعي والآثار العثمانية في الجزيرة. وأضاف أردوغان للمشهد ما يثير، فقال: إن ثمة بنوداً “لن يتحدث عنها”. الاتفاقيات لم تدر أموالا كبيرة، ولن تفعل، فهي لا تتجاوز المليار -في أكثر أرقامها تضخيمًا- حسب إفادة أحد المختصين!
لم ير البشير في الأمر تهديداً لجيرانه، فهو يقول: إن تركيا على صلة بالجميع، ويضيف المقربون من البشير: وقبل كل هذا فهو لا يحب قيود الأصدقاء!
في الداخل المُطّلع، هناك علم بأنّ موقف البشير، غرضه هو تحجيم تغوّل جناح غولن على الإسلاميين في السودان، وهو رغبة أردوغانية في تعويض السودان الذي خسر بطرده لحركة خدمة.
في الطرف الآخر، المتخم بسوء الظن المبرر من النظام السوداني، أُخرج ميناء سواكن على أنه عمل عسكري، بينما يثبت البشير -حسب هذا السيناريو- حرّيته، ويرصف لنفسه الطريق للترشح لدورة انتخابية تالية، وهي تمر -حينها- عبر رضا الإسلاميين في السودان، وعبر هذه الخطوة، يريد ضمان تقديم كشف حساب يتضمن خطوات وحركات كبرى تثبت لهم أنه لم يتخل عن إسلاميته، تماماً.
تحركت وساطات دولية، ونشأ ما أسماه البشير بالديبلوماسية الرئاسية، التي بدأت تزيح وزير الخارجية، حتى استقال إبراهيم غندور بطريقةٍ درامية وحركةٍ يجزم البعض أنها مقصودة سيبين مغزاها بعد سنوات. استعادت المجالس الرئاسية الصلاحيات التي فوضها البشير لرئيس الوزراء، وعاد البشير للحكم المباشر مجددًا. خاصةً بعد أن بدأ وزراؤه ورئيس وزرائه بالتوافد على البرلمان لإعلان عجز الدولة عن مجاراة نقص الدولار، والسيولة. وفشلت حكومة الوفاق في حلّ أزمة الوقود؛ التي اختزلها كثيرون في التساؤل الساخر: “مكانها وين؟” وهو التساؤل الذي تهرّب وزير النفط آنذاك من إجابتة. ويقول الظرفاء: إنّ البشير سيعرف مكانها بعد ثورة 19 ديسمبر (كانون الأول) التي انتهت بسلخ إحدى أذرع الحركة الإسلامية (المؤتمر الوطني) عن البشير!
قبل ذلك، انتزع السودان اعتذارًا مصريًا نادرًا، قدمه الرئيس السيسي للرئيس البشير في إثيوبيا، ثم قام السيسي بزيارة للرئيس البشير، وقدم تصريحات تؤكد أنهم أسرة واحدة، وأن مصر لن تقدم على ما يضر السودان.
الانقلاب الاقتصادي والدعم السريع… والترشح البطيء
مرة أخرى، وجد الإسلاميون أنفسهم أمام واقع جديد، بطله هو البشير، الذي بان بوضوح أنه سيترشح للرئاسة!
حينها، كان الواقع السياسي يحكمه الحال الاقتصادي من جهة، والانتخابات المقبلة التي لم يترشح لها أحد إلى الآن، ولا يجوز ترشح البشير إلا بتعديل الدستور. ولم يطلب حزبه منه الترشح بعد، حينها. وهنا كل الاختبار.
الإسلاميون من طبقة النواة الصلبة للحركة الإسلامية ومن المدنيين، يقودهم رجل الأمن القوي نافع علي نافع. كشّروا عن أنيابهم -هكذا قيل- وبدؤوا بقيادة خط صرّح بشجاعة في الاجتماع المغلق للمؤتمر الوطني بضرورة اختيار خليفة للبشير من الحركة، وأن قرار خلافته قرار للحركة وليس له كفرد. يستند نافع إلى قاعدة تنظيمية لا يمكن كسرها، إلا عبر علي عثمان محمد طه. النائب الذي ضحّى بنفسه قبل ثلاثة أعوام لضمان تنحية نافع نفسه.
يد السوق الخفية لعب بها أحد ما، بظاهرية، فتضاعف الضغط على الاقتصاد، وبدأ كبار التجار بالإدبار عن دعمه، وربما التورّط بتخريبه!
فقد الجنيه السوداني قوّته منذ الاتفاق التركي، وصار يتهاوى، ففقد ربع قيمته أمام الدولار خلال أقل من شهرين. ليصل التضخم لـ(١٤٧٪)، وبأرقام Prof. Steve Hanke، هو التضخم الثاني على مستوى العالم، ولكن هذه النكسة لم تكن اقتصادية، إذ صدف أن التجار الذين يوفرون العملة لنظام البشير، قاموا بالتواطؤ مع جهةٍ ما، دفعتهم لوقف التعاون. فكانت الانهيارات. لا يمكن فهم هذا الانهيار بمعزل عن رغبات إزاحة البشير.
وتحركت يد رابعة تستخدم قوات الدعم السريع (التي يقاتل نحو “٢٠٪” منها في اليمن). وبين هذه الجهات يتفانى خصوم البشير. فنقل قوات الدعم السريع كلها من المناطق المهمة قرب العاصمة لتذهب إلى الحدود البعيدة في كسلا، بزعم محاولة مصرية إرترية لدخول السودان.
عودة الفريق صلاح قوش… مكافحة الفساد
فجأة، تقدم رجل الأمن الأقوى صلاح عبدالله قوش، مديرًا لجهاز الأمن القومي والمخابرات. مهما كانت عيوب الفريق قوش، إلا أنّ الهزيمة أمام “الدولة العميقة” -التي تتلاعب بالاقتصاد، أو التي تتوثب للعودة للحكم- لن تكون من بينها. وكان أن قام الفريق قوش في أول يوم عمل له، بإحالة عشرات الضباط الذين يتعاملون مع الدولة العميقة إلى المعاش، ليبدأ عصر جديد.
وانطلقت حملة لمكافحة الفساد، تهاجم أولئك الذين أخرجوا أموالهم من النظام المصرفي، وأطلقوا الإشاعات بقرب انهياره. نجحت الحركة في إثبات (أن الأموال خرجت لغرضٍ سياسي)، ولكنها لم تستطع أن تقنع الشعب أن يتوقف عن الفزع!
إذن، بدأ البشير يحرك التفاصيل التي لا يتحكم بها، لحماية خطته، وعهده المقبل، وإعادة دراسة تموضعه في الخارطة، وبدأ يجد خيوطًا غائبة تربط مخاوف الداخل ومخاوف الخارج.
ولكن… الانتخابات تقترب، والخيارات تضيق، وكل الحسابات تقول: على أحد ما أن يتحرك.
هنا يتحرك البشير ولكن إلى سوريا!
سوريا… طلاق لم يكتمل!
اتجه الرئيس إلى سوريا، وأعلن بهذا الاتجاه موقفًا جديدًا وبعيدًا عن كل التيارات الإسلاموية السنيّة. وقبل أن يصل إلى السودان، انطلقت القنوات الإخوانية في الهجوم عليه، ولم يعد هو رجل الحياد المحترم، كما كانت تتغنى القنوات، بل صار الديكتاتور الذي يجب أن تنفض الحركة الإسلامية يدها منه. وقبل أن يبدأ معركته، علم أنّ الهجمة أكبر منه، وعليه التعامل مع قاعدته الصلبة أولاً، واضطرته الإشاعات أن يرضخ للإسلاميين، فيقول مع أحد إعلامييهم التونسيين: إنه ليس تابعًا لإسرائيل، ولم يجز أن تفتح أجواء بلاده لها!
التحرّك العفوي اشتعل في البلاد، والشعب الكادح خرج في مسيراته الغاضبة، في البداية: للسُّكَّر والبنزين، ثم أضيفت إلى المطالبات، سلسلة أخرى بسقف مفتوح، صيغت بلغة تجمُّعِ المهنيين البديعة، وتنزّلت في أهازيج الشباب الثائر، لا ينافسها إلا أهزوجات برنامج “في ساحات الفداء” الذي كان نظام الجبهة يذيعه في التسعينيات، ولكنّ الأغاني والهتافات المصنوعة، صوب أغلبها نحو رأس النظام. خرج الإسلاميون بسنٍ صفراء يقولون للبشير: يا مصدر السخط، سننقذك! ويلوحون للجماهير، بأنّهم يملكون خارطة طريق، تخلّص الناس من البشير، وتمنحهم مرشحًا جديدًا، يختاره الإسلاميون.
فقد بدا واضحاً، أو أريد له حسب هذه التظاهرات، أن يظهر السخط الشعبي كله، وكأنه على الرئيس البشير أولاً، ثم على النظام، وهذا ليس منطقياً، بعقلية الأحزاب السودانية! طاف البشير داخل البلاد تطوافه، وسافر إلى الخارج، ولكنه لم يعد مرتاح البال من بلدٍ مثلما عاد من مصر، التي انطلق بعدها في استراتيجية واضحة ومتلاحقة، يعرف ما يقول فيها، بالحرف، وكأنه يحفظه. وبعد أن اطمأن إلى هدوء الأوضاع نسبياً، استأنف معركته الداخلية: بقرارات في فبراير (شباط) ٢٠١٩، فأعاد البشير ترتيب الخيارات: قدّم الجيش، وأخر الإسلاميين، وألغى الانتخابات!
فماذا فعل البشير؟
جمع البشير بعض القيادات السياسية في مساء ٢١ فبراير (شباط) ٢٠١٩، ثم في صباح اليوم التالي، وسرّب بعدها أنّه يعتزم إحداث نقلة سياسية كبرى في البلاد؛ وفي الخامسة من مساء اليوم ذاته، اجتمع الفريق صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني إلى قيادات إعلامية طلب منها أن تنوّر المشاهدين بقرارات مرتقبة أبرزها: ١- تخلي الرئيس عن رغبته في الترشح لولايةٍ جديدة؛ ٢- انسلاخ الرئيس عن حزب المؤتمر الوطني؛ ٣- حل الحكومة المركزية وحكومة الولايات؛ ٤- إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وأعلن أنّ كل ذلك سيصرّح به رئيس الجمهورية في الثامنة من مساء اليوم ذاته.
وفي مساء ذلك اليوم، المشهود، انتقلت أجهزة التلفزة إلى القصر الجمهوري؛ وتأخر الرئيس في الوصول إلى ساحة الخطاب لساعات، وتعمّد المجيبون عن سبب التأخير تأكيد أنّ الرئيس في اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني. وقبل الخطاب بدقائق وصل إبراهيم أحمد عمر وجلس يسار كبير مساعدي رئيس الجمهورية، ثم تلاه في الوصول بكري حسن صالح؛ وعوض الجاز؛ وربما علي عثمان وغيرهم، ثم وصل البشير.
حقق البشير قبل الخطاب، كل ما يريد أن يقوله، فهو أراد تأكيد أن الأمن وقواته تقف إلى صفه؛ وأراد الإعلان أن القرارات المتخذة اتخذت بمعزل عن المؤتمر الوطني، وأنّ اجتماعه مع المؤتمر الوطني كان لإعلامهم، فقط.
خطاب البشير بدأ بآيات توحي بتحكيم الشريعة كثابت لا منازعة فيه، ثم أكد البشير أن الأحداث انتهت ومضت، وتمّ دراستها، وأخذ العبر منها. أي إنّ التظاهرات انتهت!
وقد تضمن الحديث إشارة بامتنان إلى رصيده السياسي باتساق عكستها عباراته التي قالها: (الإنقاذ، الحرية، المجاهدات، فجر تولينا مسؤولية البلاد، مؤتمرات الحوار الوطني، النظام السياسي، الاتفاقيات للسلام، والحوار، الوثيقة الوطنية، الإرث الوطني القادر على الإجابة على الأسئلة الحرجة!…). وفتح الباب نحو خطاب جديد، فأشار إلى أنه مع (تمكين الأفراد والجماعات من السعي للحرية)؛ ثم شجب بث الكراهية، وأبدى حزنه على موت شهداء. وأعلن الانحياز للشباب، وطموحاتهم، وأكد ثقته فيهم. وهذا كله حديث غير ما يريد الناسُ سماعه.
ثم أعاد رؤية الأيام الخوالي (٢٠١٣) التي تدور حول (الحوار وجمع الشمل: التراضي والتوافق الوطني؛ كيف يحكم السودان، نظامه السياسي…)، وتلخصها عبارة: لا بديل للحوار إلا الحوار.
حذر من الخيارات الصفرية التي لن تحل مشكلة البلاد؛ لأن العملية الدائرية لا تبني وطنًا. ومثّل كلامه دعوةً للتحرك إلى الأمام لمقاربة متجددة، ومساراً يتأسس على (تجنب مصير الدول المنفلتة) عبر تمتين وثيقة الحوار الوطني، وتأجيل النظر في التعديلات الدستورية (التي كانت ستحمله لدورة خامسة)، وأعلن أنه يقف في منصة قومية وهي رئاسة الجمهورية، ليكون على مسافة واحدة بين الجميع، موالين ومعارضين. وتشكيل حكومة مهام جديدة؛ سيكلّف بها فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة، لإنجازها، إلى حين استكمال العملية الحوارية الوطنية “لوقتها الضروري”. وفرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لعام واحد.
انتشر الجدال حول إقرار قانون الطوارئ، هل هو تأجيل للانتخابات وتعليقها؟ وهل يعني تأجيل النظر في التعديلات، تأجيل الانتخابات بالضرورة؟ وهل يعني ذلك أن البشير قام بهزيمة أفضل أوراق المؤتمر الوطني ضده؟ فالمؤتمر الوطني يقول للبشير: نحن من نرشحك، وهو بهذا القرار يؤجل الانتخابات، ربما، إلى أن يؤهل نفسه ليكون رئيسًا قوميًا، أو لا يكون. وجعل المؤتمر الوطني في ورطة اختيار رئيس الآن، وهذا البديل سيكون مخيفًا جدًا للجماهير الواعية. والأيام ربما تكشف أبعاداً تختلف عن هذه.
وهل انتهت النظرة المؤامراتية؟
تبقى مساراتها مفتوحة، ولكنْ ثمة تفسير أكثر التصاقًا بالشعب. يفارق سور الحاكمين هذا، وينظر إلى جحافل الجيل الجديد، وهي تنتزع حقها عنوةً واقتدارًا، لا من نظام البشير وحده، بل من الطبقة السياسية كلها، وهنا تظهر تجلّيات لبعث سياسي جديد، تصلح أن تكون نظرة ثانية، تختلف عن مسار استحضار التاريخ السياسي.
تجليات البعث السياسي في السودان!
كيف يمكن توصيف البعث السياسي الجديد في السّودان؟ مع احترام عمق التحولات، والحذر من العبث بالمفاهيم وتجارة الأحلام؟
لا يوجد أهميّة لموقف مَن يتعاطى مع الواقع السياسي في السودان؛ إذا ما اتفق على ركائز جوهرية، منها: أن هناك بعثًا سياسيًا جديدًا في السودان، وثمة أزمة حكم ودولة فمجتمع، ثم للآراء من بعد أن تتفرع حول تقييم أداء النخب السياسية والحكومة والمعارضة والنخب والإعلام والمنظّرين. وليس من الحكمة فصل ذلك عن العالم.
يقود تأمّل حركة الهويات في العالم، إلى الانتباه لاستفادة وتطور “سياسات الشعبوية” من منصات التواصل “الشعبية”، سواء في تعزيز شعور “فئات محرومة من المجتمع” -بالذات المفقودة- واستحضارها. تلك المنصات، كسرت احتكار المعلومة، وبجانب إيجابياتها العظيمة؛ فقد صنعت واقعًا موازيًا، يعزّزه الخيال الرغبوي، وتُسيّره قليل من المؤامرات، دون أن يُقلّل هذا الوصف من حقيقة أن من يتحكم بالسياسات الشعبوية هم الجماعة الأكثر فاعلية على الأرض أولاً، وعلى مستوى القدرة على صياغة الخطاب الشعبوي ثانيًا.
حينما نصنع تصوراتنا عن الواقع من منصات التواصل الاجتماعي، علينا الحذر من فخاخ: التضخيم، التهوين، الاختزال، والرغبوية. وعلينا أن نتذكر أننا اخترنا النوافذ التي نتابعها لأننا نتقاسم عبرها الاهتمام ونتشاركه مع من يشبهنا، فمن الطبيعي أن تثير ما نتأثر به، لذا مهما كان حجم الحدث فهو سيصلنا ضخمًا، وحينما نسمع ما لا نحبه فإننا نصادق على تهوينه، أمّا ما يستكمل الجوانب الرئيسة في أي صورة -أي ما يمثل وجهة نظر الآخر- فنميل إلى اختزالها في صور نمطية سطحية لتكون هي المثال الأكثر تمثيلاً، ويتم إدارة كل هذه العملية -التقريبية- تحت ضغط من رغباتنا، ولا ندرك -غالبًا- أننا نعيش في عالمٍ من محيطها، فنحن هنا نسمع ما نريد عن ما يهمنا.
ما الذي يجري حقًا؟ جوهريًا
“جيل الإنقاذ النفطي”، كما وصفه رجل الأمن الأول، يثور على الواقع المقيّد ويضيق بالاستبداد الاجتماعي، كما عبّر قياديو الإنقاذ أنفسهم، واقترحوا أن يكون الحل بإطلاق الحريات الاجتماعية من جديد. هل هذا هو الأمر إذن؟
ربما هذا جواب المستعجلين لإيجاد حل، ولكنّه جواب يفجر تساؤلات كبرى حول الموقف من “الليبرالية الاجتماعية”؛ فالحريات المقترحة -إن كانت صادقة- لا يمكن أن تأتي دون ثمنٍ سياسي وفكري، والمصادقة عليها تجعل مطالب التغيير أكثر رسوخًا من ذي قبل! أما إن كانت تكتيكية، فهي انحناءة لموجة عالمية، يمتطيها الأذكياء، يمكن أن نسميها الشعبوية!
والشعبوية اليوم تجتاح الأمم الغاضبة، وتضع في شعاراتها ثلاثية “حلم استعادة الماضي، وإقصاء الآخر داخل الوطن، وكراهية الغريب”، وفيها يتجلى “الدفاع عن الشعب ضد الأعداء: النخب والغرباء والأمن”، وترفع شعارها الخلاب: “إعادة الحكومة إلى الناس البسطاء”.
الغريب قد يكون دولة مثل مصر الشقيقة، أو الخليج، واستعادة الماضي قد تُمَثّل في استعادة أسماء الأبطال التاريخيين للحضارة السودانية القديمة النوبية. ربما يُفسّر تجاوز المهدية -الغريب- لأنّها تمّ استخدامها من قبل المشروع الإسلاموي، وربما تمّ القفز على السِنّارية نفورًا من العرب نَسَبًا وانتسابًا. وربما لأسباب أخرى تتعلق بصراعات الغابة والصحراء!
وفي ذلك رجوع أو تراجع يحتاج إلى تفسير؛ هو قد يساهم في خلق هوية توحيدية للقُطر، ولكنه يطرح مخاطر مجهولة، لم يتم اختبارها بعد. ولكنّ هذه الهوياتية تُحدّد تصورات اليمين واليسار “بين الغرق في الماضي والأمل في المستقبل”.
التفرقة بين التيارات اليمينية والسياسية أمر ضروري لتحليل الراهن السياسي في أيّ دولة تعيش أحزابها السياسية في نظام “الدولة الحديثة”، ولكنّ هذه الضرورة تتلاشى في ظل حالات سيولة المفاهيم وتفكُّكها. فليس صعبًا الجدال بأن الإسلاموية السودانية في إحدى وجوهها كانت تمثل تيارًا يساريًا من حيث الأدلوجة الفكرية والإيمان باتجاه التغيير! وهنا يكمن جزء كبير من خلافات الرئيس البشير والحركة الإسلامية، وخلافات كل زعيم حزب مع قاعدته.
نَقدُ التنظير السياسي السوداني بأنّ اليمين واليسار يكتبان النص ذاته -ولكنّ أحدهما يفعل ذلك باليمين، والآخر باليسار- أمر قديم. ولكنّ الأهم هو نقد السياسات السلطوية التي تقسم المسرح إلى عنصرين متضادين: الدولة والمجتمع؛ فتلك ممارسة لا يمكن تجاوزها، لأنّها تؤدي إلى تقويض الدولة وتقسيم المجتمع ذاته والدولة ذاتها.
إذا وافقنا على النظرة الشعبوية المستعجلة، سيكون الهدف مما يجري اليوم، هو إنقاذ ضحايا “الليبرالية الجديدة”، عبر أنصار تيار جديد صاعد على أنقاض الرأسمالية.
على جمال “فرقعة” هذه الكلمات، يبدو التيار الجديد في السودان أوسع من فئات عمرية؛ إنها حالة وعي وتَطوُّر لفئات كانت لا ترى في السياسة شيئاً، ولا يهمها منها إلا بعض كلمات متباينة. ولكنها اليوم أدركت، بفعلٍ من وسائط التواصل الجديدة، وإكراهات الواقع، وانكشاف سوء التدبير الحكومي لجملةٍ من القضايا: أنّ السياسة قبل الاقتصاد. فأقبلَت عليها -كيفما اتفق. وهذا أمر له محامد كثيرة، لو تمّ التعاطي معه بصورة جيدة.
ربما يُنفِّرنا هذا التعقيد من التفكير في القضية من هذه الطبقات؛ فلم يعد اليسار يُعنى بصراع الطبقات من حيث طبقيّتها، ولم يعد اليمين متجذرًا في التمسك بالمحافظة، بل كانت حيويته في تكسير “المحافظة التقليدية” لخلق محافظة جديدة!
تظهر جاذبية الشعبوية على نقيض كل هذا التعقيد، وترتكز على نقاط مباشرة وواضحة وراسخة، ولا تستحي أن تمارس الصوت الإقصائي ما دامت الأغلبية تُردّده. لذلك جاءت المطالبات بسيطة ومباشرة وواضحة، وغير مكترثة بالمابعديات والعقابيل، مستخدمة أكثر الأصوات نعومة ومباشرة وخفة روح.
والآن؟
يلح على الأطراف كلها مطلبان: الأول عقلي، يتمثل في فتح الباب للنقد لا التشكيك، وتجديد نيّة التصويب لا التحقير، والثاني قلبي، يحصر استعادة مركزية المحبة التي يقوم عليها السودان “الروحي”. والثالث مزَجَهما للنظر للمستقبل لا الماضي السحيق أو القريب. ولكن هذا الأخير لا يمكن تحقيقه إلا بعد معالجات طويلة، لذا يمكن تجاهل إلحاحه مع استحضار فكرته.
يعيش السودان اليوم حالةً من حالات الشعبوية “العالمة”، وصعود “تعصّبات” على أنقاض الرأسمالية الظالمة، مع صعود هوياتية أفريقانية متجاوزة للإسلام والعروبة، تُمثّل انحيازاً أكثر رجعيةً من “الرجعية السنّارية” في قياسات المُدَدَ، ولكنها تحوي أمل انتعاش الحالة السياسية الراكدة وبعث “هياكلها” بتقديم خطاب محدّث، وربما تاريخ مسلسل يعيد فكرة التراكم لمداواة “الانقطاع” المجتمعي والسياسي!
مم نخشى؟ غير استنساخ خدع الساسة بتبديل وجوه النظام؟
تجارة الهويات، وشعبوية العنصرية، والردة المجتمعية نحو التطرّف، كلها أمور يُخشى أن تحرِف البعث السياسي الجديد. خاصة مع الإقصاء الأجيالي، الذي يجعل الحنين الماضوي ليس سوى خادم وزاد لحالة شعورية تستخدمه في رحلة الهرب من الحاضر. وليس ثمة زاد سوى المحبة لهزيمة الخطر المحتمل.
ولكن الدعوة إلى المساواة الاجتماعية، وتعزيز مكافحة العنصرية، وإيقاف سياسات التمييز بين الجنسين، وتعليم الحِجاج والتفكير الفلسفي، ودعم المجال الروحي، والانتصار للفلكلور كفن، وبعث الثقافة التقليدية القريبة، وإيقاف محاولات التغيير القسرية: سواء الرجعية أو التقدمية؛ ربما تمثل خيارًا لتوسيع آفاق التفكير في ترشيد الوعي المقبل.
ثورتان… لا ثالث إلا فيهما
من يؤمنون بهذا المسار يرون أن في السودان حركتين: ثورة الشعب على الإسلامويين، وانقلاب الإسلاميين على الرئيس. ولا يمكن أن تنجح إحداهما إلا بفشل الأخرى! بدأت ثورة الشعب بعد انقلاب ١٩٨٩، وانتظمت فيها سلسلة من الأعمال، تمايزت إلى سلمية وعنيفة. وانتصرت السلمية بالحوار والاقتناع والإحباط. وبدأ انقلاب الإسلاميين في ١٩٩٩ مع المفاصلة بينهم. وتضاعف بعد انفصال الجنوب.
يستخدم الإسلامويون لفظ الثورة لتغطية انقلابهم؛ كما استخدموا خديعة اذهب إلى القصر وسأذهب إلى المنشية؛ لتمرير الانقلاب على الديمقراطية في ١٩٨٩.
الخيار الثالث، لإنشاء وعي تشاركي تصالحي مع إدارة الرئيس؛ يُبنى على الإقرار بسيئة الانقلاب العسكري في ٨٩ والاعتذار العملي عنها، والتفاكر الحقيقي حول إدارة التحوّل الديمقراطي، وتحديث مواثيق تسجيل الأحزاب السياسية. ارتكبه بعض السياسيين، ولكنهم يعملون بصمت. كانوا إلى ما قبل قرارات البشير في فبراير (شباط) يقولون همساً: “خلافات الإسلاميين الحالية؛ صاحب كلمة الحق فيها هو أقرب إلى الباطل. التمديد بالدستور وإن كان به عوار، إلا أنه أفضل من عودة الحكم إلى المجلس الأربعيني وحكومة التنظيم الخالصة مجددًا”.
حقيقتان يظهرهما استعراض التاريخ القريب: الأولى أن الرئيس البشير لا يُحب أن يوضع تحت خيار واحد، ولكنْ ملجؤه -الذي يسوّق الآن- هو الابتعاد عن الحركة الإسلامية ومؤتمرها الوطني، والاعتماد على الجيش، ثم على الشعب، عبر خارطة انتقال موضوعية. والحقيقة الثانية، أن المتظاهرين شجعان وأذكياء، ولكن التاريخ السياسي، يقول: إن النضال شجرة تنتج أكثر من ثمرة واحدة؛ منها الثورة، وأخرى هي الحوار.
كيف نتجنب تدمير السودان
في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣، وقبلها بعام، كانت الإشارة إلى انهيار دول الجوار بداية من الصومال الحبيبة، مرورًا بالعراق وسوريا وليبيا، كانت هذه النماذج عبارات يسوّر بها العقلاء حججهم، ويضعونها في صدر حديثهم، وينتصرون.
ولكنّ الواقع المتأزم، بعث مثلاً سودانياً أرهق أكثر هؤلاء “مرحبتين حباب الشر محل ما بتق، وتنقد الرهيفة إن شاء الله ما تتلتق” وهو دعوة للتخلص من المخاوف بمواجهتها، وهو غضب لا يمدح، ولكنه يحصل.
زاوية النظر هذه المرة، لم تختلف، ولكنّها صارت أعمق، فلم يعد الخوف على الدولة، مثل الخوف على الشعب، فأغلب المشاكل يمكن حجبها بتأهيل المجتمع لمصارعة الخطابات التي تفتت اللحمة، وتفترس المستقبل. كأن يصير الحديث عن الهوية هو النزاع الأوحد، أو يخوّف التيار المحافظ، بشعارات بعيدةٍ من الواقع، تجعله عدوًا لكل تغيير. أو أن يغذى كل تيار بعناصر العنف.
إذ يشاهد المراقب، ما يجري في سوريا والعراق وليبيا، ينظر بعين قلقة على تلك الشعوب في المستوى الأول، وهي شعوب متعلمة طالما يُنظر إليها في العالم العربي على أنها مصدر فخر، فقد نالت أوائلها الحظ الأوفر في التعليم والمعرفة، ولكنها تعيش اليوم محنة أكبر من أن تنحصر أو تنزوي، أزمة تهز بلدانهم، وتتطور لتشمل المنطقة كلها.
كيف انكسرت هذه الأمم الكبرى، وكيف غزاها التطرف، واشتعلت نيران الفتنة فيها، وأصبح الدم قوتًا لبعض أهلها، والانتقام وعد الصباح، وصار عداد الضحايا صاعدًا بلا توقف؟ هل انقضت الحكمة أم ماتت الرؤية أم إن الخيوط باتت أكبر من أن تجمعها يد واحدة، أو تراها عين؟ وماذا عسى المكلوم الحزين أن يستفيد من مشاهدة هذه الأشياء؟
إن التفرقة الدينية، والتمييز الثقافي بين مكونات الشعب الواحد، داخل إطار الدولة الواحدة، يتسبب بخلق أزمة بعيدة المدى، تنفجر في لحظات حرجة، كما جرى في العراق، إذ وظّف خصومه التمذهب السني والشيعي، في الحرب، واليوم، فعلاج أي قضية في هذا البلد العظيم، تمر عبر آلاف الفخاخ الطائفية.
حينما يتمايز الناس على أساسات لها تاريخ، يصبح كل شيء مسمومًا؛ بيئة المواطنة، وفضاء الأفكار، ويتلوث الهواء بالكراهية، التي لم تأت فعلاً من الاختلاف بين مذهبين أو جهتين أو عرب وفرس وكرد، ولكن لأن أحدًا ما، استطاع أن يلعب على أوتار هذه الاختلافات.
إذن الوصفة المثالية لتدمير الشعوب، تكمن في إحياء التفرقة، المذهبية والمناطقية والعرقية، ولكن المنطق يقول: ما دمنا نعرف وصفة مثالية للتدمير، يجب أن نحصل على وصفة مثالية للحماية والوقاية؟
صحيح، فالدولة التي تريد أن تحفظ شعبها، عليها أن تحصّنه بقيم احترام الآخر، وتعزيز ثقافة التسامح، وتأكيد مبادئ المساواة أمام دولة القانون، ورفع قيمة الوطن والدولة أمام كل شيء سواهما. وما الدولة سوى صنيعة الشعب!
يحتاج السودان، اليوم، شأنه شأن كل بلدان المنطقة، إلى ثقافة تسوية، وخارطة طريق، وتوافقيات لبناء المستقبل، وتفادي الحرب الأهلية، وإلى فهمٍ عميق، يتجاوز المقالات الانطباعية والعبارات الهتافية.
[1]– المحبوب عبدالسلام؛ أحد أبرز الكوادر الإسلامية، تمتع بلغةٍ رفيعة وأصدر بعد مفاصلة الإسلاميين، كتابًا تحت عنوان: دوائر الضوء وخطوط الظلام. شارك في تحريره نفر من الشباب المعاون له.
[2]