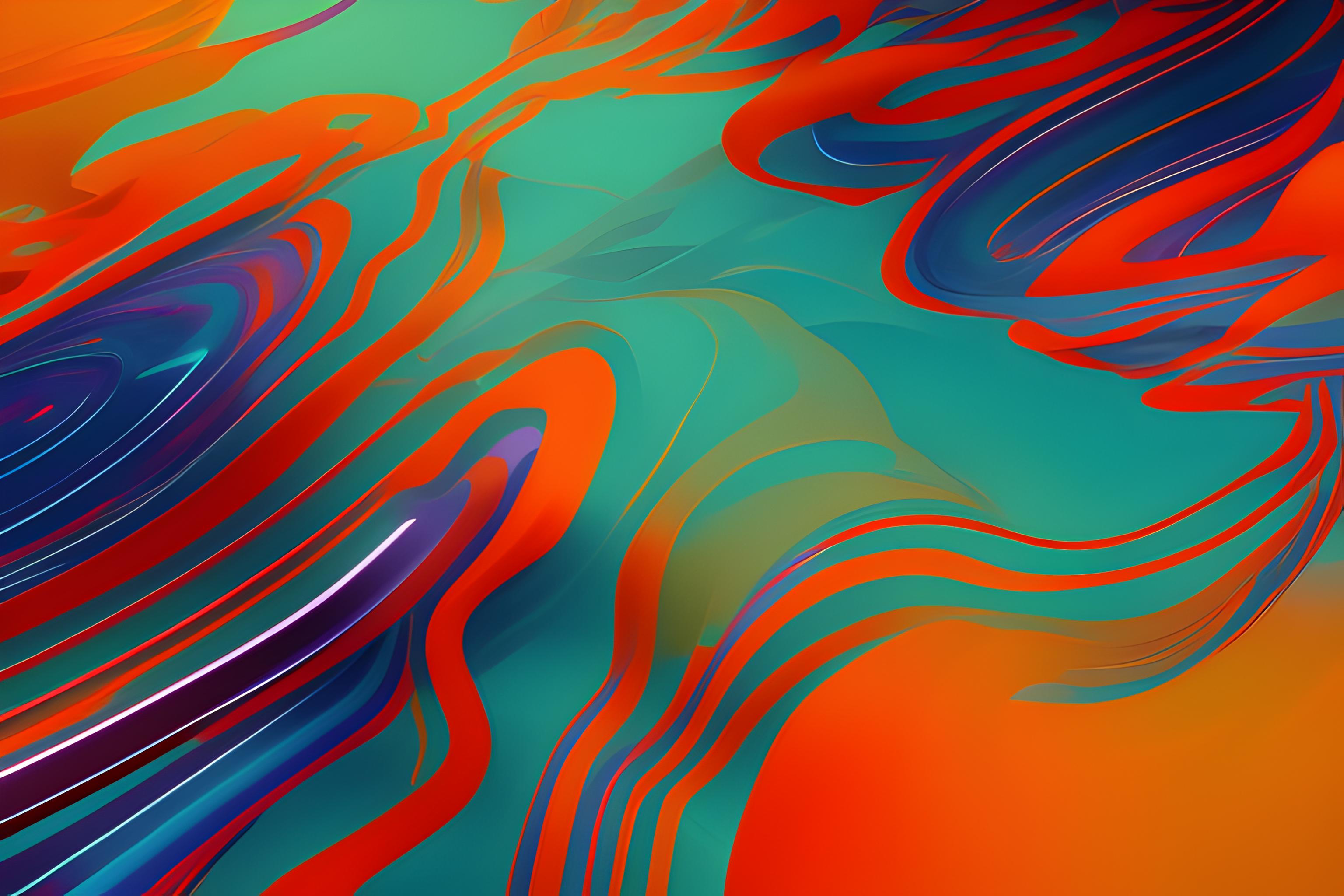ترجمة: سامي خليفة[2]
ترجمة: سامي خليفة[2]
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل كيفية وسبب توظيف القيادة القطرية عام 2011 للثورات المندلعة في مناطق من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كفرصة لنشر نفوذها الإقليمي، بدلاً من أن ترى فيها تحدياً لبنى اقتصادية أو ديمقراطية وسياسية.
في الوقت الذي تضافرت فيه التطورات الإقليمية عام 2011، مع غياب أي احتمال لحدوث أي اضطراب محلي مدبر في قطر نفسها، وهو الأمر الذي منح صانعي السياسات القطرية المجال لمزيد من التدخلات في هذا النطاق. إضافة إلى ذلك، كانت ثقة قطر بنفسها في ذروتها في أعقاب نجاحها في الفوز باستضافة كأس العالم (فيفا) 2022، والذي أدى إلى فجوة ضارة بين النوايا السياسية والإمكانات البنيوية، التي أعاقت بمرور الوقت أثر المبادرات القطرية على امتداد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير. جعلت كل تلك الإجراءات من قطر لاعباً جديداً على الساحة الإقليمية في الوقت الذي بدأت فيه قوى لها وزن ثقيل راسخ في المنطقة، تخبو.
تضم الأمور التي سنستكشفها غياب الضوابط أو الضغط المحلي على عملية اتخاذ القرار، التي تتم من أعلى الهرم إلى أدناه وعلى أيدي نخبة النخبة في قطر، والأسباب التي دفعت قطر لاعتناق توجه التغيير في 2011 بدلاً من مقاومته، ولماذا تختلف علاقة قطر بجماعة الإخوان المسلمين عن علاقة جيرانها الإقليميين بهم؟ وأهمية الثروة الهائلة التي خففت معاناة المواطنين القطريين من المصائب السياسية والاقتصادية التي حدثت في أمكنة أخرى. ونظراً لضعف احتمال تأثرها بالانتشار المعدي للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، ومع نهوض الثورة في تونس ومصر التي تركز أساساً على القيم العالمية للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والحرية السياسية والاقتصادية، كان هناك الكثير من المكاسب من إبداء موقف ظاهر للعيان بوضوح ضد الاستخفاف السلطوي في شمال أفريقيا، وسوريا واليمن. إضافة إلى ذلك، كانت تكلفة فرصة القيام بذلك منخفضة جداً في البداية، نظراً لأنه من غير المحتمل أن يرتد تعبير قطر الصريح عن تضامنها ودعمها المادي لحركات المعارضة في أمكنة أخرى عليها في عقر دارها، في الوقت الذي يجب أخذ الجهود القطرية بجدية، كمساهمة على المسرح الإقليمي والدولي.
لكن مع ذلك، سنلحظ أيضاً أن دعاة الإصلاح لم يكونوا غائبين تماماً في قطر، وسنستكشف كيف اختلفت ردود أفعال المواطنين القطريين كأفراد على الربيع العربي عن ردود فعل القيادة. إضافة إلى ذلك، ازدادت حدة التوتر بين «الشكل» و«الموضوع» وتحدي تحويل سياسية التدخل المبدئية إلى متابعة مستمرة. وثبتت صعوبة استبدال الشبكات الشخصية بالأطر المؤسساتية الفعالة على المستوى المحلي وفي المنطقة، مع حدوث حالات عديدة من التراجع إلى الخلف. وسيقوم الجزء الأخير بتفحص التداعيات الإقليمية من سياسات الناشطين القطريين نحو الاحتجاجات العربية، وتقييم التحديات التي تواجه الأمير الشاب الجديد الذي تولى السلطة في يونيو (حزيران) من عام 2013 في الوقت الذي كان فيه المد الإقليمي يتحول ليصبح ضد قطر.
نظراً لتمتعها بفوائد مزيج مثمر للغاية يضم عدداً محدوداً من السكان واحتياطات طاقة هائلة، قادت عائلة آل ثاني التي تحكم قطر عملية تحول السياسة المحلية والخارجية في أواخر التسعينيات وبداية الألفية. وتحت قيادة الأمير حمد (الذي حكم من عام 1995 إلى 2013) وحمد بن جاسم، رئيس وزرائه النافذ بين عامي 2007 و2013، حازت هذه الدولة الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن المليون نسمة وفق إحصائيات عام 2006، الاهتمام العالمي بتحولها إلى قوة إقليمية ذات وصول عالمي متزايد. ووصلت استراتيجية التدويل العدائية والدعاية للدولة ذروتها في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2010 عندما حصلت قطر بشكل مثير على استضافة كأس العالم (الفيفا) لعام 2022. وبعد خمسة عشر يوماً فقط، أشعل بائع الفواكه التونسي محمد بوعزيزي النار في نفسه، وعن غير قصد، حرّك سلسلة من الأحداث التي أشعلت شرارة الثورة في العالم العربي.
التغيير بين الأجيال
يعود نهوض قطر في بداية الألفية جزئياً إلى مجموعة من السياسات المختارة التي اتبعها الأمير ورئيس وزرائه. ولا يجب التقليل من شأن هذا؛ فالأمير حمد كان جزءاً من مجموعة من قادة العرب في هذه «الألفية» الذين ورثوا السلطة في أواخر التسعينيات وبداية الألفية، وكان المجتمع الدولي المتلهف لإحداث الإصلاح في الشرق الأوسط يتأمل منهم الكثير، على الأقل في بداياتهم. لم يواجه أمير قطر تحديات بعد أن أطاح بوالده في يونيو (حزيران) 1995. وبالفعل قام بقليل من التحرير السياسي في البلاد، إلا أن إعادة تشكيل مشهد الطاقة في البلاد احتل مركز الاهتمام، حيث إنه حدد بداية عقد من النمو الاقتصادي القوي. في تلك الأثناء، نال تحديث الأمير لشبكة تلفزيون الجزيرة وتوسيعها الاستحسان لطريقتها الجديدة في عرض الأخبار وتغطيتها في المنطقة، مما حسّن من المفهوم القائل: إن قطر مختلفة نوعاً ما.
وفي غياب التقييدات التي تفرضها القيادات الكبيرة في السن أو العاجزة، ونظراً لامتلاك قطر لموارد وفيرة تدعم ثقل القوة الناعمة، وفر اندلاع الاحتجاجات الجماعية في تونس ومصر وليبيا في بداية عام 2011، الفرصة لقادة قطر لإعادة تأكيد أنموذجهم المميز للتطور السياسي والاقتصادي، فيما بدا إيثاراً حميداً وبطريقة في غاية الوضوح في البداية. بعد فترة مبدئية من الحذر في يناير (كانون الثاني) 2011، سرعان ما لاحظ المسؤولون القطريون الملامح المتغيرة للربيع العربي وقاموا ببراغماتية بإعادة تعديل استجاباتهم السياسية. وسمح غياب الضوابط المحلية عن عملية اتخاذ القرار للمسؤولين بقيادة الأمير ورئيس الوزراء، بإعادة تموضع قطر -بشكل غير مناسب- كبطلة للثورات الشعبية في شمال أفريقيا، لتصبح فيما بعد لاعباً خارجياً مهماً في الحرب الأهلية السورية.
عكست تصرفات قطر الواضحة للغاية خلال الربيع العربي حقيقة أن صنّاع السياسة الأكبر عمراً في البلاد لم يشعروا بالراحة، من حيث سرعة التغيير الإقليمي واتجاهه في 2011. وشكلت التصرفات القطرية «استمراراً لسياستها الخارجية النشطة والمتنامية خلال العقد الماضي» كما ذكر الأكاديمي الفلسطيني خالد الحروب.[3] أما المختلف فهو أن التطورات الإقليمية في 2011، المترافقة مع الغياب المفيد لأي احتمال لحدوث أي اضطراب محلي مدبر في قطر نفسها، منحت صناعة السياسة القطرية المجال لتصبح أكثر حزماً وشمولية. ومن خلال العمل بطريقة قوية نحو البلاد وأنواع الأنظمة التي اعتبرت «غير ضرورية»، سعى الأمير ورئيس وزرائه أيضاً للتقليل من ضعف قطر أمام أي انتقاد لغياب التحرر السياسي في عقر دارها[4].
وبالرغم من انتساب قطر رسمياً إلى الوهابية والتزامها بالمذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي، الذي يؤكد على طاعة الرعايا سياسياً لولي الأمر، والمختلف بشكل هائل عن الطبيعة الشعبية والناشطة لحركة الإخوان المسلمين، فإن هذا لم يمنع قيام روابط وثيقة بينهما، والتي تمتعت بعمق تاريخي نبع من تدفق عناصر الإخوان المسلمين الهاربين من ملاحقة الحركات الوطنية والاشتراكية في مصر أيام الرئيس جمال عبدالناصر في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، ومن سوريا بعد أحداث حماة عام 1982. وكما هو الحال في دول الخليج الكبرى، فقد عمل الكثير من القادمين الجدد كمدرسين وموظفين مدنيين، وكانوا أساسيين في صوغ الآراء السياسية لجيل الشباب في الخليج ككل. إلا أن تعميق الصلات مع الإخوان المسلمين في التسعينيات، ميز قطر عن موقف دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وزرع بذور اختلاف السياسات، والذي ظهر بوضوح بعد عام 2011 [5].
وبالمقارنة مع ترويض حركة الإخوان المسلمين في الكويت (وفي السعودية بدرجة أقل)، قامت قطر بتوسيع روابطها مع الفروع الإقليمية للحركة وتنويعها، بينما أبقت الباب موصداً بإحكام على أي نشاط لها في البلاد. وبالرغم من حصول يوسف القرضاوي وغيره على منصة لهم عبر قناة الجزيرة بعد تأسيسها عام 1996، فإنهم وغيرهم من المنفيين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، كانوا يقيمون في الدوحة بناء على تفاهم ضمني ينص على امتناعهم عن التدخل في الشؤون المحلية أو التعليق عليها. مما أسس لتمايز واضح بين المجالات المحلية والإقليمية للنشاطات، وحدد النشاطات المسموحة من تلك المحظورة. وكما يذكر بيرنارد هايكل: «قامت قطر بعمل أفضل في إدارة طاقات الإخوان وتوجيهها نحو العالم الخارجي»[6].
وكانت نتيجة التواصل القطري مع الشخصيات الإسلامية عبارة عن روابط وثيقة مع العديد من قادة المعارضة الذين تم إعدادهم للعب أدوار رئيسة في الحركة الثورية في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن. كانت الثورات الشعبية في البداية مدفوعة بطلبات عالمية مثل الحرية السياسية والاقتصادية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية أكثر من الأهداف أو الأغراض الإسلامية المحددة. لكن القدرة التنظيمية الأعلى للإسلاميين السياسيين، عنت أنهم كانوا قادرين بشكل غير متكافئ على الإفادة من فرص التشاركية والانتخابات التي ظهرت. مما منح قطر ورقتي ضغط في الدول التي تعاني من اضطرابات الربيع العربي؛ هما الروابط الفردية من خلال المنفيين المستقرين في الدوحة والذين عادوا إلى بلادهم الأم، والنفوذ المؤسساتي مع ظهور جماعة الإخوان المسلمين كلاعب قوي في التحولات السياسية.
بعض الضوابط المحلية
إضافة إلى الشعور براحة أكبر من الدول المجاورة نحو توجه التحول السياسي في العالم العربي، أفادت القيادة القطرية أيضاً من حرية المناورة النسبية التي تتمتع بها على الصعيد المحلي. وكما هو حال الأنظمة العائلية الحاكمة الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، تمتع آل ثاني باحتكار لمواقع اتخاذ القرار العليا، خصوصاً في «الوزارات السيادية» مثل الخارجية والدفاع والداخلية (حتى يونيو/ حزيران 2013 وتعيين خالد بن محمد العطية وزيراً للخارجية)، إلى جانب منصب رئيس الوزراء نفسه. إلا أن تركيز السلطة في دائرة ضيقة من الأعضاء الكبار في العائلة الحاكمة لا يميز قطر في حد ذاته.
إن ما ميّز قطر عام 2011 كان الغياب شبه الكامل لأي نوع من المطالبات السياسية، المنظمة أو غير الرسمية على حد سواء، والنابعة من المواطنين القطريين. كانت معادلة الموارد- الطلب في قطر ملائمة جداً عام 2011، مما جعلها متفردة عن باقي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عنى استبعاد أي احتمال لحدوث حالة من عدم الرضا الاقتصادي أو السياسي ذات الأهمية على الصعيد المحلي، إذ تجاوزت مستويات الناتج المحلي للفرد بين المواطنين القطريين معدلاً عالياً بلغ (440.000) دولار أمريكي، ووفرت ثروة البلاد الهائلة عازلاً قوياً في وجه انتشار اضطرابات الربيع العربي. كما قادت في النهاية إلى درجة من اللامبالاة السياسية، وخنق التطلعات الديمقراطية مع شعور قلة فقط من القطريين بالميل لهز القارب وتحدي الوضع الراهن؛ وبينت نتائج مسح الشباب العرب السنوي أن نسبة المشاركين الذين قيموا الديمقراطية على أنها مهمة تقلصت إلى أكثر من النصف متراجعة من (68%) عام 2008 إلى (33%) فقط في 2010 [7].
كان القلق الموجود في قطر محدوداً بطبيعته، ويتركز ضمن دائرة من المثقفين القطريين الذين بدؤوا في التشكيك بسرعة بتوجه استراتيجيات التنمية الوطنية لعهد قوة النمو الاقتصادي. وتركز ذلك بشكل خاص حول حالة عدم التوازن الديمغرافي التي حولّت المواطنين القطريين إلى أقلية تتناقص باستمرار بين السكان. ففي صيف عام 2012، نشر علي خليفة الكواري، أحد أشهر الأكاديميين والكتاب القطريين بياناً بعنوان: «الشعب يريد الإصلاح.. في قطر، أيضاً». احتوى الكتاب الذي تمت طباعته في بيروت على إحدى عشرة مساهمة من كتاب وأكاديميين قطريين يرغبون برفع «صوت جماعي من أجل الإصلاح في قطر» بعد أن وجدوا أن الطرق الرسمية لإيصال وجهات نظرهم غير مناسبة. وبما أنه مشارك بارز جداً ومنذ أمد طويل في الدوائر الأكاديمية الخليجية، قام الكواري بتنظيم اجتماعات شهرية للمفكرين والمثقفين في مجلسه في الدوحة منذ شهر مارس (آذار) 2011. ودعا البيان الناتج عن هذه الاجتماعات لزيادة شفافية الحكومة، ومشاركة المواطنين في الديمقراطية في قطر، وشمل مواضيع في الدستور، والنظام القضائي ودور القانون، واستخدام عائدات تصدير الغاز، ومشاكل الهوية والتعليم وتراجع دور العربية، وصولاً إلى حالة عدم التوازن الديمغرافي ونقد استراتيجية قطر الوطنية للتنمية الحرة[8].
اجتماع المصالح
ومع ذلك، فإن اندلاع الربيع العربي في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010، وبدايات يناير (كانون الثاني) 2011 وضع قطر في موقف حاسم، وبما أنها كانت تشعر بنشوة فوزها باستضافة كأس العالم 2022، والارتفاع الصاروخي للاعتراف الدولي بها، فقد أفادت قيادتها من فرصة جعل قطر بعيدة عن المشاكل التي تؤثر على المنطقة الأعم. ونظراً لضعف احتمال تأثرها بالانتشار المعدي للاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية، ومع نهوض الثورة في تونس ومصر التي تركز أساساً على القيم العالمية للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، والحرية السياسية والاقتصادية، كان هناك الكثير من المكاسب من إبداء موقف ظاهر للعيان بوضوح ضد الاستخفاف السلطوي في شمال أفريقيا، وسوريا واليمن. إضافة إلى ذلك، كانت تكلفة فرصة القيام بذلك منخفضة جداً في البداية، نظراً لأنه من غير المحتمل أن يرتد تعبير قطر الصريح عن تضامنها ودعمها المادي لحركات المعارضة في أمكنة أخرى عليها في عقر دارها، في الوقت الذي عملوا أيضاً على أخذ الجهود القطرية بجدية كمساهمة مسؤولة على المسرح الإقليمي والدولي.
وبشكل مشابه لكثيرٍ، إن لم يكن لغالبية المحللين والمذيعين، تباطأ المسؤولون القطريون (وقناة الجزيرة) في الاعتراف بالحركة الاحتجاجية المتضخمة في تونس حتى وصولها إلى العاصمة، وتمثيلها لخطر محدق على ابن علي. حتى إن الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي ليوم العمل المصري بتاريخ 25 يناير (كانون الثاني) لم تحظ إلا بالقليل من الاهتمام نسبياً، وحتى لحظة بدء التظاهرات التي حفزت ثمانية عشر يوماً من الثورة ضد مبارك، كانت الجزيرة تبث أفلاماً رياضية وثائقية[9]. لكن ما إن أصبح حجم ما كان يجري في مصر واضحاً، اعترفت القيادة القطرية بسرعة بالتحولات الهائلة في المشهد الإقليمي، وقامت بتعديل سياساتها وفقاً لذلك. وساعدتها الجزيرة في ذلك، والتي أصبحت «نقطة محورية للمشاهدين في كل مكان للمشاركة في الاحتجاجات الثورية» من خلال تغطيتها الأسطورية على مدار الساعة للثورة التي تتكشف ملامحها في ميدان التحرير بالقاهرة[10].
هناك ثلاثة عوامل جعلت من مثل هذا التغيير السريع في السياسة القطرية ممكناً. أولها: هو التركز الكبير لعملية صنع القرار من أعلى الهرم إلى أدناه في قلب النخبة الحاكمة في الدوحة. حيث تفاعلت دائرة صنع القرار المحدودة هذه مع الهيكلية الشخصية للغاية للسلطة في الدوحة، لتسمح بحدوث تغيير مفاجئ في الاتجاه دون الحاجة لتصفية الاقتراحات عبر طبقات من البيروقراطية أو طلب موافقة تشريعية. كما كان حجم قطر الصغير عاملاً لعب لمصلحتها، إذ يعني ذلك أن عدد المصالح أقل، أو أن الفصائل المتنافسة ضمن دوائر صنع القرار أقل مما هو الحال عليه في دول أكبر مثل المملكة العربية السعودية. وقد ارتبط ذلك بالتفسير الثاني لحرية قطر الكبيرة في التصرف، والتي تتمثل في غياب الضوابط المحلية على صناع السياسات كما ورد سابقاً. فهيكليات النخبة صانعة القرار غير مرتبطة بمطالب محلية مهمة، مما سهل بشكل كبير إعادة توجيه السياسة القطرية بعد يناير (كانون الثاني) من عام 2011. وتقاطع كل ذلك مع عامل ثالث، هو الاتجاه الأولي «لمسار» الثورات العربية والمتوازي مع السمعة الدولية الضخمة التي تملكها قطر كلاعب مبتكر وحيوي في الشرق الأوسط، يبحث عن منصة عالمية ليعلن نفسه منها.
وفر «الخليفة» العربي فرصة للقادة القطريين لتمييز أنفسهم وبلادهم بوضوح في المنطقة، ولادعاء موقف رفيع المستوى أكثر نحو «المعايير العالمية» مثل الحقوق السياسية والإنسانية وحرية التعبير، بأقل كلفة ممكنة بالنسبة لهم. الأمر نفسه ينطبق على الجزيرة، والتي اختبرت «لحظة اختراق» من خلال تغطيتها التي لم تخف شيئاً للمراحل الأخيرة من الثورة المصرية والثورة التالية ضد نظام العقيد القذافي الديكتاتوري في ليبيا. وخلال الأسابيع المشوشة القليلة الأولى للربيع العربي، حيث بدا لوهلة على الأقل أن كل شيء ممكن، وبدا أن العالم بأسره يراقب. كانت الجزيرة بفضل ارتباطها مع قطر، الذي عُني بفعالية أن الإمارة كانت في موقع لصياغة الروايات الآتية من الربيع العربي وحوله (وخلقها في الواقع).
وبما أنها أصابت الرأي العام العالمي بالذهول بحصولها على استضافة كأس العالم (الفيفا) قبل شهر واحد فقط، فقد كان الاعتراف الدولي باسم قطر في ذروته. إضافة إلى ذلك، كان حصولها على استضافة كأس العالم يستند بشكل كبير إلى اختلاف قطر نوعاً ما عن الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفر الربيع العربي فرصة مناسبة لإظهار هذا الاختلاف البلاغي بوضوح على أرض الواقع. وتم ذلك بشكل مباشر من خلال كلمات وأفعال القادة القطريين، وغير مباشر من خلال تغطية الجزيرة للثورات (وإن بدرجة غير متساوية). وكانت النتيجة أن الديبلوماسية القطرية كانت في مقدمة محاولات جمع الأبعاد الإقليمية والدولية لردود الفعل السياسية على الربيع العربي، خاصة في الأشهر الفوضوية الأولى.
عنت الطبيعة المغلقة لصناعة القرار في قطر أنه من المحتمل أن تبقى الدوافع المحددة التي تقود عملية إعادة توجيه السياسة القطرية تحت حماية مشددة، ويصعب على المراقبين الخارجيين اختراقها. لكن هناك نظريات أخرى. فقد ذكر ديفيد روبرتس (David Roberts) من (روسي قطر) (RUSI Qatar) أن تحليل السياسة القطرية أمر معقد نظراً لغياب الشفافية والتوثيق الرسمي للسياسة، وأوراق المواقف في نظام حكم هرمي من الأعلى إلى الأدنى لا هوادة فيه. وفي مقالة نشرت عام 2012 في (ميدتيريان بوليتكس) (Mediterranean Politics) يقترح روبرتس أن: «لا توجد خطة استراتيجية واسعة النطاق لا في وزارة الخارجية ولا في الديوان الأميري في قطر، لتقوم برسم وتوجيه السياسة الخارجية القطرية، قبل وأثناء وبعد الربيع العربي»[11]. وبدلاً من ذلك تقول لينا الخطيب، الرئيس المؤسس لبرنامج حول الإصلاح والديمقراطية العربية في جامعة ستانفورد: إن هناك انتهازية براغماتية تكمن وراء «احتضان قطر السريع للثورات»، «فما إن تغيرت قواعد اللعبة مع قدوم الربيع العربي، حتى كان على قطر أن تتبنى أساليبه بسرعة لتبقى متقدمة في اللعبة السياسية»[12]. وكلاهما محق من حيث النقاط التي يطرحها، ومن المحتمل أن غياب الضوابط المحلية أو الإقليمية على صناع القرار القطريين عام 2011 سمح لقيادتها بتغيير المسار بسلاسة للاستفادة القصوى من تغيير التيارات السائدة التي تجتاح العالم العربي. وبالتالي، وبينما يقترح مهران كامرافا أن قطر كانت رائدة نوعٍ من «القوة الخفية» فإن التعبير الأكثر واقعية سيكون «القوة الانتهازية» حيث تصرف الأمير وحمد بن جاسم نحو السياق الإقليمي المتغير ببصيرة أكبر ومجال مناورة أوسع من نظرائهما.
عرض القوة القاسية والناعمة
تقاطع غياب الضوابط المحلية على صناعة القرار في البلاد مع الديناميات المتغيرة للأحداث الإقليمية. وفي المراحل الأولى، بالكاد شكل الربيع العربي تهديداً مباشراً على قطر أو على مصالحها في الخارج. ومثّل نظام القذافي الزئبقي في ليبيا منصة آمنة يمكن استناداً إليها القيام بموقف دعائي رفيع المستوى ضد إساءة الحكم السلطوية والديكتاتورية. إضافة إلى ذلك، فإن سحب الشرعية الدولية من أسد سوريا وفر فرصة مماثلة لقطر. وفي كلا الحالتين، تم تقديم الانتقال من التوسط في البيئات المتأثرة بالنزاعات إلى الدعوة إلى التدخل على أنه خطوة طبيعية في نطاق السياسة القطرية، بالاستفادة من بعض العوامل الأخرى مثل: مستوى النخبة، صناعة القرار الهرمية من الأعلى إلى الأدنى، والقدرة على حشد جميع جوانب الدولة الرأسمالية لتحقيق أهدافها. وعلاوة على ذلك، فقد شرع ذلك إعادة تموضع الأهداف القطرية مع «القيم العالمية» بطريقة لقيت صدىً قوياً لدى المجتمع الدولي للمراقبين والمحللين.
وهكذا أقحم القادة القطريون أنفسهم في دوامة الديناميات الإقليمية والسياسات العالمية المتغيرة. وسمح الموقع الفريد نسبياً للأمير وحمد بن جاسم بالقيام بدور قيادي في الاستجابة لأحداث الربيع العربي. حيث عنى فشل القوة الصلبة المذكور أعلاه أن الباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه لأنصار القوة الناعمة من النوع الذي أمضت قطر سنوات في استحقاقه خلال العقد الأول من الألفية. وبما أن العولمة تكافئ مفهوم «السلطة» في حد ذاته والقنوات التي يجري نقلها عبرها، فإن قطر، والدول الصغيرة في سياق مختلف، كن قادرات على إظهار كيف يمكن لدول صغيرة لعب دور في العلاقات الدولية في كل ما يتناسب مع حجمها[13].
اجتمعت جميع العوامل الرئيسة لسياسة قطر الإقليمية بعد شهر فبراير (شباط) 2011. أما الجديد في رد فعل السياسة على وضع ليبيا ثم سوريا، فكان نتيجة قرار جمع نطاق أدوات القوة الناعمة مع القوة العسكرية الصلبة لدعم الأهداف الإقليمية. وحددت هذه المعايير الجديدة النقلة التي لم يتم التحدث عنها كثيراً في التعامل القطري، من دور الوساطة الديبلوماسية إلى السياسة الخارجية النشطة المبنية على التدخل. ولبضعة أشهر من ربيع عام 2011، تحدى الربيع العربي الأفكار النمطية في المنطقة بعقليات غربية. تم ترويج دور قطر خاصة في ليبيا، واستخدامها لمزيج من أدوات القوة الصلبة والناعمة كرافعة لشعبيتها لدى القوى الغربية في المجتمع الدولي، والذي نظر إلى هذه الدولة على أنها صلة الوصل لتسهيل تدخله في العالم العربي، خاصة فيما يتعلق بصنع السلام وإرساء الديمقراطية وإسقاط الحكومات.
وبما أن تقارب ردود الفعل القطرية والغربية نحو الربيع العربي في بدايات عام 2011 كان متوافقاً مع الرغبة القطرية بالوصول إلى موقع محاور مستقل بين العالم الغربي والشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، حيث كانت فرصة العمل مع القوى الغربية لوضع نهاية لنظام القذافي هي ما وفر فرصة مهمة لقطر لتنفيذ الدور الذي حاكته بعناية لنفسها. ولعبت قطر فيما بعد دوراً حاسماً في الحفاظ على العلاقات الغربية- العربية خلال المرحلة الأولى من الأزمة السورية، عندما دفعت الجامعة العربية للتصرف في الوقت الذي تعطلت فيه جهود مجلس الأمن الدولي، وفي الوقت نفسه حافظت على بقاء القنوات الديبلوماسية، واحتمالات القيام بعمل متعدد الأطراف بين الطرفين مفتوحة. كان نجاحهم في جعل قطر دولة محورية بالنسبة للحوار الغربي- العربي واضحاً في الثناء الغربي المبدئي على الدولة. فقد عبر وزير الدفاع الفرنسي جيرارد لونغيت عن مشاعر الكثيرين من خلال حديثه الحماسي (فيما يتعلق بمشاركة قطر في فرض منطقة حظر الطيران فوق ليبيا): «إنها المرة الأولى التي نرى فيها هذا المستوى من التفاهم بين أوروبا والعالم العربي».
حتى إن ثناءً أكبر أتى من الرئيس أوباما في نهاية الاجتماع مع الأمير حمد في البيت الأبيض في أبريل (نيسان) من عام 2011، فقد علق علناً قائلاً: «لم نكن لنتمكن، كما أظن، من تشكيل تحالف دولي واسع القاعدة من هذا النوع، والذي لم يضم بين صفوفه أعضاء حلف الناتو فقط، بل ضم أيضاً دولاً عربية، دون قيادة الأمير»[14]. لكن الكلام الصادق ظهر عندما تحدث أوباما بنبرة مختلفة تماماً في تلك الأمسية نفسها في ملاحظات غير حذرة في عشاء لمتبرعين خاصين في شيكاغو، دون أن ينتبه إلى أنه كان يتحدث عبر ميكروفون مفتوح، وقد لخص الرئيس وجهة نظره بالأمير كما يلي:
«إنه شخص نافذ جداً، وهو داعم كبير ومشجع كبير للديمقراطية في كامل منطقة الشرق الأوسط. وأنتم ترون الإصلاح، والإصلاح ثم الإصلاح على الجزيرة. الآن، هو نفسه لا يقوم بإصلاحات مهمة. ليس هناك حركة كبيرة نحو الديمقراطية في قطر، ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن متوسط دخل الفرد في قطر يبلغ (145.000) دولار في العام مما سيخفف الكثير من المشاكل»![15]
ازدياد الحدة
حتى في هذه المراحل المبكرة من عامي 2011 و2012، عندما كانت الآمال مرتفعة بأن الربيع العربي سيؤدي إلى تغيير عميق في المنطقة، كان دعم قطر لحركات المعارضة محدوداً -حسب الدعاية- بالسياقات التي لا تفرض تهديداً ملموساً أو أيديولوجياً على الاستقرار المحلي. لكن لاحقاً حدث ما كان كافياً لتوليد حدة ملموسة مع جيران قطر في مجلس التعاون الخليجي، الذين نظروا إلى الاضطرابات المتتالية بحذر وخشية أكبر. وفي الوقت الذي زادت فيه قطر من حجم استجابتها الواسع النطاق في المنطقة للربيع العربي، تسببت تصرفاتها الإقليمية في إحداث فجوة متنامية مع دول الجوار. ظهرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أعقاب ثورات الربيع العربي في 2011 كمهندسي السياسات التي تهدف إلى التخفيف من عواقب حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وهو الأمر الذي تعتقدان حدوثه بسبب تدخلات من جانب إيران أولاً ثم الإخوان المسلمين وداعميهم ثانياً[16].
ولّد صعود نجم الإخوان المسلمين في تونس ومصر في أواخر عام 2011 وبدايات 2012 توتراً شديداً بين المسؤولين في الخليج، بشأن روابط المنظمة المفترضة والممتدة والعابرة للدولة. وظهر دليل خلال عام 2012 على تصميم المنظمة على توحيد جهودها السياسية في مصر، وقيادة حملة لزعزة استقرار إقليمية ضد من يرفضون التسليم بنوايا خيرة للجماعة، وتفوقت على إيران كهدف لبيانات الاتهام الصادرة عن عواصم دول الخليج.
وهاجم يوسف القرضاوي، المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في برنامجه الأسبوعي «الشريعة والحياة» على قناة الجزيرة الإمارات بالقول: «إن الإماراتيين بشر مثلنا، وإن كانوا يظنون أنهم أفضل شأنا، فهم مخطئون… وليس لهم حكم على الناس أقوى من غيرهم»[17].
أثارت هذه التعليقات غضب الخليج، وأججت أزمة ديبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة ومضيفيه القطريين. ورد خلفان بإصدار مذكرة اعتقال بحق القرضاوي، في الوقت الذي حذر فيه المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في مصر الإمارات العربية المتحدة، من أن كامل العالم الإسلامي سينهض للدفاع عن القرضاوي في حال إصدار مذكرة الاعتقال تلك. ثم قامت الجزيرة بتدخل تحريري وحذفت بعض تعليقات القرضاوي التحريضية، مما منع ظهورها مجدداً في إعادة البرنامج»[18].
وعلى الرغم من أن الخلاف بشأن القرضاوي اندمج في الخلافات السياسية بين المسؤولين في القاهرة والخليج، فإنه سلّط الضوء على موقف مختلف تماماً تتخذه قطر والجزيرة من جماعة الإخوان المسلمين. وبدا أن تحقيق الجماعة لمكاسب انتخابية في تونس ومصر يضعها في مصاف المستفيد الأكبر من الربيع العربي، أصبحت مواقف دول مجلس التعاون الخليجي نحوها أكثر صرامة. وخلال عام 2012، ترابطت هذه المواقف المتباينة أيضاً بدعم قطر لمجموعات الثوار السوريين المقاتلين المتنافسة. وقوضت معركة النفوذ على الإسلاميين الإقليميين التي شنتها الدوحة، من البحث عن موقف موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن المشاكل الأمنية الداخلية والخارجية. وبالتالي أصبحت العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي المنفردة تحت الضغط، مع تعبير المسؤولين الخليجيين بشكل ضمني (وعلني أحياناً) عن مخاوفهم بشأن دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وإمكانية ارتداد ذلك الأمر ضمن دول الخليج[19].
توجهت بالتساؤلات الكبيرة والشكوك الصريحة على الأهداف القطرية واستثماراتها الكثيفة، والتي لا تعد ولا تحصى في مصر، والتي تتضمن التزاماً غامضاً لم يتم تحديده أبداً ووصل إلى (18) مليار دولار على مدار خمس سنوات، والذي تقدمت به عام 2012؛ وهو عبارة عن سلسلة من المشاريع المشتركة والاستثمارات في القطاع المالي المصري؛ وأكثر من (8) مليارات دولار على شكل مساعدات مصممة لدعم الاقتصاد المصري المتداعي؛ وصفقة تزويد بالغاز للتخفيف من انقطاع الكهرباء خلال الصيف الحار، واستثناء للشركات المصرية من النظام القطري الذي ينظم عمل الشركات الأجنبية من العمل محلياً؛ واتفاقية غامضة تم توقيعها بين المدعي العام المصري حول تطوير التعاون القضائي والادعاء المشترك مع قطر. وفي وجه هذا التراجع، قال الكاتب المصري بسام صبري: «للمصرين ظاهرياً الحق في الشعور بالشك، إذ لا توجد أمور كثيرة مجانية في الحياة، ومن الطبيعي أن نتساءل عن السبب، الذي يدفع قطر لوضع ثقلها خلف مصر، وخلف الإخوان المسلمين بشكل خاص كما يبدو»[20].
وحيث إن التقارب الوثيق بين قطر والإخوان المسلمين، على الصعيد الفكري من خلال وجود يوسف القرضاوي في الدوحة، والعملي من خلال الدعم القطري لفصائل الإخوان المسلمين في سوريا ومصر وأماكن أخرى في شمال أفريقيا، قد أثار توترات جديدة في علاقات الدوحة الإقليمية والدولية، تقول لينا الخطيب: «إن غياب استراتيجية متكاملة في سياستها الخارجية، يجعل قطر عرضة لمصادر عدم الاستقرار المحلية والدولية»[21].
واجهت القيادة القطرية الجديدة سيناريو مشابهاً بعد تولي السلطة في 25 يونيو (حزيران) 2013. وتسببت الإطاحة بالحكومة المصرية بقيادة الإخوان المسلمين في القاهرة في الأسبوع التالي، في دخول الدوحة إلى وضع الحد من الأزمات، وأجبرت الأمير الجديد،على ادعاء النأي بنفسه عن متابعة سياسات والده، وبشكل وثيق أكثر، عن سياسات حمد بن جاسم. وبالمثل، فإن ما ترتب على ذلك كان أثر سياسة قطر الإقليمية والخارجية على عودة مصر إلى وضعها السابق تحت الحكم العسكري. ومثل تراجع الثورات العربية في شمال أفريقيا تراجعاً مهماً وكبيراً في أهداف قطر الإقليمية، ووضع الأمير الجديد أمام تحدٍ فوري في السياسة الخارجية، يتمثل في إعادة تعيين دعم البلاد للمجموعات الإسلامية المرتبطة بالإخوان المسلمين.
منذ شهر يوليو (تموز) من عام 2013، أظهرت تطورات الأحداث في مصر والمنطقة بشكل عام، حجم التحدي الذي تواجهه القيادة القطرية في محيط ما بعد الربيع العربي المعادي. وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة عن عدم ثقتها بالقيادة القطرية من خلال أزمتين ديبلوماسيتين في 2013-2014 ومجدداً في 2017، ترافقت الأخيرة بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة أيضاً. ومنذ الأسابيع الأولى في الحكم، واجه الأمير تميم تدريب «الحد من الخسائر» وحاول جاهداً إعادة بناء روابط الثقة مع جيرانه الإقليميين. دفعت سياسات قطر ما بين عامي 2011 و2013 بالسعوديين والإماراتيين، ليصبحوا أكثر تدخلاً بأنفسهم، لمواجهة التحركات القطرية الهادفة لتوجيه سرعة ومسار التغيير في الدول التي مر بها الربيع العربي. وأخيراً، عمل ضعف الديبلوماسية العامة القطرية في شرح سبب اتباع سياسات أو تصرفات معينة، على إحداث فراغ في المعلومات مما شجع ظهور الشائعات والتكهنات التي تستمر في العودة لتلازم القيادة القطرية الجديدة بعد سبع سنوات من بدء الربيع العربي. فخسرت سمعتها وأوراقها التي بدأت بها مغامرة الربيع، وفقدت الجزيرة والقرضاوي الموثوقية والتأثير.
[1] زميل في شؤون الشرق الأوسط، معهد بيكر للسياسة العامة في جامعة رايس (the Middle East, Rice University’s Baker Institute for Public Policy).
[2] مترجم لبناني.
[3] خالد، الحروب، «قطر والربيع العربي، «مؤسسة هاينريش بول، بدون تاريخ، على الرابط التالي:
[4] ماثيو، غراي، قطر: السياسات وتحديات التنمية (بولدو، كو: لين رينير، 2013)، ص209.
[5] برنارد، هيكل «قطر والإسلامية»، نوريف بوليسي بريف، فبراير (شباط) 2013، صفحة2.
[6] المرجع السابق، ص2.
[7] كريستين، كواتس أولريشسين، «قطر والربيع العربي». أوبن ديمقراكسي/الديمقراطية المفتوحة، 12 أبريل (نيسان) 2011.
[8] «الناشطون القطريون ينشرون مسودة للإصلاحات»، المونيتور، 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2012.
[9] لينش، الثورات العربية، ص.90
[10] المرجع السابق.
[11] ديفيد، روبرتس، «فهم أهداف السياسة الخارجية القطرية»، ميديرتاين بوليتكس/السياسة المتوسطية، 17(2)، 2012، ص233.
[12] ليندا، الخطيب، «تورط قطر في ليبيا: توازن دقيق»، 7 يناير (كانون الثاني) 2013، مؤسسة السلام العالمي/وورلد بييس فاونديشن، على الرابط التالي:
http://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2013/01/07/qatars-involvement-in-libya-a-delicate-balance
[13] كريستين كواتس أولريشسين، «دول صغيرة بدور كبير: قطر والإمارت العربية المتحدة في نهضة الربيع العربي»، جامعة دورهام، منشورات صاحب السمو الملكي الشيخ ناصر المحمد الصباح، الرقم التسلسلي: 3، 2012، ص8.
[14] «أوباما يثني على قائد قطر لمساعدته في التحالف الليبي»، رويترز، 14 أبريل (نيسان) 2014.
[15] «أوباما: لا حركة كبيرة نحو الديمقراطية في قطر»، يو إس توداي، 16 أبريل (نيسان) 2011.
[16] ف. غريجوري، غاوس، «هل السعودية تعادي الثورات فعلاً؟»، فورين بوليسي، 9 أغسطس (آب) 2011.
[17] بيرول، باسكان، «مراجعة واشنطن للعلاقات التركية والأوروآسيوية، أبريل (نيسان) 2012، على الرابط التالي:
http://www.thewashingtonreview.org/articles/the-police-chief-and-the-sheikh.html
[18] نشرة أخبار دول الخليج، 36 (920)، 22 مارس (آذار) 2013، ص4.
[19] «الصعود الإسلامي يزيد من التوتر في الخليج»، الملخص التحليلي اليومي من أكسفورد، 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012..
[20] بسام، صبري، «لماذا تدعم قطر مصر، لماذا الكثير من المصريين غير متحمسين»، المونيتور، 17 أبريل (نيسان) 2013.
[21] لينا، الخطيب، «السياسة الخارجية لقطر: حدود البراغماتية»، العلاقات الدولية، 289 (2)، 2013، ص437