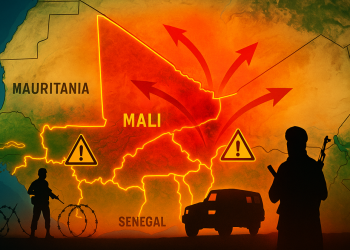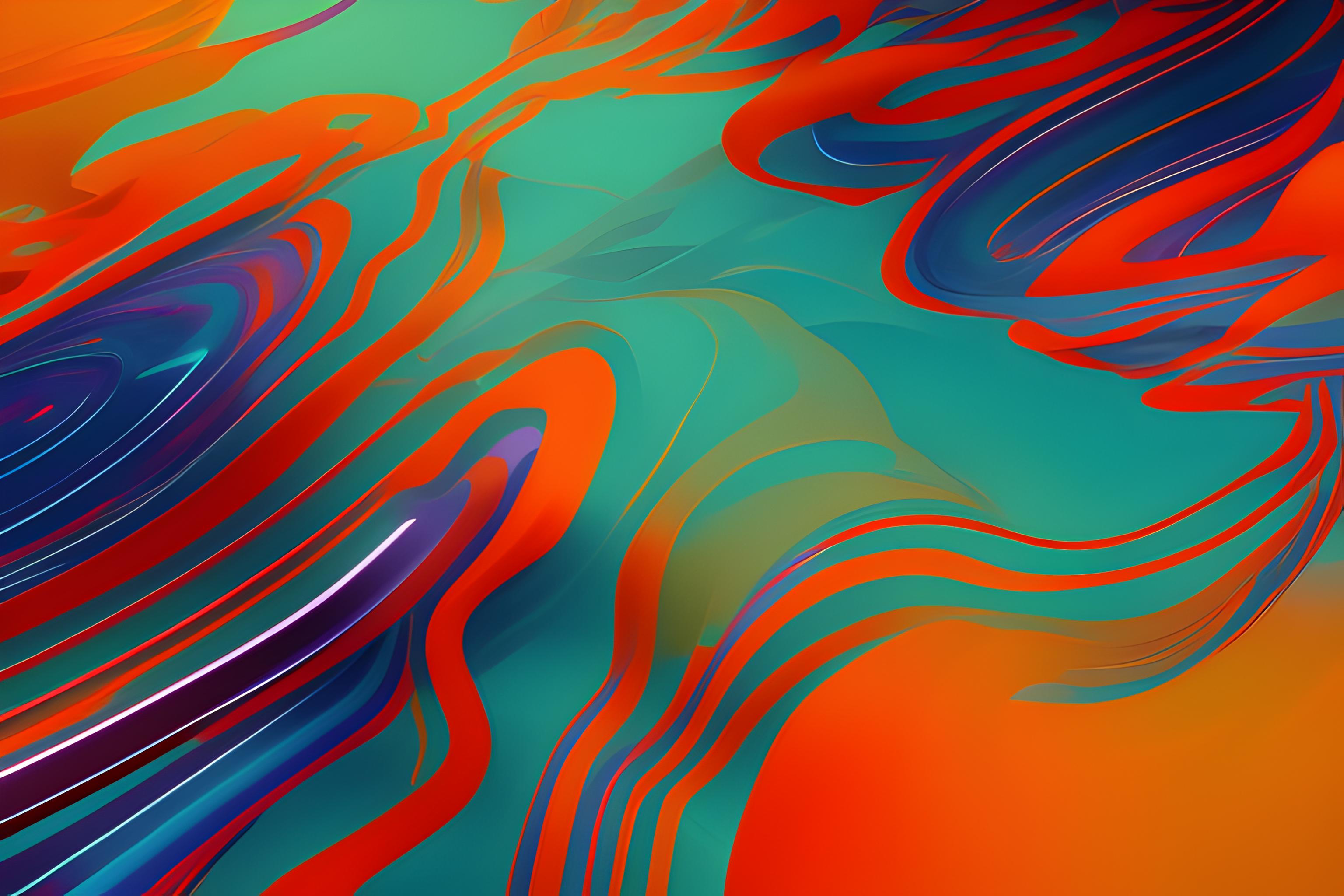أحمد بان[1]
 عاشت جماعة الإخوان المسلمين عمرها الطويل بين الأنظمة المختلفة: ملكية وجمهورية، وعيونها مصوبة نحو حكم مصر حتى أدركته بعد عقود طويلة من الصراع مع كل الأنظمة التي تكيفت معها وصارعتها، حتى ثورة 25 يناير التي حملتها على أجنحة ضعف البنيان السياسي المصري سواء الذي جسدته أحزاب مصر وقواها التي تفرغت للنضال بالحناجر عبر الفضائيات، أو المؤسسة العسكرية التي لم تجد كياناً متماسكاً تعهد لمصر به قانعة بإدارة المرحلة الانتقالية في أعقاب تنحي مبارك، بما توفر لها من نزاهة ووطنية لم تخلُ من سذاجة وضعف في الرأي والتدبير، بينما كان الإخوان يحكمون بناءهم التنظيمي ويعدون الماكينة الانتخابية التي مكنتهم من الاحتفاظ مع حلفائهم من المجموعات الإسلامية الأخرى بأغلبية مقاعد البرلمان المصري بغرفتيه: الشعب والشورى، بعد أن طلقت الجماعة شعارها الأثير «مشاركة لا مغالبة» منخرطة بعنف في مغالبة القوى الأخرى من دون رحمة، حتى إنها نكثت بعهدها للمصريين عشية ثورة يناير بأنها لن تنافس على مقعد الرئاسة.
عاشت جماعة الإخوان المسلمين عمرها الطويل بين الأنظمة المختلفة: ملكية وجمهورية، وعيونها مصوبة نحو حكم مصر حتى أدركته بعد عقود طويلة من الصراع مع كل الأنظمة التي تكيفت معها وصارعتها، حتى ثورة 25 يناير التي حملتها على أجنحة ضعف البنيان السياسي المصري سواء الذي جسدته أحزاب مصر وقواها التي تفرغت للنضال بالحناجر عبر الفضائيات، أو المؤسسة العسكرية التي لم تجد كياناً متماسكاً تعهد لمصر به قانعة بإدارة المرحلة الانتقالية في أعقاب تنحي مبارك، بما توفر لها من نزاهة ووطنية لم تخلُ من سذاجة وضعف في الرأي والتدبير، بينما كان الإخوان يحكمون بناءهم التنظيمي ويعدون الماكينة الانتخابية التي مكنتهم من الاحتفاظ مع حلفائهم من المجموعات الإسلامية الأخرى بأغلبية مقاعد البرلمان المصري بغرفتيه: الشعب والشورى، بعد أن طلقت الجماعة شعارها الأثير «مشاركة لا مغالبة» منخرطة بعنف في مغالبة القوى الأخرى من دون رحمة، حتى إنها نكثت بعهدها للمصريين عشية ثورة يناير بأنها لن تنافس على مقعد الرئاسة.
لم تصمد الجماعة لشهوة الحكم الذي بدا ثمرة حان قطافها، من دون أن تدرك أن الثمرة قد تكون مسمومة ولن تسد جوعها أو تروي ظمأها، ولكن أشواق الجماعة الطاعنة في السن التي عاشت عمرها في انتظار تلك اللحظة لم تتمهل لتسمع للحكماء من داخلها أو خارجها، ومضت في طريقها لا تلوي على شيء.
مع تجربة الإخوان في الحكم بدا الحلم الذي عاشته هي كابوساً لجل المصريين، عاماً عصيباً لم يعرفه المصريون من قبل وصفحة بائسة في تاريخهم. طوت مصر صفحة الإخوان المسلمين كقوة مؤهلة للحكم بحكم تاريخها السياسي، ولقد أسهم الإخوان في التعجيل بطي هذه الصفحة بكفاءة منقطعة النظير، وفي سرعة قياسية، ولن تنفع مقاومتهم في استعادة القبول الشعبي الذي توافر لهم، ذات لحظة قدرية، فرفع مرشحاً قيادياً في صفوفهم إلى سدة الرئاسة.
كانت الفرصة أجمل من حلم، وجاء السقوط أقسى من كابوس عليهم. كانت فترة انتقالية بين ثورتين، لا هم أطلقوا الأولى، وإن كانوا أعظم المستفيدين منها، ولا هم تنبهوا إلى أن ممارساتهم في الحكم هي التي تسببت في انطلاق الثورة الثانية، لا هم عرفوا كيف يحكمون، وها هم بعد السقوط المدوي لا يعرفون كيف يراجعون تجربتهم، تمهيداً لأن يعودوا إلى موقع المعارضة، بعدما اكتووا بنيران الحكم الذي فشلوا أن يسوسوه فخلعهم([2]).
مضت الجماعة بعيب بنيوي داخلها تمثل في أنها لم تهضم التنوع داخل جسدها، ولم تكن مؤهلة بتركيبتها القطبية التي طرأت عليها في العقود الثلاثة من حكم مبارك لمصر، ومن ثم لم تكن قادرة على هضم تنوعات وطن كمصر بمسلميه وأقباطه والتنوع الفريد في ثقافته وتاريخه الغني.
لكي نفهم أسباب السقوط التاريخي للأيديولوجيات السياسية المتطرفة كالنازية والفاشية والشيوعية لا بد لنا أن نحلل بعمق أسباب سقوطها، ليس فقط لتعارضها الكامل مع مسار تاريخ التقدم الإنساني، ولكن أيضاً للضعف الكامن في بنيتها الفكرية، وهكذا سقط حكم الإخوان المسلمين نتيجة أسباب متعددة، أبرزها عجز محمد مرسي الرئيس السابق لحزب «الحرية والعدالة» والذي أصبح رئيساً للجمهورية عن إدارة الدولة، وفشله الذريع في إقامة توافق سياسي يضمن استقرار المرحلة الانتقالية، من حيث وضع دستور توافقي تشارك فيه كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والممثلون الحقيقيون للشعب المصري.
إذا أضفنا إلى ذلك السعي المنهجي لجماعة الإخوان المسلمين في مجال «أخونة الدولة وأسلمة المجتمع» من خلال الدفع بكوادرها لتشغل المناصب الرئيسة في مفاصل الدولة جميعاً، ومحاولة فرض قيمها المعادية للحداثة على المجتمع، وفشل الحكومة الإخوانية في حل المشكلات الجسيمة التي تواجه البلاد، يمكن أن نستنتج أن سقوط حكم جماعة الإخوان كان محتماً، وإن لم يتصور أحد أن يتم بهذه السرعة نتيجة للرفض الشعبي العارم من ناحية، والدعم الإيجابي للقوات المسلحة من ناحية ثانية([3]).
لقد نسي الإخوان طوال عام من حكمهم أنهم جماعة تأتي من خارج الدولة المصرية، التي اعتادت أن تقدّم مَن يحكمون البلاد من عبدالناصر إلى مبارك، وحتى سعد زغلول، قائد ثورة 1919 ضدّ الاحتلال البريطاني، الذي شغل منصب وزير المعارف (التعليم) قبل قيادته للحركة الشعبية. ونسوا أن خبرات النجاح تقول بأن أي قوى أو جماعة راديكالية تأتي من خارج المنظومة السياسية السائدة، لابد أن تتبنّى خطاباً مطمئناً وإصلاحياً لهذه المنظومة السياسة التي صاغت ملامحها في مصر «الدولة العميقة». ويجب ألا تبدو هذه القوى أنها ستسيطر على الحياة السياسية أو تحتكرها، وأنها ستضع الدستور والقوانين الأساسية بمفردها، وتعادي الشرطة والقضاء والجيش، وتدخل في معارك مفتوحة مع السلطة القضائية ذات التقاليد العريقة، لا بغرض إصلاحها بل بغرض الهيمنة عليها –ولاسيما أن الجماعة أعدَّت وحلفاءها قانوناً للسلطة القضائية يقضي بعزل 3500 قاض بعد خفض سنّ الإحالة إلى التقاعد من 70 إلى 60 عاماً، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من جانب غالبية القضاة([4]).
لم تقدر الجماعة أنها قد تصل للحكم في المدى المنظور، لذا لم تفكر أبداً في إعداد إجابات عن أسئلة الدولة، ولم تنخرط في إعداد رجال دولة بعدما فشلت حتى في أن تقدم للمجتمع رجال دعوة، باعتبارها قدمت نفسها للمجتمع بالأساس باعتبارها جماعة دعوية وتربوية، حافظت الجماعة على تلك الصيغة الملتبسة التي اختارتها لنفسها بين كونها حركة اجتماعية من جانب، وحزباً سياسياً من جانب أخر، بينما كانت حريصة على أن تقدم نفسها لقواعدها ومحبيها على أنها هيئة إسلامية جامعة «وتستطيع أن تقول ولا حرج عليك: إن (الإخوان المسلمين) دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية وثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية»([5]). هل نحن إزاء جماعة أم جمعية أم هيئة أم دولة تريد ابتلاع الدولة في النهاية، أو يلتهم مشروعها مشروع الدولة؟ هذا بالطبع ما حاولت الجماعة أن تقوم به ولكن في النهاية ابتلعتها الدولة بعد عام واحد.
ماذا حدث للجماعة بعد عام من حكمها لمصر؟ وكيف حكمت مصر؟ هذا ما تحاول تلك الدراسة الإجابة عنه.
لم يكن حكم مصر في أعقاب ثورة 25 يناير أو الانفراد بحكمها على الأقل مسعى عاقلاً لأي قوة سياسية؛ فالواقع الاقتصادي المتدهور، وحجم التعقيدات المحلية والإقليمية والدولية التي واجهتها مصر كانا يقتضيان بناء تحالف سياسي واسع من كل القوى الوطنية، بالشكل الذي يضمن مشاركة كل الفصائل في الإنجاز إذا تحقق وتحمل نصيبها العادل من الإخفاق المحتمل.
أخطأت جماعة الإخوان في قراءة مشهد ثورة 25 يناير، وبدا لها أن اللحظة مناسبة للتمكين دون أن تتعرف على الأعباء المرتبطة بحكم بلد كمصر، خصوصاً أن الجماعة فصيل أتى للحكم من خارج الدولة المصرية العتيدة التي لم يتعرف مرسي وجماعته على طبيعة مؤسساتها القوية كالقضاء والجيش والداخلية، ولم يتحسب لمؤسسة أخرى لا تقل عن تلك المؤسسة قوة وتأثيراً وهي الإعلام، بل ناصب كل هذه المؤسسات العداء وكان من المفترض أنها ستكون أدواته في الحكم، إن تعاونت معه نجح وإن تنكرت له فشل، بالطبع دفعها هذا العداء دفعاً لعدم التعاون معه: «الواقع أن معضلة حكم الإخوان الرئيسة هي أنهم لم يستوعبوا طبيعة اللحظة التي انتقلوا فيها من المعارضة إلى الحكم، وظلّوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ضحية مؤامرات الدولة العميقة والإعلام والقوى الخارجية، ولم ينظروا إلى أداء الجماعة في السلطة وصورتها لدى قطاع واسع من المصريين»([6]).
عوامل سقوط حكم الإخوان
إقصاء جل القوى السياسية عن المشاركة في الحكم والاكتفاء بأعضاء الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) في قفز على قواعد الجدارة والكفاءة: «منذ أن تولى مرسي رئاسة الجمهورية كان ذلك إيذاناً ببداية مرحلة الفشل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين! فالقيادي الإخواني الذي رفع في مرحلة ترشحه للرئاسة شعار: «مشاركة لا مغالبة»، بمعنى أن فلسفته وفلسفة جماعته في حال الفوز ستكون التوافق السياسي، إذا به بعد أن أصبح رئيساً يقلب المعادلة ويصبح الشعار: «مغالبة لا مشاركة»!
ترجمت جماعة الإخوان هذا الشعار في الإقصاء الكامل لكل الأحزاب السياسية المعارضة عن دائرة صنع القرار؛ إضافة حتى إلى حليفها وهو «حزب النور» السلفي. ومارست الجماعة منهج الانفراد المطلق بالسلطة، والسعي إلى غزو الفضاء السياسي المصري بالكامل وذلك بالسيطرة على مجلسي الشعب والشورى، وبعد ذلك الهيمنة الكاملة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والإصرار على وضع دستور غير توافقي، وفرض استفتاء عليه مشكوك في شرعيته([7]).
وأعتقد أن أخطاء السنتين الماضيتين في مصر لا تتحملها جماعة الإخوان فحسب، بل إن جزءاً مما قد يُقال عن شمولية وانغلاق ودوغمائية جماعة الإخوان هو مشكلات تعاني منها كذلك بعض من القوى المحتشدة في ميدان التحرير، إن طبيعة البناء التنظيمي والفكري للجماعة قد تجعل منها جماعة قادرة على قيادة حزب سياسي.
إلا أنها أثبتت أنها بافتقارها للبرنامج الجامع غير قادرة على قيادة دولة ومجتمع يحمل قدراً من التنوع والتعددية السياسية والثقافية والدينية لا يقبل فيها التنميط والقولبة، وبالمقابل فإن الدعوات التي ازدادت وتيرتها في مصر حالياً والداعية لحل الجماعة لن تحل مشكلات مصر، فهي مشكلات في بعضها كانت هناك قبل أن يأتوا إلى السلطة وستستمر من دونهم في غياب رؤى استراتيجية لإعادة بناء مؤسسة الدولة ودورها في المجتمع([8]).
بدا الإخوان كقبيلة لا تثق إلا بأعضائها، ولم يفطنوا لأخلاق الحكم: «تحولت الرابطة التنظيمية والتربية الدينية لدى الجماعة إلى شعورٍ بالتمايز والتفوّق على الآخرين، فيما تحوّلت الطاقة الدينية، التي حافظت على تماسك الجماعة حين كانت في المعارضة، إلى طاقة كراهيةٍ وتحريضٍ على المنافسين والخصوم، وتسبّبت بانغلاق الجماعة وعزلها عن بقية المجتمع، فكثيراً ما استمع الكاتب لشكاوى عشرات العاملين في الوزارات التي قادها الإخوان، عن الحلقة الضيّقة التي يحكم من خلالها هؤلاء المسؤولون. فهم يجتمعون فيما بينهم في جلسات خاصة يهمس فيها الوزير الإخواني مع مستشاريه «الإخوان»، كما اعتادوا أن يفعلوا أثناء وجودهم في المعارضة، من دون أن يعلم الموظفون الآخرون شيئاً عن اجتماعهم الذي انتقل من الأماكن السرية للتنظيم إلى داخل الوزارة والمؤسسات الحكومية([9]).
طريقة صناعة القرار في مؤسسة الرئاسة، فعندما تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 30 يونيو (حزيران) العام 2012, قرر إدارة شؤون البلاد بشكل مختلف عن نظيره الرئيس السابق الذي كانت دائرة القرار في عهده مقتصرة على مجموعة من رجاله المنتمين للحزب الحاكم في جو من السرية وعدم الشفافية؛ لذا قام مرسي بتعيين هيئة استشارية مكوَّنة من سبعة عشر مستشاراً في مجالات مختلفة، وأربعة مساعدين، ونائب له، ومتحدث رسمي باسم مؤسسة الرئاسة، وقد ضمت تلك الهيئة الاستشارية أسماء عدة منها: أحمد عمران، أميمة كامل السلاموني، أيمن الصياد، محمد عصمت سيف الدولة، خالد علم الدين، سكينة فؤاد، رفيق حبيب، سيف عبدالفتاح، عمرو الليثي، فاروق جويدة، محمد فؤاد جادالله وغيرهم.
على الرغم من تلك الخطوة الجديدة التي اتخذها مرسي في بداية فترته، والتي بدت شكلاً من أشكال المؤسسية، فإنها لم تعكس في النهاية سوى واجهة لصناعة القرار الحقيقي في مقر جماعة الإخوان بالمقطم، حيث المرشد العام للجماعة والحلقة الضيقة التي أدارت الجماعة في العقود الثلاثة الماضية، وها هي تقود مصر كلها إلى الهاوية، لذا كان من الطبيعي أن يدرك أكثر هؤلاء المستشارين الحقيقة ومن ثم كان التقدم باستقالاتهم والخروج بالتزامن مع أزمة الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) العام 2012، وجاءت فيه مجموعة من القرارات على رأسها إعادة محاكمة المتهمين في قضايا قتل وإصابة المتظاهرين، وتحصين جميع القرارات والإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس منذ توليه الحكم وحتى نفاذ الدستور، وأخيراً تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى على الرغم من أن الأولى كانت تنتظر حكماً ببطلان تشكيلها في الفترة الحالية، وجميعها قرارات أثارت غضب عدد من المستشارين الذين أكدوا أن تلك الخطوة أقدم عليها الرئيس دون الرجوع إليهم أو إلى نائبه أو مساعديه، وتالياً توالت الاستقالات على مكتب الرئيس بدءاً من سمير مرقص، مستشار الرئيس السابق لشؤون التحول الديمقراطي، مروراً بالكاتبة سكينة فؤاد، والمهندس محمد عصمت سيف الدولة، وصولاً إلى الكاتب أيمن الصياد، والإعلامي عمرو الليثي، والدكتور سيف الدين عبدالفتاح. تلك الاعتراضات والاستقالات التي صاحبتها جاءت غالبيتها نتيجة تصاعد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس في محيط قصر الاتحادية، والتي راح ضحيتها كثير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، بعدما حاول أنصار الرئيس فض اعتصام لمجموعة من شباب الثورة اعتراضاً على الإعلان الدستوري الذي بدا تأكيداً على نوايا مرسي وجماعته بإحكام القبضة على البلاد والتأسيس لحكم فردي مستبد، في عجلة لم تغادر الجماعة في سلوكها السياسي، أسهمت في كشف حقيقتها على نحو مبكر وفي أقل من عام من حكمهم([10]).
حافظ الإخوان على واجهتين للحكم، مثّل حزب الحرية والعدالة الواجهة الأولى التي اقتضتها الشروط الدستورية والقانونية من دون أي صلاحيات حقيقية في النهاية، فالحزب الذى تأسس للمفارقة بعد إجراءات اختيار مؤسسيه من بين الأعضاء العاملين في الجماعة بنسبة 90% لم تُترك له أي فرصة للممارسة السياسية، بل كان دوماً كالطفل الذي ينتظر تعليمات والده، حتى إن الجماعة هي من عين رئيس الحزب وأمينه العام ونوابه وبعض أعضاء المكتب التنفيذي، وبالرغم من كل ذلك لم تثق الجماعة به بما يكفي لأن تعهد له بممارسة الدور الذي حدده له الدستور والقانون كأداة للمنافسة السياسية وممارسة السلطة إذا حاز ثقة الناخبين. أما الواجهة الثانية فقد كانت هيئة المستشارين الذين بالرغم من اختيارهم من المتعاطفين مع الجماعة، فإن ذلك لم يحل دون استقالتهم في النهاية.
الأداء المربك للرئاسة والتردد وإصدار القرارات والتراجع عنها، بما حطم صورة الرئيس لدى الشعب وبدا كالموظف الذي ينتظر تعليمات المرشد «من القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، والتي أثارت الرأي العام في الشارع المصري، ذلك القرار المتعلق بإصدار التعريفة الجمركية الجديدة، حيث نص على تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة موقتة عند إعادة استيرادها بواقع 10% من التكاليف، كما تقرر رفع الجمارك للعديد من السلع الاستهلاكية التي وصفها القرار بـ«غير الضرورية». وقد تم صدور هذا القرار من دون دراسة وافية من الجوانب كافة، وفي وقت يعاني فيه المجتمع المصري من انشقاق واحتقان سياسي، الأمر الذي خلّف آثاراً سلبية سياسية واقتصادية، حيث مُني السوق المصري بحال من الارباك والعشوائية، هذا الارباك قد أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، وبعد فترة لاحقة، أصدرت مؤسسة الرئاسة بياناً جاء فيه أن الرئيس محمد مرسي قد أوقف العمل بالقرارات الخاصة برفع الضرائب، وأن ما حدث ليس تراجعاً عن القرارات بقدر ما هو تجميد لها([11]).
غياب الرؤية حول محدِّدات السياسة الخارجية المصرية وتحديد نطاق المصالح المصرية بوضوح. لقد انعكس الفشل في إدارة الشؤون الداخلية للدولة المصرية، على السياسة الخارجية لمصر، فكانت جولات مرسي استعراضية أكثر من أي شيء، خصوصاً أن الرئيس المصري قام بـ25 زيارة خارجية لدول العالم من دون أي نتائج ملحوظة على أرض الواقع، وفقدت مصر دعم عدد كبير من الدول العربية الداعمة لها اقتصادياً.
لقد أدار الإخوان ملفات العلاقات الخارجية بصورة مضرة بالأمن القومي المصري، وظهر هذا جلياً في قرار إثيوبيا بناء سد النهضة، وقضية حلايب وشلاتين، ومع ليبيا فيما يتعلق بتسليم رموز النظام السابق مقابل الحصول على قروض مالية.
إن السياسة الخارجية لأي دولة تقوم على أساس التوازن والمصالح المشتركة، وهذا لم يتحقق في زمن الإخوان الذي كانت فيه مصر دولة رخوة تعاني من فوضى وعدم استقرار انعكسا في الارباك عند إدارة العلاقات الخارجية([12]).
الإخفاق الاقتصادي الناتج عن غياب كفاءات لدى الجماعة تنهض بالمهمة، حيث غلب على كوادرها المهنيون والعمال والطلاب، وتمثل هذا الإخفاق في غياب فلسفة اقتصادية أو رؤية تحكم القرار الاقتصادي الذي تأرجح بين اتجاه الحكومات السابقة وروح الثورة وأهدافها التي لم تجد من يتبناها أو يعبر عنها.
في هذا السياق نطرح بعض المؤشرات الدالة، حيث كشف تقرير للبنك المركزي أن حجم الدين الخارجي ارتفع لـ44 مليار دولار بنهاية شهر أبريل (نيسان) من العام 2013، مقارنة بـ34 مليار دولار في العام الماضي بزيادة قدرها 10 مليارات دولار([13]).
«أنت تقضم أكثر مما تهضم». كانت تلك وصية أردوغان إلى حليفه مرسي في محاولة لثنيه عن نهج الاستحواذ على كل مفاصل الدولة وإبطاء عجلة «الأخونة» والتمهل في استعداء المؤسسات، كالمؤسستين العسكرية والقضائية، ولدى أردوغان تجربة كبيرة ملهمة لم يَفِد منها مرسي وجماعته بالطبع، حيث كانت الطبعة الإخوانية المصرية منتمية لأربكان عقلاً وجسداً دون زهد في تطلعات أردوغان.
وهم الشعبية الذي اعتقدت الجماعة أنه سيحميها من السقوط في مواجهة خصومها. فالإخوان اعتقدوا أن القاعدة الشعبية الكبيرة التي يملكونها ستوفر لهم دعماً قوياً في سدة الحكم عند بروز خلاف بينهم وبين معارضيهم، وهو خطأ جسيم في إدراك الفارق الكبير بين القوة العددية والقوة النوعية، فالأصوات التي حصل عليها الإسلاميون جاء أغلبها من أناس بسطاء لا تتجاوز قدرتهم على المساندة أكثر من مجرد منح أصواتهم الانتخابية، وأغلبهم انتقل بعدها إلى مقاعد الانتظار ترقباً لما ستسفر عنه نتائج هذا الاختيار، وفي المقابل، فإن المعارضة كانت تضم أغلب الفئات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع المصري من قضاة وإعلاميين وشرطة وجهاز إداري ومثقفين، وهؤلاء لديهم الكثير من المصالح والمكتسبات (التاريخية) التي يمكن أن يهددها الإخوان، وهذا التهديد المحتمل يأتي في مقابل عدم وجود أي فرصة واضحة أمامهم للافادة من الإخوان، فالنخب لا يمكن أن تُدير علاقتك معها إلاّ بمنطق العصا أو منطق الجزرة. فإما أنك تملك من الإمكانات والفرص ما يمكنك معه دعم مصالحهم المباشرة، أو أن لديك من القوة ما تجبرهم به على كف الأذى خشية منك، وكلاهما لم يتوافر للإخوان، وهذه الفئة المعارضة لم تكتف في إعلان موقفها من الإخوان عند مجرد وضع علامة في الورقة الانتخابية ثم الانتظار كما فعل المؤيدون من جماهير الشعب، بل استخدمت عناصر القوة الهائلة لديها في (سحق) تجربة الإسلاميين في الحكم دفاعاً عن وجودها ومكتسباتها، وقد كان يكفي هؤلاء فقط عدم التعاون مع نظام الحكم الجديد لتدميره، فكيف الحال وقد عملوا بشكل منظم على إفشاله!([14]).
الإخوان بين الفشل السياسي والفشل الأخلاقي
يمكننا القول إن ظاهرة الفشل السياسي معروفة في ممارسات كل النظم السياسية، شمولية كانت أو سلطوية أو ليبرالية، والفشل السياسي يمكن أن يرد إلى أسباب عدة. فقد يحدث لأن توجهات صانع القرار لم تكن صحيحة في منطلقاتها، أو أن أدواته التي اعتمد عليها لم تكن مناسبة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أي إنه تجاهل رد الفعل المتوقع على القرار، سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي الوطني.
والأمثلة التاريخية على الفشل السياسي في ممارسة الأنظمة المختلفة لا حصر لها، إضافة إلى فشل الأحزاب السياسية وممثليها في مجال المنافسات الانتخابية البرلمانية والحزبية، لعل أبرزها فشل الحزب الاشتراكي الفرنسي بقيادة ليونيل جوسبان في النجاح في الانتخابات الرئاسية ونجاح جاك شيراك اليميني، مما أدى إلى استقالة جوسبان من رئاسة الحزب بل واعتزاله السياسة اعترافاً بمسؤوليته عن الفشل. ولا نريد أن نقف طويلاً عند الأمثلة الأجنبية عن الفشل السياسي. لأن جماعة الإخوان المسلمين قدمت لنا أبرز أنموذج لهذا الفشل، بعد أن أتيح لها-نتيجة الأخطاء الجسيمة التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب سقوط نظام حسني مبارك- أن تحصل على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، ثم أن تدفع برئيس حزبها (الحرية والعدالة) محمد مرسي ليكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية وينجح فعلاً –نتيجة أخطاء شتى ارتكبتها النخبة الليبرالية- في أن يصبح رئيساً للجمهورية وإن كان بفارق ضئيل للغاية عن منافسه الفريق أحمد شفيق.
لقد أدت ممارسات رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي في مجال الإخلال بثوابت الأمن القومي، إضافة إلى اعتدائه المستمر على السلطة القضائية، ومعاداته للإعلام بل وللمثقفين وإصداره إعلاناً دستورياً أعطى فيه لنفسه كل السلطات، إلى أن يدرك الشعب المصري أن حكم جماعة الإخوان الذي يستند إلى شرعية شكلية تقوم على نتائج صندوق الانتخابات، ليس سوى حكم استبدادي صريح من شأن استمراره هدم كيان الدولة المصرية ذاتها.
وهكذا يمكن القول إن الخروج الشعبي الكبير في 30 يونيو(حزيران) كان إعلاناً جهيراً بالفشل السياسي المدوي لحكم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أخطر من ذلك كله أنه دليل مؤكد على السقوط التاريخي لمشروع الجماعة، والذي يتمثل في هدم الدولة المدنية وإقامة دولة دينية في مصر تكون هي الأساس في المشروع الوهمي الخاص باستعادة الخلافة الإسلامية([15]).
ربما تجسد الفشل السياسي بوضوح، أما الفشل الأخلاقي فتمثل في مشروع الجماعة القيمي الذي طرحته واجهةٌ ساعدت على قبوله شعبياً لعقود، والذي تمثل في الدعوة لتمكين القيم من النفوس اختياراً مجتمعياً حراً وليس تنزيلاً سلطوياً بسيف الحكم. كانت لدى الجماعة فرصة تاريخية لتمكين مشروعها القيمي بعدما توافرت أجواء الحرية التي دعت لها في خطابها قبل الثورة، فهل كان المشروع قيمياً بالفعل أم إنه كان مجرد مشروع سياسي توسل بالدين للوصول للسلطة؟
لقد كان أهم ما تحتاجه وتتطلع إليه الجماعة قبل ثورة ٢٥ يناير هو الحرية: حرية التربية والدعوة، والعمل على إفساح المجال لجيل مختلف من الإخوان، جيل يبتكر ويبدع، لكن للأسف، عندما جاءت الحرية، لم يحسنوا التعامل معها، ولا تقدير استحقاقاتها ومتطلباتها، وإذا بهم يقفزون مباشرة إلى أتون الدولة، من دون تهيئة أو استعداد، خصوصاً مع وجود أفكار ملتبسة حول الوطن والديمقراطية والمواطنَة، لذلك أضاعوا على أنفسهم فرصة العمر التي طال انتظارها.
كان من المفترض أن يهتبلوا الفرصة ليعيدوا ترتيب أوراقهم وأفكارهم. قلنا لهم: من الضروري أن يكون حزب الحرية والعدالة منفصلاً بشكل كامل وحقيقي عن الجماعة، منعاً لأي ازدواجية بينهما، وفرصة لتربية سياسية واعدة، وأن تتحول الجماعة إلى جمعية تربوية دعوية تأكيداً لسيادة القانون. لكن (يا للأسف)! وقلنا أيضاً: من الضروري في تلك الفترة أن ينافس الحزب على ٢٥٪ فقط من مقاعد مجلس الشعب، وإذا تشكلت حكومة فيكون الحزب جزءاً منها وليس على رأسها، وأن ينأى الحزب عن الدفع بمرشح للرئاسة. لكن: «لقد أسمعت إن ناديت حياً»! وقلنا كذلك: من الضروري أن تقوم الجمعية التربوية والدعوية بدورها المأمول في الارتقاء بمنظومة القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية في المجتمع، لكن ذلك لم يحدث([16]).
الشرعية… الشرعية، كانت تلك الكلمة التي رددها مرسي في آخر خطاباته عشرات المرات، تماماً ككلمة «أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة» بمناسبة وبدون مناسبة، في محاولة لإقناع نفسه قبل أي أحد آخر بأنه أصبح بالفعل رئيس مصر الكبيرة. وبالعودة إلى المنهج السياسي المتخلف والعقيم الذي انتهجته قيادة الإخوان المسلمين في تسيير شؤون الحكم وإدارة الدولة إبان فترة حكمها القصيرة، نلاحظ بجلاء ووضوح كيف تعمدت إساءة الاستخدام المفرط لشعار «الشرعية» وامتهنته وابتذلت في توظيفه وتسخيره، كغطاء لسعيها المهووس إلى إحكام قبضتها على مقاليد الحكم والدولة والاستئثار بها واحتكارها لها وحدها، وإقصاء الجميع بمن فيهم –أحياناً- حلفاؤها المقربون وجعلها سلاحاً لتصفية خصومها ومعارضيها السياسيين، وقمع حرية الرأي والتعبير وخنق الحقوق والحريات، لأن هذه القيادة كابرت وعاندت ولا تزال في الاستخدام المفرط والمبتذل لشعار الشرعية، مصرة على إضفاء طابع الديمومة والقداسة على شرعية ممثلها الرئيس محمد مرسي، وأن الشعب المصري عند انتخبه في انتخابات شرعية كرئيس لكل المصريين، وتالياً لا يجوز مساءلته أو محاسبته أو نقده، أو حتى مجرد المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة يعيد الرئيس مرسي طرح نفسه مجدداً كمرشح فيها، بحجة أن تطبيق هذا المبدأ -المعمول به في الديمقراطيات كلها- من شأنه أن يتكرر مع كل رئيس جديد يأتي فور فوزه، وتلك مغالطة وحجة متهافتة وغير منطقية من دون أن تنظر تلك القيادة إلى الكيفية والظروف الاستثنائية المربكة التي انتخبت فيها الرئيس مرسي، والتي استغلتها قيادة الجماعة بأسلوب انتهازي لإيصال مرشحها إلى سدة الحكم.
إن التجربة المريرة بالرغم من قصر فترتها الزمنية لحكم الجماعة قد رسخت شعوراً وقناعة راسخة في أوساط الرأي العام الشعبي بأن الجماعة يتملكها ويسيطر عليها شغف مجنون بالسلطة والتشبث بها، ولو كان ثمن ذلك تدمير البلاد والزج بها في أتون الفتنة والحرب الأهلية المهلكة، وأن مصالح الجماعة هي الأَولى بالاعتبار من دون مصالح البلاد والعباد ومستقبل الأجيال القادمة، ولهذا فقد بات ينظر لها على عكس الماضي بأنها قوة خطيرة ومدمرة لا يمكن أن تكون مأمونة الجانب لحاضر ومستقبل البلاد([17]).
كان الخطاب المزدوج من أهم أسباب فشل الإخوان الأخلاقي، فبينما عرفوا التنقل جيداً بين خطاب التمسكن في حال الضعف، والذى تجسد بقبول فكرة التعددية السياسية وتغيير رأي الجماعة في العام 1995، وكذلك القبول بترشيح المرأة، فقد تحدثوا بقوة عن خطاب آخر في العام 2011 عندما قال نائب المرشد العام للإخوان المسلمين محمود عزت بثقة: «لا مفر من تطبيق الحدود ولكن بعد امتلاك الأرض»([18]).
لقد كان الإخوان أنفسهم هم من تسببوا في فشل مشروعهم السياسي، حيث كشفت الأحداث والممارسات أنه ليس لديهم مشروع أخلاقي حقيقي: «إن ما سيذكره التاريخ جيداً هو أن فشل الإخوان المسلمين في مصر سببه الإخوان أنفسهم وليس خصومهم، داخلياً أو خارجياً، خصوصاً عندما قرر الإخوان حكم مصر بعقلية الجماعة، وإدارتها كـ«معارضة» وليس كسلطة سياسية تنتهج منهج الحكم الرشيد الذي يجمع ولا يفرق، نهج يوحي بأن من يحكم يؤمن بتداول السلطة، لا الاستئثار بها، كما أنه يؤمن بقدسية حقن الدماء وليس التساهل مع من يقوم بالتكفير والتخوين وتهديد السلم الاجتماعي للبلاد ككل([19]).
إن قضية الجمع بين الحكم والدعوة أثبت تاريخنا فشلها. إن للدعوة مقاماً، وللحكم مقاماً. السياسة فضاء مترع بالكذب والخداع والمناورة، وهي الحلول الوسط والنسبية في الآراء والتوجهات والرؤى أو بمعنى آخر: فن الممكن. أما الدعوة فهي حديث عن مطلقات لا تقبل التجاوز. لا يتسامح الدين مع الكذب أو الخداع أو الغش ولا يستطيع تبرير ذلك. لذا؛ كانت كل محاولة لخلط الدين بالسياسة تنتهى بالإساءة للاثنين معاً. وقد هزتني قديماً الحجة البارعة التي ذكرها الصحابي العظيم عبدالله بن عمر للحسين: «إن الله لن يجمع لكم آل بيت رسول الله النبوة والخلافة». وكأنه يقول له: إن النبوة أعظم من الخلافة، وإن الدعوة أعظم من السلطة، وإن هداية الخلائق أبقى من كراسي الحكم([20]).
كيف صبغت العزلة تجربة حكم الإخوان؟
يعتبر سيد قطب هو المنظر الأهم في تاريخ حركة الإخوان، والأكثر تأثيراً في مسيرتها، خصوصاً في العقود الأربعة الماضية، في الفترة من العام 1973 – تاريخ خروج الإخوان من المعتقلات وإعادة تأسيس الجماعة مع ولاية عمر التلمساني- وحتى العام 2013، العام الذي خرجت فيه الجماعة من حكم مصر بعد تجربة حكم لم تستمر سوى عام واحد.
على الرغم من انفتاح شخصية عمر التلمساني ورغبته الجادة في الانفتاح على المجتمع المصري والعمل من خلال حزب سياسي بشكل واضح وشفاف، فقد اصطدمت مساعيه بتدبير المجموعة القطبية التي أدارت الجماعة من وراء ظهره، وتحديداً الحلقة الأضيق التي مثلها مصطفى مشهور وأحمد حسنين وحسني عبدالباقي وكمال السنانيري وغيرهم من رجال سيد قطب.
سيطرت المجموعة القطبية على أهم لجان الجماعة، وهي لجنة التربية المسؤولة عن صوغ الشخصية الإخوانية عقدياً وفكرياً، ومثلت كتابات سيد قطب: «في ظلال القرآن»، و«هذا الدين» و«معالم في الطريق»، أهم الأدبيات التي شكلت ضمير القواعد الإخوانية، وكان أخطر ما حدث للشخصية الإخوانية هو العزلة الشعورية التي قدمت باعتبارها السلوك القويم في مواجهة ما سماه بالجاهلية: «نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية: تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية، هو كذلك من صنع هذه الجاهلية»([21]).
وفي مواجهة هذه الجاهلية لابد من طليعة، هي من وجهة نظره شرط التمكين للأمة، يقول: «إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق، تمضي في خضم الجاهلية الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض جميعاً، تمضي وهي تزاول نوعاً من العزلة من جانب، ونوعاً من الاتصال من الجانب الآخر بالجاهلية»([22]).
إذن هي العزلة التي تتعزز في ضمير الفرد الإخواني لتجذر شيئاً فشيئاً قطيعته مع المجتمع، الذي يتعامل معه من دون أن يتوحد معه وجدانياً. هو منفصل عنه لا يشعر بمشاعره ولا يشاركه أحلامه، فعندما يحلم المصري بدولته الوطنية ويفكر لها ويطرب ويهتز وجدانه لنشيدها الوطني، يحلم الإخواني بدولة أخرى أممية ليس لها نشيد أو عَلَم، ولكنها تسكن وجدانه المعزول المستعلي: «إن أولى الخطوات في طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه وتصوراته، وألاّ نعدل نحن في قيمنا وتصوراتنا قليلاً لنلتقي معه في منتصف الطريق، كلا إننا وإياه على مفرق الطريق، وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق، وسنلقى في هذا عنتاً ومشقة وستفرض علينا تضحيات باهظة، ولكننا لسنا مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر به منهجه الإلهي، ونصره على منهج الجاهلية»([23]).
بهذه النفسية تتعزز القطيعة بين الإخوان والمجتمع الذي يريدون أن يحكموه، من دون أن يجمعهم معه شعور واحد أو حلم واحد. لذا؛ حرصت تلك القيادة القطبية التي تشربت تلك الأفكار على أن يمضي مسارها في حكم مصر على هذا النحو، وقد احتلت فيه هذه الأفكار محور تفكيرها وانعكست بوضوح على سلوكها السياسي.
هل كان الإخوان مستعدون لحكم مصر؟
حين انخرط الإخوان في الحياة السياسية المصرية بعد عامين من مقتل السادات، بدأوا من الجامعات والنقابات، ولغياب الحس الاستراتيجي لديهم وظفوا الجامعة لإدارة معارك وهمية حول نصرة قضية فلسطين وحرق العلم الإسرائيلي في رحاب الجامعة، وتجنيد الطلبة والأساتذة ليكونوا خدماً لـ«العجل المقدس»، متمثلاً في التنظيم الذي تحول من رافعة لمشروعهم السياسي، إلى هدف في حد ذاته، حتى تحولت معارك الحفاظ عليه إلى الغاية الأولى بالرعاية!
بينما كانت النقابات المهنية فرصة ذهبية تستطيع الجماعة أن تحولها إلى مناشط ومراكز أبحاث ترتقي بالمهن والمهنيين، بالعمل على ملفات التنمية والنهضة من خلال مشروعات تتبناها تلك النقابات، خصوصاً النقابات التي حازت الجماعة فيها ثقة أعضائها وقادت مجالسها التنفيذية، مثل: الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والمعلمين. هل عكفت نقابة الأطباء مثلاً على تطوير رؤى وملفات للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الكادر الطبي تدريباً وتثقيفاً وتأهيلاً؟ وهل قدمت النقابات مبادرات للقطاع الأهلي للنهوض بهذا الملف؟ وهل قدمت نقابة المهندسين رؤى فنية أو مشروعاً قومياً تتبناه مثل النهوض بالتدريب المهني أو رفع كفاءة المهندس والفني من خلال برامج تدريب وتطوير لمصانعنا ومعامل أبحاثنا؟ وهل استفادت من مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى وقدمت رؤى لتطويرها بما يصب في صالح تحقيق استقلال فني وتكنولوجي يعبد الطريق لاستقلال القرار الوطني؟ وهل قدمت نقابة المحامين مشروعات لدستور جديد أو لتطوير البنية التشريعية المصرية وتحديثها؟ وهل قدمت نقابة المعلمين رؤى لتطوير التعليم المصري؟ للأسف لم يحدث شيء من ذلك، بل تحولت النقابات إلى منابر سياسية تؤدي بعض أدوار الأحزاب التي تصاغرت حتى تحولت إلى شقق خاوية تعلق لافتة باسم الحزب، وجريدة لا يقرؤها أحد.
لم يعمل الإخوان أبداً على إسقاط النظام السابق، بل باركوا التوريث (أن يخلف جمال مبارك أباه)، كما لم يعملوا أبداً على وراثة هذا النظام، وحين وقعت الثورة في 25 يناير تعاملوا معها بتوجس في البداية، ثم حين أيقنوا أن أجهزة الأمن انكسرت تقدموا الصفوف بتنظيمهم الذي حافظوا عليه سنوات من دون أي إعداد للحكم، وحين حلت الاستحقاقات الانتخابية كان من السهل أن يتحللوا من عهد قطعوه على أنفسهم أمام الشعب المصري ويرشحوا واحداً منهم لوراثة حكم مصر، وقد وقع اختيارهم على خيرت الشاطر، الرجل القوي في الجماعة وذراعها المالية، نائب المرشد، وحين استبعد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كانت الجماعة حاضرة بمرشحها الاحتياطي محمد مرسي، النائب البرلماني السابق، زعيم الكتلة الإخوانية في مجلس الشعب العام 2005، رئيس القسم السياسي بالجماعة، الأستاذ الجامعي السابق. كان الرجل اختياراً مثالياً من وجهة نظر المجموعة القطبية التي اختارته؛ فهو عضو ملتزم تنظيمياً، يسمع ويطيع القيادة، ولاؤه قوي للمرشد ولنائبه الرجل القوي خيرت الشاطر، كما أنه صنع مجده وترقيه السريع في التنظيم من طاعته القيادة القطبية التي عينته في مجلس شورى الجماعة العام، ثم عينته عضواً في مكتب الإرشاد من دون أي مسوغات حركية داخل التنظيم، وقفز على حظوظ من هم أقدم منه في التنظيم، وقد كان الرجل أداة استبعاد العديد من الشخصيات الإصلاحية داخل مكتب الإرشاد، لعل أشهرهم عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب، حتى دانت للقطبيين السلطة داخل مكتب الإرشاد بالكامل، كما احتفظوا بأغلبية مجلس الشورى العام من خلال التدخل بتعيين أعضاء محسوبين عليهم، وزيادة حصص بعض المحافظات، وعندما أعلنت اللجنة العامة للانتخابات فوز محمد مرسي كان التنظيم القطبي حاضراً برجاله ليضعهم في كل مفاصل الدولة، في خطة التمكين التي كان خيرت الشاطر قد أعدها منذ منتصف التسعينيات واكتشفتها أجهزة الأمن المصرية حين دهمت مقر اجتماع مجلس الشورى العام للجماعة العام 1995، وقد طور الشاطر هذه الخطة ووضع رجاله في القصر حول محمد مرسي، حيث مثلت الحلقة الأضيق حول الرئيس محمد مرسي شخصيات تم استدعاؤها من الخارج كشخصية ياسر علي، طبيب الأمراض الجلدية الذي كان يعمل طبيباً بإحدى مستشفيات السعودية، قبل أن يوضع اسمه ضمن مؤسسي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، ثم عضواً بحملة خيرت الشاطر الانتخابية، ثم حملة مرسي بعد خروج الشاطر، ليعين بعدها متحدثاً رسمياً باسم رئاسة الجمهورية في قفز على القواعد المستقرة في رئاسة الجمهورية، باختيار المتحدث الرسمي من بين سفرائنا في الخارجية المصرية.
أما أحمد عبدالعاطي الصيدلاني الذي كان شريك خيرت الشاطر في إحدى شركات الأدوية، فقد عين مديراً لمكتب الرئيس، بينما عين أيمن هدهد، أحد أفراد سكرتارية خيرت الشاطر الخاصة، مستشاراً أمنياً للرئيس من دون أي خبرة في وظيفة بهذه الخطورة، فضلاً عن عدد وافر من أفراد التنظيم الذين غصت بهم ردهات وحجرات القصر الرئاسي، إضافة إلى عدد كبير من المستشارين الذين تم تعيينهم في الوزارات التي يقودها وزراء «إخوان» في الحكومة. أما المنصب الأخطر فقد كان من نصيب عصام الحداد، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، المقرب من خيرت الشاطر، وأداة الاتصال الرئيسة بين خيرت الشاطر ومحمد مرسي، وأداة الاتصال بين التنظيم الدولي للإخوان والرئيس، وقد كان هو وزير الخارجية الفعلي.
وحين بدا للرئيس مرسي أنه قد تمكن من الحكم تحلل من العهود التي قطعها أمام ممثلي اجتماع «فيرمونت» يوم التفت حوله رموز القوى الوطنية قبل إعلان فوزه مساندة له، ليتراجع بعدها عن تعيين شخصية وطنية مستقلة رئيساً للوزراء، وإعادة النظر في تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، وغيرها من المطالب، ليقوم بتعيين هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري الأسبق، رئيساً للوزراء في 24/ 7/ 2012. وبعد شهر واحد من هذا الاجتماع وفي ذكرى احتفالات أكتوبر (تشرين الأول)، احتل قتلة السادات المقاعد الأولى في الاحتفال الذي أقيم بإستاد القاهرة للرئيس بين أنصاره، فبدا الاحتفال كما لو كان احتفاء بالانتصار على الدولة المصرية وجيشها! وفي 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه أقدم مرسي على أعظم حماقة دقت أول مسمار في نعش حكمه، بإعلان دستوري أصدره في ظل أجواء مشحونة سياسياً:
حكم قضائي ببراءة جميع رموز النظام السابق، وضباط الداخلية المتهمين بجرائم قتل متظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير، باستثناء عدد قليل من القيادات السياسية تحت ضغط الشارع.
محاولة الرئيس المصري تنحية النائب العام عبدالمجيد محمود عن منصبه، وتصادم قطاري الفيوم، وحادث قطار أسيوط الذي قتل فيه حوالي 47 تلميذاً، مما أدى إلى قلب الرأي العام ونقصان شديد في شعبية مرسي في الشارع ووصفه بالضعيف في مواجهة الفساد المستشري في أجهزة الدولة -بالذات من طرف الإعلام الخاص.
تعرض المتظاهرين في ذكرى أحداث «محمد محمود» إلى البلطجة والإرهاب في مكان حدوث مجزرة 2011 نفسه، حيث ألقى مجهولون قذائف مولوتوف عليهم من على أسطح المباني المجاورة، وذلك قبل صدور الإعلان بأيام.
انطوت مواد الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي على قرارات خطرة أهمها: تحصين قرارات الرئيس والإعلانات الدستورية التي يصدرها من الطعن أمام أي جهة قضائية، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي لم تعكس في تركيبتها القوى الوطنية المختلفة، وامتلكت المجموعات الإسلامية المؤيدة للرئيس الأغلبية الكاسحة فيها، كما أطلق الإعلان يد الرئيس في اتخاذ أي تدابير أو إجراءات استثنائية، بل وتعيين نائب عام بقرار من رئيس الجمهورية.
كان هذا الإعلان تأكيداً من جانب الرئيس مرسي وجماعته أنهم ماضون في اتجاه حكم فردي استبدادي لتمرير مشروع الدولة الدينية، التي توسلت بامتلاك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه ثم تمرير دستور أقرب إلى برنامج سياسي للجماعة منه إلى وثيقة تعايش مشترك وعقد اجتماعي لما بعد ثورة 25 يناير، وكان من الطبيعي أن تنتفض السلطة القضائية وتعلن في 25/ 11/ 2012 أن هذا الإعلان اعتداء على القضاء المصري، ليقوم بعدها أنصار الجماعة بحصار المحكمة الدستورية، لمنعها من الحكم في دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ليبدأ بعده بأيام أول مستشاري الرئيس في الاستقالة، احتجاجاً على الإعلان الدستوري والنهج الإقصائي للجماعة.
كيف تنظر الجماعة إلى المعارضة؟
تنظر جماعة الإخوان المسلمين إلى المعارضة السياسية لها باعتبارها مجموعة من الشخصيات الانتهازية التي تنشط في الفضاء الإعلامي، من دون أي وجود في الشارع، ولا تقيم لهم وزناً، وتعتبر أنه كانت لهم فائدة في عهد مبارك فقط، كواجهة يختبئ الإخوان خلفها، وقد قامت المعارضة المصرية بتعويم الجماعة في أكثر من مفصل سواء حركة «كفاية» أو «الجمعية الوطنية من أجل التغيير»، ولكن لأن الإخوان أصبحوا في الحكم فلم يرحبوا بمعارضة قوية، واستهلكوا طاقتها في حوارات عبثية تحت مظلة وهمية تتحدث عن الشراكة الوطنية من دون أي شاهد من الواقع يؤكد إيمان الإخوان بالشراكة الوطنية، التي هي جزء من خطاب للاستهلاك المحلي فقط، وللمعارضة التي هي لدى الإخوان مجرد مسهل سياسي في لحظات الانسداد السياسي، أما وقد انفتحت الآفاق لديهم فقد تكفل خيرت الشاطر –بأمواله- بإعداد خطة اختراق كل المجموعات المعارضة سواء النشطة في الشارع من مجموعات «الألتراس» أو «6 أبريل» أو الأحزاب السياسية التي يحتاجها في مواسم الاستحقاقات الانتخابية، ويشتري لافتاتها بمقعد أو مقعدين في البرلمان ليتشدق بالحديث عن تحالف سياسي واسع.
حسن مالك الذراع الاقتصادية
بينما بدا أن خيرت الشاطر قنع بالدور السياسي، نشط شريكه حسن مالك في تأسيس جمعية رجال أعمال «ابدأ»؛ لتكون حاضنة تضم رجال أعمال الإخوان مع رجال أعمال مبارك في شراكة الحكم والمال الجديدة، حيث أصبحت بوابة المرور لأي مستثمر هي بوابة جمعية «ابدأ». وعكس هذا بالطبع أن الإخوان لا يبدأون بما بدأ به رجال مبارك، بل يبدأون من حيث انتهى مبارك، حيث لم نشهد التحالف بين السلطة ورأس المال في مصر إلا قبل نهاية عهد مبارك بعشر سنوات، بينما فضل الإخوان الانطلاق مع السنة الأولى لهم في الحكم، مما عجل -بالطبع ضمن عوامل أخرى- في نهاية هذا الحكم.
سلك الإخوان طريقهم نحو الحكم من دون أن يكون لديهم خطة، وحاولوا أن يبيعوا الوهم للمصريين مرة تحت لافتة «مشروع النهضة»، ومرة تحت لافتة «الشريعة»، وفي النهاية لم يظفر المصريون بالنهضة ولم يسعدوا بثمرات الشريعة، وهذه أزمة الإسلاميين في علاقتهم بالسياسة: اللجوء للشعار على حساب الموضوع، والمظهر على حساب الجوهر: «هناك إسلاميون لا يصلحون للتعامل السياسي، السياسة ليست حفل شاي، بل مجال للصدام والتنازع والتراجع خطوتين لكي تتقدم خطوة»([24]).
لم تتنبه الجماعة لتحذير المؤسس عندما قال: «وعلى هذا، فالإخوان أعقل وأحزم من أن يتصدوا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلا بد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود، ويتعلم فيها الشعب كيف يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة»([25]).
هل تخلى الإخوان عن العقل والحزم لحساب الحماقة والعجلة التي قادتهم لفخ الحكم، من دون أن يعدوا للسؤال إجابته وعادوا بالمشروع الإخواني إلى نقطة الصفر من جديد؟ هذا ما أعتقد أنهم فعلوه.
قدمت جماعة الإخوان نفسها راعية لمشروع ضخم، يستهدف إعادة الكيان الدولي للأمة تحت راية الخلافة، جماعةَ إحياء إسلامي تستهدف تمكين القيم من نفوس الناس، فيتقمصوها سلوكاً يُعبِّد طريقهم نحو النهوض، كان الرهان الأول دوماً للجماعة في مسيرتها هو كسب المجتمع أو الشارع، سواء كان فضاء الدولة والمجتمع مغلقاً بالتضييق، فيكون بالتعاطف مع مظلوميتهم التاريخية بالنظر لطبيعة الشعب الذي يتعاطــف مع المظلوم، باعتبار الشعب نفسه صاحب مظلومية ممتدة عبر التاريخ مع حكامه، وبرع الإخوان في الإمعان في تقمص هذا الدور الذي انسحب على فترات طويلة من تاريخهم، مما كرس في الوعي الجمعي أن هذه جماعة مظلومة وقدمت الشهداء في سبيل ما تؤمن به من مبادئ، أو بالنشاط الخيري والاجتماعي إذا سمح النظام السياسي لهم بذلك، وتحولت أدوات العمل الخيري والاجتماعي التي توسلوا بها في امتلاك عقول وقلوب المصريين انتصاراً لقيم الدين وتدعيماً لثقة الناس في الدين سبيلاً لإنهاء معاناتهم، تحولت إلى أدوات تُؤَمِّن أصوات الناخبين في الصناديق في رحلة الإخوان نحو حكم مصر، ولم يعد الهدف هو تمكين قيم الدين باعتبارها الرافعة الحقيقة لنهضة الأمة حين يتربى أفراد المجتمع عليها، فيبرز منهم السياسي الذي يتقيد بالأخلاق، والطبيب النابه، والمعلم المجد، والفني المحترف، والمواطن الصالح في كل ميدان من ميادين الحياة. كان هذا فضاء الجهاد الحقيقي للجماعة إن أخلصت لما تحدثت عنه من قيم: أن تطلق للمجتمع من وعاء الدعوة والتربية أفضل العناصر من دون أن تتقدم للمنافسة على الحكم بنفسها، بحيث تزدهر القيم في المجتمع من خلال الاختيار المجتمعي الحر وليس تنزيلاً بسيف السلطة، ولكنها حين لاحت لها فرصة الحكم تقدمت إليها من دون أن تتذكر أنها تحرق أهم مرحلة في مشروعها وهي مرحلة المجتمع، لتقفز على مرحلة الحكم والدولة، وليتها استمعت لأصوات عاقلة تحدثت للجماعة ناصحة قبل وصولها للحكم بعقد كامل، مثل الدكتور حسان حتحوت، الرمز الإخوانى الشهير ممن صاحبوا حسن البنَّا، الذي كتب يقول: «لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا، وهل تجدي لو، ربما لكنت أنصح الإخوان بألا يتعجلوا دخول ميدان السياسة، خصوصاً الحكم، لنترك العظْمة للكلاب وننشغل بتحويل شعب مصر كله إلى شعب مؤمن بربه، ليس في العبادات فقط، ولكن في المعاملات والعمق الروحي، فلا يتحرك الإخوان والرأي العام معهم، بل وهم الرأي العام»([26]). حكمة بالغة، فهل أغنت النذر؟
[1] باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية، عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين.
[2] طلال، سلمان، عن مصر بعد حكم الإخوان، جريدة الشروق، عدد 31/ 7/ 2013.
[3] السيد، ياسين، حكم الإخوان في مصر: فشل سياسي وسقوط تاريخي، جريدة الحياة، عدد 4/ 8/ 2013.
[4] عمرو، الشوبكي، كيف سقط حكم الإخوان؟ مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 1 أغسطس (آب) 2013.
[5] حسن، البنَّا، رسالة المؤتمر الخامس، ، دار الدعوة، 1990، ص174.
[6] عمرو، الشوبكي، كيف سقط حكم الإخوان؟ م.س.
[7] السيد، ياسين، حكم الإخوان في مصر: فشل سياسي وسقوط تاريخي ، م.س.
[8] باقر، النجار، إخفاق الإخوان المسلمين في حكم مصر، جريدة الشرق الأوسط، عدد 22/ 7/ 2013.
[9]عمرو، الشوبكي، م.س.
[10] هدى، زكريا، مستشارو الرئيس يكشفون آليات اتخاذ القرار بمؤسسة الرئاسة؛ جريدة اليوم السابع، ديسمبر (كانون الأول)، 2012.
[11] أحمد، البهنساوي، قرار جمهوري بزيادة التعريفة الجمركية على 100 سلعة غير ضرورية، جريدة الوطن، 2013.
[12] أشرف، كمال، حصاد عام من حكم الإخوان لمصر ، موقع أنباء موسكو، 29 /6/ 2013، على الرابط التالي:
http://anbamoscow.com/world/20130629/383594397.html
[13] موقع البوابة نيوز، على الرابط التالي:
albawabhnews.com/News/42794
[14] محمد، حبيب، ماذا حدث عندما جاءت الحرية، جريدة الوطن المصرية، 17/ 9/ 2013.
[15] السيد ياسين، حكم الإخوان في مصر: فشل سياسي وسقوط تاريخي، م.س.
[16] محمد، حبيب، ماذا حدث عندما جاءت الحرية، م.س.
[17] عبدالله، سلام الحكيمي، سقوط حكم الإخوان في مصر… نظرة حول الأسباب والتداعيات، جريدة الوسط اليمنية، 18/ 7/ 2013.
[18] هذا التصريح في أبريل (نيسان) ٢٠١١، في مؤتمر بحي إمبابة في القاهرة بعد أقل من ثلاثة أشهر على قيام ثورة 25 يناير.
[19] طارق، الحميد، فشل مشروع إخوان مصر، 23 يونيو (حزيران) 2013، جريدة الشرق الأوسط، العدد 12626.
[20] ناجح، إبراهيم، صراع أهل الدعوة والحرب على السلطة، جريدة الوطن المصرية، عدد 24 /8/ 2013.
[21] سيد، قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، طبعة وزارة المعارف السعودية، نسخة إلكترونية، ص 19.
[22] المرجع السابق ص 9.
[23] المرجع السابق، ص 29.
[24] عبدالله، النفيسي، من لقاء تلفزيوني مع قناة الرسالة حول الإسلاميين والحكم، يوتيوب.
[25] حسن، البنَّا، من رسالة المؤتمر الخامس، مجموعة الرسائل، دار الدعوة، 1990، ص191
[26] حسان حتحوت، العقد الفريد، دار الشروق، 2000، ص112.