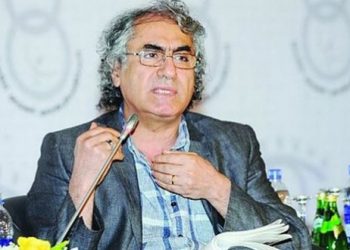مؤلف كتاب “الخميني في فرنسا الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثقة حول قصة حياته وحادثة الثَّورة”، لهوشنك نهاوندي، أحد المساهمين في السياسة والإدارة الإيرانيتين في عهد الشاه، كتاب مثير في معلوماته، وتوثيقه من الأطراف كافة، جدير بالقراءة، صدر بالفرنسية (2010)، ثم بالعربية (2016) عن طريق “معهد الدراسات الإيرانية حالياً”. اعتمد الكتاب على وثائق من العهدين الملكي والإسلامي، وعلى مقابلات مع أهل الشأن في الأحداث، خطأَ العديد من المعلومات التي بالغ بها صانعو الخميني، وكذلك خطأَ المعلومات التي تداولها خصومه، بمعنى كان الكتاب علمياً موثقاً، بعيداً عن الإسفاف والتضخيم، كاشفاً مختلقات العهد الإسلامي الإيراني بعد ثورة 1979.
مؤلف كتاب “الخميني في فرنسا الأكاذيب الكبرى والحقائق الموثقة حول قصة حياته وحادثة الثَّورة”، لهوشنك نهاوندي، أحد المساهمين في السياسة والإدارة الإيرانيتين في عهد الشاه، كتاب مثير في معلوماته، وتوثيقه من الأطراف كافة، جدير بالقراءة، صدر بالفرنسية (2010)، ثم بالعربية (2016) عن طريق “معهد الدراسات الإيرانية حالياً”. اعتمد الكتاب على وثائق من العهدين الملكي والإسلامي، وعلى مقابلات مع أهل الشأن في الأحداث، خطأَ العديد من المعلومات التي بالغ بها صانعو الخميني، وكذلك خطأَ المعلومات التي تداولها خصومه، بمعنى كان الكتاب علمياً موثقاً، بعيداً عن الإسفاف والتضخيم، كاشفاً مختلقات العهد الإسلامي الإيراني بعد ثورة 1979.
حسب الكتاب، صارت قضية صناعة روح الله الخُميني، بعد ظهور دراسات عديدة تناولت حياته وصعوده المفاجئ، حقيقة لا تخمين واختلاق أعداء، فالرَّجل بدأ حياته السياسية السنة 1963، كأحد رجال الدِّين المعترضين على إجراءات الثورة البيضاء، التي بدأها النظام الشاهنشاهي، والتي فيها نفع للإيرانيين كافة، وعلى وجه الخصوص العمال والفلاحون والنساء، حيث تقرر توزيع الأراضي على الفلاحين على حساب الإقطاعيين وشراكة العُمال في المصانع والمعامل، ومن حقّ النساء الانتخاب والترشُّح للانتخاب، فوجد رجال الدِّين الثوريون في الإجراء الأخير حجة أو عذراً للدفاع عن الدِّين، فخروج المرأة إلى الانتخاب ومساهمتها في العمل السياسي والحزبي يعرضها إلى مخالفة الإسلام، كذلك أن المساواة بين النساء والرجال يُخالف الشريعة، ومِن هذا الباب أُعلن الاحتجاج ضد الثورة البيضاء، إضافة إلى تضخيم ما جرى من اتفاق مع واشنطن على عدم خضوع العسكريين الأمريكان للمحاكم الإيرانية.
استعرض الكتاب حياة الخميني من إيران إلى النجف ثم إلى فرنسا، حيث الضاحية الباريسية “نوفل لوشاتو”، التي أقام بها الخميني ومرافقوه، لنحو شهرين، وفيها نُسجت القصة التي نقلت الخميني من رجل دين عادي، منح درجة آية الله من مراجع أكبر منه لسبب إنقاذه من حمن الإعدام، إلى آية الله العظمى والإمام ثم المرشد. يصعب فهم أن القصة نسجت نفسها بنفسها مِن دون كاتب سيناريو، يتابع أدوار قصته أو روايته، لكنها تظهر كأنها تغيير طبيعي في الحكم، استحقه الخميني فرفع إلى عرش إيران، وبكل سهولة.
التحق إبراهيم يزدي، وهو أمريكي- إيراني، وعلى اتصال بالدوائر الأمريكية، ليرافق الخميني من بغداد إلى باريس، وقدم نفسه على أنه الناطق باسمه ومترجمه، ثم رافقه إلى إيران، ليصبح وزيراً للخارجية لفترة وجيزة، لكنه، حسب الكتاب، كان الرابط مع المخابرات المركزية الأمريكية، أما الذين هيأوا الخميني بباريس فهو أبو الحسن بني صدر، الذي أصبح رئيساً للجمهورية، ثم هرب من حكم الإعدام، وصادق قطب زادة الذي تولى حقيبة وزارة الخارجية، وبعدها حكم عليه بالإعدام، ونُفذ به (1982) بحجة التآمر على الثورة، وأُخذ آية الله العظمى بهذه التهمة أيضاً، كان الاثنان يترجمان للخميني، وبوابة الفرنسيين إليه.
بعد وصوله إلى باريس وجد الخميني نفسه إماماً، وتحت تصرفه الإعلام الغربي والأمريكي أيضاً، فقد كانت “البي بي سي الفارسية”، والتي تُذيع مِن لندن، تلفزيون الثورة بحقّ، مهمتها إذاعة بيانات ورسائل الخميني يوماً بيوم، مع تضخيم تفاصيل الثورة داخل إيران. أخذ يتقاطر على الخميني في نوفل لوشاتو الكبار من الصحافيين والإعلاميين والسياسيين، ممَن لم يسمع به قبل وجوده في الضاحية الباريسية. سهلت للخميني بضاحية نوفل لوشاتو كافة وسائل الاتصال الخارجي، من مدن خطوط هاتف وبريد خاص لإرسال أشرطته إلى طهران، وخطوط تلكس داخل البناء، حتى إن أحد الصحفيين أخبر وزارة الداخلية الفرنسية عن ذلك، فقيل له هذا لا يخصك، مع حراسة مشددة فرنسية، وكتابة المديح له في الصحف الفرنسية الكبيرة، مع مكان إقامة واسع جداً له ولمرافقيه.
حسب الكتاب أن السيناريو بدأ يُحاك منذ 1975 بعد أن تصلب شاه إيران في رفع أسعار البترول، وأخذ يعد العدة للاكتفاء الذاتية في الكثير من البضائع ومنها الأسلحة، وأخذ لا يعنى بالمصالح الأمريكية والأوروبية كالسابق، وبدأ يتحدث عن إيران عظمى قد تستغني عن القوة الغربية، إلى جانب أن الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان لم يكن مرتاحاً لشاه إيران، لأمور بروتوكولية حدثت لأكثر من مرة، لكن هذا لم يكن المؤثر الأول، بقدر ما أن القضية أبعد من هذا بكثير.
إلى جانب ذلك أن اليسار الأوروبي على العموم، ينتصر لأي قوى تُخالف العهد الملكي الإيراني، حتى وجدوا في الخميني الرجل الثوري، الذي يستحق الدعم، ومثلما صارت البي بي سي البريطانية قناة للثورة أصبحت “الليموند” الفرنسية صحيفة الثورة، حيث تجري اللقاءات مع الخميني، والعراب كان إبراهيم زادة، الذي كانت له صلة بالأمريكان، ورافق الخميني من العراق إلى فرنسا، كذلك قام صادق قطب زادة وحسن بني صدر بدور المترجمين والأعرابيين بين الفرنسيين والخميني.
على خلاف الواقع أخذت وسائل الإعلام الغربية تشير إلى الخميني بالإمام ورجل المرحلة، مع أنه لم يكن بالمستوى الفقهي الذي يمنحه لقب آية الله، وما حدث أنه عندما اعتقل 1963 وسُجن، اجتمع رجال الدين الكبار ومن بينهم شريعتمداري، المرجع الكبير في زمانه والذي اعتقله الخميني بعد انتصار الثورة، ومنحوه درجة الاجتهاد، أي أصبح آية الله.
كان الخميني، بعد وصوله النجف منسياً، وبما أن تغيير الحكم في إيران، والذي اُتخذ فيه قرار أمريكي وغربي، يبحث عن قائد، فلم يجد أفضل ولا أسهل من تقديم مثل الخميني، وبدأ الأمر من هناك، حتى وصل إلى باريس وضاحيتها نوفل لوشاتو، أُسدل الستار عن تاريخه السابق، بأنه ابن رجل هندي، ووالده رجل عادي، وعلى غرة أصبح والده ثورياً شهيداً على يد رضا بهلوي، بينما حادثة مقتل والده مصطفى قد حدثت قبل أن يتولى رضا شاه الحكم ويصبح ملكاً، إنما كان ضابطاً في الجيش القاجاري وقتها، وأن قتله له علاقة بكونه كان يعمل لدى أحد ملاكي الأرض، وهو الذي يتولى الاتصال بالفلاحين، وتبليغ ما يريده ذلك الملاك، فوقع الغضب ضده مباشرة، وقُتل، ولم يكن رجل دين كبيراً، ولا كان ضد الإقطاع والملكية، لكن الحقيقة أنه كان رجلاً متواضعاً، ولقبه “الهندي”. غير أن تاريخ الأُسرة قد تبدل، حسب متطلبات مهمة الرجل الذي سيتولى قيادة الثورة، وهذا ما حصل بالفعل، فالثورة تحتاج إلى إمام وآية الله العظمى، وله أُسرة ثورية ضد حكم الشاه، فكان كذلك.
كان مرض شاه إيران، الذي أخذ يتسرب إلى الأوساط السياسية السنة 1976، وكان قد بدأ معه قبل عام، حوَّل صاحبه بالتدريج إلى شخصية ضعيفة، غير قادة على مواجهة الحوادث الجسام، ولم يتخذ خطوات عملية لإنقاذ العرش من الانهيار. تحدث الكتاب عن دخول عناصر ثورية عربية وفلسطينية إلى إيران، ومساهمتها في بث الرعب عن طريق الاشتراك في التظاهرات، وممارسة القتل على أن المقتولين كانوا ضحايا رصاص النظام.
اعتمد المؤلف هوشنك على مذكرات أحد قادة الحرس الثوري، والذي ساهم في التمهيد للثورة، أن جماعة الخميني كانوا يأخذون الجنائز، بطرق عديدة، ويشيعونها على أنها ضحايا قوات الأمن، وذلك لإثارة الرأي العام، والقيام بحرق المؤسسات والتفجيرات، ومن أبرزها كان تفجير سينما في عبادان، والتي يرتادها جمع غفير من الإيرانيين، من نساء ورجال وأطفال، وقد أسفر هذا التفجير عن حرق مبنى السينما وحرق مَن في داخله، وهم كانوا أكثر مِن أربعمائة إنسان، وذلك في السنة (1978)، وكان الغرض هزّ الثقة في النظام، واتهام النظام في الفعل نفسه.
حاول شاه إيران في طرق كثير، إعادة الاستقرار، كي يتمكن من نقل العرش إلى ولده وهو ولي العهد، فالمرض أخذ يتطور في جسده، والثورة قائمة. لكنه لم ينجح، حسب الكتاب، باختيار رئيس وزراء مناسب للمرحلة، فالإصلاحات التي حاولها رؤساء الوزراء الذين تناوبوا على رئاسة الوزراء، كل شهرين أو ثلاثة، لم تكن مجدية، بل جاءت متأخرة، لكن أي شاه إيران ضيعت فرصة اختيار أحد قادة الجيش، المعروفين بحزمهم، لرئاسة الوزراء، بقدرته على ضبط حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي أُعلنت، وخلاف هذه الأحكام المعلنة، إلا أن التظاهرات مستمرة.
حسب الكتاب “الخميني في فرنسا” كانت هناك مبالغة في أعداد المتظاهرين، بل إن الأعداد التي خرجت لتأييد الحكم الملكي لم تكن أقل، غير أن الأمور أخذت تسير نحو الانتكاسة. بعدها رُشح لرئاسة الوزراء ابن الضابط الذي أعاد الشاه بعد أن ترك إيران في عهد رئيس الوزراء مصدق، وكان هذا زوج ابنة الشاه، من زوجته الملكة ثريا المصرية، إلا أن الصراعات داخل الأسرة الملكية، وميل الملكة فرح إلى بختيار (آخر رئيس وزراء في العهد الملكي) قد حسم الموقف، وبختيار نفسه لم يكن في داخله على وئام مع الأسرة الملكية، فقد أُعدم أبوه لسبب من الأسباب. لذا كان بختيار يُفكر بإلغاء الملكية، لكن بطريقة أُخرى، عن طريق دفع الشاه إلى الخروج من إيران، والتسوية مع الخميني.
كان الخميني في النجف يتوسط لشاه إيران كي يعود إلى قمّ، ومِن المؤكد أنه سيخضع لنظام الدولة، لكن الشاه، الذي لولا موافقته ما وصل الخميني إلى النجف، امتنع عن إعطاء الموافقة، من دون اكتراث بأهمية الخميني نفسه. ظل التضخيم الثوري مستمراً للخميني، حتى إنه عندما توفي ولده مصطفى الخميني، بسبب السمنة ومرض السُكري، أقاموا له داخل إيران مجلس عزاء ونعتوه بالشهيد، على أنه قتيل السافاك الإيرانية، والتي حلت محلها اطلاعات في النظام الإسلامي. غير أن الأمن الإيراني لم يسع لمنع مجالس العزاء التي أقامها أصحاب الخميني.
صاحب ذلك أن كانت العلاقات العراقية الإيرانية، قبل 1975، سيئة فأخذ النظام العراقي يستفيد من وجود الخميني كمعارضة وبالتنسيق مع الشيوعيين الإيرانيين، والذين اعترف بهم نظام الخميني في بداية الثورة، ثم قضى عليهم، وأخرج قادتهم على شاشة التلفزيون كعملاء للاتحاد السوفيتي، مع أنه -حسب الكتاب- أن المخابرات الروسية كانت تشجع نشاط آية الله، وليس بعيداً عن ذلك تم بتنسيق مع الدولة العراقية القريبة من موسكو آنذاك.
أخذ أعوان الخميني يصلون إلى ضاحية نوفل الباريسية، ويحكي الكتاب عن وصول حسين منتظري من إيران إلى باريس، والذي هو الآخر أخذ رتبة آية الله، وعندما وصل استقبل عند باب الطائرة من قِبل الفرنسيين، وكان يملأ الطائرة مزاحاً مع الآخرين، ومعلوم أن منتظري كان تلميذاً لدى الخميني، والأخير لم يحصل على الاجتهاد، فكيف بتلميذه يكون قد لُقب بآية الله، وهي عادة تمنح للمجتهد في الفقه؟!.
حسب وثائق مؤلف كتاب “الخميني في فرنسا”، كان منتظري يأخذ مساعدة من أحد الشخصيات القريبة جداً من القصر، أي أحد أقارب الشاهبانو أو الملكة فرح ديبا نفسها، يعطيه كراتب تحت مسمى الزكاة أو الخمس والمساعدة، وعندما أراد السفر إلى باريس، للالتحاق بالخميني، لجأ إلى هذه الشخصية للحصول على جواز وتذكرة سفر ومصروف جيب، وقد حصل على ذلك، وركب الطائرة إلى باريس، إلا أن أحد الركاب، لاحظ خفة هذا الشيخ وتوزيعه المكسرات والحلوى على الركاب، ثم عند نزوله استقبله رجال فرنسيون على باب الطائرة، وأخذوه حيث يقيم الخميني، فما سرّ ذلك؟!
كان النقاش جارياً داخل القصر الملكي عن مغادرة الشاه إلى خارج إيران، لكنه كان يُريد خروجاً يحفظ به كرامته، حتى من دون التفكير بالعودة، بينما لو أصبح غير شاهبور بختيار رئيساً للوزراء لكان الأمر آخر، فقد اقترح محبو الشاه ألا يُغادر إيران ويفقد العرش، بل ممكن مغادرة طهران إلى ناحية أُخرى، والجيش على استعداد لإعادة الأوضاع إلى نصابها، خصوصاً وأن العديد من الإضرابات قد انتهت، وعاد العمل في مؤسسات النفط في الأهواز والمؤسسات الأُخرى، لكن شاه إيران ظل مصراً على عدم تدخل الجيش ضد المتظاهرين، فلا يُريد مزيداً من الدِّماء، وربّما حالة المرض فرضت عليه هذا الشعور، بينما جماعة الثورة كانوا يقومون باغتيالات وتدمير للمؤسسات.
يقول مؤلف الكتاب هونك نهاوندي: كان على ما يبدو كل شيء يجري لصالح الخميني، وربما الخميني نفسه لم يصدق ما يحصل، فهو قد صرح في مقابلة له بأن لا يتولى منصباً حكومياً، ولا له شأن بالحكومة، وإنما يبقى ناصحاً مراقباً، والحكومة يتولاها أهل الاختصاص، كذلك تكلم عن الديمقراطية والانتخابات والعدالة الاجتماعية، وأنه بعيد عن الثأر أو الانتقام، لكن ما حصل كان خلاف ذلك تماماً.
حصل أن غادر الشاه وأسرته طهران، وترك أمور البلاد تُدار بيد شاهبور بختيار، وقد أراد هذا الأخير التحدث مع الخميني، وترك كبار رجال الدين في قُمّ، أولئك الذين كانوا يريدون وضعاً دستورياً، وتقليلاً من صلاحيات الشاه، وليسوا مع تغيير النظام، لكن تسارع الأوضاع جعل هؤلاء، وبينهم محمد كاظم شريعتمداري، غير مؤثرين، وسط الشحن الثوري، وتضخيم صورة الخميني إلى الحد الذي كانت تُقال عنه شائعات بأنه المهدي المنتظر، حتى حصل عندما قال له أحدهم ذلك اكتفى بهز رأسه والالتفات، ولم ينفِ أو يزجر الرجل، فهذا لم يتوافق مع الفكر الشيعي عن المهدي، لكنها فترة وجيزة ويعلن الخميني نفسه نائباً للإمام.
انتهى كل شيء، وهبطت الطائرة الفرنسية بطهران، والتي دُبرت مِن قبل الحكومة الفرنسية، ليس كما نُشر أن العسكريين قد استقبلوا الخميني، إنما جرى التمثيل، وهو ارتداء عناصر للملابس العسكرية، كي يُعطى تصور لدى الرأي العام بأن الجيش مع الخميني.
سقط النظام الملكي رسمياً في شباط (فبراير) 1979، وكان الإجراء الأول محاكمات صورية لكبار ضباط الجيش، أما مكان الإعدام فكان سقف البناية التي سكن فيها آية الله الخميني أو الإمام الخميني، بعد أن كُتبت له سيرة ذاتية مزينة بالتقديس والكرامات، فصار عهد جديد، غير أن الظلم الذي كانت تشكو وتبالغ فيه المعارضة تحول وتبنته السلطة الجديدة.
تضمن الكتاب العناوين الآتية: السنوات الخمسون الأولى مِن حياة رجل الدِّين، الخطوات الأولى في السياسة، بداية المواجهة مع الحكومة، النفي إلى النَّجف، في طهران ضعف الحكومة وارتباكها، السَّفر، قصة نوفل لوشتاتو، معبود اليساريين والسُّذج، في طهران عجز الحكومة وانهيارها، آخر المساعي والحيَل، النهاية: لا شيء.