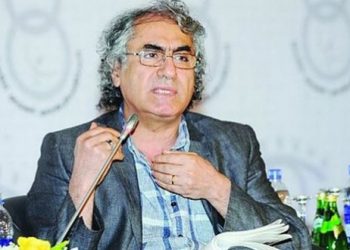آدم غارفينكل[1]

مع ظهور الإرهاصات المنذرة بتفشي جائحة فايروس كورونا، بدأت تلوح في الأفق رواية سردية عن أساليب القيادة الفاعلة بين الدول؛ وهي رواية يمكن صوغها بعبارة بسيطة على النحو التالي: أصبح بمقدور الأنظمة المستبدة فرض قيود صارمة وبالغة القسوة على رعاياها، وبذا أثبتت قدرتها على قلب منحنى انتقال العدوى هبوطاً بعد صعود، في حين أن الأنظمة الديمقراطية أثبتت أنها إما غير راغبة في فرض قيود مماثلة على شعوبها أو غير قادرة على ذلك. والخلاصة أنه عندما يجِدُّ الجِّدُّ، تتفوق الحكومة الاستبدادية على الحكومة الديمقراطية.
إذا كان ما تقدم يبدو مماثلاً إلى درجة ما للنقاش الذي دارت رحاه حول “القيم الآسيوية” (Asian Values) في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم، عندما زعمت أصوات معينة في الأنظمة الاستبدادية الجديدة (Neo-Authoritarian)، أو على الأقل أنظمة الحكم القائم على أسلوب الرعاية أو “أنظمة الحكم الأبوية” (Paternalistic Regimes) في آسيا، أن طريقتها في ممارسة الحكم كانت بصفة عامة متفوقة على الأساليب الغربية لأغراض تحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي؛ فإن ذلك مماثل لما مضى –على الأقل من حيث استلهام الرؤى إن لم يكن من خلال التوجيه المباشر نحو المجالات السياسية نفسها. وفي الوقت الحاضر، تماماً كما كان الشأن في السابق، اتضح أن هذه الحجة جرى تبسيطها تبسيطاً مخلاًّ أدخلها في دائرة الخطأ، فأصبحت مغلوطة من الأساس.
ينبغي أن تكون الخلاصة آنفة الذكر مثيرة لاهتمام العرب بصفة خاصة، لا سيما وأن أحوالهم السياسية عاصفة وملتهبة بصفة عامة في هذه الأيام، وتغلي غليان النار في المرجل؛ وهي مرشَّحة لأن تنحرف فتنجرف إلى أي عدد من التوجهات والاتجاهات المتعددة.
لعل أكثر ما يستحوذ على الاهتمام في أزمات من قبيل الأزمة الحالية ثلاثة أمور تتمثل إجمالاً فيما يلي: أولاً: ما إذا كان أغلب الناس يعتقدون أن حكومتهم تتعهدهم بالفعل بالرعاية الحقة، وتهتم بأمرهم وتُعنى بأحوالهم وتعلي من شأنهم؛ ثانياً: ما إذا كانت الشعوب على ثقة بأن حكوماتها تتحلى بالقدر اللازم من التروي والتفكير المتأني والفكر الثاقب والحصافة، وحسن التدبير في الإعداد لمواجهة طوارئ الصحة العامة؛ وأخيراً، ما إذا كان الشعب نفسه موحداً ومتماسكاً كمجتمع متكاتف يشد أزر بعضه بعضاً، بغض النظر عن مشاعر أفراده تجاه قادتهم الحكوميين الحاليين. ولبسط ما تقدم بصورة مختلفة اختلافاً طفيفاً، فإن ما يهم يتمثل في مستوى التماسك السياسي للمجتمع، وفطنة الطبقة السياسية وحكمتها وحصافتها وفصاحتها وكفاءتها الإدارية على مر الزمن، ومستوى الثقة الاجتماعية الراسخة المغروسة الضاربة الجذور في أعماق المجتمع نفسه.
هذه المتغيرات الثلاثة لا تنفصم عراها بأي طريقة سهلة، أو يمكن توقعها على نطاق تصنيفات أنظمة الحكم وتوصيفاتها وأنماطها؛ ذلك أنه يمكن للأنظمة الاستبدادية والديمقراطية -على حد سواء- أن تحرز درجات عالية في الأداء على مستوى المتغيرات الثلاثة آنفة الذكر؛ لأن التداخل بين الثقافة السياسية والظروف والملابسات الجارية لا يخضع لنظام تصنيف أيديولوجي ثنائي واضح وقاطع ومحدد المعالم. أما العوامل الأخرى التي ليس لديها ارتباط يذكر، أو لا شأن لها بنوع الحكم والأيديولوجيا، فهي ذات أهمية كبرى في هذا الخصوص؛ ومن أمثلتها: حجم المحتوى السياسي، أو الطابع السياسي لنظام الحكم، والثقافة الإعلامية، والخواص الشخصية المحضة المميزة للقيادة نفسها.
دعنا نتطرق بإيجاز شديد لثلاث دول نلقي من خلالها الضوء باقتضاب على التفاعل والتأثير المتبادل بين المتغيرات الثلاثة، الخاصة بأنواع أنظمة الحكم أو الأيديولوجيات، أو بهما معاً، والمتغيرات الظرفية السياقية الثلاثة المتعلقة بقرائن الأحوال المرافقة لها، والتي تم إيرادها للتو. أما الدول الثلاث فهي: الصين والولايات المتحدة وسنغافورة.
الصين… دولة الرعاية وتحديات الوباء
هل يعتقد معظم المواطنين الصينيين أن حكومتهم تتعهدهم بالفعل بالرعاية الحقة، وتهتم بأمرهم وتُعنى بأحوالهم، وتعلي من شأنهم؟ الإجابة بوجه الإجمال: نعم؛ ذلك أن سجل الحزب الشيوعي الصيني الذي يمتد لسبعين عاماً يمنح زعامته الحالية الحق في توقع الحصول على الثقة: ففي الأشياء التي تستحوذ على بالغ الاهتمام من أغلب الناس -والذين لا يضعون مسألة التفويض السياسي الفردي (أي اختيار الأفراد لمن يمثلونهم سياسياً) في مركز متقدم على قائمة الأولويات لأسباب ودواعٍ تاريخية وثقافية- أفلح الحزب في بلوغ المبتغى وتحقيق النتائج المتوخاة، متمثلةً في إيجاد منحنى بياني إيجابي للتمثيل الإحصائي للرخاء والرفاه والازدهار المادي المحسوس والمحسوب، واستتباب الأمن والنظام العام، واستعادة الكرامة الوطنية.
هل يعتقد معظم الصينيين أن الحكومة تمكنت من إعداد الخطط السليمة وتوفير الموارد اللازمة لمواجهة طوارئ الصحة العامة؟ يصعب القول بذلك، إلا أنه عند إلقاء نظرة من الخارج، يبدو أنه تم بذل قدر معتبر من الجهود التي جرى تسخيرها للتصدي للأمر في حدود المرحلة التنموية للدولة الصينية.
هل يتمتع أفراد قومية الهان في الصين -على أقل تقدير- بمستويات عالية من الثقة الاجتماعية؟ نعم، وبمؤدى هذا المستوى من الثقة الاجتماعية -المبنية على صيغة من صيغ القومية العرقية الموغلة في القدم إلا أنها صيغة مُجْدِيَة وفاعلة- يتم التغاضي عن الكثير من الخطايا والآثام مثل ارتفاع معدلات الفساد الصغير (أو فساد الصغار)، وازدياد عدد الحالات التي تتعارض فيها المصلحة مع الواجب لدى النخبة، وانعدام كفاءة النظام المالي وقصوره في تخصيص الموارد المالية.
الولايات المتحدة ….عن الحقيقة الجديدة
والآن دعنا نتطرق إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هل يعتقد أغلب الأمريكيين أن الحكومة الاتحادية تتعهدهم بالفعل بالرعاية الحقة، وتهتم بأمرهم وتُعنى بأحوالهم في مثل هذه الأوقات؟ كلا، ليس حقاً؛ بل ما انفكّت سحب كثيفة من التشاؤم المشوب بالسخرية تسود في أوساط المجتمع الأمريكي في العقود الأخيرة. يرى الأمريكيون العاديون أن النظام زائف ومزوَر، وأن الكونغرس يحظى بدرجة متدنية جداً من التقدير والاحترام. ويُغرِب معظم الناس في الضحك ولا يتمالكون أنفسهم عندما يزعم السياسيون أنهم يقدمون خدمة المصلحة العامة على مصالحهم الشخصية. لا غرو -إذن- أن غالبية من يدلون بأصواتهم من الناخبين إنما ينزعون بالفعل إلى الثقة فيمن ينتخبونهم من نواب في الكونغرس وإلى استلطاف هؤلاء النواب، حتى وهم يكادون ينتقصون من قدر الآخرين جميعهم، ويحطّون من شأنهم. فالعديد من الناخبين يسهل خداعهم والتغرير بهم وتضليلهم بكل بساطة. وقل مثل هذا عن الوحدات البيروقراطية ذات العلاقة؛ فهي لا تحظى بأي قدر من الثقة. ولعل أقل ما يقال في هذا الصدد -على سبيل المثال-: إن مركز مكافحة الأمراض (CDC) يحتل مركزاً متقدماً إلى حد ما؛ ولكن هذا لا ينطبق البتَّة على وزارة الخدمات الصحية والبشرية (HHS) أو وزارة الأمن الداخلي (DHS) أو إدارة الغذاء والدواء (FDA) أو إدارة المحاربين القدامى (Veterans Administration).
هل يعتقد معظم الأمريكيين أن الحكومة تمكنت من إعداد الخطط السليمة وتوفير الموارد اللازمة والتصرف بحكمة؟ العديدون افترضوا ذلك، لا سيما وأن الأداء السابق لم يكن بذلك القدر من السوء. بيد أن الأزمة الراهنة أماطت اللثام عن الحقيقة الجديدة، بحيث تبدت واضحة للعيان، فأصبحت مكشوفة أمام الجميع: لم يكن هنالك تخطيط متقن أو تخصيص سليم للموارد، لا من قبل الحكومة الاتحادية، ولا من قبل الغالبية من حكومات الولايات؛ بل حتى ولا من قبل الشركات المعنيَّة في القطاع الخاص.
عندما انبرى الدكتور أنطوني فوسي (Anthony Fauci) (مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المُعْدية) إلى الإدلاء بشهادته أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بتاريخ 11 مارس (آذار) 2020، أفاد بأنه “إخفاق” بالنظام ألا يوجد ما يكفي من الفحص والاختبارات لفيروس كورونا المستجد (COVID-19). وأردف قائلاَ: “إن النظام ليس مجهزاً في واقع الأمر، ولا مهيأً بما يتناسب مع ما نحتاج إليه في هذا الوقت –ما تسألون عنه الآن”. ولكنه، للأسف، لم يقل لماذا لم يكن النظام مجهزاً على النحو الذي أشار إليه، ولم يشأ أحد أن يسأله؛ ويعزى ذلك إلى سبب واضح، هو أن الجميع على علم بأن الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض لم تطلب توفير موارد مالية كافية للتجهيز السليم والإعداد الصحيح؛ كما أن الكونغرس -على تعاقب دوراته- لم يخصص موارد مالية كافية لهذا الغرض.
أما إدارة ترامب، فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، فتخلصت كليّاً من خلية الأمراض المعدية في مجلس الأمن الوطني؛ وهي الخلية التي تشكلت في عهد إدارة أوباما. ولعل من دواعي الحسرة أن قائمة المقترحات الخاصة بالتأهب والاستعداد الطبي المعزز، والتي درج الخبراء، بل وحتى القلة من السياسيين السابقين من أمثال الدكتور بيل فريست، على تقديمها على مر السنين، والتي لم تحظ إطلاقاً بأي تأييد معتبر، هي عبارة عن قائمة طويلة وقراءتها تسبب الابتئاس والاكتئاب والضيق[2].
هل هنالك ثقة اجتماعية؟ لا: بادئ ذي بدء، يشار إلى أن المجتمع الأمريكي الذي يعد أكثر تنوعاً -وإلى حد بعيد- من المجتمع الصيني، قد ظل يعاني لعشرات السنين من نزيف في الثقة الاجتماعية لجملة من الأسباب[3] ومع هذا، هنالك أوجه تفاوت مهمة بين الولايات. ففي حين أن سكان مينيسوتا -على سبيل المثال- يبقون على أهبة الاستعداد ويهرعون للتعاضد فيما بينهم ويهبُّون هبًّة رجل واحد إذا هبًّت عاصفة ثلجية، نجد أن أفراد العشيرة في نيو أورلينز لا يبدؤون، مجرد البدء، في مساعدة بعضهم بعضاً في الأعاصير العاتية الشديدة، والعواصف العنيفة الهوجاء التي لا تبقي ولا تذر. ويعزى ذلك إلى أنماط الهجرة والهجرة المضادة والنزوح والارتحال، والموروثات الثقافية الضاربة العمق والعميقة الجذور. ولكن هل ينطبق هذا على المجتمع ككل؟ لا مراء في أن مستوى الثقة الاجتماعية منخفض في العقود الأخيرة؛ وقد زاده ضغثاً على إبالة وقْعُ الآثار الجانبية للاستقطاب السياسي الحاد، الذي من جرائه يبدو معظم السياسيين أسوأ مما هم عليه بالفعل لدى معظم العقلاء من الناس.
سنغافورة…كفاءة الرعاية الحقة
والآن دعنا نتناول سنغافورة. تُرى، هل يعتقد أغلب السنغافوريين أن حكومتهم تتعهدهم بالفعل بالرعاية الحقة وتهتم بأمرهم وتُعنى بأحوالهم؟ الإجابة: نعم، بالتأكيد. وهل يثقون في أن أفراد الطبقة التكنوقراطية (مَنْ يتولون مقاليد الحكم مِنْ أصحاب الكفاءة والاختصاص والمعرفة والدراية الفنية والعلمية والدربة العملية) كانوا على القدر المطلوب من الكفاءة في التخطيط الصائب والتخصيص السليم لموارد الميزانية؟ بكل تأكيد. وهل يتمتع المجتمع بمستويات عالية من الثقة الاجتماعية العميقة؟ أما هذا السؤال، فهو سؤال مخادع ومراوغ وموارب؛ وهو سؤال يتوقف على هوية السائل.
هنالك أسباب موضوعية لانعدام الثقة بين القوميات الرئيسة الثلاث. وعلى غرار ما دأبت الحكومة على السعي إليه لأكثر من خمسين عاماً، يظل التناغم والوئام والانسجام الاجتماعي في سنغافورة يسير على قاعدة “عش ودع غيرك يعيش أو عش ودع الآخرين يعيشون”، ويصير ديدنه التعايش المتسامح مع التنوع أكثر من كونه مثالاً للأنموذج الأمثل للعيش بسعادة في “الكامبونغ” الكبير (كامبونغ كلمة مالاوية تعني المنطقة المقفلة المحيطة بالمنازل)؛ إلا أنه يبدو أن هذا أمر جيد بالقدر المطلوب لأن تباشر الحكومة أعمالها. فالناس هنا من جميع المشارب الثقافية يتوقعون بالفعل أن يحظوا باحترام الآخرين، وهم بصفة عامة يحظون بحق وحقيقة بالاحترام من الغير. كذلك، هنالك إحساس بأن الجميع يتمتعون بقدر معتبر من الإنصاف في التعامل والتكافؤ في الفرص على نحو يتم التعبير عنه على هيئة آداب سلوك عام، وأصول تعامل مع الآخرين بمراعاة مشاعرهم، والتصرف معهم بدماثة خلق وبطريقة مهذبة للغاية. وعلى هذا، فقد يتظاهر الكثير من الناس بذلك؛ ولكنهم يتظاهرون به للقيام به في أغلب الأوقات من قبل معظم الناس.
والآن دعنا نُلْقِ نظرة على المتغيرات العارضة، دعنا نبدأ أولاً بحجم المحتوى أو الطابع السياسي. من الواضح الآن، كما كان واضحاً في الماضي الذي يعود إلى قرون مونتيسكيو (Montesquieu Centuries)، أن دولة المدينة –أو المدينة التي تكون بشكل دولة (City-State)– تفضي إلى الفعالية والكفاءة في الإدارة وتسيير الأمور وتصريفها، إذ يسمح حجم سنغافورة بمستوى من التخطيط والرقابة وإدارة المعلومات، على نحو يتعذر تحقيقه في أماكن شاسعة الأراضي ومترامية الأطراف، مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وربما كانت هنالك مسألة أهم، هي أن هنالك توقعات كبيرة وآمالاً عريضة بأنه ما دام كل شيء في سنغافورة خاضعاً للتخطيط المحكم والإدارة المتقنة، وطالما أن هنالك ثقة راسخة في أن الحكومة جيدة جداً من حيث الأداء، فإن تنفيذها لبرامج الصحة العامة عند الأزمات سيكون جيداً جداً هو الآخر. ونسجاً على هذا المنوال، يظل الافتراض بأن الحكومة بريئة من الأخطاء الوظيفية والمهنية الكبرى قائماً إلى أن يثبت العكس. وهكذا فهي تبدأ بالافتراضات الإيجابية التي تكون لها بمثابة الدرع الواقي والحصن الحصين.
حتى الآن، لم تخيِّب الحكومة هنا ظناً. فقد ظل أسلوبها محكماً ونهجها متقناً، ولم يقع منها أي زلل في الخطاب أو ازورار عن الجادة في الأداء. ففي واقع الحال، أصبحت سنغافورة واحدة من أكثر الأماكن أماناً في العالم المتقدم في يوم الناس هذا؛ إذ إن معدل الوفيات فيها من جراء فيروس كورونا صفر. أكرر: صفر. وحتى الآن، تم دفع مقدار الكمية المتجهة لانتقال العدوى إلى أسفل، فظل منخفضاً. قد يكون هنالك ارتفاع كبير ومفاجئ في الإصابات فيما بعد. وفي حقيقة الأمر، هذا ما يتوقعه الكثير من الناس داخل الحكومة وخارجها -بيد أن الوضع حتى الآن جيد جداً وعلى ما يرام- كما أن الوضع في المكان يسفر -إلى حد بعيد- عن المردودات الإيجابية.
الوباء في الإعلام…حذر، انفتاح متفجر وانقياد
فيما يتعلق بالثقافة الإعلامية التي من الواضح أنها أقل استقلالاً عن الاعتبارات المتعلقة بالأيديولوجية ونوع النظام الحاكم من العامليْن العارضيْن الآخريْن، فإن الثقافة الإعلامية في الصين تخضع لدرجة عالية من الرقابة والضبط التنظيمي. ولأجل هذا لا مندوحة للناس عن الاعتماد على الإعلام الحكومي لاستقاء المعلومات الأساسية عن أزمات الصحة العامة؛ وهذا بمثابة سيف ذي حدين.
في دولة الحزب الواحد اللينيني (الذي لم يعد ماركسياً)، تواجه الحكومة مصاعب جمة في تجميع أجزاء الحقيقة لتكتمل صورتها ويتم طرحها في حيز التداول وروايتها لها وتبليغها بها هي نفسها. تتمثل الطريقة التشغيلية المعهودة في دق عنق المراسل الذي ينشر الأخبار السيئة، وإطلاق النار عليه. ولأجل هذا يُحْجِم المراسلون في أغلب الأحيان عن الاتيان بمثل تلك الأخبار، فينتهي الأمر بأن تصبح القيادة العليا مغيَّبة في كثير من الأحيان عن حقيقة ما يجري بالفعل على أرض الواقع.
لعل هذا هو السبب الرئيس في البداية السيئة جداً للصين في التعامل مع الفيروس عند تفشيه للوهلة الأولى. فقد كشفت السلطات النقاب عما جرى في ووهان؛ ولم تكن القيادة المركزية على علم ودراية بخطورة الموقف إلا في وقت متأخر من ذلك اليوم. لقد كان المسؤولون المحليون خائفين -بكل ما تحمل الكلمة من معنى- من إبلاغ المسؤولين في بكين وإحاطتهم علماً بما جرى.
وبتحديد أكثر، نشير إلى أن الدكتور لي ونليانغ (Li Wenliang)، وهو الطبيب الذي حاول دق ناقوس الخطر وتحذير السلطات المحلية في ووهان، تم قمعه وإسكاته ومُنِعَ من الكلام وانتهى به الأمر إلى أن تُوُفِّيَ بعد فترة قصيرة بافتراض أن المرض هو سبب وفاته.
من ناحية أخرى، في حالة الإشراف الأكثر طموحاً في العالم، تعد مراقبة المعلومات أمراً مفيداً، على الأقل لكبح جماح الشائعات وتخفيف وتيرة الرعب والذعر ودحض نظريات المؤامرة. فكيف يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين كل ما سبق بيانه؟ وهل أصبح المجتمع الصيني في الوقت الحالي أكثر ثقةً في الحكومة التي أفلحت في أن تجعل منحنى الإصابة بالعدوى مستقيماً من خلال تقليص عدد الإصابات؟ أم إنه أصبح أقل ثقة بحكومته من جراء التخبط الواضح في المراحل المبكرة؟ أم الحقيقة أن مستشفى جرى إنشاؤه بطريقة متسرعة سرعان ما انهار بشكل مخزٍ ومفضوح؟ من السابق لأوانه تماماً إصدار حكم في هذا الصدد.
أما الثقافة الإعلامية الأمريكية، فهي منفتحة ومفتوحة على مصراعيها؛ وهي مترعة بقاذورات الطفح الإلكتروني الكريه، والسفاسف والترهات والتفاهات وضروب الهراء الأخرى؛ وقد رزئت الثقافة الإعلامية في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بنمط تجاري يعلي من شأن الإثارة الحسية وفخاخ الإغراءات والغواية المضللة على حساب الحقائق والتحليل الرصين. لا يوجد في الولايات المتحدة في يوم الناس هذا إنسان عاقل راشد يثق في وسائل التواصل الإلكترونية لتقديم أخبار شاملة وذات صدقية ويمكن الوثوق بها أياً كان موضوعها؛ وهذا يقذف بالعديد من الأشخاص بلا هوادة إلى مزالق الإحالة الذاتية لوسائل التواصل الاجتماعي؛ مما يزيد الأوضاع سوءاً على سوء. ومع تضعضع نطاق التركيز والانتباه الذي أصبح في حالة يرثى لها، بسبب انتشار ظاهرة الإدمان العصبي والفسيولوجي على التسمُّر أمام الشاشات، ولا سيما في أوساط الشباب، فإن المحظوظين ممن يتلقون الأخبار الحقيقية النادرة يكونون -في أغلب الأحيان- ممن تعوزهم المهارة ويفتقرون إلى الخلفية التعليمية، ويفتقدون الصبر -بصفة خاصة- لفهم تلك الأخبار واستيعابها بأي طريقة.
ففي هذا المقام، لا طائل من أن يكون لدينا في الوقت الحالي، رئيس لا يألو جهداً في الإمعان في استغلال تقنيات المعلومات الحديثة، وهو لا يلوي على شيء لتحييد جهود الصحافة المهنية، ولا يرمش له طرف أو يشعر بمثقال ذرة من تبكيت الضمير وتأنيبه، وهو يختلق الأكاذيب التي يرى أنها تخدم أهدافه السياسية، فينثر هذه الأكاذيب والافتئاتات والافتراءات يمنةً ويسرة، وينشرها على القريب والبعيد متى رأى أنها تناسب أغراضه ومراميه؛ وهذا أمر يتم بشكل يومي. أما في كذبه وتحريه الكذب البواح، فهو كذاب أشِر لا يشعر بأي ذرة من خجل. وأما كل من استغرب أن الرئيس سعى إلى أن ينحي باللائمة على المهاجرين ذوي الأصول الإسبانية والأوروبيين القادمين من القارة والصين، وأن يحملهم مسؤولية تفشي الجائحة في الولايات المتحدة، تماماً كما فعل مساء اليوم الثاني عشر من شهر مارس (آذار) في خطابه الذي بثه إلى الأمة من البيت الأبيض، فلا بد أنه كان في غفلة ولم يكن منتبهاً؛ وسيكون الشعور بالإحباط وخيبة الأمل من نصيب كل من يرى أن هذا لن يؤثر في ما يعتقده الملايين من الأمريكيين الأقل تعليماً، وما يقومون به إزاء الجائحة التي اجتاحت البلاد. ولن يستطيع أحد القول بما سيحدث إذا اتضح أن الرئيس وربما أيضاً نائب الرئيس -بل وربما السيد/ بايدن، والسيد/ ساندرز كذلك- مصابون بفيروس كورونا.
تتخذ الثقافة الإعلامية في سنغافورة موقعاً ما بين رصيفتيها في الصين والولايات المتحدة. فهي مطواعة سلسة الانقياد وسهلة الانصياع ولكنها ليست خاضعة للرقابة، وتتناثر فيها الآراء المتنوعة هنا وهناك حول بعض المسائل، ولكن ليس من قبيل لا يوجد شيء محظور وكل شيء مسموح كشأن لوثة التطرف في التحرر من القيود، على غرار ما هو سائد في الولايات المتحدة. فقد صرح مارك توين ذات مرة قائلاً: “ينعم الشعب الأمريكي بثلاث آلاء عظيمة ويتمتع بثلاث مكرمات عظمى، هي: حرية التعبير، والصحافة الحرة، والحس السليم في عدم استخدام أي منهما”. ولعل من دواعي الحسرة أن الجزء الأخير من الإفادة لم يعد كما كان من قبل.
إذا كان غياب أي إعلام مستقل في الصين ينعكس سلباً على مصداقية الإعلام الرسمي ويزعزع الثقة فيه، فإن أصوات النشاز في الإعلام بالولايات المتحدة تجعل من الصعب على المعلومات الدقيقة الصادرة عن الجهات الخبيرة أن تطغى وتتغلب على ما تحدثه البيئة الإعلامية الحالية من جلبة وضوضاء، ومن معدل منخفض جداً لنسبة المحتوى الرصين إلى المستوى الغث (أو نسبة الإشارة إلى التشويش بلغة الاتصالات). أما في سنغافورة، فينزع الإعلام إلى تعظيم قيمة الحكومة في مثل هذه الأوقات، ولكن دون إطلاق العنان وترك الحبل على الغارب للوزراء؛ إذ إنه عندما يقع زلل أو خلل من المسؤولين، فمن المؤكد أن الجمهور الواعي والمتيقظ سيكون على علم بذلك.
عليه؛ يصبح لدينا وضع كلاسيكي معتدل ومتوازن. فالثقافة الإعلامية في الصين باردة أكثر مما ينبغي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية ساخنة أكثر مما ينبغي. أما الثقافة الإعلامية في سنغافورة، فهي مناسبة تماماً، على الأقل في الوقت الحالي وفي هذا الوضع القائم بصفة خاصة.
القادة الثلاثة وإدارة الأزمة
أخيراً، لدينا الخواص الشخصية المميزة للقادة. ففي وضع مثل الوضع الذي يشهد تفشياً لجائحة الكورونا، نحتاج إلى قادة يستطيعون إعطاء الانطباع بالحزم والتصميم والحيوية والحماس والهدوء ورباطة الجأش في آنٍ معاً؛ قادة يمكنهم إثبات أن الحكومة تعمل في تناغم وانسجام لتحقيق المصلحة العامة، ويقدرون على تحقيق التوازن المطلوب بين بث الأمل والتبصر بالعواقب، وبين الخوف والرجاء. تُرى، ماذا فعل الزعماء الكبار الثلاثة حتى الآن؟
أما الرئيس الصيني شي جين بينغ، فهو بالفعل يعطي الانطباع بالحزم والعزم وقوة الشكيمة، مع الهدوء ورباطة الجأش، إلا أنه يفتقر إلى الدفء. ومن المؤكد أنه ليس دنغ شياو بينغ (1904-1997). وأما دونالد ترمب، فهو الكابوس المرعب عينه في مثل هذه الأوقات؛ بل بما يفوق المعهود في الأوقات الاعتيادية؛ فهو لا يستطيع أن يبقي على الحقائق مضطردة ومباشرة وواضحة، حتى عندما يقرأ من نص مكتوب على ورقة. وهو يناقض حتى آراء الخبراء العاملين معه -مفضلاً عليها التخمينات الغريبة. ومن الواضح أنه يكون أكثر اهتماماً بتطمين الأسواق لمصلحته السياسية الخاصة من اهتمامه بتهدئة روع الأمة وتخفيف مخاوفها لصالحها. ولو كان مخلصاً لأمته ووفياً لها، لكان من الممكن تأييده عند إعادة روايته للحقيقة بشيء من البراعة والحذق؛ ولكن لما كانت مصلحة الأمة ليست من بين دوافعه، كان من الواضح أن أكاذيبه وتوجهاته الخاطئة ليست مصدراً للسكينة والهدوء الاجتماعي، وإنما من شأنها تغذية الهواجس والشكوك المترسخة أصلاً لدى معظم الأمريكيين بأن حكومتهم ليس بوسعها أن تتخذ أي إجراء صحيح في هذه الأيام. فهو ليس باراك أوباما أو حتى جورج دبليو بوش أو بيل كلينتون.
وماذا عن سنغافورة؟ حسناً، لورنس وونغ وزير التنمية الوطنية البالغ من العمر (47) عاماً، والذي تصدّر المشهد وأوكلت إليه مسؤولية الإشراف على الاستجابة الحكومية لأزمة الكورونا، كان أداؤه خالياً من الأخطاء. وقد أخذ على عاتقه مهمة التصدي للأمور، واستحوذ على الاهتمام وتمكّن من الرد على الأسئلة، بحيث تمكَّن رئيس الوزراء لي هسين لونغ من البقاء خلف الكواليس، حيث ينبغي أن يبقى. لا مراء في أن رأس المال القيادي قيم جداً وغال للغاية في أزمة من قبيل هذه الأزمة، بحيث لا يجوز إطلاقاً استنزافه وتبديد طاقاته وإهدارها من جراء الاستخدام المفرط. عندما خاطب رئيس الوزراء الأمة، أيضاً في مساء اليوم الثاني عشر من شهر مارس (آذار) 2020، كان خطابه مقتضباً ومباشراً وواضحاً وهادئاً ومُطَمْئِناً -متحدثاً بما قل ودل.
يشار في هذا الصدد إلى أن لدى رئيس الوزراء، السيد/ لي، سلبيات، هي كإيجابياته سواءً بسواء: فهو ابن لي كوانغ يو. وعلى هذا فمن ناحية، ينزع الناس -خصوصاً إذا كانوا صينيين- إلى افتراض أن التفاحة لا تسقط بعيداً عن الشجرة، وأن هذا الشبل من ذاك الأسد: فإذا كان الأب قد أدرك أنه سيكون زعيماً، سيدرك الابن الأمر نفسه. ومن الناحية الأخرى، فهذه هي شهرة الأب التي سارت بها الركبان، وسمعته الكبيرة التي سرت في أوساط الغالبية من السنغافوريين (وليس كلهم)، والتي بفضلها لا يمكن عزله وخلعه من الحكم، حتى لو ظهر فجأةً لكل من فيشنو أو بوذا أو يسوع.
في ضوء ما قيل أعلاه، ظهر “لي” دونما أخطاء في مساء الأمس. وكأمريكي مقيم في سنغافورة، أسفرت مقارنتي بين الأداءين في المساء عينه -أداء “لي” من جهة وأداء ترمب من جهة أخرى- عن شعوري بفزع متضخم وهو -للأسف- ليس شعوراً جديداً.
يمكن أن تكون الحكومات الأوتوقراطية الاستبدادية فاعلة وغير فاعلة -تماماً كما هو شأن الحكومات الديمقراطية- ذلك أن الثقافة السياسية المتراكمة التي تتبلور مع مرور الوقت، من شأنها أن تستميل بعض الدول بحيث تتجه نحو توابع مسارات تتوالى تباعاً، ويعتمد لاحقها على سابقها، وتنطوي على تعريف أنواع أنظمة الحكم -بيد أن التنوع في تلك الثقافات السياسية داخل أنواع أنظمة الحكم المعرَّفة تعريفاً أيديولوجياً، يكون واسع النطاق بدرجة تثير شكوكنا في وجود أي قيود صارمة لتفسير التفاوت في الأداء في أزمة صحة عامة.
وبالمحصلة، لم يكن الاتحاد السوفيتي البائد أقل استبداداً وقتها من الصين في الوقت الحالي؛ إلا أنه في واقع الحال تعامل مع كارثة تشيرنوبيل بطريقة رديئة، ليس في البداية فحسب، وإنما أيضاً طوال فترة استمرار الأزمة. ويكفي فقط أن ننظر إلى كيفية تعامل الحكومة الاستبدادية في إيران مع الأزمة لنقف على كنه الأمر ونستجلي الحقيقة. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فلَمْ تكن أقل ديمقراطية قبل جيلين أو ثلاثة أجيال منها في يوم الناس هذا. ومع ذلك، فقد تصدَّت لأزمات الصحة العامة بصورة رائعة تماماً في الماضي. وأما قطر، فعدد سكانها أقل من عدد سكان سنغافورة؛ ولديها بيئة دولة مدينة أو مدينة بشكل دولة أكثر قابلية للرقابة والضبط والخضوع للتحكم والسيطرة بالمقارنة مع سنغافورة، ومع هذا لم تكن استجابتها لأزمة الصحة العامة أكثر فعالية من استجابة سنغافورة لذات الأزمة، على الرغم من أن قطر أتيحت لها مدة زمنية أطول بكثير لأخذ الاحتياطات واتخاذ التدابير اللازمة وإحكام التأهب والاستعداد. ليس هنالك إذاً أنماط واضحة، متجذرة في البناء الأيديولوجي في هذا الخصوص. ثمة عوامل أخرى هي التي تبلور المردودات وتشكل الحصيلة.
لم يكن هذا الذي بين يديكم بمثابة تحليل علمي جامع مانع قائم على معطيات علم الاجتماع؛ وإلا، لَكُنْتَ مستمراً في قراءة هذا المقال ومتسمراً أمامه لساعات من الآن -بيد أنني أحسب أن حالة ظاهرة الوجاهة ولا تحتاج إلى برهان ما لم يحدث العكس، إنما تمثل دليلاً لا يرقى إليه الشك على أن حجم الطابع الحكومي في شكل الدولة وتقلبات الثقافة الإعلامية المتشكلة عن طريق جملة من العوامل، ونفوذ الشخصية وقوة تأثيرها هي أمور من شأنها تفسير الحقيقة أكثر من الشخصية الأيديولوجية للدولة. وإن نجاح سنغافورة في التصدي للجائحة -حتى الآن على الأقل- لا يقيم الحجة على صلاحية الحكومات القائمة على أسلوب الرعاية أو “الحكومات الأبوية” أو القيم الآسيوية أو إدارة أفراد الطبقة التكنوقراطية (مَنْ يتولون مقاليد الحكم مِنْ أصحاب الكفاءة والاختصاص والمعرفة والدراية الفنية والعلمية والدربة العملية) ممن يسعون لمباشرة الحكم بلا هوادة وبعزم لا يلين أو أي شيء من هذا القبيل. فهي فوق هذا وذاك حجة ودليل على أن سنغافورة هي سنغافورة، عمل بطولي فذ وإنجاز عظيم لا تضاهيها فيه أي دولة أخرى في العالم.
[1]* كاتب عمود منتظم في مركز “المسبار للدراسات والبحوث”، وزميل زائر متميّز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة.
[2]– See my “Fighting Ebola,” The American Interest Online, September 8, 2014
[3]– “Pourquoi n’avons-nous pas confiance en grand-chose?” Commentaire, N° 164, Hiver 2018-19, a translation of “In Way Too Little We Trust,” TAI Online, D