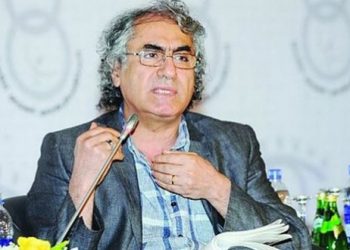أصبح من المسَلّم به لدى الكثيرين منا؛ أن الاسترقاق لم يعد له وجود، كمحطةٍ بارزةٍ في مشوار التجربة الإنسانية. وصرنا نبشِّر بهذا التغيير ونشير إليه؛ كدليلٍ على قدرة الجنس البشري على المضي قدماً والذهاب بعيداً في دروب الرقي الأخلاقي، بيد أن إخضاع هذا الأمر لمزيد من التدقيق والتمحيص يحتم علينا أن نتوقف هنيهةً للمراجعة والتقويم.
لقد ظل الرق يمثل جزءاً من الثقافة البشرية منذ فجر التاريخ المكتوب. فقد كان نظام الاستعباد أمراً اعتيادياً للغاية وطبيعياً تماماً، محفوراً في لحمة النسيج الاجتماعي ومنقوشاً في سَدَاتِهِ على نطاق المجتمعات البشرية، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من صميم التسلسل الهرمي الطبيعي؛ وذلك حتى الثلث الأول من القرن التاسع عشر. أما في يوم الناس هذا، فيكاد الرق يكون منبوذاً على مستوى العالم أجمع مع ظهور مبدأ المساواة الذي بزغ نجمه وشق طريقه بقوة على نطاق كوكب الأرض؛ إذ لا توجد حكومة على وجه البسيطة؛ تفسح مجالاً للرق والعبودية باستثناء: قلة من الجيوب المعزولة في منطقة الساحل.
بطبيعة الحال، ظل الراديكاليون والإصلاحيون المناهضون للرأسمالية يجادلون منذ منتصف القرن التاسع عشر، على أقل تقدير، بأن الرق في حقيقة الأمر لم يختف قط؛ لا سيما وأن عدم المساواة المتجسد في مطلوبات السوق قد أفضى إلى “عبودية الأجر (wage slavery)”. وبذا يكون تجريد اليساريين لمفهوم العبودية قد خضع للمزيد من التجريد. وقد عمد بعض الراديكاليين في هذه الألفية إلى إعادة صياغة مفهوم الرق والعبودية على هيئة جَأْرٍ بالشكوى من التدخل في شأنهم الخاص والتداخل مع أمور حياتهم الثرة والثرية والمستحقة؛ وهي شكوى تطرحها “كوري روبين (Corey Robin)”، المتخصصة في العلوم السياسية في كلية بروكلين، وتشرحها كما يلي:
“إن جدال الاشتراكيين ضد الرأسمالية لا يكمن في أنها تفضي إلى إفقارنا، وإنما إلى تكبيلنا ومصادرة حرِّياتنا. فعندما تكون رفاهيتي تحت رحمتكم ومتوقفة على نزواتكم ومرهونة بأهوائكم، وعندما تجبر متطلبات الحياة الضرورية المرء على الخضوع لمطالب السوق والرضوخ لإملاءات أصحاب العمل، نعيش عندئذٍ ليس في ظلال الحرية وإنما تحت نير السيطرة ونيران الهيمنة. يود الاشتراكيون وضع حد لتلك السيطرة والهيمنة: الانعتاق من سطوة الرئيس في مقر العمل والتحرر من الاضطرار لافتعال البسمة المتكلَّفة لأجل إبرام صفقة للبيع، ومن الاضطرار للبيع لأجل البقاء على قيد الحياة.
أما فكرة أن الرأسمالية بمفردها، أو حتى بصفتها العامل الرئيس ضمن عوامل أخرى، هي التي تفرض التسلسل الهرمي للعلاقات الإنسانية، فهي فكرة غريبة حقاً؛ والأغرب منها فكرة أن الاشتراكية هي المعادل المكافئ للحرية؛ مما يقود إلى الحالة “الأورويلية (Orwellian)”، (نسبةً للروائي جورج أورويل)، التي تفضي بدورها إلى أفكار “جنونية بحق”، وحقيقة تخطر على عقول المثقفين والمفكرين وتكون حاضرةً في أذهانهم، فتجعل الشخص النرجسي يُنْحِي باللائمة على الآخرين حيال أي مزايا، يحول أي شيء دون حصوله عليها أو تحصيلها من قبله. وقد نُصِرُّ أيضاً على الاستغناء عن العائلات أياً كان وصفها وأياً كانت صفتها، إن كان لنا أن نتخلص من جميع المشرفين والرؤساء المباشرين، فضلاً عن الاستغناء عن الحاجة لمقتضيات اللياقة وأدبيات التعامل بكياسة ولطف ولغو الكلام، بالإضافة إلى الحاجة لمهارات الاستمالة والإقناع.
إلا أنه بالرجوع إلى ذاكرة التاريخ، لم يكن مجرد رواج مبدأ المساواة -الذي ظهر إلى حيز الوجود في الألفية المنصرمة في أحضان الثورة الإبراهيمية (Abrahamic revolution) ولكنه لم ينطلق على مستوى العالم على يد القوى الأوروبية إلا بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية- هو ما يفسر النقلة الكبرى في المواقف تجاه تجارة الرقيق والاسترقاق -ذلك أن التقنية، التي تأتَّت عن طريق الثورة الصناعية بطريقة سريعة نوعاً ما مع مرور اللحظات التاريخية، هي التي أدت إلى تقويض أسس المسوغات الاقتصادية للعبودية والاسترقاق. فما إن حلت الآلة محل الإنسان في العمل حتى انتفت الحاجة إلى العبيد بصفتهم عاملاً من عوامل الإنتاج، فأصبح لا لزوم لوجودهم؛ أينما وُجِدَ ما يكفي من رأس المال والقدرات الفنية لإنجاز العمل! وفوق هذا وذاك، كان إحلال الآلة محل الانسان ذا تأثير واضح في مجال الزراعة على الرغم من أن بعض الاختراعات الميكانيكية، وبصفة خاصة محالج القطن التي اخترعها “إيلي ويتني (Eli Whitney)”، زادت من قيمة الجهد البدني والعمل اليدوي للعبيد خلال فترة انتقالية بحيث أصبحت أعلى وليس أقل (أعلى كما هو في المثال الأمريكي في لحظة واحدة).
وكشأن التاريخ الثقافي ثراءً وتنوعاً، من الطبيعي أن يكون التاريخ الاجتماعي للعبودية والاسترقاق متنوعاً بالمثل. تشير السجلات المبكرة إلى أن معظم العبيد كانوا عبارة عن أشخاص تجرعوا مرارة الهزيمة وتعرضوا لمضاضة الاستيعاب في الإمبراطوريات البدائية القديمة المنتشرة. أما استعباد المرء لأقرانه في مجتمعه، فقد كان أقل انتشاراً حتى مع تطور النظام الطبقي مع مرور الوقت في مرحلة ما بعد الثورة الزراعية، بالتلازم والتزامن مع تصنيف الأعمال والتقسيم الطبقي حسب الأحوال الاجتماعية. وهكذا ظهرت الاختلافات وتجلَّت أوجه التمايز في العديد من الثقافات العتيقة بين الرقيق، الذين كانوا يندرجون في عداد المتاع وما ملكت الأيمان، والخدم الأُجَراء المرتبطين بسند تعهد ثنائي –سواء بموجب عقد مؤقت أو بمقتضى اتفاق متبادل مستديم– والذين ما كان لهم أن يكونوا كذلك.
ربما يؤيد “التناخ” الكتاب العبري؛ (الأسفار العبرانية من الكتاب المقدس اليهودي)هذا التمييز ويشهد عليه. فعلى سبيل المثال، يمكن استعباد المهزومين، بل وينبغي استرقاقهم، لأن الأرض كانت تتقاسمها القبائل كما كانت تتقاسمها العشائر والعائلات داخل كل قبيلة! ولم تكن ملكية الأراضي تؤول إلى الأفراد بأي حال. لذا كان لدى كل فرد عمل يقوم به في إطار العمل الجماعي الموزَّع وفقاً للتسلسل الهرمي الاجتماعي. فإذا اضطرت العائلات للتنازل عن ملكية بعض الأراضي المخصصة لها أو للتنازل عن ملكية تلك الأراضي كلها لأي سبب، نص القانون على أن يكون مرور كل (50) سنة من حادثة التنازل بمثابة مناسبة لتخليد ذكرى تلك الحادثة “مناسبة اليوبيل للحادثة المذكورة”، احتفاءً واحتفالاً يُسْتَعاد بموجبهما الترتيب الاقتصادي الأصل، فيعود إلى حيز التطبيق، وتعود الأمور فيه إلى نصابها، فتُعاد الأرض إلى القبائل التي كانت تمتلكها أصلاً، ويتم إلغاء جميع الديون ذات العلاقة بتلك الأرض. وكان هذا هو أول نموذج مدرج في سجلات التاريخ لاستعادة الترتيب أو إعادة الترتيبات. فلئن غرد أحدهم خارج السرب وخرج عن إطار هذا النظام بحيث أصبح يعرض عمله على شخص لا تربطه به أي صلة، فإن ذلك إنما ينمّ عن وجود ظروف مؤسفة وغير عادية وغير موفقة.
لاحظ المؤرخون جملةً من أوجه التفاوت في العادات والأعراف والظروف والأحوال المرتبطة بالاستعباد والاسترقاق. تشير أوجه التباين المذكورة بشكل عام إلى الاختلافات في أنواع المزارع وأنماط الزراعة، والهياكل والبنى الاجتماعية، والثقافات السائدة لدى المجتمعات التي تروج فيها تجارة الرقيق، والعوامل الأخرى المتعلقة بالمناخ والتضاريس والمعالم الطبيعية والسمات والملامح العامة لسطح الأرض. ومع ذلك، ما انفكّت التقنية تمثل الحافز الرئيس لأهم اختراع في اقتصاديات الرق والاستعباد. عندما ظهر الطلب الشديد على عمل العبيد، ولكن لم يكن بالمقدور الحصول على تلك الأيدي العاملة عن طريق إلحاق الهزيمة بالآخرين وإخضاعهم في الأراضي المجاورة، أفضى تطوير السفن العملاقة التي تمخر عباب البحار والأمواج في المياه الزرقاء العميقة بالمحيطات إلى قلب المعادلة رأساً على عقب: فعلى خلاف الأمثلة السابقة للرق والاستعباد حيث كان العبيد يساقون سَوْقاً إلى العمل في أراضيهم المغتصبة منهم عنوةً بعد اندحارهم وهزيمتهم من قبل أسيادهم الأجانب الجدد، أصبح العبيد الآن يُخْتَطَفون ويُنْقَلون بعيداً عن أراضيهم للعمل لدى أسيادهم في المناطق البعيدة ذات المناخات الغريبة. وفقاً للأدلة الأثرية المتعلقة بالتجارة البحرية بين شرق آسيا والشرق الأوسط، يعود تاريخ تجارة الرقيق والمتاجرة في الأشياء القيمة والثمينة الأخرى -على أقل تقدير- إلى القرن العاشر قبل الميلاد.
أما تجارة الرقيق عن طريق البر، فقد تطورت هي الأخرى. ومن أمثلة ذلك أن القبائل الجرمانية (Germanic tribes) أقدمت على الاتجار بالسلافيين (Slavic peoples) الذين تم أسرهم في القرن الرابع الميلادي على أقل تقدير، بنقلهم من شرق أوروبا إلى بلاد القوط الغربيين في إسبانيا في مرحلة ما قبل دولة المرابطين. وجدير بالذكر أن كلمة “slave” باللغة الإنجليزية هي كلمة مشتقَّة من كلمة “Slav“.
الاستثناء الإبراهيمي
من المئات إن لم تكن الآلاف من أمثلة الاسترقاق في مختلف الثقافات بجميع القارات المأهولة خلال عشرات القرون، نعرف مثالاً شمولياً واحداً فقط لعبت فيه المعاملة الإنسانية للرقيق والعبيد دوراً محورياً في التسويغ الأخلاقي لثقافة الأسياد، هو مثال الثورة الإبراهيمية المنوه به أعلاه، والذي أسفر عن ظهور النسخ الرئيسة الثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلامية.
قد يتطلب الأمر كتاباً بأكمله لبسط المواقف الكاملة لليهودية والمسيحية والإسلام تجاه العبودية والاسترقاق، لا سيما وأن تلك المواقف شهدت تطورات توالت تباعاً مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن تلخيصاً للحقائق الأساسية سيكفي لأغراضنا في هذا المقام.
في اليهودية، كما في المسيحية والإسلام فيما بعد، يعد وجود العبودية أمراً مسلّماً به كنظام اجتماعي قائم. وقد كانت العبودية منتشرة في فترة ما قبل العهود الحديثة، لدرجة أن مناهضتها جملة وتفصيلاً تعد أمراً غير مثمر وبلا طائل، حتى إذا تسنى لأي شخص أن يناهضها ويتخذ موقفاً مناوئاً لها. تنطوي نصوص الكتاب العبري والعهد الجديد والقرآن الكريم على الإقرار بهذه الرؤية كأمر مسلم به ومفروغ منه.
بيد أن الكتاب العبري ينطوي على خروج صارخ وانعطافة حادة من النغمة التي كانت سائدة وقتها فيما يتعلق بكيفية معاملة العبيد والرقيق. فقد كان هنالك استبعاد وعدم إقرار بالقسوة والوحشية والسطو والسلب حتى قبل حلول الحاخامية أو العبرية المتأخرة. وقد وردت نصوص متكررة في التوراة (سفر الخروج “خروج اليهود من مصر” 20:22، الخروج 23:9؛ سفر الأحبار أو سفر اللاويين أو الكتاب الثالث من التوراة 19:33؛ سفر تثنية الاشتراع 24:18) يتردد فيها السبب ذاته لجميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالعبيد والرقيق والخدم: “لأنكم كنتم عبيداً في أرض مصر”. وبعبارة أخرى، ينبغي عليكم أن تتذكروا معاناتكم وأن تعترفوا بها وتتعرفوا عليها أكثر من أن تتسببوا في معاناة الآخرين. فضلاً عما تقدم، وهذا أمر بالغ الأهمية، إذا قست قلوبكم تجاه عبيدكم، ستصبحون عندئذٍ مثل فرعون: ستكونون ألد الأعداء لأنفسكم.
لم تنته معاناة اليهود بخروجهم من مصر. فقد عانوا من أشكال جديدة من العبودية في عهد الحكم الهلنستي، وبصفة خاصة في العهد الروماني. هنالك تعقيدات تكتنف تاريخ العبودية وطبيعتها في العالم الهلنستي: فعلى الرغم من أن العبيد مملوكون، إلا أنهم قد يصبحون من وقت لآخر من أعضاء الأسرة الذين يحظون بالتقدير والاحترام؛ حتى إن البعض منهم قد يكونون متعلمين يعرفون القراءة والكتابة ويعملون كأمناء سر لأسيادهم. بيد أن ذلك لم يكن الحكم -بل إنه لم يكن الحكم في العهد الروماني في “الأراضي المحتلة” بالإمبراطورية. فقد كان الكثير من الأثرياء اليهود يمتلكون العبيد في العهد الهلنستي، وبعد ذلك دارت عليهم الدوائر وأدارت لهم الدنيا ظهرها فأصبح العديد منهم من العبيد نتيجة للعديد من المحاولات الفاشلة للتمرد والعصيان ضد الحكم الروماني. وقد كان لهذه التجربة المتنوعة تأثير على مواقف الحاخامية أو العبرية المبكرة تجاه العبودية والاسترقاق.
لأجل هذا كان بن سيرا (Ben Sira)، وهو عالِم عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، يفضِّل تحرير العبيد وإعتاق رقابهم. وقد نصح زميله يهوذا في أثناء فترة الهيكل الثاني فقال له: “دع روحك تحب العبيد الأذكياء ولا تسلب منهم حريتهم[2]“.
بعد عدة قرون، ورد في التلمود، في الجزء المتعلق بالزواج التقليدي اليهودي في مرحلة “كيدوشين” أو الخطوبة، أن اليهودي يجب عليه أن يعامل خادمه كما يعامل نفسه سواءً بسواء. لا يجوز للسيد أن يأكل الخبز الطازج الفاخر ويطعم خادمه اليهودي خبزاً يابساً بائساً، ولا ينبغي له أن يعاقر من الخمور ما هي صهباء ومعتّقة ويسقي خادمه خمراً رديئاً؛ ولا يجوز له أن ينام على الفراش الوثير بينما ينام خادمه على الحصير. واختتم النص بالعبارة التالية: “كل من اشترى عبداً يكون قد اشترى لنفسه سيداً”؛ والمقصود هو اجتناب شراء العبيد.
بالمثل، ورد في موضع آخر بالتلمود (بافا متزيا 60 ب) ما يؤكد هذه النقطة من خلال التشديد على أن الاستعانة بيهودي فقير لإنجاز الأعمال حسب الضرورة أفضل من تملك العبيد أو الاحتفاظ بالخدم بصفة مستديمة. وفي هذا الصدد، ورد في “جيمارا” (الجزء الآرامي الأحدث من التلمود) ما يلي:
“ما هو تزيين الشخص؟ هو كما في الحادثة المتعلقة بعبد معيَّن طاعن في السن، ذهب إلى حيث صبغ شعر رأسه وخضّب لحيته باللون الأسود، بحيث يعطي انطباعاً بأنه أصغر سناً وأكثر شباباً؛ ثم مَثَلَ أمام “رافا” وقال له: اشترني أكن لك عبداً؛ فقال له “رافا” إن هنالك قولاً حاخامياً مأثوراً: دع الفقراء يكونوا من أفراد أسرتك. أنا أتبع نصيحتهم ولذلك لست في حاجة إلى عبد. وإذا احتجت إلى مساعدة يمكن أن أحصل عليها من المتسولين الذين درجوا على ارتياد منزلي وعلى التردد عليه مراراً وتكراراً.
نجد الموقف المبدئي نفسه لدى موسى بن ميمون أو ميمونيدس (Maimonides) (1138-1204)، وهو أهم مفسر يهودي خلال القرون الوسطى. ولكن لأجل فهم ما ينبغي عليه أن يقول يجب التحقق من أنه كتب ما كتب بعد أكثر من (1300) سنة من تملك أي يهودي لعبد كنعاني، أو منذ وجود أي مجموعة من الناس تحمل اسم الكنعانيين. وفي عمله النادر النفيس “مشناه توراة” في الكتاب أو الجزء الثاني عشر، الذي يسمى “الأملاك”، هنالك جزء فرعي تحت مسمى القوانين المتعلقة بالعبيد. ففي المقطع الثامن بالجزء التاسع، سرعان ما ينتقل موسى بن ميمون من نص القانون التوراتي، والذي لن يناقضه أو يحيد عنه قيد أنملة، إلى روح المنظور الحاخامي:
“يجوز أن يُسْتَعَان بعبد كنعاني لأداء العمل الشاق. وعلى الرغم من أن هذا هو القانون، فإن من موجبات التقوى ودواعي الحكمة أن يتحلى المرء بالرفق والرأفة ويتوخى العدل ويتحرى الإنصاف، وألا يثقل كاهل عبيده بما لا يطاق، وألا يتسبب في الإضرار بهم. وينبغي له أن يسمح لهم بمشاركته طعامَه وشرابَه. فقد كان هذا هو دأب الرعيل الأول من حكماء الأجيال السابقة والذين كانوا يذيقون عبيدهم من أطايب كل طبق من طعام يختصون به ويستأثرون به لأنفسهم، ويحرصون على إطعام حيواناتهم وعبيدهم وإمائهم قبل أن يتناول أي منهم وجباته.. وبالمثل ينبغي علينا ألا نضايق عبيدنا، وأن نجتنب الإساءة إليهم بالأفعال أو الأقوال لأن التوراة ينص على أن يقدموا الخدمة لا أن يتعرضوا للإهانة والإذلال أو يكال لهم السباب. ولا ينبغي الصراخ في وجوههم وصب جام الغضب عليهم؛ وإنما ينبغي ملاطفتهم والتحدث إليهم بلين ورفق مع حسن الإصغاء إليهم والإنصات إلى شكاواهم ومطالباتهم؛ إذ لا توجد القسوة والعجرفة والعنجهية إلا لدى غير اليهود من الوثنيين وعبدة الأصنام. وبالمقابل فإن أحفاد سيدنا إبراهيم -الأب الرئيس- رحماء يعم فيض رحمتهم فيشمل الجميع.”
أورد موسى بن ميمون الالتزام الأخلاقي الأساس بمزيد من الاستفاضة والتفصيل في كتابه الشهير “دليل الحائرين (Guide for the Perplexed)”، تحديداً في 3:39، حيث يختط نهجاً تأويلياً يشمل القوانين المتعلقة بالعبيد في إطار أرحب ومقاربة أشمل للاستدلال والتسويغ الأخلاقي؛ فهو يرى خيطاً مشتركاً في الآتي:
… القوانين الخاصة بالأشياء التي يلزم “تقدير قيمتها” والأشياء “التي يلزم تخصيصها ووقفها”؛ وكذا القوانين المتعلقة بكل من “المقرض والمقترض” والعبيد. عندما تتفحص هذه المبادئ وتتمعن فيها ستتبين لك بجلاء ووضوح فائدة كل منها وستستبين تلك الفائدة: إنها تعلّمنا كيف نتعاطف مع الفقير ونعين العاجز ونساعد المحتاج بطرائق عدة؛ كما أنها تعلمنا ألا نؤذي مشاعر من قعدت بهم الحاجة وعصف بهم ذل الفاقة والإملاق والعوز، وألا نهزأ بمن قذفت بهم الظروف في أتون العجز وقلة الحيلة.
يشتمل النقاش التالي على مزيد من التفاصيل والمصادر الخاصة بتلك المبادئ. فعلى سبيل المثال، يؤكد موسى بن ميمون أهمية القانون الذي ينص على وجوب تحرير العبد إذا فقأ سيدُه عينَه أو كسر سنَّه (سفر الخروج 21:26-7)؛ كما ينص على أنه إذا أقدم سيد على ضرب عبده ضرباً مبرحاً حتى مات ضرباً، وجب أن تكون عقوبة السيد هي الموت لارتكابه جريمة القتل؛ هذا بالإضافة إلى الأمر الذي مفاده أن “العبد الآبق من سيده لا يجوز لك أن تعيده إلى سيده” (سفر تثنية الاشتراع 13:15). أما لماذا، فلأجل تأكيد أننا إذا كنا مطالَبين بمراعاة العدل في هذه الحالة وفي الحالات الأخرى لمن هم في أدنى مراتب الحياة في الطبقة الدنيا، طبقة العبيد، فإلى أي حد يجب علينا أن نبدي مزيداً من الاحترام لكرامة من ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ وبعبارة أخرى، يرى موسى بن ميمون أن معاملة العبيد تنطوي على سجايا وخصائص متأصلة في صميم طبيعة المجتمع ومُنْبِئة عن شخصية كل فرد من الأفراد الذين يشكلون قوام ذلك المجتمع. وإذا كان السادة قساة على عبيدهم من الناحيتين البدنية والنفسية، فإن هؤلاء السادة ومن يشاهدون سلوكهم الوحشي ويشهدون عليه سيكونون أكثر استعداداً للقسوة على الآخرين كذلك.
وبرأيي أن موسى بن ميمون استنبط تأويلاته بطريقة متماشية تماماً مع الفكر اليهودي الذي تعود جذوره إلى العصور الحاخامية المبكرة وربما قبل ذلك. وعلى الرغم مما تقدم، فقد ألَّف النسخة الأصلية من كتابه “دليل الحائرين” باللغة العربية وأمضى حياته بأكملها في رحاب دار الإسلام متنقلاً من قرطبة إلى فاس إلى القاهرة –حتى إنه التحق بجامعة القرويين في المغرب! لذا ربما كان للفكر الإسلامي المتعلق بالعبودية صدى وتأثير على تحليله الرصين. ومع هذا فمن الوارد أن يكون هنالك غلو وتهويل في الزعم بما يلي –كما فعلت المؤرخة جوناثان بروكوب:
“تنطوي الثقافات الأخرى على تقييد حق السيد في إيذاء عبده؛ ولكن قلة هي الثقافات التي تحض السادة على معاملة عبيدهم برفق ورحمة. أما إدراج العبيد في فئة الأفراد الضعفاء الآخرين في المجتمع ممن يستحقون الحماية، فهو أمر غير مألوف وغير معروف إلا في القرآن الكريم. لذا يتمثل الإسهام الفريد والمتميز للقرآن الكريم في تشديده وحرصه على مكانة العبيد في المجتمع، وفي تأكيده لمسؤولية المجتمع تجاه العبيد، وقد يكون هو التشريع الأكثر تقدماً واستجابةً للتطلعات في زمانه فيما يتعلق بالرق والاستعباد”[3].
بصفة عامة، يحذو القانون الإسلامي حذو الموروث اليهودي الصحيح، ويتوسع في سياق ذلك الموروث[4]. ويلاحظ أن تطور التلمود في مراحله المتأخرة، في جيراما تحديداً كما ورد آنفاً، تواصل واستمر عن طريق النهضة والتكامل مع الإسلام. وقد تم تقنينه وتبويبه في بادئ الأمر كتابةً عام 500 ميلادي تقريباً ولكن لم يكتمل التبويب حتى الفترة بين عام (750-800) على وجه التقريب؛ لذا فقد ظل مستمراً في التطور خلال القرون الأولى للإسلام، في القدس وبومبيديتا وصورا في بلاد الرافدين حيث كانت توجد الأكاديميات التلمودية الكبرى. ومن المؤكد أن العلماء في عهدي الأُمويين (من عام “661-750”) والعباسيين (من “750-1258”) كانوا على علم بها وبأعمالها الممتدة في دار الإسلام.
لذا لم يكن من الواضح أي التقاليد الإبراهيمية هي التي أثرت على الأخرى وكيف كان التأثير ومتى حدث. فربما حدث التأثير في الاتجاهين (تأثيراً وتأثراً وانفعالاً وتفاعلاً)، مع مرور الوقت. بيد أنني أعتقد أنه يكفي تأكيد المشتركات الجوهرية العامة للمبادئ والاستدلالات والمسوغات الأخلاقية التي تجمع بين تلك التقاليد الإبراهيمية. تختلف اليهودية عن الإسلام في بعض التفاصيل القليلة؛ ولكن لا يوجد اختلاف حول المسائل الأخلاقية أو القانونية الجوهرية فيما يتعلق بهذا الموضوع.
ماذا عن المسيحيين؟ كان المسيحيون الأوائل، من ضحايا روما، شأنهم كشأن اليهود سواءً بسواء، وليس أقل منهم بأي حال. ومن أصول تصوراتهم اليهودية تبلورت مواقفهم تجاه العبودية؛ وهي مواقف ليست أقل سلبيةً. ولكن بعد قرون عدة ، انبرى العديد من المسيحيين البرتغاليين والإسبانيين والهولنديين والفرنسيين والإنجليز وغيرهم لتجارة الرق، وانخرطوا فيها وهي تتطور في الساحل الغربي لأفريقيا. أما المسيحيون فيما عرف لاحقاً بمسمى الولايات المتحدة بعد عام 1776، فقد مارسوا أيضاً تجارة الرق. وأما المستعمرون البرتغاليون والهولنديون، فقد تبنوا النظام الحالي للرقيق الوطنيين في جزر الهند الشرقية، ومضوا قدماً في هذا الصدد إلى أن أنهى البريطانيون ذلك النظام فيما بعد. وأما الإسبان، فقد أقدموا أيضاً على سلب السكان الأصليين في العالم الجديد، وعلى استعباد هؤلاء السكان على غرار ما أقدمت عليه الإمبراطوريات العتيقة بالعالم القديم.
وكدأب الأثرياء اليهود في العهود الفارسية والهيلينية، والأثرياء المسلمين في العديد من العهود، جاء دور المسيحيين عندما توفرت لديهم السلطة والثروة وسنحت لهم الفرصة: فقد فسروا حريتهم تفسيراً خاطئاً بأنها الحرية في أن يفعلوا ما يودون فعله، وليس ما ينبغي عليهم فعله.
الاستثناء الأمريكي
هنالك أيضاً الكثير من الوقائع والأحداث التاريخية التي تتطلب التلخيص. بيد أن الصفحات الأمريكية في سجل تاريخ العبودية تستحق وصفاً مختصراً؛ لأنها وثيقة الصلة بالأغراض المتوخاة في هذا المقام.
من المؤكد أن العبودية القديمة في العالم القديم كانت تتعلق بالاختلافات بين المجموعات البشرية –ذلك أن الصراع بين من هم داخل المجموعة ومن هم خارجها، استناداً إلى الاختلاف في اللغة والدين، هو صراع قديم قِدَم الذاكرة الجمعية للبشرية؛ ولكن لم يتم إطلاقاً تعريف هويات من هم داخل المجموعة ومن هم خارجها، وتحديد تلك الهويات بصورة صارخة وسافرة على أساس لون البشرة -أو ما كان من المتوهم وقتها بأنه من أساسيات العنصر العرقي– حتى أوان فتح الصفحة الأنجلو أمريكية في سفْر العبودية. ولم يشهد أي إرث قانوني تقليدي آخر تطوراً للمفهوم العنصري الزائف بشأن “الملوَّنين”؛ بمعنى أنه إذا كان لدى أي شخص –ذكراً كان أم أنثى- قطرة من دم “من غير الجنس الأبيض”، فإنه يصنف بأنه من “الملوَّنين”.
أما العامل الرئيس الآخر الذي يلزم ضبطه وتسجيله، فهو عامل الصدفة –ذلك أن العبودية في أمريكا الشمالية لم تبدأ بصورة كبيرة حتى حوالي عام 1680. فقد كانت الأعداد قليلة جداً قبل ذلك التاريخ. وقد اكتسبت العبودية زخماً هائلاً واكتست بهالة كبيرة بعد أن اخترع وايتني محالج القطن عام 1793. إلا أنه في ذلك الوقت كانت اعتراضات البروتستانت على العبودية من الناحية الدينية قد حظيت بالموافقة والتأييد بصورة متسارعة في بريطانيا وأمريكا. وكما هو معلوم تماماً، تم حظر تجارة الرق في الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس جفرسون؛ كما تم حظر العبودية جملة وتفصيلاً في بريطانيا وعلى نطاق الإمبراطورية البريطانية عام 1833. وبعبارة أخرى، بمجرد أن بدأ “العمل والنشاط التجاري” في التطور، شهدت البيئة المعيارية نقلة بطريقة أفضت إلى نسف الأساس الفلسفي والمسوغ الأخلاقي للعبودية.
والآن، أصبح الأوروبيون والأمريكيون العاملون في تجارة الرق -بيعاً وشراءً للرقيق- مفتقرين إلى أي شيء بأي قدر من قبيل الحساسية التي كانت لدى اليهود والمسلمين حيال الكيفية التي يجب اتباعها في معاملة العبيد. لقد كانت العبودية في أمريكا قائمة بصفة مستديمة على تحريفات وتشويهات دينية زائفة للإنجيل، وهي تشويهات وتحريفات أكثر تزمتاً وتصلباً؛ وكانت العبودية في أمريكا أشد قسوةً وعنفاً من العبودية في دار الإسلام. تجمّعت هذه العوامل المتقاطعة وتبلورت في السياق المناسب لينتج عنها قدر من التنافر الشديد في الأفكار والاستبصار المتأني والتفكير الجاد بشأن العبودية. ولعل أبرز مثالين لما ورد أعلاه من التنافر والتفكير الجاد هما جورج واشنطن وجورج ماسون مؤلف وثيقة الحقوق؛ فكلاهما امتلك العبيد، وكلاهما من فيرجينيا؛ ولكن ما من أحد يتصدر القائمة سوى توماس جيفرسون!
لقد امتلك جيفرسون عدداً من العبيد وكان على علم بأن مزارعه لن تدر له أرباحاً من دون هؤلاء العبيد عطفاً على التقنية البدائية التي كانت موجودة وقتها، وندرة العمال الأحرار الذين يمكن اكتراؤهم والاستعانة بهم. إلا أنه مع ذلك لم يكن ذاهلاً أو غافلاً عما كان يجري حوله. ففي كتابه الشهير الذي صدر عام 1781م تحت عنوان “ملاحظات حول ولاية فيرجينيا“، كتب في الاستفسار السابع عشر ما يلي:
“لابد أن هنالك تأثيراً سلبياً لا شك فيه على أخلاقيات شعبنا بسبب وجود الرق بين ظهرانينا. فمجمل التجارة بين الأسياد والعبيد عبارة عن تمرين مستمر لترويض العواطف الجياشة والمشاعر الصاخبة والاستبداد المتواصل والطغيان غير المنقطع من ناحية، والخضوع المذل والاستكانة المهينة من الناحية الأخرى. أطفالنا يرون هذا رأي العين، ويتعلمون تقليده لأن الإنسان حيوان من شيمته التقليد والمحاكاة”.
بطبيعة الحال، رأى العبيد الظاهرة نفسها، وكان القليلون منهم محظوظين بالقدر الذي مكنهم من الكتابة عن تلك الظاهرة. فقد أورد أوستن ستيوورد (Austin Steward) في كتابه الذي أصدره عام 1857م بعنوان “عبد لاثنين وعشرين عاماً وحر لأربعين عاماً” أن “تلك السلطة غير المقيَّدة وغير المحدودة من شأنها أن تحوِّل الإنسان العادي إلى طاغية مستبد، وتحول الأخ الشقيق إلى شيطان ووسواس خنّاس”. أما هاريت جاكوبس (Harriet Jacobs)، فقد عممت هذه الملاحظة في كتابها الذي صدر عام 1861م بعنوان “أحداث في حياة أَمَةٍ أو فتاة من الرقيق”، حيث كتبت ما يلي: “العبودية لعنة على البيض والسود على حد سواء”. لقد كان جيفرسون وستيوارد وجاكوبس يقتبسون من موسى بن ميمون أو ميمونيدس (Maimonides) ويعيدون صياغة ما ذهب إليه قبلهم؛ ولا مراء في أنهم كانوا يقتبسون من المفسرين اليهود والمسلمين الآخرين دونما إدراك منهم.
الخلاصة
عندما يتحدث طبيب أو ممرض يحمل حقنة مع طفل صغير فيقول له إن هذه الإبرة التي سأحقنك بها “ستؤلمني أكثر مما تؤلمك”، فهذه كذبة أريد بها إشغال الطفل وإلهاؤه في لحظة حقنه بالإبرة. ولكن عندما نفكر في العلاقة بين الأسياد والعبيد، فإن احتمال أن تفضي العلاقة إلى إيذاء السيد تماماً كما تؤذي العبد ليس كذبة ولا إلهاء؛ بل حقيقة لا سبيل لإنكارها.
ما الذي حصل عليه فرعون من قسوة قلبه؟ لقد حلت به الكارثة في البحر الأحمر. وكل شر أَمَرَ به للعبيد العبريين ارتد عليه وبالاً وشراً مثله، سواء بسواء؛ مصيبة مقابل مصيبة مقابل مصيبة لعشرة أمثالها. والعبرة هنا في النص بمقارنته مع التجربة وبمطابقته مع الواقع.
أما السطوة أو السلطة أو السيطرة، فغالباً ما تصطحب معها الغطرسة والخيلاء والزهو؛ كما أنها تجلب العجرفة والعنجهية والتكبر والتجبر. وهي تولِّد الخمول والغرور وعدم الإحساس بالآخرين مراعاةً لمشاعرهم، وتأتي كذلك برفقة الاعتزاز الكاذب بالنفس والاغترار بها، مع وجود ضرب من ضروب التوحد العاطفي والوجداني النابع من الذات. وهي فوق هذا وذاك تجلب الغربة الشعورية والاستلاب النفسي والذهول عن التجربة الإبداعية المنضبطة ذاتياً في الحياة العملية. أما الرغبة في السيطرة على الآخرين والمتولدة لدى السيد، فهي تنتقل في كثير من الأحيان إلى زوجة السيد وأطفاله. وحاصل ما تقدم بمجمله هو تآكل روح الجماعة في المجتمع برمّته. وكما لاحظ ابن خلدون في المقدمة (مقدمة ابن خلدون)، يؤدي حب السيطرة في نهاية المطاف إلى استدعاء مزيج من التفسخ والانحلال والانحطاط والجبرية والحتمية.
في عيد الفصح، اليهود مأمورون بأن يتفكروا في أنفسهم وفي كيف أنهم كانوا هم أنفسهم عبيداً في مصر وتم إعتاقهم. يأكل اليهود الخبز الفطير (ماتزا) الذي يسمى “خبز الابتلاء” ويبتعدون عن كل منتج خمير للتجسيد الرمزي للحاجة إلى زجر النفس وكبح جماحها وتنقية الروح من شوائب الكبْر والزهو والخيلاء. وهو وقت للبحث عن التهديدات الجديدة التي تنطوي عليها العبودية لمنع تداعياتها السلبية ودرء آثارها الضارة: فمن هو عبْد المال، وعبْد العمل، وعبْد اللهاث خلف الأبهة الاجتماعية الجوفاء، وعبد الجنس، وعبد التسلط على الآخرين، بل ومن هو عبد الأجهزة التقنية وأنظمة المعلومات التي أدمنها الكثير من الناس في الآونة الأخيرة.
ينبغي التوقف برهةً للتدبر والتفكير مليّأً في هذا النوع الأخير من أشكال العبودية الجديدة. فقد ظلت الأجهزة والأدوات لعشرات الآلاف من السنين، تمثل امتدادات لحواس الإنسان وأطرافه وإضافات لما بين جوانحه وجوارحه، وهي بمثابة الوسائل البديلة لأداء الشق البدني من العمل. وهذه الأجهزة والآلات مختلفة: فهي ليست امتدادات لأجسادنا أو سعرات حرارية مضافة لإعانتنا على إنجاز العمل، وإنما هي أجهزة ظلت تقوم مقام البدائل مطلقة العنان للفكر الإنساني، ومن شأنها أن تفضي إلى اضمحلاله وضموره وتلاشيه. فإذا كان بمقدورنا الذهاب إلى صالة التمارين الرياضية عندما يفضي انتشار الأجهزة والآلات التي تؤدي إلى الاقتصاد والتوفير في العمل إلى ضمور عضلاتنا وأجسادنا، فماذا عسانا أن نفعل عندما يتسبب انتشار أجهزة تقنية المعلومات في ضمور العديد من الأدمغة والعقول؟ إن المتضررين من هذه الأجهزة لا يدرون ماذا يفعلون. إنهم لا يدركون هذا الشكل الجديد من أشكال العبودية لأن عقولهم أصابها الضمور لدرجة أنهم لا يرون هذا الضمور وهو يداهمهم؛ وكدأب فرعون، يتوهمون أن هذه الأجهزة تمثل العبيد وهم الأسياد. ولا يرون المصائب تحل بهم إلا بعد فوات الأوان ولات ساعة مندم.
أما عيد الفطر المبارك، فهو يخدم أغراض المسلمين ببعض الطرق الشبيهة بطرق عيد الفصح في خدمة أغراض اليهود. وقد أخبرني أصدقائي من المسلمين كيف أن رمضان يقتضي الصبر والانضباط بصفة خاصة في هذه السنة أكثر من أي وقت مضى. وأخبروني كيف أن البعد الخاص بالزهد والتنسك في الصيام من شأنه حض المرء وتشجيعه على ممارسة التأمل الباطني ومحاسبة النفس، وتزكية القلب والوقفة الجادة مع الذات وسبر أغوار الصفات الشخصية والأفعال والأقوال والعلاقات مع الآخرين. فالصيام بهذه الطريقة شبيه بما أسماه اليهود “خبز الابتلاء” لجهة أنه يستنهض همم الناس ويستحث عزائمهم ليقِفوا بصورة واقعية على عيوبهم وأوجه القصور لديهم، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالزهو والكبر والخيلاء، مع التصميم وعقد العزم على اتخاذ ما يلزم حيالها وتدبرها بما يلزمها.
وهكذا يتضح أن البشرية لم تتمكن بعد من طي صفحة العبودية السوداء إلى الأبد، ولم تضع شرور العبودية تماماً خلف ظهرها، ولم تستطع اجتناب العقوبات المرتبطة بها. فكل ما في الأمر أن إغراءات العبودية يمكن أن تكون ماكرة ومخادعة، تماماً كإغراءات الأجهزة الدقيقة الجديدة ناعمة الملمس، والتي هي بالتأكيد دقيقة وماكرة. فهي إغراءات مخادعة لدرجة أنها يمكن أن تفضي بنا إلى الارباك واللبس في معرفة من هو السيد ومن هو العبد. وفي ضوء ما يحدق بالروح من المهدِّدات القديمة والجديدة على السواء، يكون احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك في هذا الوقت أهم من احتفالهم به في أي وقت مضى. لذا وباستصحاب هذه الروح، يطيب لي أن أهنئ جميع أصدقائي المسلمين وأقول لهم: عيد مبارك!
[1]– كاتب عمود منتظم في مركز “المسبار للدراسات والبحوث”، وزميل زائر متميّز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا في سنغافورة.
[2] Ben-Sira, Sirach (“Book of Ecclesiasticus”), 7:21.
[3] Brockopp, “Slaves and Slavery”, Encyclopaedia of the Qurʾān (Georgetown University, 1987).
[4] I assume al-Mesbar readers will be more familiar with Islamic sources and interpretations than Jewish ones, which is why I have elaborated the Jewish source material. But for easy reference, key verses in the Quran include: 2:177, 2:221, 4: 25, 4:36, 4:92, 5:92, 9:60, 16:71, 23:6, 24:33, 24:58, 33:50, 58:3, 70:30, and 90:13.