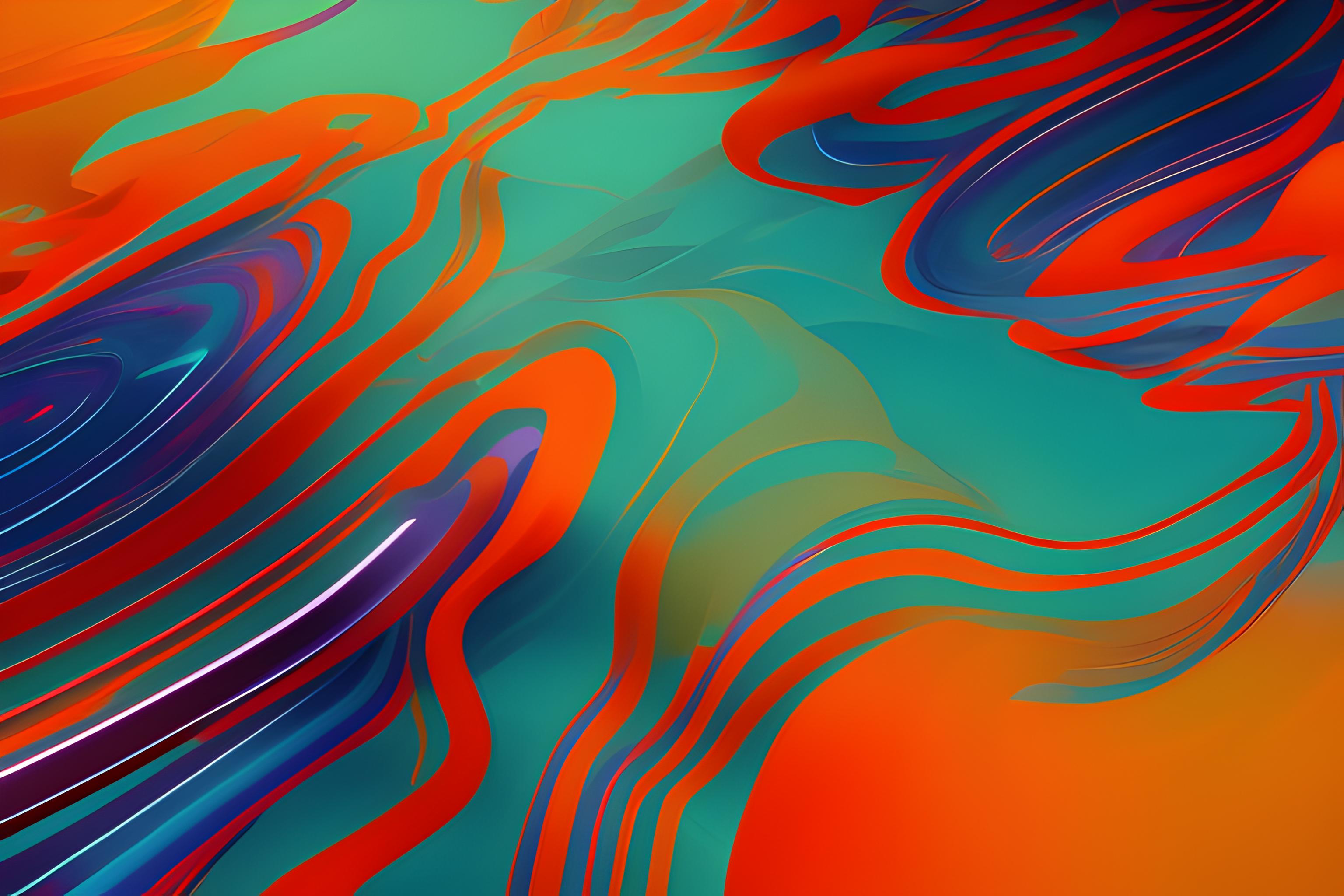يتناول كتاب المسبار «الحركات الإرهابية في أفريقيا: الأبعاد والاستراتيجيات» (الكتاب الثاني والأربعون بعد المئة، أكتوبر/ تشرين الأول 2018) الحركات الإرهابية في عدد من الدول الأفريقية، فيسعى إلى تحديد الظروف التاريخية والعوامل الاجتماعية والسياسية والإقليمية المساعدة على ظهورها، مما يسمح بتشكيل فهم أعمق حولها بهدف وضع استراتيجيات قادرة على النفاذ إلى جذور المشكلة الإرهابية، خصوصاً أن الدول الأفريقية ليس لديها رؤية استراتيجية موحدة أو مشتركة لمكافحة الإرهاب.
تنمو الحركات الإرهابية المنتشرة في عدد من الدول الأفريقية في بيئات جاذبة، إذ لم تستطع السلطات المتعاقبة، منذ حقبة الاستقلال والتحرر من الاستعمار، تثبيت وتوطيد دعائم الدولة القوية مما سمح بانتشار أسرع لـــ«فرق وجماعات الموت» التي تستغل ضعف الأنظمة السياسية وعوامل التهميش الاقتصادي والسياسي والصراعات القبلية والإثنية، وتعقيد التركيبة الاجتماعية وتداخلاتها، وتوسع أطر التداخل بين الدين والقبيلة والأيديولوجيا والإثنية؛ كل ذلك وغيره يتطلب دراسة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا في سياقات مغايرة لأساليب الفهم التقليدي، فأنشطة الحركات الإرهابية لا تقتصر على تنفيذ الأجندة الدينية والسياسية، إذ تتقاطع مع تعقيدات التركيبة القبلية وفشل سياسات الاندماج الاجتماعي، أي غياب أو عدم قدرة الحكومات على تحديث البنى المجتمعية، مما آل وساعد على تفجر الصاعق الإرهابي وانتشار جماعاته.
استراتيجيات مكافحة الإرهاب في الدول الأفريقية
يفحص عبده مختار موسى -بروفيسور في العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية (السودان)- استراتيجيات مكافحة الإرهاب في الدولة الأفريقية من خلال النظر في طبيعة المشكلات التي تواجهها، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات في بعض الخصائص الجوهرية لكل دولة أو منطقة/ إقليم في أفريقيا. وبصورة عامة لا تأتي “الاستراتيجيات” من فراغ، بل هي من ناحية ردة فعل مباشرة على الأزمات التي ظلت تواجهها القارة منذ انحسار الاستعمار وحتى عصرنا الراهن. ومن ناحية أخرى يمكن النظر للاستراتيجيات بأنها وليدة ظروف موضوعية وحتمية أملتها المتغيرات الداخلية والخارجية. كما أن هذه الاستراتيجيات هي وليدة فلسفة ورؤى محلية لا يمكن دراستها بمعزل عن طبيعة النظام السياسي، وجزئياً الإرث الاستعماري ثم فشل النخبة الوطنية والفساد وغياب الحكم الرشيد.
يدرس الباحث كيفية إتمام المقاربة لمسألة الاستراتيجيات هذه. ويترجم هذه المشكلة الجوهرية في أسئلة محورية: هل هنالك توجّـه عام للدول الأفريقية نحو صوغ استراتيجية/ استراتيجيات مشتركة لمواجهة/ مكافحة الإرهاب؟ وتحت أي إطار مؤسساتي: الاتحاد الأفريقي، أم المنظمات الإقليمية داخل القارة (الإيكواس/ الإيقاد/ الكوميسا… إلخ)؟ أم هل تتم هذه الاستراتيجيات معزولة ومستقلة في كل دولة على حدة، ثم تكون مهمة الباحثين تجميع هذه الاستراتيجيات في استراتيجية شاملة موحدة؟ وما الجهة المنوط بها تنسيق هذه الاستراتيجيات؟ وما علاقة هذه الاستراتيجيات بالاستراتيجيات الدولية الأخرى (الأمم المتحدة) في سياق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب؟ ثم ما الغطاء الشرعي لهذه الاستراتيجيات لكي يتم تنزيلها لسياسات تكون الدولة/ الدول مُـلزَمة بتطبيقها؟ هل هي الشرعية الدولية (الأمم المتحدة) أم دستور الدولة المعنية وتشريعات برلمانها، أم الاتحاد الأفريقي؟ وما الآليات التي تتم بها أو عن طريقها وضع هذه الاستراتيجيات؟ هل الفقـر والحرمان أحد محركات الإرهاب؟ وهل الدين أحد دينامياته؟ وإذا كان الدين هو محرك رئيس في الإرهاب، فأي نوع من الاستراتيجية مناسبٌ لمكافحته؟
ويرى أنه لا توجد في الواقع استراتيجيات موحدة أو مشتركة في القارة الأفريقية لمكافحة الإرهاب، وبالتالي تهدف هذه الدراسة المفتاحية لمحاولة «حثّ» الدول الأفريقية لصوغ مثل هذه الاستراتيجية. وهي ضرورة يفرضها التوجّه العالمي نحو توحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، التي صارت تهدد الأمن والاستقرار في مختلف مناطق العالم. فهي ظاهرة عالمية تحتم رؤية استراتيجية عالمية. وتأسيساً على ذلك ينبغي أن يكون للقارة الأفريقية إسهامها الواضح في هذا الهم العالمي. وتبعاً لذلك تفترض هذه الدراسة أن الاستراتيجيات الأفريقية لمكافحة الإرهاب (Anti-Terrorism Strategies) هي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات الدولية.
الأديان والقبيلة والسلطة في أفريقيا: سيرة العنف
يستعرض النور محمد حمد -محلِّل سياسي- سيرة العنف وصراع الموارد والنفوذ في الأديان في القبيلة والسلطة في أفريقيا، ويتناول الإثنية بين السياقين الأوروبي والأفريقي، والعنصرية والرق، والطائفة والقبيلة وتركة سياسات الاستعمار، وانتقالها من الصراع الأيديولوجي إلى الصراع الإثني والديني.
عانت القارة الأفريقية من ظاهرة التنوع الكبيرة، التي هي السمة الغالبة على معظم أقطارها. فالقارة الأفريقية تحتضن آلاف الإثنيات، وآلاف اللغات، والكثير جدًا من الأديان، ومن المذاهب، داخل الدين الواحد. وقد كان نصيب أقطارٍ أفريقيةٍ عديدةٍ، من هذا الطيف الواسع من التعدد: مئات القبائل، ومئات اللغات، وعشرات الأديان، والمذاهب. ولقد خلف الاستعمار وراءه قنابلَ موقوتةً، في كل مكان، تمثّلت في التخطيط العشوائي للحدود السياسية للبلدان. وأيضًا في تقسيم المجتمعات، وتأجيج النزعات الانفصالية. وكل ذلك إنما كان لخدمة مصالح الدول الاستعمارية الأوروبية.
لا يبرئ الباحث الاستعمار من تأجيج الصراعات العرقية والقبلية في القارة الأفريقية، فدور الاستعمار في كل ذلك، مُثْبَت. لكن ما تشير دراسته إليه، هو أن الاستعمار استخدم لمصلحته، أوضاعًا وجدها، قائمةً أصلاً، في القارة الأفريقية. فالرق -على سبيل المثال- كان ممارسًا في أفريقيا، قبل مجيء الاستعمار بقرون. والاسترقاق -كما هو معروفٌ- نشاطٌ بشريٌّ قديمٌ، لم يخل منه مجتمع من المجتمعات، في كل حقب التاريخ. أحدثت تجارة الرق، في المجتمعات الأفريقية، شروخًا اجتماعيةً عميقةً. هذه الشروخ هي الوقود الذي يستخدم في تأجيج الانقسامات، الإثنية، والقبلية، الذي تحولت، في مناطق كثيرة من أفريقيا، إلى صراعاتٍ مسلحة.
يشير الباحث إلى أن مشهد الصراع، على أفريقيا الآن، وصل إلى أكثر أطواره تعقيدًا وخطورة. فقد انقضت مرحلة الاستعمار المباشر منذ منتصف القرن العشرين. أما مرحلة الاستعمار غير المباشر، فربما تكون قد بدأت في التراجع، نتيجةً لتكاثر اللاعبين في الملعب الأفريقي. كما انقضت مرحلة الصراع الأيديولوجي لحقبة الحرب الباردة. وهكذا، دخلت أفريقيا في الصراعات الإثنية. وفي هذا المناخ الأفريقي الجديد المتسم بالشد، والجذب، والحروب، تكاثر اللاعبون في الملعب الأفريقي.
«إكس سيليكا» و«أنتي بلاكا» في أفريقيا الوسطى: الأبعاد الدينية للصراع
يدرس إدريس آيات -باحث في الدراسات الاستراتيجية والشؤون الدولية- بدايةً، التكوين العقدي للجماعات الدينية في أفريقيا الوسطى في التاريخ المعاصر، ثم يعرف بميليشيا “إكس سيليكا” الإسلامية، وركيزتها الدينية، وإرهابها على الطائفة المسيحية، ويقدم “مجزة بانغي” كمثال على ذلك، ذاكرًا تداعياتها، ثم يدرس حركة “أنتي بلاكا” المسيحية- الوثنية، وركيزتها الدينية، متناولًا الوساطات الدولية التي لعبت دورًا لحل الصراع، وصولاً إلى دعوة المصالحة من المؤسسات الدينية: الكنائس والمساجد. يرى الباحث أن الحلول وطرق التسوية المبنية على الهوية الدينية تجعل المشكلة قائمة ولن تنتهي هذه الحرب العقدية بين الجماعتين. لذا فإن «منتدى الحوار لأفريقيا الوسطى» الذي أسسه زعماء الأديان لتهدئة الوضع، لن ينهي الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى لسبب بسيط؛ ألا وهو أن المنتدى أيضا يكرس ربط الفئتين بانتمائهما العقدي. كان الأحرى اجتماع الشعب على أساس المواطنة التي فوق كل شيء. لذا يجب النّظر إلى الجميع كمواطنين لا كمسيحي ومسلم أو وثني. هكذا تأقلم «اليهود» في أوروبا بعدما عانوا من المحرقة النازية. لذا طالما يبقى التمييز على البعد الديني قائماً؛ سيبقى التقسيم ويصبح «حذر الغراب» هو السمة التي تميّز الطائفتين مما يكرس «عقلية الغير» أكثر فأكثر.
البعد الديني في الصراع السياسي في موزمبيق
حامد المسلمي -باحث دكتوراه في العلوم السياسية، بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، في جامعة القاهرة- يرى أنه مع 2015 ظهر متغير جديد في الحياة السياسية الموزمبيقية، بتنامي التطرف بين أوساط الإسلاميين، وانتشار الأفكار الإرهابية، تبع ذلك عمليات عدة نُسبت إلى متطرفين إسلامويين، وفي 2018 أعلن تنظيم داعش عن وجوده في الشمال الموزمبيقي. في هذا الإطار تطرح الدراسة الإشكالية التالية: إلى أي مدى أثر البُعد الديني في الصراع السياسي في موزمبيق؟ تسعى هذه الدراسة إلى تناول البعد الديني في الصراع السياسي في موزمبيق من خلال ثلاثة محاور: جذور الصراع السياسي والحرب الأهلية في موزمبيق، والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية وأثرها على تجدد الصراع في موزمبيق، البعد الديني في الصراع السياسي وتطوره.
يرى المسلمي أن الإرث الاستعماري واستخدام الدين لتبرير احتلال البلدان، ونمط التنمية غير المتوازي الذي اتبعته البرتغال، مما انعكس على ممارسات فريليمو عقب الاستقلال، ثم الحرب التي خاضتها فريليمو ضد الأديان تحت دعاوى عدة -ولأسباب فُصلت في البحث- إنما عملت على اتجاه المواطنين إلى التطرف الديني من جانب، والالتجاء إلى المؤسسات والجمعيات الدينية من جانب آخر، مما عمل على تقوية دور المؤسسات والجمعيات الدينية في مقابل سلطة الدولة على المواطنين، وذلك بالإضافة إلى التوظيف الانتقائي لفريليمو والتنمية غير المتوازنة، مما زاد من الاحتقان الشعبي. وذلك بالإضافة إلى المتغيرات الدولية والإقليمية ولعنة الموارد وتنامي ظاهرة الإرهاب عالميًا، كل هذه الأسباب أسهمت في التطرف الديني في موزمبيق.
الحركات الدينية المسلحة في أفريقيا: جيش الرب والشباب المجاهدين
تشير نرمين محمد توفيق -باحثة مصرية متخصصة في شؤون الحركات المتطرفة- إلى أن الحركات الدينية العنيفة تشكل خطراً أمنياً كبيراً في القارة الأفريقية؛ وقد نشطت في السنوات الأخيرة وباتت على رأس أولويات الدول والحكومات والجهات المعنية المهتمة بمكافحة الإرهاب. تسعى دراستها إلى تسليط الضوء على الحركات الدينية الإرهابية في أوغندا والصومال وترتكز على حركتين: “جيش الرب للمقاومة” و”حركة الشباب المجاهدين”، وتأخذ بالاعتبار نشأتهما التاريخية والأيديولوجية المتطرفة المتبناة من قبلهما ونشاطهما الإرهابي وكيفية مواجهة كلا التنظيمين الإرهابيين.
إن حالة الدراسة تعكس خطورة الحركات المسلحة وقدرتها على الاستمرار لفترات طويلة، ومن على شاكلته من الجماعات المشابهة، فعلى نقيض ما يتصور البعض أن حرب هذه الجماعات أمر سهل، فإن بقاء جيش الرب فترة تزيد عن الثلاثين عاماً، يؤكد صعوبة التعامل الأمني مع هذا النوع من الجماعات المسلحة، ساعده على ذلك حالة الغموض المعلوماتي المتعلقة بالتنظيم، فلا هيكل معروفاً له ولا أيديولوجية واضحة، وهناك غموض في مصادر التمويل ومصادر الحصول على الذخيرة؛ ومن هنا تبرز أهمية الاستفادة بشكل كبير من المعلومات التي يتم الحصول عليها من المقاتلين الذين تركوا التنظيم أو من يتم القبض عليه منهم، ويجب التعامل مع هذه الجماعات بدرجة كبيرة من التيقظ والتتبع الدائم لها ولاستراتيجياتها القتالية، حتى تتمكن القوات الرسمية من ملاحقتها والقضاء عليها. اتضح كذلك من الممارسات التي ارتكبها جيش الرب ضد أهل شمال أوغندا، أن أفعاله لا تتفق مع الهدف الذي أعلنه في سعيه لرفع الظلم والتهميش عن سكان شمال أوغندا وإقامة دولة الرب المقدسة، فمعظم جرائمه وهجماته انصبت على مواطني هذه المنطقة التي أرهقتها الحروب والصراعات والفقر، بالإضافة إلى أن معظم عمليات جيش الرب تركزت في مناطق ذات أغلبية مسيحية، سواء في شمال أوغندا وجنوب السودان، مما يؤكد أن حروبه لم تكن من أجل إقامة دولة الرب المسيحية كما ادعى، وإنما للسيطرة على السلطة والثروة، وأن ما رفعه بخصوص تطبيق الوصايا العشر لم يكن سوى شعارات كاذبة للوصول إلى ما يريد، وتبرير ممارساته، وتجنيد مزيد من الأتباع، مثله مثل باقي الحركات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية مقدسة لا لشيء إلا لتحقيق أهدافها.
فيما يتضح من تجربة حركة الشباب في الصومال أنه طالما استمر انهيار مؤسسات الدولة وتفاقمت الصراعات الداخلية، زادت فرص ظهور الجماعات المسلحة التي تؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار، ويمكن القول: إنه على الرغم مما تمر به حركة الشباب المجاهدين من تراجع نفوذها في الأراضي الصومالية فهذا لا يعني نهايتها، بسبب طبيعة المنطقة المتناسبة مع استراتيجية الكر والفر وحرب العصابات التي تتبناها الحركة، بالإضافة إلى استمرار النزاع القبلي في الصومال، والذي استفادت ولا تزال تستفيد منه «الشباب»، فقدرة الحكومة الصومالية الحالية بقيادة الرئيس عبدالله فرماجو على التعامل مع الأزمة الصومالية لا تزال محدودة، وحتى مع افتراض إمكانية القضاء عليها فمن السهولة بمكان أن يُعيد بعض عناصر الحركة تشكيل أنفسهم داخل حركة جديدة باسم جديد، تتبنى النهج نفسه وتستمر في قتال من يعارضها، كما حدث بعد تفكك اتحاد المحاكم الإسلامية وتكوين حركة الشباب ذاتها.
البعد الديني في تكوين التنظيمات الإرهابية بالدول الأفريقية.. مالي أنموذجاً
يدرس مادي إبراهيم كانتي -باحث لدرجة الدكتوراه في العلوم السياسية، (جامعة القاهرة)- البعد الديني في تكوين التنظيمات الإرهابية بالدول الأفريقية، ويقدم مالي كنموذج. متناولًا الإرهاب والدين في أفريقيا، والإسلام والأوضاع الاجتماعية والثقافية في مالي، والجماعات الإسلامية السلمية، والتنظيمات الإسلامية الجهادية في مالي. مشيرًا إلى أن مالي كانت من ضمن الدول التي عانت من ظاهرة الإرهاب، المستورد من خارج البلاد في بداية الألفية الجديدة، ولكن منذ سنوات، أصبحت صناعة من إنتاج الشعب المالي. يشير كانتي إلى أهم الجماعات الإرهابية النشيطة في مالي ويذكر منها: «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» (AQMI) وهي تعد امتدادًا للجماعة السلفية للدعوة والقتال (GSPC) الجزائرية، و«حركة أنصار الدين» التي تأسست من قبل إياد غالي (مالي الجنسية) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 في شمال مالي، وقد بدا واضحًا أنه استثمر مكانته الاجتماعية وتوجهه السلفي الفكري لقطف ثمار عشر سنوات من عمل عناصر «تنظيم القاعدة» في المنطقة، فجاءت الاستجابة لدعوة إياد غالي مزدوجة اليوم، حيث تلبي البعد الديني والقومي لدى الطوارق والانفصاليين، وتتناغم مع الدعوة الجهادية المنتشرة هناك. وتعد «حركة الجهاد والتوحيد في غرب أفريقيا» نسخة عربية من حركة «أنصار الدين» الطوارقية، على الرغم من أن تأسيسهما حصل بالتزامن، فحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ظهرت إثر انشقاق قادتها عن تنظيم القاعدة. فكتيبة ماسينا هي جماعة تم إنشاؤها من السكان المحليين في مالي، وتُقاد هذه الجبهة من طرف قبائل الفلان (الفولاني) التي تشكل أغلبية مقاتليها. في بداية مارس (آذار) 2017 أعلنت الجماعات الإرهابية في مالي، اندماجها في تنظيم واحد تحت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين».
تعتبر ظاهرة الإرهاب المتزايدة في مالي من أخطر أشكال التهديد الأمني التي تواجه الدولة، لأنها تستهدف في جانب مهم منها أمن واستقرار ومستقبل مجتمع غرب أفريقيا، ويجمع الفعل الإرهابي بين مطامع وأهداف القوى الخارجية التي لا تريد استخدام أدواتها المباشرة، وإنما تعتمد على محركات في خلق الأزمات داخل الدول المستهدفة أو استغلال حدودها أو الظروف السياسية المحيطة، أو في أحيان أخرى تفرق في لحمة ونسيج المجتمع داخل تلك الدولة، وقد يشجع فئة من فئاته على سلوك يلحق الضرر بالمجتمع، مما يهدد سلامته بما في ذلك استخدام العنف، وصولاً لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية قد تنعكس في جانب منها خدمة لأطراف خارجية إقليمية أو دولية.
«العنف الديني» في نيجيريا: جماعة «بوكو حرام»
يقول حكيم نجم الدين -كاتب وباحث نيجيري-: إن النقاشات سيطرت حول ما يسمى “الإرهاب الديني” على الساحات العالمية، ونال الموضوع حظه في لقاءات المنظمات الدولية ومؤتمرات المراكز البحثية الأمنية، نتيجةً للحوادث الإرهابية منذ عام 1980، والتي لم يشهد العالم مثلها من قبل. وعلى الرغم مما يُثار حول هذه القضية العالمية من إشكاليات أو محاولات لجعلها ميزة دين معيّن أو منطقة دون غيرها، فإن الواقع يؤكد أن الإرهاب يتخذ أشكالاً مختلفة، وأن “العنف الديني” في معناه الواسع ينطوي على ما هو أكثر من الإرهاب. فيتناول الباحث الجذور التاريخية للعنف الديني في نيجيريا، مشيرا إلى أزمة “ميتاتسين” في ثمانينيات القرن المنصرم، وكيفية انتقال بوكو حرام من الوعظ والإرشاد إلى التطرف المسلح، مستعرضا أيديولوجيتها، وأهدافها، وتجنيدها للأطفال، وعلاقتها بداعش، كما يستعرض الباحث إخفاقات ونجاحات في مكافحة السلطات لـ”بوكو حرام”.
فيشير الباحث، في حالة نيجيريا، إلى أن «العنف الديني» يتمثّل في الصدامات بين ذوي المعتقدات المختلفة، وخصوصاً بين مسلمين ومسيحيين، والذي يمكن تعقبه إلى أزمة بلدة «تافاوا باليوا» في ولاية بوتشي (شمال نيجيريا) عام 1948 ، ثم أحداث الشغب التي اندلعت في مدينة كانو (شمال نيجيريا) عام 1953 بين الشماليين معارضي الاستقلال الفوري لنيجيريا من بريطانيا في ذلك الوقت، والجنوبيين داعمي الاستقلال الفوري. وقد ساهم أيضاً اختيار الكاميرونيين الشماليين الانضمام إلى نيجيريا في استفتاء عام 1961 في تأجيج الصراع الديني في البلاد. واليوم يُعتبر تمرد «بوكو حرام» العنوان الرئيس لـ«العنف الديني» في البلاد. وإذ تُحدد الجماعة المعروفة اليوم باسم «بوكو حرام» هويتها على أنها «حركة إسلامية» تمثّل «الفهم والمنهج الصحيحين» للشريعة الإسلامية، وتصف أنشطتها اللاإنسانية بـ«ثورة دينية»، فإن هذه الجماعة –المصنفة دولياً ضمن الجماعات الإرهابية- مثال هامّ لكيفية تبرير العنف من قبل المتشددين والمتطرفين من خلال استغلال الأيديولوجيات الدينية، وكيف تتطور تقاليد العنف القديم في سياق الحداثة والتكنولوجيا الجديدة في القرن الحالي. بل التاريخ وحصاد هجمات الجماعة يجعلانها مناسبة لدراسة الطبيعة المتغيرة للمنظمات الإرهابية، لا سيما في غرب أفريقيا، ونموذجا حيًّا لنوع جديد من الظاهرة الإرهابية المعاصرة.
يخلص الباحث في دراسته إلى أن النزاعات العرقية والدينية في نيجيريا تدور حول سعي مجموعات عرقية أو منطقة ذات أغلبية دينية معينة إلى الاستقلال أو التمكين وبناء الهوية، والتخوف من القوة الاقتصادية والسلطة السياسية والهيمنة الثقافية لمنطقة أخرى، وأن الاشتباكات الدينية في نيجيريا اليوم نتيجة لعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية.
تتباين وجهات نظر الكُتاب النيجيريين في قول «جون بادين» بأن ما تشهده نيجيريا هو «حالة اختبار للحضارات»، إلا أن الأكاديميين النيجيريين متفقون على أنه لا يمكن حلّ الأزمة بما قاله الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والذي اقترح تقسيم نيجيريا قسمين: الجنوب للمسيحيين والشمال للمسلمين. وقد أكدت دراسة «بييرى وباركندو» أنه توجد أقليات مسيحية كبيرة في بعض الولايات الشمالية النيجيرية وأقليات مسلمة كبيرة في منطقة الجنوب، بينما ينتشر المسلمون والمسيحيون في الأجزاء الوسطى من البلاد (الحزام الأوسط) بنسب متساوية، مما يعني أن تقسيم نيجيريا على أساس الخطوط الطائفية لن يجدي نفعا. عليه يجب حجب الشبكة الحدودية القابلة للاختراق، والتي تمكّن «بوكو حرام» من الحصول على الأسلحة والدعم المادي والبشري من الحركات الإرهابية الأخرى في غرب أفريقيا وشرقها، والقيام بتحييد الأيديولوجية الدينية عن الشباب النيجيري بالتعاون مع الأئمة وزعماء الدين المحليين، لأن الأيديولوجية تلعب دوراً هاماً في عملية التجنيد، وهي القوة الأساسية التي تعتمد عليها «بوكو حرام»؛ فالمعارك الفكرية أكثر أهمية من المعارك المادية في مكافحة الحركات الإرهابية، إذا ما اقترنت بمعالجة الشكاوى المحلية -كالحد من الفقر والبطالة والمساواة في الحياة السياسية والاقتصادية في نيجيريا.
التنوع المجتمعي العربي الحالة المغربية نموذجاً
يقول إدريس لكريني -مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي عياض بالمغرب-: إن التنوع المجتمعي يعد أحد المزايا التي تطبع المجتمعات الإنسانية والدول الحديثة؛ فجميع الدول تحتضن بين جنباتها العديد من الأعراق والإثنيات والثقافات واللغات. وإذا كانت بعض الدول قد استطاعت توظيف هذا التنوع على وجه بنّاءٍ وسليم في دعم الوحدة وتحقيق التنمية، فإن دولاً أخرى شكل هذا التنوع بالنسبة لها عامل فرقة وتهديد لأسسها ومقوماتها. ويضيف أن مفهوم الأمن انتقل من طابع ضيق ارتبط عادة بتلك الحالة التي تغيب فيها التهديدات العسكرية بالأساس؛ إلى مفهوم واسع ودينامي منفتح على عدد من العناصر الجديدة في أبعادها البيئية والقانونية والتكنولوجية والاجتماعية والروحية، حيث ظهرت مصطلحات جديدة في الأوساط الأكاديمية والسياسية، من قبيل الأمن القانوني، والأمن المعلوماتي، والأمن الغذائي، والأمن الروحي.
على الرغم من الغنى الذي يطبع مكوناتها الاجتماعية؛ تعيش الكثير من دول المنطقة العربية على إيقاع الصراعات الداخلية التي لم تخل من عنف؛ بسبب الفشل في تدبير الاختلاف داخل مجتمعاتها. وفي مقابل ذلك؛ نجحت عديد الدول العربية في توظيف تنوعها المجتمعي لتعزيز الاستقرار، ودعم الوحدة.
ويستعرض الباحث الحالة المغربية في هذا السياق. مشيرا إلى أن المغرب يتميّز بثرائه الثقافي وتنوعه المجتمعي؛ كما ظلّ على امتداد التاريخ ملتقى للحضارات والثقافات المختلفة التي أسهمت في إغناء هذه الثقافة؛ وقد راكم في السنوات الأخيرة مجموعة من الجهود والتدابير الرامية إلى تمتين هذه الوحدة، وتوظيف هذا التنوع على وجه حسن.
يتناول الباحث التنوع المجتمعي والممارسة الديمقراطية عربيًا، والمغرب وتدبير التنوع في إطار الوحدة، والمذهب المالكي والأمن الروحي بالمغرب.