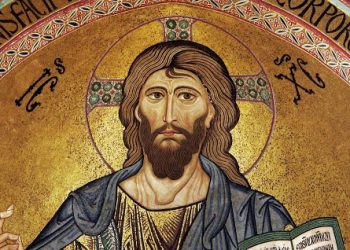سنة 2004، وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالجمهورية التونسية على مطلب تأهيل لماجستير دراسات مقارنة للأديان كان قد تقدم به ودافع عنه بإصرار الأستاذ محمد الحدّاد. وكنا نشعر أن هذا القرار يمثّل حدثا ليس فقط في مستوى الجامعة التونسية، ولكن أيضا لكل البحث الأكاديمي العربي المهتم بالدراسات المقارنة للأديان. وقد مثّل هذا الحدث أيضا تواصلا مع جهود بذلتها الأجيال السابقة والعديد من الروّاد، إذ شهدت الجامعة التونسية قيام دروس في الحضارات المقارنة منذ السبعينات. أمّا بلوغ فكرة الدراسة المقارنة للأديان على أساس حيادي وموضوعي فقد تطلب تجسيمها وقتا طويلا. فما المقصود من هذه الدراسة؟
يعني إقرار ماجستير في هذه المادة أنّه يمكن للطلبة أن يتخصّصوا في موضوع محدّد هو الشأن الديني، وأن يعتمدوا مقاربة معينة هي القائمة على المقارنة. ونحن نتحدث عن «الشأن الديني» وليس الدين، باقتباس الكلمة التي استوحاها ريجيس دوبريه من علم الاجتماع، للإشارة إلى أن هذا التدريس ليس دينيّا، بل هو تدريس يقصد عرض الأديان بموضوعيّة من خلال تنوعها وتعدّدها، ويعتبر الشأن الديني مرتبطا بسياقه التاريخي والاجتماعي ككل الظواهر الأنثروبولوجية القابلة للتحليل والتعقّل بواسطة الدرس العقلي والروح النقدية. وسأنطلق من تعريف قدّمه ريجيس دوبريه صاحب «تقرير حول تدريس الشأن الديني في المدرسة اللائيكية»، فهو يقول: «لا يمكن أن ننفي أنّ عبارة الشأن الديني عبارة دبلوماسية. فهي عبارة مقبولة في الاستعمال بسبب ملاءمتها وحيادها. فهي لا تميّز معتقدا ما، كل معتقد يجد فيها بعض غرضه. فاللائيكي الذي يخشى من العودة المتسللة للروحانية سيتقبّل كلمة ديني لأنّها مسبوقة بكلمة «شأن» التي تدفع إلى الرضا. والمؤمن المتحفّظ على تقليص الإيمان الحيّ إلى معطى وضعي سيتقبّل كلمة شأن لأنّها متبوعة بكلمة ديني. ليس المهمّ الوعاء مادام السرّ موجودا! فاستقبال الكلمتين معا يحيّدهما معا: الوضي بالروحاني والعكس بالعكس. فكلّ من المعتقد أو النافي يجد في هذه العبارة غرضه ما لم يتعمّق في النظر اليها».
نرى من خلال هذه الفقرة التي كتبها ريجيس دوبريه كيف يمكن تحديد فلسفة تدريس الشأن الديني والصعوبات الأساسية في هذا التدريس، فهو ليس تدريسا طائفيا غايته تخريج المؤمنين الصالحين ولا هو تدريس ضد الدين هدفه تخريج ملحدين. إنّه تدريس يهدف إلى تكوين عقول نابهة تتمتّع بثقافة دينية تعدديّة ويمكن لها أن تنفتح على الثقافة الكونية في مستوياتها الفنية والفلسفية والأدبية وتكون قادرة على فهم وتحليل الظواهر الدينية بموضوعية مهما كان أصلها. ونرى من هنا عظمة هذا التحدّي المطروح أمامنا. وقد يبدو الأمر هينا، لكن كيف العمل ومن أين البداية؟
عقد اجتماع أوّل للإعلام بانطلاق الماجستير حضره عدد غفير من أساتذة الجامعات، وباعتبار المشروع جديدا وغير مسبوق فقد كان النقاش طويلا وصريحا وحادّا أحيانا. وتمّ تحديد لجنة التدريس بعد هذا الاجتماع ثمّ تحديد نظامه الداخلي، وهو يعمل اليوم مثل بقية الماجستيرات التي توفرها الجامعات التونسية وأصبحت له تقاليده الخاصة، ومع ذلك فإنّ العديد من الأسئلة تظلّ تطرح على هيئة التدريس وهي أسئلة مهمة تدفعنا للتفكير وإلى التأمل في الدور المنوط بنا وإلى تدقيق مناهج عملنا.
ويمكن تقسيم هذه الأسئلة أساسا في ثلاث نقاط كبرى. الأولى تتعلّق بموضوع الماجستير أي الشأن الديني، لماذا يطرح هذا الموضوع في كلية آداب وعلوم إنسانية؟ ألا يتداخل هذا التدريس بما يقدّم في المؤسّسات الدينية؟ أليس علماء الدين هم الأولى وحدهم بالحديث عن الشؤون الدين؟ وتتعلّق النقطة الثانية بالمساهمين في هذا التدريس أي الأساتذة أنفسهم، من يمكن له الاضطلاع بهذا التدريس؟ أليس الأولى أن يكون المدرسين من متخرجي المؤسسات الدينية كي يكونوا قادرين على الحديث حول الدين «من الداخل» وبمقتضى تقاليد مستمرة منذ قرون؟ ألا يخشى أن يتجاهل المؤرّخون والمختصون في الآداب بعدا أساسيا في الشأن الديني وهو الإيمان، يدفعهم إلى ذلك إمّا الخيار الأيديولوجي أو التجاهل، لأنهم تعوّدوا على استعمال وسائل تحليل عقلانية ونقدية؟
أمّا النقطة الأخيرة فموضوعها تعليمية الظواهر الدينية، فكيف يمكن دراسة النصوص المؤسسة للأديان بالتغاضي عن قدسيتها؟ كيف يمكن دراستها من جهة أدبية وتاريخية لا غير؟ وإذا كان المقصود دراسة أديان عديدة أفلا نهمش الأديان بأن نضعها جميعا في مرتبة واحدة؟ هذه أهمّ محاور التساؤلات المطروحة والجديرة بالبحث، مع التذكير دائما بالأسس النظرية والمفهومية التي تميّز هذا الاختصاص الجديد نسبيا في الجامعة التونسية.
يبدو التساؤل الأوّل أساسيا، وهو يدور حول موضوع الدراسة، أي الشأن الديني، وحضوره في كلية آداب وعلوم إنسانية. وهو مهمّ في تحديد طبيعة الماجستير نفسه. وهناك جهتان تعبّران عن هذا التساؤل مع أنهما متعارضتان في الدوافع والرؤى. الجهة الأولى هي التي يمكن أن نطلق عليها «لائيكي» مع أنّ هذه الكلمة تعيّن واقعا غامضا وفضفاضا حتى في أذهان الذين ينسبون أنفسهم إلى اللائيكية. ويعتبر هؤلاء أن هذا النوع من الدراسة ينبغي أن يقدّم في المؤسّسات الدينية ولا مكان له في كليات الآداب لأن تدريس الدين هو قضية رجال الدين. وتعكس وجهة النظر هذه موقفا يقوم على تجاهل الدراسات المقارنة للأديان وما تنتجه من بحوث. والحقيقة أن هذا الموقف يسهّل انتشار الجهل بالظاهرة الدينية وليس من الجدير بموقف يقول إنه لائيكي أن يعامل بالتجاهل ظواهر يؤكد كل يوم أهميتها في حياة الأفراد، سواء كانوا مؤمنين أم لا.
ونجد من جهة أخرى الموقف نفسه يدافع عنه المختصون في الشريعة الذين تدفعهم –طبعا- دوافع أخرى، فهم يستغربون أن يحصل هذا التدريس خارج مؤسسات التعليم الديني. لكن الحقيقة أن هذا الماجستير لا يكون له معنى إلا إذا قدّم في كليات الآداب والعلوم الإنسانية. فهو يقدّم القدر الضروري من المعارف حول تعقّل العالم الذي نعيشه اليوم وهو ينتمي إلى مجال مختلف عن مجال اللاهوت. فهو لا يطرح على نفسه أن يقدّم تكوينا دينيا أو أخلاقيّا للطلبة والباحثين. وإنّما يهدف لتنمية الروح التحليلية والنقديّة باعتبارها الوسيلة المثلى لطلب الحقيقة والحصول على المعارف الموضوعية والدقيقة والقابلة للإثبات. لذلك فإن ماجستير الدراسات المقارنة للأديان ينأى بنفسه عن لائيكية متطرفة تعادي التعليم الديني وتعليما دينيا يهدف إلى التربية الأخلاقية بواسطة الدين.
لا تقل النقطة الثانية المطروحة أهمية عن الأولى وهي المتعلقة بالمدرسين. ومضمونها أن الأديان تدرّس أفضل من «الداخل» بدل «الخارج» وهذا الرأي نسمعه من المسلمين والمسيحيين. وقد سئلت أكثر من مرة وأنا أدرس المجادلات المسيحية التي مزقت فرنسا في القرن السادس عشر: ألا يكون الدرس أكثر وضوحا لو تولّى أستاذ مسيحي مهمّة القيام به؟ وطرح أيضا السؤال عن تعليم العبرية وهل يكون من الأولى أن يتولّى أستاذ يهودي هذا الدرس؟ والحقيقة أن هذه الأسئلة تخفي موقفا معينا يحيل على عقيدة المدرس وارتباطها بموضوع درسه، وإذا قبلنا بهذا المنطق فإنّنا سنشترط أن لا يدرّس غير المسلمين الموضوعات المتصلة بالإسلام، ولا غير المسيحيين يدرّس تلك المتصلة بالمسيحية، ولا غير اليهود يدرّس تلك المتصلة باليهودية… إلخ. ويرى البعض أن التدريس «من الخارج» لا بدّ أن يكون باردا وباهتا ومبالغا في الحيادية ومشبوها. لكن هذا الادعاء يخالف مجمل القواعد البيداغوجية المعتمدة في التعليم، بل إنّ التعليم الحقيقي هو الذي يقوم على التمييز بين المدرس وموضوع درسه، فهل نفرض أن يكون أستاذ الإنجليزية بريطانيا، وأستاذ الفرنسية فرنسيّا، وأستاذ الصينية صينيّا؟ إنّ المدرّسين في ماجستير الدراسات المقارنة هم أساتذة مشهود لهم بالكفاءة والقدرة الأكاديمية ولهم مواقفهم الشخصية المرتبطة بضمائرهم، لكن مهمتهم لا تتمثل في الحديث عن هذا الجانب الشخصي، مع أنه يمكن التفكير في الاستماع إلى رجال دين بصفة الشهادة والروحية ما تلاءم ذلك مع النظام الداخلي للمؤسسة الجامعية. وقد أجاب الأستاذ الحدّاد مرّة على هذا الاعتراض بالقول: «هل يطلب من أستاذ يدرّس الحرب العالميّة الأولى أن يكون من الجيل الذي عايشها؟»
النقطة الثالثة التي تطرح علينا هي التعليمية. كيف يمكن أن ندرّس «الشـأن الديني»؟ عندما تطرح النصوص المؤسسة للأديان الثلاثة الكبرى فإن معطى القداسة فيها يحضر في الأذهان سواء لدى المدرس أو الطالب، وليس المطلوب نفي هذا المعطي لكننا لا نعتبر ذلك متناقضا مع محاولة التحليل. فهذه النصوص لا تدرّس من وجهة نظر إيمانية باعتبارها وحيا ولا تشرح حرفيا، بل هي مطروحة من وجهة نظر أنثروبولوجية وباعتبارها نصوصا قد نشأت في سياق معيّن تأثّرت به وأثّرت فيه. فهي قابلة أن تدرس بالأدوات التي تتيحها لنا العلوم الإنسانية والاجتماعية، فهي نصوص تحمل الرموز والمعاني وتقبل التحليل اللّساني والأنثروبولوجي والثقافي. والمهم في دراسة الظواهر الدينية أن تدرّس الظاهرة، أي النص والسياق، فهذا ما يضمن في رأيي الطابع الموضوعي والعلمي لهذا التدريس.
الآن وقد حدّدنا الإطار النظري لموضوعنا، فكيف تنظم الدراسة بالنسبة إلى طالب هذا الماجستير؟ يتضمن ماجستير الدراسات المقارنة للأديان والحضارات مرحلتين، الأولى مرحلة التكوين النظري وتضمّ دروسا عامة إجبارية ومجموعة من الندوات يختار الطالب أربعا منها ودرسين تكميليين في اللّغة المتخصّصة وهي تضمّ الفرنسية والعبريّة. وتتضمّن المرحلة الثانية تدريبا بيداغوجيا يفرض فيه على الطالب أن يحضر ندوات تدريب على تقنيات البحث والتعليم، ويتولى الطالب بعد هذه الندوات تحديد موضوع بحث وإعداد مشروع لذلك.
وأخيرا فإن الطالب يمنح مهلة سنة لإعداد مذكرة في موضوع البحث الذي اقترحه تحت إشراف أستاذ مؤطّر وتقوم لجنة الماجستير بإجازة الموضوعات قبل ذلك ثم السماح بمناقشتها بعد إعدادها، ويمكن للطالب أن يطلب من اللجنة مهلة إضافية لإعداد مذكرة البحث تمنح له بصفة استثنائية.
ومن الموضوعات التي طرحت في الدروس العامة والندوات يمكن أن نذكر ما يلي:
مفاهيم ومناهج الدراسات المقارنة للأديان.
الإصلاحات الدينية المقارنة.
الدين والعنف.
الأديان والطعام والشراب.
التشريع في الأديان التوحيدية.
حوار الأديان.
فلسفة الأديان.
الوحي في الأديان التوحيدية.
الأسواق الدينية.
الأصوليات.
مشكلات الفترات المبكرة في تاريخ الأديان… إلخ.
وقد ناقش العديد من الطلبة إلى حد الآن مذكرات بحث متميزة تسمح لهم بمواصلة الدراسة والبحث، وهي تتصل بمجالات مختلفة مثل الحوار الإسلامي – المسيحي، واليهودية، والإسلاميات… إلخ.
لقد بدأنا بالإشارة إلى أن نشأة هذا الماجستير قد أطلقت الكثير من الآمال، ونودّ الآن أن نوضّح الآمال والطموحات التي كان يحملها الأشخاص الذين شاركوا في هذا المشروع. فقد اعتقدنا أنّ إنشاء تدريس علمي وأنثروبولوجي للظواهر الدينية يمثل معطى إيجابيا في تجديد المنظومة الجامعية التونسية التي نرجو أن تضطلع بدورها في متابعة أحداث عالمية غير مستقرّة ومتغيرة باستمرار. فالرغبة تحدونا جميعا في أن يواصل بلدنا الريادة في مجال تطوير الأفكار والعقليات مع المحافظة على تقاليده في هذا المجال. فنحن نعيش في عالم تملؤه الأحقاد وتنتشر فيه دعوات الصدام والانكفاء على الذات وغلبة الهويات القاتلة، وقد أصبح صدام الحضارات لدى العديد من الناس واقعا يوميا وليس مجرد افتراض ثقافي. إن وجود تدريس منفتح وعقلاني للظواهر الدينية يمكن أن يسهم في تفادي هذه المخاطر، فهو سيفتح الأذهان ويقرب بين الحضارات فيتمكن الفرد من الالتقاء بالآخر المختلف عنه ثقافيا ودينيا وأخلاقيا. ومن قبل الالتقاء بالآخر فقد قبل أيضا مراجعة نفسه وتطويرها وإثراءها بما يستفيده من الآخر. وهذا هو سبيل الفرد لتفهم تعقد الظواهر والتعود بتنسيب الأمور والحصول على القوة النفسية الضرورية للسيطرة على المشاعر والنزوات.
إن العقل الذي يبحث ويحاول الفهم هو العقل المستقل والحرّ الذي لا يخضع للإملاءات ولا ينجرّ إلى الاستمالة المذهبيّة، وهو المواطن الذي لا يمكن مغالطته والتلاعب بعقله ولا تؤثر فيه الدعوات الخارجية. فتدريس الشأن الديني يساعد على استقلالية الفرد وحمايته من الانحرافات الطائفية ويجعله متصفا بالتسامح والانفتاح، ويبعده عن الحلول التبسيطية والمتطرفة والكاريكاتورية. إن التاريخ يعلمنا أن عقل الأنوار هو القادر على التصدي للظلامية. والعقل المستنير هو المواطن ذو التكوين الجيّد القادر على أن يعيش في عالم التعدّدية وفي مجتمع التعدّدية، وأن يتعايش مع معتقدات الآخرين وفلسفاتهم بما في ذلك وجود الملحدين والعاطلين عن الديانات في المجتمعات الحديثة. فالرهان الأكبر هو تكوين مواطن واع بتعقيدات العالم الحديث الذي لا مناص فيه للأديان من أن تتعايش مع بعضها البعض في كنف السلام ومن دون نزوع إلى العنف. فهل نحن طوباويّون وحالمون إذا وضعنا أمام أنفسنا هذه الأهداف النبيلة؟ ربّما، لكن الأحلام هي التي تتقدّم بالإنسانية، ومهمّة الجامعة أن تحوّل الحلم إلى حقيقة.
الأستاذ عبدالرزاق العيادي هو من أعضاء هيئة تدريس ماجستير الدراسات المقارنة للأديان والحضارات الذي أُحدث في كلية الآداب بجامعة منوبة. تونس سنة 2004.
النص معرب من الفرنسية.