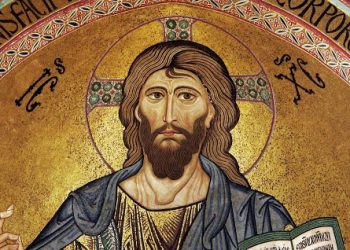يعلم الجميع أنّ النموذج الجمهوري الفرنسي يشهد منذ عشرين سنة قدرا من الاضطرابات تتعلّق بطريقته في تأسيس العلاقة بين الدولة والدين. وقد أصبح مبدأ اللائيكية موضع تساؤل ومراجعة، إن لم يكن موضع نقد، مع أنّ غاية هذا المبدأ أن يضع الأديان خارج الفضاء العام، ويمنع أصحاب الشأن العام من التدخّل في الفضاء الديني، وغالبا ما يذكر هذا المبدأ على رأس الخصوصيات الفرنسية باعتباره قد رسم طريق التقدّم نحو إعلاء شأن العقل الكوني. لكن يبدو أنّ هذه الخصوصية القومية في صدد التحوّل إلى عائق إذا ما قارنّا بالجيران الأوروبيين وبالبلدان الغربية عموما، وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار التحوّلات الأساسيّة والمشتركة بين مجتمعاتنا، أي ما يدعى عادة بـ«عودة الديني». فالدين يفرض نفسه في قلب الحداثة عبر مسار مزدوج يشهد في الآن ذاته فردنة الإيمان وإنعاش صناعة الذاكرات الجماعيّة في خطابات دينيّة. وتلتقي هذه الظاهرة بأخرى وهي كثافة الهجرات والتنقلات، لذلك تطرح المسألة الدينية بحدّة وفي صياغات جديدة، خاصّة، وقد أصبح الدين (والإسلام خصوصا) مرتكزا لتشكلات الهويّة لدى المجموعات المهاجرة.
تبدو اللائيكيّة على الطريقة الفرنسيّة عائقا أمام السياسات المدعوّة بالإدماجية في نظر البعض؛ لأنّها تسفر عن نتائج ذات منحى تمييزي مع أن مقصدها الأصلي كان إحلال المساواة. ويمكن طبعا أن نسلي أنفسنا بأن جيراننا يواجهون بدورهم المصاعب نفسها، فلا يكفي أن يتغيّر اقتصاد العلاقات بين الدولة والأديان. وهناك طريقة أخرى للتخفيف من استثناء المصاعب الفرنسيّة، تتمثّل في إضفاء طابع النسبيّة على النموذج الفرنسي بتعميم مبدأ اللائيكية على أوروبا كلّها. فكلّ البلدان الأوروبيّة ستعتبر حينئذ لائيكيّة، لكن بعضها يمارس لائيكيّة «تضمين» inclusive والبعض الآخر يمارس لائيكية «إبعاد» (خاصّة في فرنسا)([1]). وهذا ما يفتح في رأي المدافعين عن هذا الطرح المجال لسياسات أوروبيّة مشتركة في ميدان التعليم المرتبط بالقضايا الدينيّة، على الرغم من طابع «المداركة» subsidiarité لهذه الأخيرة في ظلّ الوحدة الأوروبيّة. يبقى أنّ السياق الوطني الفرنسي يحتوي على خصوصيّات حادّة تبرز بمناسبة إدخال دراسة الإسلام في برامج التعليم الثانوي، وهذا ما سنحاول إيضاحه في هذه الورقة.
إنّ الصعوبات المعنية يمكن أن تعتبر الثمن الذي يدفعه التاريخ الوطني وقطائعه. فمنذ الثورة الفرنسيّة إلى القرن التاسع عشر، لم يحصل التوافق بين الدين والدولة في فرنسا. وقبل ذلك كانت الأنوار قد غامرت برفع الدين عن الفضاء السياسي. ولم يكفّ النظام الجمهوري، على الأقلّ منذ أن أصبحت الجمهوريّة الثالثة جمهورية فعليّة، عن مطاردة الدين من الفضاء العام، في ظلّ مسار صدامي وجد نهايته، في ما يتعلّق بالكاثوليكيّة، في قانون 1905 المدعو بـ«قانون الفصل بين الدولة والكنيسة».
إنّ حقل التعليم العام سيبدو بسرعة في صورة الحقل الاستراتيجي في هذا المجال. ومن الأمور المعبّرة أنّ سيرورة الفصل بين الدين والدولة قد بدأت مبكّرا في الحقل التعليمي تحديدا، وذلك بواسطة قانون 28/03/1882 (السابق طبعا لقانون 1905) وهو يتعلّق بالتعليم الابتدائي الإجباري. فالتعليم العمومي (أو ما كان يدعى بالمعارف العمومية) كان أوّل ميادين المعركة. كان مطلوبا تحرير المدرسة من الكنيسة الكاثوليكيّة، وتحرير العقول من سلطتها بالتبعيّة، إذ كانت الكنيسة الكاثوليكيّة شديدة الحضور في المعاهد بفضل قانون فالوس سنة 1850 الذي كان يمنح «للهيئات الدينيّة حقّ المراقبة والتفتيش والتوجيه في المدارس الابتدائيّة الحكوميّة والخاصّة». لقد ألغى قانون 1882 هذه الوصاية الدينيّة على المدارس، وخصّص يوم عطلة يضاف إلى الأحد «ليتمكن من يرغب من الأولياء في إعطاء أبنائهم التعليم الديني خارج المباني المدرسية» (البند الثاني من القانون). وعلى مستوى مضامين الدراسة، استبدلت حصص «التربية الأخلاقيّة والدينيّة» بحصص للتربية الأخلاقيّة والمدنية، لكن البرامج الرسميّة احتفظت في التعليم بفصول عن «الواجبات تجاه الرب» إلى سنة 1923([2]). وقد ظهرت هذه النزعة لإبعاد الدين في التعليم الثانوي أيضا، سواء في توجهات البرامج الرسميّة أو تصرّفات المدرسين الذين كانوا مطبوعين بالعلمويّة السائدة في عهد الجمهوريّة الثالثة.
إدخال تعليم الشأن الديني في البرامج: تصوّر جديد للائيكية
قام هذا الوضع الذي وصفناه على تصوّر صلب للفصل بين التعليم والدين، وقد تواصل إلى ثمانينيات القرن العشرين. وبدأت أولى الخروقات مع التقرير الذي أعدّه فيليب جوتار حول تعليم التاريخ وسلّمه في 09/1989 إلى وزير التربية القوميّة. وفي الفترة نفسها كان مجلس الدولة يدرس قضية ارتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات المدرسية. لقد اعتبر فيليب جوتار أنّ «الجهل بالديني قد يمنع الأذهان المعاصرة من فهم الأعمال الأساسيّة لتراثنا الفني والأدبي والفلسفي» واقترح إدخال تاريخ الأديان في البرامج المدرسيّة لمعالجة ضعف المعرفة بالقضايا الدينيّة لدى التلاميذ.
ونظّم مركز البحث والتطوير البيداغوجي في مدينة بوزنسان سنة 1991 ندوة وطنيّة للإسهام في تعميق التفكير حول وسائل التعليم مع احترام مبدأ اللائيكيّة. وبالتوازي مع ذلك طوّر جون بوبيرو أطروحات في الاتّجاه نفسه في كتاب صدر سنة 1990 ولقي صدى واسعا([3]). لكنّ هذا التوجّه لم يطبق عمليّا إلاّ سنة 1996 بمناسبة إصلاح البرامج المدرسيّة في التاريخ والجغرافيا والتربية المدنيّة. فقد دعمت الإصلاحات تعليم تاريخ الأديان (أو تعليم الأديان في حصص التاريخ) في أقسام السنة السادسة والخامسة والثانية، وأعيدت صياغة المقرّرات المدرسيّة لتلبية هذه التوجهات ابتداء من سنة 2000.
أمّا الحادثة الثانية الأساسيّة في استعادة الديني في التعليم العام الفرنسي، فهي نشر تقرير ريجيس دوبريه حول تعليم الشأن الديني في المدرسة اللائيكية في 2/ 2002. جاء هذا التقرير قصيرا وكتب في أسلوب إنشائي نادرا ما يستعمل في مثل هذه المناسبات، وقد أعاد بقوّة المطالبة بضرورة تغيير التصوّرات الفرنسية حول اللائيكيّة (الانتقال من لائيكية غير مؤهلة إلى لائيكية فطنة)، وبحث في العلاقة الموضوعيّة بين التعليم والدين عبر تطوير مفهوم «الشأن الديني»، واستبعد فكرة تخصيص مادّة لهذا التعليم مقترحا توزيع محاوره داخل الاختصاصات المتوافرة، وقدّم مجموعة من التوصيات المتعلّقة خاصّة بالبيداغوجيا وبتكوين المدرسين([4]).
يبقى أنّ هذه الحركة المزدوجة لإدماج الأديان وإبعادها في الوقت نفسه تتميّز ببعض الغموض. فهناك فارق بين توجّه موضوعي يميّز بوضوح بين الدين «موضوعا ثقافيا» والدين «موضوعا عباديّا» (تقرير دوبريه)، وتوجّه ذاتي لاستلهام القيم يمثل أيضا جزءًا من المنظومة التعليمية، والعلاقة بين التوجهين ليست يسيرة التحديد. وقد نصّ مرسوم 4/7/2006 على وجود «قاعدة مشتركة للمعارف والمهارات لدى التلاميذ، تطبيقا للبند التاسع من قانون التوجيه والبرامج لمستقبل المدرسة الصادر في 23/04/2005، ويشهد هذا المرسوم على الطابع المزدوج للأهداف التعليمية، من حيث إنها تجمع بين نقل المعارف وبناء الهويّة على أساس أخلاقي مشترك. ويرد في الفصل الثاني من المرسوم أنّ «الأمّة تحدّد الدور الأوّل للمدرسة في جعل التلاميذ يشتركون في قيم الجمهوريّة». فالمطلوب حينئذ هو «إضفاء المعنى في الثقافة المدرسيّة الأساسيّة». وقد وقع تحديد سبع مهارات منها مهارتان تتّصلان بموضوعنا وهما: الثقافة الإنسوية والمهارات الاجتماعيّة والمدنيّة.
فالنقطة الخامسة المتعلقة بالثقافة الإنسوية تندرج في مسار تقرير دوبريه؛ إذ لا يمكن تحصيل هذه الثقافة من دون محدّدات تاريخيّة وجغرافيّة تتضمّن الدين. فالمحدّدات التاريخيّة ترتبط بأحداث مؤسسة «تبرز العلاقة بين الشؤون السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والدينيّة». وكذلك يتطلب فهم «وحدة العالم وتعقّده» مقاربة أولى لـ«تعدّد الحضارات والمجتمعات والأديان» و«الشأن الديني بفرنسا وفي أوروبا، باعتماد نصوص تأسيسيّة (وخاصّة مقتطفات من الكتاب المقدس والقرآن) وروح لائيكية تحترم المشاعر والقناعات». لكن في الوقت نفسه يحتوي هذا الفصل على عناصر تحدّد الهويات، مع المحافظة على توازن دقيق مع نسبيّة الهويّة. فنقرأ أنّ الثقافة الإنسوية «تمكن التلاميذ من تحصيل معنى القطيعة والهويّة والمغايرة و«تسهم في بناء شعور بالانتماء إلى مجموعة قائمة على المواطنة». ثمّ هي تغذي الاستعداد «للمشاركة في ثقافة أوروبيّة».
أمّا النقطة السادسة المتّصلة بالمهارات الاجتماعيّة والمدنيّة، فهي تستعيد هذا المسار المتأرجح للهويّة، إذ توصي بـ«ترسيخ شعور الانتماء إلى الوطن وإلى الاتّحاد الأوروبي، في ظلّ الاحترام الناتج عن اختلاف الاختيارات الشخصيّة بين الأفراد». وقد حدّدت البرامج الجديدة للتاريخ والجغرافيا والتربية المدنية في المدارس، الصادرة في النشرة الرسمية لوزارة التربية بتاريخ 28/05/2008، آليات تنفيذ هذه القاعدة المشتركة: «تساهم البرامج الثلاثة… في إكساب المهارات الكبرى لهذه القاعدة المشتركة، وخاصّة فيما يتعلّق بالثقافة الإنسوية والمهارات الاجتماعية والمدنية»، ولكن «فيما وراء هذه القاعدة»، تندرج البرامج في أفق تأسيس هويات ذات غاية إدماجيّة. بمعنى أنها «تعدّ التلاميذ للعيش المشترك والاندماج في المجتمع» و«تلقنهم مرجعيات ثقافيّة تسمح لهم بأن ينخرطوا بطريقة أفضل في الزمان والفضاء وفي منظومة قيم ديمقراطية» وتساعد على «تأسيس هويّة ثريّة ومتعدّدة ومنفتحة على الغيرية». ونجد ضمن التوجهات الخاصّة ببرنامج التاريخ هدف ترسيخ «ثقافة تاريخية مشتركة» لدى التلاميذ، على أن يكون أحد عناصرها «اكتشاف تعدّد الحضارات ورؤى العالم».
إنّ استعمال مفهوم «الحضارة» يضخّم من حقل الغموض، فهو يفتح الرؤية إلى العالم، لكنه يرسم حدودا لطرق القراءة («الحضارات» تعني أنه توجد حضارتنا وحضارات الآخرين). ويقع التنصيص أيضا على «الهدف المدني (الذي يعدّ) الشباب للعيش أحرارا في مجتمع حرّ». وثمّة معطى آخر يبدو أكثر أهميّة في هذا التأرجح بين مسار هدفه المعرفة ومسار هدفه تلقين القيم الجماعيّة، وهو يتعلّق بالطريقة التي يطلب بواسطتها من البرامج أن تأخذ بعين الاعتبار «القضايا الرئيسة لمجتمعنا»، وقد ذكرت موجزة، ويبدو أنّ البرامج تعتمد على طريقة التوسط، فهي تنصّ على أن «الجزء المخصّص للتاريخ الوطني جزء أساس. ويحضر معه تاريخ أوروبا بحيث يتمكن التلاميذ من رؤية شاملة». لكنّ هذا البناء للمحاور التاريخيّة، الفرنسيّة والأوروبيّة، المتضمّن مشاغل تتعلّق بالهويّة، يخضع بعد ذلك إلى توسط يقوم بدور التنسيب لأبعاده. ينبغي الاهتمام بالتاريخ الوطني، لكن النصّ يضيف دراسة «الإسهامات المتواصلة للهجرة». ينبغي الاهتمام بالتاريخ الأوروبي، لكن النصّ يظلّ منفتحا على «التاريخ غير الأوروبي»، كي يمكن إدراج تاريخ تجارة الرقيق والعبودية… مطروحا في الأمد الطويل». وأخيرا، نشهد تواصلا مع تقرير دوبريه عند الحديث عن «إدراج تعليم الشؤون الدينية بتنزيلها في السياقات التي ظهرت فيها كي يتوافر فهم أفضل لأصولها»، إنّ هذه العبارة الأخيرة لا تخلو بدورها من التشابه، بما أنّ الحديث عن الأصول قد يطرح مشكلات في نظر التاريخ (كما سنبين لاحقا).
من المفهوم حينئذ أنّ النصوص التنظيمية تحاول التخفيف من القضية الاجتماعية في إعداد البرامج، وخاصّة قضية الهجرة واندماج المهاجرين. وإذا كان التعليم يهدف إلى الإسهام في تحقيق الاندماج، وهو أمر مشروع في حدّ ذاته، فإنّ تعليم الشأن الديني يفترض تلقين معارف تتداخل مع قضايا قيمية (فحص المدونات الدينية بمقتضى القيم الجمهورية). وفي هذا السياق، يصبح تنزيل هذا التعليم في ظلّ برامج التاريخ تمرينا خطيرا، خاصّة إذا تعلّق بالإسلام، ويضع المدرس نفسه في وضع حرج. فهل أنّه مطالب بالاكتفاء بنقل المعلومات كما هي مسطرة في البرامج (وسنرى أن هذا الموقف لا يخلو أيضا من مخاطر كبرى) أم إنّ عليه حشد هذه المعلومات في أفق جمهوري ولائيكي واندماجي؟ إنّ قراءة البرامج تؤكّد أنّ المدرس سيجد نفسه في وضع دقيق؛ إذ عليه أن يأخذ بالاعتبار أمرين ويضع أمامه هدفين:
– الأوّل يتّصل بالمعلومة، وهذا جانب قد سجّله جيّدا تقرير دوبريه. على المدرّس أن يفسّر الماضي كما هو، كي يتمّ التعويض عن النقص في معرفة النقاط المرجعيّة المتّصلة بالدين في مجتمع لائيكي، فهذا النقص هو الذي اعتبر مسؤولا عن عسر فهم العديد من المراجع الثقافية والأدبية والفنيّة. لكن هذه المعرفة بالماضي مدعوّة أيضا إلى المساعدة في فهم الحاضر المتميّز بانهيار الأيديولوجيات، وعودة الديني في الحقل السياسي وتأسيس الهويات على أساس ديني، كما يبرز بوضوح من خلال أهميّة السجل الديني الإسلامي في هويّة جزء مهم من المجموعات المهاجرة.
– الثاني يحيل إلى رهانات تتصل بالاعتراف بالآخر وبالاندماج والعيش المشترك. فالمطلوب من المدرس أن يستعيد ماضيا مفهوما ومعترفا به لدى أصحابه، وأن يقدّم مفاتيح لفهمه لدى الآخرين، فهو يتوجّه إلى جمهورين مختلفين حضورهما متنوّع حسب فصول الدراسة، وأفق انتظارهما غير متوافق بالضرورة.
يحدث أن تتحدّث النصوص الوزاريّة نفسها عن ازدواج الجمهور المتّجه إليه بالحديث. هناك مثلا «وثيقة مصاحبة» لبرامج التاريخ والجغرافيا صدرت عن مركز البحث والتطوير البيداغوجي سنة 1999([5]) وهي توضّح في خصوص بناء مشروع مشترك للقسم الدراسي موضوعه المغرب (العربي) (مادة الجغرافيا، مستوى السنة الخامسة) أنّ «تعليم إقليم من العالم يعني نقل ثقافة لغايات تعليمية»، لكنّه يهدف إلى أمرين مختلفين، «تمكن هذه المعرفة البعض من تقبل التعدديّة، وتمكن البعض الآخر من الشعور بالاعتراف بثقافتهم الأسريّة وتعينهم على تأسيس هويتهم، (ص 40). إنّ دراسة منطقة المغرب الكبير –التي يشار إلى انتمائها إلى العالم العربي الإسلامي– تؤدّي حسب هذا التصوّر إلى التخفيف من حدّة سوء الفهم وقلّة التسامح وتمنع من تكوّن سلوك رفض الآخر أو الانطواء على الذات».
لكن هل يمنح المدرس، وهو يواجه هذه المهمّة المعقّدة، كلّ الوسائل التي تساعد على «التخفيف من ثقل الهويّة داخل مجتمع يتعرّض أكثر من أيّ وقت مضى إلى تفتّت الشخصيّات الجمعيّة» (تقرير دوبريه، ص 26)؟ نرغب أن نثبت في الصفحات القادمة أنّ إقحام دراسة الشأن الديني –خاصّة ما يتعلّق منه بالإسلام– في البرامج المدرسيّة يمثّل معطى إيجابيّا في البحث عن التجانس الاجتماعي، لكنّه مصحوب بالكثير من النقائص، سواء من جهة العلاقة البيداغوجيّة أو في مستوى تصوّر البرامج التي تتعارض أحيانا مع الأهداف المعلنة.
عـلاقة بيداغـوجيّة للبناء
إنّ العلاقة البيداغوجيّة المتصلة بتعليم الإسلام ليست دائما بالهيّنة. فهناك العديد من المصاعب الجديّة التي تطرح بسبب غموض الأهداف (دور المعرفة ودور الإدماج) ووضع المعارف حول الدين واختلاف طلبات التلاميذ، وتبرّر هذه المصاعب بطرق مختلفة داخل أقسام الدراسة. وحسب بعض المعاينات الميدانيّة التي قام بها –خاصّة- علماء اجتماع التربية([6]) يمكن أن تقدّم بسطة عن العلاقة البيداغوجيّة التي تجمع بين باحثين، أحدهما المدرس وثانيهما التلميذ، وهي علاقة غير متجانسة وربّما كانت قائمة على التنافس. فالأمر المميّز في هذه الوضعيّة هو أن التلاميذ يمكن أن يعتبروا أنّهم أصحاب مهارات في الموضوع المطروح ويشكّكوا في أهليّة المدرس أو مشروعيّته في القيام بهذا التدريس.
فمن جهة المدرس، تطرح مشكلة اختلال العلاقة البيداغوجية والتشكيك في مهاراته حول الموضوع. إذ إنه سيدرّس موضوعات جديدة، خاصّة في التاريخ والجغرافيا، وقد قام بجهد إضافي لاكتساب معارف بشأنها، كما تؤكّد ذلك التقارير المشار إليها. ونظرا إلى أنّ وضعية المدرس هي وضعية المجتمع نفسها، أي نقص المعارف في الموضوعات الدينيّة، فإنّنا ندرك أهميّة الرهان المتمثّل في توفير فرص تكوين ملائمة([7]). ثمّ إنّ العمل البيداغوجي يندرج بطبعه ضمن إطار ملزم هو البرنامج المقرّر رسميّا، ويجد المدرّس نفسه رهن كفاءة هذا البرنامج أو قلّة كفاءته، كما سنرى لاحقا. وأخيرا، يمكن أن يحصل تداخل بين الاختيارات القيمية للمدرس والعلاقة البيداغوجية في هذا الحقل المتميّز بكثافة الطابع الأخلاقي. إنّ نوعا من التمسّك باللائيكيّة سيسفر عن مقاومة لإدخال دراسة الشأن الديني في البرامج، ويعيد شكلا من الحنين الجمهوري إلى عهد الفصل الحادّ بين المدرسة والدين. بل قد يضع المدرس نفسه في وضع المندّد بالأديان وبصفة خاصة بالإسلام فيعتبره دينا معاديا للائيكية ومستنقصا من شأن المرأة ولا يحترم حقوق الإنسان عموما. لكن يوجد أيضا الموقف النقيض الذي يتمثّل في اختيار توقف حذر ودفاعي يسفر عن عروض باهتة حول الأديان([8]). ومن هذا المنظور أيضا يمكن أن نفهم إمكانيّة التعارض بين تعليم الشأن الديني والتربية المدنية، وهذا ما تغافلت عنه البرامج (الأديان من منظور التاريخ، اللائيكية من منظور التربية المدنية).
أمّا في ما يتعلّق بالتلاميذ، فإنّ أوّل ما يبرز من المصاعب هو ما يتصّل بتوقعاتهم من تدريس الشأن الديني. فلئن كانت البرامج تعمل على تلبية طلبات معرفيّة حول الأديان، وهي طلبات مشروعة ومرحب بها، فإن المشكلة قد تطرح عندما يخلط التلاميذ بين سجلين مختلفين: تعليم الشأن الديني وتعليم الأديان. وتتضخم إمكانات هذا الخلط عندما يغيب تعليم مواز للأديان خارج المدرسة. وهناك وجه آخر للخلط يحصل بادّعاء إصلاح خطأ الأستاذ. فبسبب الطابع الديني للحقيقة قد يعتبر بعض المسلمين أنهم وحدهم المؤهلون للحديث عن القضايا التي تتّصل بالإسلام. ويعتبر هؤلاء أنّ المدرسة الحكومية اللائيكية ليست لها مشروعيّة الحديث عن هذه القضايا وأن معلوماتهم إنّما يستقونها من مصادر أخرى أكثر مشروعيّة مثل الأسرة والمدرسة القرآنيّة ومواقع الإنترنت الإسلاميّة والفضائيّات العربية… إلخ.
إنّ الأعمال السوسيولوجيّة القليلة التي تمكنّا من الاطلاع عليها تبرز بوضوح هذه المصاعب المتّصلة بالعلاقة البيداغوجيّة، ثمّ إنّ هذه المصاعب تزداد حدّة للأسباب التالية:
– الشعور بالتمييز في الحياة المدرسية وهو شعور يمكن أن يحلّ بالتلاميذ المسلمين إذا أرادوا تطبيق واجباتهم وعاداتهم الدينية (العطل المدرسية والأعياد الدينية، المأكولات المقدمة في المطاعم المدرسية، الزي، مراعاة التوقيت الرمضاني…إلخ). فلهذا السبب تبدو المعارف التي تقدمها المدرسة حول الإسلام معارف مشكوكا فيها.
– طبيعة المعارف المقدمة للتلاميذ، لاسيما في المرحلة الأولى من التعليم وهي مرحلة هيكلة ذهنياتهم، ويغلب فيها أن تمثل عائقا أمام العلاقة البيداغوجيّة. فالمعرفة الدينية الأوليّة البسيطة والخارجة عن السياق تصطحب بمعرفة تاريخية بسيطة أيضا بالحضارة الإسلامية، التي غالبا ما تختصر في العالم العربي.
– تكوين الأفواج غالبا ما يؤثّر في آليات العلاقة البيداغوجيّة، فالخارطة المدرسية متنوعة من حيث التوزيع الجغرافي للمجموعات البشرية، فيمكن للمدرس أن يواجه أغلبية من التلاميذ المسلمين يعتبرون أنفسهم أغلبيّة مسحوقة، أو على العكس، يمكن أن يقوم بالدرس حول الإسلام أمام تلاميذ غير مهتمين بالعبادات أو متعدّدي الانتماءات الدينيّة.
– إنّ الغياب شبه الكلي لمدارس دينية إسلامية تجعل التلاميذ المنحدرين من الأوساط الأكثر راديكاليّة ينخرطون كليا في التعليم الحكومي، وهذا الوضع قليل الوجود لدى بقيّة الانتماءات الدينية.
إنّ أهمّ نقاط التصادم في العلاقة البيداغوجيّة هي تلك التي تتصل خاصّة بالقرآن وقراءته وطريقة تقديمه (خاصّة برنامج السنة الخامسة). فالحيّز الذي منح للنصّ القرآني في التعليم قد أسفر عن القدر الأكبر من الانتقادات المتعارضة. فالبعض يعتبر أنّ هذا الحيّز محدود لأنّ الإسلام هو القرآن (نستشعر من هذا النقد الروح السلفية)، والبعض يعتبر أنّه وقعت المبالغة في هذا الحيّز ويطالب بالاهتمام أكثر بالإسلام بصفته ممارسة يوميّة. كذلك يكثر انتقاد آليات تفسير النصّ القرآني، فيرى البعض أن طريقة اختيار السور والآيات ليست طريقة جيّدة، فلا يمكن أن نحتفظ بأجزاء فقط ونخلط بين السور والآيات المختلفة، فهذا الأمر ممنوع شرعا. وأخيرا يرى البعض أن توجهات النصّ القرآني (المترجم) لا تخلو من مشكلات، خاصّة أنها قد لا تناسب المصحف الذي يستعمله التلميذ بلغته الأصليّة.
لكن يمكن أيضا لبرنامج السنة الثانية أن يثير مشكلات لأنّه مهيأ لوجهات نظر متباينة حول العلاقة بين الأديان والفضاءات الثقافيّة (انظر لاحقا). ويمكن أن تثار مشكلات أيضا في طريقة الحديث عن الأديان الكتابية الأخرى، فيمكن لتلاميذ مسلمين أن يرفضوا الاهتمام بدروس حول الكتاب المقدس اليهودي أو التاريخ اليهودي أو أن يرفضوا مثلا زيارة كنيسة.
لا شكّ أن من العسير تفادي كلّ هذه المشكلات، فهي الوجه الآخر لإقحام الأديان في برامج التعليم العام، مع ما يترتب على ذلك من تقاطع بين سجل الإيمان وسجل العلم. لكن يمكن التخفيف من هذه المشكلات بتفادي منزلقين على الأقلّ: أ- الخلط بين المستويات وموضوعات القول. ب- الجوهرانية.
إنّ التمييز بين مستويات القول يعني التمييز بين الوضع الديني (العقيدة واللاهوت) والوضع العلمي للحقيقة. ونعلم أنّ ضعف التعليم الديني الرسمي (catéchisme) في الإسلام خارج المدرسة يزيد هذا الخلط تعقيدا. فالتمييز بين مستويات القول هو تمييز بين الإسلام دينا والإسلام ثقافة وحضارة، وقد جرت العادة (في اللّغة الفرنسية) على التمييز بينهما بكتابة إسلام بالحرف الصغير في الحالة الأولى وبالحرف الكبير في الحالة الثانية، لكنّنا لا نجد أثرا لهذه العادة في الكتب المدرسيّة.
ويعني رفض الجوهرانية رفض اعتبار الإسلام جوهرا واحدا ولونا موحّدا في عقائده وأنماطه الحضاريّة والثقافيّة. ذلك أنّنا إذا وقعنا في الجوهرانيّة وأضفنا إلى ذلك الإيهام بالثبات والمغايرة والصدام، فإنّنا نكون قد أسهمنا في «صناعة» إسلام متعال على الزمان والمكان. ومن رهانات البرامج أن تعيد تنزيل العالم الإسلامي في تاريخه وتنوعه. فهذا هو الدور الذي تضطلع به مادتا التاريخ والجغرافيا (خاصّة الجغرافيا الاجتماعية). فهل تنجح البرامج في إبراز التحوّلات في العالم الإسلامي بطرح المحاور على مدى زمني طويل، وتأكيد تنوّع الممارسات الدينيّة، وأيضا الممارسات السياسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة، وكذلك طرق تبيئتها؟
يوميّات اختفاء الإسلام على مدار التاريخ
إنّ المحددات الكرونولوجيّة المقترحة في دراسة الإسلام في مستوى المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي تتميّز بأنّها تجعل العالم الإسلامي يبرز بروزا مفاجئا في عصرين محددين، ثمّ يختفي بنفس الطابع المفاجئ الذي ظهر به([9]).
فبعد دراسة العصر القديم في السنة السادسة، يخصّص في برنامج السنة الخامسة في جزئه الأوّل (الصياغة السابقة لإصلاح 2008) فصل عنوانه «من الإمبراطوريّة الرومانيّة إلى العصر الوسيط»، والمحور الثاني في هذا الفصل يتحدّث عن «العالم الإسلامي»، ومن البداية يرتبط هذا العالم بالنبوّة والوحي بطريقة تجعله عالما منغلقا. وتبدو توجّهات البرامج واضحة جدّا في هذه المسألة فهي تتضمّن ما يلي: «الأمر الأساسي يتمثّل في تقديم محمد والقرآن وانتشار الإسلام وحضارته. وينبغي التركيز على الحضارة وإشعاعها… أكثر من الاهتمام بالأحداث السياسية الناتجة عن توسعها»([10]). إنّ التركيز على اللّحظة المؤسسة يجعل البرنامج يؤكّد القطيعة ويفصل بين عصر سابق وعصر لاحق، وهذا أمر خطير العواقب. إذ تبدو الحضارة الإسلامية محدّدة بالوحي والنبوّة وخاضعة لثنائيّة الانتشار والانحطاط. فالعصر السابق هو الجزيرة العربيّة ذات التنظيم القبلي والوثني في القرن السادس، والعصر اللاحق هو عصر فتوحات العرب الذين حملوا معهم مبادئ الإسلام وقادوا الجهاد بنجاح أمام الإمبراطوريات المنقسمة الضعيفة، وانتهى التوسع في مدينة «بوانييه» ومعركتها المشهورة([11]). إنّ هذه الطريقة في العرض تمنع من المقاربة التاريخية للحضارة الإسلامية وتحوّل الزمن الديني إلى زمن تاريخي([12])، أي إنّها في النهاية تخدم وجهة النّظر الأصولية. فكأن الوحي قد حدّد قبلا كل شيء (الملاحظة تنسحب أيضا على الأديان التوحيدية الأخرى). وعلى هذا الأساس يقع تقسيم المراحل: الماقبل (الجاهلية) والعصر الذهبي (فترة النبوّة والفتوحات) والمابعد (الانحطاط والنهضة المرجوّة). قد لا نتمكن من تفكيك هذه التمثّلات إلاّ بالاهتمام بالبناءات السياسية الناتجة عن توسّع العالم الإسلامي في فترة سابقة لما يدعى بتفكك الخلافة في القرن العاشر (بداية الانحطاط؟)([13]).
ولا تقدّم البرامج الجديدة (النشرة الرسميّة بتاريخ 28/08/2008) وضعا أفضل في هذه المسألة، فهي توصي بالحديث عن المسلمين «في سياق الغزو وإنشاء الإمبراطوريات العربية الأولى التي شهدت تدوين التقليد الإسلامي (من القرن السابع إلى القرن التاسع). ويقع الحديث عن هذا التقليد من خلال دراسة «بعض المقاطع (القرآن…) المرتبطة بتأسيس الإسلام». أجل تنبه البرامج إلى ضرورة الإشارة إلى «التنوع الديني والثقافي لإسلام العصر الوسيط»، لكنها لا توضّح ما إذا كان هذا التنوّع مقصورا على العلاقة بالأديان الأخرى أم هو تنوّع داخل الإسلام نفسه، مع ما تعنيه هذه الحالة الثانية من إعادة النظر في ما اعتبر سابقا أسس الإسلام. ونضيف أنه قد وردت في مقدمة البرامج إشارة إلى الحس التاريخي عبر الدعوة إلى التمييز بين الإسلام دينا، والإسلام الوسيطي حضارة.
ثمّ بعد هذا العرض يستعيد التاريخ مساره تاركا العالم الإسلامي وراءه متوقفا في القرن التاسع، فلا يذكر حوله بعد ذلك إلاّ حادثة واحدة هي سقوط غرناطة سنة 1492. ثمّ يتواصل برنامج السنة الخامسة بالحديث عن المسيحية الغربية، وتدعو البرامج إلى «إبراز تنوّع الهياكل السياسية وتطورها»، مع أنها قد سكتت عن ذلك سابقا فيما يخصّ العالم الإسلامي. ويتأكّد اختفاء العالم الإسلامي من التاريخ مع برامج السنة الرابعة (القرون 17-19) والسنة الخامسة (القرن العشرون)، فلم يعد للإسلام فيها أيّ حضور. ويترتب على هذا الوضع أمران: أوّلهما: أنه يؤكّد أطروحة انعزال العالم الإسلامي وانحطاطه وخروجه عن تاريخ الحضارات الكبرى، وثانيهما: أنه يوجّه التاريخ كله إلى أوروبا وقومياتها ويغلقه على خارجها، فيستجيب بذلك إلى هدف البرامج في دعم الهويّة الأوروبية، لكنه يضيق الطابع الإدماجي لهذه الهويّة.
تستعيد برامج التاريخ في المرحلة الثانية المسار نفسه الكرونولوجي مع تأكيد ضرورة ترسيخ «البحث عن المعنى وإعمال الفكر والعقل النقدي» (منشور بتاريخ 01/07/2002، الجريدة الرسميّة بتاريخ 10/07/2002، الملحق). ويقترح برنامج السنة الثانية البحث في «أسس العالم المعاصر» بتقديم دراسة «بعض اللحظات التاريخية التي تمثّل قطائع كبرى». فهذا البرنامج الذي يتواصل إلى حدّ القرن التاسع عشر لا يتحدّث عن العالم الإسلامي إلاّ بمناسبة واحدة ترتبط بالعصر الوسيط. وعندما ينتقل إلى القرن الثاني عشر، وهو القرن الذي اعتبر الأكثر تهيؤا لدراسة «تنوّع الحضارات الوسيطيّة» فإنّه يوصى بأن لا يقع البحث عن عرض شامل، وإنما يقع الاكتفاء بإبراز الأسس الدينية (كاثوليكيّة روميّة، إسلامية وأرتودكسية) والسياسية للحضارات الوسيطية الثلاث التي وقع الاحتفاظ بها (الغرب الوسيطي، الإمبراطورية البيزنطيّة والعالم الإسلامي). ثمّ تستعبد الفقرات الدراسية([14])، كما كان الشأن في القسم الخامس، عرض أسس الأديان الكتابية الثلاثة مع التركيز على التجليات الحضاريّة للإسلام في العلوم والبناء. أمّا التاريخ السياسي للعالم الإسلامي في هذه المرحلة فلا يكاد يبين. وما يذكر من شذرات أحداث فإنّما يهدف إلى تأكيد «استحالة الوحدة الإسلامية» (شأن حضاري أم معاينة تاريخية؟)، وهذه الأحداث تتعلق بعصور سابقة على القرن الثاني عشر: القطيعة الشيعيّة، الخلفاء المتنافسون في القرن العاشر. ولا يذكر حول الفترة التي تهمنا إلاّ قدوم الترك من آسيا الوسطى وتغيّر الدولة في الغرب الإسلامي من المرابطين إلى الموحدين. وممّا يلفت النظر أن ابن خلدون لا يذكر أبدا ولا تستعمل نصوصه، فمع أنه عاش طبعا بعد هذا القرن فإنّ كتاباته مفيدة لفهم هذا القرن. لكن يبدو أنّه وقع تفضيل الحديث عن ابن رشد أو ابن سينا والتركيز على إشعاع الحضارة الإسلامية في القرن الثاني عشر للتهيئة لاختفاء العالم الإسلامي بعد ذلك وتركه في غياهب النسيان أثناء فترة ظهور الأزمنة الحديثة.
ذلك أنّ المحاور التي يتناولها برنامج السنة الثانية هي التالية: الحركة الإنسية والنهضة – الثورة والتجارب السياسية الفرنسية إلى 1851 – أوروبا المتغيّرة هي النصف الأوّل من القرن التاسع عشر. فهذه المحاور لا تترك مكانا للعالم الإسلامي، وتقتصر على تعميق المسائل المتّصلة بالحداثة في أوروبا وفي فرنسا. ويتواصل اختفاء الإسلام حتى سنة 1945؛ لأنّ برنامج السنة الأولى لا يتضمن غير المحاور التالية: العصر الصناعي وحضارته من منتصف القرن التاسع عشر إلى 1939، فرنسا من منتصف القرن التاسع عشر إلى 1914، الحروب والديمقراطيات والأنظمة الشمولية (1914-1945). لقد اختفت «الحضارة المشعّة» في غياهب النسيان. ولا بدّ أن ننتظر القسم الدراسي الأخير والجزء الأوّل من البرنامج (العالم من 1945 إلى يومنا) كي نرى العالم الإسلامي يعود إلى ساحة التاريخ العالمي. وتأخذ هذه العودة الأشكال التي رأيناها سابقا مع العصور الإسلامية الأولى، إذ تبرز بمظهر القطيعة التي حصلت مع الثورة الإيرانية التي ستفرز الحركات الإسلامية، ويقدّم البرنامج بروز هذه الحركات ابتداء من السبعينيات كـ»حدث أساسي» في النظام العالمي الجديد. وتبرز أيضا بمظهر الانقسام واللااستقرار، فالشرق الأوسط يصوّر على أنه «وكر لعدم الاستقرار»، صحيح أنه سيشار إلى العوامل الدولية التي تسهم في إذكاء صراعاته، لكن يقع التركيز أيضا على الصراعات والأزمات بين دوله والانقسامات الداخليّة في المجموعة الإسلاميّة والمواجهات بين المجموعات العرقيّة والعقديّة بما يهيئ للحروب الأهلية([15]).
لا أحد يمكنه أن يطعن في هذه المعاينات المشار إليها، لكن ما يجدر نقده هو أنها تطرح من دون تنزيلها في أفق طويل الأمد. فاختفاء كلّ الإشارات إلى الفترات السابقة يوحي بأنّ العالم الإسلامي ظلّ راكدا وأنّه لم يدخل العصر الحديث إلاّ من بوّابة العنف والإرهاب، وهذا ما قد يثير أفكارا واستنتاجات مؤسفة وخطيرة([16]).
إنّها لمفارقة أن نصنع عالما إسلاميا أو حضارة إسلامية تدخل التاريخ ابتداء من القرن السابع، ثمّ تترك على قارعة الطريق، فيهمش فيها تاريخ الإمبراطوريّة العثمانية التي اضطلعت بدور أساسي ولم تكن غائبة عن الساحة غير الأوروبية… ولا الأوروبيّة! فهذه الإمبراطوريّة لا تظهر إلاّ ظهورا باهتا في مقرّر السنة الثانية بمناسبة الحديث عن «نضال اليونان من أجل الاستقلال» ودخولهم الرّمزي في الفلك الأوروبي سنة 1830([17]). ويذكر بصفة خاصّة إعلان الاستقلال في المؤتمر القومي سنة 1822 الذي يرد فيه ما يلي: «لا نطالب بغير عودتنا إلى الجمعيّة الأوروبية لأنّ ديننا وتقاليدنا وموقعنا تدعونا إلى أن ننضمّ إلى العائلة الكبرى للمسيحيين»، كما يذكر قول شاتوبريان: إنهم مسيحيون مثلنا، بل أقول إنهم ولدوا في اليونان مهد الحضارة». وفي السياق نفسه يلفت انتباهنا غياب آخر موضوعه الحركة الإصلاحية التي بدأت في القرن التاسع عشر، سواء في عاصمة الخلافة أو في بعض مقاطعاتها المستقلة. فهذه الحركة لا تذكر في أيّ موضع من المواضع، مع أنّ تحليلها يمكّن من فهم قضية علاقة الدول والمجتمعات في العالم الإسلامي بالحداثة (كان يمكن إدراج هذه المسألة في الجزء الأوّل من برنامج السنة الأولى المتعلق بالعصر الصناعي وحضارته وبصفة خاصّة في فصل: الدين والثقافة). وأخيرا فإنّ التحاليل المقدمة لتلاميذ السنة الأولى والثانية حول موضوع الاستعمار ونهايته، تظلّ ضعيفة حول موضوع: هل المرجعية الإسلامية للمجموعات السياسية والمجتمعات المستعمرة، يمكن أن تمثّل عاملا يفسّر مقاومة الاستعمار، كما يفسّر التطوّرات الحديثة للعالم الإسلامي، وخاصّة صعود حركات الإسلام السياسي؟ ذلك مع أنّ برنامج السنة الدراسية الأولى يؤكّد أن التوسّع الأوروبي «ظاهرة معقّدة غذت المقاومات وشجّعت المبادلات وأثّرت في الثقافات الأوروبيّة (النشرة الرسميّة عدد 7 بتاريخ 03/10/2002). ويتّضح من وراء السطور رهان الإدماج بالبحث عن قراءة مشتركة للمسار الاستعماري يمكن أن تقبله المجموعات المهاجرة من المستعمرات الفرنسية السابقة.
وإضافة إلى هذه الفراغات، نلاحظ غياب القضايا التاريخية «الساخنة» المتصلة بالمجتمع الفرنسي المعاصر في علاقته بالهجرة والأديان، باستثناء بعض الإشارات الواردة في الكتب المدرسيّة عندما تتحدث عن الإسلام الفرنسي أو الإسلام في فرنسا. فالكتاب المدرسي للسنة النهائية الصادر عن دار النشر «ناتهان» يوضّح أنّ «ممارسة الديانة الإسلامية تمثل عامل اندماج في المجتمع الفرنسي» وأنّ «الحركات الإسلامية تمثّل أقليّة من المسلمين» (ص 334). لكن هذه الأقوال المطمئنة غير كافية، ألن يكون مفيدا أن تفتح الكتب المدرسية حقلا للتفكير حول ذاكرة التاريخ الاستعماري، مثلما أقدمت عليه عندما طرحت ذاكرة الحرب العالميّة وذاكرة المذبحة اليهوديّة؟ ولو قدمت بعض المسائل حول الإسلام المغاربي وحدّدت خصوصياته وتنوعاته لأسهم ذلك في كسر التمثلات الجامدة للعالم الإسلامي ومنح مفاتيح قراءة حول تنظم الإسلام في فرنسا، فالكتاب الذي أشرنا إليه يكتفي بالقول: إن «المسلمين يجتمعون في جمعيات ترتبط ببلدانهم الأصلية، وإن التنافس بين هذه البلدان (المغرب والجزائر) قد أخّر ظهور مؤسسات ممثلة للإسلام بفرنسا» (الصفحة نفسها).
إنّ هذه المحاور الثلاثة الغائبة في البرامج: الإمبراطوريّة العثمانية، الحركة الإصلاحيّة، وحضور الإسلام في سيرورة الاستعمار ونهايته، ترتبط بحقول دراسة وبحث تاريخيين شهدت نشاطا مهما في العشرية الأخيرة، سواء في فرنسا أو في الخارج، فلو توافر تعاون بين مجموعات البحث ومسطّري البرامج لتوافرت حول هذه المحاور نتائج طيّبة.
مخاطر الجوهرانية: هل ضروري أن نبحث عن أسس الحضارة الإسلاميّة؟
كأن البرامج تقول: كلّ شيء في الإسلام قد تحدّد مع أصوله. والأصول هي مدونات تضمنت الوحي (القرآن) والسنة النبويّة (أقوال النبي وأعماله المروية في الأحاديث). لكن هذه المدونات صنعت الحضارة، بمعنى أنها وجهت في الآن ذاته التنظيم السياسي والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والمعمار والفنون عموما والأدب والعلوم… أنها تهيكل العالم الإسلامي عبر مرجعيات ثابتة لا تتغير مع العصور. إنّ التركيز على الشأن الحضاري يؤكّد وحدة الإسلام في أسسه وفي تجلياته، هذه هي الصورة التي توجّه البرامج، خاصة في السنة الخامسة من التعليم، وإلى حدّ ما في السنة الثانية أيضا، فهي تبرز النصوص المؤسسة ثمّ تبحث عن الثوابت في الحضارة الإسلاميّة.
إنّ مقاربة المدونة تكشف عن مسار يقف عاجزا أمام الوظائف الدينية للنصّ وللوحي بصفته قطيعة وتشريعا. فالقرآن لا يطرح أبدا في أفق تاريخي، سواء فيما يتصل بعلاقاته بالتقاليد الدينية السابقة أو ما يتصل بآليات نقله وكتابته واستقراره. إنّ تنزيل بدايات الإسلام في سياقها التاريخي، كما تدعو إلى ذلك برامج السنة الخامسة، وكما يمكن أن يستفاد من الأبحاث العديدة التي ظهرت مؤخّرا، يبدو أنه يشمل الشخصيات الإسلامية المؤسسة، وأوّلها النبي محمّد، أكثر من أن يشمل النص المؤسس([18]). صحيح أنّ السياق يفترض على الأقلّ التأريخ للنصوص (القرآن، الأحاديث والسنة، السيرة)، لكن الكتب المدرسية الحالية تكاد تقتصر على مختارات من الآيات القرآنية موضوعها الأركان الخمسة للإسلام وبعض المسائل التي قد تثير الجدل، مثل الممنوعات الغذائية ووضع المرأة (تعدّد الزوجات، الميراث…)([19]). ويمكن لهذا الاختيار أن يكون وجيها (مع أنه لا يقدّم صورة شاملة عن وظائف النصّ القرآني وبناه)، لكنه قد يسفر عن علاقة بيداغوجية خطيرة. فالمدرس ليس عالما ولا فقيها ولا باحثا في الإسلاميات، فكيف يمكن له أن يقتحم غمار التفسير القرآني الذي يحيل إلى البعد القيمي للإسلام؟ ألن يجازف حينئذ بالتعرّض إلى المقاومات التي ذكرناها أعلاه؟ أو أنه قد يضطر إلى الاكتفاء بالتفسيرات الحرفية التي قد ترضي بعض المعارضين لكنها ترسخ الجوهرانية –الصورة النمطية للإسلام الذين يعدّدون الزوجات ويحرمون نساءهم من الميراث!– بما يتعارض وهدف الإدماج الذي تحدثت عنه البرامج. في الواقع، لا يمكن حلّ المشكلة إلاّ بتوضيح مرجعيات التأويل كي يتّضح تنوع القيم والممارسات الإسلامية في علاقاتها بالمدونة القرآنية.
تنسحب هذه الملاحظة أيضا على طريقة التعامل مع التعبيرات والتجليات للحضارة الإسلاميّة، فهي تبدو منخرطة في مسار متواصل، ويبرز ذلك في مثالين: المدينة المسلمة، ودور التجارة في الاقتصاد الإسلامي. تتحدث الكتب المدرسية للسنتين الخامسة والثانية عن «المدينة الإسلامية» بصفتها عنصرا رئيسيا في الحضارة الإسلامية، فقد نشأ نموذج للمدينة من بغداد إلى القيروان يتميز بالدور المحوري للدين (المسجد) ثم للسياسة (القصور) ثم للاقتصاد (الأسواق). يقول مثلا الكتاب المدرسي للسنة الثانية: إنّ الحضارة الإسلاميّة تتميّز «بثقافتها الحضرية الرفيعة». ويضيف أنّ المدن الإسلامية في العصر الوسيط كانت «عديدة وكانت من أكثر مدن العالم سكانا». وأنها تتمحور حول جامع كبير يجمع المسلمين في صلاة الجمعة ويمثل أيضا محور الشأن العام ومكان التعليم، ويحاط بالأسواق، وهي أحياء تجارية وحرفيّة تنشط المدينة» (ص 78).
هكذا يسجّل الشأن الحضاري في المعمار الإسلامي. لكن الواقع أنّ معمار العالم الإسلامي يتميّز بالاختلاف الشديد حسب الفضاء والزمان (تقدّم المنطقة المغاربية أمثلة واضحة في هذا الصدد) وأنه كان محلّ مساءلة المفكرين المسلمين (ابن خلدون ونظرية التقابل بين حضارة المدينة وحضارة البدو). ومن هنا تبرز أيضا الصورة النمطيّة العكسية التي تقول: إنّ الإسلام دين الصحراء([20]). ثمّ إنّ مفهوم المدينة الإسلامية يخضع بنفسه إلى عدّة انتقادات (شديدة) من الباحثين المعاصرين المختصين في معمار العالم الإسلامي. صحيح أنّ البرامج تعكس الرّغبة في الإعلاء من شأن الحضارة الإسلامية، خاصّة بربطها بين التطوّر المعماري وتطوّر «العلوم الإسلامية» في القرن الثاني عشر، لكنها ترسخ المغايرة الحضارية بين العوالم، وتحيل ضمنيا إلى الوصايا النبوية حول تأسيس المدن.
وتقدّم حيويّة المدن أيضا بصفتها انعكاسا للحيوية التجارية في العالم الإسلامي. فنجد ملفا في الكتاب المدرسي للسنة الخامسة يتحدث عن «أهميّة التجارة» ويذكر أنّ «التجار كانوا كثيرين في بلاد الإسلام». ويقع التركيز على استعداد المسلمين للتجارة، كما تشهد على ذلك كثرة المبادلات والتنقلات وتطوّر علوم الملاحة وتنظيم الأماكن بما يسهل تعاطي التجارة (الأسواق والفنادق وقصور القوافل) أو استعمال نقود عالية القيمة، وتسمح هذه الجوانب بالتهيئة للمحور المتبادل المطروح في السنة الثانية، إذ يعدّل نوعا ما فكرة تقابل الحضارات. ذلك أنه «بالرغم من الحروب»، الحروب الصليبية مقابل الجهاد، فإنّ «المبادلات التجارية قد تكاثفت… واستفادت من ذلك المدن الإيطالية» (ص 90). ويقع التطرق إلى أهمية التواصل الثقافي والمثاقفة التي حصلت في الأندلس وصقلية. لكن الرّبط المبالغ فيه بين التجارة والحضارة الإسلاميّة قد يؤدّي إلى أفكار نمطيّة خطيرة، وكان الأولى أن تقع الاستفادة من هذا المحور استفادة تاريخية (المسلمون والحضارة الصناعية) أو معاصرة (دور المهاجرين من العالم الإسلامي في المؤسسات الاقتصادية للمجتمعات الغربية).
إنّ الطريق إلى الجنّة محفوفة بالأشواك. لا شكّ أنّ إقحام دراسة الإسلام والعالم الإسلامي في البرامج الدراسية يمثل خطوة محمودة باعتبار الحاجة المعرفيّة والحاجة إلى التجانس الاجتماعي. لكن طرح الموضوع في قالب حضاري لا يخلو من مخاطر([21]) لأنه قد يجعل حاضر المجتمعات المعاصرة يقرأ من خلال ما يعتبر ثوابت، خاصّة في محيط دراسي لم تنضب فيه المجادلات الدينيّة. ويمكن أن نتفهّم ضرورة التدرّج البيداغوجي حسب التدرج في مستوى الدراسة، لكن علينا حينئذ أن نعدّل الأمر بتنويع مستويات المعاينة كي نقدّم دائما أمثلة مضادة ونعمّق فكرة تنوّع المجتمعات وتعقدها. ولئن كان البحث الأكاديمي نفسه قد وقع أحيانا في بعض هذه المزالق، فإنّه قد حقّق أيضا تقدّما مرموقا في دراسة هذه المحاور في السنوات الأخيرة، ونذكر من ذلك -من دون ترتيب- الدراسات حول القرآن وأصوله، والدراسات حول التنقلات في المتوسط من العصر الوسيط إلى اليوم، والدراسات التي جدّدت القراءة للإصلاحية الإسلاميّة وتطوّر الدراسات العثمانية، والأبحاث حول الإسلام والهجرة في أوروبا بين الحربين، والاهتمام بالإسلام الهامشي… إلخ. فالبرامج المدرسية يمكن أن تستفيد من هذه الأعمال ومن الدورات التدريبية الموجهة إلى المدرسين كي تلبي الأهداف المعلنة في البرامج المرسومة.
وبالنظر إلى هذه الرهانات فقد تأسست مؤسسات لتقوم بدور الوساطة بين البحث العلمي والمؤسسات العموميّة العاملة في حقل التعليم والتكوين. فنذكر من هذه المؤسسات معهد الدراسات حول الإسلام ومجتمعات العالم الإسلامي، وقد أنشئ سنة 1999 في شكل مركز بحث تابع لمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، وأنيط به دور مواصلة التفكير في تكوين الإطار الديني للإسلام بفرنسا. ونذكر منها المعهد الأوروبي لعلوم الأديان وقد أنشئ سنة 2002 ضمن المدرسة التطبيقية للدراسات العليا، وجاء نتيجة نشر تقرير دوبريه. فهاتان المؤسستان ساهمتا بأعمالهما في تقديم وثائق بيداغوجيّة وضعت على ذمّة المدرسين(22) كما أنّها تتولى تنظيم دورات تدريبية بطلب من الجامعات.
جون فيليب برا أستاذ التاريخ بجامعة روان الفرنسية وتولّى إدارة معهد الدراسات حول الإسلام ومجتمعات العالم الإسلامي التابع لمدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية بباريس.
النص معرب من الفرنسية
[1] نجد تطويرا لوجهة النظر هذه في كتاب دومنيك بورن وجون بول ويلام (إشراف): تدريس المسائل الدينية، أي رهان؟ حوارات مدرسية، أرموند كولان، 2007، صفحات 77-91 (بالفرنسية).
[2] راجع المصدر السابق، صفحات 60 – 77، في سبيل تأريخ للعلاقة بين التعليم العام والدين.
[3] جون بوبيرو: من أجل ميثاق لائيكي جديد، منشورات سوري، باريس، 1990 (بالفرنسية).
[4] شهد هذا التقرير أيضا متابعة بمناسبة الندوة الوطنية متعددة الاختصاصات التي انعقدت في 5-7/2/2002 بإشراف إدارة التعليم وأكاديمية فرساي وقد نشرت أعمالها على الموقع الإلكتروني
eduscol.education.fr
[5] يمكن الاطلاع عليها في الموقع:
www.sceren.fr/secondaire/histoire
[6] راجع مثلا: ماري لوجون وسيمون ترسجيني: التعليم العام مساحة للمطالبة الفردية والجماعية بفرنسا: التجذّر عبر الإسلام. نشر في مجلة الأنثروبولوجيين، عدد 100 – 1001، صفحات 49 – 73.
وأيضا: جاكي شابرول ورودريغ كوتولي وفرنسواز لورسوري وجيرار آتالي: تعليم الإسلام: بعض الرهانات، الورشة البيداغوجية للقاءات ديرانس الثالثة. وأيضا: ألكسي برشادسكي: الإسلام والمدرسة في مرسيليا، الجامعة الصفية 2002: أوروبا والإسلام، إسلامات أوروبا. وكذلك: الإسلام والتعليم الوطني، ضمن مجلة «93». (كلّ هذه الأعمال بالفرنسية).
[7] هذا ما يؤكده تقرير دوبريه.
[8] تعليم الشأن الديني، مصدر مذكور، ص 131.
[9] نجد هذه المعاينة في العمل المذكور سابقا ليورن وويلام، ص 107، وكذلك في العمل الذي سيصدر قريبا لأنلياس نوف حول «تعليم تاريخ الإسلام الوسيط بين الريبة والمعاكسة»، ندوة نظّمت بدار المعلمين العليا بمدينة «ليون» من 11 إلى 13/3/2009 وكان موضوعها الإسلام والغرب في العصر الوسيط. أشكر المؤلفة التي أمدتني بالبحث.
[10] راجع: إدارة التعليم المدرسي: التعليم في المعاهد، التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية، البرامج والوثائق المصاحبة، 09/2004.
[11] مارتن إيفرنل (إشراف): التاريخ والجغرافيا للسنة الخامية، هاتيي، ص 36.
(12) راجع حول هذه النقطة باسكال بوراسي: تعليم تاريخ الأديان التوحيدية الثلاثة، ضمن: تعليم الأديان التوحيدية الثلاثة، هاتيتي، باريس، 2009، ص 10-12.
[12] الكتاب المدرسي المذكور، ص 36.
[13] انظر مثلا: كتاب التاريخ للسنة الثانية، منشورات هاتيي، بإشراف غيوم لكنتراك، ص 78 وما يليها.
[14] انظر لدى الناشر نفسه وبالإشراف نفسه كتاب التاريخ للسنوات النهائيّة، ص 178…
[15] تدريس الشأن الديني، مذكور، ص 107.
[16] المصدر المذكور، ص 256 وما يليها.
[17] هذه الترجمة لاسم النبيّ (Mohamed). تمثّل في ذاتها عنصر صعوبة في العلاقة البيداغوجيّة، لذلك نصّ الكتاب المدرسي للسنة الثانية على إمكانية اعتماد Mahomet أو Mohamed وهذا الحلّ لن يغلق الجدل لكنه يسمح بفهمه.
[18] راجع كتاب السنة الخامسة المذكور سابقا، ص 32-33.
[19] نيكول صمند: الإسلام، أي معرفة ندرس؟ (مداخلة بالفرنسية).
[20] حلّلت إنلياس جيّدا لغات المقاربة الحضارية في المقال المذكور سابقا.
[21] نذكر بصفة خاصّة ثلاثة كتب: أوروبا والإسلام، إسلامات أوروبا (2003)، تدريس الشأن الديني (2003)، مقاربات الإسلام: التاريخ، المصادر، الحاضر (2006) وكذلك كتاب بورن وويلام المذكور سابقا. ويمكن أن نذكر بعض العناوين الأخرى: الإسلام للمدرسين (2004) – تاريخ الإسلام (2007) – تدريس الديانات التوحيديّة الثلاث (2009). مع العلم أنّ معهد دراسات الإسلام ومجتمعات العالم الإسلامي قد أنشأ سلسلة «الإسلام محلّ نقاش» وهي تتضمن المحاور الكبرى مثل أصول القرآن وحكم الصورة وتمثّلات الجنس والفكر الإسلامي المعاصر والجهاد وإسلام الهوامش… إلخ (كلّ هذه المراجع باللّغة الفرنسية).