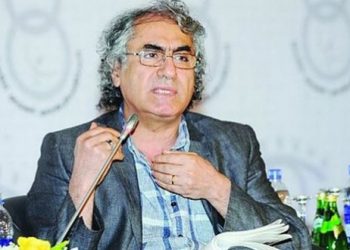في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، خالجت بعض المحللين الأمريكيين هواجس وساورتهم شكوك وظنون بشأن وجود صلة محتملة بين العراقيين والإرهابيين “الجهاديين؟” على الرغم من غياب الدليل الاستخباراتي القاطع على ثبوت تلك الصلة. ولعل هذا ما يفسِّر -إلى حد بعيد- كيف أن المقاربة المنطقية للحرب (التي جرى بحثها في الجزء الثاني من هذه السلسلة) خرجت من السياق وانحرفت بشدّة عن المسار، وانجرفت بقوة إلى التمرغ في أوحال السياسة وغوائل الشخصنة والسموم والهموم الثقافية الأخرى، التي أسهمت في وقوع الكارثة المستمرة التي انطلقت شرارتها في مارس (آذار) 2003.
علَّل البعض غياب الدليل على وجود تلك الصلة بأنه لا يرقى إلى منزلة الدليل على الغياب –وهذا تعبير “رامسفيليدي” آخر (من تعبيرات رامسفيلد) لأولئك الذين قد لا تسعفهم الذاكرة ولا يسعهم التذكر. أمَّا أن وكالة الاستخبارات المركزية فقدت الكثير، واختلط عليها الأمر كثيراً، وتورطت وتأرجحت بين الفوضى والحيرة والارتباك في ماضيها المتقلب، فهذا صحيح بحق وحقيقة ولا سبيل لإنكاره. ففي الحالة العراقية تحديداً، أساءت وكالة الاستخبارات المركزية التقدير فيما يتعلق بمدى التقدم في سير الأحداث في العراق منذ عام 1991 وحتى تاريخه، فقلَّلت من شأنه بصورة ملحوظة. ولأجل هذا قرر بعض الأشخاص أنه ربما كان هنالك تجاوز في بحث الاحتمالات واستقصائها. إلى هنا، ليس في هذه الصورة ما يشوبها بما يشينها.
كانت لوري مايلْروي من بين هؤلاء الأشخاص؛ وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وعملت في السابق مدرِّبة أو مدرِّسة في كلية الولايات المتحدة للحربية البحرية؛ ويشار أيضاً إلى أنها ابنةٌ لوالديْن كُتِبَتْ لهما النجاة من “محرقة” الهولوكوست. لقد كانت الدكتورة مايلروي على قناعة بأن الاستخبارات العراقية هي المسؤولة عن تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993؛ وهي قناعة ترسخت لديها قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 بمدة طويلة. وكانت ترى أيضاً أن تفجير المبنى الاتحادي بمدينة أوكلاهوما في أبريل (نيسان) 1995 كان من تدبير الاستخبارات العراقية؛ كما كانت كذلك ترى أن جميع المؤامرات الإرهابية التي حيكت ضد أمريكا تندرج ضمن حملة انتقامية عراقية خفية للثأر من إذلال العراقيين على يد أمريكا عام 1991.
أعرف لوري معرفة جيدة –ذلك أنني كنت مستأجراً جزءاً من الطابق السفلي بمنزلها في منطقة كليفلاند بارك بواشنطن، منطقة كولومبيا، لمدة وجيزة قريباً من بداية عهدي الذي أمضيته في قطع الطريق جيئةً وذهاباً بين فيلادلفيا وواشنطن، عندما كنت أعمل محرراً تنفيذياً لمجلة “ذي ناشيونال إنترست (The National Interest)”. وبينما كانت لوري تمضي أمسياتها في المنزل –وإن لم يكن ذلك بصورة مستديمة –كنت أمضي وقتي بالطابق السفلي في القراءة أو محاولة الخلود إلى النوم، وكانت في بعض الأحيان تتمتم وتهمهم وحدها، وتتحدث مع نفسها بصوت جهير عن صدام حسين، وهي تخبط برجليها على البلاط بعصبية يُداخلها الخوف، ويتملكها الهم والغم عن المخاطر التي كانت تتوقعها.
أما دوافعها، فهي ليست محل شبهة أو موضع ريبة وشك. فقد كانت حقاً ترى أنها تمتلك المفتاح للحيلولة دون وقوع الأضرار الماحقة ليس على الولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضاً على إسرائيل. وكانت ترى، بصورة ملؤها الزهو والفخر، أن عليها التزاماً أخلاقياً يملي عليها القيام بكل ما يسعها القيام به لمنع ذبح المزيد من الأبرياء على أيدي الطغاة والإرهابيين العرب.
لئن دأبْنا على مناقشة كل هذه الأمور من حين لآخر، فإن حالتها المزاجية أصبحت مع مرور الوقت مسكونةً بالهواجس، ومشحونة بالوساوس التي استبدّت بها أيما استبداد، وبصفة خاصة خلال الفترة الفاصلة بين الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وبداية قرع طبول الحرب في العراق في مارس (آذار) 2003. ويوماً بعد يوم، طفق صدرها يضيق وأصبحت لا تطيق أي اعتراض من أصدقائها. أما أعداؤها، فبطبيعة الحال يرفضون آراءها بازدراء واحتقار واستخفاف كما هو متوقع منهم. وفي حين أن الأصدقاء لم يكن أمامهم سوى التسليم بأي فرضية وقبول أي افتراض، فإن المنتقدين غير مرحَّب بهم بالمرّة. لقد أدى يقينها المطلق إلى إثارة نوازع الذعر والوجل في نفسي، وجعلت الرعب يدبُّ في أوصالي.
بيد أنني لم أكن أستنكر ما كانت تسوقه من حجج أو أرفضها بصورة تلقائية، وذلك لا لسبب سوى أن شخصيتها كانت في بعض الأحيان تتجلى فيها صفات البركان عند الثوران. ففي واقع الأمر، سبق أن نَشَرَتْ لها مجلة “ذي ناشيونال إنترست” مقالاً في عددها الصادر في شتاء 1995/1996 بناءً على اقتراح وارد مني؛ وكان ذلك أول مقال لها يحدد معالم أطروحتها العامة، ويوضح ملامح تلك الأطروحة التي تمحورت حول تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993. لقد أخبرني أوين هاريس المحرر المسؤول بمجلة “ذي ناشيونال إنترّست” أن الوجاهة أو المعقولية ليست دليلاً على إثبات الصحة، وقد وافقته فيما ذهب إليه؛ ولكنني رددت عليه بأننا كمحررين لا نوافق على حجتها أو نصادق عليها ولا نزكّيها، وإنما فقط ننشرها لعرضها على عموم الأفراد والنقّاد. وذكَّرتُ أوين بأنه كثيراً ما نشر مقالات لم يكن موافقاً على ما ورد فيها –بما في ذلك أشهر مقال تم نشره في المجلة على الإطلاق- لأنها أثارت نقاشاً مفيداً وأثرته واستثارت قرائح المحاورين وقدحت زناد أفكارهم؛ بل إن بعضها أدى إلى زيادة الاشتراكات في المجلة، ربما ليس على سبيل المصادفة أو من قبيل الأحداث العَرَضية. لذا أبدى مباركته وموافقته على النشر.
تُرى، هل أنا نادم على ظهور ذلك المقال على صفحات مجلة “ذي ناشيونال إنترّست” قبل حوالي خمس سنوات من نازلة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001؟ الإجابة: لا. أما الأسباب التي قادتني إلى الرغبة في توسيع دائرة النقاش العام وقتها، قبل مدة طويلة من تغيُّر سياق الأحداث بفعل هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، فهي أسباب وجيهة ومعقولة في الوقت الحالي تماماً، مثلما كانت وجيهة ومعقولة في ذاك الوقت.
أما جيمس وولسي المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الذي أعرفه أيضاً، فهو الآخر لم يرفض ما ذهبت إليه مايلروي. فقد كتب وولسي مقدمة تعريفية تنطوي على دعاية مغالىً فيها لكتاب مايلروي الذي نشرته عام 2000 تحت عنوان “دراسة عن الانتقام (A Study of Revenge)”. وفوق هذا وذاك، أصبح بول وولفويتز من المعجبين بجهود مايلروي والمشيدين بها والمروجين لها. وعندما أصبح نائباً لوزير الدفاع في يناير (كانون الثاني) 2001، استصحب أفكار مايلروي وأخذها إلى شأو بعيد –وبطبيعة الحال وضعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الأمر برمّته على صفيح ساخن لمنظور جديد محمَّل بالكثير من المحاذير والنُّذُر التي تشي بوخيم العواقب.
كان وولفويتز ومايلروي قلقيْن بصفة خاصة، أشد قلقاً مما يبديه المحلل العادي، إزاء ما يمكن أن يعنيه التهديد العراقي لإسرائيل وللولايات المتحدة على حد سواء. لقد قَدِمَ والد وولفويتز من بولندا بعد الحرب العالمية الأولى –متأخراً بثلاثين سنة عن معظم المهاجرين اليهود الذين توافدوا إلى أمريكا من تلك المنطقة. وقد هلك جميع أفراد أسرته لأبيه في مهلكة الهولوكوست. لك -إذن- أن تحاول أن تتخيل مقدار الرعب والخوف من أن هجمات صاروخية عراقية قد تضرب إسرائيل وتزلزل أركانها في حرب جديدة، خلافاً لصواريخ سكود التي أدت إلى شل حركة الحياة وتعطيلها تماماً في البلاد خلال حرب 1991 –ذلك أن الصواريخ الجديدة قد تحمل الغازات السامة التي لا تكون مختلفة بطريقة مقصودة عن غاز “زايكلون بي (Zyklon-B)” الذي تم استخدامه في أوشفيتز. إنه لمن الخطأ -إذن- ألا يُقَدَّرَ العمق السحيق لذلك الجرح الغائر بما يستحقه من تقدير، وألا تُقَدَّر قوة تأثير تلك الحادثة المأساوية حق قدرها في تشكيل التصورات وبلورة المواقف وغرس المخاوف وقذف الرعب في قلوب اليهود حتى يوم الناس هذا. إنه ليس شيئاً يمكن أن يتلاشى تأثيره وتنمحي آثاره خلال جيل واحد، أو جيلين أو حتى ثلاثة أجيال.
كانت لوري باحثة مبدعة تتصف بالمثابرة والسعي الحثيث والجهد الدؤوب، وتتوخى الحرص الشديد وتتحرى الالتزام الصارم بأخلاقيات العمل البحثي الرصين، والتقيد بتلك الأخلاقيات بصورة مذهلة. فعندما كان الأمر متعلقاً بواقعة مدينة أوكلاهوما -على سبيل المثال- تمكنت لوري بطريقة أو بأخرى من الحصول على تسجيلات بهاتف نيكول. وقد كشفت تلك التسجيلات النقاب عن سلسلة من المكالمات الهاتفية المبهمة وغير الواضحة إلى الفلبين خلال الفترة التي سبقت وقوع التفجيرات. من الجدير بالذكر أنه كانت هنالك سفارة ومحطة استخبارات عراقية بالفلبين في ذلك الوقت. وفي هذا السياق، يشار إلى أن الصلات بين العراق والفلبين، بما في ذلك جزيرة مينداناو التي تقطنها أغلبية مسلمة، والتي كانت تشهد موجات تمرد وعصيان، تعود في حقيقة الأمر إلى القرن الثالث عشر، كجزء من شبكة الرحلات التجارية التي تتحكم فيها الرياح الموسمية. وما انفكّت لوري تتساءل عما إذا كانت الاستخبارات العراقية تمد يد العون لجبهة تحرير مورو كوسيلة أو أداة للإضرار بأحد حلفاء الولايات المتحدة، والتمكن من الوصول إلى أهداف لتنفيذ أعمال إرهابية في الفلبين. ومن وجهة نظري أرى أن ما ذهبت إليه لوري لم يكن مجرد رأي ليس له أي مدلول، وإن لم يقم عليه أي دليل حتى الآن.
سرعان ما وقفتُ بعد ذلك على حقيقة أمر المحامين وممثلي الادعاء الاتحاديين في تلك القضية، على الأقل في الولايات المتحدة. إنهم لا يقولون الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، كما ظللنا نردد دوماً حسب التقاليد القانونية والقضائية الأمريكية الإنجليزية (الأنجلو أمريكية)؛ وإنما يسعون دونما كلل أو ملل إلى إماطة اللثام عن أكبر قدر من البراهين والأدلة والبيِّنات المطلوبة لكسب القضية، بينما يتعاملون مع المعلومات التي من شأنها إرباك عملية اتخاذ القرار من قبل هيئة المحلّفين، درجاً على ما جرت به العادة، أو تعقيد إجراءاتها، إما بتجاهل تلك المعلومات أو حجبها جملةً وتفصيلاً. ولأجل هذا لم تُبذل أيُّ جهود في محاكمة تيرى نيكول للكشف عن الصلات المتعلقة بالفلبين. (لم يكن المدعي الاتحادي الرئيس في تلك القضية سوى النائب العام الحالي ميريك جارلاند). لم يقم الادعاء العام إطلاقاً بإثارة موضوع الصلات المذكورة أعلاه، على الرغم من أنه كان أغلب الظن على إلمام به؛ ومن المؤكد أنه كان آخر شيء من الممكن أن يقوم به ممثلو هيئة الدفاع –والذين لم يكونوا على إلمام به، على أرجح الاحتمالات.
لقد اتضح بصورة شبه مؤكدة أن لوري كانت حالةً تصلح للدرس والبحث في المرافق الدراسية والبحثية، وللإدراج في كتب المقررات الدراسية فيما يتعلق بالانحياز التأكيدي (confirmation bias) في العمل (وهو انحياز سلوكي يُقصد به تفسير البيانات أو المعلومات بطريقة تدعم المعتقدات والافتراضات والتوقعات الموجودة مسبقاً لدى الفرد، بغض النظر عما إن كان ذلك عن قصد أو دون قصد). فقد دأبت لوري على ليِّ عنق كل حقيقة وتحوير كل واقع ومتوقع لخدمة نظريتها الخاصة بالمكيدة العراقية الخفية. وقد أصبح استيقانها من صحة نظريتها مطلقاً بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 مع تصاعد المخاطر بصورة حادة وبلوغها عنان السماء. وإذا كان ذلك كذلك، فلا مندوحة –إذن- عن النظر إلى نظريتها الأساسية بأنها معقولة ووجيهة، والنظر إليها هي بأنها محقة في ضوء تلك المخاطر. ولأجل هذا فهي جديرة بالمتابعة والاهتمام.
إلا أن لوري لم تكن محقة في واقع الأمر؛ كما أن استقصاء الصلات والارتباط بين العراق و”الجهاديين؟”، حال طرح الأمر على بساط البحث في وزارة الدفاع، أدى إلى تفريخ المزيد من الادعاءات والمزاعم التي لم تكن إطلاقاً قيد البحث أو موضوعاً للنقاش من قبل لوري، وليس هنالك أي تفصيل لطبيعتها وتعليل لكنهها أو أي دليل على صحتها؛ بل إنها أقل وجاهة ومعقولية وقابلية للتصديق، ومنها مثلاً: المزاعم المتعلقة بكعكة اليورانيوم الصفراء بالنيجر؛ والاجتماعات المزعومة في براغ بين عملاء عراقيين وعناصر “جهادية؟”؛ والقصص والحكايات المدرّة للدخل والمحققة للأموال، والتي تنم عن ضيق الأفق لدى رماة “الكرة المنحرفة (Curveball)” وقلة من المخبرين الآخرين، وما في حكم ذلك.
بيد أنه لا يستقيم عقلاً –ولن يكون من المنطقي البتة– أن يكون في وجود القليل من الدعاوى العجيبة والمزاعم الغريبة، مع خطاب أو خطابين من خطابات الغلو والتشدد التي درج ديك تشيني نائب الرئيس على إلقائها، ما يثبت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية كانوا يكذبون على طول الخط وفي جميع الأوقات، كما لو أنهم كانوا أعضاء في جمعية سرية شنيعة السلوك وشائنة السيرة، بخصوص المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. (يوجد المزيد عن ذلك في الجزء الرابع من هذه السلسلة من المقالات…).
كانت الحقيقة أكثر تعقيداً مما ورد أعلاه. أما المفتاح لفهمها، فهو يتمثل في الإقرار بأن ما حدث إنما كان في جوهره عبارة عن معركة وصراع داخل الدوائر الانتخابية للإدارة الأمريكية لخطب ود جورج ولكر بوش وكسب موقفه وتجييره لصالحها. وفي إطار تلك المعركة الحامية الوطيس الرامية إلى استمالة الرئيس وإقناعه باتخاذ قرار الحرب، عاجلاً وليس آجلاً، أصبح الطرح المنطقي المعقول أمراً يشوبه التخمين ويكتنفه الغموض ويعتريه الانحراف وتتخلله الروايات الملتوية ولا تنقصه الأفكار المُغْرِضَة.
أفضى ما تقدم أيضاً إلى بذل جهود لولا أن تم كبحها لأسفرت عن تكملة لفضيحة إيران –كونترا في أيام إدارة ريجان[1].
قصارى القول في هذا الصدد: إن عملية اتخاذ القرارات عالية المستوى من قبل الإدارة أصبحت أقرب ما تكون إلى الانحراف عن المسار والخروج عن السياق، لا سيما وأن الفترة الفاصلة بين أحداث سبتمبر (أيلول) 2001 واندلاع الحرب في مارس (آذار) 2003 امتدت لأكثر مما ينبغي، ولم يشأ أحد أن يقرع جرس الإنذار أو يطلق صافرة التحذيرات للحيلولة دون تحطم القطار من جراء خروجه من المسار. ففي نهاية المطاف يندرج ذلك أولاً وأخيراً ضمن مسؤولية الرئيس، ويقع تحت عاتقه وذلك عن جميع العاملين لديه في القسم التنفيذي العامل معه، طالما أنه هو (ونائب الرئيس الذي لا يُعوَّل عليه كثيراً) وحده مِنْ بين أفراد القسم التنفيذي مَنْ وصل إلى منصبه عن طريق الانتخاب. وهذا أمر ذو شأن وأهمية في الأنظمة الديمقرطية: ذلك أن السلطة والمسؤولية تخضعان لموافقة المحكومين –ممثَّلين في رئيس منتخب بطريقة صحيحة وسليمة. بيد أن تردد بوش وافتقاره إلى الحسم والحزم، وبصفة خاصة قلة خبرته –وهذا عامل آخر من العوامل التي لم يرد لها ذكر -تقريباً- في الروايات التقليدية –اجتمعت سوياً لتلعب دورها في هذا الخصوص.
قَدمَ جورج وولكر بوش إلى البيت الأبيض وهو تنقصه الخبرة في مجال اتخاذ القرارات الحكومية الاتحادية عالية المستوى خلافاً لوالده الذي كان عضواً في الكونجرس وسفيراً لدى الأمم المتحدة ومديراً لوكالة الاستخبارات المركزية ونائباً للرئيس ريجان. أما بوش الابن، فقد كان حاكماً لولاية تكساس، ولكنه لم يلتحق قط بالكونجرس ولم يشغل إطلاقاً أي منصب على أي مستوى في مجال مزاولة الأعمال البيروقراطية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمن الوطني. وكان من الطبيعي أن يتشكك بوش في ملَكاته ويرتاب في قدراته فيما يتعلق باتخاذ القرارات وإصدار الأحكام في المسائل التي يلزمه تدبُّر أمرها والبت فيها، وهو يقف في مواجهة شخصيات متنفذة من قبيل تشيني ورامسفيلد وباول. لا غرو -إذن- أن يلجأ بوش الابن إلى الارتجال عندما تكون المشورة التي يحصل عليها من كبار مستشاريه مختلفة بصورة حادة.
في واقع الحال، تم تكريس جزء كبير من وقت “كبار المسؤولين” وتخصيصه لجمع الأدلة المفترضة على وجود تهديد عراقي وشيك ومباشر، لإقناع بوش بخوض غمار الحرب بينما خُصِّص وقت قليل جداً للتخطيط الفعلي للحرب وعقابيلها. وكما هو معروف تماماً، عكفت وزارة الخارجية على إعداد الخطط التفصيلية المستفيضة للآثار السياسية والدبلوماسية العامة للحرب، بينما كان الكثيرون من كبار المسؤولين بوزارة الدفاع يرون أن تلك الجهود لا تنطوي على تحليل موضوعي، وإنما مجرد حيلة لا غير لإقناع الرئيس بوش “فقط لكي يقول لا”، على الأقل في الوقت الحالي.
من الواضح أيضاً أن المدنيين بوزارة الدفاع، وكذا العديد من منسوبي القوات النظامية كانوا يعتقدون أن عراقاً خاضعاً للعقوبات وبقدرات مستنزفة تماماً وقوات عسكرية مُنْهَكَة إلى أبعد الحدود، سيكون لقمة سائغة وخصماً ضعيفاً وستكون مهمة إخضاعه وكسر شوكته سهلة ويسيرة. لم يخطئ هؤلاء الأشخاص في قراءة التوازن العسكري وإنما وقعوا في خطأ أكبر: لقد كانت قراءتهم للدولة نفسها خاطئة.
لم يكن من باب الصدفة –إذن- أن تكون المعرفة عن العراق في الأوساط الحكومية الأمريكية ضعيفة وواهية وغير وافية. أما لماذا؟ فلأن العلاقات الدبلوماسية تم قطعها عام 1968 مع صعود حزب البعث إلى سدة الحكم بعد حرب يونيو (حزيران) 1967. ولأجل هذا وصلت المعرفة بالدولة العراقية وعملية الإلمام بأحوالها إلى طريق مسدود لدى مسؤولي العلاقات الخارجية والخدمات الأجنبية والعاملين في مجال الاستخبارات، لا سيما وأنه لم تكن هنالك أي بنود واضحة على قائمة المعروضات في ذلك المسار التخصصي. ظلت دولة العراق لسنوات عديدة بعيدة عن العين، حيث لم يكن هنالك أي مسؤول أمريكي بأي رتبة وفي أي مرتبة في زيارة للعراق في مهمة رسمية، وبذا أصبحت بعيدة عن البال. وهذه نقطة أخرى قلَّما تم التطرق إليها في الروايات التقليدية عن الحرب –هذا إن ورد لها ذكر أصلاً في تلك الروايات.
يوجد شخص واحد فقط متابع لمجريات الأمور في العراق بمكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية، وهو مكتب رائع على الرغم من أنه أصغر بكثير من أي من مرافق وكالة الاستخبارات المركزية والتجمعات الاستخباراتية الأخرى في الولايات المتحدة. أما الشخص المذكور أعلاه، فهو ستيف جرمُّون الذي كان على بعض الإلمام بالعراق. وأما أنا، وبما أنني سبق أن درَّست مادة السياسة الدولية للشرق الأوسط في جامعة بنسلفانيا (Penn) وكنت على إطلاع على كل شيء كُتِب باللغة الإنجليزية عن العراق، فإنني أعرف -على الأقل- مقدار ما يعرفه ستيف، مع أنني كنت مجرد محرر خطابات متعاون بقسم تخطيط السياسات بالوزارة!
وأسوأ ما في الأمر أنه يكاد لا يوجد أحد رفيع المستوى لديه اهتمام بالمجتمع أو التاريخ أو الخارطة العرقية أو الثقافية في العراق. وقتها، دفعني هذا النسيان المتعمّد وذلك التغافل المقصود إلى تذكُّر فيتنام، كما ذكَّرني بأهزوجة مقفاة شهيرة وقديمة منسوبة إلى هلير بيلوك (Hilaire Belloc) تذهب إلى ما مفاده: “مهما يحدث، حصلنا على الحد الأقصى من قوة النيران الساحقة، وهم لم يحصلوا” وبعبارة أخرى، قوتنا متفوقة إلى حد بعيد، ولذلك سيموت العدو –سيموت سريعاً- بغض النظر عن ثقافته أو تاريخه أو معتقداته. لذا فما الداعي لتكبد أي مشاق وتجشُّم أي عناء بشأنها؟
وثمة ملحوظة أخيرة حيال هذه النقطة تتمثل في أن وحدات الاستخبارات الأمريكية ظلت لفترة طويلة تتخذ موقفاً متحيزاً ضد المعلومات مفتوحة المصدر والمعلومات المستمَدَّة من مصادر عامة. وهذا أمر مفهوم بالنسبة لتشكيلات ووحدات على غرار وكالة الاستخبارات الدفاعية التي تتمثل مهمتها في معالجة المعلومات ذات الفائدة المباشرة والاستخدام قصير الأمد وقريب المدى للمحاربين في ميادين القتال، وفي التعامل مع تلك المعلومات الحساسة جمعاً ونشراً وتوزيعاً. أما بالنسبة لوكالة الاستخبارات الأمريكية، فهي أقل تحمُّلاً وتسامحاً مع هذا الأمر، وإلى حد بعيد. وعلى هذا فإن نوعية الأشياء التي نعرفها، أنا وغيري من العلماء –عن التاريخ والثقافة والأدب– ليس من الضروري أن تكون معروفة لدى محللي وكالة الاستخبارات المركزية، وليس بالضرورة أن يكونوا على كثير إلمام بها.
وعلى أي حال كانت خطة الحرب الفعلية، كما ظهرت وقتها، أقل بقليل من أن تكون ضرباً من التفاهات وصغائر الأمور: فهي تقوم على مفهوم “الصدمة والرعب (shock and awe) أو الهيمنة السريعة” في بداية الحرب لشل إرادة العراقيين في القتال وتدمير قدرتهم على رد الفعل، وقتل صدام مع زمرته من النظام البعثي، وتنصيب أحمد الجلبي وصغار تابعيه العائدين من المنفى بدلاً عنهم، ومن ثم المبادرة إلى الخروج حالاً من العراق ومغادرته بأسرع ما يمكن.
لم تمض الأمور على ما يرام، ولم تأت رياح الأحداث في العراق بما تشتهي سفن الأمريكيين، ولم يكن لها إطلاقاً أن تمضي على النحو المطلوب تحت أي ظروف يمكن تخيُّلها؛ ولم تكن هنالك أي خطة بديلة أو ما يُعرف بالخطة (ب). أما الدليل على غياب الخطة البديلة، فيكمن في حقيقة أنه لا توجد وكالة حكومية أمريكية لديها خطة أو ميزانية لاحتلال العراق لأمد متطاول. ولم يكن هنالك أي شخص يرغب في أي شيء من هذا القبيل؛ وينطبق هذا بالتأكيد على وزارة الخارجية والبيت الأبيض ووزارة الدفاع. أما المفارقة الكبرى في تلك الفوضى العارمة والمثيرة للشفقة في آنٍ معاً، فهي أنه، وعلى الرغم من كل شيء، انتهى بنا الأمر في نهاية المطاف إلى ما انتهينا إليه. لقد أقدمنا على بعثرة أوراق الدولة وتمزيق أوصالها وحل حزب البعث وتفكيك الجيش العراقي، مما أدى إلى إيجاد المعادلة المثالية لاندلاع انتفاضة، ووضعنا أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الوساطة في حرب أهلية بين أطراف لا يسعنا إلا اللجوء إلى الحدس والتخمين فيما يتعلق بمصالحها، كما أن علاقاتنا معها بين واهية ومعدومة؛ أو عدم التوسط في الحرب الأهلية وترك العراق يواجه مصيره المتمثل في الانهيار الداخلي وتهديد المنطقة برمّتها. ومن باب “مُكْرَهٌ أخاك لا بطل”، آثرنا الخيار الأول.
يُرجى السماح بملحوظة شخصية أخرى تقفز بنا وثباً إلى عام 2004، ولكنها تلقي الضوء ساطعاً على ضعف المعرفة المؤسسية لدى الحكومة الأمريكية عن العراق. من المؤكد أن الأشياء التي حدثت في أثناء الاحتلال فاجأت كبار المسؤولين وأخذتهم على حين غرّة. ولتوسيع دائرة المعرفة بمركز الاستخبارات والبحوث (INR) بوزارة الخارجية، حصلْتُ على إذن لعقد ورش عمل صغيرة من وقت لآخر في المبنى الرئيس (يقصد به المبنى الرئيس لوزارة الخارجية الكائن في الشارع الثاني والعشرين والشارع “ج” بالشمال الغربي) وهي ورش تضم خبراء من خارج الوزارة من العالمين ببواطن الأمور في العراق للمساعدة في ترسيخ الفهم العام، وأحياناً في مواضيع أكثر تحديداً.
أما المشاركون في تلك الورش فهم ليسوا جميعاً من المواطنين الأمريكيين. وبما أنه لم تكن هنالك معلومات مصنّفة تتعلق بهم، فقد طلبنا منهم عدم طرح تلك الجلسات للنقاش وعدم ذكرها على الملأ أمام العامة، ووعدناهم بأننا أيضاً لن نأتي على ذكرهم. فقد أردنا أن يشعر المشاركون بالأمان والطمأنينة بالقدر الذي يمكنهم من أن يكونوا صريحين معنا. وقد طرحنا سؤالاً محدداً لكل مجموعة دونما توضيح للأسباب التي قد تجعل السؤال منطوياً على التأثير السلبي على المعلومات الاستخباراتية؛ لكونه سؤالاً محملَّاً بمزيد من الإشارات الضمنية. وبعد ذلك كنت أقوم بتلخيص وقائع الجلسات وضبطها في محضر أقدمه لوزير الخارجية كولن باول.
كان أحد الأسئلة متعلقاً بالكمين الذي نُصِبَ لموكب في مدينة عراقية تدعى سامراء. بعد أن استعاد العراق سيادته على يد سلطة الائتلاف المؤقتة في الثلاثين من يونيو (حزيران) 2004، تعاونت الحكومة الأمريكية مع العراقيين في توزيع العملات الورقية الجديدة والطوابع البريدية والمستندات الرسمية الأخرى. وكان نقل الأموال والطوابع والمستندات الأخرى يتم في عربات مصفَّحة في قوافل ومواكب ترافقها وحدات صغيرة من مشاة البحرية وقوات المارينز الأمريكية. لم تقع أي حوادث للمواكب التي كانت متجهة إلى بغداد والبصرة والمدن والمواقع الأخرى، بما في ذلك تكريت. ولكن في سامراء تم نصب كمين، فكان رد الفعل متجاوزاً لكل الحدود من قبل المارينز الذين استخدموا القوة المفرطة وإطلاق النار بصورة وحشية وفظيعة على المدينة. لذلك كان السؤال هو: لماذا سامراء وليس أي مدينة عراقية أخرى؟ من الواضح أن الخبراء الأمريكيين، المدنيين والعسكرين على حد سواء، لم تكن لديهم إجابة عن السؤال.
كانت لديَّ معرفة محدودة للإجابة عن السؤال من واقع قراءتي للتاريخ العراقي، ولكن أعضاء لجنة الخبراء لدينا ظفروا بالإجابة في أقل من خمس دقائق –ذلك أن سامراء كانت عاصمة المحافظة الإقليمية التي يعود تاريخها إلى العهد العثماني، ولكن بعد أن استولى البعثيون على مقاليد السلطة أقدم صدام حسين على نقل العاصمة إلى مسقط رأسه في مدينة تكريت. ومع نقل العاصمة انتقلت معها العديد من الوظائف والكثير من الأموال التي غادرت مدينة سامراء؛ مما تسبب في إراقة الدماء التي سالت أنهاراً بين المجموعتين.
أما التكريتيون الذين كانوا ذات يوم مهيمنين على الحكومة العراقية ومسيطرين على الجيش العراقي، فقد أقاموا علاقات مختلطة محسوبة بالقلم والمسطرة مع أهالي سامراء. فقد عيَّن صدام بعض أبناء عمومته وأبناء أخواله السُّنِّيين لواءات في القوات النظامية وأعضاء في حزب البعث، ثم ما لبث أن أرسل بعضهم إلى حيث الرهن وراء القضبان وأردى آخرين منهم قتلى مع أعضاء آخرين اختيروا من بين أفراد العشيرة. وهكذا تمكن صدام من أن يجعل من يتحدَّوْنَه يقفون على أطراف أصابعهم في حالة دائمة من الترقب واليقظة والحذر. فإذا خرج أحد زعماء العشائر عن المسار المرسوم له وشق عصا الطاعة، أو إذا تخيّل صدام مجرد تخيل أن زعيم العشيرة المذكور أعلاه خرج عن المسار المرسوم ربما استناداً إلى وشاية أو لمجرد كذبة بلْقاء ذهبت بها الركبان نتيجة خصومة شخصية، لن يكون ذلك الزعيم في منأى من أن تؤخذ كريمته أو ابنة أخته أو ابنة أخيه سحباً إلى إحدى غرف الاغتصاب سيئة السمعة والصيت، والتابعة للنظام البعثي.
لا غرو -إذن- ولا غرابة أن تتردد سامراء وتتلكأ أيما تلكؤ في الانضمام إلى الانتفاضة التي هبّت في تكريت ضد الاحتلال الأمريكي. ولأجل هذا دخل التكريتيون في اقتتال بالأسلحة النارية في المدينة متوهِّمين أن المارينز سيستخدمون القوة المفرطة ويقتلون بعض أهل سامراء؛ وبذا يسحبونهم ويدفعونهم إلى القتال بحثاً عن الثأر والانتقام؛ وهذا ما حدث بالفعل، وعلى وجه الدقة والضبط.
بيت القصيد: كان أعضاء جهاز الاستخبارات الحكومي في حيرة من أمرهم إزاء استيعاب ما تقدم؛ لأنهم كانوا يفتقرون إلى الفهم الحدْسي وحضور البديهة والوعي الفِطْري (metis) إزاء فضائهم أو مضمارهم الخاص وفنائهم الداخلي –الاجتماعي والمادي على حد سواء. أما الأشخاص الذين استجلبتُهُمْ للمشاركة في ورش العمل، فقد كانت لديهم البديهة الحاضرة والوعي الفطري –قولاً واحداً.
وبالمقابل هذا هو السبب الذي دعاني إلى أن أقترح على وزارة الخارجية الاستعانة بخبير في مجال الإسلام السياسي، على أن يكون شخصاً يتمتع بنوع آخر من الذكاء الفطري والاتقاد الذهني وحضور البديهة، على غرار ما هو مطلوب بشدة في هذا الخصوص. يوجد في وزارة الخارجية أشخاص على إلمام جيد بالموضوع؛ منهم على سبيل المثال ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية، الذي ذهبْتُ إليه لمقابلته في مكتبه بالدور السادس فحدثني عن مسؤول علاقات خارجية (خدمة خارجية) يعمل في تونس، وهو خبير من النوع المنوَّه عنه أعلاه؛ وأشار بفطنة وكياسة إلى أن المشكلة تكمن في أن تلك ليست وظيفة محددة لأحد الموظفين؛ وفي بيئة بيروقراطية عندما تكون المهمة في أحد المجالات المثيرة للاهتمام ليست مهمة محددة لأي شخص محدد، فقد جرت العادة على ألا يتم إنجاز تلك المهمة بغض النظر عن الكفاءات والمواهب المتاحة.
حظيت الفكرة باستلطاف وزير الخارجية باول، ولذا أخبرني بأن أمضي قدماً في تنفيذها؛ فأجبته متشككاً في الأمر الذي أصدره حيث قلت له: “أتقصدني أنا يا سيدي؟” وأردفت قائلاً: “إنني مجرد محرر خطابات”. رد علي قائلاً وهو يبتسم: “فكرتك تقع على مسؤوليتك” ثم تحول إلى المهام الأخرى المنوطة به. هذه هي الكيفية التي أحضرت بها أحمد الرحيم إلى وزارة الخارجية؛ وهو خبير في الفلسفة الإسلامية في العصور الوسطى، ومن مواليد العراق وأمضى سنوات عديدة في لبنان. استغرق الأمن الدبلوماسي أكثر من ستة أشهر لاستصدار التصريح الأمني لأحمد لتمكينه من العمل في وزارة الخارجية، على الرغم من أن لديه تصريحاً أمنياً مؤقتاً من وزارة الدفاع؛ وربما كان غياب التنسيق في استخراج التصاريح الأمنية بين الوكالات الحكومية قصة أخرى حريٌّ بنا أن نرويها في وقت آخر؛ ولكنه في نهاية المطاف التحق بالعمل وأنجز العديد من المهام بطريقة جيدة.
كان الوزير رامسفيلد يرى أن في الحملة الأفغانية ما يثبت صحة رؤيته المتمثلة في إيجاد طريقة أمريكية لخوض الحروب بقوات أصغر حجماً وأكثر رشاقة وأقل تكلفة (بحيث يكون من الأسهل أن تتم استدامتها سياسياً) وأشد تنكيلاً وفتكاً بالعدو. وفي واقع الحال، أفضت جهوده الرامية إلى إصلاح وزارة الدفاع قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) إلى تنفير العديد من الضباط الكبار والمسؤولين رفيعي المستوى وتزهيدهم في مناصبهم، حتى إن منصبه هو نفسه أصبح في مهب الريح. إلا أنه بعد القوات الأمريكية (426) –التي كان بعضها مزوداً بأجهزة توجيه بالليزر أو مؤشرات ليزر (تضخيم الضوء بانبعاث الإشعاع المحفز أو المنبعث) وهي أجهزة محمولة على صهوات الخيول لتوجيه قوة النيران الأمريكية!– مع حلفاء محليين فعّالين ومؤثرين للغاية على غرار التحالف الشمالي بقيادة أحمد شاه مسعود، أدت المهمة المطلوبة على الوجه المطلوب في أفغانستان، اختال رامسفيلد مزهواً مبتهجاً منتفخ الأوداج واثق الخطى وهو يبحث عن الفرصة التالية لإثبات صحة رؤيته. فهو يرى أن أحمد الجلبي يمثل الحلف الشمالي في العراق؛ وأن الصدمة والرعب هي الخطوة المكملة للضربة الساحقة التي وُجِّهَتْ إلى طالبان. لم يمعن رامسفيلد النظر في التفاصيل.
عندما سعى الوزير باول وآخرون إلى إثبات ما تنطوي عليه المقارنة من خطل وخديعة، لم يسفر سعيهم إلا عن تأجيج العداوة الموجودة أصلاً مع وزارة الدفاع، وإلى خروجهم من دائرة صنع القرار. وعندما ذهب ريتشارد هاس مدير تخطيط السياسات وقتها للاجتماع مع كونداليزا رايس بناءً على تعليمات باول؛ لأجل تمحيص الشائعات التي وصلت إلى أسماعه بخصوص العراق، ألجمت كونداليزا هاس وألقمته حجراً حتى قبل أن يفتح فمه، حيث قالت له: “وفِّر عليك جهودك يا ريتشارد. لقد تم بالفعل اتخاذ القرار بخوض الحرب”. بعبارة أخرى، اتُّخِذَ قرار خوض غمار الحرب دون اجتماع لجنة كبار المسؤولين (Principals’ Committee). فقد تمكن الممالئون والمؤيدون لقرار خوض الحرب من إقناع بوش في نهاية المطاف للمضي قدماً في الدخول في الحرب؛ ولكن بوش “صاحب القرار” افتقد الحزم وافتقر إلى الجرأة لإخطار وزير خارجيته وجهاً لوجه.
في هذه المرحلة، كان لا بد من أن يتخذ باول قراراً: إما أن يستقيل من منصبه، أو يبقى فيه ثم يسعى جاهداً لتوجيه القرار الخاص بالحرب، بحيث يصب في المسارات التي من شأنها أن تفضي -على الأرجح- إلى الخروج بأخف الأضرار وأقل الخسائر. قرر باول أنه إذا استقال قد يكون وولفويتز بديله على الأغلب؛ وهو لا يرى كيف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تخفيف وطأة الأوضاع وتلطيف غلوائها. من المؤكد أن وولفويتز كان يرغب في أن يتبوأ منصب وزير الخارجية. ففي أثناء المداولات ومجريات الأمور وما حدث من أخذ ورد في الفترة الانتقالية، كان من المزمع أن يتم تعيين وولفويتز في بادئ الأمر ليكون نائباً للوزير باول بينما يتم تعيين ريتشارد آرميتاج ليكون نائباً لرامسفيلد؛ ولكن باول لم يكن متحمساً لتعيين وولفويتز بسبب اختلافات قديمة بينهما، ولأجل هذا اختار صديقه آرميتاج نائباً له لعلمه بأن آرميتاج يستطيع بالفعل مباشرة الشأن الإداري لشبكة بيروقراطية واسعة النطاق، وأن من الوارد ألا يستطيع وولفويتز القيام بذلك.
أثبت وولفويتز صحة ما ذهب إليه باول، وذلك عندما عمل وولفويتز في وزارة الدفاع، حيث كان من دأبه أن ينزع دائماً إلى الاهتمام بالسياسة أكثر بكثير من اهتمامه بالإدارة، وهي المسؤولية الرئيسة لنائب الوزير درجاً على ما جرت به العادة من الناحية التقليدية. وهذا راقَ لي أنا أيضاً –ذلك أن بول كان عميد الكليّة التي عملت بها عندما كنت محاضراً في كليَّة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز في منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث كان من الواضح وقتها لجميع المهتمين والمعنيين أن الإدارة ليست من مجالات اهتمامه. لقد كنا ذات يوم نتجاذب أطراف الحديث في مكتبه –هو وأنا فقط– فقلت له: إنه قد يصبح في يوم من الأيام مديراً لوكالة الاستخبارات المركزية أو وزيراً للدفاع؛ فردّ عليَّ بهدوء ولطف وهو يضع ذراعيه على جنبيه رافعاً كفيه إلى أعلى: “ولكن لماذا ليس وزيراً للخارجية؟”
وعليه تحدث باول مع بوش في مقر إقامته وأخبره بأنه سيظل مرابطاً معه ومرتبطاً به -شريطة أن يسمح له بوش بمحاولة تدويل الجهود، وتكوين ائتلاف أو تحالف يكون بقدر الإمكان على غرار الائتلاف أو التحالف متعدد الأطراف، الذي خاض معركة عاصفة الصحراء وكسبها عام 1991 عندما كان والده رئيساً للولايات المتحدة. كان باول يريد أن يحد من الأضرار الدبلوماسية داخل هيكل التحالف، ولذلك فقد كان باول –خلافاً لآخرين– يضع دائماً الاستراتيجية الأمريكية الكبرى وسلامة أدواتها وأذرعها الرئيسة نُصب عينيه. وافق بوش على طرح باول.
استصدر باول قراراً من مجلس الأمن بالأمم المتحدة هو القرار رقم (1441) الذي وفَّر المبررات للعمل العسكري وفقاً للقانون الداخلي. وكان ذلك كافياً أو ينبغي أن يكون كافياً -بيد أن آخرين في مجلس الأمن كانوا مصرّين على صدور قرار تنشيطي ثان من المجلس. فكّر باول في الحصول على القرار الثاني بحيث يكون مرتباً له بطريقة جيدة، إلى أن تم تثبيطه في آخر لحظة من قبل وزير الخارجية الفرنسي دومينيك فيلبان. على الرغم من أن القرار الثاني لم يكن ضرورياً حسب الاصطلاح القانوني الصارم، فإن حقيقة الفشل في صدوره حملت في ثناياها تأثيراً قوياً حسب الاصطلاح السياسي.
على الرغم من أنني كنت شخصية هامشية صغيرة جداً، حاولت بطريقتي الخاصة أن أسهم في جهود تدويل الحرب للحد من الأضرار التي نجمت عنها. وفي تلك المرحلة تقدمت للوزير باول بتوصية مفادها أن نموذج “العمل الخيري” لإعادة إعمار العراق، المقرر له أن يكون مطروحاً في مؤتمر المانحين المزمع عقده في سبتمبر (أيلول) 2003 في مدريد، ينبغي أن يتم تبديله أو ضمه إلى نموذج “شركة مساهمة”.
وقد جادلت بأن مؤتمرات المانحين المذكورة أعلاه لم تسفر إطلاقاً عن توفير الدعم أو تقديم العون الذي تم التعهد به، ولم ينجم عنها أي اهتمام جاد بمدى التقدم في سير الأعمال؛ ولكن يمكن تحقيق الأفضل من ذلك بكثير من خلال إعطاء الشركات والحكومات الأوروبية والآسيوية حصة مالية ونصيباً في كعكة إعادة تعمير العراق عن طريق القروض التي يمكن سدادها بمعدلات سعر فائدة تنافسية من إيرادات النفط المستقبلية في العراق –فضلاً عن العقود المغرية لرجال الأعمال والشركات الأوروبية والآسيوية، لتنفيذ الكثير من الأعمال على الأرض.
كان باول متفهماً ومتفاهماً، ولكنه قال لي: إنه “فات الأوان على قلب الأمور رأساً على عقب”. وعلى رأس ذلك، صدر إعلان من وولفويتز، على حين غرة ودونما سابق إنذار حسب علمنا، بأن العقود الخاصة بإعادة إعمار العراق لن تُمنح للدول التي عارضت سياسة الولايات المتحدة في العراق. لن يتطلب الأمر كثيراً من الخيال لتصوير رد الفعل في المبنى الكائن بالشارع الثاني والعشرين والشارع (ج) [مبنى وزارة الخارجية].
وفي غضون ذلك، درج رامسفيلد على التحدث رجماً بالغيب عن العراق في اجتماعات لجنة كبار المسؤولين. ولم يَعُد يهتم بالعراق أكثر من اهتمامه بالترويج للديمقراطية. وكان اهتمامه منصبّاً على قوة أمريكا وسمعتها وكيفية تطويرهما. وكانت تلك هي مهمته كما يراها؛ إذ لم تكن مهمته إخطار الرئيس بما ينبغي عليه القيام به. ولهذا السبب أشاد بوش في مذكراته برامسفيلد وأسبغ عليه عبارات الإطراء والثناء لاحترامه تسلسل القيادة والأوامر[2]. لم يورد بوش ملاحظات مماثلة عن تشيني نائب الرئيس؛ والقارئ الحصيف لا يفوت عليه فحوى ذلك.
كانت العراق فرصة، وليست قضية، بالنسبة لرامسفيلد. وقد ساند تشيني في جهوده لإقناع الرئيس بالدخول في الحرب لأن تشيني كان نصيره ومحاميه وحاميه في الإدارة. ففي واقع الأمر كان رامسفيلد هو أول من عيّن تشيني في الجهاز التنفيذي في أثناء إدارة نيكسون، وكان رامسفيلد وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس فورد قبل أن يشغل تشيني هذا المنصب في إدارة بوش وولكر بوش.
هذا ما كنت أرمي إليه عندما تحدثت سابقاً عن سلطة الشخصيات وعلاقاتهم، وعن كيفية تفاعلهم في الحكومة خلال الأزمات وغيرها. بيد أن رامسفيلد رفض أن تتورط القوات العسكرية الأمريكية في العراق. فقد رفض -على سبيل المثال- توريط وزارة الدفاع وإدخالها في مأزق استجواب السجناء والتحقيق معهم على الرغم من وجود القدرات اللازمة، ممثلةً في الشرطة العسكرية ونظام السجون (توجد مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص في الجزء الخامس). رفض رامسفيلد دعم قوة برية أكبر حجماً لمباشرة العمليات الأرضية؛ ولذا ظل يقاوم لفترة طويلة فكرة وجود تمرد فيما كان جارياً على أرض الواقع، واصفاً إياه بأنه مجرد نشاط لبعض من كانوا يناصرون نظام البعث العراقي حتى الرمق الأخير، والذين يتعين سحقهم والتخلص منهم. وعندما أرسل الجنرال جاي جارنر إلى العراق بعد نهاية مرحلة المقاومة الأولية التي استمرت لفترة وجيزة، أمرَه بالدخول والخروج بصورة متكررة خلال سبعة أسابيع؛ وكان يعني ما يقول.
عندما أصبح بول بريمير رئيساً لسلطة الائتلاف الانتقالية، وقصقصت الحكومة الأمريكية أجنحة السيادة العراقية وقصمت ظهرها برعونة وغباء، صدرت له الأوامر بأن يكون تابعاً لكل من رامسفيلد والرئيس؛ إلا أن رامسفيلد لم يكن راغباً في واقع الأمر في التحدث معه، وبذا أزاح رامسفيلد عن كاهله عبء الورطة المعقدة وألقى بها على عاتق البيت الأبيض. وهكذا مضى رامسفيلد قدماً مع تشيني وولفويتز والآخرين في مشوار الدخول في الحرب، ولكنه أمر قادة جيشه بأن تكون حرباً سريعة وخفيفة و”نظيفة” وخاطفة –تماماً كتلك التي دارت رحاها في أفغانستان. عندما تعثرت تلك الخطة وتهاوت أركانها، نقل إلى الآخرين المسؤولية عن كل عيب ونقيصة فيما كان يحدث، ورمى إليهم بتلك المسؤولية؛ ومن بينهم باول وآرتيماج بوزارة الخارجية.
وكما أُثير من قبْل في الجزء الثاني من هذه السلسلة من المقالات، فإن أحد مبررات الحرب العراقية –المتمثل في نقل العراق من خانة العدو إلى منزلة الوكيل لأجل الضغط على إيران من الجانبين ووضعها بين المطرقة والسندان- لم يتم قط التصريح عنه علناً وعلى رؤوس الأشهاد. أما المفارقة المحزنة، فهي أن هذا المبرر، وهو مبرر مقنع ومفحم ولكنه طموح للغاية، كان سيتصادم مباشرةً مع رؤية رامسفيلد، لو أنه حظي بمزيد من الاهتمام أو شغل حيزاً أكبر في أذهان كبار المسؤولين وفي عملية التخطيط.
ولعل من دواعي الحسرة أننا لن نعرف إطلاقاً ماذا كان سيحدث لو أن الولايات المتحدة سعت إلى البحث عن الجائزة (the brass ring) في العراق، أو بعبارة أخرى البحث عن الجائزة الكبرى (the Big Snow). بدلاً عن ذلك، مضت مجريات حرب العراق قدماً كمأزق اعترته الأخطاء العملياتية سعياً وراء أهداف أقل طموحاً، وبجدول زمني تم تكريسه ليس لمواجهة المهدِّدات الفعلية وإنما لخدمة الأجندة والروزنامة السياسية الأمريكية، عبر عملية قرارات داخلية كانت بمثابة مثال نموذجي لكيفية عدم اتخاذ القرارات الكبرى والرئيسة؛ وقد شابها الإخفاق الاستخباراتي الذريع ليس لمرة واحدة، وإنما لمرتين ألقيتا بسدولهما وظلالهما القاتمة على السياسة بأكملها.
أهُما إخفاقان استخباراتيان ذريعان وليسا إخفاقاً واحداً فقط؟ ما هما هذان الإخفاقان إذن؟ سنرى في المرة القادمة… يرجى التحلي بالصبر.
* آدام جارفينكل: كاتب عمود لدى مركز المسبار، كما أنه عضو بهيئة تحرير مجلة “أمريكان بيربوس (American Purpose)” في واشنطن. عمل خلال الفترة من 2003 إلى 2005 كاتباً لخطابات وزير الخارجية –ملتحقاً بمجموعة تخطيط السياسات بالوزارة.
[1]– انظر مذكرات جورج تينيت “في قلب العاصفة” [At the Center of the Storm] (HarperCollins, 2007) ص311-314.
[2]– بوش، نقاط القرار (كراون، 2010)، ص92.