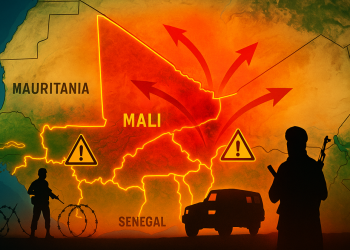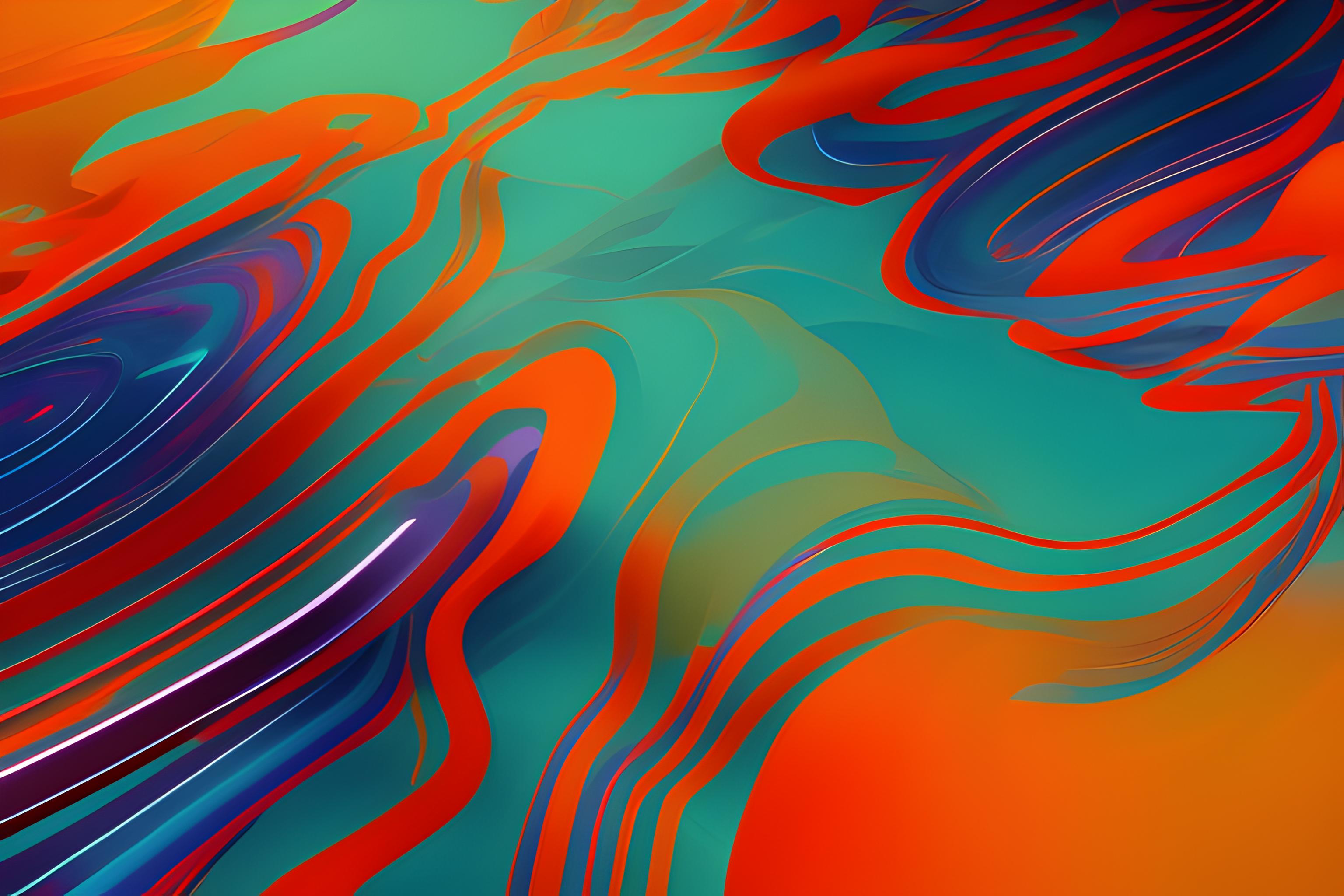مضى وقت طويل على الخرافة (myth) الأمريكية والغربية والدولية، أو “الأسطورة المدنية (urban legend)”، التي تذهب إلى أن إدارة جورج بوش الابن –الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة– كَذَبَتْ بشأن وجود كميات متكدسة من أسلحة الدمار الشامل وبرامجها في العراق؛ لأجل تبرير الحرب ضد نظام صدام حسين البعثي. من المؤكد أن تلك الخرافة متأصلة وراسخة في أدبيات اليسار الأمريكي؛ إذ إن التعبير عن الشك أو تأكيده بخصوصها يعد ضرباً من هرطقات العلمانية وترهاتها. يفترض أيضاً أن يكون الأمر كذلك في كل مكان في أوروبا وغيرها، أينما سادت معاداة أمريكا كأمر اعتيادي ومألوف.
لا يهم وجود أي قدر من الأدلة الفعلية التي تثبت العكس، مما يدل مرة أخرى على صحة فحوى القول المأثور: إن الحزبية تورث الغباء والأيديولوجية تورث الخبال. أما عندما يتصادم الواقع مع الأيديولوجية، فيكون الأسوأ -إلى حد بعيد- من نصيب الواقع في أغلب الأحيان؛ وهذا صحيح على الرغم من حقيقة ما عبّر عنه مؤلف روايات الخيال العلمي جيروم ديك (Jerome Dick)، عندما قال ذات مرة: إن “الواقع هو ذلك الشيء الذي لا يختفي عندما تتوقف عن الإيمان به”.
في هذه الأوقات –أوقات ما بعد الحداثة– هنا في اليمين حالياً كما في اليسار، حيث يختلق الإحساس الذاتي (أرجو المعـذرة على استخدام هذا التعـــــبير) دليلاً واقعـــــياً، فإن ما حدث بالفعل فيما يتــــعلق بملف أسلحة الدمــار الشامل في العراق وما يمــــكن إثبــــــاته عمليــــــاً، والذي يتـلخص في أنه جمْعٌ بين الخطأ وعدم الصواب وبعض الغلو في الخطاب –لا الكذب المتعمّد– يصبح “نسخة” من الحقيقة؛ وهي نسخة ليست أصدق من غيرها. لذا لا يهم أنه ما من أحد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية أو في الحكومة البريطانية يوافق على هذه الأسطورة المدنية في يوم الناس هذا، أياً كان رأيهم، الآن أو حينها، عن الحرب في حد ذاتها. لقد كانوا هناك وقتها، وعايشوا تفاصيل التجربة؛ ويعلمون أنها محض زيف. [سنأتي بعد لحظات إلى ما يعرفونه بعد أن تهيّأ السياق اللازم].
لحظة ما بعد الحداثة:
يكاد لا يوجد أحد يرفع حاجبيه مغلقاً فمه متعجباً أو يفغر فاه رافعاً حاجبيه مندهشاً، بعد حوالي عقديْن من الزمن، من أن متحدثاً –على سبيل المثال- باسم معهد كليرمونت بكاليفورنيا، الذي كان ذات يوم محافظاً ولكنه أصبح اليوم سريالياً، يدَّعي أن “الكذبة الكبرى أو الكذبة البلقاء” عن انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عبارة عن “نسخة من الحقيقة”
أو أن كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قالت لأحد الطلاب في إحدى المناسبات عامة التي أقيمت أخيراً: إن حديثها الصاخب ضد إسرائيل (وبصورة ثانوية عن المملكة العربية السعودية) لا ينبغي بأي حـال قمْعه وكبـْته أو “إلغـــاؤه” لأنــه “يمثّل الحقيـــــقة كمــــا تـــــراها”.
فالأمر من أوله إلى آخره متعلق بتحيز كل فرد لحزبه أو تحزُّبه لجماعته أو انحيازه “لقبيلته”. أما الأكاذيب، فأغلب الظن أنها تثير الدهشة في الوقت الحالي في أوساط الحزبيين مفْرطي التعصب: ذلك أنك إذا نظرتَ إلى المحافظين بعين الاستخفاف والاحتقار، يكون معهد كليرمونت عندئذٍ مخطئاً ومرتكباً جُرْم التشويش الشنيع والتشويه الفظيع. أما إذا كنتَ على النقيض من ذلك، تكنّ الكرْه لإدارة بايدن -هاريس لافتراض كونها اشتراكية أو حتى شيوعية، تصبح الإفادة التي أدلت بها نائبة الرئيس بمثابة الصورة المصغرة للحماقة “الكبرى”. وأما أولئك القلة من المثابرين الذين دأبوا على الدفاع عن الحقيقة في حد ذاتها ولأجل جوهرها النفيس، والمحشورين في منطقة وسطى موحشة على ساحة المشهد العام، فقد أصبحوا متعودين تماماً على حملات الرياء والافتراء والنفاق والافتئات، على نحو يحول دون انخداعهم بمظاهر الألم والمناظر المؤسفة.
يرجى أيضاً ملاحظة أن المعنى المباشر الواضح للكلمات السهلة البسيطة أصبح مطروقاً بصورة غريبة في السياق الثقافي الأمريكي الحالي. دعونا نتساءل: ما المذهب المحافظ أو الاشتراكي؟ ولكي يكون سؤالنا وثيق الصلة بموضوعنا في هذا المقام، ما الكذبة؟ إنها كل ما يقوله عضو الحزب، أياً كان ما يتفوَّه به، ويمكنه أن يستميل به الآخرين من السذّج سريعي التصديق، وأن يقنعهم بأن ما يقوله حق وصدق؛ أو على الأقل يزعم أنه يصْدُقهم القول ويزعمون أنهم يصَدِّقونه فيما يقول.
أما الدوافع لتلفيق الأكاذيب وتصديقها في آنٍ معاً، فهي متفاوتة ومتعددة ومتنوعة؛ إذ يتمثل الدافع لدى البعض في مجرد أن يكونوا جزءاً من إحدى الجماعات، ومن ثم فهُمْ سيصدِّقون أيَّ شيء يقال لهم لكي ينضمّوا إلى الجماعة، أو لكي يبقوا فيها إن كانوا أصلاً منضوين تحت لوائها –ذلك أن تصديق كل ما هو بعيد الاحتمال وليس في وارد الحدوث وغير مرجّح الصحة في الأوضاع والخلفيات المتعلقة بإحدى الجماعات، إنما يساعد بحق وحقيقة على تماسك تلك الجماعة. ولعل هذا ما يفهمه أي شخص فكَّر بالفعل من قبل في علم النفس الاجتماعي الخاص بسلوك القطيع (أو غريزة القطيع لدى الجماهير)؛ حيث يرتبط هذا الدافع ارتباطاً وثيقاً بالظاهرة الحالية المتمثلة في نظرية “كيو أنون QAnon) ” ( وهي نظرية مؤامرة من ابتداع اليمين الأمريكي المتطرّف تتناول بالتفصيل خطّة سرية مزعومة لما يُسمّى “الدولة العميقة في الولايات المتحدة” ضدّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأنصاره.
يُصنَّف بعض الناس ويَتَّصِفون بأنهم من الدهماء والغوغائيين بطبعهم وطبيعتهم. هؤلاء هم الرعاع من الناس، الذين يؤمنون بأن استخدام اللغة بطريقة انتهازية ووصولية من شأنه حماية الحقائق “العليا” حتى وإن كان سيلغي الحقيقيَّ منها. يوصف هؤلاء وأمثالهم أيضاً بأنهم حثالة القوم وأرذلهم من السفلة الأوغاد وأهل الدناءة وقلة المروءة.
يعتقد البعض أن جميع المسؤولين الحكوميين والسياسيين كَذَبَةٌ كأمر طبيعي مفروغ منه ولا مراء فيه، وأنهم عن بكرة أبيهم يكذبون كما يتنفَّسون؛ وأن من المؤكد بطبيعة الحال أن بوش كذَّاب أشِر فيما يتصل بأسلحة الدمار الشامل بالعراق. وقد عبّر جورج أورويل (George Orwell) عما تقدَّم بشكل أفضل، وإن كان على نحو موغل في الغلو على الطريقة البريطانية، عندما قال: إن “اللغة السياسية (وينطبق هذا -مع بعض أوجه التفاوت– على كل ألوان الطيف السياسي بجميع أحزابه السياسية، من المحافظين إلى الفوضويين) صُمِّمت كي تجعل الأكاذيب تلبس ثوب الحقائق، وكي تقتل ما هو جدير بالاحترام، وكي تجعل جزيئات الهواء الصرف تكتسب قوام الجوامد الصلب” أي تجعل العدم يقوم مقام الوجود.
صحيح أن لغة السياسة تعرف العديد من الطرق للتعبير عن حقيقة أو تغييب أخرى والتهرب من ذكرها. وفي هذا الصدد، حريٌّ بنا أن نقول: إنه في بعض الأحيان قد يكون التغاضي عن ذكر الحقيقة، والتلاعب بالفوارق الدقيقة التي لا تكاد تُدْرَك، من الأمور المبررة، أو المفهومة على أقل تقدير، حتى في سياق السجال السياسي في الأنظمة الديمقراطية. وصحيح أيضاً أن الأمريكيين من دأبهم دائماً وأبداً النزوع نحو عدم الثقة في سلطة الدولة، بحيث يقل منسوب تلك الثقة كلما كانت تلك السلطة أكثر نزوعاً نحو المركزية أو أقرب إلى مستوى الحكم الاتحادي.
بيد أن التحيز المتمثل في أن الحكومة الأمريكية، على أقل تقدير، تكذب، كأمر طبيعي مفروغ منه، على مواطنيها كما تكذب على السلطات الأجنبية سواءً بسواء، ما هو إلا تحيز متحامل تعززه “ميمات” الترفيه الجماهيري الصاخب، وليس توصيفاً دقيقاً للواقع. (ميمات “memes” تعني، فيما تعني، وحدات المعلومات الثقافية التي تتحكم في السلوك، والتي يمكن نقلها من عقل لآخر بطريقة مشابهة لانتقال الجينات /المورثات من فرد لآخر؛ وهي عبارة عن مصطلح صكَّه البيولوجي ريتشارد داوكنز عام 1976. وتشمل الأمثلة التي ساقها داوكنز كلاً من فنون التمثيل الإيمائي والنغمات والعبارات الملتقطة في الشارع والمعتقدات وأنماط اللبس وطرق البناء وصناعة الأقواس في البناء المعماري ونحو ذلك). ما قيل إذاً لم يكن كَذِباً بواحاً لأن مَنْ زعموه كانوا يعتقدون أنه صدْق بالفعل، تماماً كما أنَّ أطفال النصارى الأمريكيين يصدِّقون أسطورة “بابا نويل” أو “سانتا كلوز” (وهي أسطورة خرافية من نسج الخيال، ألَّفها الكبار فصدّقها الصغار). إلا أن الجملة المعترضة المؤلمة في هذا السياق لفترة الشغور الرئاسي المتوقعة بعد حكم ترامب، هي أن الأمر يظل غير صحيح في الغالب الأعم.
لعل من المهم التنويه بأن الناس صاروا في جميع الأحوال تقريباً ميّالين إلى تفضيل الثقة وتغليبها على الحق والصدق. لقد ظل البقاء على قيد الوجود معتمداً على الثقة في السلطة الاجتماعية بحيث يصبح الدفاع الجماعي، أو الدفاع عن الجماعة، أمراً ممكناً مع الأخذ بجميع العوامل والظروف ذات العلاقة في الحسبان. أما الثقة، فتتمثل فيما تقوله النخبة الموثوق بها، أياً كان الذي تقول. وتصبح الثقة أمراً لازماً وملازماً في العلاقات الاجتماعية، بحيث يمارسها جميع الأفراد تقريباً، ويصبحون جميعاً بارعين في تفسيرها عندما يبلغون سن الرشد؛ في حين أن الحق أو الصدق عبارة عن مفهوم مجرد، بحيث إن بعض الذين يصبحون على إلمام ووعي باللغة الاصطلاحية المتعلقة بالمفاهيم هم فقط مَنْ يتعلمون كيفية التعامل معه. وأما الوقائع والحقائق على مختـــــلف المستــــــويات –مما هو إجــــابة صحيـــــحة بخصـوص حل مســــائل الجبـــر ووصولاً، دعنا نقل، إلى ما هو صواب بخصوص العدالة الاجتماعية– فيمكن أن تكون طوع تلك الاعتبارات أو يتم تطويعها وفقاً للاعتبارات آنفة الذكر، وبصفة خاصة عندما تجتمع العاطفة المتقدة مع ديناميكيات الجماعة لتلوي أعناق تلك الحقائق والوقائع.
لم تكن ويلات ما بعد الحداثة وشرورها متطورة قبل عشرين عاماً كتطوُّرها في يوم الناس هذا؛ إذ أفضت الكذبة “الترامبية” البلقاء -أو كذبة ترامب الكبرى- بشأن انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى إعادة تعريف الحزب الجمهوري؛ وهي الكذبة التي كانت ضرورية لتبرير الخطة القانونية الزائفة للتعديل الثاني عشر في الدستور الأمريكي لأجل إبطال نتائج التصويت، حيث احتوى ذلك على “البلطجة” الواضحة والفوضى العارمة التي ضربت بأطنابها عند اجتياح مبنى الكابيتول (المقر الرئيس للسلطة التشريعية الاتحادية/الكونغرس) في اليوم السادس من شهر يناير (كانون الثاني). عندما يعتقد الناس أنهم أصبحوا أقليّة سكانية صغرى في ديمقراطية انتخابية كبرى، سيعمد البعض منهم إلى ممارسة التضام والتكتل مع التخفي والاستتار على النحو الذي يرقى إلى حكم الأقليّة. ولأجل هذا أصبح الحزب الجمهوري حزباً غير ديمقراطي، وبات مناوئاً للديمقراطية بحكم واقع الحال، حيث كرس جهوده وسخّر موارده للدفاع عن هوية النصرانيين البيض وصلاحياتهم وامتيازاتهم؛ ولأجل هذا أذِنَ الحزب لنفسه باستخدام أي وسائل يراها ضرورية لبلوغ غاياته.
أما اليسار “المرتبك،” فلم يكن أقل جنوحاً في الخيال واستغراقاً في الأوهام من حيث طريقة استخدام اللغة؛ ولذا يعمد إلى التكييف “الغائي” لما يرى أنه الحق والصدق. فقد أصبح اليسار كما اليمين الأقصى سواء بسواء من حيث التوجه ذي المحصلة الصفرية في سياق الثقافة السياسية ذات الحصيلة الإيجابية للحركة التحررية التقليدية التي تمثل أرفع تعبير سياسي، أو قُلْ أسمى التجليات السياسية، لحداثة التنوير. كلا اليسار واليمين إذاً أضحى مشغولاً باعتصار الحياة لإخراجها قسراً من الحداثة التنويرية. لقد تطرقْتُ في موضع آخر للأسباب التي أفضت إلى حدوث ذلك؛ ولهذا لن أكرر هنا ما طرحته سابقاً[1]، إلا أنه عند طرفي النقيض على الطيف السياسي الذي يتخذ شكل حدْوة الفرس أو نعل الحصان، يكون استخدام اللغة على غرار ما يفعله المحامون المتمرسون الذين يترافعون أمام المحاكم: تُستخْدَم اللغة لأغراض غائية (من باب أن الغاية تبرر الوسيلة) بغض النظر عن جميع البراهين والبينات والوقائع والحقائق.
نعيش في أمريكا الآن، على الأقل من الناحية السياسية، في عالم ما بعد الحقيقة، في عالم يشهد تنافساً حامي الوطيس بين الهراء والخواء (أستمحيكم العذر على استخدام اللغة الوصفية الناطقة). وقد لخص هاري فرانكفورت هذا الأمر في كتابه الذي صدر عام 2005 بعنوان “عن الهراء (On Bullshit)”، حيث قال:
عندما يتحدث رجل صادق وأمين، فهو لا يقول إلا ما يرى أنه حق وصدق. وبالنسبة للكاذب، لا مندوحة له بالمقابل من أن يرى أن إفاداته زائفة وأن قوله زور. أما بالنسبة لمن يتعمَّد قول الهراء وسقط القول متجاوزاً مرحلة الكذب (بولشيتر “bullshitter“)، فتسقط عنده كل تلك الرهانات؛ فلا هو بالصادق ولا هو بالكاذب؛ ولا تكون عيناه متجهتين صوب الحقائق على الإطلاق -كشأن الرجل الصادق الذي يضع الحقائق نصب عينيه، وكذا الكاذب الأفاك-إلا بالقدر الذي تكون عنده تلك الحقائق وثيقة الصلة بمصلحته في الحصول على ما يروم مما يقول. فهو لا يهتم بما إذا كانت أم لم تكن الأشياء التي يقولها تصف الواقع بصورة صحيحة؛ وإنما فقط يلتقط منها أو ينتقي ما يخدم أغراضه.
ما كان ناقصاً وبدائياً قبل سبعة عشر عاماً أصبح في الوقت الحاضر مكتملاً ومزدهراً ومزهراً كامل الإزهار، ومحنة إدارة ترامب خير شاهد على هذا؛ فهي توضحه وتلقي عليه الضوء. ومع ذبول أوراق المعرفة العميقة[2] وازدهار التعصب الحزبي الشديد في خضم لحظة شعوبية تتساوى فيها جميع الآراء، من حيث الصحة بغض النظر عن قيام الدليل عليها أو غيابه، أصبحت الثقافة السياسية الأمريكية غارقة في الهراء (بولشيت) حتى أذنيها. ومن ثم فما جرت عليه العادة بأن ينظر إليه بأنه “أسطورة مدنية”، هشة الأساس وقابلة للمشاحّة والطعن، عن أسلحة الدمار الشامل في العراق عام 2003-4 أصبحت متأصلة ضاربة الجذور، فيما يرى العديد من الناس أنه حقيقة أمسى محوها واستئصالها ضرباً من المحال في الوقت الحالي.
لقد أصبح من المتعذر تماماً إصلاح ما شاه وفسد من تلك اللغة العامة الشائعة، كما هو الشأن في تعريف الكذبة في حد ذاته، حيث تعرض هو الآخر للتشويه. كنت قد تحدثْت قبل عدة سنوات أمام جمع غفير من كارهي بوش الابن وشانئيه، فحرصْتُ على التمييز بين الكذبة والغلطة (أو الخطأ أو الفشل والإخفاق) بخصوص أسلحة الدمار الشامل في العراق. انبرى أحد الحاضرين وهو لا يلوي على شيء –لا شك في أنه كان متحدثاً باسم الكثيرين– معرباً عن الرأي المثير للاهتمام بأن ما حدث قد حدث ولا يوجد فرق. لا بدّ أن هذا الشخص المتحمس للتعبير عن العبثية في سياق سياسي -وهي عبثية لا يمكن إطلاقاً التعبير عنها في أي سياق آخر– إنما يجسد “منطق اللا منطق، أو معقولية غير المعقول” حسب تعريف خوسيه أورتيغا جاسيت (José Ortega y Gasset) في مؤلَّفه الصادر عام 1929 “ثورة الجماهير أو تمرد الجماهير (The Revolt of the Masses)”:
تتميز صنوف الفاشية والسندكالية (مبدأ سيطرة منظمات العمال على وسائل الإنتاج وتوزيع المنتجات، ثم السيطرة على المجتمع والحكومة بسبيل الإضرابات العامة وما إليها من الوسائل) بالظهور الأول لنوع من الرجال لا يكترث أبداً لإبداء الأسباب أو حتى يعبأ بأن يكون على صواب، ولكنه يكون ببساطة مصمماً على فرض آرائه. كان هذا من مستحدثات الأمور ومستجداتها غير المألوفة: ألا يكون الصواب صواباً ولا يكون معقولاً: “منطق اللا منطق (the reason of unreason)”
تندرج الأمية الأخلاقية (Moral illiteracy)، كيفما حدثت، ضمن الأمور القبيحة. أما النوع المسنود منها بالأيديولوجية، فهو بشع وشائن بما يفوق حدود الوصف والتعبير، ويأتي بكلفة عالية لهدم المعنى المقصود من الكلمات نفسها، وتقويض أركانه، فتكون الألفاظ مجرد سقوف معلقة على أعمدة الهواء. وقد كان الأمر مضحكاً، ويظل كذلك، عندما نقرأ الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة لما كتبه لويس كارول (Lewis Carroll) في كتابه الشهير “عبر المرآة (Through the Looking Glass)” عام 1871:
قال همبتي دمبتي بلهجة ملؤها الاستخفاف والاحتقار: “عندما أستعمل كلمة من الكلمات، فإنها تعني ما أقول، لا أكثر ولا أقل”.
وقالت أليس: “السؤال هو عما إذا كنْتَ تجعل الكلمات تعني أشياء عديدة مختلفة”.
وقال همبتي دمبتي: “السؤال هو: ما الذي سيكون سائداً ومسيطراً –هذا كل ما في الأمر”.
ولكن عندما نقرأ جميع الأجزاء الثلاثة مقابل مرآة الوسط الحالي، ستعود بنا الذاكرة إلى هاري فرانكفورت؛ وعند التأمل سيصبح كل ذلك شيئاً أقل من أن يقال عنه: إنه فَكِهٌ وظريف.
فهم السياق:
كمـــا ورد في الجـــــزء الثــــــالث من هــــذه السلسلة المؤلفة من خمسة أجزاء، “لا يستقيم عقلاً –ولن يكون من المنطقي البتَّة– أن يكون في وجود القليل من الدعاوى العجيبة والمزاعم الغريبة، مع خطاب أو خطابين من خطابات الغلو والتشدد التي درج ديك تشيني نائب الرئيس على إلقائها، ما يثبت أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية كانوا يكذبون على طول الخط وفي جميع الأوقات، كما لو كانوا أعضاء في جمعية سرية شنيعة السلوك وشائنة السيرة، بخصوص المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل”. كانت هنالك أيضاً بعض المزاعم والدعاوى العجيبة التي تواترت تباعاً خلال الفترة بين الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 واندلاع حرب العراق في مارس (آذار) 2003، منها تلك التي تتعلق بكعكة “خام” اليورانيوم الصفراء بالنيجر؛ وهنالك الدعاوى التي ساقتها مايلروي وأشياعها، والتي تذهب فيها إلى أن الاستخبارات العراقية هي المسؤولة عن جميع المؤامرات والفظاعات الإرهابية في السنوات السابقة، من تفجير مركز التجارة العالمية عام 1993 إلى تفجير المبنى الاتحادي بمدينة أوكلاهوما في أبريل (نيسان) 1995؛ ومن ثم فإن الاستخبارات العراقية هي التي كانت تقف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أيضاً.
إلا أن كل ذلك، خلال 2002 وأوائل 2003، كان -أو أصبح- جزءاً من حملة انطلقت داخل الإدارة الأمريكية، ومن داخلها، لاستمالة الرئيس وإقناعه بأن يتخذ قرار الحرب، وأن يتخذه اليوم قبل الغد، قبل أن ترتفع حمّى موسم الحملة الانتخابية عام 2004. كان الفصيل المؤيد لقرار الحرب يرى أن ذلك لم يكن أمراً مضموناً على الإطلاق، لا سيما وأن أصواتاً أخرى في الإدارة –ليس أقلها صوت وزير الخارجية كولن باول– أعربت عن شكوكها حيال الحكمة من تلك السياسة أو على الأقل التوقيت السابق لأوانه، بينما لا تزال الحرب في أفغانستان في انتظار تحقيق النصر السياسي الذي لم يتحقق فيها بعد. بدا بوش غير قادر على اتخاذ قرار حاسم قبل صيف 2002؛ وكان في كل مرة ينجذب في اتجاه الرؤية التي يبديها آخر محاور يتجاذب معه أطراف الحوار.
البعيدون عن مجريات الأحداث، وكذا العليمون ببواطن الأمور، يميلون في كثير من الأحيان إلى تهويل مستوى التآلف والانسجام لدى أي نخبة سياسية مناوئة. وهم على إدراك تام بالانقسامات الداخلية في معسكرهم، ولكنهم في العادة يتجاهلون الدليل على وجود الانقسامات في المعسكر المناوئ أو يقللون من شأن ذلك الدليل[3]. لذا بالنسبة لكارهي بوش، فإن تفسير الدعاوى والمزاعم القليلة ولكنها متجانسة، وإن كانت غريبة في ذلك الوقت، لن يتحول إطلاقاً إلى ما كان في حقيقة الأمر عبارة عن حملة لخطب ود الرئيس وكسب رأيه: إنما كانت بدلاً عن ذلك بمثابة مؤامرة محكمة التدبير تهدف إلى الكذب، ثم تحري الكذب.
يذهب الكثيرون كذلك إلى إثبات القانون الذي ينصرف إلى أن المعرفة ديدنها الفصل والتمييز، وأن الجهل ديدنه الخلط والتجميع. لذا إذا كانت بعض الحجج التي سيقت عن أسلحة الدمار الشامل في العراق حججاً داحضة بصورة عجيبة، فهذا يعني أن جميع الحجج التي أُورِدَتْ عن أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت حججاً باطلة من أقصاها إلى أدناها، وبلُحْمَتها وسَداها. ثمة كاتب إسرائيلي يفكر في قدراته التحليلية بأكثر مما ينبغي، ويغالي في الاعتناء بها وفي إظهارها، زعم أخيراً في رسائل خاصة تبادلها معي، بعد مدة طويلة من الواقعة وكأنما كان ذلك على سبيل التباهي والتبجح والخيلاء والاستعراض، أنه ما أن سمع عن مسألة “كعكة” النيجر الصفراء حتى أدرك أن جميع الحجج المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل كانت باطلة وداحضة من أولها إلى آخرها. ولعل ما قُصِدَ منه التباهي والاستعراض لم يكن في واقع الأمر سوى إحراج بامتياز؛ إلا أن رؤيته إزاء القواعد الفعلية للبرهنة والإثبات كان بها الكثير من الغبش، وبما حال دون رؤيته للأمور على حقيقتها.
إن طريقته في الاستدلال المنطقي لم تكن منطقية، وإن كانت شائعة ومنتشرة للغاية. وبكل حال هذا هو كنهها، وهذه هي ماهيتها. إذا صح ذلك، فهو يعني أن الإشكاليات المتعلقة بأناس معيَّنين في البطانة المحيطة بنائب الرئيس تشيني كانت بمثابة النظير المكافئ للجهود المهنيَّة المضنية والمخلصة التي بُذِلت خلال عدة سنوات بعد عام 1991 من أناس من أمثال الدبلوماسيين السويديين ورؤساء لجنة الأمم المتحدة الخاصة “أونسكوم (UNSCOM)” التي أنشئت لنزع أسلحة الدمار الشامل من العراق بقرار من مجلس الأمن -رولف إيكوس وهانس بليكس، ومَنْ خلَفَهُما بعد الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، ديفيد كاي. بالطبع هذا عبث لا طائل من ورائه –وإن كان مؤثراً ومثيراً بالفعل لجهة أن بليكس وكاي، ومن بعدهما تشارلس دويلفر الذي حل محل كاي، هم الذين أبلغوا عن غياب أسلحة الدمار الشامل المتكدسة، عندما أصبح الدليل على الخطأ واضحاً وبادياً للعيان.
علاوة على ما تقدم، إذا كنتَ تكره آخرين فإن قانون الخلط يوجب عليك على وجه الحتم واللزوم أن تتصرف حيال دوافعهم بالمثل، وأن تحط من قدرها. ولهذا إذا كان كبار المسؤولين في إدارة بوش الابن تعمدوا الكذب جميعهم بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق ليتخذوها ذريعة لشن الحرب، فما هي -إذن- الأسباب الفعلية المفترضة التي دفعتهم للدخول في الحرب؟ تنقسم الإجابة الخيالية المتخيَّلة عن هذا السؤال إلى جزأين أساسيين:
في أحدهما، والذي يؤمن به الكثير من الأمريكيين الذين لديهم معرفة أفضل، كان الغرض بسيطاً: الهيمنة العسكرية على الشرق الأوسط، تماماً كما ترغب أي قوة إمبريالية حقيقية إذا أسعفتها الوسائل ونهضت بها القدرات. تكمن الإشكالية في هذه الحجة في أنه لا يوجد في أي من الوثائق المتعلقة بالسياسة الأمريكية في ذلك الوقت ما يثبت صحة ما انطوت عليه الحجة المذكورة. والحقيقة هي -دعونا نستدعِ ما ورد في الجزء الثالث من هذه السلسلة من المقالات -أنه لا توجد وكالة حكومية أمريكية، مدنية أو عسكرية، لديها ميزانية لهزيمة العراق واحتلاله على نحو يسوِّغ لأي أحد تسويق مثل هذه الدعوى. ولكن بطبيعة الحال لأنهم لا يعرفون هذه الحقيقة ولا يودون معرفتها؛ حيث يقتضي ذلك التقصي والبحث والتماس المعرفة الصحيحة من مظانّها الصحيحة حول كيفية الأداء الحكومي الفعلي –وهذا مما لا بد من اجتنابه لئلا تتأثر الجوانب التبسيطية الساذجة والمريحة في الفكر الأيديولوجي، وينقطع خيطها من جراء تعقيدات الحقيقة وتداخل خيوطها. بناءً على الدليل المعتبر، إذا أخطأ امرؤٌ في الاستراتيجية الأمريكية الكبرى والشاملة لمرحلة ما بعد الحرب وأساء فهمها على أساس أنها استراتيجية تقليدية إمبريالية أو تتعلق باحتلال الأراضي، يكون ذلك المرء ممن لا يمكن بأي حال مساعدتهم بأكثر من مساعدة مَنْ يصر على أن الأكاذيب والأخطاء تندرج سواءً بسواء تحت السلوكيات المتكافئة من الناحية الأخلاقية.
أما الدافع الثاني “الحقيقي” لخوض الحرب في العراق، فهو أكثر إحراجاً وإرباكاً لأي شخص على معرفة بالحقيقة. يتلخص هذا الدافع في الشعار الاحتجاجي الذي رفعه ماركسويد (Marxoid) “لا للدم مقابل النفط”. لذا كانت حرب العراق في المبتدأ والمنتهى تتعلق بالنفط؛ فهل كان الأمر كذلك؟
لا بد أن أي شخص يزعم هذا الزعم ليس لديه أي فكرة عن كيفية العمل وآليته في مجال صناعة النفط وفي سوق النفط –ذلك أن سعر النفط يُحدَّد عالمياً ويسعَّر بالدولار الأمريكي في خضم مجريات صناعة تتكامل عملياتها رأسياً/عمودياً، ويكون فيها استكشاف النفط والتنقيب عنه واستخراجه وتكريره ونقله وتسويقيه عبارة عن منظومة مترابطة الحلقات. أما فكرة أن أي دولة بمفردها، حتى لو كانت الولايات المتحدة، تستطيع بكل بساطة أن “تأخذ” نفط دولة أخرى وتستأثر به لنفسها، فهي فكرة غريبة وعجيبة. ماذا يعني هذا؟ أيعني أن حكومة الولايات المتحدة تستأجر ناقلات نفط لاستخراج النفط وتحميله كله على تلك الناقلات التي تمخر عباب المحيطات عائدةً أدراجها إلى الولايات المتحدة لتخزينه في مجموعة كاملة من مرافق تخزين النفط حديثة الإنشاء؟ إذا أقدمت الحكومة الأمريكية على شيء من هذا القبيل، وهو في حالة العراق قد يستغرق سنوات عديدة عطفاً على الكميات الاحتياطية الأكيدة، سيكون ذلك النفط هو النفط الأغلى ثمناً والأعلى كلفةً الذي يتم توفيره للمستهلك الأمريكي.
تشريح فشل استخباراتي:
أخيراً دعونا نتساءل: ما الذي حدث؟ وما أصل الخطأ الاستخباراتي المتعلق بأسلحة الدمار الشامل؟ وما الذي يفهمه -تقريباً- كل شخص عمل في حكومة الولايات المتحدة وفي العديد من الحكومات الحليفة في ذلك الوقت حيال ما حدث بالفعل؟
نبادر إلى القول: إن ما حدث لم يكن سراً بأي حال. فقد كان متاحاً في المصادر العامة للسنوات ذوات العدد. وأعتقد أنه كان مطروحاً كأفضــــــل ما يكون من قبـل شخص ألّف كتــاباً قبل مارس (آذار) 2003 بعنــوان “العاصــــــفة الوشـيكة، تبريـــــر حرب العـــراق (The Threatening Storm, advocating war with Iraq)”: كينيث بولاك (Kenneth Pollack) محلل المعلومات الاستخباراتية في إدارة كلينتون. ففي مقال تحت عنوان “جواسيس وأكاذيب وأسلحة: ما الخطأ الذي حدث؟ أو أين كان الخطأ كامناً؟” نُشِرَ في عدد يناير (كانون الثاني)/ فبراير (شباط) 2004 من مجلة أتلانتيك (Atlantic)، طرح بولاك مصادر الخطأ. من الأفضل لك أن تقرأ المقال بنفسك. ومع هذا يمكن تلخيصه بسهولة كما يلي:
أولاً: يلزم ألا يفوت على أحد أنه عندما دخل المفتشون الأمريكيون إلى الأجزاء العراقية الخاصة بعد حرب الخليج 1991، ذُهِلَ المسؤولون الاستخباراتيون الأمريكيون والمسؤولون الاستخباراتيون الآخرون أيما ذهول من مستوى التقدم الهائل والتطور المدهش للعراقيين في المجال النووي. يجيء هذا الاندهاش مقترناً بماضي وكالة الاستخبارات المركزية وإخفاقاتها السابقة في التكهن بالتقدم التقني السوفيتي وفي التكهن -على سبيل المثال- بمفاجأة “التفجير النووي السلمي” الهندي عام 1974. فقد كان سجل الوكالة حافلاً بالحالات المضطردة لسوء التقدير. وعلى هذا لما كانت وكالات الاستخبارات لا تحب أن تُضْبَط متلبِّسةً بارتكاب الخطأ نفسه بالطريقة نفسها مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، فقد ارتكبت وكالة الاستخبارات المركزية بدلاً عن ذلك خطأ في الاتجاه المعاكس. هذه هي الطبيعة البيروقراطية للنفس البشرية.
ثانياً: ومع هذا، كانت وكالة الاستخبارات المركزية والمنظمات المنتسبة إليها مدفوعة للقيام بما قامت به من جراء سلوك النخبة العراقية، وسلوك صدام حسين تحديداً. فقد أراد صدام أن يستفيد من مظهر من يمتلك قدرات أسلحة الدمار الشامل لأن هذا كان يساعده على ردع منافسيه الإقليميين ولجمهم، وبصفة خاصة إيران، والتي استخدم ضدها الأسلحة الكيميائية في أثناء حربه ضدها؛ كما أن هذا من شأنه ترويع ومن ثم إسكات، أي معارضة داخلية محتملة لنظامه. يجب أن نتذكر في هذا المقام حمْلة الأنفال التي شُنَّت بعد حرب الخليج ضد الأكراد المتمردين في العراق، وبصفة خاصة ما حدث في حَلَبْجَة. ولأجل هذا كان مفتشو الولايات المتحدة والمفتشون الآخرون مهتمين بمخزون الأسلحة البيولوجية والكيميائية أكثر من اهتمامهم بالأسلحة النووية؛ لأن الافتراض كان قائماً على أساس أن هذه هي الأدوات التي كان صدام يرغب في الاحتفاظ بها جزئياً لتهديد أبناء شعبه. وبطبيعة الحال، كان هذا كله عبارة عن خديعة مدبّرة، كما أن المفارقة تكمن في أن تلك الخديعة، ولأننا صدّقناها، هي التي أفضت في نهاية المطاف إلى أن يتم العثور على صدام في حفرته داخل الأرض، وإلى أن توصله أخيراً إلى حبل المشنقة. أما صدام نفسه، فقد كان بالمقابل يظن أننا كنا نخادعه؛ وللأسف، لم نكن نحن كذلك بالنسبة له.
اتضح أخيراً أن برامج أسلحة الدمار الشامل في العراق كانت موجودة منذ أمد بعيد، وظلت موجودة في أثناء الفترة التي شهدت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن وجولات التفتيش التي كان يجريها، والتي كانت بمثابة تهديد مفروض على النظام العراقي، وسيف مسلط على رقبته. بيد أن الكميات المتكدسة من الأسلحة إما أنه تم التخلص منها، أو تم نقلها إلى سوريا بمساعدة روسيا لتقليص الفرص أمام مفتشي لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالعراق لضبط تلك الأسلحة في العراق. وقد كان السوفيت، وأخيراً الروس، في خدمة صدام حسين على طول الخط، واضطلعوا بدور المحامي المدافع عن صدام من خلال إحباط جولات التفتيش التي تتم بناءً على الطلب، وتنبيه السلطات العراقية وتحذيرها عندما تكون جولات التفتيش على وشك التنفيذ. وكانت لعبة القط والفأر التي استمرت لعدة سنوات هي التي ساعدت على إقناع معظم الناس الواقعيين بأن صدام لديه ما يخفيه؛ وإلا فلماذا كان يذهب بعيداً إلى هذه الحدود ويسعى إلى إحباط المفتشين؟
من المؤكد أيضاً أن البرامج ظلت موجودة حتى وإن لم يكن هنالك وجود لكميات متكدسة من الأسلحة. لقد كانت “الدكتورة جرثومة” -البروفيسورة رحاب طه -حقيقية؛ كما أن البرامج أُودِعَتْ ببساطة تحت عهدة طرف ثالث تحسباً لليوم الذي تُرْفَع فيه العقوبات. تم توثيق تلك البرامج بصورة تفصيلية دقيقة في تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) 2004، كتبه تشارلز دويلفر الذي كان مسؤولاً في الاستخبارات الأمريكية لمدة طويلة، والذي حل محل ديفيد كاي. ولعل من دواعي الأسف أن دويلفر دفن الموضوع الرئيس للتقرير تحت ركام التفاصيل المسهبة في تقرير مطنب ومستفيض، مكون من ثمانية أجزاء. وهكذا كان العنوان الرئيس لجمعية مراقبة الأسلحة، على تقرير كتبه بول كير: “دويلفر يثبت بطلان المزاعم الأمريكية حول وجود أسلحة الدمار الشامل”. في حقيقة الأمر، نفى التقرير وجود كميات متكدسة من أسلحة الدمار الشامل والبرامج النشطة لتلك الأسلحة، ولكنه بالمقابل أثبت بصورة مقنعة وجود برامج أسلحة الدمار الشامل تحت العهدة والضمان لدى طرف ثالث.
ثالثاً: يجب تذكُّر أن عملية ثعلب الصحراء التي أطلقتها إدارة كلينتون في ديسمبر (كانون الأول) 1998 –التي ترتب عليها قصف مزعوم لعدة أيام لتمكين فرق التفتيش من الوصول بشكل أفضل إلى المرافق العراقية وفقاً لأوامر مجلس الأمن –انتهت بطرد المفتشين وعدم تمكنهم من الرجوع لمزاولة مهامهم. وفي أعقاب عملية ثعلب الصحراء، حُجِبَتْ الرؤية عن الاستخبارات الأمريكية واستخبارات الدول الحليفة، ولم تستطع معرفة ما كان يجري حقيقةً أو ما لم يكن جارياً بالفعل داخل العراق؛ وكانت النتيجة الكلية هي التشجيع على الحدس والتخمين لصالح الخطورة القصوى عطفاً على سجل الأخطاء السابقة في الاتجاه المعاكس.
الخطاب الذي ألقي أمام مجلس الأمن في فبراير (شبط) 2003:
دعُونا ننفذ مباشرةً إلى لب الموضوع وجوهره: عندما خاطب وزير الخارجية الأمريكي كولن باول (الذي وافته المنيّة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسة شهيرة بتاريخ 05 فبراير (شباط) 2003؛ أترى هل كان يكذب متعمداً؟ تزعم الأسطورة المدنية دونما تردد، ودونما دليل للبرهنة، أنه كان يكذب. أما الحقيقة، فهي أنه لم يكن كاذباً فيما قال وقتها.
مرة أخرى، لم يكن سراً كيف صيغ ذلك الخطاب في ذلك الوقت؛ ومع هذا يمكن الآن إضافة القليل من التفاصيل المفيدة إلى الرواية السردية الحالية. كما ورد من قبل، كانت هنالك معركة جارية على قدم وساق داخل الهياكل العليا للإدارة لأجل خطب ود الرئيس وكسب رأيه. كان باول على علم بجهود مكتب نائب الرئيس تشيني لاستخدامه ناطقاً بلسان الإدارة، لا سيما وأنه –خلافاً لمعظم الآخرين– يحظى بمصداقية يمكن الاستفادة منها؛ حتى إن تشيني صرح بمثل ذلك علناً. وافق باول في إطار تفاهمه السابق مع الرئيس على أن يظل مرابطاً مع بوش شريطة أن يسمح له بمحاولة تدويل الائتلاف الذي سيخوض الحرب إلى أقصى حد ممكن. أما البديل، كما طُرِحَ في الجزء الثالث من هذه السلسلة من المقالات، فهو أن يستقيل باول فيفسح المجال أمام احتمال أن يعمد من يحل محله إلى ترك الحبل على الغارب وإطلاق العنان وعدم تطبيق أي كوابح على الإطلاق على ما يرى باول أنها سياسة تفتقر إلى الرويّة والحصافة.
كان باول يقيم على مقربة من مقر وكالة الاستخبارات المركزية في لانجلي بولاية فيرجينا. ولذا فهو لا يتجشم كثير عناء في إمضاء الساعات الطوال في الوكالة مدققاً ومستنطقاً للمسودات المختلفة لنصوص الخطاب الذي فُرض عليه أساساً من قبل موظفي نائب الرئيس تشيني. وفي الوقت نفسه كانت الفرصة متاحة أمامه للاطلاع على التقييمات والتقديرات الأكثر حذراً وتحفظاً واحترازاً، والصادرة عن مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية التي يقود دفّتها.
وفي غضون ذلك كانت كاتبة الخطاب، لايين ديفيدسون، قد أمضت سنواتها السابقة في تحرير الخطابات لمدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينت. وكانت تعرف المكان جيداً، ولديها الفرصة للوصول إلى الأشخاص المهمين والمفيدين لمساعدتها على وزن المعطيات والعناصر المكونة للحقائق الواقعية والوقائع الحقيقية، وتقييم تلك العناصر التي يمكن إدراجها في الخطاب. استبعد باول، بمساعدة ديفدسون، أي شيء لم يتمكن الخبراء المهنيون من تأكيده أو لم يشأ أي منهم تأكيده؛ ويشمل ذلك الخبراء والمختصين في وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية. بعد ثلاثة أيام بلياليها من الجهود المضنية في صياغة الخطاب وتدبيج عباراته وترتيب فقراته، أصبح باول على قناعة معقولة بأنه لن تكون هنالك مزاعم غير مؤسسة، أو دعاوى لا أساس لها من الصحة، من شأنها إفساد العرض والتشويش عليه.
بصفتي محرراً لخطابات باول خلال الجزء الأكبر في السنتين اللتين أعقبتا تلك الحادثة، أستطيع أن أشهد وأؤكد من واقع خبرتي وتجربتي الشخصية أن باول –على خلاف بعض من حل محلهم أو حلوا محله– كان يحرص على أن ينقِّح كل جملة ويقلِّبها من الأوجه كافة ويجلوها ويستجلي مدلولاتها في النص المقترح لأي خطاب؛ فهو لا يقرأ أي شيء يقدمه له موظفوه. فقد أكدت لي ديفيدسون الكثير من هذا القبيل عن مفعولات خطاب فبراير (شباط) 2003: لقد كان يدقق في كل جملة بعين الناقد الأريب.
عكف باول وديفيدسون خلال تلك الأيام الثلاثة على استبعاد جميع الزوائد وإزالة جميع البثور، وسحب جميع الدعاوى والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة، أينما وجداها في الخطاب، باستثناء اثنتين أو ثلاث من الدعاوى في الخطاب؛ كانت إحداها تتعلق بمعنى رسالة جرى اعتراضها بين المسؤولين العراقيين، وثانية تتعلق بمختبر بيولوجي متنقل، وأخريات قلائل اتضح أنها لم تكن دقيقة. ولكن كانت هذه عبارة عن أخطاء غير مؤثرة وطفيفة، كتلك التي تنتج عن الفرق بين النتائج التي نحصل عليها بالملاحظة والنتائج المحسوبة على أساس صيغة ما. فهي إذاً ليست أكاذيب إلا إذا بُتِرَتْ كلمة “كذبة” من سياقها الدلالي المألوف وأخرِجت من معناها الاعتيادي لتعني شيئاً مختلفاً تمام الاختلاف.
هذا ما حدث بالفعل وما تشهد عليه جميع الوثائق ذات العلاقة –وهي وثائق بعضها متاح لعموم الأفراد وبعضها الآخر لم يصبح متاحاً بعد. لا يوجد مثقال ذرّة من دليل فِعْلي على أن ثمة أكاذيب متعمدة وجدت طريقها عن قصد إلى خطاب باول.
طبيعة اللغة السياسية (طبيعة لغة السياسة):
الأمر سيان، فلا فرق البتة. وكما ورد آنفاً لم يعد هنالك أحد يستطيع استخراج “كذبة أسلحة الدمار الشامل” وانتزاعها من مخزون الأسطورة المدنية إلا كمن يستطيع نزع مسمار بلا رأس غُرِزَ عميقاً في لوح من الخشب الصلب. ولتوضيح كيف أن العواطف والنزعات الأنانية متداخلة بطريقة شديدة التشابك في هذا الموضوع، أعرف شخصاً انتقص من قدر باول وكال له عبارات الذم والاستهجان في فترة دق طبول الحرب، وعندما كانت الاستعدادات جارية على قدم وساق لخوض غمارها؛ وذلك لأن باول تجرأ على الشك في الضرورة الملحّة للحرب. كانت عبارة “المقاتل المتردد أو المقاتل الكاره للقتال” تعد تعبيراً مخففاً بالمقارنة مع الطريقة التي تحدث بها ذلك الشخص (وهو صديق قديم) في ذلك الوقت عن موقف باول. فإذا بذلك الشخص نفسه، والذي شغل منصباً مرموقاً في وزارة الخارجية في عهد كوندوليزا رايس بعدما تركت أنا الخدمة معها في مايو (أيار) 2005، يتخذ موقفاً مغايراً تماماً بعد سنوات قليلة فيصبح شارحاً وموضحاً -بصورة تنم عن الندم وتستصحب الشعور بالإثم- لوجهة النظر التي تذهب إلى أن حرب العراق كانت فاجعة كارثية النتائج والتداعيات. أصبح هذا الشخص بعدئذٍ ينتقد باول لأنه لم يفعل الكثير لإيقاف حرب كان الشخص المذكور يدافع عنها بحماس منقطع النظير في ذلك الوقت. يصعب إيراد أي حجج ضد هذا النوع من “المنطق”.
كان باول يعرف أن الحياة السياسية ليست خالية تماماً من العيوب؛ وكان يعرف أن الناس الذين يعتقدون أن الحياة ينبغي أن تكون رحيمة وعطوفة إزاءهم، لمجرد أنهم أناس جيدون ويحق لهم أن يتوقعوا العطف والرحمة والحنو، كمن يتوقع أن ثوراً لن يهاجم أحداً لمجرد أنه نباتي لا يتناول اللحوم. ولذلك في حين أن باول ظل ندمان أسفاً إلى أن مات على ما حدث، لم يكن من عادته أن يمارس جلد الذات بصورة مفْرطة بسبب ما حدث.
لسوء الحظ، يعد عدم الواقعية المصحوب بالوقاحة ورداءة الطبع بمثابة الطبيعة الثانية للسجال السياسي الذي قلّما يظهر فيه المنطق أو يطل فيه العقل برأسه. إلا أن هنالك أوقات، كتلك التي نعيش فيها حالياً، يبدو فيها أن المنطق في إجازة لتناول وجبة الغداء في فينّا. أما لماذا؟ فهي ليست المرة الأولى. وقد عبّر عنها أورويل على النحو الأمثل في مقال كتبه عام 1946 بعنوان “أمام ناظريْك (In Front of Your Nose)”:
لكي ترى بوضوح ما هو أمام ناظريك يلزمك التزام المناجزة والمقاومة المستمرة. في الحياة الخاصة، يكون معظم الناس واقعيين بصورة معقولة. عندما يخطط أحدهم لميزانيته الأسبوعية، فإن حاصل جمع اثنين زائداً اثنين يساوي أربعة، ويظل هذا ثابتاً. ومن الناحية الأخرى، تكون السياسة نوعاً من العالَم المتعلق بالجزيئات الأصغر من الذرّة أو العالَم غير الإقليديسي؛ أو غير الأُقليديّ: غير المُتَعَلِّق بأُقْليدس (non-Euclidean world)، حيث يصبح من السهل تماماً للجزء أن يكون أكبر من الكل، أو لمادتين أن تحتلّا الحيز المكاني نفسه في الوقت نفسه، وفي آنٍ معاً؛ وهكذا تظهر التناقضات والعبثية؛ وهي تعود جميعها في نهاية المطاف إلى معتقد سري تكون بموجبه الآراء السياسية للفرد غير قابلة للفحص والتمحيص بعرضها على مرآة الحقيقة الراسخة –خلافاً للميزانية الأسبوعية.
***
هذا ما حدث: قلّة من النقاد البعيدين عن مجريات الأحداث هم الذين سيسمحون بفحص معتقداتهم السياسية والمتعلقة بالسياسة بعرضها على مرآة الحقيقة وقياسها بمسطرة الواقع. يمكنهم أن يتخذوا موقفاً عقلياً أو حالة مزاجيةً وأن يلونوا جميع ما يريدون بفرشاة الفضيلة، ولن يدفعوا أي ثمن لجهلهم المقترن بالنفاق والتظاهر بالتقوى. صحيح أن الحقيقة لا تذهب بعيداً ولا تختفي؛ ولكن من المؤكد أنها تميل إلى أن تبتعد عن بعض الناس.
[1]– “The Darkening Mind”, American Purpose, December 7, 2020, and “The Collapse of Reality”, American Purpose, February 1, 2021
[2]– See my “The Erosion of Deep Literacy”, National Affairs (Spring 2020).
[3]– For the social science evidence on this point, see Robert Jervis, Perception and Misperception in International Relations (Princeton University Press, 1976), chapter eight, especially p. 324.